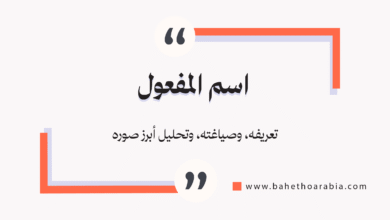الصفة المشبهة باسم الفاعل: تعريفها، أوزانها، ودلالتها على الثبوت

مقدمة: الكشف عن أسرار الصفة المشبهة باسم الفاعل
في رحاب اللغة العربية الواسعة، تبرز المشتقات كأدوات دقيقة تمنح الكلام عمقاً ومرونة. ومن بين هذه المشتقات، تحتل الصفة المشبهة باسم الفاعل مكانة فريدة، فهي لا تصف فحسب، بل ترسخ الصفة في الموصوف وكأنها جزء لا يتجزأ من كيانه. هذا المقال هو دليل أكاديمي شامل يستعرض ماهية الصفة المشبهة باسم الفاعل، ويغوص في قضية الثبوت والتغير التي تحيط بها، ويستعرض أشهر أوزانها وصيغها، وكيفية اشتقاقها، مما يقدم للقارئ فهماً متكاملاً لهذا المبحث الصرفي الهام.
تعريف الصفة المشبهة باسم الفاعل ودلالتها الأساسية
تُعرَّف الصفة المشبهة باسم الفاعل بأنها اسم مشتق من مصدر الفعل، وتأتي للدلالة على صفة ثابتة في صاحبها. من الأمثلة على ذلك: حَسَنٌ، كريمٌ، لطيفٌ، شجاع، جبان، أحمر، أسود، أحمق، طرب، فرح، سكران. فعندما نقول: “خالد كريم”، تدل فيه كلمة “كريم” على صفة ثابتة في خالد، وهذه هي الوظيفة الجوهرية التي تؤديها الصفة المشبهة باسم الفاعل.
وقد تُحمل بعض الأسماء الجامدة على معنى الصفة المشبهة باسم الفاعل، نحو: أب، أم، ابن، بنت، أخ، ذو، للدلالة على الكمالية في تلك الصفة. إن الصفة المشبهة باسم الفاعل تحمل هذا الاسم لأنها تشبه اسم الفاعل أو اسم المفعول؛ فكلمة (كريم) تشبه (كارم)، وكلمة (كريه) تشبه (مكروه). يكمن وجه الشبه في أن اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل، كلها تدل على صفة قائمة في صاحبها. والفرق الأساسي بينها هو دلالة الصفة المشبهة باسم الفاعل على الثبوت، فحتى إن لم تكن دالةً على الثبوت الحقيقي، فإن صياغتها النحوية تدل على إرادة الثبوت والترسيخ.
قضية الثبوت والتغير في الصفة المشبهة باسم الفاعل
إن قضية الثبوت في الصفة المشبهة باسم الفاعل هي قضية نسبية، تتحقق أحيانًا، ويمكن ألا تتحقق في كثير من الأحيان. فقد تدل الصفة المشبهة باسم الفاعل على التغير، وقد تحدد بزمن معين، نحو قولك: “أنت فرح”، فالفرح شعور لا يستمر في الفرح، فهي هنا صفة طارئة. وتقول: “كان أخوك مريضاً، ولكنه أصبح صحيحاً”، و”أنت حزينٌ الآن”. فالصفات المشبهة (مريض، صحيح، حزين) في الجمل السابقة هي ذات أوقات محددة، مما يوضح مرونة دلالة الصفة المشبهة باسم الفاعل.
أشهر أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل
ليس للصفة المشبهة صيغ مُطّردة وثابتة، ولكنها غالباً ما تصاغ من مصدر الفعل اللازم، وتحديداً من بابي (فَعَل يفعِل، و فَعُل يفعُل). وتُعد معرفة أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل من أساسيات فهمها. وأشهر صيغها هي:
- أفْعَل: ومؤنثه فَعلاء، والجمع فُعْل. نحو: أحمر *** حمراء (ج. حُمْر)، أعرج *** عرجاء (ج. عرج)، أصم *** صماء (ج. صم)، أبكم *** بكماء (ج. بكم)، أخرس *** خرساء (ج. خرس)، أحمق *** حمقاء (ج. حمق)، أشمط *** شمطاء (ج. شمط).
- فَعْلان: ومؤنثه فَعْلى. نحو: عطشان *** عطشى، جَوْعان *** جوعى، ريّان *** ريّا، حرّان *** حرّى، غرثان *** غرثى، سكران *** سكرى.
- فَعَل: نحو: حَسَن، بَطَل.
- فُعُل: نحو: جُنُب، وهو وزن قليل الاستخدام في الصفة المشبهة باسم الفاعل.
- فُعال: نحو: شُجاع وفُرات.
- فَعَال: نحو: جَبَان وحصان.
- فَعْل: نحو: سبط وضَخْم وسَهْل.
- فِعْل: نحو: صِغْر ومِلْح.
- فُعْل: نحو: حُرّ وصُلْب.
- فَعِل: نحو: فَرِح، بَطِر، أَشِر، شرِس، غضب، فَطِن، لبقٌ، كَمِدٌ.
- فاعِل: نحو: صاحب، طاهر.
- فعيل: نحو: كريم، عفيف، طويل، قليل، خليٌ، بخيل. وهذه الصيغة من أشهر صيغ الصفة المشبهة باسم الفاعل.
- فيعِل: نحو: سَيِّد، طيِّب، هيِّن.
- فيعَل: نحو: فيصّل، صَيرف.
صيغ سماعية أخرى للصفة المشبهة باسم الفاعل
إلى جانب الأوزان القياسية، توجد لصيغ الصفة المشبهة باسم الفاعل أشكال سماعية كثيرة، يدل على معناها السياق الذي ترد فيه. من هذه الصيغ: طُوال، كُبّار، بُهلول، صِنديد، رِعديد، سلسال، عرمرم، دِعبِل، زمهرير، قمطرير، سلهب، عريان.
تحويل اسم الفاعل واسم المفعول إلى الصفة المشبهة باسم الفاعل
يجوز تحويل اسم الفاعل ليدل على معنى الصفة المشبهة باسم الفاعل، ويتم ذلك بإضافته إلى فاعله أو إلى مفعوله. تقول: الله واسع المغفرة، أخوك راحم القلب، الله خالق الأكوان، مالك كل شيء، أنت راجح العقل، حاضر البديهة، شامخ الرأس. ويجوز تحويل الفاعل إلى تمييز، نحو: أنت راجحٌ عقلاً، حاضرٌ بديهةً، شامخٌ رأساً. ويجوز رفعه، نحو: خالدٌ راجحٌ عقله، حاضرة بديهته، شامخٌ رأسه.
وكذلك يجوز تحويل اسم المفعول إلى الصفة المشبهة باسم الفاعل بإضافته إلى نائب الفاعل، أو برفع نائب الفاعل بعده، أو بتحويل نائب الفاعل إلى تمييز. نحو: أخوك مشكور العملِ، أو مشكورٌ عملُه، أو مشكورٌ عملاً. وتقول: أخوك محصنُ الخلقِ، أو مُحْصَنٌ خلقهُ، أو محصنٌ خلقاً. إن هذه المرونة تزيد من غنى استخدام الصفة المشبهة باسم الفاعل.
صياغة الصفة المشبهة باسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي
بناءً على ما سبق، فإن الصفة المشبهة باسم الفاعل المشتقة من غير الثلاثي المجرد تكون على وزن اسم الفاعل المضاف إلى فاعله، إن كان الفعل لازماً، أو تكون على وزن اسم المفعول مضافاً إلى نائب فاعله إن كان الفعل متعدياً. من أمثلة الصفة المشبهة باسم الفاعل من الفعل اللازم: مرتفع القامة، مشتد العزيمة، معربد الخلق، مستقيم الرأي. ومن أمثلتها من الفعل المتعدي: مُبعثَر التفكير، مُزلزل النفس، مُزخرف الثياب، مقطّع الحديث.
خاتمة: الأهمية البلاغية للصفة المشبهة باسم الفاعل
وفي الختام، يتضح أن الصفة المشبهة باسم الفاعل ليست مجرد مصطلح صرفي، بل هي أداة لغوية وبلاغية تمنح الوصف قوة الثبوت والرسوخ. من خلال استعراض تعريفها الدقيق، ومرونتها في الدلالة على الثبوت النسبي، وتعدد أوزانها القياسية والسماعية، وصولاً إلى كيفية صياغتها من الأفعال الثلاثية وغير الثلاثية، ندرك عمق الدور الذي تلعبه الصفة المشبهة باسم الفاعل في إثراء التعبير العربي. إن إتقان هذا المبحث يفتح آفاقاً أوسع لفهم جماليات اللغة ودقة بنيتها التركيبية.
سؤال وجواب
١ – ما هو الفرق الجوهري بين الصفة المشبهة باسم الفاعل واسم الفاعل؟
الفرق الجوهري يكمن في الدلالة الزمنية وطبيعة الصفة. الصفة المشبهة باسم الفاعل تدل على صفة ثابتة، راسخة، أو طبيعة ملازمة للموصوف، مثل “كريم” أو “شجاع”. أما اسم الفاعل فيدل على صفة متجددة وحادثة، مرتبطة بزمن معين (الآن أو المستقبل)، وتدل على من قام بالفعل على وجه الحدوث، مثل “كاتب” (شخص يقوم بالكتابة الآن) أو “جالس” (شخص يقوم بالجلوس). فالثبوت واللزوم هو سمة الصفة المشبهة، بينما الحدوث والتجدد هو سمة اسم الفاعل.
٢ – لماذا سُميت الصفة المشبهة “باسم الفاعل” تحديداً؟
سُميت الصفة المشبهة باسم الفاعل بهذا الاسم لأنها تشبه اسم الفاعل في كونها تدل على من قام بالفعل أو اتصف به، كما أنها تعمل عمل فعلها فترفع فاعلاً في المعنى (معمولها). فكما أن “ضارب” يدل على من قام بالضرب، فإن “حسن” تدل على من اتصف بالحُسن. إلا أنها تخالفه في أنها لا تدل على الحدوث، بل على الثبوت، ولذلك اكتسبت هذا الاسم المركب الذي يجمع بين الشبه (في العمل والدلالة على صاحب الصفة) والاختلاف (في الدلالة على الثبوت).
٣ – كيف يمكن للصفة المشبهة أن تدل على صفة متغيرة رغم أن أصل دلالتها الثبوت؟
إن قضية الثبوت في الصفة المشبهة باسم الفاعل هي قضية “ثبوت نسبي” أو “ثبوت في الصياغة”. فعندما تُستخدم الصفة، فإن القصد اللغوي منها هو إظهار الصفة وكأنها ثابتة في تلك اللحظة الموصوفة، حتى وإن كانت في الواقع صفة عارضة. فقولك “أنت فرحٌ الآن” يستخدم صيغة تدل على الثبوت (فَعِل) لوصف حالة الفرح كأنها تملأ كيان الشخص في تلك اللحظة، وهذا أبلغ من قول “أنت تفرح”. فالصياغة نفسها هي التي تحمل معنى الثبوت المقصود، لا بالضرورة طبيعة الصفة في الواقع.
٤ – ما هي أشهر الأوزان التي تأتي عليها الصفة المشبهة من الفعل الثلاثي؟
تتعدد أوزان الصفة المشبهة باسم الفاعل، ولكن أشهرها وأكثرها شيوعاً من الفعل الثلاثي هي:
- فَعِيل: للدلالة على السجايا والطبائع، نحو: كريم، بخيل، شريف، طويل.
- أَفْعَل: الذي مؤنثه “فَعْلاء”، ويدل غالباً على الألوان والعيوب والحلى، نحو: أحمر، أعرج، أكحل.
- فَعْلان: الذي مؤنثه “فَعْلَى”، ويدل غالباً على الامتلاء أو الخلو، نحو: عطشان، غضبان، ريّان.
- فَعَل: نحو: حَسَن، بَطَل.
- فَعِل: للدلالة على الحالات النفسية والعوارض، نحو: فَرِح، قَلِق، أَشِر.
٥ – كيف تتم صياغة الصفة المشبهة من الأفعال غير الثلاثية؟
تُصاغ الصفة المشبهة باسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي على نفس وزن اسم الفاعل أو اسم المفعول من ذلك الفعل، مع إضافة معمولها بعدها لإرادة الثبوت.
- إن كان الفعل لازماً: تُصاغ على وزن اسم الفاعل ثم تضاف إلى فاعلها، نحو: “معتدلُ القامةِ” من الفعل اعتدل، و”مستقيمُ الرأي” من الفعل استقام.
- إن كان الفعل متعدياً: تُصاغ على وزن اسم المفعول ثم تضاف إلى نائب فاعلها، نحو: “مُهذَّبُ الطبعِ” من الفعل هُذِّبَ، و”مُحكمُ الصنعةِ” من الفعل أُحكِمَ.
٦ – ما هي الحالات الإعرابية للاسم الواقع بعد الصفة المشبهة (معمولها)؟
يجوز في معمول الصفة المشبهة باسم الفاعل ثلاث حالات إعرابية، وهي:
- الرفع: على أنه فاعل للصفة المشبهة، نحو: “محمدٌ حَسَنٌ خُلُقُه”.
- النصب: على أنه تمييز إذا كان نكرة، أو “شبيهاً بالمفعول به” إذا كان معرفة، نحو: “محمدٌ حَسَنٌ خُلُقاً”.
- الجر: على أنه مضاف إليه، نحو: “محمدٌ حَسَنُ الخُلُقِ”. وهذا الاستعمال هو الأكثر شيوعاً لأنه الأقوى في الدلالة على الثبوت واللزوم.
٧ – هل يمكن اشتقاق الصفة المشبهة من فعل متعدٍ؟
الأصل والغالب في اشتقاق الصفة المشبهة باسم الفاعل أن يكون من مصدر الفعل الثلاثي اللازم، خاصةً من بابي “فَعُلَ يَفعُل” الذي يدل على الغرائز والطبائع، و”فَعِلَ يَفعَل” الذي يدل على الحالات العارضة. أما اشتقاقها من الفعل المتعدي فهو قليل ونادر، وإذا حدث، فإنه غالباً ما يكون على صيغة “فعيل” بمعنى “مفعول”، مثل: “قتيل” بمعنى مقتول، و”جريح” بمعنى مجروح، وهنا يقرب معناها من اسم المفعول أكثر.
٨ – كيف نفرّق بين صيغة “أفْعَل” التي تأتي صفة مشبهة وتلك التي تأتي اسم تفضيل؟
يمكن التفريق بينهما من خلال عدة علامات سياقية ونحوية:
- المؤنث: مؤنث “أفعل” في الصفة المشبهة باسم الفاعل هو “فَعْلاء” (أحمر، حمراء). أما مؤنث اسم التفضيل فهو “فُعْلَى” (أكبر، كُبرى).
- الدلالة: الصفة المشبهة تدل على صفة قائمة في الموصوف دون مقارنة (رجلٌ أحمرُ). أما اسم التفضيل فيدل على المفاضلة والمقارنة بين شيئين اشتركا في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها (خالدٌ أطولُ من علي).
- الاستعمال: اسم التفضيل غالباً ما يُتبع بحرف الجر “مِنْ” للمقارنة، أو يضاف إلى نكرة أو معرفة بقصد التفضيل.
٩ – ما قيمة الصيغ السماعية الكثيرة للصفة المشبهة؟
تدل الصيغ السماعية الكثيرة (مثل: صنديد، بهلول، رعديد) على ثراء المعجم العربي وقدرته على التعبير عن أدق الفروق في المعاني. هذه الصيغ، رغم عدم قياسيتها، تحمل دلالات بلاغية وموسيقية قوية، وتستخدم غالباً لإعطاء معنى الصفة زخماً ومبالغة، مما يجعلها فعالة جداً في الشعر والنثر الفني لترسيخ الصورة الذهنية للموصوف.
١٠ – ما هي القيمة البلاغية لاستخدام الصفة المشبهة باسم الفاعل في الكلام؟
تكمن القيمة البلاغية الأساسية في قدرة الصفة المشبهة باسم الفاعل على تحويل الصفة من مجرد وصف عابر إلى سمة جوهرية وطبيعة متأصلة في الموصوف. استخدامها يمنح الكلام قوة وثباتاً، ويجعل الصورة أكثر رسوخاً في ذهن المتلقي. فهي أداة بلاغية تُستخدم في المدح والذم ووصف الطبائع لترسيخ الصفة وجعلها جزءاً لا يتجزأ من هوية الموصوف.