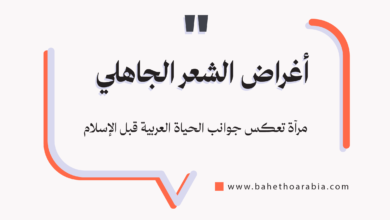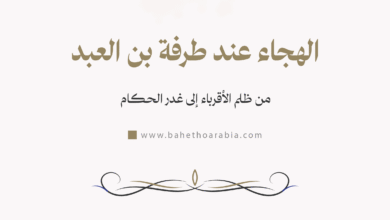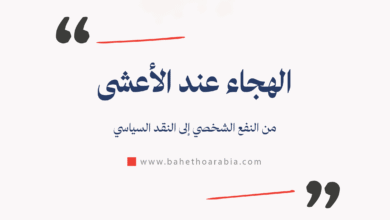الحكمة في الشعر الجاهلي: تعريفها، مصادرها، وأبرز موضوعاتها

في صحراء شبه الجزيرة العربية، حيث كانت الحياة صراعًا دائمًا مع الطبيعة وتقلبات الدهر، لم يكن الشعر مجرد فنٍ للترفيه أو التفاخر، بل كان ديوان العرب وسجل حياتهم ومرآة عقولهم. ومن بين أغراضه المتعددة، برزت “الحكمة” كجوهرٍ ثمين يعكس عمق النظرة الإنسانية في فهم الوجود. لم تكن هذه الحكمة نتاج فلسفات نظرية معقدة، بل كانت عصارة تجارب حية، وخلاصة تأملات ولدت من رحم المعاناة والنجاح، الفقر والغنى، والحياة والموت.
تغوص هذه المقالة في أعماق الحكمة في الأدب الجاهلي، فتبدأ بتحديد مفهومها اللغوي والفلسفي، وتكشف عن مصادرها الأصيلة المتجذرة في التجربة الإنسانية. ثم تنتقل لتحلل أبرز محاورها، وعلى رأسها الجدلية الخالدة بين الحياة والموت، مرورًا بالنظرة الواقعية للمال والناس، وانتهاءً بلمحات ثاقبة في الأخلاق والسياسة. وأخيرًا، ترسم المقالة السمات المميزة التي جعلت من حكمة الجاهليين بصمة فريدة في تاريخ الفكر الإنساني، خالدة بخلود الشعر الذي حملها إلينا.
تعريف الحكمة ومكوناتها
تُعرّف الحكمة في اللغة بأنها العدل والإتقان. ففي “اللسان“، يُقال إنّ “الحكمة العدل”، وأن “أحكم الأمر” تعني “أتقنه”. وتُطلق صفة “الحكيم” على الرجل الذي “قد أحكمته التجارب”، أي أصبح متقنًا للأمور.
أما في المعجم الفلسفي، فالحكمة هي العلم والتفقه. فقوله تعالى: ﴿ولقد آتينا لقمان الحكمة﴾ يعني العلم والفهم. وتُعرّف الحكمة أيضًا بأنها العدل، والكلام الموافق للحق، وصواب الأمر، ووضع الشيء في موضعه الصحيح. وقيل أيضًا إنها “معرفة الحقائق على ما هي عليه بقدر الاستطاعة”، وهي “العلم النافع” الذي يُعبر عنه بمعرفة ما للإنسان وما عليه، أو “معرفة الحق لذاته، ومعرفة الخير لأجل العمل به”.
الجانبان النظري والعملي للحكمة
يتضح من هذه التعريفات أن للحكمة وجهين أساسيين: وجه نظري ووجه عملي.
- الوجه النظري: يمثل المعرفة العميقة والإدراك الدقيق لحقائق الحياة والكون. وكما عرّفها ابن سينا، هي “صناعة نظر يستفيد بها الإنسان تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه، وما عليه الواجب مما ينبغي أن يكسبه فعله لتشرف بذلك نفسه، وتستكمل عالماً معقولاً مضاهياً للعالم الموجود”. غاية هذا الجانب هي بلوغ الحق المجرد.
- الوجه العملي: يتجلى في تطبيق المُثل والقيم التي يدركها العقل السليم، بهدف تحقيق السعادة والطمأنينة. غاية هذا الجانب هي تطبيق المبادئ لأنها خير، والخير أولى بالاتباع.
إذاً، الحكمة الحقيقية هي علم وعمل متلازمان. فالشخص لا يُعد حكيمًا إذا كان عالمًا ولكنه لا يعمل بمقتضى علمه، أو إذا كان يعمل دون فهم مبادئ علمه. لذلك، لا تصدر الحكمة في أغلب الأحيان إلا عن العقلاء المجربين والمتبصرين بعواقب الأمور، مما يمكّنهم من النطق بكلمات جامعة تُعبّر عن أحوال الناس بعبارات قليلة.
تعريف الحكمة في الشعر وتأثرها بالبيئة
يمكن تعريف الحكمة في الشعر بأنها القدرة على تكثيف الأفكار العميقة في ألفاظ دقيقة ومركزة، بحيث تحمل الأبيات القليلة معاني عظيمة، وهي ما أطلق عليه العرب “جوامع الكلم”.
إن الحكمة ليست مجرد أفكار نظرية مجردة، بل هي مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بظروف الحياة. فهي تتأثر بالبيئة المحيطة، والعصر الذي تنشأ فيه، وخصائص الشخص الذي يصوغها. وهذا ما يفسر وجود لون خاص لكل شاعر، نابع من اختلاف طبائعهم وتفاوت نظرتهم إلى الحياة والواقع.
لذلك، نجد أن حكمة زهير بن أبي سلمى تختلف عن حكمة طرفة بن العبد، وعن حكمة الأفوه الأودي، وعن حكمة امرئ القيس. حتى عندما تنبع الحكمة من واقع مشترك وتجربة واحدة، فإن صور التعبير ووسائله تتباين، مما يجعل لكل كلمة طابعاً خاصاً يعكس مزاج الشاعر.
وبناءً على هذا الاختلاف، يمكننا ملاحظة أنماطاً متباينة في الحكمة الشعرية؛ فبعضها يتسم بالهدوء والاتزان والأسلوب الوعظي والرضا الإرشادي، بينما يتسم بعضها الآخر بالتشاؤم واليأس والمرارة والتمرد على الواقع القاسي.
مصادر الحكمة الرئيسة والثانوية
إن المصدر الأول للحكمة هو تجارب البشر وذكاؤهم وبصائرهم النفاذة. وتنشأ الحكمة من تأمل الماضي والحاضر، واستخلاص العبرة العامة من المواقف الخاصة، والنظر في جوانب الحياة المختلفة وقياس بعضها على بعض.
قد تكون للحكمة مصادر أخرى مثل فلسفة القدماء، والوحي السماوي، والقيم الأخلاقية، والتشريعات الدينية. إلا أن تأثير هذه المصادر كان محدوداً في الشعر الجاهلي، وذلك لقلة حظ الجاهليين منها، واعتمادهم الأكبر على التجربة الحية والعملية.
ويمكن إيجاد العذر للعرب في ضمور هذه المصادر، فبسبب عدم استقرارهم في ممالك ذات حضارة مستقرة ومؤسسات تعليمية مثل المعاهد والمدارس التي عرفها الإغريق، لم يتسن لهم دراسة فلسفات الأمم الأخرى والاقتباس منها. وخير مثال على ذلك هو اقتباس أبي الطيب المتنبي في العصر العباسي من آراء أرسطو. لهذا السبب، ظل المصدر الرئيسي للحكمة عندهم هو الحس الصادق المقرون بالذكاء الفطري، والتجارب الحياتية التي ينظمها العقل بشكل دقيق.
وسائل حفظ الحكمة وخلودها (الأمثال والشعر)
نظرًا لأن العرب كانوا يعتمدون على الحفظ الشفوي بدلاً من الكتابة، فقد خلّدوا حكمهم في نمطين من الكلام يسهل حفظهما ونقلهما: الأمثال والشعر.
- المثل: هو جملة موجزة وقوية وعميقة، تتميز بالشمولية التي تجعلها قابلة للتطبيق على آلاف الحالات المختلفة.
- الشعر: هو كلام موزون ومُقفّى، يتميز بسرعة تعلّقه بالذاكرة وجاذبيته للسمع، بالإضافة إلى إيقاعه العذب وصوره المؤثرة وعواطفه الجياشة.
غالبًا ما يلتقي هذان النمطان ليُصبحا نمطًا واحدًا، حيث يأتي المثل على وزن الشعر كأنه شطر من بيت، أو يتحول البيت الشعري إلى مثل متداول بعد انفصاله عن قصيدته الأصلية. وفي هذه الحالة، تبقى الحكمة راسخة في الذاكرة بينما تُنسى التجربة والمناسبة التي ولدت البيت.
لا نبالغ إذا قلنا إن كثيرًا من القصائد تُروى فقط لما تحتويه من حكم، وإن الحكم الموجزة تخلّد الشعراء أكثر من قصائدهم الطويلة. بل إن العديد من الحكم تظل راسخة في الذاكرة العربية حتى بعد أن تُنسى أسماء الحكماء الذين توصلوا إليها.
يكمن سبب هذا الخلود في أن العربي في حله وترحاله لم يكن لديه قانون مكتوب يحتكم إليه أو دستور يسترشد به. لهذا، كان يستوحي الحكمة من الشعر والأمثال ليضيء بها في معضلاته، ولم يكن يعنيه معرفة قائلها بقدر ما كان يعنيه الاحتجاج بالقول نفسه. ولهذا السبب، نجد مجموعة كبيرة من الأمثال والأبيات الشعرية التي لا يُعرف أصحابها، ومع ذلك تحظى بمكانة خاصة عند العرب الذين يحفظونها ويشرحونها ويحددون المواضع المناسبة لقولها والتمثل بها.
أ -الموت
يُعَدّ الموت في التصوّر الشعري العربي القديم رحلةً بلا عودة؛ فبدايتها معلومة ونهايتها مجهولة. إنها سفر الروح إلى عالم غامض حيث تستقر بعيدًا عن الجسد وعن الأحياء. وقد عبّر عن ذلك عبيد بن الأبرص بقوله:
وكل ذي غيبة يؤوبُ * وغائبُ الموتِ لا يؤوبُ
لقد كانت الحياة البدوية في العصر الجاهلي تقوم على الترحال المستمر، لكن الرحلة الأخيرة -وهي الموت- كانت تثير تفكيرهم وتدفعهم للتأمل والاستسلام. فالوقوف أمام باب الموت لم يمكّن أحدًا من رؤية ما وراءه، مما جعل أي محاولة للإلحاح أو الجدال بلا جدوى، فالباب مغلق ومآله الإخفاق.
وعندما نظر قس بن ساعدة في “قافلة الموت”، لم يستطع تحديد أولها من آخرها، ورأى القافلة تسير في اتجاه واحد لا رجعة فيه. فتوصل إلى حقيقة مؤلمة وواضحة، وهي أن العاقل هو من يكون دائم الاستعداد لهذه الرحلة الأخيرة:
في الذّاهبين الأوليـ * ـن من القرونِ لنا بصائرُ
لمّا رأيتُ مواردًا * للموتِ ليسَ لها مصادرُ
ورأيتُ قومي نحوها * تمضي الأكابرُ والأصاغرُ
لا يرجعُ الماضي إلـ * يّ ولا من الباقينَ غابرُ
أيقنتُ أنّي لا محا * لةَ حيثُ صارَ القومُ صائرُ
موضوعات الحكمة في الشعر الجاهلي
إذا أردنا أن نوضح أغراض الحكمة في الشعر الجاهلي باستخدام مصطلحات عصرية، يمكننا القول إن أبرز محاورها كان يدور حول جدلية الحياة والموت وما يرتبط بها من أسباب ونتائج. لم يكن اهتمام العرب بهذا المحور فريدًا من نوعه، فقد كان يشغل تفكير العديد من الشعوب قديمًا وحديثًا. وقد تناوله الفلاسفة بنظرياتهم المجردة، وعالجه الشعراء بالإثارة والتصوير، فيما قام علماء الاجتماع برصده واستنباط نتائجه، وتتبعه مؤرخو الحضارة، بينما عبر عنه أهل الفن بالجمال والإمتاع.
يتناول هذا النص في البداية الجانب السلبي من هذه الجدلية، وهو الموت، وكيف صوره الشعراء، وما هي الاستنتاجات التي توصلوا إليها من حقيقته المؤلمة والثابتة.
قد يظن الإنسان أن سفره إلى الموت مؤجل لا معجل، وأنه ليس مقصودًا بنذر الموت التي تحيط به من كل جانب. وقد يعتقد أن الموت الذي أدرك غيره اليوم قد عفا عنه، وأن لديه متسعًا من الوقت، ولكنه في الحقيقة غافل عن الحقيقة. فما يبدو بعيدًا قد يقترب، والحياة قد أحاطت الإنسان بحبل أوله في عنقه وآخره في يد الموت، وهو قادر على شد هذا الحبل وخنق صاحبه في أي لحظة.
وقد عبر الشاعر طرفة بن العبد عن هذه الحقيقة بقوله:
أرى الموت أعداد النفوس ولا أرى * بعيداً غداً، ما أقرب اليوم من غد
لعمرك إن الموت ما أخطأ الفتى * لكا لطول المرخى، وثنياه باليدِ
ويرى الشاعر زهير بن أبي سلمى أن الموت قوة جاهلة وعمياء، لا تصطاد بعد ترصد ولا تختار فرائسها وفق نظام معقول. فهي كناقة معصوبة العينين تدوس برؤوس الناس بمناسمها العريضة الباطشة، فمن أخطأته اليوم أدركته غدًا. لا ينجو منها الشجاع ولا الجبان، ولا يحمي منها الحذر ولا الحيطة. وقد صور ذلك بقوله:
رأيت المنايا خبط عشواء، من تصب * تمته ومن تخطئ يُعمر، فيهرم
ومن هاب أسباب المنايا ينلنه * وإن يرق أسباب السماء بسلّم
هذا التصور يَبعد الموت عن الذات الإلهية القادرة، ويجرده من الحس الديني، ومن طيوف الإيمان المترقرقة في شعر زهير وأمثاله من شعراء العصر الجاهلي. وبذلك، تبقى القوة المسيطرة على الحياة والموت غامضة، أو على قدر كبير من الغموض.
لقد استسلم الشاعر الجاهلي لقوة الموت، ولم يدرك مصدرها، فحكم بالموت على كل شيء، ولم يصف بالخلود صنمًا يعبده، أو وثنًا يتقرب به إلى الله. بل خلع جلال الخلود على شيء لا يدرك بالحس، وهي قوة الزمان. فالزمان وحده هو الخالد، بينما الناس والأحياء والأموال مصيرها إلى الفناء.
يرى الشاعر الجاهلي أن في الحياة سرًا غامضًا يدفع الإنسان دفعًا، ويسوقه سوق الجزار للدابة إلى المذبح، ثم يلقيه في غيابة العدم.
يقول زهير بن أبي سلمى:
بدا لي أن الناس تفنى نفوسهم * وأموالهم، ولا أرى الدهر فانيا
أراني إذا ما بتّ بتّ على هوى وأني إذا أصبحت أصبحتُ غادي
إلى حفرة أهدى إليها مقيمة * يحث إليها سائق من ورائيا
لو أن زهيرًا حكم بالفناء على الجسد فقط، واستثنى منه النفس، لكان في حكمه ما يشفع لمن يتوسم فيه الإيمان بالله والبعث والحساب في قوله:
ولا تكتمن الله ما في نفوسكم * ليخفى، ومهما يكتم اللهُ يَعْلَم
يؤخر، فيوضع في كتاب فيـدخـر * ليوم الحساب أو يعجل فينقم
لكن زهيرًا رأى أن الفناء يدرك النفس كما يدرك الجسد. وإذا كانت النفس فانية لا باقية، فما هو الجوهر الذي سيُعرض للحساب والعذاب أو الثواب يوم القيامة؟
وهكذا، يمكننا أن نزعم أن الشعر الجاهلي لا ينطوي على تصور واضح تتراءى فيه النفس خالدة، ولا على تصور الموت مرتبطًا بإله يُحيي ويُميت. وهذا يثير التساؤل عما إذا كانت حكمة الجاهليين لم تستوعب ما سبقها من فلسفات وعقائد وأديان. فالخلود – كما يرى سيد عويس – كان واضحًا في عقائد المصريين القدماء، ولذلك حرص الفراعنة على تحنيط الأجساد لتعود إليها الروح يوم القيامة. والقيامة بعد الموت هي ركن من أركان العقيدة المسيحية، لأن النفس الخالدة لا يمكن أن يتسلط عليها فناء.
إن تصور الفناء والخلود لا يهمنا لذاته، وإنما يهمنا تأثيره في سلوك الإنسان الجاهلي، وما يستتبعه من تصور للخير والشر، وما يرافقه من إقباله على الشهوات أو انصرافه عنها. فكيف صور الشاعر الجاهلي الحياة، وما هي الحكم التي عكست هذا التصور؟
ب -الحياة
لئن كان استخلاص تصورٍ للموت، يتسم بتقارب السمات والملامح، من خلال أشعار العصر الجاهلي أمراً ممكناً، فإن الظفر بتصورٍ مماثلٍ للحياة يظل مطلباً بعيد المنال. ويعود ذلك إلى أن مواقف الشعراء من الحياة تكتسي ألواناً متعددة وتخضع لتأثير عوامل شتى، تشمل طبيعة الشاعر ومزاجه الشخصي، وحالته المادية من فقر أو غنى، وطبيعة علاقته بأسرته وقبيلته، بالإضافة إلى المرحلة العمرية التي نظم فيها شعره.
وبناءً على ذلك، نجد أن تصور الحياة يأتي على قدر كبير من التباين والاختلاف.
فهذا زهير بن أبي سلمى، وقد بلغ من الكبر عتياً، يُعرب عن سأمه من الحياة بعد أن ناهز الثمانين عاماً، إذ بدت له حملاً ثقيلاً لا تُطاق وطأته. ورغم أنه لم يصل إلى حد تمني الموت، فإنه لم يكن يُقبل على الدنيا إقبال المتلهف لشهواتها، أو الحريص على استمراريتها، وفي ذلك يقول:
سئمتُ تكاليفَ الحياةِ ومن يعشْ * ثمانينَ حولاً، لا أبا لكَ، يسأمِ
وعلى ذات الدرب، لم يكن عبيد بن الأبرص أقل من زهير شعوراً بمرارة العيش وهوانه، إذ يقول:
والمرءُ ما عاشَ في تكذيبٍ * طولُ الحياةِ له تعذيبُ
وإذا كانت الحياة، مهما امتدت، تمثل وهماً كبيراً، فإن ما فيها من نِعمٍ ليس إلا أوهاماً أصغر حجماً، وما تحويه من لذاتٍ لا يعدو كونه ظلالاً راحلة. فإن لم تفارق الملذات الإنسان، فارقها هو حتماً. فما يمتلكه المرء في يومه، تنتزعه منه يد المنية في غده. فلِمَ هذا التعلق ببريقها الزائف وسرابها الخادع؟ يقول عبيد في هذا المعنى:
فكلُّ ذي نعمةٍ مخلوسُها * وكلُّ ذي أملٍ مكذوبُ
وكلُّ ذي إبلٍ موروثُها * وكلُّ ذي سلبٍ مسلوبُ
ومهما امتد بالإنسان الأجل وتعاظمت فيه العزيمة، فإن عمره يظل قصيراً، ونشاطه ضرباً من العبث، وعمله مجرد لهو. فلماذا إذن يُعنّي المرء نفسه بعملٍ قد توافيه منيته قبل إتمامه؟ يقول لبيد بن ربيعة:
إذا المرءُ أسرى ليلةً ظنَّ أنَّهُ * قضى عملاً، والمرءُ ما عاشَ عاملُ
وحتى لو افترضنا جدلاً أنه أنجز ما شرع فيه، وأدرك ما كان يسعى إليه، أفلا يبقى للموت موعدٌ محتوم؟ فإن كان الأمر كذلك، فإن الموت لا محالة سينتزع منه ما صنعه، ويجبره على التخلي عن كل شيء:
بَلينا وما تبلى النجومُ الطوالعُ * وتبقى البلادُ بعدنا والمصانعُ
وعلى هذا المنوال، صاغ الأفوه الأودي رؤيته للحياة بأكملها، بما فيها من ملذات ومباهج، فلم يرها إلا ظلاً فانياً وعاريةً مصيرها الاسترداد، حيث يقول:
إنما نعمةُ قومٍ متعةٌ * وحياةُ المرءِ ثوبٌ مستعارْ
كما ارتأى أن جانب الشر فيها هو الأرجح، وأن النحس عليها هو الغالب، فقال:
والمرءُ ما تصلحُ له ليلةٌ * بالسعدِ تفسدُهُ ليالي النحوسْ
والخيرُ لا يأتي ابتغاءً بهِ * والشرُّ لا يغنيهِ ضرحُ الشَّموسْ
ومن هنا، نستطيع أن نزعم أن هؤلاء الشعراء قد أسسوا لتيارٍ تشاؤمي في المشهد الجاهلي، إذ كانوا ينطلقون في رؤيتهم من شيخوختهم المتاخمة للقبور، ومن هذا المنظور كانوا يطلقون أحكامهم على طفولة الحياة وشبابها، متخذين من الموت معياراً نهائياً للتقييم. ولهذا السبب، طغت على أحكامهم تلك مشاعر اليأس، والضجر، والقلق، والشعور العميق بالعجز والخيبة.
شهد العصر الجاهلي تيارًا فكريًا آخر من الحكمة، يغاير التيار الذي ينظر إلى الدنيا من منظور الموت، إذ كان هذا التيار ينظر إليها من منظور الحياة. ويُعنى بلذاتها من منطلق الغريزة لا العقل، ويستلهم حكمه من التجربة الحية لا من التصور الميت. يمثل هذا التيار طرفة بن العبد كزعيم له، ومن أبرز رموزه الأعشى وامرؤ القيس.
فقد أدرك طرفة حقيقة الموت وأنه يسوّي بين الناس جميعًا، وأن القبر الذي يُدفن فيه أبخل الناس وأزهدِهم قد لا يختلف عن قبر أكثرهم ترفًا وإسرافًا. كما أدرك أن الحياة ما هي إلا كنز يتناقص بمرور الأيام حتى يفنى الإنسان. وقد عبر عن هذه الحقيقة في أبياته:
أرى قبر نحام بخيل بماله * كقبر غويٍّ في البطالة مفسدِ
أرى العيش كنزاً ناقصاً كل ليلة * وما تنقص الأيام والدهر ينفد
لكن هذه الحكمة، التي تشبعت بالغريزة، لم تقُد طرفة إلى الزهد والابتعاد عن مباهج الدنيا، بل دفعته إلى اغتنام الفرص قبل فواتها، وقطف ثمار الحياة قبل ذبولها. وقد أشار إلى ذلك بقوله:
كريم يروي نفسه في حياته * ستعلم إن متنا غداً أينا الصدي
إن الموت الذي أورث زهيرًا حالة من الضجر من الحياة هو نفسه الذي ألهب في قلب طرفة الشاب شغفًا بها. فالشاعران يتفقان في إيمانهما بحتمية الموت، ولكنهما يختلفان في ردة فعلهما. فبينما يستسلم زهير للحياة الرتيبة، يتجه طرفة إلى الحانة ليغرق نفسه في الخمر، ويبدد ماله في اللذائذ والمباهج قبل أن يسلبه الموت ماله، أو يسلبه الحياة التي تُمكنه من التمتع بماله.
أرى الموت يعتـام الكـرام ويصطفي * عقيلة مال الفاحش المتشدد
ج –الناس والمال
يتضح أن النزعة الواقعية التي هيمنت على نتاج طرفة بن العبد الشعري كانت أكثر ملامسةً لنفوس الناس وأعمق تأثيراً، مما جعلها أجدر بالانتشار والذيوع. وعند استقراء حِكَم الشعراء، نجد أن أصداء هذه النزعة الواقعية تتردد بوقعٍ قوي وعميق. ويتجلى أول هذه الأصداء في الإقرار الراسخ بما للمال من سطوةٍ على حياة البشر وما ينطوي عليه من مخاطر.
فمن هذا المنطلق، يُصوَّر الفقر على أنه محنة تُذِلُّ الإنسان وتحطُّ من كرامته، وتجعله عالةً على الآخرين، مما يورثه بغضاء الناس ونفورهم منه، فيصل به الحال إلى أن يتنكر له أقرباؤه ويتخلى عنه أصحابه. وقد عبّر عروة بن الورد عن هذه الحقيقة المرة بقوله:
إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسه * شكا الفقر أو لام الصديق فأكثـرا
وصار على الأدنين كلا وأوشكـــت * صلات ذوي القربى له أن تنكرا
إن هذه السطوة القاهرة للمال تمتد لتُحدث انقلاباً في موازين الحياة ذاتها، فهي التي تُعيد تشكيل المفاهيم والقيم الإنسانية، وتُملي على الأفراد أنماط سلوكهم. وبما أن الطبيعة البشرية تميل إلى اتباع المصالح الشخصية، فإن الناس يرسمون مسارات حياتهم وفقاً لهذه المصالح. فحينما يشهدون النعمة والثراء يتكاثران عند شخص ما، يتهافتون على التقرب منه، ويسارعون إلى إسباغ ألقاب الشرف والمجد عليه، واصفين إياه بالنبل والفضل. ولكن ما إن تزول عنه تلك النعم حتى يتفرقوا من حوله، غير عابئين بماضيه المشرّف أو أصله العريق. ويُجسّد أوس بن حجر هذه النظرة بقوله:
فإني رأيت الناس إلا أقلهم * خفاف العهود يكثرون التنقّلا
بني أم ذي المال الكثير يرونه * وإن كان عبداً – سيد الأمر جحفلا
وهم لمقل المال أولادُ علةٍ * وإن كان محضاً في العمومة مخولا
وتصل هذه النظرة الواقعية إلى ذروتها في تصوير الناس كظلمةٍ غادرين، لا يتورعون عن أكل مال اليتيم، ولا تردعهم دموع الثكالى وآلام المكلومين. ولعل في قصة طرفة بن العبد وأمه، اللذين يُعدّان من أشهر ضحايا الطمع في العصر الجاهلي، خير مثال على ذلك. فهذا الظلم الفادح الذي عاناه طرفة هو ما دفعه إلى التمرد والتبرم بأهله، وقد حذّر من مغبة الظلم وعواقبه الوخيمة، قائلاً:
قد يورد الظلم المبين آجنا * ملحاً يخالط بالزعاف ويقشب
وفي سياق تجربته المريرة، لم يجد طرفة في الشقاء الإنساني ما هو أشد إيلاماً من ظلم الأقرباء الذين استغلوا وصايتهم على من هم تحت رعايتهم، فاستباحوا أموالهم ونهبوها دون وازع من ضمير أو قرابة، وهو ما صوره في بيته الشهير:
وظلم ذوي القربى أشدّ مضاضة * على المرء من وقع الحسام المهند
هكذا، إذن، رسم الشعر الجاهلي صورة مدمرة للمال، مُظهراً إياه في صورة وحشٍ كاسر، شديد الضراوة والفتك، يعمل على تمزيق الروابط الاجتماعية، وتشويه قيم الفضيلة، وإفساد حياة البشر. غير أن هذه الصورة القاتمة، على الرغم من صدقها، لا تمثل سوى وجه واحد من وجوه الحكمة التي تمتع بها شعراء العصر الجاهلي.
فأمّا الوجه الآخر المشرق لهذه الحكمة، فيتمثل في اعتبار المال وسيلة أساسية لصون العرض، ودرعاً يقي من الإهانة، وعاملاً يعزز التكافل والترابط بين أبناء القبيلة الواحدة. وفي هذا الصدد، يقول زهير بن أبي سلمى:
ومن يجعل المعروف من دون عرضه * يفره، ومن لا يتق الشّتم يُشتمِ
ومن يك ذا فضلٍ، ويبخل بفضله * على قومه يُستغن عنه ويُذْمَمِ
ويسير على الدرب ذاته المثقب العبدي، مؤكداً على هذا المفهوم في قوله:
لا يبالي طيب النفس به * تلف المال إذ العرض سلم
بل إن زهيراً يذهب إلى أبعد من ذلك، فيرتقي بوظيفة المال ليجعله أداة لخدمة المجتمع بأسره، داعياً إلى أن يعم نفعه الجميع. فمن منظور العقل والحكمة، يرى أن السلام ونبذ الحرب هما الغاية الأسمى، وأن ثروات الأغنياء يمكن أن تُوظَّف لتكون بمثابة المهر الذي تُسترضى به ربة السلام وتُخطب وُدّها، كما يوضح في قوله:
بمال ومعروف من القول تسلم * وقد قلتها إن ندرك السلم واسعاً
فالحرب، في جوهرها، مَهلكةٌ للعقل ومَضلّةٌ لأهل الرشاد. أما السلام، فعندما يبسط رواقه على الناس، فإنه يفسح المجال أمام العقل ليتفتح ويزدهر، ويتيح للخير أن يسود ويعم، كما أنه يضيّق على الجاهل سُبُل الانحراف والتهور، مما يدفعه إلى التحلي بالحلم، والتظاهر بالعلم، والانصياع لمنطق الحق. وهذا ما أشار إليه الأفوه الأودي بقوله:
يحلم الجاهل للسلم، ولا * يقر الحلم إذا ما القوم غارما
ج -نظرات في الأخلاق والسياسة
كان الجاهليون – على ما فيهم من حمية وعجرفية – يولون العقل مكانة بارزة، ويزرون بالجهل. غير أنّ المرء قد يرغم على الجهل، وهو له كاره، ويبحث عن العقل فلا يجده، لأن البيئة أقوى من الفرد، ولأن المفاهيم الشائعة تقهر الرأي المعاند في أغلب الأحيان، ولذلك زجر علقمة فقال:
والجهل ذو عرض لا يستراد له * والحلم آونة في الناس معدوم
ومن تعرض للغربان يزجرها * على سلامته لا بد مشؤوم
ومن كان في شبابه أحمق نزقاً مغلوباً بحرارة الرأس فالدهر كفيل برده إلى الوقار. أما إذا غلب الحمق، الشيخ، فلا شفاء له من دائه. قال زهير :
وإن سفاه الشيخ لا حلم بعده * وإن الفتى بعد السفاهة يحلم
فهل معنى ذلك أن أخلاق الناس عند الجاهليين اكتساب لا طبع؟ يبدو أن جمهرة الشعراء كانت تميل إلى الحكم على الأخلاق بأنها طبع فطر عليه الناس، وأن الإنسان عاجز عن مغالبة طبعه. قال زهير:
ومهما يكن عند امرئ من خليقة * وإن خالها تخفى على الناس تعلم
ومن تظاهر بما ليس فيه فالتجارب كفيلة بفضحه والكشف عن معدنه، قال ذو الإصبع:
كل امرئ راجع يوماً لشـيـمـتـه * وإن تخلق أخلاقاً إلى حين
وفي العلاقات الإنسانية كانت نظرات الشعراء نفاذة، إذ استطاعت أن ترصد ما في هذه العلاقات من رياء ونفاق غير أنّ الشعراء اختلفوا: فمنهم من دعا إلى المصانعة، ورأى أنه لابد منها في الحياة الوادعة المستقرة. قال زهير:
ومن لا يـصـانع في أمور كثيرة * يضرس بأنياب ويوطأ بمنسم
ومنهم من عد المصانعة ضرباً من المخادعة، قدم النفاق وأهله، والرياء ومن يتخلق به. قال الأفوه:
بلوت الناس قرناً بعد قرن * فلم أرَ غیَر خلابٍ وقالِ
ومنهم من وضع معياراً للإخلاص، ومحكاً للصداقة الحق والوفاء المحض. فالصديق الصدوق ذو وجه واحد صريح، وفيه غيرة على صاحبه في حضوره وغيبته يدفع عنه افتراء المتخرّصين، ويعينه في النوائب قال أوس:
وليس أخوك الدائم العهد بالذي * يذمّك إن ولّى ويرضيك مقبلا
ولكن أخوك النائي ما دمت آمنا * وصاحبك الأدنى إذا الأمر أعضلا
والوفاء الحق مبدأ يعقبه سلوك، وقول يشفعه عمل، وأوفى الأوفياء الغيور على الصديق، المقيم على العهد السريع إلى الخير والبر في غير تردد قال زهير:
ومَن يُوفِ لا يُذَمَم ومَن يُهْدَ قلبُه * إلى مطمئن البر لا يتجمجم
ومع أن المجتمع الجاهلي كان أقرب إلى البداوة فقد حفلت الحكم بما يدل على ان تصوراً سليماً للسياسة كان يطوف بأذهان الشعراء. وهذا التصور شبيه في بعض جوانيه بما ذهب إليه أفلاطون في جمهوريته، إذ عرف الفضيلة بأنها سيطرة الجانب العقلي من النفس على جاني الشهرة والغضب … والعدل تحقيق فضيلة العقل، المجتمع هو الحكام والفلاسفة.. فالفلاسفة هم الحكام في جمهورية أفلاطون».
وإذا لم يكن في المجتمع الجاهلي فلاسفة فقد كان فيه عقلاء، يصلحون للرئاسة في جمهورية أفلاطون، وشعراء رأوا مارأه أفلاطون، ومنهم الأفوه الأودي الذي ناط السياحة والسياسة بأهل الرشد، وحلهم تبعة القيادة، وحذرهم من التخلي عما نديتهم ملكاتهم له، لأن تخليهم يسمح للمعتمرين من المفسدين بأن يستطيلوا ويعيثوا في الأرض:
لا يصلح الناس فوضى لا سراةَ * لهم ولا سراة إذا جُهّالهُم سادوا
تلقى الأمور بأهل الرشيد ما * صلحت فإن تولوا فبالأشرار تنقادُ
إذا تولی سراةُ القوم أمرَهم * نما على ذاك أمر القوم فازدادوا
وبعد؛ فالشعر الجاهلي زاخر بالحكمة العميقة والنظرات الثاقبة التي حلّل بها أصحابها جوانب الحياة المختلفة، ودعوا فيها إلى ما يعتقدون أنه الحق والخير والقليل الذي ذكرناه يغني عن الكثير الذي أغفلناه.
السمات المميزة للحكمة في الشعر الجاهلي
ينبغي التنويه، عقب المقارنة التي استعرضناها بين الفكر الفلسفي لأفلاطون والحكمة المنسوبة إلى “الأخوة”، إلى أن الشعر الجاهلي لا يشتمل على منظومة فلسفية تهدف إلى تقديم تفسير كليّ للوجود والحياة، يستند إلى أسس منطقية متماسكة ويقوم على مقدمات تفضي إلى نتائج محددة. فالتباين الجوهري يكمن في أن حكمة العرب كانت وليدة التجربة العملية، بينما انبثقت حكمة اليونان من رحم الفكر الفلسفي النظري. وبناءً على هذا الاختلاف، اتسم شعر الحكمة في العصر الجاهلي بمجموعة من الخصائص والسمات الفارقة، وهي كالتالي:
١. ارتباطها الوثيق بالفطرة والتجربة
لقد أجاد الباحث يحيى الجبوري في توضيح هذه السمة، حيث يرى أن هذه الحكمة لا ترقى إلى مصاف الفلسفة الممنهجة ذات الأصول الراسخة أو الفكر المنظم القائم على علم مدروس. وإنما هي أقرب إلى كونها تعبيراً عن الإحساس الذاتي والتأثر الوجداني منها إلى نتاج للتفكير العلمي المنهجي. فهي في جوهرها تمثل رؤى خاصة وانطباعات شخصية، وتأملات عميقة في قضايا الوجود كالحياة والموت، كما تعد بمثابة مساعٍ لوضع أطر أخلاقية، يسترشد بها المجتمع في تبني الخصال والسلوكيات الحميدة، ونبذ الأفعال والعادات المستهجنة. ولهذا السبب، تجلّت حكمتهم في صورة حقائق كلية مجردة، تتناغم مع الفطرة الإنسانية السليمة وتستقي مادتها مباشرةً من التجربة والملاحظة الواقعية.
٢. الوضوح والابتعاد عن الألفاظ الغريبة
تكمن علّة هذه الخاصية في كون الحكمة تهدف إلى تكثيف الحقائق الإنسانية الكبرى وتلخيصها، مما يجعلها في غنى عن استدعاء المعجم اللغوي المتخصص المرتبط بالبيئة الصحراوية، بما فيها من حيوانات ونباتات، أو بالحياة البدوية وما يتعلق بها من خيام وأطلال. فهذه المفردات تمثل المصادر الرئيسة لما يُعرف بـ«الغريب» من الألفاظ، الذي قد يستعصي فهمه على القارئ المعاصر الذي انقطعت صلته بتلك البيئة البدوية.
٣. تداخلها مع الموضوعات الشعرية الأخرى
انطلاقاً من كون الحكمة الجاهلية تمثل عصارة تجارب حياتية وليست بناءً نظرياً فلسفياً متكاملاً، فإنها لم تُفرد في نصوص مستقلة، بل وردت مبثوثةً ضمن سياق الموضوعات الشعرية الأخرى، لتؤدي وظيفة تكميلية وتوضيحية لها. وقد عزز من هذا الانتشار في ثنايا النصوص طبيعة القصيدة الجاهلية القائمة على تعدد الأغراض، وبنيتها الفنية المعتمدة على استقلالية الأبيات كوحدات دلالية مكتملة، حيث يشكل كل بيت، بشطريه المتكاملين وزناً وبناءً لغوياً، وحدة معنوية قائمة بذاتها. وقد أفضى هذا التداخل إلى ارتباط الحكمة الوثيق بالأفكار التي تستدعيها، فبدت مندمجة فيها بعمق، ونابضة بالحيوية والواقعية. ولم يخرج عن هذا النمط السائد إلا عدد قليل من الشعراء في قصائدهم المطولة، ومن أبرزهم زهير بن أبي سلمى، الذي خصص جزءاً متتابعاً من الأبيات في ختام معلقته الشهيرة لبلورة رؤاه وتأملاته في الحياة.
٤. تأثرها بمجموعة من المؤثرات المتنوعة
تأثرت الحكمة الجاهلية بطائفة من العوامل المختلفة، أبرزها البيئة الجغرافية والاجتماعية التي نشأ فيها الشاعر، ورصيده من الخبرات الحياتية المكتسبة، فضلاً عن منهجه الخاص في الحياة والمنظومة القيمية التي يعتنقها. وعلى الرغم من هذا التنوع في المؤثرات، فقد حافظت الحكمة الجاهلية على درجة عالية من التكامل والتشابه في مُثُلها العليا وقيمها الجوهرية، إذ هيمنت عليها قيم المجتمع البدوي بشكل واضح، مع حضور محدود لبعض أخلاقيات وقيم أهل الحضر.
خاتمة
وهكذا، يسدل الستار على تحليلنا للحكمة في الشعر الجاهلي، والتي كشفت عن نفسها كظاهرة فريدة، تتميز بارتباطها الوثيق بالفطرة والتجربة الحية لا التنظير الفلسفي. هي ليست حكمة الفلاسفة المنعزلين في صوامعهم، بل حكمة المحاربين والشيوخ الذين واجهوا الحياة وجهاً لوجه، فجاءت أقوالهم واضحة، موجزة، ومفعمة بالصدق.
لقد تجلت هذه الحكمة في ثنايا القصائد، فلم تكن غرضًا مستقلًا بذاته، بل روحًا تسري في جسد الشعر، لتضيء جوانب الحديث عن الموت والحياة، والمال، والأخلاق. وإن القيمة الحقيقية لهذه الحكمة لا تكمن في بنائها لمنظومة فكرية متكاملة على غرار اليونان، بل في قدرتها الفائقة على تكثيف الحقيقة الإنسانية في أوجز عبارة، لتصبح نبراسًا يهتدي به الإنسان في دروب الحياة، وشاهدًا على أن أعمق الفلسفات قد تولد من أبسط التجارب وأصدقها.