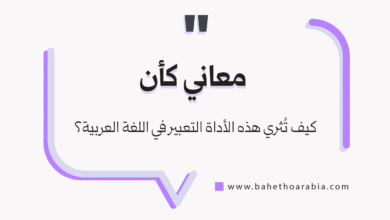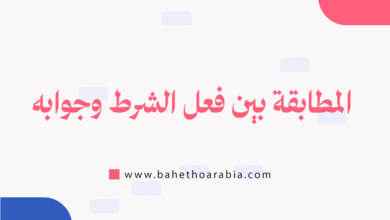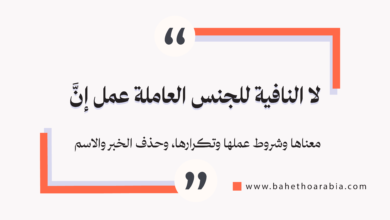التنازع في النحو: تعريفه وأحكامه، والعامل في التنازع
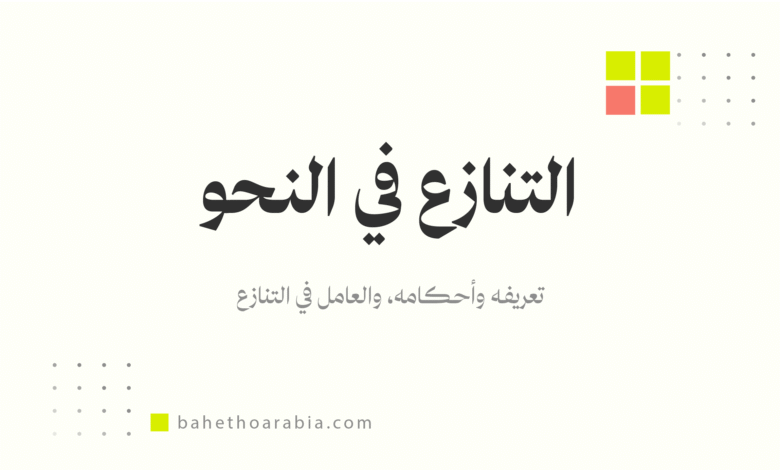
يمثّل التنازع ظاهرة نحوية مركزية تتعلّق بتعاقب عاملين على معمول واحد متأخر، ويقتضي التنازع تحقيق توازن دقيق بين متطلبات المعنى ومواقع الإعراب. ويظهر التنازع في تراكيب الكلام الفصيح قديمه وحديثه، حيث يتسابق عاملان متقدمان إلى طلب معمول واحد، فيُبحث عن أحقّهما بالإعمال وأقربهما إلى السياق. ومن خلال التنازع تتبيّن مرونة النظام النحوي وقدرته على استيعاب العلاقات التركيبية المعقّدة دون إخلال بالمعنى.
ويتأسّس النظر في هذه القضية على مجموعة من الأحكام المقرّرة في أبواب العمل، إذ يُشترط في العاملين التصرف، ويُراعى في التنازع طبيعة المطلوب من فاعل أو مفعول به، كما تُضبط حدود التقديم والتأخير. كما أن التنازع يفتح أفقاً لبيان أثر القرب والسبق بين العاملين وما يترتب عليه من ترجيح عند المدرستين البصرية والكوفيّة. وتتضح معايير التنازع عند تحليل الأمثلة القياسية والشواهد، فيُقاس عليها استعمال المتكلمين. وبذلك يُصبح التنازع مدخلاً عملياً لاختبار صلاحية القواعد الإعرابية في حلّ الإشكالات التطبيقية.
وسيعرض هذا النص معالجة منهجية لمفهوم التنازع من خلال تعريفه وأحكامه، مع ضبط المصطلحات المرتبطة بالعامل والمعمول. وسنتابع صور العاملين الممكنة في التنازع وتمييز ما يصحّ منه وما لا يصحّ، مع بيان حدود التقديم والتأخير وآثارهما. كما نقف عند آراء النحاة في التنازع وترجيحاتهم العملية، ونُتبع ذلك بسؤالات تطبيقية وأسئلة شائعة تُعمّق الفهم. ويُختم بعرضٍ يستجمع أهم نتائج دراسة التنازع ويربط بينها وبين مسائل العمل في العربية.
التنازع في النحو: تعريفه وأحكامه
التنازع هو أن يتقدّم عاملان ويتأخّر عنهما معمول مطلوب لكل واحد منهما من حيث المعنى. ومن ذلك قولنا: (جاءَ وجلسَ زيدٌ)، (زارني وأكرَمْتُ سعدٌ). ويُسمّى العاملان المتقدّمان (المُتَنَازِعَينِ)، والمعمول المتأخر (المُتَنَازَعُ عليه). ففي قولنا: (جاء وجلس زيد) المتنازِعَان هما الفعلان (جاء وجلس)، والمتنازَع عليه هو (زيد)، وقد تنازع العاملان فاعلاً. وفي قولنا: (زارني وأكرمت سعد) المتنازِعَان هما الفعلان (زارني وأكرمت)، والمتنازع عليه هو (سعد)، وقد طلب الفعل الأول فاعلاً، وطلب الفعل الثاني مفعولاً به.
العاملان في التنازع
قد يكون العاملان:
١ – فعلين متصرّفين، كقوله تعالى: {آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيهِ قِطْراً}، (سورة الكهف: ٩٦).
٢ – أو اسمين يعملان عمل الفعل، كقول الشاعر:
عُهِدْتَ مُغِيثاً مُغْنِياً مَنْ أَجَرْتَهُ * فَلَمْ أَتَّخِذْ إِلَّا فِنَاءَكَ مَوئِلَا
فالمتنازِعان (مغيثاً ومغنياً) وكلٌّ منهما اسم فاعل يعمل عمل فعله، وقد تنازعا المفعول به (مَنْ).
٣ – أو فعلاً واسماً يعمل عمله، كقوله تعالى: {هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَه}، (سورة الحاقة: ١٩). فكلمة (هاؤم) اسمُ فعلِ أمرٍ بمعنى خذوا.
يتبيّن من التعريف السابق أن التنازع لا يكون بين فعلين جامدين؛ لأن شرطهما التصرف، ولا بين حرفين، ولا بين جامد وغيره أو بين حرف وغيره. ولا يقع التنازع في معمول متقدّم أو متوسّط بين العاملين؛ لأن العامل الأول يكون قد استوفى معموله قبل مجيء الثاني فلا يتحقق المقصود، نحو: (أيَّ الطلاب كافأتَ وأكرمتَ؟)، ونحو: (زرتُ الفائزَ وهنأتُ). ففي المثال الأول: (أي) اسم استفهام منصوب على أنه مفعول به للفعل (كافأت)، وفي المثال الثاني (الفائز) مفعول به للفعل (زرت)، وليس في المثالين ما يحقّق صورة النزاع بين العاملين.
آراء العلماء في التنازع
إذا تنازع عاملان جاز إعمالُ أيِّهما شئتَ باتفاق النحاة في مسائل التنازع، ورجّح الكوفيون إعمال الأول لسبقه، ورجّح البصريون إعمال الثاني لقربه من المفعول به، وقيل: هما سواء. ولم يضطرب النحاة في باب اضطرابهم في باب التنازع، ولم تختلف آراؤهم في موضوع اختلافَ آرائهم فيه، ويمكن أن نستخلص من آرائهم في التنازع ما يلي:
أ – إذا وقع التنازع جاز إعمال أيٍّ من العاملين دون ترجيح.
ب – إن أعملنا الأول في المعمول أعملنا الثاني في ضميره، نحو: (وصل وجلسا أخواك).
ج – إن أعملنا الثاني أعملنا الأول في ضميره المرفوع، نحو: (جَفَونِي ولم أَجْفُ الأخلَّاءَ)، ونحذفه إن وقع في موضع نصب، نحو: (أكرمتُ وزارَني الأصحابُ).
وثمة قضايا كثيرة يفترضها النحاة ويصطنعون لها أمثلة ويبنون عليها قواعد، غير أنها لا تَرِدُ في الاستعمال إلا نادراً، ولذا ضُرِب عنها صفحاً.
اقرأ أيضاً: الاشتغال: تعريفه وأحكام الاسم المشتَغَل عنه
سؤالات وإجاباتها عن درس التنازع
١ – التنازع هو أن يتقدّم عاملان ويتأخّر عنهما معمول مطلوب لواحد منهما. (صحيح أم خطأ)؟
الإجابة: خطأ؛ فالمعمول مطلوب لكلٍّ منهما.
٢ – في التنازع يُسمّى العاملان المتقدّمان (المُتَنَازِعَينِ)، والمعمول المتأخر (المُتَنَازَعُ عليه). (صحيح أم خطأ)؟
الإجابة: صحيح.
٣ – قد يكون العاملان فعلين متصرّفين وجامدين، (صحيح أم خطأ)؟
الإجابة: خطأ، فالعاملان لا يكونان فعلين جامدين.
٤ – لا يكون العاملان اسمي فاعل، (صحيح أم خطأ)؟
الإجابة: خطأ، قد يأتي العاملان اسمي فاعل.
٥ – أحد المتنازعين في قوله تعالى {هَاؤُمُ اقْرَؤُوا كِتَابِيَه} هو اسم فعل، (صحيح أم خطأ)؟
الإجابة: صحيح، هو اسم الفعل (هاؤم).
الأسئلة الشائعة
١ – ما التعريف الدقيق للتنازع وحدوده ضمن أبواب العمل؟
الإجابة: يُعرَّف هذا الباب بوصفه حالة يتقدم فيها عاملان صريحان أو مؤوّلان على معمول متأخّر، ويطلب كلٌّ منهما ذلك المعمول من جهة المعنى. تحدد القواعد طبيعة العاملين (تصرفاً وزماناً ومعنى) وتضبط موقع المعمول. كما تُراعى العلاقة بين الموقع التركيبي ودلالة السياق، لضمان سلامة الإعراب. ويُنظر إلى الشواهد القياسية والقرآنية والشعرية لإثبات الضوابط.
٢ – كيف يُميَّز بين العاملين عند وقوع التنازع في الفعلين المتصرّفين؟
الإجابة: يعتمد التمييز على مبدأين: القرب والسبق؛ فالأقرب إلى المعمول يُرجَّح عند البصريين، والمتقدم يُرجَّح عند الكوفيين. كما يُنظر إلى متطلّبات المعنى: فإن كان أحد العاملين لا يطلب إلا الفاعل والآخر لا يطلب إلا المفعول، أمكن توزيع العمل بينهما. ويتأكد ذلك باختبار عودة الضمائر المناسبة عند الإعمال. ويُستأنس بالاستعمال الموثّق في الشواهد.
٣ – ما أثر التقديم والتأخير على مجرى التنازع في التراكيب؟
الإجابة: إذا تقدّم المعمول أو توسّط بين العاملين استوفى العامل الأول حقَّه، فيخرج المثال من صورة النزاع. أمّا إذا تأخّر المعمول عن العاملين بقي احتمال الإعمال مفتوحاً، فتجري قواعد الإضمار والتوزيع. ويُستدلّ على الأثر بتغيّر العلامة الإعرابية للمعمول بحسب العامل المُعمَل. ويفيد التحليل الدلالي في تعيين الأحقّ بالإعمال عند الاشتباه.
٤ – ما ضوابط الضمير العائد عند إعمال أحد العاملين في باب التنازع؟
الإجابة: إذا أُعمل أحد العاملين في الاسم الظاهر وجب في الغالب أن يعود للآخر ضميرٌ مناسب في المحل الذي يطلبه؛ فإن كان يطلب فاعلاً عاد ضمير رفع، وإن كان يطلب مفعولاً عاد ضمير نصب. ويجوز حذف الضمير بشروط إذا وقع في موضع نصب، مراعاةً للإيجاز وسلامة التركيب. وتُراعى المطابقة في النوع والعدد مع المرجع. وتتأكد سلامة الضمير بالقرائن اللفظية والمعنوية.
٥ – كيف يتعامل النحاة مع الشواهد التي يندر فيها التنازع؟
الإجابة: الشواهد النادرة تُستقرأ مع ضوابط القياس، فإن وافقت أصول الباب احتجّ بها، وإلا عُدّت شاذّة لا يُقاس عليها. ويُقارن بين روايات النصوص الشعرية والقرآنية لضبط وجه الإعراب. كما تُناقش احتمالات التأويل والتضمين قبل الحكم بالندور. ويُرجَّح ما يوافق جمهور الاستعمال ويحفظ سلامة المعنى.
٦ – ما الفرق بين التنازع والاشتغال من جهة البناء الإعرابي؟
الإجابة: باب الاشتغال يختصّ بتقديم اسم يتعلّق به عامل متأخر بشرطٍ مخصوص، بينما يبحث هذا الباب في تعاقب عاملين على معمول متأخر. في الاشتغال يُراعى تناسب العامل مع الاسم المشغول عنه، وفي الباب الآخر يُراعى تعارض الطلب بين عاملين. ويختلف توزيع الضمائر وأحكام الحذف في البابين. ويُفصل في ذلك بالنظر إلى نوع العامل وموقع المعمول.
٧ – متى يمتنع التنازع بسبب الجمود أو دخول الحروف؟
الإجابة: يمتنع عند الجمود لانتفاء شرط التصرف، كما يمتنع بين الحروف لأنها لا تعمل عمل الأفعال. ويمتنع بين الجامد وغيره أو بين الحرف وغيره لعدم تحقق شروط العمل المتقابلة. كما يمتنع إذا تقدّم المعمول أو توسّط على نحوٍ يستوفي معه العامل الأول عمله. هذه الموانع تضبطها أمثلة قياسية يُقاس عليها.
٨ – كيف يُطبَّق مبدأ القرب والسبق في معالجة التنازع؟
الإجابة: يُقدَّم الأقرب إلى المعمول عند من يرى القرب معياراً راجحاً، ويُقدَّم الأسبق عند من يُعلي شأن الترتيب الزمني في التركيب. قد يُصار إلى التوفيق بين المعيارين بالنظر إلى الدلالة والسياق. كما تُراعى علامات الربط اللفظي التي قد تُسهم في ترجيح أحد العاملين. ويستند الحكم إلى أصلٍ نظري مدعوم بالشواهد.
٩ – ما المعايير التعليمية لتدريب الطلاب على تحليل أمثلة التنازع؟
الإجابة: تبدأ المعايير بتحديد العاملين ونوعيهما، ثم تعيين موقع المعمول وطلب كل عامل له. يعقب ذلك اختبار إمكان الإضمار والتوزيع، مع مراعاة المطابقة الدلالية. تُستعمل مخططات تحليلية تبين سلسلة العمل وحركة الإعراب. ويُعزَّز الفهم بتمارين تطبيقية متدرجة الصعوبة والشواهد الأصيلة.
١٠ – ما أبرز الأخطاء الشائعة في فهم التنازع وكيف تُصحَّح؟
الإجابة: من الأخطاء الخلطُ بين العمل في الظاهر والعمل في الضمير، أو إغفال شرط التصرف في العاملين. كذلك يُخطئ بعض الطلاب في تقدير موضع المعمول وزمن استيفاء العامل الأول له. تُصحَّح هذه الأخطاء بالتدرّب على أمثلة مضبوطة الإعراب، وبالرجوع إلى قواعد الباب ومناقشة علل الترجيح. كما يفيد التفريق بين القواعد العامة والاستثناءات النادرة.
خاتمة
تُظهر القراءة التحليلية أن التنازع يقدّم نموذجاً مُحكماً لتفاعل العوامل الإعرابية عند تعلّقها بمعمول واحد متأخر، وأن ضبط حدوده يُعين على تفسير كثير من الظواهر التركيبية في العربية. ويتيح التنازع معياراً دقيقاً لاختبار صلاحية مبدأ العمل عند تزاحم المطالب الإعرابية، ويؤكد أن القاعدة لا تُفهم إلا في ضوء السياق ودلالته. ومن ثمّ يغدو التنازع مدخلاً لفهم أعمق لبنية الجملة وعلاقاتها الداخلية.
كما يبرز من تتبّع الشواهد أن المدارس النحوية قدّمت جملة من الترجيحات العملية، وأن التباين بينها لا يُنقص من وحدة المنهج بقدر ما يثري أدوات التحليل. ويُبين التنازع أثر القرب والسبق وموقع المعمول في تعيين الأحقّ بالإعمال دون إخلال بالمعنى. وتكشف هذه المعالجة أن التنازع يستوعب فروقاً دقيقة بين صور العاملين، ويُحافظ في الوقت نفسه على انسجام الإعراب.
وبالجملة، فإن إتقان قواعد التنازع يُعدّ خطوة أساسية في تمكين الدارس من تحليل النصوص وتحديد مواقع العمل والإضمار والتوزيع. وتُسهم ممارسة الإعراب على الشواهد في ترسيخ مهارات التمييز بين وجوه الإعمال المختلفة. وفي ضوء ذلك يتّضح أن التنازع ليس مجرد مبحث نظري، بل أداة تطبيقية فعّالة لفهم العربية وصياغتها بدقة.