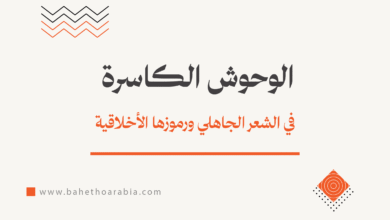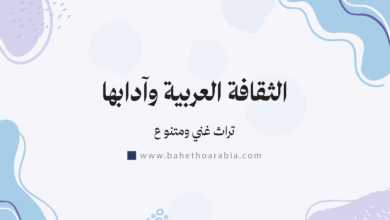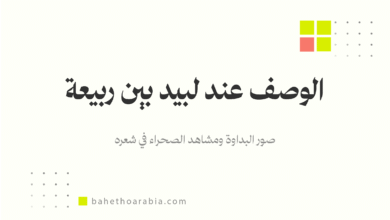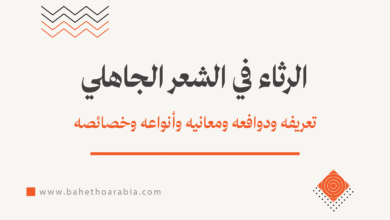الوصف في الشعر الجاهلي: جماليات الطبيعة بين السكون والحركة في عيون الشعراء
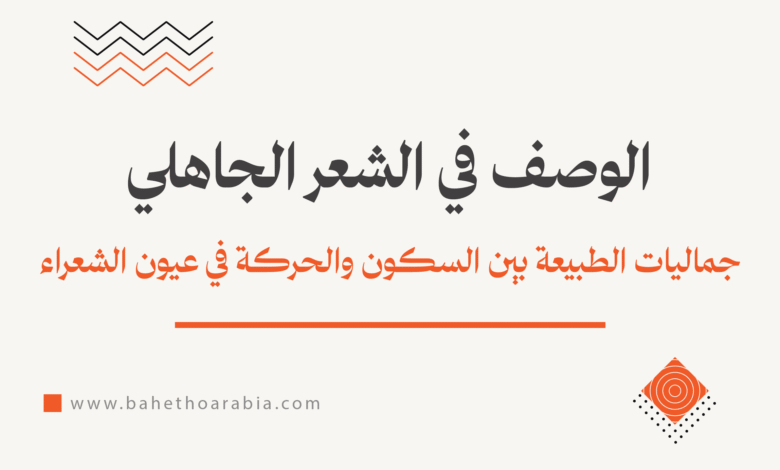
إذا كان المحسوس في الأدب واللغة يُعتبر أقدم ظهوراً من المُجرَّد، فإن الوصف يبرز كأحد أقدم الأغراض في الشعر الجاهلي لارتباطه الوثيق بالحواس. ألا تُلاحظ كيف تنقل الحواس – كالجسور بين العالم الخارجي والعقل – صور الموجودات إلى الدماغ، حاملةً إياها مرئيةً أو مسموعةً؟ ثم كيف يتحول هذا الكمّ من الصور الذهنية إلى كلماتٍ منسوجةٍ في أبياتٍ وقصائد، يعيد الشاعر من خلالها تشكيل تلك التمثيلات الحسية بأسلوبٍ فنيٍّ يختاره؟
ليس في تأكيد قدم الوصف ما يُفيد أنه كان منذ بدايته غرضاً مُستقلاً بذاته، يحتل مساحةً واسعةً في القصائد، بل كان يتداخل مع أغراضٍ أخرى، يتسلل بين ثناياها. ويُعزز هذا الرأي أمورٌ؛ كقول ابن رشيق: “الشعر إلا أقلّه راجع إلى باب الوصف”، وحقيقة أن الشعراء في الأغراض غير الوصفية – كالكرم والشجاعة – كانوا يعمدون إلى التشبيهات الحسية لتجسيد الأفكار المجردة. فالكرم يُشبَّه باندفاع السيل وغزارة المطر، والشجاعة بزئير الأسد وانقضاض النسر، وحقد الأقارب يُصوَّر بحدّ السيف ولهيب الجمر، حتى تصبح المعاني وكأنها ماثلةٌ أمام العين. وهذا ما يُفسر القولة القديمة: “أحسن الوصف ما نُعت به الشيء حتى تكاد تراه عياناً”.
فكيف يُعَرَّف الوصف في المنظور النقدي القديم؟ وما أبرز الموضوعات التي شكَّلت مادة الوصف في الشعر الجاهلي؟ وما السمات الفنية التي ميّزت وصف الجاهليين؟ أسئلةٌ تُلقي الضوء على طبيعة هذا الغرض الذي جعل الحواسَ جسراً بين الواقع والفن.
معنى الوصف وتقسيمه
أوضح ابن رشيق أن جَوهر الوصف يكمن في “الكشف والإظهار”، مُستشهداً بتعبيرٍ مجازيٍّ: “وُصِفَ الثوبُ الجسدَ إذا نَمَّ عليه ولم يستره”. ومن زاويةٍ تحليليةٍ، عرَّفه قدامة بن جعفر بأنه “ذكر الشيء بحسب ما فيه من أحوال وهيئات”، بينما ركَّز أحمد بن فارس على بعده الجمالي فوصفه بأنه “تحلية الشيء”، مشيراً إلى أن “الصفة” تمثل السمة الملازمة له. وأضاف ابن فارس تمييزاً دقيقاً بين الوصف والنعت، نقلاً عن الخليل بن أحمد الفراهيدي: فالنعت – خلافاً للوصف – لا يُطلق إلا على المحمود، بينما الصفة تشمل المدح والذم. وهكذا، يصبح الوصف أشمل؛ إذ يَسرد الواصف سمات الموصوف (مديحاً أو قدحاً)، بينما يقتصر النعت على تجميل الصفات في خيال السامع.
ولأن الشعراء يَصوغون صوراً تتناغم مع عواطفهم – مديحاً لحبيبٍ، أو هجاءً لعدوٍّ – اختار النقاد تسمية “الوصف” لهذا الغرض، ليكون مُتسعاً لاحتواء الجميل والقبيح، والحبيب والمكروه. ولم يُفرِّط القدماء في دراسة الوصف رغم تداخله مع أغراضٍ كالغزل والفخر؛ فحافظوا على مواضعه داخل القصائد كعنصرٍ عضويٍّ، كدراسة عالم الآثار للنقوش دون انتزاعها من جدران المعابد، محلِّلين جمالياتها وعيوبها بإنصاف.
أما عن أدواته الفنية، فقد اتفقوا على استخدامه فنون البيان كالتشبيه والاستعارة، لكنهم ميّزوا بينه وبينها؛ فالتشبيه – بحسب ابن رشيق – “اختبار عن حقيقة الشيء”، بينما الوصف “مجاز وتمثيل”، مع تأكيده أن الوصف يتواءم مع التشبيه دون أن يذوب فيه، إذ غالباً ما يظهر في تفاصيله الثانوية. وهكذا، تجلَّت رؤية النقاد للوصف كفنٍّ قائمٍ بذاته، رغم تشابكه مع الأغراض والأدوات، كنسيجٍ مُلوَّنٍ تجتمع فيه خيوطُ المعاني والصور.
تحليق في مرابع الوصف الجاهلي
لم يَكتفِ الدارسون المحدثون بدراسة القصائد الجاهلية ككيانٍ متكامل، بل اقتحموا عوالمها مُجتازين حُدودَها، فانتزعوا الصورَ الوصفية منها كأحجارٍ ثمينةٍ لتحليلها بمعزلٍ عن سياقها الأصلي. وهكذا، صَنَّفوا ما استخرجوه إلى فئتين رئيسيتين: الطبيعة الساكنة التي تخلو من النبض الحيّ، وتشمل أوصاف الجبال الشامخة، والشعاب الوعرة، والأودية المترامية، إضافةً إلى الأطلال البائدة، والدارات المهجورة، والحرّات القاحلة، والغدران الخالية، والآبار الغائرة، مع تفاصيل الأمطار الهاطلة وما يرافقها من برقٍ يلمع ورعدٍ يُدوي وسيولٍ جارفة. ولم يغفلوا وصف السماء بكلِّ أحوالها: غيوماً تكتسي، ونجوماً تتلألأ، وصَفاءً يشرق أو كَدراً يعتم، والأرض بما تحويه من صخورٍ صمّاء، ورمالٍ ذهبية، وأشجارٍ شامخة، وأعشابٍ متمايلة، وواحاتٍ خضراء.
أما الطبيعة الحيّة المُتحركة، فحَوَتْ عالَمَ الكائنات الصحراويّ بكلِّ تناقضاته: من الإبلِ المُطواعةِ والخيولِ الأصيلةِ والغنمِ الرعويةِ، إلى السِّباعِ المُفترسةِ والضَّواري المُتربصةِ والأفاعي الزاحفةِ، دون إغفال الحشراتِ الدقيقةِ والطُّيورِ المحلقةِ، ليَخلُصوا إلى تصوّرٍ لصحراءٍ زاخرةٍ بالحياةِ الفطريةِ المتشبثةِ بترابِها.
ولكنْ، تبقى الصحراءُ – في جوهرها – مَلكةَ السُّكونِ المُطلَق: صمتٌ يُرهب، رتابةٌ تُمتد، فراغٌ يَسدُّ الأفقَ وحشةً وضجراً، وهيبةٌ تَربضُ على الفلواتِ والكثبانِ. وهنا تتناقضُ شمسُ الصحراءِ مع شمسِ الغابةِ؛ فبينما تبعثُ الأخيرةُ الحياةَ في الأعشاشِ والأوكارِ، تُحولُ الأولى الرمالَ إلى مرآةٍ تُحرقُ الأبصارَ بسَرابٍ خادعٍ، يجرُّ العطاشَى – كالشاعرِ سُويد بن أبي كاهل اليشكريّ – إلى فِخاخِها:
كم قطعنا دون سلمى مهمهاً *** نازحَ الغور إذا الآلُ لَمَعْ
في حَرور يُنْضَجُ اللّحمُ بها *** يأخذ السّائر فيها كالصَّقَعْ
بل بلغ التوهُّمُ ببعضِ الشعراءِ – كشبيب بن البرصاء – أن رأى السَّرابَ سيلاً عَرِمًا يندفعُ قبل الضحى من القممِ إلى السُّفوحِ، هائجاً في صحراءَ قاحلةٍ:
ومُغبرّة الآفاق يجري سحابها *** على أُكْمها قبل الضحى، فيموجُ
وهكذا، تحوَّلتْ الصحراءُ في الشعرِ الجاهليِّ إلى لوحةٍ تتنازعُها الحياةُ والموتُ، الواقعُ والخيالُ، الصَّلابةُ والهشاشةُ.
رحلة الرياح في فلاة الكلام
عندما يَبلغُ الظهيرةَ ذروتَها، وتَلتهبُ الهاجرةُ، وتجفُّ الألسنةُ في الأفواهِ، وتتورَّمُ العيونُ في المحاجرِ، وتَسيرُ القافلةُ عبرَ الفلاةِ مرحلةً تلوَ الأخرى – كسُفنٍ تشقُّ أمواجَ البحرِ – تَخيّلَ زهيرُ بنُ أبي سُلمى أنَّ القافلةَ سُفنٌ تَطفو في السرابِ، تعلو تارةً وتنخفضُ أُخرى، تختفي حيناً وتظهرُ حيناً، مُتّجهةً إلى مواضعَ كالأشرافِ وقطنَ، كأنها من بعيدٍ أشجارُ المقلِ:
يقطعْنَ أجوازَ أميالِ الفلاةِ كما *** يغشى النَّواتي اللُّجَ بالسّفنِ
يخفضُها الآلُ طوراً، ثمّ يرفعُها *** كالدَّوم يعمدنَ للإشرافِ أو قَطَنِ
وحينَ يُسرعُ السيرُ بالقافلةِ، ويَمضي النهارُ قبلَ وصولِ العطاشَى إلى الماءِ، ويُحيطُ الظلامُ بالسائرينَ، توهمَّ بشرُ بنُ أبي خازمَ أنَّ صوتَ “السِّهام” (ريحاً باردةً) هوَ أنينُ الشياطينِ:
وخَرقٍ تعزِفُ الجِنّانُ فيه *** فيا فيه تحنُّ بها السِّهام
وللرياحِ في الصحراءِ أجناسٌ وأسماءٌ: فـ”الدَّبور” ريحٌ مشؤومةٌ تُبعدُ السحابَ، فترتبطُ بالشدائدِ، كما وصفَ الأعشى ازدحامَ الدروعِ المتحاتّةِ بصوتِها الذي يُشبهُ حفيفَ الحصيدِ اليابسِ تحتَ هبوبِ الدَّبورِ:
لها جرسٌ كحفيفِ الحصـــــــــــا *** د صادفَ بالليل ريحاً دَبورا
أما “السَّموم” فريحٌ لافحةٌ تُحوِّلُ الوجوهَ والظباءَ إلى ما يشبهُ الشواءَ، كما صورها البعيثُ الحنفيُّ:
وهاجرة تشوي مهامها سمومُها *** طبخت بها عيرانةً واشتويتُها
لكنَّ الصحراءَ – رغمَ قسوتِها – لا تخلو مِن نسماتٍ رطبةٍ كـ”الشامية” التي تُلطفُ الجفافَ آخرَ الليلِ، فتصفُها أبياتُ الأسعرِ الجعفيِّ:
باتت شاميةُ الرياح تلفُّهم *** حتى أتَوْها بعدَما سقط الندى
وتَهُبُّ رياحُ “الصَّبا” و”القَبُول” معَ الربيعِ حاملةً العبيرَ، بينما تَجلبُ الرياحُ الجنوبيةُ المطرَ منَ اليمنِ والحجازِ، فتَملأُ الغدرانَ، كما في قولِ عبيدِ بنِ الأبرصِ:
هبّت جنوبٌ بأولاه ومال به *** أعجاز مزنٍ يسح الماء دلاّح
فأصبح الرّوضُ والقيعانُ ممرعةً *** من بين مرتفق فيه ومن طاحِ
وهكذا تتحوّلُ الريحُ – بسحابِها المُشرَعِ – إلى جسرٍ بينَ الصحراءِ والسماءِ، كأنّما تُعيدُ رسمَ الحياةِ بأنفاسِها المُتقلبةِ.
سحابة الشعرِ تمطر جمالاً
ربما كانت الغيمةُ السوداءُ المُثقَلةُ بالمطرِ لوحةً عزيزةً على عبيدِ بنِ الأبرصِ أو أوسِ بنِ حَجَرٍ؛ فهيَ تُحيي في نفسِ الشاعرِ أُفُقَ الأملِ، فَيَتهَافُ لها شَوقاً، يَتَقافَزُ فَرَحاً بِظِلالِها، ويَتمدَّدُ شَغَفاً ليُلامِسَ ذيلَها المُتدلّي:
دانٍ مسفٍ فُوَيقَ الأرضِ هيدبُه *** يكادُ يدفعه من قامَ بالرّاحِ
وليسَ في سُحبِ السماءِ أعظمُ مِن “الهَتُون”، فإذا عَبَرَتْ سماءَ الجاهليينَ سحابةٌ تَحمِلُ بُشرى الغيثِ، تَهادَوا البَشائرَ، وطلبَ امرؤُ القيسِ إلى رِفاقِه أنْ يَتَلَذّذوا ببَريقِها الوامضِ مِن بَعيدٍ، ويَرصدوا امتِدادَها مِن أقصى الأُفُقِ إلى أقصاهُ، وهيَ تُكَلِّلُ قِمَمَ الجبالِ بعَمائِمَ سُودٍ. لكنْ هيهاتَ أنْ تُجارِيَ نفوسُ الناسِ نَفسَ الشاعرِ تَوقاً للتأمُّلِ، واهتِزازاً للجَمالِ، وقُدرةً على اصطيادِ لُؤلُؤِ الفنِّ مِن أعماقِ الكونِ:
أصاحِ ترى برقاً أُريكَ وميضَه *** كلمع اليدين في حَبيٍ مكلّلِ
قعدت واصحابي له بين ضارجٍ *** وبين العُذيب بُعدما متأمّلي
علا قطناً بالشيم أيمنُ صَوْبه *** وأيسره على الستار فيذبُلِ
وحينَ تَبرُقُ السماءُ وتُرعِدُ، وتَنهمِرُ سيولُ المطرِ على الجبالِ، تَفرُّ الوُعولُ المُعتَصِمةُ بالشِّعابِ هاربةً مِنَ الفيضانِ الذي اقتَلَعَ نَخيلَ تيماءَ، وهَدَّمَ بيوتَها، ولم يَنجُ إلا الصَّروحُ الشامخةُ بِحَجَرِها. وكيف تَنجو الوُعولُ مِن سُيولٍ غَمَرَتِ الضواريَ السُّودَ، ونَثَرَتْ أشلاءَها مُلَطَّخةً بالوَحلِ، كأنَّها جُذورُ بَصَلٍ بَرِّيٍّ؟
ومرّ على القنان من نَفَيانه *** فأنزل منه العُصمَ من كل موئلِ
وتيماءَ لم يترك بها جذعَ نخلةٍ *** ولا أُجُماً إلّا مشيداً بجندلِ
كأنّ السّباع فيه غرقى عشيةً *** بأرجائه القصوى أنابيشُ عنصلِ
هذهِ لَمحاتٌ مِن لوحةٍ شاسعةٍ، أبدعَ امرؤُ القيسِ رَسمَها بِفَرْشاةِ فَنّانٍ وَاقعيٍّ، كأنَّ في عَينَيهِ عدسةَ سينما تَصطادُ المَشاهدَ بِأبعادِها، وتُخلِّدُ الأماكنَ بأسمائِها، والحركاتِ بِعُنفِها وسُكونِها، وتَرصُدُ الطبيعةَ بِحَيويَّتِها الثائرةِ، وطاقتِها المُدمِّرةِ، تَتَنَقَّلُ بَينَ أطرافِ الأُفُقِ، وقِمَمِ الجبالِ، وأَقدامِ السُّفوحِ، وبَينَ الوُعولِ الهاربةِ والضَّواري الغارقةِ، التي تَرَكَها السَّيلُ جُثَثاً بلا قُبورٍ.
متناقضات الماء بين الخراب والولادة
رَغمَ ما يُخلِّفُهُ السَّيلُ مِن دَمارٍ يَقتَلِعُ النَّخيلَ ويَهدُمُ المَنازِلَ، يَبقى المَاءُ – بِقَدَريَّتِه – أصلَ الحَياةِ. فحينَ يَهدَأُ غَضَبُهُ، ويَستَقِرُّ في الشِّعابِ والأباطِحِ، يَتحوَّلُ إلى غُدرانٍ تَختَزِنُ الحَياةَ، ومَواردَ تَلتَمِسُها العُطاشَى. وحتَّى السَّيلُ العَظيمُ الذي يَعبُرُ وَادِياً وَعِراً – لَم تَطَأْهُ قَدَمٌ – يَخلَعُ الصُّخورَ مِن جَوانِبِه، مُحَوِّلاً مَقالِعَها إلى بِرَكٍ تَتَدَفَّقُ بِمَاءٍ عَذبٍ بَارِدٍ.
وَغُدرانٌ تَبْقَى مَوَاهِبُها دَائِمَةً: تُروي ولا تُستَرقُ، تُجدِّدُ الحَياةَ دونَ أنْ تَتَجَدَّدَ، ولا تَضِيقُ بِوافِدٍ – ولو كانَ مِن شَياطينِ الصَّعاليكِ كـ”تَأبَّطَ شَرّاً” الذي يَتَباهى بِورودِها:
وشعب كشلّ الثوب شكسٍ طريقُه *** مجامعُ صُوْحيه نِطاف مخَاصِرُ
به من سيول الصّيف بيضٌ أقرَّها *** جُبَارٌ كصُمّ الصخر فيه قراقرُ
به سَملاتٌ من مياهٍ قديمةٍ *** مواردها ما إن لهنّ مصادرُ
ولأنَّ جَزيرَةَ العَرَبِ تَفِدُها الأنهارُ الجاريةُ نَذراً، يَذهَلُ البَدويُّ إذا وَقَفَ أمامَ نَهرٍ عَظيمٍ كالفُراتِ. وإذا كانَ الواقِفُ شاعِراً كـ”النابغة الذبيانيِّ” – هارِباً مِن غَضَبِ النُّعمانِ – تَسْتَوْحِشُ نَفسُهُ، فَيَتتبَّعُ بِبَصَرِهِ تَقَلُّبَ الأمواجِ وهيَ تَقذِفُ الزَّبَدَ على شاطئِ النَّهرِ، وتَمتَلِئُ رُعباً كامتِلاءِ الفُراتِ مِن حُطامِ الأشجارِ، فَيَشُدُّهُ إحساسُهُ بِضَعفِهِ لِيُقارِنَ نَفسَهُ بِسَفينةٍ تُحاوِلُ اجتيازَ النَّهرِ فَتَعْيَا، ويَستَغيثُ فَلا يُغاثُ. حتَّى يُخيَّلَ إلَيهِ أنَّ لا مَلجَأَ مِن سُلطانِ النُّعمانِ إلاّ الاعتِصامُ بِعَفْوِهِ:
فما الفرات إذا جاشتْ غواربُهُ *** ترمي أواذيُّه العِبرين بالزّبدِ
يُمدّه كلُّ وادٍ مُترعٍ لجب *** فيه حطامٌ من الينبوتِ والخَضَدِ
يظل من خوفه الملّاح معتصماً *** بالخيزُرانةِ بعد الأيَن والنَّجدِ
يوماً بأجودَ منه سيبَ نافلةٍ *** ولا يَحُول عطاءُ اليوم دونَ غدِ
ومَهما اشتَدَّ عَصفُ الرِّياحِ، وقَصَفَ الرَّعْدُ، وانْهالَتِ الأَمطارُ، وَهَدَرَتِ السُّيولُ وَالأَنهارُ، تَبقَى طَبيعةُ الصَّحراءِ – بِجَوهَرِها – هُدوءاً مُطْبِقاً. فإذا خَمَدَتِ الرِّيحُ، وَغاضَ المَاءُ، عادَتْ إلَيها رَزانَتُها الوَقُورَةُ، وانْشَقَّ رَملُها الرَّوِيُّ عَنْ نَباتٍ مُتَنوِّعٍ، كأنَّما الحَياةُ تَنبُتُ مِن رَحِمِ الكَوارِثِ.
واحةُ الشِّعرِ تَتَفَتَّحُ بِأغصانِ الحُروفِ
لَعَلَّ أبهَى ما تَحمِلُهُ الرِّمالُ بَينَ ثَناياها – وأَنْفَعَهُ – هُوَ عَرائسُ النَّخيلِ؛ فَمِن رُطَبِها وَتَمرِها يَكتَسِي الشَّاعِرُ قُوتاً، وتَحتَ سَقفِها المُمتَدِّ يَجِدُ الظِّلَّ الوارِفَ. فَلا عَجَبَ أنْ تَكونَ واحَةُ النَّخيلِ مَأوَى قَلبِ الرَّبيعِ بنِ أَبِي الحَقيقِ، حَيثُ يَسكُنُ إلَيها، ويَتَمَتَّعُ بِأغصانِها المُتدَلِّيَةِ، وَقِطافِها الدَّانِيَةِ، وَأوراقِها المُتناسِقَةِ، بَاسِطاً تَسابيحَهُ لِلقُدرَةِ الَّتِي أَبدَعَتْ صُنعَها، وَنَسَجَتْ مِن أليافِها ثِياباً قَشيبَةً:
أذلك أمْ غرسٌ من النخل مترع *** بوادي القرى فيه العيونُ الرّواجعُ
لها سعفٌ جُعدٌ وليفٌ كأنه *** حواشي برودٍ حاكهنّ الصّوانعُ
وَحينَ يُغادِرُ البَدويُّ النَّخيلَ، تَطلُعُ لَهُ في أَكنافِ الصَّحراءِ أَشجارٌ وَشُجَيراتٌ: مِنها شَجَرَةُ “الأرْطَى“ الَّتِي يَلوذُ بِظِلِّها الثَّورُ الوَحشِيُّ مَعَ صِغارِهِ، وَشَجَرَةُ “الأراك“ الَّتِي تُظَلِّلُ الظِّباءَ وَالآرامَ، وَشَجَرَةُ “الأثْل“ الَّتِي تَصيرُ رَمزاً لِلرُّسوخِ وَالشَّرفِ، حَتَّى يُقالَ لِلمَجدِ الأَصيلِ: “مَجدٌ مُؤثَّل”. وَشَجَرَةُ “السَّمُر“ الَّتِي تَحومُ حَولَها أَساطيرُ العَربِ كَونَها مَوطِناً لِـ”العُزَّى” – إحَدَى آلِهَتِهِم – وَكانَتْ مَظَلَّةً لِامرِئِ القَيسِ وَهُوَ يَبكي حَبيبَتَهُ بِدُموعٍ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ حَنظَلاً.
وَمِنَ الأَشجارِ الَّتِي وَصَفَها شُعراءُ العَربِ: “الغَرَب“ (شَجَرٌ تُصْنَعُ مِنهُ أَقداحٌ بَيْضٌ)، وَ“النَّبْع“ (شَجَرٌ صَلْبٌ يَنبُتُ في قِمَمِ الجِبالِ، تُتَّخَذُ مِنهُ الرِّماحُ)، وَمِنهُ – أَو مِن “الضّال“ – صُنِعَتْ قَوسُ الشِّماخِ بنِ ضِرَارٍ العَذراءُ، الَّتِي غَدَتْ أَثمَنَ قِسِيِّ العَربِ وَأَشهَرِها. أَمَّا ثَمَنُها الَّذي باعَها بِهِ الشِّماخُ مُضطَرّاً، فَهُوَ إزارٌ نَفيسٌ، وَأَربَعُ أَوَاقٍ، وَثَمانِي أَساوِرَ مِن ذَهَبٍ خَالِصٍ، وَثَوبَانِ مُخَطَّطانِ، وَتِسعُونَ دِرهَماً فِضِّيّاً، وَجِلدٌ مَدبوغٌ.
وَأَمَّا شُهرَتُها، فَلِأَنَّها نَبتَتْ في أَجَمَةٍ كَثيفَةٍ تَحفَظُها الأَغصانُ، فَخَرَجَ غُصنُها الأَملَسُ مُستَقِيماً كَأَنَّمَا نَحَتَتْهُ يَدُ القُدرَةِ دِرعاً لِحِمايةِ هَذَا الكَنزِ. لِذَلِكَ لَم يَستَطِعِ الصَّانِعُ – رَغمَ بَراعَتِهِ – انتِزاعَها إلّا بَعْدَ إزاحَةِ الفَسائلِ وَالأَعشابِ حَولَها، كَما وَصَفَ الشِّماخُ:
تخيّرها القوّاس من فرع ضالة *** لها شذبٌ من دونها وحواجز
نمت في مكان كنّها، واستوت به *** فما دونها من غيلها متلاحز
فما زال ينجو كلّ رطب ويابس *** وينغلّ حتى نالها وهو بارز
أَفَلا يَحِقُّ لِلشَّاعِرِ أَن يَندَمَ بَعدَ بَيعِ هَذِهِ القَوسِ؟ فَهُوَ لَم يَبِعْ غُصناً فَحَسْبُ، بَلْ باعَ وَاحَةً كامِلَةً في غُصنٍ، وَذِكرَى عَزيزَةً لَنْ تَخْلُقَها الدُّنيا. فَمِنَ الوَفاءِ أَن يُبكِيَها عِندَ فِراقِها:
فلمّا شراها فاضت العينُ عبرةً *** وفي الصدر حُزَّازٌ من الوجد حامِزُ
هَكَذا تَحوَّلَتِ الأَشجارُ في شِعرِ العَربِ إلَى رُموزٍ تَحْمِلُ أَنفاسَ الحَياةِ، وَأَساطيرَ الصَّحراءِ، وَدُمُوعَ الشُّعراءِ.
رَوْحُ الطَّبيعةِ تَتَنَفَّسُ بَيْنَ أَشْطَارِ الشِّعْرِ الجَاهِلِيّ
في الشِّعرِ الجَاهِلِيِّ تَتَجَلَّى لَوْحَاتٌ فَنِيَّةٌ عَدِيدَةٌ لِكُرومِ العِنَبِ المُتَرَاقِصَةِ تَحْتَ ظِلَالِ النَّخِيلِ، وَذِكْرٌ مُفَصَّلٌ لِلأَعْنَابِ وَالثِّمَارِ كَالتُّفَّاحِ وَالتِّينِ وَالرُّمَّانِ، وَعِنَايَةٌ فَائِقَةٌ بِأَزْهَارِ الصَّحْرَاءِ مِثْلَ العَرَارِ وَالشِّيحِ وَالقَيْصُومِ، وَتَغَنٍّ بِعُطُورِ اللَّبَانِ وَالسَّلَمِ وَالخُزَامَى. وَلَعَلَّ الأَقْحُوَانَ فِي ذَلِكَ العَصْرِ كَانَ يُلْهِمُ الشُّعَرَاءَ مَا تُلْهِمُهُ الوُرُودُ البَيْضَاءُ مِنْ مَعَانِي النَّقَاءِ وَالصَّفَاءِ، وَالتَّوْقِ إِلَى الفِطْرَةِ البَسيطَةِ. وَلَعَلَّ الرَّيْحَانَ كَانَ يُمَثِّلُ فِي عُيُونِ العَرَبِ مَا يُمَثِّلُهُ الغَارُ عِنْدَ الأُورُوبِيِّينَ. وَلَعَلَّ شَغَفَهُمْ بِرَائِحَتِهِ دَفَعَهُمْ إِلَى تَسْمِيَةِ كُلِّ زَهْرَةٍ طَيِّبَةِ العِطْرِ بِاسْمِهِ، فَشَاعَ ذِكْرُهُ فِي أَشْعَارِهِمْ. وَقَدْ صَوَّرَ الشَّنْفَرَى مَجْلِسًا أَوَى إِلَيْهِ مَسَاءً، فَتَخَيَّلَ تَحْتَ سَقْفٍ مِنَ الرَّيْحَانِ المُعَطَّرِ بِقَطَرَاتِ المَطَرِ، المُتَفَتِّحِ أَزْهَارًا، الفَاحِشِ عِطْرًا، فَقَالَ:
فَبِتْنَا كَأَنَّ البَيْتَ حُجِّرَ فَوْقَنَا *** بِرَيْحَانَةٍ، رِيحَتْ عِشَاءً وَطُلَّتِ
بِرَيْحَانَةٍ مِنْ بَطْنِ حُلْيَةَ نَوَّرَتْ *** لَهَا أَرَجٌ مَا حَوْلَهَا غَيْرُ مُسْنَتِ
سَبَقَ أَنْ تَحَدَّثْنَا عَنْ طَبِيعَةِ الصَّحْرَاءِ وَسُكَّانِهَا، لِأَنَّ جُزْءًا كَبِيرًا مِنْ بِلاَدِ العَرَبِ صَحَارَى وَفَلَوَاتٌ، لَكِنَّ ذَلِكَ لَا يَعْنِي انْعِدَامَ الخُضْرَةِ؛ فَفِي بِلَادِهِمْ رِيَاضٌ أَحْصَى “يَاقُوتُ الحَمَوِيُّ” مِنْهَا مِائَةً وَسِتًّا وَثَلَاثِينَ رَوْضَةً، ثُمَّ أَضَافَ: «وَالرِّيَاضُ المَجْهُولَةُ كَثِيرَةٌ جِدًّا». وَفَسَّرَ تَشَكُّلَ الرَّوْضَةِ قَائِلًا: «فِي البَادِيَةِ قِيعَانٌ وَسَلْقَانٌ وَاسِعَةٌ تَسْتَقِرُّ فِيهَا المِيَاهُ بَعْدَ السُّيُولِ، فَتَنْبُتُ أَنْوَاعًا مِنَ العُشْبِ وَالبُقُولِ، وَلَا تَذْبُلُ سَرِيعًا. وَعِنْدَمَا تَخْضَرُّ تِلْكَ الرِّيَاضُ فِي مَوْسِمِ الأَمْطَارِ، تَصِيرُ مَرَاعِيَ خِصْبَةً لِلعَرَبِ». ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَ الحَدِيقَةِ وَالرَّوْضَةِ: «الحَدِيقَةُ هِيَ الرَّوْضَةُ المُلْتَفَّةُ النَّبَاتِ، حَيْثُ يَتَكَاثَفُ العُشْبُ كَأَنَّهُ سِيَاجٌ».
وَمِنْ أَبْهَى الصُّوَرِ الَّتِي نَقَشَهَا الجَاهِلِيُّونَ لِلرِّيَاضِ مَا وَرَدَ فِي مُعَلَّقَةِ عَنْتَرَةَ عِنْدَ وَصْفِهِ ثَغْرَ حَبِيبَتِهِ عَبْلَةَ، حَيْثُ شَبَّهَ رَائِحَتَهُ بِرَوْضَةٍ لَمْ تَدُسَّهَا حَيَوَانَاتٌ، بَلْ حَدِيقَةٍ عَذْرَاءَ سَقَاهَا مَطَرٌ نَقِيٌّ، فَامْتَلَأَتْ غُدْرَانُهَا بِمَاءٍ صَافٍ كَالدَّرَاهِمِ الفِضِّيَّةِ، وَاسْتَمَرَّتِ الأَمْطَارُ تَهْطِلُ عَلَيْهَا كُلَّ مَسَاءٍ حَتَّى اخْضَرَّتْ، فَرَقَصَ الذُّبَابُ فِيهَا فَرَحًا كَمَا يَتَرَنَّمُ السَّكْرَانُ الطَّرُوبُ. وَلَوْ أَنْعَمْتَ النَّظَرَ فِي الذُّبَابِ المُنْشَرِحِ لَرَأَيْتَهُ يَلْهُو بِأَرْجُلِهِ، يَبْسُطُهَا وَيَقْبِضُهَا، وَيَحُكُّ بَعْضَهَا بِبَعْضٍ، كَمَا يَفْعَلُ الرَّجُلُ الَّذِي يُشْعِلُ النَّارَ بِزِنَادٍ بِيَدٍ غَيْرِ مُكْتَمِلَةِ الخِلْقَةِ.
هَكَذَا حَوَّلَ الشُّعَرَاءُ الجَاهِلِيُّونَ طَبِيعَةَ صَحْرَائِهِمِ القَاسِيَةِ إِلَى فُسَيْفِسَاءٍ مِنَ الجَمَالِ، يُنَاجُونَ بِهَا الحُبَّ وَالحَيَاةَ.
أو روضةٌ أنفاٌ تضمّن نبتها *** غيثٌ قليلُ الدِّمن ليس بمعلمِ
حادت عليه كلّ عين ثرَّة *** فتركن كل قرارة كالدّرهم
سَحّاً وتسكاباً فكلّ عشيّةٍ *** يجري عليها الماءُ لم يتصرّمِ
وخلا الذباب بها ليس ببارحٍ *** غَراداً كفعْلِ الشارب المترنمِ
هَزِجاً يحُك ذراعَه بذراعِه *** قدح المكبّ على الزناد الأجذمِ
الفصولُ والنجومُ: نَظْمُ الزَّمَنِ فِي نَسِيجِ الشِّعْرِ الجَاهِلِيّ
ارتبطَتْ صُوَرُ الطَّبيعةِ فِي الشِّعرِ الجَاهِلِيِّ بِدَقَائِقِ الزَّمَنِ، فَصاغَ الشُّعَرَاءُ حَكَايَاتِ الفُصُولِ: الخَرِيفِ زَمَنِ قِطَافِ الثِّمَارِ بَعْدَ نُضْجِهَا، وَالشِّتَاءِ زَمَنِ القُرِّ وَالقَسْوَةِ، وَالصَّيْفِ مَوْسِمِ السَّرَابِ اللَّاهِبِ، وَالرَّبِيعِ وَقتِ اخْضِرَارِ الأَرْضِ وَخُضُورِ المَرَاعِي. حَتَّى إِذَا وَجَدَتِ القَبِيلَةُ رَوْضَةً غَمَرَهَا الثَّلْجُ ثُمَّ أَذَابَتْهُ أَمْطَارُ الرَّبِيعِ، تَرَاجَعَ عَنْهَا الرُّحَّلُ – كَعُبَيْدِ بنِ الأَبْرَصِ – لِسَبَخَتِهَا:
فِي رَوْضَةٍ ثَلَّجَ الرَّبِيعُ قَرَارَهَا *** مُوَلِّيَةٍ لَمْ يَسْتَطِعْهَا الرُّوَّدُ
وَبَدَا لِكَوْكَبِهَا صَعِيدٌ مِثْلُ مَا *** رِيحُ العَبِيرِ عَلَى المَلَابِ الأَصْفَدُ
وَمِنْ فُصُولِ السَّنَةِ الطَّوِيلَةِ تَتَفَرَّعُ وَحَدَاتٌ زَمَنِيَّةٌ دَقِيقَةٌ: اللَّيْلُ بِاثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَاعَةً (الغَسَقُ، الفَحْمَةُ، العَشْوَةُ…)، وَالنَّهَارُ بِمِثْلِهَا (الشُّرُوقُ، الرَّأْدُ، المُتَوَعُ…). وَرُبَّمَا نَبَعَتْ هَذِهِ الدِّقَّةُ مِنْ حَاجَةِ البَدْوِ إِلَى ضَبْطِ مَوَاقِيتِ التَّرْحَالِ وَالتَّأَمُّلِ النَّجْمِيِّ، فَصَاغُوا كُلَّ سَاعَةٍ بِمَشْهَدٍ: الصَّبَاحُ وَقْتُ الغَارَاتِ، الضُّحَى وَقْتُ سُكُونِ النُّفُوسِ، العَشِيُّ وَقْتُ خُرُوجِ الأَغْوَالِ المُرْعِبَةِ. وَمَنْ كَانَ عَلَى سَفَرٍ – كَزُهَيْرِ بنِ أَبِي سُلْمَى – أَسْرَعَ نَحْوَ مَأْمَنِهِ:
تُبَادِرُ أَغْوَالَ العَشِيِّ، وَتَتَّقِي *** عِلَالَةَ مَلْوِيٍّ مِنَ القَدِّ مُحْصَدِ
أَمَّا اللَّيْلُ فَهُوَ مَلْجَأُ الهَوَاجِسِ؛ حَيْثُ يَخْلُو الشَّاعِرُ إِلَى أَحْزَانِهِ، فَيَصِفُهُ امْرُؤُ القَيْسِ بِجَمَلٍ ضَخْمٍ يَتَمَطَّى عَلَى القُلُوبِ، وَيَسْتَدْعِي الفَجْرَ – وَإِنْ كَانَ لَا يَجْلِبُ سَلَاوَى – لِيَغْسِلَ أَثَرَ الأَرَقِ:
وَلَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُولَهُ *** عَلَيَّ بِأَنْوَاعِ الهُمُومِ لِيَبْتَلِي
فَقُلْتُ لَهُ لَمَّا تَمَطَّى بِصُلْبِهِ *** وَأَرْدَفَ أَعْجَازًا وَنَاءَ بِكَلْكَلِ
أَلَا أَيُّهَا اللَّيْلُ الطَّوِيلُ أَلَا انْجَلِي *** بِصُبْحٍ وَمَا الإِصْبَاحُ مِنْكَ بِأَمْثَلِ
لَكِنَّ سِحْرَ النُّجُومِ لَمْ يَغِبْ عَنْ بَصِيرَةِ الشُّعَرَاءِ: الشَّمْسُ، القَمَرُ، الدَّبَرَانُ، السِّمَاكَانِ، الشِّعْرَى، الفَرْقَدَانِ، الثُّرَيَّا … كَانَتْ مَصَادِرَ لِلمَعَانِي وَالصُّوَرِ. فَعَنْتَرَةُ يُشَبِّهُ وَجْهَ حَبِيبَتِهِ بِالقَمَرِ المُحَاطِ بِالنُّجُومِ:
وَبَدَتْ فَقُلْتُ البَدْرُ لَيْلَةَ تَمِّهِ *** قَدْ قَلَّدَتْهُ نُجُومَهَا الجَوْزَاءُ
وَيَرْقُبُ البِشْرُ بنُ أَبِي خَازِمٍ بَنَاتِ نَعْشٍ – السَّبْعَةَ نُجُومِ – تَدُورُ كَبَقَرَاتٍ وَحْشِيَّةٍ حَتَّى يَغِيبَ ضَوْؤُهَا مَعَ الفَجْرِ:
أُرَاقِبُ فِي السَّمَاءِ بَنَاتِ نَعْشٍ *** وَقَدْ دَارَتْ كَمَا عُطِفَ الصِّوَارُ
وَيَرَى النَّابِغَةُ الذُّبْيَانِيُّ فِي مُحَيَّا مَحْبُوبَتِهِ بَهَاءَ الشَّمْسِ تَحْتَ غِشَاءٍ رَقِيقٍ:
قَامَتْ تُرَاءَى بَيْنَ سَجْفَيَّ كُلَّةٍ *** كَالشَّمْسِ يَوْمَ طُلُوعِهَا بِالأَسْعَدِ
هَكَذَا كَانَتِ النُّجُومُ – كَمَا يَرَى د. عَبْدُ الأَمِيرِ شَامِي – مِرْآةً لِجَمَالِ الطَّبِيعَةِ وَبَشَرَةِ الحَبِيبَةِ وَبَطُولَاتِ الفَارِسِ، تُلَقِّنُ الشُّعَرَاءَ أَلْسِنَةَ المَجَازِ وَالإِشَارَاتِ، فَصِيغَتْ بِهَا أَبْيَاتٌ تَتَأَلَّقُ كَالزُّئَبْقِ فِي قَوَارِيرَ سَمَاوِيَّةٍ.
الطبيعةُ في مرآة الشعر الجاهلي: جبالٌ تَحتَجِفُ السُّحبَ وكثبانٌ تَرقُصُ مَعَ الرِّياحِ
ارتَبَطَ عُلُوُّ النُّجُومِ في خَيَالِ الشَّاعِرِ الجَاهِلِيِّ بِعَظَمَةِ الجِبَالِ، فَكَما احتَفَتِ السَّمَاءُ بِالنُّجُومِ، احتَفَتِ الأَرْضُ بِالجِبَالِ كَرَمْزٍ لِلصَّلَابَةِ وَالبَطُولَةِ. فَفي حِينِ يَصِفُ تَأَبَّطَ شَرًّا – سَيِّدَ الصَّعَالِيكِ – تَسلُّقَهُ القِمَمَ الشَّامِخَةَ مُحَاذِيًا النُّسُورَ، مُتَّخِذًا مِنَ الصُّخُورِ مَلاذًا لَا يُدرِكُهُ إِلَّا مَنِ امتَلَأَ جَسَارَةً، نَجِدُ أَبَا دُؤَادَ الأَيَادِيَّ يُحَوِّلُ الجِبَالَ إِلَى كِيَانَاتٍ حَيَّةٍ تَتَحَرَّكُ مَعَ قَوَافِلِ الإِبِلِ، فَتَظُنُّهَا جِبَالًا تَرْكَبُ جِبَالًا:
فَإِذَا أَقبَلَتْ تَقُولُ إِكَامٌ *** مُشْرِفَاتٌ فَوقَ الإِكَامِ إِكَامُ
وَلَمْ تَكُنِ الجِبَالُ مُجَرَّدَ كُتَلٍ صَخْرِيَّةٍ، بَلْ مَصَدَرًا لِلتَّشْبِيهِ فِي رِجَاحَةِ العَقْلِ؛ حَيْثُ يُقَارِنُ بِشْرُ بنُ أَبِي خَازِمٍ عُقُولَ بَنِي بَدْرٍ بِالجِبَالِ، فَتَرْجَحُ كِفَّةُ رَضْوَى وَأُحُدٍ عَلَيْهِمْ. أَمَّا الأَوْدِيَةُ فَهِيَ مَسَاحَاتُ الحَنِينِ؛ فَامْرُؤُ القَيْسِ يَتَذَكَّرُ حَبِيبَتَهُ “سَلْمَى” فِي وَادِي الخُزَامَى، لَا كَامْرَأَةٍ مُنْعَزِلَةٍ، بَلْ كَجُزْءٍ مِنْ مَشْهَدٍ طَبِيعِيٍّ تَتَحَرَّكُ فِيهِ الظِّبَاءُ وَتَرِدُ البِئْرَ.
وَلَكِنْ لَيْسَ كُلُّ مَا يَبدُو جَبَلًا جَبَلًا! فَالرِّمَالُ تَنْحَتُهَا الرِّيَاحُ إِلَى أَكْوَامٍ مُتَحَرِّكَةٍ، تُشَبَّهُ بِالأَمْوَاجِ العُظْمَى، لَهَا أَسْمَاءٌ تَتَنَاوَلُ أَشْكَالَهَا: الحَبْلُ (المُسْتَطِيلُ)، الحَقَفُ (المُعْوَجُّ)، الدَّعْصُ (المُسْتَدِيرُ)، السَّقْطُ (المُنْقَطِعُ)، الكَثِيبُ (المُحدَوْبُ). وَفِي وَصْفِهَا تَجْلِسُ الحَسَنَاءُ – كَمَا عِنْدَ عُبَيْدِ بنِ الأَبْرَصِ – عَلَى رَدَفٍ كَثِيبِ الرِّمالِ الرَّطْبِ، كَأَنَّهَا غُصْنٌ لَدْنٌ نَبَتَ فِي قَلْبِ الصَّحْرَاءِ.
لَقَدْ حَوَّلَ الشُّعَرَاءُ الجَاهِلِيُّونَ الصَّحْرَاءَ إِلَى مَتْحَفٍ لِلطَّبِيعَةِ: سَاكِنِهَا بِجِبَالِهَا وَرِمَالِهَا، وَحَيِّهَا بِظِبَائِهَا وَسُيُولِهَا. فَهَلْ وُجِدَ فِي شِعْرِهِمْ “مَعْرَضٌ آخَرُ” لِلطَّبِيعَةِ الحَيَّةِ المُتَحَرِّكَةِ؟ إِنْ كَانَ، فَمَا صُوَرُ الأَشْجَارِ المُتَمَوِّجَةِ، وَالحَيَوَانَاتِ الهَارِبَةِ، وَالسُّيُولِ الجَارِفَةِ؟ وَمَا السِّمَاتُ الفَنِّيَّةُ الَّتِي مَيَّزَتْ وَصْفَهُم لِلْجَمَادِ عَنِ الحَيَوَانِ؟ أَسْئِلَةٌ تَكْشِفُ أَنَّ الصَّحْرَاءَ لَمْ تَكُنْ قَفْرًا فِي عُيُونِهِمْ، بَلْ كَانَتْ كِتَابًا مَفْتُوحًا عَلَى جَمَالِ الكَوْنِ وَعُنْفِوَانِهِ.