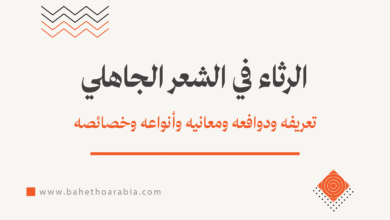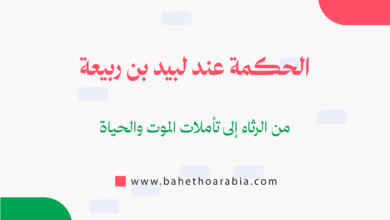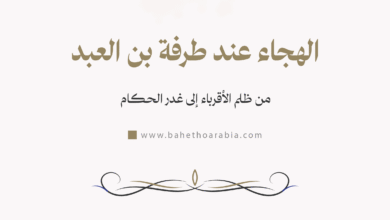الوصف عند زهير بن أبي سلمى: من الأطلال إلى تصوير الحيوان والصراع في الصحراء
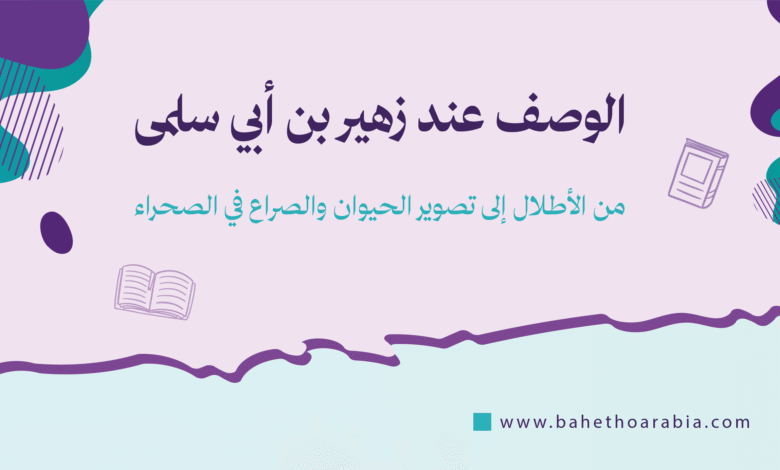
في رحاب الصحراء الشاسعة، حيث تتشكل الحياة وتتحدد ملامحها بقسوة الطبيعة وصفائها، تبرز عين الشاعر كعدسة فنان تلتقط أدق التفاصيل، وتحول المشاهد الصامتة إلى لوحة فنية نابضة بالحياة. ويُعد زهير بن أبي سلمى أحد أبرز هؤلاء الفنانين الذين جعلوا من الوصف أداة أساسية لفهم العالم والتعبير عنه. إن الوصف عند زهير بن أبي سلمى ليس مجرد زخرفة شعرية أو حشو لغوي، بل هو جوهر تجربته الإبداعية، والوسيلة التي يكشف من خلالها عن رؤيته العميقة للحياة والموت والحرب والسلام. من الوقوف على الأطلال البالية التي تروي حكايات الماضي، إلى تتبع حركة الحيوان الوحشي في صراعه من أجل البقاء، استطاع زهير أن يبني عالماً شعرياً متماسكاً يقوم على الدقة الحسية والواقعية المفرطة. تسعى هذه المقالة إلى الغوص في أعماق هذا الفن، واستكشاف كيف أصبح الوصف عند زهير بن أبي سلمى بصمة فنية خالدة، تعكس عبقرية شاعر حوّل مفردات بيئته المحدودة إلى صور شعرية كونية لا تزال تدهشنا حتى اليوم.
الوصف عند زهير بن أبي سلمى
قبل الخوض في تحليل الوصف عند زهير بن أبي سلمى، يتم توضيح معاني بعض المفردات الأساسية التي وردت في سياق سابق:
١ – الحامل: هو من يحمل حمالة، لم يُرَد عليه فعله ولم يُسَفّه رأيه. أما القاعد فهو الذي لم يحمل الحمالة بل صُوِّب رأيه ونُصِر.
٢ – الفري: يعني القطع. الخالق: هو الذي يُقدّر الأديم ويهيئه ليقطعه. والمعنى: أنك إذا تهيأت لأمرٍ مضيت له وأنفذته، في حين أن بعض القوم يُقدر الأمر ويتهيأ له ثم لا يُقدم عليه عجزاً وضعف همة.
٣ – بما علمت: أي بما بلوت من أمرك وشاهدت. ما أسلفت: أي ما قدمت في الشدائد. والذكر: هو ما يُذكر به من الفضل.
٤ – الستر دون الفاحشات: أي أن بينه وبين الفاحشات ستراً من الحياء وتقوى الله، ولا ستر بينه وبينها.
الوصف
لم يتخذ الوصف عند زهير بن أبي سلمى شكلاً مستقلاً بموضوعات متفردة، بل كان جزءاً لا يتجزأ من الموضوعات الشعرية الأخرى. فقد استخدمه الشاعر كأداة لتحلية معانيه، وركيزة أساسية لتوضيح أفكاره، ومن خلاله تتجلى شاعريته الأصيلة.
يُعد الوقوف على الأطلال من أبرز الأغراض الشعرية ارتباطاً بفن الوصف، ويظهر أن زهيراً كان من أكثر الشعراء الجاهليين اهتماماً بإتقان هذا الغرض. ويُعزى هذا الاهتمام إلى كونه وريثاً لمدرسة أوس بن حجر، الذي يُعتبر شيخ المدرسة التقليدية التي وصفها الدكتور طه حسين بأنها تعتمد بشدة على الحواس في تشكيل الصورة الشعرية. وهذا ما يميز منهجية الوصف عند زهير بن أبي سلمى.
كان زهير في وصفه للأطلال حريصاً على ذكر الجزئيات، لذلك امتلأ شعره بأسماء الأمكنة كالمتثلم، وحومانة الدرّاج، والرس، وثادق، ومنعج، والرقمتين. كما حفل بأسماء النساء اللواتي عشن في هذه الأمكنة كأم أوفى، وليلى، وسلمى، وأسماء. وهذا الحرص على التفاصيل هو سمة بارزة في الوصف عند زهير بن أبي سلمى.
أَمِنْ أُمِّ أَوْفَى دِمْنَـةٌ لَمْ تَكَلَّـمِ *** بِحَـوْمَانَةِ الـدَّرَّاجِ فَالمُتَثَلَّـمِ
وَدارٌ لَهـا بِالرَّقْمَتَيْـنِ كَأَنَّهـا *** مَراجِيْعُ وَشْمٍ فِي نَواشِرِ مِعْصَـمِ (والرقمتان هما موضعان، أحدهما قرب المدينة والآخر قرب البصرة، وقد أراد بالرقمتين المنطقة الواقعة بينهما. أما الوشم فهو نقش بالإبرة يُحشى بالمداد، كانت تستخدمه نساء الجاهلية للزينة. والنواشر هي عصب الذراع، والمعصم هو موضع السوار منها).
وَقَفْتُ بِها مِنْ بَعْدِ عِشْرِيْنَ حِجَّةً *** فَلَأْياً عَرَفْتُ الدَّارَ بَعْدَ تَوَهُّـمِ (لأياً: أي بعد جهد. والحجة: هي السنة).
وبعد أن دفعته الدقة إلى تحديد الزمان الذي انقضى على رحيله عن الطلل الذي كان وطناً عامراً بأهله، مضى يتعرف معالمه، فتعرفه وتعرف ما أبقت السنون منه كالأوتاد المغمورة بالرمل، وأثافي القدور السوداء، والنؤي الذي كان يحيط بخيمته قبل الرحيل:
أَثَافِيَّ سُفْعاً فِي مُعَرَّسِ مِرْجَـلٍ *** وَنُؤْياً كَجِذْمِ الحَوْضِ لَمْ يَتَثَلَّـمِ (الأثافي: هي الحجارة التي تُجعل عليها القدر. سفعاً: أي سوداً تخالطها حمرة. المعرس: هو موضع نزول المسافر في الليل، واستعاره هنا لموضع القدر. النؤي: هو حاجز يُرفع حول البيت من تراب يمنع الماء من الدخول إلى البيت. الجذم: هو الأصل).
وإلى جوار الأوتاد والنؤي والأثافي، تظهر بقايا مبارك الإبل ومجاثم الأغنام التي حلت فيها بعد رحيل القوم أسراب الآرام والبقر الوحشي والظباء:
بِها العِيْنُ وَالأَرْآمُ يَمْشِيْنَ خِلْفَـةً *** وَأَطْلاؤُها يَنْهَضْنَ مِنْ كُلِّ مَجْثَمِ (العين: هي بقر الوحش، وسميت بذلك لسعة أعينها. الآرام: هي الظباء الخالصة اللون. خلفة: أي إذا ذهب قطيع خلف مكانه قطيع آخر. الأطلاء: جمع طلا، وهو ولد البقرة وولد الظبية الصغير. المجثم: هو المبرك).
ومن رؤية الأطلال تقفز إلى خيال زهير صور الظعائن، فيصف هوادج النساء وسير قافلتهن على سفوح التلال، ولمعان السراب. وتأسر ذاكرته، كما أسرت من قبل باصرته، حمرة الهوادج وحمرة فتات الصوف المتساقط منها، فيستعيد المشهد ليعيد رسمه من جديد بحركاته وألوانه:
تَبَصَّرْ خَلِيْلِي هَلْ تَرَى مِنْ ظَعَائِنٍ *** تَحَمَّلْنَ بِالعَلْيَاءِ مِنْ فَوْقِ جُرْثُـمِ (الظعائن: النساء على الإبل. العلياء: بلد. جرثم: ماء لبني أسد. تحملن: أي رحلن).
عَلَوْنَ بِأَنْمَـاطٍ عِتَـاقٍ وَكِلَّـةٍ *** وَرَادٍ حَواشِيْهـا مُشَاكِهَةِ الـدَّمِ (علون بأنماط: أي طرحوا على أعلى المتاع أنماطاً، والنمط هو ما يُفترش. الكلة: هي الستر. مشاكهة: أي مشابهة. وراد: أي حمراء).
كَأَنَّ فُتَاتَ العِهْنِ فِي كُلِّ مَنْـزِلٍ *** نَزَلْنَ بِهِ حَبُّ الفَنَا لَمْ يُحَطَّـمِ (فتات العهن: هو ما تفتت من الصوف المصبوغ. الفنا: هو شجر له حب أحمر).
غير أن الصور الأكثر تأثيراً في نفس الشاعر تتجلى في الوصف عند زهير بن أبي سلمى للحيوان، سواء الأليف منه أو الوحشي، كالناقة والحمار الوحشي والقطاة والصقر. ولما كانت الناقة أحب الحيوانات إلى قلوب الجاهليين، فقد عُني الشعراء بوصفها. ونظراً لمكانة الناقة، فقد حظيت بعناية خاصة في الوصف عند زهير بن أبي سلمى، الذي ركز على أعضائها وحركاتها وسيرها، وقارنها بالحمار الوحشي حيناً وبالظليم حيناً آخر، لما عُرف به الظليم من رشاقة وسرعة:
كَأَنَّ الرَّحْلَ مِنْهَا فَوْقَ صَعْلٍ *** مِنَ الظِّلْمَانِ جُؤْجُؤُهُ هَوَاءُ (الصعل: هو الظليم. والصعل: هو الصغير الرأس، ويوصف به الظليم. جؤجؤه هواء: أي صدره خالٍ ضامر).
وعلى الرغم من دقة وصف الناقة والظليم، فإن الوصف عند زهير بن أبي سلمى لمشاهد الصيد يُعد أكثر دقة وبراعة، بل يمكن اعتباره من أجمل ما ورد في شعره كله. وفي ألواح الطرد، يظهر الحمار الوحشي والثور والكلاب، كما يظهر الصراع بين الثور والكلاب، وفي هذا الصراع ينتصر الثور ويطعن بقرنيه النافذين ما يطعن، فتهرب الكلاب مروعة. وسيظهر للقارئ من المقطعات التي سنذكرها أن زهيراً لم يكن يصيد الطرائد، ولم يكن يفخر بمطاردتها، بل كان يكلّف الرماة المهرة من غلمانه صيد الحمر الوحشية، فيكمنون ويجرون وراء الطريدة ويتبعونها سهامهم النافذة، فتنجو منها في أغلب الأحيان، ويُصيبها بعضها في بعض الأحيان، ثم يأتي بها الغلمان نازفة الأوداج، فيصطلون ويشتوون.
وقد لاحظ الدكتور إحسان النص أن الوصف عند زهير بن أبي سلمى يتجنب المخاتلة في الصيد والخداع في القنص وإراقة الدماء، فيكلّف بهذا العمل الدامي غلمانه. ولم يستبعد أن يكون مسلكه هذا نابعاً من فطرة مسالمة فُطر عليها، ومن نفس راقية تكره الخداع والرياء، وتصدف عن الصراع والدماء، وتبغض اعتداء الأقوياء على الضعفاء كاعتداء الصقر على القطاة. فقال: «وهو يقفُ دائماً إلى جانب الضعيف المعتدى عليه، وتأبى عليه طبيعته التي تكره البغي والعدوان أن يجعل الصقر يظفر بطريدته، بل نحس وكأنه يقف منه موقف الشامت بخيبته المسرور بعودته صفر اليدين».
فَزَلَّ عَنْهَا، وَأَوْفَى رَأْسَ مَرْقَبَةٍ *** كَمَنْصِبِ العِتْرِ دَمَّى رَأْسَهُ النُّسُكُ (المرقبة: هي المكان المرتفع حيث يرقب الرقيب. المنصب: هو الحجر الذي يُذبح عليه. العتر: هو ذبح كان يُذبح في رجب. النسك: هو ما ذُبح تعبداً).
وإذا كانت الأطلال والأظعان وحيوان الصحراء أبرز الموصوفات في شعر زهير، فما هي أهم السمات في وصفه؟ في تحليل السمات الفنية، يذهب الدكتور طه حسين إلى أن زهيراً كان وريثاً لأوس بن حجر في خصائصه الفنية، ورأى أن أخص هذه الخصائص التي تميز الوصف عند زهير بن أبي سلمى هي أن زهيراً كان كأستاذه أوس شديد اتصال الخيال بالحس، وشديد الاعتماد على الحواس في إخراج صوره الشعرية، وهو أحرص من أستاذه على هذا. ونحن على أخذنا بهذا الرأي لا نقصر هذه الخصيصة على زهير وأوس، فالشعر الجاهلي كله حسي مادي، مسرف في صبغ المعاني بالصبغة الحسية، لأنه وليد الطبيعة البدوية المفطورة على الصراحة والوضوح، وابن الصحراء الصافية السماء، المشرقة الآفاق البعيدة عن الغموض. وإذا تفاوت الشعراء في هذه الخصيصة، فتفاوتهم مردود إلى اختلاف حظوظهم من رهافة الحس والموهبة المبدعة، لا إلى اختلافهم في المذاهب.
كان زهير يرسم ألواحه الفنية من الجزئيات التي يلتقطها بصره الحديد من العالم المحسوس، ولذلك جاءت الصور في الوصف عند زهير بن أبي سلمى شديدة الواقعية، وربما بلغت به الواقعية حداً يضعف عنده أثر الخيال المبدع ويبهت بريق الفن، إذ يجتزئ الشاعر من التصوير بتعداد الأشياء التي يراها، كقوله في صفة الشرب ومجلس الشراب:
لَهُمْ طَاسٌ وَرَاوُوْقٌ وَمِسْكٌ *** تُعَلُّ بِهِ جُلُوْدُهُمُ وَمَاءُ (الراووق: هو المصفاة، وهي خرقة تُصفى بها الخمر. تُعل جلودهم: أي تُطيّب بالمسك مرة بعد مرة).
فليس في هذه الصورة غير أدوات يذكرها اللسان كما التقطتها عدسة العين، وغير رائحة نقلها الأنف إلى العصب فترجمها اللسان. وفي سياق منهجه الفني، يعتمد الوصف عند زهير بن أبي سلمى على التشبيه، فيقرن صورة بصورة، وتنقله الصورة إلى أختها، كتصويره الدموع التي انسابت من عينه حينما وقف على الأطلال، فإذا هي قطرات غزيرة تسيل من دلو خرجت من بئر، أو عقد من اللؤلؤ لم يحسن ناظمه ربط سلكه فانفلت وتساقطت حباته:
كَأَنَّ عَيْنَيَّ، وَقَدْ مَالَ السَّلِيْلُ بِهِمْ *** وَعَبْرَةً مَا هُمُ لَوْ أَنَّهُمْ أَمَمُ (السليل: هو وادٍ. وسال السليل بهم: أي ساروا فيه سيراً سريعاً. وعبرة ما همُ: أي عبرتي، و”ما” زائدة. الأمم: هو القصد والقرب).
غَرْبٌ عَلَى بَكَرَةٍ أَوْ لُؤْلُؤٌ قَلِقٌ *** فِي السِّلْكِ خَانَ بِهِ رَبَّاتِهِ النُّظُمُ (غرب: دلو عظيمة. قلق: لا يستقر. رباته: صواحبه. النظم: جمع ناظمة).
ويرى الدكتور شوقي ضيف أن الوصف عند زهير بن أبي سلمى قد تفوق على شعر امرئ القيس، لأنه لم يقنع من التصوير بحشر الصور البيانية التي تلقاها تتعاقب في شعر الملك الضليل أرتالاً متلاحقة، بل جاوز هذه المرتبة الأولى من مراتب الطريقة البيانية إلى مرتبة متقدمة سماها «التحقيق»، وهي سمة جوهرية في الوصف عند زهير بن أبي سلمى. فقال: «ولعل أول ما يستدعي الباحث في عمل زهير أنه يعنى بتحقيق صوره، فهو لا يأتي بها متراكمة، كما كان يصنع امرؤ القيس، بل يعمد إلى تفصيلها، وتمثيلها بجميع شعبها وتفاريعها، وكأنه يبحثها ويحققها». ويؤيد رأيه هذا بثلاثة أبيات يصوّر فيها زهير امرأة استعارت جمالها من الظباء واللؤلؤ والبقر الوحشي؛ فعنقها الأغيد عنق ظبية، وعيناها الحوراوان كانتا في محجري بقرة وحشية، وجلدها الوضيء مغسول بأشعة اللؤلؤ:
تَنَازَعَهَا المَهَا شَبَهًا وَدُرُّ الـ *** ـبُحُوْرِ وَشَاكَهَتْ فِيْهَا الظِّبَاءُ (تنازعها المها شبهاً: أي فيها من بقر الوحش شبه وهو حسن العينين. شاكهت الظباء: أي شابهت الظباء في طول العنق. ودر البحور: ما فيها من صفاء وملاحة).
فَأَمَّا مَا فُوَيْقَ العِقْدِ مِنْهَا *** فَمِنْ أَدْمَاءَ مَرْتَعُهَا الخَلَاءُ (فويق العقد: أي عنقها. الأدماء: هي الظبية البيضاء. الخلاء: هو المكان الخالي، وخصها به لأنها إذا تفردت تجزع فتتشوف وتمد عنقها).
وَأَمَّا المِقْلَتَانِ فَمِنْ مَهَاةٍ *** وَلِلدُّرِّ المَلَاحَةُ وَالصَّفَاءُ
وتستتبع هذه الخصيصة الدقة في رصد الحركات في خطوط المشاهد وألوانها لتحيا. وقد كان زهير بارعاً في اقتناص الحركات من الطبيعة ونقلها إلى ألواحه المرسومة، وتتجلى هذه البراعة في الوصف عند زهير بن أبي سلمى. وحركاته تبطئ حيناً وتعنف حيناً وفق حركة الموصوف. فإن كانت الحركة بطيئة وفّر لها الشاعر ما يقتضيه بطؤها من لين وانسياب، وإن كانت سريعة وفّر لها ما تحتاج إليه من عنف وصخب. وربما جمع نوعي الحركة في موضوع واحد كوصف الصيد، فحينما وصف الكمون والترصد، خلع على المشهد نمطاً من الهدوء المتحفز والسكون المتحرك، إذ أكمن غلامه خلف شجيرات ليرقب الطرائد، وبعد فترة رجع إليه الغلام ينساب خلف الشجرة صامت الخطو، يتقاصر ويتجمع، ليخفي جسمه عن الطرائد، وأبلغ سيده أنه رأى سرباً من حمر الوحش خلف مسحل صبغ العشب مشفريه باللون الأخضر. ويُظهر الوصف عند زهير بن أبي سلمى هنا قدرة فائقة على التقاط المشهد:
فَبَيْنَا نَبْغِي الصَّيْدَ جَاءَ غُلَامُنَا *** يَدِبُّ، وَيُخْفِي شَخْصَهُ وَيُضَائِلُهْ (نبغي: أي نبتغيه. يدب: على هيئته. يضائله: أي يُصغّره).
فَقَالَ: شِيَاهٌ رَاتِعَاتٌ بِقَفْرَةٍ *** بِمُسْتَأْسَدِ السَّوْبَانِ حُوٌّ مَسَائِلُهْ (شياه: هنا بمعنى الحمير. المستأسد: ما طال من النبت وقوي. حو: أي ذو نبت شديد الخضرة. المسائل: حيث يسيل الماء).
ثَلَاثٌ كَأَقْوَاسِ السَّرَاءِ وَمِسْحَلٌ *** قَدِ اخْضَرَّ مِنْ لَسِّ الغَمِيْرِ جَحَافِلُهْ (السراء: شجر تُتخذ منه القسي، أي ضامرات. مسحل: هو الحمار. اللس: الأخذ بمقدم الفم. الغمير: نبت أخضر قد عمره نبت أطول منه. الجحافل: جمع جحفلة وهي الشفة).
فالمشهد – كما ترى – هادئ لين الحركات، لكنه ينطوي على تنمر وتحفز. وهذه الحركة المكظومة تنبئ بانفجار قريب. وقد انفجرت حينما أمر الشاعر وليده بالكرّ على الحمر الوحشية، فاندفع خلفها كأنه مطر دفعته السماء إلى الأرض، فهو كلما انطلق ازداد سرعة، والحمر تتوثب أمامه ناثرة في عينيه ووجهه ما يعلق بحوافرها من التراب والحصى، والوليد يتلقى بصدره ووجهه نثار الحصى، ويشق بساقيه سحاب الغبار المثار:
فَتَبِعَ آثَارَ الشِّيَاهِ وَلِيْدُنَا *** كَشُؤْبُوْبِ غَيْثٍ يَجْفِشُ الأَكْمَ وَابِلُهْ (الشؤبوب: الدفعة من المطر. يجفش: يُخرج ما فيها. الوابل: هو أغزر المطر وأعظمه قطراً).
يُرِنَّ الحَصَى فِي وَجْهِهِ وَهْوَ لَاحِقٌ *** سِرَاعٌ تَوَالِيْهِ صِيَابٌ أَوَائِلُهْ (تواليه: أي رجليه وعجزه. صياب أوائله: أي مقدمه قاصد يصوب، وأوائله: يداه وصدره).
ولاشك في أن القارئ قد وقف على براعة الشاعر في استخدام اللغة وتسخيرها لتحريك المشهد؛ فاسم الفاعل الدال على استمرار الحركة، والمضارع الذي يحول المشهد من قصة قديمة إلى مسرحية مرئية، كلاهما بعث الحياة في أوصال اللوح المرسوم.
ويقودنا تحليل الحركة إلى ظاهرة فنية أخرى بارزة في الوصف عند زهير بن أبي سلمى، وهي تجسيم المعاني المجردة وتشخيصها. فإذا تراءى لزهير أن يصور الموت، اختار من حيوانات الصحراء أضخمها وهو الناقة، ثم عصب عينيها وهاجها وأطلقها تدوس من تلقاه في طريقها. وهي في قتلها الناس لا تتبع نظاماً ولا تلتزم قاعدة:
رَأَيْتُ المَنَايَا خَبْطَ عَشْوَاءَ مَنْ تُصِبْ *** تُمِتْهُ، وَمَنْ تُخْطِئْ يُعَمَّرْ، فَيَهْرَمِ
ويتجلى هذا التجسيم ويتضخم في الوصف عند زهير بن أبي سلمى للحرب، فبعد أن يصف زهير الحرب بصفات النار المشبوبة والرحى الساحقة الماحقة، يجعلها ناقة ولوداً، تحمل التوائم وتنجب الأشائم، ولا تتمخض إلا عن أبناء السوء:
وَمَا الحَرْبُ إِلَّا مَا عَلِمْتُمْ وَذُقْتُمُ *** وَمَا هُوَ عَنْهَا بِالحَدِيْثِ المُرَجَّمِ (ما ذقتم: أي ما جربتم. المرجم: هو المظنون).
مَتَى تَبْعَثُوهَا تَبْعَثُوهَا ذَمِيْمَةً *** وَتَضْرَ إِذَا ضَرَّيْتُمُوْهَا، فَتَضْرَمِ (تضر: أي تتعود. تضرم: أي تشتعل).
فَتَعْرُكْكُمُ عَرْكَ الرَّحَى بِثِفَالِهَا *** وَتَلْقَحْ كِشَافاً ثُمَّ تُنْتَجْ فَتُتْئِمِ (الثفال: جلدة تكون تحت الرحى إذا أُديرت يقع الدقيق عليها. تلقح كشافاً: أي تخصب إثر وضعها. تتئم: أي تأتي بتوأمين).
فَتُنْتِجْ لَكُمْ غِلْمَانَ أَشْأَمَ كُلُّهُمْ *** كَأَحْمَرِ عَادٍ، ثُمَّ تُرْضِعْ فَتَفْطِمِ (أشأم: أي شؤم وشر. أحمر عاد: أراد أحمر ثمود وهو عاقر الناقة).
ونظراً لكون زهير شاعراً أعرابياً لم يعاين ترف الحضارة، ولم يتمتع بما تمتع به أبناء الملوك كامرئ القيس أو المتصلون بالملوك كالنابغة، فقد ظل الوصف عند زهير بن أبي سلمى متكئاً على ما يراه في الصحراء من مشاهد راتبة، ويسخر لهذا التصوير حيوانها الأليف والوحشي، ويختار من أعضاء الحيوان ما يبرز به المعاني والأفكار. فجاءت صوره مكرورة، وجاءت الصورة الواحدة معبرة عن أكثر من فكرة، وهو ما يفسر طبيعة الوصف عند زهير بن أبي سلمى المرتبطة ببيئته. فالناقة التي استعارها زهير للحرب وأولدها أولاد الشؤم، ظهرت في معرض آخر ذات أنياب حادة معقوفة وعواء عنيف محيف، لا لتنفر الناس من الحرب، بل لتثبت شجاعة الممدوحين الذين يخوضون غمارها:
إِذَا لَقِحَتْ حَرْبٌ عَوَانٌ مُضِرَّةٌ *** ضَرُوْسٌ تَهـِرُّ النَّاسَ أَنْيَابُهَا عُصْلُ (لقحت: أي حملت بمعنى اشتدت. العوان: هي التي قوتل فيها مرة بعد مرة. ضروس: أي عضوض سيئة الخلق. تهر الناس: أي تجعلهم يكرهونها. عصل: أي معوجة بمعنى قديمة).
تَجِدْهُمْ عَلَى مَا خَيَّلَتْ هُمْ إِزَاءَهَا *** وَإِنْ أَفْسَدَ المَالُ الجَمَاعَاتُ وَالأَزْلُ (ما خيلت: أي على كل حال. إزاءها: أي ينهضون بها ويحسنون القيام بتدبيرها. المال: الإبل. الأزل: الشدة).
وعذر زهير في هذا التكرار أنه بدوي لم تضع الحياة بين يديه غير مادة محدودة يستمد منها صوره ويعبر بها عن أفكاره.
ويحتل الحصان المرتبة الثانية بعد الناقة في الصور الشعرية التي يقدمها الوصف عند زهير بن أبي سلمى، إذ يحمل على صهوته أفكار الشاعر ومشاعره؛ فمرحلة الشباب من عمر الإنسان جواد مسرج متأهب للطراد، ومرحلة الهرم جواد أتعبه طول الجري فعُري من راحلته وارتبط ليستريح:
صَحَا القَلْبُ عَنْ سَلْمَى وَأَقْصَرَ بَاطِلُهْ *** وَعُرِّيَ أَفْرَاسُ الصِّبَا وَرَوَاحِلُهْ (أقصر: أي كفّ. باطله: أي لهوه. عُرّي أفراس الصبا ورواحله: أي ترك ركوب الباطل والتصابي).
وهذا يبرهن على أن زهيراً، على الرغم من ضآلة المادة التي أتاحتها له بيئته، كان يمتلك قدرة فائقة على استغلال الطبيعة وتوليد الصور المتعددة من مواد محدودة، وهي ميزة أساسية في الوصف عند زهير بن أبي سلمى. فيشبه حيواناً بحيوان كتشبيه البقر الوحشي بالإبل البيض:
كَأَنَّ أَوَابِدَ الهِجَـانِ بِهَا *** هَجَـائِنُ فِي مَغَابِنِهَا الطِّلَاءُ (الأوابد: هي التي تسكن القفر فتتوحش. الهجائن: جمع هجان وهي الناقة البيضاء. المغابن: جمع مغبن وهو باطن أصل الفخذ والمرفق. الطلاء: القطران).
ويشبه حجراً بطائر، كتشبيه حجارة الموقد التي لبست ثوباً من الرماد الأسود بثلاث حمامات سود:
وَغَيَّرَ ثَلَاثٌ كَالحَمَامِ خَوَالِدٌ *** لَهُنَّ بِحَافَاتِهِ هَامِدٌ مُتَلَبِّدُ
ويقرن حيواناً بنبات كتشبيه الظعائن التي تعوم في سراب الصحراء بأشجار المقل، لكنه لا ينسى – وهو يصور قافلة الظعائن – أن يقرن الإبل المتنقلة بين الكثبان بسفن تترنح فوق الموج:
يَقْطَعْنَ أَجْوَازَ أَمْيَالِ الفَلَاةِ كَمَا *** يُخْفِضُهَا الآلُ طَوْراً ثُمَّ يَرْفَعُهَا
فيخلع على صوره البدوية ظل الحضارة.
خاتمة
وفي ختام هذه الرحلة التحليلية في عالم زهير الشعري، يتضح أن الوصف عند زهير بن أبي سلمى يتجاوز كونه غرضاً شعرياً تقليدياً ليصبح منهجاً فكرياً وفنياً متكاملاً. لقد رأينا كيف بنى صوره على أساس من الواقعية الحسية، معتمداً على بصره الثاقب وحواسه المرهفة في التقاط أدق التفاصيل، سواء في معالم الأطلال الدارسة أو في حيوية الظعائن الراحلة. وبرع في “تحقيق” الصورة وتفصيلها، مانحاً إياها عمقاً وحياة، كما تجلى في رصده الدقيق لحركة الحيوان ومشاهد الصيد المفعمة بالتوتر والترقب. والأهم من ذلك، استطاع زهير أن يستخدم أدواته الوصفية لتجسيم المعاني المجردة كالموت والحرب، محولاً إياها إلى كائنات محسوسة تترك أثراً عميقاً في نفس المتلقي. ورغم أن بيئته الصحراوية فرضت عليه تكرار بعض الصور، إلا أنه أثبت قدرة إبداعية فذة على توليد معانٍ متعددة من المادة الواحدة. وهكذا، يظل الوصف عند زهير بن أبي سلمى شاهداً على عبقرية شاعر كان مهندس كلمات، ونحاتاً بارعاً نحت من صخرة الواقع الصحراوي أروع الصور وأخلدها.
الأسئلة الشائعة
١ – ما هي السمة الأساسية لفن الوصف عند زهير بن أبي سلمى؟
السمة الأساسية هي أن الوصف لم يكن غرضاً شعرياً مستقلاً بذاته، بل كان أداة فنية مدمجة في ثنايا القصيدة تخدم أغراضاً أخرى كالفخر والمدح والحكمة. استخدمه زهير لتوضيح أفكاره، وتحلية معانيه، وإبراز قدرته الشعرية، مما يجعله عنصراً وظيفياً وبنيوياً في شعره وليس مجرد زخرفة.
٢ – كيف تجلت الواقعية الحسية في وصف زهير للأطلال؟
تجلت الواقعية الحسية من خلال اعتماده الشديد على الحواس، خاصة البصر، في نقل صورة الديار المهجورة. فلم يكتفِ بالوقوف العاطفي، بل قدم وصفاً دقيقاً ومفصلاً للجزئيات المادية مثل أسماء الأماكن (الرقمتين، حومانة الدراج)، وبقايا الأوتاد، وآثار النيران (الأثافي)، والنؤي، مما يجعل المتلقي يكاد يرى المشهد بعينيه.
٣ – ما المقصود بخصيصة “التحقيق” في شعر زهير، وكيف تفوق بها على غيره؟
“التحقيق”، كما أشار الدكتور شوقي ضيف، هو منهج زهير في بناء الصورة الشعرية عبر تفصيلها وتمثيلها بجميع أجزائها، بدلاً من تكديس الصور المتلاحقة كما فعل امرؤ القيس. يتجلى ذلك في وصفه للمرأة، حيث لا يكتفي بالتشبيه العام، بل “يحقق” مصدر كل صفة جمالية، فينسب عنقها للظبية، وعينيها للبقرة الوحشية، وصفاء جلدها للؤلؤ، مما يمنح الصورة عمقاً ودقة.
٤ – كيف استخدم زهير الحيوان كأداة فنية في شعره الوصفي؟
استخدم زهير الحيوان على مستويين: الأول هو الوصف الحسي المباشر لحركاته وأعضائه، كما في وصف الناقة السريعة ومقارنتها بالظليم، أو وصف الحمار الوحشي في مشاهد الصيد. أما المستوى الثاني، فهو استخدامه كأداة رمزية لتجسيم المعاني المجردة، حيث استحالت الحرب في شعره ناقة ولوداً تنجب الشر، وأصبح الموت ناقة عشواء تخبط بلا تمييز.
٥ – اشرح ظاهرة “تجسيم المعاني” في شعر زهير، مع مثال وصفي الحرب.
تجسيم المعاني هو تحويل المفاهيم المجردة إلى كائنات مادية محسوسة لها صفات وحركات. وأبرز مثال هو وصفه للحرب، حيث لم يصفها بنتائجها فقط، بل جعلها كائناً حياً بشعاً: فهي ناقة “عوان” (قوتل فيها مراراً) و”ضروس” (عضوض)، تُلقح وتُنتج غلمان الشؤم، وتدور كرحى ساحقة. هذا التجسيم يمنح الفكرة المجردة قوة تأثيرية هائلة.
٦ – هل يُعد التكرار في صور زهير الشعرية نقطة ضعف أم انعكاساً لبيئته؟
يُعد التكرار انعكاساً طبيعياً لبيئته البدوية المحدودة المصادر، وليس نقطة ضعف فنية. فعلى الرغم من استخدامه المتكرر لصور الناقة والحصان وحيوانات الصحراء، إلا أنه أظهر براعة فائقة في توظيف الصورة الواحدة للتعبير عن معانٍ مختلفة؛ فالناقة قد تكون رمزاً للحرب مرة، وأداة للمقارنة في السرعة مرة أخرى، مما يدل على قدرته على توليد الدلالات من المادة المتاحة.
٧ – كيف برع زهير في تصوير الحركة في مشاهد الصيد؟
برع زهير في تصوير الحركة عبر التدرج والتباين. فهو يبدأ بمشهد الكمون والترصد المليء بالهدوء المتحفز والسكون المترقب، ثم ينتقل فجأة إلى حركة الانفجار والمطاردة العنيفة السريعة. وقد استخدم أدوات لغوية فعالة لتحقيق ذلك، مثل الفعل المضارع الذي يبث الحياة في المشهد ويجعله حاضراً، واسم الفاعل الذي يدل على الاستمرارية.
٨ – ما هو الفرق الجوهري بين منهج الوصف عند زهير بن أبي سلمى ومنهج امرئ القيس؟
الفرق الجوهري يكمن في طريقة بناء الصورة. امرؤ القيس يميل إلى “التراكم”، حيث تتلاحق الصور البيانية المتعددة بسرعة لرسم مشهد عام. أما زهير فيميل إلى “التحقيق”، حيث يتناول صورة واحدة ويعمد إلى تفصيلها وتحليلها وإبراز كافة جوانبها بدقة متناهية، مما يجعل صوره أكثر عمقاً وتماسكاً وإن كانت أقل عدداً.
٩ – إلى أي مدى تأثر زهير بن أبي سلمى بأستاذه أوس بن حجر في مجال الوصف؟
تأثر زهير بأستاذه أوس بن حجر بشكل كبير، فهو يعد وريث مدرسته الفنية التي تقوم على شدة الاتصال بالحس والاعتماد على الحواس في بناء الصورة. لكن زهيراً لم يكن مجرد مقلد، بل تفوق على أستاذه في إتقان هذا المنهج، وأصبح أكثر حرصاً على الدقة الواقعية وتفصيل الجزئيات، مما جعله يطور هذا الاتجاه ويصل به إلى ذروته.
١٠ – لماذا يُعتبر وصف الصيد من أجمل ما ورد في شعر زهير؟
يُعتبر وصف الصيد من أجمل شعر زهير لأنه يجمع كل خصائصه الفنية في لوحة واحدة متكاملة: فهو يمزج بين الواقعية الدقيقة في وصف الحيوانات، والبراعة في تصوير الحركة المتدرجة من السكون إلى الانفجار، والقدرة على بناء مشهد درامي متكامل الأركان يظهر فيه الصراع من أجل البقاء، كل ذلك بلغة شعرية دقيقة ومحكمة.