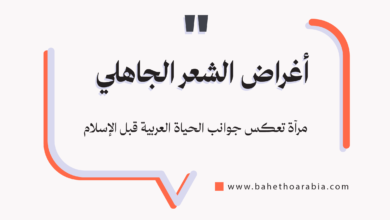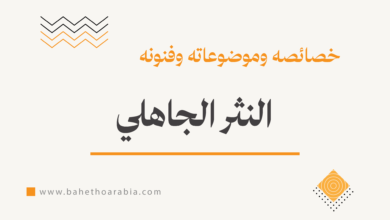الحياة العامة في العصر الجاهلي وتأثيرها في الأدب
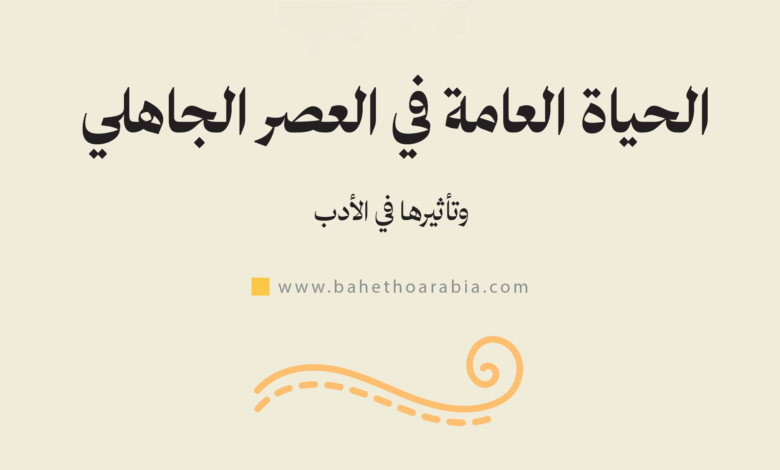
يظل الحديث عن الأدب الجاهلي ضرباً من الرجم بالغيب مالم نربط المعلول بالعلة، والنتيجة بالسبب أي: مالم نربط هذا الأدب بطبيعة الأرض التي نبت فيها، ثم بمظاهر الحياة التي كنفته.
تأثير الطبيعة في الأدب الجاهلي
نبت هذا الأدب في شعاب الحجاز، وهضاب نجد، وفي الصحارى والفلوات الممتدة من بحر القلزم (الأحمر) في الغرب إلى البحرين وعُمان في الشرق. والمناخ في هذه البقاع حارٍ، والسماء صافية. فلا غابٌ يَكسو الأرض، ولا ضباب يَغشى السماء، لهذا جاءت لغة العرب واضحة الدلالات، وأدبهم صريح المعاني، لا يعرف الغموض والرمز. غير أن هذه الرهبة المخيّمة على مجاهل الصحراء خوّفت الشاعر، فإذا هو يسمع عزيف الجن، ويرى أشباح الغيلان، ويذكر ذلك كله في شعره.
وفرضت البداوة على الشاعر التنقل من بقعة إلى بقعة مع قومه الباحثين عن الماء والعشب، فإذا القصيدة رحلة فكرية ذات مراحل، يتنقل فيها الشاعر بين آفاق الأفكار. يبدأ ببكاء الأطلال، ويمضي منها إلى صفة الطريق الذي يجوزه، والرفيق الذي يصحبه. فإذا مر برسم المحبوبة وقف بين يديه خاشعاً خشوع العابد في محرابه، يتغنى بمرابع الصِّبا، ومفاتن الحبيبة، ثم يمضي لمطيته، فإذا هو ووحش الصحراء رفقة، فينعت ناقته، ويقارنها بما يرى من حمر الوحش والظباء، ثم يفخر بنفسه وبقومه تأملاً بمحامدهم، مباهياً بأيامهم التي ظهروا فيها على الأعداء، باكياً قتلاهم الذين
قضوا في الدفاع عن العِرض. وهو راض بهذا التنوع في الموضوعات، والناس عنه راضون كأنهم مجمعون على أن البداوة تعني الترحل، وأن الترحل يجب أن يظهر في الأدب ظهوره في الحياة.
ولمّا كانت الحياة في الصحراء تلصق الإنسان بالطبيعة، بلا جدار يدفع الريح، ولا سقف يقي من الشمس والمطر، فقد أحسّ العربي تقلّب الأنواء إحساساً حادّاً، إذ صفعه الرعد القاصف، واقتلعه السيل الجارف، وداعبته النسمة اللعوب، وظلّله الدوح الوارف، وحملته النخلة السامقة، ووخزه الشوك النافذ، فجاء وصفه للطبيعة حسيّاً، دقيق التصوير، جليّ السمات، وليد معايشة ومعاشرة.
تأثير الحياة الاجتماعية والسياسية في الأدب الجاهلي
إن الصحراء التي فرضت على العرب الترحّل، فرضت عليهم العيش في المجتمع القبلي بوجهيه الاجتماعي والسياسي، ثم فرضت على أدبهم سمات هذا المجتمع.
يتألف مجتمع القبيلة من ثلاث طبقات:
طبقة الأحرار التي تتشكل من السادة الأشراف، وعملهم القتال لحماية الحمى.
وطبقة العبيد الذين جمعهم الأسر، والاسترقاق بالشراء، والاختطاف، وعملهم الرعي والسقي، والاحتلاب والاحتطاب، وخدمة الأحرار.
وطبقة الموالي التي كانت تلوذ بالقبيلة القوية مستجيرة بها، ومنزلتها بين بين، فهي دون الأحرار، وفوق العبيد، شرفاً وعملاً.
ورأس هذه الطبقات الثلاثة رئيس القبيلة القائم بأمورها المتولي سياستها.
وأهم الخصال التي تخوله الزعامة السياسية الشجاعة والكرم والحَصَافة والفصاحة، فإذا جمع هذه الخصال دانت له القبيلة بالطاعة في السلم وفي الحرب. فانقادت خلفه في السلم على مساقط الماء ومنابت الكلأ، وانقادت وراءه في الحرب إلى مقارعة القبائل التي تزاحمها على الماء والكلأ، وتحاول أن تغصبها الشاء والإبل.
وقد ترك هذا النظام القبلي أثره في أدب العرب، إذ دفع الشعراء إلى تسعير الخصومة بين القبائل، وخضب القصص والأمثال بتمجيد البطولة، وجهر كلّ ذي لسن وبيان بالدعوة إلى الأخذ بالثأر، حتى ضجّ أدب الجاهلية بقعقعة السيوف، وتفجرت فيه صيحات المفاخرة والمنافرة، وزخر بفيض من المعاني والصور الحماسية، وضم بين جنبيه تاريخاً غير رسميّ يقبس منه الأحفاد نخوة الجداد، ويتعهد الشعراء بالتجديد كلّما رثّ، وبالإضرام كلما خبا، إذا ينفخون فيه روح الحميّة، ويؤثرون الغضب الرعن على الحكمة الرّزان، فتعجز القلّة المتعلقة كزهير بن أبي سلمى عن مغالبة الكثرة التي طغت عليها الجاهلية الجهلاء، كعمرو بن أبي كلثوم، وقريظ بن أنيف، ودُرَيد بن الصُمّة.
ولم يكن هذا النظام القبلي ـ على شيوعه ـ الشكل السياسي الوحيد في جزيرة العرب، فقد شهدت بلاد العرب إمارات صغيرة كإمارة كِنْدَة التي حُجْر والد امرئ القيس آخر أمرائها، وإمارة كبيرة كإمارتي الغساسنة والمناذرة على تخوم الروم والفرس.
وفي هاتين الإمارتين لقي شعراء القبائل منتجعاً يقصدونه، وسوقاً تروج فيها بضاعتهم، ومستبقاً يتنافس فيه الفحول من شعراء الصحراء كالنابغة الذبياني، وحسان بن ثابت، والأعشى، والمنحل اليشكريّ، وعلْقمة الفحل، والمُرَقِّش الأكبر. فلا يكاد الفحل منهم يجري فيه غلوة أو غلوتين حتى يخلع لامة الحرب، ويستلين خِلَعَ الأمراء.
لقد ساعد نظام الإمارة أدب الصحراء على أن يبتعد بعض الابتعاد عن الأفق القبلي البدوي المغلق، وهيّأ للشعراء أسباب التحليق في أفق قومي واسع، وأتاح لهم أن يكونوا – على اختلاف أنسابهم – سفراء أقوامهم لدى المناذرة والغساسنة، وشفعاءهم عند الأمراء، فارتقى بذلك فن المديح، ومازجه الاعتذار، وجدّت فيه معاني وصور، أوحى بها العيش في القصور، ومنادمة الأمراء، وأدب الشراب، والإصغاء إلى الغناء، والتقلب بين الرّياش والطنافس. واستلان الشعراء أكسية الحرير، فلانت نفوسهم، ورقّت ألفاظهم، وبرئت من الحواشي المستكره.
تأثير الحياة الاقتصادية في الأدب الجاهلي
فرضت طبيعة الجزيرة على أهلها نمط الحياة الاقتصادية، كما فرضت عليهم أنماط الحياة الأخرى. فالماء في فلواتهم الواسعة لا يجري في أنهار دائمة، بل يسيل في أودية، أو يجتمع في غدران.
وكلما جادت السماء على الأرض أمرعت المراعي، وكثرت الأنعام، وشبع الأعراب، فإذا احتبس المطر جفّت الموارد، ويبس العشب وظمئ الإنسان والحيوان، ورحل القوم إلى منتجع آخر.
لهذا كله لم يعرف العرب الزراعة المنظمة، ولا الصناعة المقيدة؛ لأن الزراعة تعني الالتصاق بالأرض، والصناعة تتطلب الاستقرار وتنشط في المدن المعمورة.
ولما كان البدو في رحلة دائمة؛ فإنهم كانوا يضطرون في سنوات الجدب إلى تحصيل أقواتهم بالإغارة والسلب، ولا يجدون فيهما غضاضة، بل يعدون الغزو من شيم الأبطال.
وقنع البدو من استثمار الطبيعة برعي الأنعام، وتربية الإبل والشاء؛ للانتفاع بألبانها ولحومها وأوبارها، ومن التجارة بهداية القوافل إلى مقاصدها في مسالك الصحراء. فأزْرَوْا بالصناعة، واحتقروا من يمارسها من أهل القرى والمدن، وعيّروا أصحاب الصناعة كالحداد والصائغ، ورَمْوا مَنْ يعمل في هذا المضمار بأنه قَيْنٌ أو عبد.
ولم يكن سكان المدن أقل من البدو احتقاراً للصناعة، فقد كانوا يأنفون من مزاولتها، ويكلفون العبيد والعمال الوافدين عليهم من البلاد المجاورة بالبناء وبالصناعة.
وكان لأغنيائهم تجارة منظمة بين الشام واليمن، عادت عليهم بالربح الوفير، وبرع أهل مكة في التجارة، ووجدوا في مكاسبهم مأمنهم من الجوع والخوف. {لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا ربّ هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف}. فخالفوا القبائل، وأفادوا من احترام العرب للكعبة، وأقاموا أسواقاً ينشط فيها الشعر والتجارة، ومن هذه الأسواق عكاظ وذو المجاز والمَجنّة.
وعادت هذه الأسواق على قريش بثراء عريض، ومكانة مرموقة، فظهرت منهم في مكة طبقة السّراة الذين احتجنوا المال، وباهَوا بالسرف والشرف، وطبقة من الفقراء الأذلاء المقيمين على حسد ونقمة.
وترك هذه النمط من الحياة آثاره في اللغة والأدب:
أما اللغة فقد كثرت فيها المفردات المتصلة بالإبل والخيل والشاء؛ لأنها عماد الحياة في الصحراء.
نقل رينان عن دوهامر (أنه توصل إلى جمع أكثر من ٥٦٤٤ لفظاً لشؤون الجمل رفيق الأعرابي في الصحراء، ومؤنسه في وحشته). ويمكن أن يحصي الباحث عدداً يقارب هذا العدد من ألفاظ الخيل، تتصل بصفاتها وأعضائها وأعمارها وسيرها وأنسابها.
وأما الأدب فقد حفلت أمثاله وقصصه وشعره بالمعاني المتعلقة بالخصب والجدب، والريّ والجفاف، والصيد والطرد، والجواد والجمل، حتى أصبحت الناقة تنافس المرأة في مكانتها من قلب الشاعر، وفي حظها في تصويره، وحفلت الأراجيز والمطولات جميعاً بمقدار عظيم من الشعر في صفة النوق والخيل، وغرق هذا الوصف في سيل غريب اللغة لا يفهمه اليوم غير المشتغلين بالمعجمات.
تأثير الحياة العقلية والدينية في الأدب الجاهلي
لم يعرف عرب نجد والحجاز في العصر الجاهلي شيئاً من العلم والفلسفة بالمعنى الدقيق؛ لأن بداوتهم حرمتهم الاستقرارَ، والعلمُ يحتاج إلى شعب مستقر، يعكف على دراسة الحياة ويستنبط منها الحقائق، ويدوّن هذه الحقائق، ويبحث عن أسبابها، ويربط المعلول بالعلّة، والنتيجة بالسبب.
فإذا حُرم العقل المنطق الذي يضبط حركته وينتظم تفكيره غلبته الخرافة، وطفق يلتمس الدليل على ما يَعْجِزُ عن تعليله في معتقدات بدائية.
ومع ذلك كله فقد وقف الجاهليون على جملة من المعارف، تحصلت لهم من التجربة والمعاينة، فعرّفوا أشياء عن النجوم ومواقعها، وسخّروا معرفتهم لهداية قوافل التجارة، وأطالوا النظر في السُّحُبِ، وتتبعوا تقلب الأنواء، واستنبطوا من مشاهداتهم أموراً كثيرة أفادتهم في معرفة الرياح والأمطار. ودفعتهم الحاجة إلى دراسة الأعشاب والنباتات والحيوانات، وأفضت بهم هذه الدراسة إلى الوقوف على طائفة من حقائق الطب والتداوي بالعسل، وعصارة بعض الأعشاب، ومعالجة جراحهم أو جراح خيولهم ونوقهم بالكيّ، وعالجوا الحَوَل بإدامة النظر في حجر الرحى عسى أن تنشط بذلك عضلات العين وأعصابها.
ومن المعارف التي تشهد لهم بالذكاء ودقة الملاحظة الفراسَة ومعناها معرفة أخلاق المرء من خَلْقه وهيئته، والقِيافة ومعناها معرفة الناس من آثار أقدامهم. واختلطت هذه المعارف بأباطيل منكرة كالكهانة التي يدّعي مدّعوها معرفة الغيب، والزجر والطّرق بالحصى وفحواهما تنفير الطائر بحصاة يرميها الأعرابي، فإذا اتجه الطائر إلى اليمين تفاءل الرامي وإذا اتجه إلى اليسار تشاءم.
ووعت ذاكرتهم أخبار الآباء والجداد، وشيئاً من أخبار الروم والفرس، غير أن اعتمادهم على الحافظة عرّض محفوظهم للنسيان والخطأ، ولامتزاج الخبر الصحيح بالأسطورة المختلقة.
وسَلِمَت من هذه الأخطاء والتخليط أنسابهم التي حرصوا اشد الحرص على حفظها، والاعتزاز بنقائها.
قال أحمد بن فارس: (وللعرب حفظ الأنساب، وما يُعلم أحدٌ من الأمم عني بحفظ النسب عناية العرب).
لم يكن للعرب قبل الإسلام معتقد ديني واحد، بل دانوا بعقائد متباينة، ولعلّ الوثنية كانت أوسع أديانهم انتشاراً. فقد أصبحت مكة مستقرها ومجمع الأصنام والأوثان التي يقدسونها، ويتعبدونها ويتسمون بالعبودية لها، كعبد يغوث، وعبد العزّى، وعبد مناة. ويبدو أن المكّيين كانوا أشد احتفالاً بها من سواهم؛ إذ اتخذوا وثنيتين: وثنية رسمية معبدها الكعبة التي تضم أشهر آلهتهم، ووثنية خاصّة لها في الدُّور أصنام تتعبدها الأُسر وتحوطها بالإكبار.
على أن الجاهليين لم يكونوا متعصبين للأوثان، ولم يعتقدوا أنها الخالقة المدبرة للكون وأمور الناس، وإنما هي طبقة من الوسطاء تقرب الناس إلى الله. وربما كانت الوثنية بقية دين قديم يدعو إلى التوحيد، ثم آل التوحيد إلى شرك لافتراق القبائل، واستقلال كل قبيلة بوثن أو صنم.
وإلى جانب الوثنية والوثنيين ظهرت جماعة قليلة عاقلة انتبذت الأصنام وآمنت بإله واحد قادر إيماناً قلبياً لا ترفِده رسالة سماوية، ولا ترسخه عبادة وشعائر، وسمّيت هذه الجماعة (الحنفاء)، ويغلب على الظن أنها البقية الباقية ممن كانوا على دين إبراهيم عليه السلام.
وعرف العرب اليهودية والنصرانية، وعبادة الكواكب التي سمّى القرآن من يعبدونها (الصابئين) كما عرفوا عبادة الملائكة والجن، وتسربت إليهم المجوسية، غير أن هذه الأديان جميعاً لم يكن لها ذيوع وشيوع كالوثنية.
فما تأثير عقليتهم وعقائدهم في أدبهم؟
ذكرنا قبلُ أن العقل العربي آمن بالوصول إلى الحقائق عن طريق الجوارح، بعد المعاينة والاختبار، وأن الترحل الملازم للبداوة لم يُتِحْ لهذا العقل ما أتيح لعقول الشعوب القديمة المتحضرة من الاستقرار والاستمرار اللذين يحملان على الأناة في التأمّل، والرويّة في البحث، والاستقصاء للانتقال من الجزئي إلى الكلّي.
ومع ذلك استطاع العقل العربي أن يلخص تجارب الحياة التي تمرس فيها الإنسان بالصعاب، استطاع أن يلخصها بالحكم والأمثال والوصايا والخطب والقصائد، وأن يطبع هذه الفنون الأدبية بطابع فكري عميق، لكنه لا يرقى إلى مستوى الفلسفة النظرية المتكاملة التي تبحث في مظاهر الوجود استناداً إلى المنطق المشفوع بالبراهين، لتصل إلى حقائق مجردة، ولتضع نظاماً متماسكاً يفسّر مظاهر الوجود.
ومن الذين أُثِر عنهم التعقل، والنظر الحصيف الأفوه الأودي، وطرفة بن العبد، وأكثم بن صيفي، وزهير بن أبي سلمى، والأحنف بن قيس، وعدي بن زيد. إذ حفلت أقوال هؤلاء وأشعارهم بحكم عميقة، تترجم آراءهم في الحياة والموت، وتأملهم في الكون، وذكرهم الكواكب كالسُّها، والشِّعْرَى، والفَرْقدين، والسِّماكين، والجوزاء، والعَيُّق، وسُهيل، وربطهم هذا الذكر بسبحات فكرية.
وبَيْن هؤلاء مَنْ ذكر الله وملائكته، ويوم الحساب، ومجازاة كلّ عامل بعمله في أبيات لا ندري ما حظُّها من الصدق، كالشعر المنسوب إلى زهير وأمية.
وربما كان طرفة أصدق تعبيراً عن العقلية العربية الجاهلية، فهو ذو عقل واضح صريح، ومذهب واقعي لا مواربة فيه، فالحياة عنده لذّات مهددة بالزوال، والموت خاتمتها المحتومة، فلماذا يبدد الإنسان عمره القصير في التفكير والتدبّر غير المُجديين، فالحياة أوضح من أن تحتاج إلى تحكيم ينقدها، أو فيلسوف يكشف خفاياها؛ لأنه مهما يغص في أغوارها فلن يخرج بغير القَسَمات المرسومة على محيّاها المنظور.
الأسئلة الشائعة
كيف أثرت الطبيعة الصحراوية في خصائص الأدب الجاهلي؟
فرضت الصحراء بمناخها الحار وصراحتها لغةً واضحةً وصريحةً في الأدب، بعيدةً عن الرمز والغموض. كما أوحت المخاوف من مجاهل الصحراء بصور الجن والغيلان في الشعر. بالإضافة إلى ذلك، أدى التنقل المستمر بحثًا عن الماء والكلأ إلى بناء القصيدة كرحلة فكرية تنتقل بين الموضوعات (كالبكاء على الأطلال، ووصف الرحلة، والفخر).
ما تأثير النظام القبلي على الأدب الجاهلي؟
عزز النظام القبلي قيمَ الشجاعة والكرم والثأر، مما انعكس في الأدب عبر تفجير الصراعات القبلية، وتمجيد البطولة، وذكر الحروب. كما ساهم في ظهور شعر الفخر والحماسة، مثل قصائد عمرو بن كلثوم، وظهرت طبقات المجتمع (الأحرار، العبيد، الموالي) في سياق التراتبية الاجتماعية داخل النصوص الأدبية.
كيف انعكست الحياة الاقتصادية للعرب الجاهليين على أدبهم؟
اعتماد العرب على الرعي والتجارة والغزو أدى إلى غنى اللغة بمفردات الإبل والخيل والصيد (مثل ٥٦٤٤ مصطلحًا لشؤون الجمل). كما ظهرت في الأدب موضوعات الجدب والخصب، ووصف الغارات، واحتقار الصناعة، وتمجيد حياة البدو مقابل سكان المدن.
ما دور الأسواق الأدبية مثل عكاظ في تطوير الشعر الجاهلي؟
كانت أسواق عكاظ وذو المجاز منصاتٍ لتبادل الشعر والتجارة، حيث تنافس الشعراء (كالنابغة الذبياني والأعشى) في إلقاء قصائدهم، مما ساهم في انتشار الشعر ورفع مستوى الإبداع، خاصة في فنون المديح والاعتذار.
كيف تأثر الأدب الجاهلي بالمعتقدات الدينية والعقلية العربية؟
سيطرت الوثنية على المعتقدات، لكنها اختلطت ببقايا التوحيد (الحنفاء)، والخرافات كالكهانة والزجر بالحصى. كما غلب على العقلية العربية الاعتماد على التجربة الحسية، مما أنتج حِكَمًا وأمثالًا واقعية (كأقوال زهير وطرفة)، دون الوصول إلى فلسفةٍ نظريةٍ كاليونان.
ما الفرق بين شعراء الصحراء وشعراء الإمارات كالغساسنة والمناذرة؟
شعراء الصحراء (كعمرو بن كلثوم) ركّزوا على الحماسة والقبيلة، بينما تأثر شعراء الإمارات (كالنابغة الذبياني) بالحضارة والاستقرار، فتنوعت موضوعاتهم بين المدح وأدب الشراب، ورقَّت ألفاظهم لاختلاطهم بالحُكّام.
لماذا يُعتبر الشعر الجاهلي سجلًّا غير رسمي لتاريخ العرب؟
لأنه احتوى على أحداث القبائل، وحروبها، ومناقبها، كذكر انتصارات القبائل على الأعداء، وتفاصيل الحياة اليومية، مما حفظ تاريخهم شفهيًّا عبر الأجيال.
كيف تفسر غياب الفلسفة المنظمة عند العرب الجاهليين؟
نتيجةً لطبيعة الحياة البدوية القائمة على الترحال، والتي حالت دون الاستقرار اللازم للتأمل الفلسفي، فاكتفوا بملاحظاتٍ حسيةٍ وحِكَمٍ عمليةٍ نابعةٍ من التجربة، دون بناء نظريات مجردة.
ما أبرز السمات الفنية للأدب الجاهلي؟
- الوضوح والصراحة في التعبير.
- الاعتماد على الوصف الحسي الدقيق (كوصف الناقة والخيل).
- تنوع الموضوعات داخل القصيدة الواحدة (الرحلة، الغزل، الفخر).
- استخدام الصور المستمدة من البيئة (العواصف، السُحب، الحيوانات).
هل كانت الوثنية دين العرب الوحيد في الجاهلية؟
لا، فقد تنوعت معتقداتهم بين الوثنية (الأصنام)، والحنفية (توحيد مُبهم)، واليهودية، والنصرانية، وعبادة الكواكب، لكن الوثنية كانت الأكثر انتشارًا، خاصة في مكة.