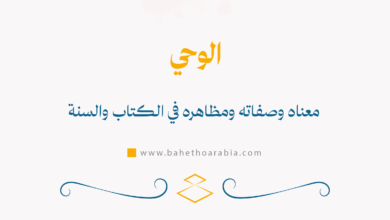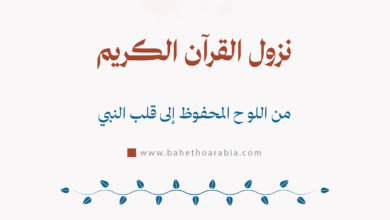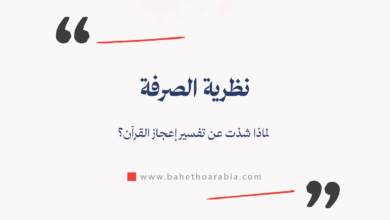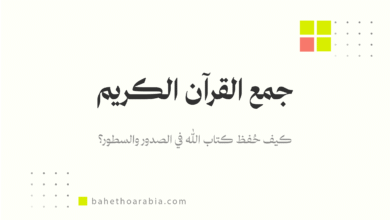التشبيه في القرآن: كيف أبدع القرآن الكريم في هذا الفن البلاغي؟
ما الذي يميز التشبيه القرآني عن غيره من أساليب البيان؟
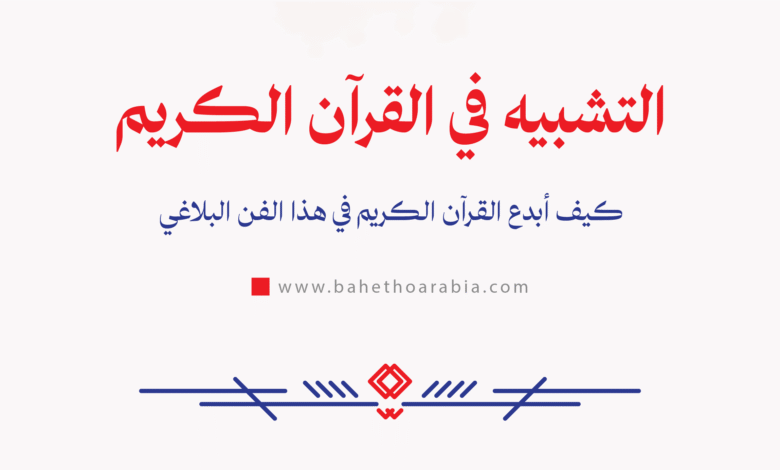
يمثل التشبيه أحد أبرز الفنون البلاغية التي اعتمد عليها القرآن الكريم في إيصال معانيه السامية وتقريب المفاهيم إلى أذهان المخاطبين، حيث استخدم هذا الأسلوب بطريقة معجزة تجمع بين الوضوح والتأثير والجمال. إن دراسة التشبيه في القرآن تكشف عن عظمة البيان القرآني وتفرده في توظيف هذا الفن البلاغي بما يخدم الرسالة الإلهية ويحقق الغاية من الخطاب.
المقدمة
التشبيه من أوسع فنون البلاغة، وأكثر ألوان البيان تأتياً في الكلام، سواء في ذلك البيان العربي أو غير العربي، حتى إنه ليعتبر أقرب شيء من وسائل الإيضاح لتقريب الفكرة إلى المخاطب أو إقناعه بها، والى التأثير في نفس السامع وإثارة الانفعال الذي يبتغيه منشئ الكلام في سامعه. ولهذا قال المبرد في الكامل: (لو قال قائل إن التشبيه هو أكثر كلام العرب لم يبتعد).
إن التشبيه في القرآن يتجاوز كونه مجرد وسيلة بيانية إلى أن يكون عنصراً جوهرياً في بناء المعنى القرآني، فهو يشارك في أداء الفكرة الأساسية ولا يقتصر دوره على الزخرفة اللفظية. وقد أدرك علماء البلاغة عبر العصور أهمية دراسة هذا الفن في القرآن الكريم، فعقدوا له الدراسات المتخصصة وأفردوا له المؤلفات القيمة التي تستكشف أسراره وتبرز جمالياته المعجزة التي لا تنقضي.
تعريف التشبيه
الشبَه والشِّبْهه والشبيه كالمثَل والمِثل والمَثيل، والتشبيه في اللغة هو التمثيل. أما في اصطلاح البلغاء فله تعريفات كثيرة، منها: تعريف السكاكي التشبيه بأنه: الدلالة على مشاركة أمر الأمر في معنى. وعرفه غيره بأنه: إلحاق شيء بذي وصف في وصفه. وغير ذلك من تعاريف. وهذه التعاريف المتداولة إنما تقتصر على تعريف التشبيه من حيث بنيته، ولا تراعي فيه قيمته الفنية والغرض الذي يؤديه.
فإذا ما أردنا تعريف التشبيه تعريفاً يراعي هذه الناحية الجوهرية وجدنا أننا تتلاقى مع الدكتور أحمد بدوي في كتابه من بلاغة القرآن، فنعرف التشبيه بما يلي: التشبيه: لمح صلة بين أمرين من حيث وقعهما النفسي، وبه يوضح الفنان شعوره نحو شيء ما حتى يصبح واضحاً وضوحاً وجدانياً، وحتى يحس السامع بما أحس به المتكلم، فهو ليس دلالة مجردة ولكنه دلالة فنية. ومن قبل سبق عبد القاهر بهذه الفكرة فقال يبين فضل التشبيه البياني: إنه يعمل عمل السحر في تأليف المتباينين حتى يختصر ما بين المشرق والمغرب، ويجمع ما بين المُشْئِم والمُعْرِق وهو يريك من المعاني الممثلة بالأوهام شبهاً في الأشخاص الماثلة، والأشباح القائمة، وينطق لك الأخرس، ويعطيك البيان من الأعجم، ويريك الحياة في الجماد. ويريك التئام الاضداد فيأتيك بالحياة والموت مجموعين، والماء والنار مجتمعين.
الاهتمام العلمي بتشبيهات القرآن
وقد عني العلماء بتشبيهات القرآن، وعقدوا لها دراسات كثيرة، وأفرد ابن ناقيا البغدادي لها كتاباً سماه (الجمان في تشبيهات القرآن). غير أنه اقتصر على دراسة الآيات القرآنية التي فيها تشبيه، ولم يستخلص من عمله هذا نتائج عامة وقواعد جامعة. لكن الإمام الزركشي عقد لذلك فصلاً قيماً في كتابه «البرهان في علوم القرآن» اقتبسه منه السيوطي في الإتقان.
واستوفيا في دراستهما أقسام التنبيه مع الأمثلة من القرآن مما يبرز للمتأمل عظمة القرآن وتشعب تفننه في هذا اللون الهام من ألوان البيان، حتى قد اعتمد كل من درس التشبيه من المعاصرين على هذه التقسيمات وأمثلتها. ونقتبس منها فيما يلي أهم تقسيمين للتشبيه في القرآن، وهذه التقسيمات تساعدنا على فهم عمق البيان القرآني وروعة أساليبه في استخدام هذا الفن البلاغي المتميز.
تقسيم التشبيه باعتبار طرفيه
ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى أربعة أقسام، لأنهما:
- إما حسيّان، كقوله تعالى: (حتى عاد كالعرجون القديم). وقوله: (كأنهم أعجاز نخلٍ منقَعِرْ)
- أو عقليان، كقوله تعالى: (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة)
- وإما تشبيه المعقول بالمحسوس، كقوله تعالى: «مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت»، وقوله: (مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح)
- وأما عكسه فمنعه الإمام، لأن العقل مستفاد من الحس، ولذلك قيل: من فقد حساً فقد علماً، وإذا كان المحسوس أصلاً للمعقول فتشبيهه به يستلزم جعل الأصل فرعاً والفرع أصلاً، وهو غير جائز
وأجازه غيره كقوله: وكأن النجوم بين دُجاه * سنن لاح بينهن ابتداع. وينقسم التشبيه باعتبار آخر من أحوال طرفيه إلى خمسة أقسام: الأول: قد يشبه ما تقع عليه الحاسة بما لا تقع، اعتماداً على معرفة النقيض والضد، فإن إدراكهما أبلغ من إدراك الحاسة، كقوله تعالى: (كأنه رؤوس الشياطين)، فشبه بما لا نشك أنه منكر قبيح، لما حصل في نفوس الناس من بشاعة صور الشياطين، وإن لم نرها عياناً. الثاني: عكسه، كقوله تعالى: (والذين كفروا أعمالهم کسرابٍ)، أخرج ما لا يحس – وهو الإيمان – إلى ما يحس – وهو السراب – والمعنى الجامع بطلان التوهم بين شدة الحاجة وعظم الفاقة.
الثالث: إخراج ما لم تجر العادة به إلى ما جرت به، نحو: «وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة»، والجامع بينهما الانتفاع بالصورة. وكذا قوله: (إنما مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء)، والجامع البهجة والزينة، ثم الهلاك، وفيه العبرة. الرابع: إخراج ما لا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها، كقوله: (وجنة عرضها السموات والأرض)، الجامع العظم، وفائدته التشويق إلى الجنة بحسن الصفة. الخامس: إخراج ما لا قوة له في الصفة إلى ما له قوة فيها، كقوله: (وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام)، والجامع فيهما العظم، والفائدة البيان عن القدرة على تسخير الأجسام العظام في أعظم ما يكون من الماء. وعلى هذه الأوجه تجري تشبيهات القرآن.
تقسيم التشبيه من حيث وجه الشبه
ينقسم التشبيه من حيث وجه الشبه إلى مفرد ومركب: أما المفرد فمعروف. وأما المركب فهو أن يكون وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض، كقوله تعالى: (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً). فالتشبيه، ركب من أحوال الحمار؛ وذلك هو حمل الأسفار التي هي أوعية العلم، وخزائن ثمرة العقول، ثم لا يحسن ما فيها، ولا يفرق بينها وبين سائر الأحمال التي ليست من العلم في شيء، فليس له مما يحمل حق سوى أن ينقل عليه ويتعبه.
وقوله: (مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتناً). وقوله: (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء)، قال بعضهم: شبه الدنيا بالماء، ووجه الشبه أمران: أحدهما: أن الماء إذا أخذت منه فوق حاجتك تضررت، وإن أخذت قدر الحاجة انتفعت به، فكذلك الدنيا. وثانيهما: أن الماء إذا أطبقت كفتك عليه لتحفظه لم يحصل فيه شيء، فكذلك الدنيا، وليس المراد تشبيهها بالماء وحده، بل المراد تشبيهه بهجة الدنيا في قلة البقاء والدوام بأنيق النبات الذي يسير بعد تلك البهجة والغضاضة والطراوة إلى ما ذكر.
أمثلة بارزة على التشبيه المركب
ومن تشبيه المفرد بالمركب قوله: (مثل نوره کمشكاة) فإنه سبحانه أراد تشبيه نوره الذي يلقيه في قلب المؤمن، ثم مثله بمصباح، ثم لم يقنع بكل مصباح، بل بمصباح اجتمعت فيه أسباب الإضاءة، بوضعه في مشكاة، وهي الطاقة غير النافذة، وكونها لا تنفذ، لتكون أجمع للتبصر، وقد جعل فيها مصباح في داخل زجاجة، فيه الكوكب الدُّري في صفائها، ودهن المصباح من أصفى الأدهان وأقواها وقوداً، لأنه من زيت شجر في أوسط الزجاج لا شرقية ولا غربية، فلا تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار بل تصيبها أعدل إصابة.
وهذا مثل ضربه الله للمؤمن، ثم ضرب للكافر مثلين: أحدهما: (كسراب بقيعة)، والثاني: (كظلمات في بحر لجّي) شبه في الأول ما يعمله من لا يقدر الإيمان المعتبر بالأعمال التي يحسبها بقيعة، ثم يخيب أمله، بسراب يراه الكافر بالساهرة، وقد غلبه عطش يوم القيامة، فيجيئه فلا يجده ماء، ويجد زبانية الله عنده، فيأخذونه فيلقونه إلى جهنم. إن التشبيه في القرآن يتميز بالعمق والشمول، حيث يجمع بين عناصر متعددة لتكوين صورة كاملة متكاملة تؤثر في النفس وتحرك المشاعر.
خصائص التشبيه في القرآن
نستخلص من هذه الدراسة لهذا النص خصائص التشبيه في القرآن وهذه الخصائص هي:
أولاً: استمداد القرآن عناصر التشبيه فيه من الطبيعة والكون. فالعناصر هنا في النص: النار، المطر، السحاب الكثيف المظلم، المطر الغزير، الصواعق عودها وبروقها. وليس هذا خاصى بهذا التشبيه بل هو من سنن القرآن العامة في التشبيه. وفي هذا يقول الدكتور أحمد بدوي: «اتخذ القرآن الكريم من الطبيعة ميداناً يقتبس منها صور تشبيهاته، من جمادها ونباتها وحيوانها.
فيما اتخذه القرآن مشبهاً به من جماد الأرض: الجبال، والحجارة، والرماد، والعين، والخشب المسندة، والياقوت، والمرجان، والماء النازل من السماء، والبحر اللجي. الخ. ومما اتخذه مشبهاً به من نبات الأرض: العرجون، وأعجاز النخل، والعصف المأكول، والحبة تنبت سبع سنابل، والشجرة الطيبة والشجرة الخبيثة وهشيم المحتظر، والزرع الذي أخرج شطأه والجنة أصابها إعصار. ومما شبه القرآن به من حيوان الأرض: الإنسان نفسه في أحوال مختلفة والأنعام، والجمال، والعنكبوت، والحمار، والكلب، والفراش، والجراد. وهذا يذكرنا كذلك بأمرين: الأول ما سبقت الإشارة إليه، وهو العرض الأساسي من التشبيه – الوضوح والتأثير -.
والثاني: أن قيمة المشبه به أو (نفاسته) ليست موضع عناية القرآن الكريم، لأن البحث هنا عن (القيمة الفنية) لا عن النفاسة (المادية) أو (الندرة) التي كانت موضع عناية لدى بعض الشعراء في بعض العصور!! ولهذا كذلك فإن تشبيهات القرآن لا تحمل طابع عصر معين، أو بيئة معينة، ولا تزيد المعنى وضوحاً، والصورة تأثيراً في بعض العصور دون بعض، كما نجد كثيراً من التشبيهات التي استجادها النقاد، أو كانت مستجادة عندهم في عصر من العصور نتيجة لبعض القيم الفنية أو الاجتماعية التي سادت في ذلك العصر. هذا الاعتماد من القرآن على الطبيعة والكون في تشبيهاته وكذا في حكمه وأمثاله، وحجاجه وبراهينه هو سر خلود القرآن، وسر عمومه لكل الناس في كل البيئات وكل العصور، لأنه يستند إلى مقومات لا تتبدل ولا تتغير تلك المقومات هي الإنسان والطبيعة، وذلك ما أعلنه القرآن على العالم بقوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين. وقال تعالى: (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق).
ثانياً: أن التشبيه لا يأتي في الكلام جزءاً زائداً عن الفكرة الأساسية، لإيضاحها والتأثير في نفس المخاطب، بل إنه يستعمل في القرآن عنصراً أساسياً يشارك في أداء المعنى والفكرة، إلى جانب وظيفته في الإيضاح والتأثير. وذلك واضح في النص المدروس فإن التشبيه بالمستوقد للنار هو الذي عرفنا ظلمة القضية في قلب المنافق وخبطه على عشواء، حتى أنه لا ينتفع بحواسه (صم بكم). وكذلك فإن التشبيه الثاني للمنافقين بأصحاب الصيب الذين أخذتهم السماء في ليلة شاتية قاسية جداً هو الذي عرفنا أبداً تعريفاً على ما في قلوبهم من الخوف والهلع، والتردد والاضطراب، بما رسمه لنا من حركاتهم وتصرفاتهم.
ثالثاً: الدقة البالغة أقصى غاية والإحاطة في عقد التشبيه: في وصف المشبه به، وفي وصف المشبه. فهنا في هذا النص نجد في التشبيه الأول: الدقة في وصف المشبه به، باستعمال فعل (استوقد) بزيادة السين والتاء للمبالغة، وكلمة (ناراً) نكرة المناسبة هول النار، و(أضاءت) الدالة على قوة النور، ثم المفاجأة بذهاب النور إلى ظلام شديد أفادته صيغة الجمع (ظلمات)، ثم (لا يبصرون) التي لا تبقي أي بصيص من الرؤية. مما يفيد في وصف المشبه الذي هو ظلمة الحيرة والضياع في نفوس المنافقين. وفي التشبيه الثاني ترتسم اللوحة كاملة تعرض أهوال الطبيعة في كل كلمة: (صيب، من السماء، فيه ظلمات، ورعد، وبرق.. كلما أضاء لهم مشوا فيه..). إلى آخر ما سبق مشروحاً مفصلاً في دراسة النص.
رابعاً: الإحكام في عقد التشبيه بين أطرافه: فالمناسبة أو وجه الشبه الذي تلمحه الآيات في التشبيهين بالغ غاية الإحكام والتناسب، على الرغم من البون بين خفايا النفوس ومظاهر الطبيعة التي اعتمد عليها التشبيهان، لكن براعة الانتقاء والعرض ربطت بين المشبه والمشبه به في كلا التشبيهين لتنقلنا تلك النقلة المعجزة من المستوقد الذي ذهب الله بنوره وأصحاب الصيب في الأهوال المحيطة إلى أن تفهم جيداً بل تتأثر وتنفعل بصورة نفسية المنافقين الضائعة، والخائفة والقلقة والمترددة المذبذبة (لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء).
تنوع التشبيهات القرآنية
ويتفنن القرآن في هذه الخصوصية تفنناً معجزاً، فيشبه الأحياء بالأحياء، ويشبه الجماد بالجماد (وتكون الجبال كالعِهن المنفوش)، ويشبه الإنسان بالحيوان: (مثل الذين حمِّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً). (فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمرٌ مستنفرة فرَّت من قسورة). بل قد يشبه الأحياء بالجماد: (فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية).
ويقول في صفة المنافقين: (وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسنّدة يحسبون كل صيحة عليهم). وغير ذلك كثير يطول بنا بحثه واستيفاؤه. إن التشبيه في القرآن الكريم يظهر قدرة فائقة على الجمع بين المتباعدات وإيجاد أوجه الشبه الدقيقة بين العناصر المختلفة، مما يجعل المعنى أكثر وضوحاً وتأثيراً في النفس البشرية.
الخاتمة
وبعد: فإن خصائص التشبيه القرآني لا تقف عند هذه العناصر، ولا على نحو ما ذكرناه هنا، بل إنك واجد في كل تشبيه افتناناً لا تجده في غيره، وواجد في أمثلة كل خصوصية تنويعاً لا ينتهي منه العجب، ولا ينقضي الانفعال بالعنصر الجمالي الذي فيه، والذي هو من دلائل إعجاز أسلوب القرآن.
إن التشبيه في القرآن يمثل نموذجاً فريداً للبيان الإلهي الذي يجمع بين الوضوح والعمق، والبساطة والإعجاز، والتأثير النفسي والهداية الروحية. فكل تشبيه قرآني يحمل في طياته معاني متعددة ودلالات عميقة تتكشف للمتدبر مع كل قراءة وتأمل، مما يجعل دراسة هذا الفن البلاغي في القرآن الكريم ميداناً خصباً للبحث والاستكشاف، ومصدراً لا ينضب من الجمال البياني والإعجاز اللغوي. وهكذا يبقى التشبيه في القرآن شاهداً على عظمة الكلام الإلهي وتفرده بين سائر أنواع البيان البشري، مؤكداً أن هذا القرآن لا يمكن أن يكون من صنع البشر، بل هو كلام رب العالمين المنزل على خاتم النبيين والمرسلين.
سؤال وجواب
ما الفرق بين التشبيه في القرآن والتشبيه في الكلام العادي؟
التشبيه في القرآن يتميز بكونه عنصراً أساسياً يشارك في أداء المعنى والفكرة وليس مجرد زخرفة لفظية، بينما في الكلام العادي قد يأتي التشبيه جزءاً زائداً للإيضاح فقط. كما أن التشبيه القرآني يستمد عناصره من الطبيعة والكون بطريقة معجزة تجعله صالحاً لكل زمان ومكان، ويتسم بالدقة البالغة في وصف المشبه والمشبه به، والإحكام في عقد المناسبة بينهما بما يؤثر في النفس تأثيراً عميقاً ويحرك الانفعالات الوجدانية.
لماذا اعتمد القرآن على الطبيعة في تشبيهاته؟
اعتمد القرآن على الطبيعة في تشبيهاته لأنها مقومات ثابتة لا تتبدل ولا تتغير عبر الزمان والمكان، مما يجعل التشبيهات القرآنية صالحة لكل الناس في كل البيئات والعصور. فالطبيعة بعناصرها من جماد ونبات وحيوان معروفة للجميع ومشاهدة في كل مكان، وهذا يحقق الغرض الأساسي من التشبيه وهو الوضوح والتأثير، كما أن هذا الاعتماد يعد سر خلود القرآن وعمومه، كما قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي الأرض آيات للموقنين.
ما المقصود بالتشبيه المركب في القرآن؟
التشبيه المركب هو أن يكون وجه الشبه من أمور مجموع بعضها إلى بعض وليس صفة واحدة مفردة. ومن أمثلته في القرآن قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً، فالتشبيه هنا مركب من عدة أحوال: حمل الأسفار التي هي أوعية العلم، ثم عدم الفهم لما فيها، وعدم التفريق بينها وبين الأحمال الأخرى. وكذلك تشبيه نور المؤمن بالمشكاة التي فيها مصباح في زجاجة من أصفى الزيت، فهو تشبيه مركب من عناصر متعددة تجتمع لتعطي الصورة الكاملة.
كيف يخدم التشبيه المعنى القرآني؟
يخدم التشبيه المعنى القرآني بطرق متعددة أهمها: تقريب الفكرة المجردة إلى ذهن المخاطب وجعلها محسوسة وواضحة، والتأثير في نفس السامع وإثارة الانفعالات المطلوبة، وإبراز الصفات الخفية في المشبه من خلال ربطها بصفات ظاهرة في المشبه به. كما أن التشبيه في القرآن يعمل عمل السحر كما قال عبد القاهر، فينطق الأخرس ويريك الحياة في الجماد ويجمع الأضداد، مما يجعل المعنى أكثر رسوخاً في الذهن وأشد وقعاً في القلب.
ما أنواع التشبيه من حيث طرفيه؟
ينقسم التشبيه من حيث طرفيه إلى أربعة أقسام: الأول تشبيه الحسي بالحسي كقوله تعالى: كأنهم أعجاز نخل منقعر. والثاني تشبيه المعقول بالمعقول كقوله: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. والثالث تشبيه المعقول بالمحسوس كقوله: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. أما عكس الثالث وهو تشبيه المحسوس بالمعقول فقد منعه بعض العلماء لأن العقل مستفاد من الحس فيكون تشبيه الأصل بالفرع، وأجازه آخرون بأمثلة من الشعر العربي.
لماذا قال المبرد إن التشبيه أكثر كلام العرب؟
قال المبرد هذا القول لأن التشبيه يعتبر أقرب وسائل الإيضاح لتقريب الفكرة إلى المخاطب وإقناعه بها، وهو من أوسع فنون البلاغة وأكثر ألوان البيان تأتياً في الكلام سواء العربي أو غيره. فالعرب بطبيعتهم يميلون إلى التصوير والتخييل في كلامهم، ويستخدمون التشبيه للتأثير في نفس السامع وإثارة الانفعال المطلوب. وهذا الاستخدام الواسع للتشبيه في كلام العرب جعل المبرد يقرر أن من قال إن التشبيه أكثر كلام العرب لم يبتعد عن الصواب.
ما الفرق بين التعريف اللغوي والاصطلاحي للتشبيه؟
التشبيه في اللغة هو التمثيل، مأخوذ من الشبه والشِّبْهه والشبيه كالمثَل والمِثل والمَثيل. أما في اصطلاح البلغاء فله تعريفات كثيرة تراعي بنيته البلاغية، فعرفه السكاكي بأنه الدلالة على مشاركة أمر الأمر في معنى، وعرفه غيره بأنه إلحاق شيء بذي وصف في وصفه. لكن التعريف الأشمل الذي يراعي القيمة الفنية والغرض هو أن التشبيه لمح صلة بين أمرين من حيث وقعهما النفسي، وبه يوضح الفنان شعوره نحو شيء ما حتى يصبح واضحاً وضوحاً وجدانياً.
ما أهمية دراسة التشبيه في القرآن الكريم؟
دراسة التشبيه في القرآن الكريم تكشف عن عظمة البيان القرآني وتشعب تفننه في هذا اللون الهام من ألوان البيان، وتبرز جوانب الإعجاز البلاغي في القرآن. كما أنها تساعد على فهم المعاني القرآنية فهماً أعمق من خلال تأمل الصور التشبيهية ووجوه الشبه الدقيقة. وقد اهتم العلماء بهذا الموضوع فأفردوا له مؤلفات خاصة كالإمام الزركشي في البرهان والسيوطي في الإتقان وابن ناقيا في كتابه الجمان في تشبيهات القرآن، مما يدل على أهمية هذا العلم في فهم القرآن وإدراك إعجازه.
كيف يحقق التشبيه القرآني الوضوح والتأثير معاً؟
يحقق التشبيه القرآني الوضوح من خلال نقل المعنى المجرد أو الخفي إلى صورة حسية مشاهدة ومعروفة للناس من الطبيعة والكون، كتشبيه قسوة القلوب بالحجارة. ويحقق التأثير من خلال الدقة البالغة في اختيار عناصر التشبيه ووصفها وصفاً مفصلاً يرسم لوحة كاملة تحرك المشاعر، كما في تشبيه حال المنافقين بأصحاب الصيب في الظلمات والرعد والبرق. وهذا الجمع بين الوضوح والتأثير يجعل المعنى راسخاً في الذهن مؤثراً في القلب، فيحقق الهداية والإقناع معاً.
ما معنى قول عبد القاهر إن التشبيه يعمل عمل السحر؟
يقصد عبد القاهر أن التشبيه له قدرة عجيبة على تأليف المتباينين والجمع بين المتناقضات بطريقة تبهر العقل وتأسر القلب، فهو يختصر المسافة بين المشرق والمغرب ويجمع ما بين المتباعدات. كما أن التشبيه يجعل المعاني المجردة كأنها أشخاص ماثلة وأشباح قائمة، وينطق الأخرس ويعطيك البيان من الأعجم ويريك الحياة في الجماد. بل يريك التئام الأضداد فيجمع الحياة والموت معاً والماء والنار مجتمعين، وهذا كله من عجائب التشبيه التي تشبه السحر في تأثيرها وقدرتها على تحويل الصور والمعاني.