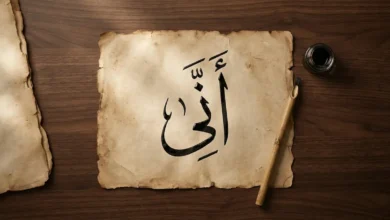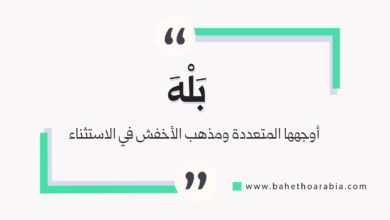المؤنث في اللغة العربية: دليلك الشامل للأنواع والعلامات والقواعد

يحتل مفهوم الجنس النحوي (التذكير والتأنيث) مكانة محورية في بنية اللغة العربية، ويُعدُّ أحد المباحث الأساسية في علمي النحو والصرف. لا يقتصر أثر هذا المفهوم على تحديد هوية الاسم المعجمية فحسب، بل يمتد ليشكل ركيزة أساسية في بناء الجملة العربية السليمة، حيث تترتب عليه قواعد المطابقة الصارمة بين أجزاء الكلام المختلفة، كالمبتدأ والخبر، والفعل والفاعل، والصفة والموصوف. إن إتقان قواعد التذكير والتأنيث لا يمثل مجرد إلمام بظاهرة لغوية، بل هو شرط لا غنى عنه لتحقيق الدقة البلاغية والسلامة التركيبية في التعبير.
وعلى الرغم من أن التمييز بين المذكر والمؤنث قد يبدو بديهيًا في مظهره الأولي المرتبط بالجنس البيولوجي للكائنات الحية، إلا أن اللغة العربية تقدم نظامًا أكثر تعقيدًا وعمقًا وتجريدًا. فهذا النظام يتجاوز المؤنث الحقيقي (الدال على أنثى من إنسان أو حيوان) ليشمل المؤنث المجازي (الذي يعامل معاملة المؤنث دون أن يكون له جنس حقيقي)، والمؤنث المعنوي (الذي يدل على مؤنث دون أن يحمل علامة لفظية ظاهرة)، مما يفتح الباب أمام دراسة دقيقة للأسس التي استند إليها العرب في تصنيف الأسماء.
تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل منهجي وشامل لمفهوم الاسم المؤنث في اللغة العربية. ستتناول الدراسة بالتفصيل تعريف المؤنث، مستعرضةً أنواعه المختلفة من حقيقي ومجازي ومعنوي، معززةً ذلك بأمثلة توضيحية. بعد ذلك، ستنتقل إلى تفصيل علاماته الصرفية التي تميزه، وهي: التاء المربوطة، والألف المقصورة، والألف الممدودة، مع بيان الأوزان القياسية والسماعية لكل منها. كما ستلقي المقالة الضوء على الصيغ الصرفية التي يستوي في استخدامها المذكر والمؤنث، وهي ظاهرة لغوية تكشف عن مرونة اللغة وثراءها. وأخيرًا، ستستكشف الدراسة الوظائف الدلالية المتعددة للتاء المربوطة، التي تتجاوز مجرد التأنيث لتشمل معاني كالوحدة، والجنس، والمبالغة، والتعويض، بما يزيل أي لبس قد يحيط بهذه الظاهرة اللغوية. ومن خلال هذا العرض الأكاديمي المباشر، الذي يلتزم بالنص الأصلي دون اختصار أو حذف، سيتمكن القارئ من تكوين فهم دقيق ومتكامل لهذا المبحث الأساسي من مباحث علم الصرف العربي.
تعريف المؤنث وأنواعه
يُعرَّف الاسم المؤنث في اللغة العربية بأنه الاسم الذي يدل على مؤنث، وينقسم من حيث الدلالة إلى مؤنث حقيقي، أو مجازي، أو لفظي، أو معنوي.
١ – المؤنث الحقيقي: هو ما يدل على أنثى حقيقية من الكائنات الحية، سواء كانت من البشر أم من الحيوان. من أمثلته: زينب، سعاد، ليلى، عصفورة، ناقة، دجاجة، عُقاب.
٢ – المؤنث المجازي: هو اسم لجماد لا يمتلك جنسًا حقيقيًا، ولكنه يُعامل في اللغة معاملة المؤنث. من أمثلته: لقمة، ورقة، شمس، أرض، صحراء، ذكرى، أذن، عين، نار، سماء.
٣ – المؤنث المعنوي: هو ما يدل على مؤنث، سواء أكان حقيقيًا أم مجازيًا، ولكنه يخلو من علامات التأنيث اللفظية الظاهرة. من أمثلته: مريم، سعاد، أرض، حرب، شمس.
إضافة إلى ذلك، ورد عن العرب استخدام بعض الكلمات للدلالة على المذكر والمؤنث على حد سواء، ومن هذه الكلمات: سبيل، طريق، دلو، سكين، سوق، لسان، ذراع، سلاح، فرس، عُنُق، خمر، حيّة، شاة، دابّة، سَخْلة.
علامات التأنيث
تتصل علامات التأنيث بآخر الاسم للدلالة على جنسه، وتنحصر هذه العلامات في ثلاثة أنواع رئيسة هي: التاء المتحركة المربوطة، والألف المقصورة، والألف الممدودة.
١ – تاء التأنيث: تدخل هذه التاء قياسًا على الأسماء المشتقة المستخدمة كصفات، ولا تُعد صيغة تأنيث مستقلة. من أمثلتها: مجهولة، منطلقة، كاتبة، مستعدة. كما ورد سماعًا دخولها على بعض الأسماء الجامدة، مثل: إنسانة، فتاة، غلامة، رَجُلة، ظبية، عمّة، طفلة، امرأة، حمارة، أسدة، بِرذَوْنة. علاوة على ذلك، توجد صفات مشبهة خاصة بالإناث قد لا تلحقها تاء التأنيث، مع جواز دخولها عليها في بعض الحالات، ومنها: طالق، حامل، حائض، شائل، خاذا، ضامر، عاطف، مشدِن، مرضع.
٢ – ألف التأنيث المقصورة: تدخل هذه الألف سماعًا على الأسماء المعربة، سواء كانت جامدة أم مشتقة. وتأتي على أوزان متعددة، من أشهرها:
- وزن (فُعْلَى): ويأتي في الأسماء مثل: طوبى، بُشرى، رُجْعى، عُسرى. وفي الصفات مثل: حُسْنى، أنثى، صُغرى، حُبلى.
- وزن (فَعْلَى): ويأتي في الأسماء مثل: سلمى، رضوى، دعوى. وفي الصفات مثل: عطشى، كسلى، سكرى. وفي صيغ الجمع، نحو: جرحى، قتلى، صرعى.
- وزن (فِعْلَى): ومثاله: ذكرى.
- وزن (فَعَالى): ومثاله: صحارى، عَذارى، حَبالى.
- وزن (فُعَالى): ومثاله: حُبارى، سُكارى.
٣ – ألف التأنيث الممدودة: تدخل هذه الألف سماعًا على بعض الأسماء المعربة، سواء كانت جامدة أم مشتقة. وتأتي على أوزان متعددة، من أشهرها:
- وزن (فَعْلَاء): نحو: صحراء، هَيْجاء، بغضاء، بيضاء، سوداء، حمقاء، حوراء، زهراء.
- وزن (فُعَلَاء): نحو: خُيَلاء. ويُستخدم هذا الوزن للإشارة إلى المرأة في حالة معينة، كما في قولهم: (نُفَساء). وقد يأتي هذا الوزن دالًا على الجمع، نحو: فُقَهاء، عُلماء.
- وزن (أَفْعِلَاء): نحو: أربعاء، أصدقاء، أطبّاء، أقوياء، أنبياء.
- وزن (فِعْلِيَاء): نحو: كِبرياء، فيزياء.
الصيغ التي يستوي فيها التذكير والتأنيث
توجد في اللغة العربية صيغ صرفية محددة يستوي فيها الاستعمال للمذكر والمؤنث دون الحاجة إلى إضافة علامة تأنيث، وتتضمن هذه الصيغ ما يلي:
١ – صيغة (فُعَلَة): وهي من صيغ المبالغة لاسم الفاعل. فيُقال: رجل هُمَزة، وامرأة هُمَزة، وطفل لُعَبَة، وطفلة لُعَبة، وشعب تُكَلةٌ، وأمة تُكَلة.
٢ – صيغة (فَعُول): وهي من صيغ المبالغة لاسم الفاعل. فيُقال: فتاة صبور، ونفس حقود، وظبية نفور، وأمّة ظلوم، وامرأة عجوز.
٣ – صيغة (فَعَّالَة): وهي من صيغ المبالغة لاسم الفاعل. فيُقال: رجل علّامة، وامرأة علّامة، وطفل فَهّامة، وطفلة فهّامة.
٤ – صيغة (مِفْعَال): وهي من صيغ المبالغة لاسم الفاعل. فيُقال: زوجة مِهذار، وبنت مِطواع، وطالبة مِمْراح، وسماء مِدْرار.
٥ – صيغة (مِفْعِيْل): وهي من صيغ المبالغة لاسم الفاعل. فيُقال: طالبة مِنْطِيْق، وفتاة مِعْطير.
٦ – صيغة (فُعْلَة): ترد بمعنى اسم المفعول. فيُقال: صديق ضُحْكَة، وصديقة ضُحْكَةٌ، وابن لُعْنَة، وابنة لُعْنَة.
٧ – صيغة (فَعِيْل): ترد بمعنى اسم المفعول. فيُقال: طفل لعين، وأرض سليب، وامرأة دفين، وإصبَع جريح.
٨ – صيغة (فِعْل): ترد بمعنى اسم المفعول، نحو: بعير ذِبْح، وناقة ذِبْح، وفتى نِضْو، وفتاة نِضْو، ورأي مسخ، وفكرة مسخ. كما تأتي بمعنى اسم الفاعل أو الصفة المشبهة، نحو: شاب بكر، وشابة بكر، وماء ملح، ومياه ملح، وقومٌ ضدّ، وأمّة ضدّ.
٩ – صيغة (فَعَلٌ): ترد بمعنى اسم المفعول، نحو: ثور قَنَصٌ، وبقرة قَنَص، وبعير جَزَرٌ، وناقةٌ جزر، ودرع سَلَبٌ، وثوب سَلَبٌ.
١٠ – صيغة (مِفْعَل): هي صفة مشبهة. نحو: فتاة مِغْشَم، وكتيبة مِكَرٌّ.
كما سُمِع عن العرب استعمال صفات أخرى كثيرة يستوي فيها المذكر والمؤنث، منها ما هو مصدر في الأصل، نحو: عدل، رضا، صوم، فِطر، زور. ومنها ما هو اسم جامد، نحو: غير، سوى، شبيه، شبِه، مع، دون، مئة، ألف، نيِّف، كلّ.
المعاني الأخرى للتاء المربوطة
إلى جانب دلالتها الأصلية على التأنيث، تؤدي التاء المربوطة وظائف دلالية أخرى، منها:
١ – الدلالة على الوحدة: قد تدخل التاء المربوطة على اسم الجنس الجمعي لتحويله إلى صيغة المفرد. من أمثلة ذلك: برتقالة، ثمرة، ضربة، إيماءة، انطلاقة، بقرة، نَمْلة، سفينة.
٢ – الدلالة على الجنس: في حالات معينة، قد تؤدي إضافة التاء المربوطة إلى بعض الأسماء الدالة على الوحدة إلى نقل دلالتها إلى الجنس، ومن أشهر أمثلتها: الكمأة.
٣ – الدلالة على المبالغة: تُضاف التاء إلى بعض الصفات لإكسابها معنى المبالغة، نحو: راوية.
٤ – توليد صيغة المبالغة: تدخل التاء على بعض صيغ المبالغة لغرض التوليد أو التأكيد، نحو: فروقة، ملولة، حقودة، علّامة، مدّاحة، نسّابة.
٥ – التعويض عن حرف محذوف: قد تأتي التاء المربوطة عوضًا عن حرف محذوف من بنية الكلمة، سواء أكان:
- عوضًا عن الفاء المحذوفة، نحو: عِدة، صِلة، زِنة، جِهة.
- أو عوضًا عن اللام المحذوفة، نحو: إرادة، إعانة، تربية، توصية، أكاسرة، عمالقة، زنادقة، قراصنة.
- أو عوضًا عن ياءي النسب، نحو: أزارقة، مناذرة، غساسنة، مغاربة، مشارقة، قرامطة، حنابلة.
٦ – توكيد التأنيث: قد تُستخدم التاء لتوكيد تأنيث بعض الأسماء، وذلك في حالتين:
- دخولها على صيغ منتهى الجموع لتوكيد تأنيثها، نحو: ملائكة، صيارفة، تبابعة، صياقلة.
- أو دخولها على اسم مفرد مؤنث أصلًا لزيادة تأكيد تأنيثه، نحو: عجوزة، فَرَسة، أو لتأكيد تأنيث الجمع، نحو: فحولة، حجارة.
٧ – الدلالة على الجمع: قد تُستخدم التاء في بعض الحالات للدلالة على الجمع، كما في الانتقال من المفرد إلى الجمع في الكلمات التالية: بقّال وبقّالة، وسيّاف وسيّافة، وخيّال وخيالة، وبصريّ وبصريّة، وكوفيّ وكوفيّة، ومارّ ومارّة.
خاتمة
ختامًا، يتبين من خلال هذا العرض المفصل أن مبحث الاسم المؤنث في اللغة العربية يمثل نظامًا دقيقًا ومتشعبًا، يتجاوز التقسيم الثنائي البسيط المعتمد على الجنس البيولوجي. لقد استعرضت هذه المقالة الأبعاد المختلفة لهذا المفهوم، بدءًا من تصنيف المؤنث إلى حقيقي ومجازي ومعنوي، مرورًا بتحديد علاماته الصرفية القياسية والسماعية، وصولًا إلى استكشاف الصيغ التي يستوي فيها التذكير والتأنيث، مما يكشف عن مرونة اللغة وثراء أبنيتها.
إن التحليل المعمق للوظائف المتعددة للتاء المربوطة يبرهن على أن العلامة النحوية الواحدة يمكن أن تحمل دلالات متنوعة تتجاوز وظيفتها الأصلية، لتشمل الوحدة، والمبالغة، والتعويض، وغيرها من المعاني التي تخدم دقة التعبير. ويبرز هذا البحث التفاعل المستمر بين القياس والسماع في تشكيل قواعد اللغة، وهو ما يمنحها حيويتها وقدرتها على استيعاب الظواهر اللغوية المختلفة.
بذلك، يُثبت مبحث المؤنث أنه ليس مجرد باب من أبواب علم الصرف، بل هو مفتاح أساسي لفهم بنية اللغة العربية العميقة، وركيزة لا غنى عنها لضمان السلامة التركيبية والدقة البلاغية. فالإلمام بهذه القواعد والتفصيلات يُعد شرطًا ضروريًا لكل باحث ومتعلم يسعى إلى إتقان اللغة والتمكن من أسرارها.
الأسئلة الشائعة
السؤال ١: ما الفرق الدقيق بين المؤنث المجازي والمؤنث المعنوي؟ يبدو أن هناك تداخلًا بينهما، فكلمة “شمس” ذُكرت في كلا القسمين.
الإجابة: هذا سؤال دقيق ومهم. يكمن الفرق الأساسي بين المؤنث المجازي والمؤنث المعنوي في زاوية التصنيف:
- المؤنث المجازي (Metaphorical Feminine): هو تصنيف يعتمد على طبيعة المدلول. فهو اسم لشيء غير حي (جماد أو مفهوم مجرد)، ولكن العرب عاملته معاملة المؤنث في اللغة. أمثلته: شمس، أرض، دار، نار. فالتصنيف هنا يركز على كون الاسم لا يمتلك جنسًا بيولوجيًا حقيقيًا.
- المؤنث المعنوي (Semantic Feminine): هو تصنيف يعتمد على الشكل اللفظي للكلمة. فهو كل اسم يدل على مؤنث (سواء أكان حقيقيًا أم مجازيًا) ولكنه يخلو من علامات التأنيث اللفظية الظاهرة (التاء المربوطة، الألف المقصورة، الألف الممدودة). أمثلته: مريم، سعاد (مؤنث حقيقي معنوي)، وشمس، أرض (مؤنث مجازي معنوي).
إذًا، كلمة “شمس“ هي مؤنث مجازي لأنها جماد، وهي في الوقت نفسه مؤنث معنوي لأنها لا تنتهي بعلامة تأنيث. فالتصنيفان لا يستبعد أحدهما الآخر، بل يصفان الكلمة من منظورين مختلفين.
السؤال ٢: كيف يمكن لكلمة مثل “سبيل” أو “طريق” أن تكون مذكرة ومؤنثة في آن واحد؟ وكيف أحدد جنسها عند الاستخدام؟
الإجابة: هذه الظاهرة تعكس ثراء اللغة العربية ومرونتها. وجود كلمات يستوي فيها التذكير والتأنيث يعني أن العرب استخدموها بالوجهين، وكلاهما صحيح فصيح. تحديد جنسها في الاستخدام يعتمد على السياق والتقليد اللغوي المتبع.
- في القرآن الكريم: استُعملت كلمة “سبيل” بالتذكير والتأنيث. قال تعالى: “قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ” (يوسف: ١٠٨)، وهنا استُعملت مؤنثة. وقال تعالى: “وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا” (الأعراف: ١٤٦)، فجاءت مذكرة.
- عند الاستخدام: أنت مخير في الغالب، ولكن قد يكون أحد الاستعمالين أكثر شيوعًا من الآخر. المعاجم اللغوية الموثوقة غالبًا ما تشير إلى هذه الكلمات وتذكر أنها “تُذكّر وتُؤنّث”. في الكتابة الأكاديمية أو الرسمية، يمكنك اختيار وجه واحد وتثبيته في النص لضمان الاتساق.
السؤال ٣: لماذا بعض الصفات الخاصة بالإناث مثل “حامل” و”مرضع” و”طالق” لا تلحقها تاء التأنيث غالبًا؟
الإجابة: يُعزى ذلك إلى أن هذه الصفات هي في الأصل خاصة بالنساء، فلا يحدث لبس أو غموض عند استخدامها بدلالتها الأصلية. القاعدة هنا أن الصفة إذا كانت مختصة بالإناث ولا يشاركها فيها الذكور، فلا حاجة لإلحاق علامة التأنيث بها لأن المعنى واضح ضمنًا. ومع ذلك، أجاز النحاة دخول التاء عليها للتأكيد أو عند استخدامها بمعنى مجازي، فيصح أن يقال “امرأة حاملة” على قلة. أما إذا استُخدمت الصفة في غير معناها الأصلي (مثلاً: “سحابة حاملة للمطر”)، فإن إلحاق التاء يصبح ضروريًا لرفع اللبس.
السؤال ٤: لماذا نقول “امرأة صبور” و”رجل علّامة” باستخدام صيغ يستوي فيها المذكر والمؤنث؟ ألا يتعارض هذا مع قاعدة المطابقة؟
الإجابة: هذه الصيغ (مثل فَعُول، فَعّالة، مِفْعال) هي استثناءات من قاعدة المطابقة الصارمة، وهي استثناءات قياسية لها سبب بلاغي. هذه الصيغ هي في الأصل صيغ مبالغة، وقوة المبالغة فيها جعلتها تتجاوز التمييز الشكلي بين الجنسين. فكأنما المقصود هو التركيز على الحدث أو الصفة نفسها (الصبر الشديد، العلم الغزير) بغض النظر عن جنس المتصف بها. لذا، لا يعد ذلك خطأ أو تعارضًا، بل هو من الأساليب العربية الفصيحة التي تساوي بين المذكر والمؤنث في هذه الأوزان الصرفية المحددة للدلالة على شدة الصفة.
السؤال ٥: الألف الممدودة (اء) من علامات التأنيث، فلماذا نجدها في جموع مذكرة مثل “علماء” و”فقهاء” و”أصدقاء”؟
الإجابة: هذا سؤال ممتاز ويكشف عن فارق جوهري. الألف الممدودة التي تعد علامة للتأنيث هي “ألف التأنيث الممدودة“، وهي ألف زائدة تسبقها همزة، وتلحق بالاسم المفرد للدلالة على تأنيثه، مثل: صحراء، حسناء، بيضاء.
أما الألف الممدودة في كلمات مثل “علماء“ و**”فقهاء”**، فهي ليست ألف تأنيث، بل هي جزء من صيغة جمع التكسير (فُعَلاء)، وهي صيغة خاصة بجمع المذكر العاقل على وزن “فعيل” (عليم -> علماء) أو “فاعل” (عالم -> علماء). فالهمزة هنا ليست للتأنيث، بل هي جزء من بنية الجمع. إذن، يجب التمييز بين الألف التي هي علامة صرفية للتأنيث، والألف التي هي جزء من بنية صرفية أخرى كالجمع.
السؤال ٦: ما المقصود بعبارة “تدخل سماعًا” التي تكررت في المقالة؟ هل يعني ذلك عدم وجود قاعدة منطقية؟
الإجابة: مصطلح “سماعًا“ في علم الصرف والنحو يعني “ما ورد عن العرب واستُعمل في لغتهم دون أن يندرج تحت قاعدة قياسية مطردة يمكن تطبيقها لتوليد كلمات جديدة”. هذا لا يعني عدم وجود منطق، بل يعني أن القاعدة غير إنتاجية (غير قياسية).
- القياس: هو قاعدة عامة يمكن تطبيقها على كلمات جديدة، مثل إضافة تاء التأنيث إلى اسم الفاعل لتحويله للمؤنث (كاتب -> كاتبة).
- السماع: هو ما حُفظ من كلام العرب كما هو ولا يُقاس عليه، مثل أوزان ألف التأنيث المقصورة والممدودة. نحن لا نخترع اليوم كلمة جديدة على وزن “فُعْلى” لتكون مؤنثة، بل نلتزم بما سُمع عن العرب. فالسماع يعكس التطور التاريخي الطبيعي للغة الذي تم توثيقه وحفظه.
السؤال ٧: كيف يمكن للتاء المربوطة أن تدل على التأنيث، ثم تدل على الوحدة، ثم على المبالغة؟ أليس هذا مربكًا؟
الإجابة: هذا التعدد في وظائف التاء المربوطة هو مثال على الاقتصاد اللغوي، حيث تُستخدم علامة واحدة لأداء وظائف مختلفة يحددها السياق وبنية الكلمة. الأمر ليس مربكًا إذا فهمنا السياق الصرفي لكل وظيفة:
- التأنيث (وظيفة أصلية): عند إلحاقها بصفة مذكرة (جميل -> جميلة).
- الوحدة: عند إلحاقها باسم جنس جمعي لتدل على فرد منه (شجر -> شجرة، نمل -> نملة). هنا، الكلمة الأصلية “شجر” تدل على الجنس كله، والتاء تحدد واحدة منه.
- المبالغة: عند إلحاقها بصفة لتكثيف معناها (راوٍ -> راوية)، أي كثير الرواية. السياق هنا هو المبالغة وليس مجرد التأنيث.
فالسياق الصرفي وبنية الكلمة الأصلية هما اللذان يحددان وظيفة التاء في كل حالة.
السؤال ٨: هل يمكن تبسيط معنى “التعويض” كأحد أدوار التاء المربوطة؟ المثال “عِدَة” ليس واضحًا تمامًا.
الإجابة: بالتأكيد. “التعويض” يعني أن التاء المربوطة أضيفت لتحل محل حرف أصلي حُذف من الكلمة لسبب صرفي. لنأخذ المثال “عِدَة“:
١. أصل الكلمة هو المصدر من الفعل “وَعَدَ“. المصدر القياسي هو “وَعْد“.
٢. عند بناء اسم المرة منه أو مصدر آخر، يُحذف حرف الواو (فاء الكلمة) تخفيفًا.
٣. لتجنب أن تبدأ الكلمة بساكن وتصبح الكلمة قصيرة جدًا، تُضاف التاء المربوطة في آخرها كتعويض عن الواو المحذوفة في أولها.
إذًا: وَعَدَ -> عِدَة (حُذفت الواو وعُوّض عنها بالتاء). ومثلها: وَصَلَ -> صِلَة، وَزَنَ -> زِنَة.
فالتاء هنا ليست للتأنيث، بل هي علامة صرفية تشير إلى حدوث حذف في بنية الكلمة.
السؤال ٩: ما هو الفرق الجوهري بين استخدام التاء للدلالة على “الوحدة” مثل (نملة) واستخدامها للدلالة على “الجنس” مثل (كمأة)؟
الإجابة: الفرق بينهما عكسي تمامًا ويعتمد على طبيعة الاسم الذي دخلت عليه التاء:
- الدلالة على الوحدة: تحدث عندما تدخل التاء على اسم جنس جمعي (اسم يفرق بين واحده وجمعه بالتاء). الاسم بدون تاء (نمل، شجر، بقر) يدل على الكثرة والجنس، وإضافة التاء (نملة، شجرة، بقرة) تخصصه وتدل على فرد واحد من هذا الجنس.
- الدلالة على الجنس: تحدث في حالات نادرة عندما تدخل التاء على اسم يدل على الوحدة أصلًا. المثال الأشهر هو “الكمء” (نوع من الفطر)، الذي يدل على الفرد الواحد. عند إضافة التاء لتصبح “الكمأة”، تنتقل الدلالة من الفرد إلى الجنس أو الصنف كله. هذه حالة خاصة ومحصورة في كلمات قليلة.
السؤال ١٠: لماذا تُضاف التاء المربوطة إلى جموع تكسير مثل “ملائكة” و”صيارفة” مع أنها جموع لمذكر ومؤنث؟
الإجابة: تُضاف التاء المربوطة هنا لغرض “توكيد التأنيث اللفظي للجمع“. هذه الجموع (على وزن فَعَالِلَة) هي جموع تكسير، وجموع التكسير لغير العاقل تُعامل معاملة المؤنث المفرد (“الملائكة قالتْ”). إضافة التاء المربوطة في نهاية الجمع مثل “ملائكة” و”صيارفة” و”عمالقة” هي سمة لفظية لهذه الصيغة من الجمع، وهي تؤكد هذا التأنيث اللفظي للجماعة. هي ليست لتأنيث أفراد الجمع، بل هي جزء من بنية صيغة الجمع نفسها، لتمييزها عن صيغ أخرى ولإضفاء صفة التأنيث على الكلمة ككتلة واحدة.