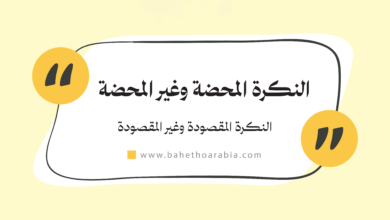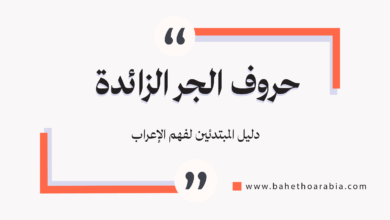جزم المضارع في جواب الطلب: متى يجوز ومتى يمتنع؟

تقدّم هذه المقالة إطاراً منهجياً لشرح قاعدة جواب الطلب في العربية بوصفه آلية نحوية للجزم. نؤصّل لتقدير أداة الشرط إن وفعل الشرط، ونبيّن كيف يتحقق جواب الطلب حين يرتبط الطلب برباط الشرط والسببية. نستعرض أنماط الطلب اللفظي والمعنوي، مع شواهد قرآنية وشعرية توضّح اشتغال جواب الطلب ومواطن الرفع عند انعدام الرباط. ونبيّن حضور جواب الطلب بعد الأمر والنهي والاستفهام والعرض والتمنّي والترجّي، وكيف يغني فعل القول عن مقول القول. الغرض أن يحصل القارئ على أدوات تحليلية دقيقة تمكّنه من تمييز الخبر الذي معناه أمر، وتتبع علامات جواب الطلب في السياق التعليمي والتطبيقي.
تعريف القاعدة وأقسام الطلب
يجزم الفعل المضارع إذا وقع جواباً للطلب المتقدم، ويكون هذا الجزم على تقدير أداة الشرط (إن) وفعل الشرط، ولا فرق بين الطلب اللفظي والطلب المعنوي؛ فكلاهما ينجزم جوابه إذا صح تقدير الشرط. وهذا ما يشار إليه في النحو بـ جواب الطلب. والطلب اللفظي هو الأمر والنهي والدعاء والاستفهام والعرض والحض والتمني والترجي، والطلب المعنوي هو الذي يكون خبراً في الظاهر ولكن معناه الطلب. فأيًّا كان النوع، يتحقق فيه جواب الطلب إذا أمكن تقدير الشرط. وجميع هذه الصيغ يمكن أن يتلوها جواب الطلب بحسب السياق. وعند إمكان تقدير الشرط، ينجزم جواب الطلب في جميع هذه الأنحاء.
جواب الأمر
يكثر مجيء جواب الطلب بعد الأمر والنهي؛ لأن معنى الطلب فيهما أوضح من غيرهما من أقسام الطلب. قال تعالى: {ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل}. فالفعل (ذرهم)، فعل أمر بمعنى دعهم، وجواب الطلب (يأكلوا) مجزوم؛ لأنه جواب للأمر. ومثل ذلك قوله تعالى: {أرسلْه مَعَنَا غداً يرْتعْ ويلعبْ}. وقال تعالى: {فاتّبعوني يحببكم الله}. وقال عمرو بن الإطنابة:
وقولي كلما جَشَأَتْ وجاشَتْ مكانكِ تُحمدِي أو تستريحي
فالفعل (تحمدي) مجزوم؛ لأنه جواب لاسم فعل أمر (مكانك). وهذه الأمثلة تُظهر على نحو مباشر كيف يعمل جواب الطلب في التركيب الأمرِي. وعليه، فإن اقتران الأمر بما يليه يحقق جواب الطلب مباشرة.
جواب النهي والاستفهام والتمني والعرض والترجي
يقال في باب النهي: لا تعامل الناس بقسوة يحبوك، ومن باب الاستفهام: أين بيتك أزرك؟، ومن باب التمني: ليت أصدقائي كثيرون لا أخشى شيئاً، ومن باب العرض: ألا تسافر معي تكن سعيداً، ومن باب الترجي: لعلك تزورنا تصب خيراً، ومن العرض قول عنترة:
هلّا سألتِ الخيلَ يابنة مالك إن كنت جاهلةً بما لم تعلمي
يخبركِ من شهد الوقيعة أنّني أغشى الوغى وأعفُّ عند المغنم
فالفعل (يخبرك) جواب العرض (هلّا سالت). أما جواب الشرط (إن كنت جاهلة) فهو محذوف دلّ عليه الكلام السابق، والتقدير (إن كنت جاهلة فاسألي، وإن تسألي يخبرك). وتُبيّن هذه الأمثلة تحقق جواب الطلب في صيغ النهي والاستفهام والتمني والعرض والترجي. وفي هذا السياق يظهر جواب الطلب باعتباره نتيجة للعرض. وهذا التقدير يبرز العلاقة بين الشرط و جواب الطلب.
انتفاء رباط الشرط والسببية
إذا لم يرتبط الفعل الذي يأتي بعد الطلب برباط الشرط والسببية فإنه يرتفع. وتكون الجملة صفة أو في محل نصب حالاً. تقول: (اكتب مقالة توضح فيها رأيك في الشعر المعاصر). فالفعل (توضح) مرفوع، والجملة في محل نصب لـ (مقالة)؛ لأن رباط الشرط والسببية مفقود بين الطلب وما بعده. وتقول: (اترك ولدك يعبّر عن أفكاره) فالفعل (يعبّر) مرفوع والجملة في محل نصب، حال. ولا يكون حينئذ جواب الطلب متحققاً لغياب الرباط الشرطي السببي. وبانتفاء هذا الرابط لا يُجزَم الفعل لأن شرط جواب الطلب غير متوفر. ومن ثم لا ينعقد جواب الطلب بلا هذا الرباط.
الطلب المعنوي
ومن الطلب المعنوي قولهم: اتقى الله امرؤٌ فعل خيراً يُشَب عليه، لأن المعنى: ليتّق اللهَ امرؤ، فهو في ظاهره خبر، ومعناه أمر. ومن ذلك قوله تعالى: {هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله، وتجاهدون بأموالكم وأنفسكم …. يغفر لكم}. فمعنى (تؤمنون)، و (تجاهدون): آمنوا وجاهدوا، فظاهر الفعلين خبر، ومعناهما الأمر. وهنا يتحدد جواب الطلب على وفق هذا المعنى الأمرِي. وعليه فإن تركيب الجملة يحمل دلالة تؤهل تحقق جواب الطلب في سياق الطلب المعنوي. وبذلك يُفهم جواب الطلب في سياق الخبر الذي معناه الأمر.
حذف الأمر ودلالة فعل القول
وقد يحذف الأمر ويدل عليه فعل القول، من ذلك قوله تعالى: {قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم}. فالمعنى: قل لعبادي: أقيموا الصلاة وأنفقوا مما رزقكم الله… فقد أغنى فعل القول (وهو فعل أمر) عن مقول القول الذي فيه معنى الأمر، وجاء جواب الطلب ليدل أيضاً على مقول القول. وفي هذا المثال يتضح جواب الطلب على وجه بيّن. وتدل صيغة الجزم هنا على تحقق جواب الطلب.
خاتمة
يخلص البحث إلى أن جواب الطلب هو محور الجزم في هذا الباب، وأن تقدير الشرط إن وفعل الشرط شرطٌ لصحته. تبيّن الأمثلة أن سلامة الربط السببي تجعل جواب الطلب مجزوماً، وأن انتفاءه يرفع الفعل وتؤول الجملة إلى صفة أو حال. كما يثبت أن الأخبار ذات معنى الأمر تلتحق بالطلب اللفظي في إعمال جواب الطلب، وأن حذف مقول القول لا يُلغي دلالة جواب الطلب. وبذلك يُتاح للدارس تطبيق قاعدة جواب الطلب في التحليل والإنشاء بثقة وانضباط.
الأسئلة الشائعة
السؤال 1: ما هو المبدأ النحوي الأساسي الذي يحكم جزم الفعل في “جواب الطلب”، وكيف تشرح المقالة آلية عمله؟
الإجابة: المبدأ النحوي الأساسي الذي يحكم جزم الفعل في “جواب الطلب” هو تقدير أداة الشرط “إنْ” وفعل الشرط المحذوفين. تشرح المقالة هذه الآلية باعتبارها الإطار المنهجي لفهم القاعدة؛ فالجزم لا يحدث اعتباطاً بل لأنه يُنظر إلى الجملة على أنها تتضمن بنية شرطية كامنة. عندما نقول: “اتبعوني يحببْكم الله”، فإن التقدير النحوي هو: “إنْ تتبعوني يحببْكم الله”. فالفعل “يحببكم” لم يُجزم لأنه تلا الأمر “اتبعوني” مباشرةً، بل لأنه وقع جواباً لشرط مقدّر، وهذا الشرط هو المفهوم من الطلب المتقدم. وبهذا التقدير، يتحول الطلب (الأمر في هذا المثال) إلى سبب، ويتحول الفعل الذي يليه إلى نتيجة مترتبة عليه، وهو جوهر العلاقة الشرطية. تؤكد المقالة أن هذا التقدير هو الشرط اللازم لصحة الجزم، وأنه لا فرق في ذلك بين أنواع الطلب المختلفة، سواء كانت لفظية صريحة أم معنوية مفهومة من السياق.
السؤال 2: تفرّق المقالة بين “الطلب اللفظي” و”الطلب المعنوي”. اشرح الفرق الجوهري بينهما مع تقديم مثال لكل نوع من النص.
الإجابة: الفرق الجوهري بين “الطلب اللفظي” و”الطلب المعنوي” يكمن في صيغة التعبير عن الطلب.
- الطلب اللفظي هو ما يُعبَّر عنه بصيغ نحوية مخصصة للطلب بشكل مباشر وصريح. تعدد المقالة هذه الصيغ وتشمل: الأمر (مثل: {ذرهم يأكلوا})، والنهي (لا تعامل الناس بقسوة يحبوك)، والاستفهام (أين بيتك أزرْك؟)، والعرض (ألا تسافر معي تكنْ سعيداً)، والحض، والتمني، والترجي، والدعاء. في كل هذه الحالات، تكون أداة الطلب أو صيغته ملفوظة في الجملة.
- الطلب المعنوي، على النقيض، هو ما لا يستخدم صيغة طلب صريحة، بل يأتي في صورة جملة خبرية في ظاهرها، ولكن سياقها ومعناها يدلان على الطلب. المثال الذي تسوقه المقالة هو قولهم: “اتقى الله امرؤٌ فعل خيراً يُثَبْ عليه”، فالمعنى هنا ليس الإخبار بأن شخصاً ما اتقى الله، بل هو طلب ودعاء بأن يتقي الله، أي “لِيتَّقِ اللهَ امرؤٌ”. ومثال آخر من القرآن الكريم هو قوله تعالى: {هل أدلكم على تجارة… تؤمنون بالله… يغفرْ لكم}، حيث إن الفعلين “تؤمنون” و”تجاهدون” وردا بصيغة الخبر (المضارع المرفوع)، لكن معناهما الأمر، أي “آمنوا وجاهدوا”، ولذلك جاء جوابهما “يغفر لكم” مجزوماً. فالطلب هنا يُفهم من دلالة الكلام لا من لفظه.
السؤال 3: لماذا يُعَدُّ الأمر والنهي من أبرز أبواب تحقق “جواب الطلب” كما تشير المقالة؟ وكيف يظهر ذلك في الشواهد المذكورة؟
الإجابة: تعد المقالة أن الأمر والنهي هما من أبرز أبواب تحقق جواب الطلب وأكثرها شيوعاً، والسبب في ذلك أن معنى الطلب فيهما يكون في أوضح صوره وأكثرها مباشرة مقارنة ببقية أنواع الطلب كالاستفهام أو التمني. فالأمر يقتضي فعل شيء، والنهي يقتضي ترك شيء، وكلاهما يستدعي نتيجة مترتبة عليه بشكل منطقي مباشر.
ويظهر هذا الوضوح جلياً في الشواهد:
- في الأمر: قوله تعالى: {ذرهم يأكلوا ويتمتعوا}، فتركهم (الأمر) هو سبب مباشر لأكلهم وتمتعهم (النتيجة). وكذلك قوله: {فاتّبعوني يحببكم الله}، فاتّباع الرسول سبب مباشر لمحبة الله. وفي الشعر، قول عمرو بن الإطنابة: “مكانكِ تُحمدِي”، فالثبات في المكان (وهو اسم فعل أمر) هو السبب المباشر الذي يترتب عليه الحمد.
- في النهي: قولهم: “لا تعامل الناس بقسوة يحبوك”، فالامتناع عن القسوة (النهي) سبب مباشر لمحبتهم.
هذا الترابط السببي المباشر والواضح بين صيغة الأمر/النهي والفعل الذي يليه يجعل من السهل تقدير أداة الشرط (إن تذرهم يأكلوا / إن لا تعاملهم بقسوة يحبوك)، مما يجعل هذين البابين النموذج الأمثل لشرح القاعدة.
السؤال 4: ما هو “رباط الشرط والسببية”، وماذا يترتب نحوياً على انتفائه في الجملة التي تلي الطلب؟
الإجابة: “رباط الشرط والسببية” هو العلاقة المنطقية التي تجعل الفعل الثاني نتيجة حتمية ومترتبة على حدوث الفعل الأول (الطلب). بمعنى آخر، يجب أن يكون الطلب سبباً لحدوث الجواب. هذا الرباط هو الذي يبرر تقدير أداة الشرط “إنْ”، لأنه لا يمكن وجود بنية شرطية بدون علاقة سببية بين فعل الشرط وجوابه.
عندما ينتفي هذا الرباط، يترتب على ذلك أثران نحويان مهمان:
- رفع الفعل المضارع: لا يعود هناك مبرر لجزم الفعل، فيجب رفعه لعدم وجود ناصب أو جازم.
- تغير الإعراب الكلي للجملة: الجملة الفعلية التي تبدأ بالفعل المرفوع لا تكون جواباً للطلب، بل تأخذ موقعاً إعرابياً آخر، غالباً ما يكون صفة (نعتاً) أو حالاً.
وتوضح المقالة ذلك بمثالين:
- “اكتب مقالةً توضحُ فيها رأيك”: هنا الفعل “توضح” مرفوع، لأن التوضيح ليس نتيجة حتمية للكتابة، بل هو وصف لطبيعة المقالة المطلوبة. لذلك، تُعرب جملة “توضح فيها رأيك” في محل نصب صفة لـ “مقالة”.
- “اترك ولدك يعبّرُ عن أفكاره”: الفعل “يعبر” مرفوع، لأن تعبيره عن أفكاره يصف حال الولد أثناء تركه، وليس نتيجة مترتبة على الترك. فالجملة “يعبر عن أفكاره” في محل نصب حال.
إذن، انتفاء هذا الرباط يفك الارتباط الشرطي ويحول الجملة من علاقة “سبب ونتيجة” إلى علاقة “وصف أو بيان هيئة”.
السؤال 5: كيف يتحقق جواب الطلب بعد صيغ غير الأمر المباشر، كالاستفهام والعرض؟ استشهد بمثال من المقالة وبيّن آلية عمله.
الإجابة: يتحقق جواب الطلب بعد صيغ كالاستفهام والعرض بنفس الآلية التي يعمل بها مع الأمر، وهي تضمّن هذه الصيغ معنى الطلب الذي يصح معه تقدير الشرط والجزاء. فالاستفهام قد لا يكون لطلب المعرفة فقط، بل لطلب الفعل، والعرض هو طلب فعلٍ برفق ولين.
تستشهد المقالة بمثالين واضحين:
- في الاستفهام: “أين بيتك أزرْك؟”. هنا، الاستفهام عن مكان البيت ليس مجرد سؤال، بل هو مقدمة لطلب الزيارة. فالمعنى: “أخبرني عن بيتك لأزرك”، والتقدير الشرطي هو: “إنْ تخبرني عن بيتك أزرْك”. فجُزم الفعل “أزر” لأنه نتيجة مترتبة على الإجابة عن السؤال.
- في العرض: قول عنترة: “هلّا سألتِ الخيلَ يابنة مالك… يخبرْكِ من شهد الوقيعة”. الأداة “هلّا” تفيد العرض والتحضيض، وهي طلب للسؤال. والفعل “يخبرك” جاء مجزوماً لأنه النتيجة المترتبة على هذا الطلب. والتقدير، كما تشير المقالة، هو: “إنْ تسألي يخبرْكِ”. فالعرض هنا قام مقام فعل الشرط، والإخبار هو جوابه.
فالآلية ثابتة، وهي وجود طلب ضمني أو صريح يؤدي إلى نتيجة، مما يسمح بتقدير بنية الشرط والجزاء.
السؤال 6: تشير المقالة إلى حالة خاصة يغني فيها “فعل القول عن مقول القول”. وضّح هذه الحالة مستعيناً بالشاهد القرآني المذكور.
الإجابة: هذه الحالة الخاصة تحدث عندما يأتي فعل الأمر “قُلْ” متبوعاً بجواب طلب مجزوم مباشرة، دون ذكر الجملة التي أُمر بأن يقولها (مقول القول). في هذه البنية، يقوم فعل الأمر “قل” بنفسه مقام الطلب، ويقوم الجواب المجزوم بالدلالة على كل من النتيجة ومحتوى القول المحذوف.
الشاهد القرآني الذي أوردته المقالة هو قوله تعالى: {قُلْ لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا…}. التحليل النحوي هنا كالتالي:
- الفعل “قل” هو فعل أمر.
- مقول القول (أي الكلام الذي أُمر النبي بقوله) محذوف، وتقديره: “أقيموا الصلاة وأنفقوا”.
- الفعلان “يقيموا” و”ينفقوا” جاءا مجزومين (بحذف النون). وهذا الجزم ليس لأنهما مقول القول، بل لأنهما جواب الطلب.
- التقدير الكامل للجملة هو: “قل لهم أقيموا وأنفقوا، فإنْ تفعلوا ما أُمرتم به (أي إن تقيموا وتنفقوا) فإن الله يجازيكم…”، فالجواب هنا يدل على الجزاء المترتب على الامتثال للأمر المأمور بتبليغه.
وبهذا، يكون فعل الأمر “قل” قد أغنى عن ذكر مقول القول (الأمر المباشر)، وجاء الجواب “يقيموا” ليدل عليه وعلى نتيجته في آن واحد، وهو من أساليب الإيجاز البلاغي في القرآن.
السؤال 7: في ضوء المثال “اكتب مقالةً توضحُ فيها رأيك”، لماذا جاء الفعل “توضحُ” مرفوعاً وليس مجزوماً حسب تحليل المقالة؟
الإجابة: جاء الفعل “توضح” في هذا المثال مرفوعاً وليس مجزوماً لأن شرط الجزم الأساسي، وهو “رباط الشرط والسببية”، مفقود. تشرح المقالة أن الجزم في جواب الطلب لا يتحقق إلا إذا كان الفعل الثاني نتيجة مترتبة ومسببة عن الفعل الأول (الطلب). في جملة “اكتب مقالةً توضحُ فيها رأيك”، لا توجد هذه العلاقة السببية. ففعل “توضح” لا يمثل نتيجة لفعل “اكتب”، بل هو يصف وظيفة المقالة أو طبيعتها.
التقدير الشرطي هنا غير صحيح؛ فلا يصح أن نقول: “إنْ تكتب مقالةً توضحْ فيها رأيك”. المعنى الصحيح هو طلب كتابة مقالةٍ صفتها أنها توضح الرأي. ولهذا السبب، فإن الفعل “توضح” يبقى على أصله مرفوعاً، وتُعرب الجملة الفعلية “توضح فيها رأيك” في محل نصب صفة (نعت) للاسم النكرة قبلها “مقالةً”. ولو كان السياق يقتضي السببية، لكان الجزم صحيحاً، كما لو قيل: “اكتب مقالةً جيدةً تنلْ بها جائزة”، فهنا نيل الجائزة نتيجة مترتبة على كتابة المقالة الجيدة، فيصح الجزم.
السؤال 8: ما الدور التحليلي الذي يلعبه تقدير أداة الشرط “إنْ” وفعل الشرط في فهم بنية “جواب الطلب”؟
الإجابة: يلعب تقدير أداة الشرط “إنْ” وفعل الشرط دوراً تحليلياً محورياً وجوهرياً في فهم وتأصيل قاعدة “جواب الطلب”. فهذا التقدير ليس مجرد افتراض شكلي، بل هو الأداة المنهجية التي تكشف عن البنية المنطقية والنحوية العميقة للجملة. وتتمثل أهميته في النقاط التالية:
- توفير التعليل النحوي للجزم: يفسر هذا التقدير سبب جزم الفعل المضارع، حيث يربطه بقاعدة جزم جواب الشرط المعروفة، وهي قاعدة أصيلة ومستقرة في النحو العربي. فبدلاً من القول إن الفعل يُجزم لمجرد مجيئه بعد الطلب، يقدم التحليل سبباً أعمق وهو أنه جواب لشرط مقدر.
- معيار للتمييز بين الجزم والرفع: يعمل هذا التقدير كـ”اختبار” لصحة الجزم. فإذا صح المعنى عند تقدير “إنْ” وفعل الشرط، وجب الجزم. وإذا فسد المعنى أو لم يستقم، كما في مثال “اكتب مقالة توضح فيها رأيك”، انتفى الجزم ووجب الرفع. فهو بذلك أداة دقيقة للفرز بين الحالات.
- إبراز العلاقة السببية: تقدير الشرط يسلّط الضوء على “رباط الشرط والسببية” الذي تؤكد عليه المقالة، حيث يجعل من الطلب سبباً (فعل الشرط المقدر) ومن الفعل المجزوم نتيجة له (جواب الشرط)، مما يكشف عن البنية المنطقية للجملة.
السؤال 9: كيف توسع المقالة مفهوم “الطلب” ليشمل ما هو أبعد من صيغة الأمر الصريحة، وما أثر ذلك على تطبيق القاعدة؟
الإجابة: توسع المقالة مفهوم “الطلب” بشكل كبير ليتجاوز صيغة فعل الأمر المباشر، ويشمل كل ما يحمل معنى الطلب دلالياً، سواء كان ذلك بصيغة لفظية معينة أو بمعنى يُفهم من السياق. هذا التوسع له أثر مباشر على نطاق تطبيق القاعدة، حيث يجعلها أكثر شمولاً ودقة. ويتجلى هذا التوسع في محورين رئيسيين:
- تعدد الطلب اللفظي: لا تحصر المقالة الطلب في الأمر والنهي فقط، بل تعدد ثمانية أنواع من الطلب اللفظي هي: الأمر، والنهي، والدعاء، والاستفهام، والعرض، والحض، والتمني، والترجي. هذا التعداد يوضح للدارس أن أي صيغة من هذه الصيغ يمكن أن تكون منطلقاً لجواب طلب مجزوم إذا توفرت الشروط.
- إدراج الطلب المعنوي: وهو التوسع الأهم، حيث تبيّن المقالة أن الطلب يمكن أن يُفهم من جملة خبرية لا تحتوي على أي أداة طلب. فقوله تعالى {تؤمنون بالله… يغفرْ لكم} يُعامل نحوياً كقولنا “آمنوا… يغفرْ لكم”، لأن المعنى هو الحث والأمر.
أثر هذا التوسع هو أنه ينقل تركيز المحلل النحوي من شكل الصيغة (اللفظ) إلى وظيفتها ومعناها (الدلالة). فالقاعدة لا تطبَّق بشكل آلي على صيغ محددة، بل بناءً على تحقق معنى “الطلب” الذي يصح أن يكون سبباً لنتيجة، مما يمنح الدارس أداة تحليلية أعمق وأكثر مرونة.
السؤال 10: وفقاً لخاتمة المقالة، ما هي الفائدة التحليلية والتطبيقية التي يكتسبها دارس النحو من فهم قاعدة “جواب الطلب” بعمق؟
الإجابة: تلخص خاتمة المقالة الفائدة المكتسبة في تمكين الدارس من امتلاك أدوات تحليلية دقيقة وتطبيقية تمكنه من التعامل مع التراكيب اللغوية بثقة وانضباط. ويمكن تفصيل هذه الفائدة في النقاط التالية:
- القدرة على التحليل الدقيق: فهم آلية تقدير الشرط والرباط السببي يمنح الدارس القدرة على تحليل سبب الجزم أو الرفع تحليلاً منطقياً وعلمياً، بدلاً من الاعتماد على الحفظ المجرد.
- التمييز بين التراكيب المتشابهة: يصبح الدارس قادراً على التمييز بين جملة يكون فيها الفعل جواباً للطلب (اذهب إلى المكتبة تجدْ بغيتك) وجملة أخرى يكون فيها الفعل صفة أو حالاً (اذهب إلى المكتبة تضمُّ كتباً نادرة). هذا التمييز ضروري للفهم الصحيح للنص وإعرابه.
- فهم الأساليب البلاغية: إدراك مفهوم “الطلب المعنوي” و”إغناء فعل القول عن مقوله” يفتح الباب أمام فهم أساليب الإيجاز والبلاغة في النصوص الرفيعة، كالقرآن الكريم والشعر، حيث لا تأتي المعاني دائماً في قوالب مباشرة.
- التطبيق في الإنشاء: على المستوى التطبيقي، يكتسب الدارس القدرة على استخدام هذا التركيب النحوي في كتابته وإنشائه بشكل سليم، فيستطيع صياغة جمل فيها علاقة سببية بين طلب ونتيجته باستخدام أسلوب جزم جواب الطلب، مما يثري لغته ويعزز دقتها.
باختصار، الفائدة تتجاوز مجرد معرفة القاعدة إلى امتلاك منهجية في التفكير النحوي والتحليل الدلالي.