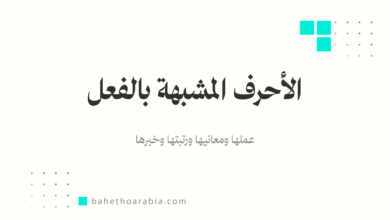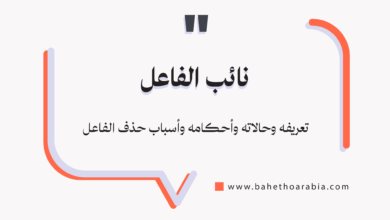الاستثناء والمستثنى بإلا: تعريفه وأركانه وأدواته وأنواعه وأحكامه وإعرابه
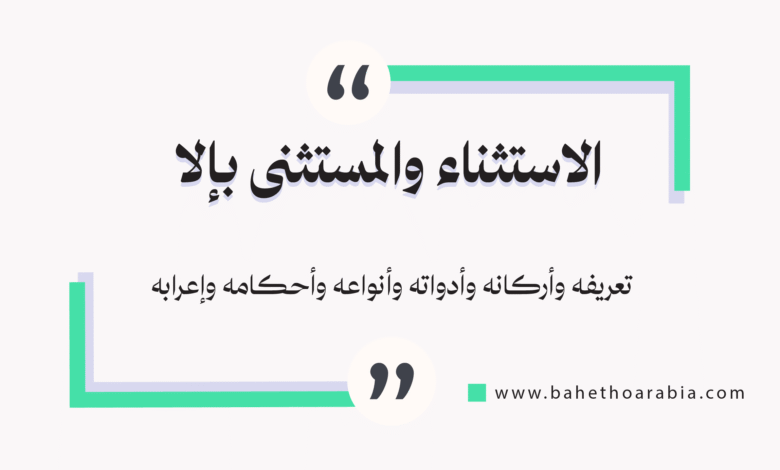
يتناول هذا الدرس موضوعاً محورياً لطلبة العربية، هو باب الاستثناء. سنتناول فيه: تعريف الاستثناء، وأدواته، وأنواعه، وأحكامه، والمستثنى بإلّا وأحواله، وإعراب المستثنى بإلّا، والوصف بإلّا، والاستثناء بغيرٍ وسوى، والاستثناء بخلا وعدا وحاشا، والاستثناء بـ ليس، ولا يكون، وشبه الاستثناء.
تعريف الاستثناء
الاستثناء: إخراج العنصر الواقع بعد أداة الاستثناء من الحكم المسند إلى ما قبلها، مثل: (زارني الرِّفَاقُ إلَّا زيداً)؛ إذ جُعِل ما بعد (إلّا) خارجاً من حكم ما قبلها، وهو الزيارة.
أركان الاستثناء
للاستثناء ثلاثة أركان:
أ – المستثنى منه، وهي في المثال السابق كلمة (الرفاق).
ب – المستثنى، وهو (زيد).
ج – أداة الاستثناء، وهي (إلّا).
وفي المثال المذكور حُكِم على المستثنى منه بحكمٍ عام، ثم خُصّ منه المستثنى، والحكم هنا هو (الزيارة).
أدوات الاستثناء
أدوات الاستثناء ثمانٍ: إلّا، غير، سوى، خلا، عدا، حاشا، ليس، لا يكون.
أنواع الاستثناء
للاستثناء خمسة أنواع هي:
١ – الاستثناء المتصل: وهو ما اتحد فيه جنس المستثنى وجنس المستثنى منه، نحو: (نَجَحَ الطُّلَّابُ إلَّا سَعْداً). فـ سَعْدٌ داخل في عموم الطلاب، وقد كان الحكم (النجاح) شاملاً، ثم خصصناه بإخراج المستثنى (سعداً)، فزال عمومه وصار خاصاً ببعض الطلاب، ولذلك فغاية الاستثناء المتصل هي (التخصيص بعد التعميم).
٢ – الاستثناء المنقطع: وهو ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منه، نحو: (وَصَلَ الطُّلَّابُ إلَّا كُتُبَهُمْ، ورحلَ التُّجَّارُ إلَّا بضائعَهُمْ). فالمستثنى ليس جزءاً من المستثنى منه، ولذلك لم يقع هنا تخصيصٌ لعموم؛ إذ لا معنى لاستثناء شيء من غير جنسه، وإنما المراد الاستدراك؛ فالمعنى: وصل الطلاب لكن كتبهم لم تصل. ويُشترط في المنقطع وجود صلةٍ بين الطرفين تُنشئ مناسبةً ذهنيةً بينهما؛ فالكتب ليست من الطلاب، لكنها ملازمة لهم في التصور، ومن هنا حسُنَ الاستدراك دفعاً لتوهّم موافقتها لهم بحسب العادة.
٣ – الاستثناء التام: وهو ما استكمل الأركان الثلاثة، سواء أكان الكلام مثبتاً أم منفياً.
٤ – الاستثناء المُفَرَّغ: وهو ما حُذِف فيه المستثنى منه، وتقدّمه نفيٌ أو نهيٌ أو استفهام، كقوله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ} آل عمران: ١٤٤.
٥ – الاستثناء الموجب: وهو ما خلا من النفي وشبهه، نحو: (زُرْتَ الآثَارَ إلَّا قلعةَ الحصنِ).
٦ – الاستثناء غير الموجب: وهو ما صُدِّر بـ
• نفي، نحو: (ما جاءَ أحدٌ إلَّا زيدٌ أو زيداً).
• أو شبه النفي، وهو النهي أو الاستفهام، نحو: (لا تَزُرْ أحداً إلَّا زيداً)، أو (هل جاءَ أحدٌ إلَّا زيدٌ أو زيداً؟).
أحكام الاستثناء
- من شروط المستثنى منه أن يكون معرفةً أو نكرةً مفيدة، وتتحقق الإفادة بـ
• الإضافة، نحو: (وصلَ رفاقُ الكفاحِ إلَّا خالداً).
• الوصف، نحو: (جاءني رجالٌ كرامٌ إلَّا واحداً منهُمْ).
• الوقوع في حيّز النفي أو النهي أو الاستفهام:
أ. النفي، نحو: (لم أرَ أحداً إلَّا زيداً).
ب. النهي، نحو: (لا تُصادِقْ أحداً إلَّا سعداً).
ج. الاستفهام، نحو: (هل رأيتَ أحداً إلَّا خالداً؟). - ويُشترط في المستثنى أن يكون معرفة، كما تقدّم في الأمثلة، أو نكرةً مختصّة، نحو: (جاءَ القومُ إلَّا رجلاً مريضاً)، و(وصَل الصَّحْبُ إلَّا واحداً منهُمْ).
أحوال المستثنى بإلّا
للمستثنى بـ إلّا ثلاثُ حالات:
١ – وجوب نصبه على الاستثناء، وذلك في ثلاثة مواضع:
أ – إذا ورد الاستثناء في كلامٍ تامٍّ موجب، نحو: (جاءَ القومُ إلَّا زيداً).
ب – إذا تقدّم المستثنى على المستثنى منه، سواء أكان الكلام موجباً، نحو: (جاءَ إلَّا سعيداً المسافرونَ)، أم كان سالباً كما في قول الكميت بن زيد:
وما لي إلَّا آلَ أحمدَ شيعةٌ * وما لي إلا مذهبَ الحقِّ مذهبُ
فهنا (آل) مستثنى بإلّا منصوب وجوباً لتقدّمه على المستثنى منه (شيعة)، ولولا هذا التقدّم لجاز فيه النصب والإتباع على البدلية؛ لأن الكلام تامٌّ منفيّ.
ج – إذا كان الاستثناء منقطعاً، نحو: (وصلَ المسافرونَ إلا حقائبَهُمْ)، وكقوله تعالى: {مَا أَنْزَلْنَا عَلَيكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى} سورة طه: ٢ – ٣، وكقوله تعالى: {مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ} سورة النساء: ١٥٦.
ويُجِيز بنو تميم البدل في الاستثناء المنقطع، وعلى مذهبهم جاء قول الراجز عامر بن الحارث:
في بلدةٍ بِهَا أنيسُ * إلَّا اليَعَافِيرُ وإلَّا العِيسُ
الشاهد في البيت: إبدال (اليعافير، والعيس) من (أنيس) مع أنهما ليسا من جنسه، و(إلّا) الثانية تأكيد للأولى.
٢ – جواز الرفع والنصب؛ أي جواز إتباعه للمستثنى منه على البدلية أو نصبه على الاستثناء، وذلك إذا جاء المستثنى تالياً للمستثنى منه في كلامٍ تامٍّ منفيٍّ أو شبه منفيّ.
• المنفيّ، كقوله تعالى: {مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلاً مِنْهُمْ} سورة النساء: ٦٥؛ وقد قُرِئت: (قليلاً) بالنصب على الاستثناء، و(قليلٌ) بالرفع على البدلية من المستثنى منه، وهو واو الجماعة في محل رفع فاعل.
• شبه المنفيّ، كقوله تعالى: {وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ} سورة آل عمران: ١٣٥.
• وقد يكون النفي معنوياً، كما في قول الأخطل:
وبالصَّريمةِ منهُمْ مَنْزِلٌ خَلَقٌ * عَافٍ تَغَيَّرَ إلَّا النُّؤْيُ والوَتِدُ
الشاهد: تضمّن الشاعر معنى النفي، فجازت البدلية من فاعل (تغيّر) وهو الضمير المستتر؛ لأن معنى تغيّر: لم يبقَ على حاله.
- فإن جُرَّ المستثنى منه بحرفِ جرٍّ زائدٍ؛ كان البدل من محلّه لا من لفظه؛ فيقال: (ما جاء مِنْ أحدٍ إلَّا زيدٌ أو زيداً).
- ولا يجوز الجرّ على البدلية من اللفظ؛ لأن زيادة الجار مسوّغها توكيد النفي، وما بعد (إلّا) مثبتٌ غير منفيّ، فلا تُزاد عليه حروف الجر، والبدل على نية تكرار العامل؛ أي إن العامل في البدل مُقدَّر مماثلٌ للعامل المذكور.
إعراب المستثنى بإلّا
يُعرب المستثنى بإلّا بحسب العوامل في موضع الاستثناء المُفرَّغ، أي عند حذف المستثنى منه مع بناء الكلام على نفيٍ أو ما يشبهه (نهيٍ أو استفهام).
• النفي، نحو: (ما جاءَ إلَّا زيدٌ)، زيد: فاعل.
• النهي، نحو: (لا تفعلْ إلَّا الخيرَ)، الخير: مفعولٌ به.
• الاستفهام، نحو: (هلْ يفوزُ إلَّا المُجِدُّونَ؟)، المجدّون: فاعل.
وسُمّي هذا النوع مُفرَّغاً؛ لأن ما قبل (إلّا) قد تفرّغ للعمل فيما بعدها.
الوصف بإلّا
- قد تُحمل (إلّا) على (غير) فيوصف بها، كما حُمِلَت (غير) على (إلّا) فاستُثني بها؛ فتُعرب (إلّا) مع ما بعدها صفةً لما قبلها، كقوله تعالى: {لَو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} سورة الأنبياء: ٢٢.
- وقد يصح الوصف والاستثناء معاً، كما في الحديث: «الناس هلكى إلا العالِمون، والعالِمون هلكى إلا العاملون، والعاملون هلكى إلا المخلصون». فإن رُفع ما بعد (إلّا) كانت (إلّا) وما بعدها في محل رفعٍ نعتاً لـ الناس، والتقدير: (الناس غير العالمين هلكى …)، وإن نُصب كان ما بعد (إلّا) مستثنى منصوباً.
الاستثناء بـ غيرٍ وسوى
الأصل في (غير) و(سوى) أن يُستعملَا للوصف، فنقول: (جاء رجلٌ غيرُكَ أو سواكَ)، ثم حُمِلَا على (إلّا) فجرى بهما الاستثناء، ويكون ما بعدهما مجروراً بالإضافة دائماً، وهما اسمان يُعطيان إعراب ما يُعرب به الاسم بعد (إلّا) وتنسحب عليهما أحكامه كلّها، فنقول:
- جاء الصحبُ غيرَ زيدٍ: (غيرَ) واجبة النصب؛ لأن الاستثناء تامٌّ موجب.
- ما جاءَ غيرَ زيدٍ الطلابُ: واجب النصب؛ لتقدّم المستثنى على المستثنى منه.
- جاء المسافرون غيرَ أمتعتهم: واجب النصب على الاستثناء المنقطع.
- ما جاء الصحبُ غيرُ أو غيرَ زيدٍ: يجوز الرفع على البدلية أو النصب؛ لأنه استثناء تامٌّ منفيّ.
- ما جاء غيرُ زيدٍ: مرفوع على أنه فاعل؛ لأن الاستثناء مُفرغ.
وجميع ما سبق جارٍ في (سوى). ويرى بعض النحاة أن (سوى) ظرفٌ منصوب على الظرفية المكانية بمعنى (بدلَ أو مكانَ)، غير أن حملها على (غير) في باب الاستثناء أسهل وأيسر.
الاستثناء بـ خلا وعدا وحاشا
يُستثنى بـ (خلا، عدا، حاشا) لتضمّنها معنى (إلّا)، ويجوز في المستثنى بها وجهان:
١ – الجر على اعتبارها حروف جر شبيهة بالزائدة لا تحتاج مع مجرورها إلى تعليق، نحو: (جاءَ الرِّفاقُ خلا زيدٍ)، زيد: اسمٌ مجرورٌ لفظاً منصوبٌ تقديراً على الاستثناء.
٢ – النصب على اعتبارها أفعالاً ماضية، وفاعلها ضميرٌ مستترٌ وجوباً تقديره هو – خلافاً للأصل –، والمستثنى بها مفعولٌ به منصوب، والجملة في محل نصب حال من المستثنى منه، نحو: (جاءَ الرفاقُ خلا زيداً)، أي خالين من زيد.
فإذا اقترنت بها (ما) المصدرية تعيّن نصب ما بعدها وامتنع الجر؛ لأن (ما) المصدرية حرف، فلا يدخل حرفٌ على حرف؛ لذا يمتنع حمل هذه الأدوات على الحرفية عند اقترانها بـ (ما)، ويجب حملها على الأفعال الماضية، كقول الشاعر:
تُسَلُّ النَّدَامى ما عداني فإنَّني * بكلِّ الَّذي يَهوى نديمي مولَعُ
الشاهد في البيت: دخول (ما) المصدرية على (عدا) فأُعرب فعلاً ماضياً، ولذلك اتصلت به نون الوقاية، والياء في محل نصب مفعولٍ به، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره هو – خلافاً للأصل –، والجملة في محل نصب حال من الندامى.
- ومما تختصّ به (حاشا) أنها تستعمل للتنزيه والاستثناء، فنقول: (يُغْرِقُ الأطفالَ في الإيذاء حاشا زيداً)، ولا يُقال: (نفعل الخيرَ حاشا زيداً)؛ لأن فعل الخير لا يُنزَّه عنه الإنسان.
- وقد تُستعمل للتنزيه دون الاستثناء، فيقال: (حاشَ للَّهِ أو حاشا للَّهِ، أو حاشا اللَّهِ)، فتُثبت ألفها أو تُحذف؛ فتُعرب مفعولاً مطلقاً، وما بعدها مضافاً إليه، أو جارّاً ومجروراً متعلقين بها. وتُبنى إذا جاءت غير منوّنة ولا مضافة، نحو: (حاشَ لله أو حاشا لله)، وتُعرب في غير ذلك.
- كما تُستعمل فعلاً متعدّياً بمعنى (أستثني)، كقول النابغة الذبياني:
ولا أرى فاعلاً في النَّاسِ يشبهه * ولا أُحاشي منَ الأقوامِ مِنْ أَحَدِ - وتأتي بمعنى (جانَبَ)، نحو: (حاشَى العربَ أن ينسَوا فلسطينَ)، والتقدير: حاشَى العربَ نسيانُ فلسطين.
وهنا جملة (ينسوا فلسطين) جملةٌ فعلية، صلةٌ للموصول الحرفي، لا محلّ لها من الإعراب، و(أن) مع صلتها في تأويل مصدرٍ مرفوعٍ على أنه فاعلٌ للفعل (حاشى).
الاستثناء بـ (ليس)، و(لا يكون)
(ليس) و(لا يكون): فعلان ناقصان يرفعان الاسم وينصبان الخبر، وقد يَرِدان بمعنى (إلّا) فيُستثنى بهما، نحو: (جاءَ الطُّلَّابُ ليس زيداً أو لا يكون زيداً)، والمنصوب خبرٌ لهما واجبُ النصب، واسمهما ضميرٌ مستترٌ وجوباً تقديره هو، والجملة حالية من المستثنى منه.
ملحوظة: لا يُستعمل فعل (يكون) في الاستثناء إلا بصيغة المضارع، ولا يُستعمل معه من أدوات النفي غير (لا).
تنبيه: رأى بعض النحاة أن استعمال (خلا، عدا، حاشا، ليس، لا يكون) في باب الاستثناء نقلها من الفعلية إلى الحرفية، فلا تطلب فاعلاً ومفعولاً أو اسماً وخبراً، وأن المنصوب بعدها منصوبٌ على الاستثناء؛ وهذا رأيٌ وجيه، غير أن جمهور النحاة على الرأي الأول الذي جرينا عليه في الإعراب.
شبه الاستثناء
يكون شبه الاستثناء بكلمتين:
الأولى: (بَيْدَ) بمعنى (غير)، ولا تُستعمل في الاستثناء المنقطع، وتلازم النصب على شبه الاستثناء، كما تلازم الإضافة إلى المصدر المؤوّل من (أنَّ) ومعموليها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ بَيْدَ أَنِّي مِنْ قُرَيشٍ».
الثانية: (لا سيما): مؤلّفة من (لا) النافية للجنس و(سي) بمعنى (مثل) مضافة إلى (ما). وهي تركيب يُؤتى به لترجيح ما بعدها على ما قبلها في حكمٍ مشترك، نحو: (أُحِبُّ الطُّلَّابَ ولا سِيَّمَا المجتهدينَ).
وللاسم الواقع بعدها أوجهٌ إعرابية متعدّدة نقتصر منها على الأيسر:
١ – إن كان الاسم نكرة؛ جاز الجر والرفع والنصب، فنقول: (أُحِبُّ العملَ ولا سيَّما عملٍ أو عملٌ أو عملاً يَعود بالنفعِ على الأُمَّة). و(لا) في جميع ذلك نافيةٌ للجنس تعمل عمل (إن)، وخبرها محذوف تقديره كائنٌ أو موجود، وتفصيل الإعراب كالآتي:
أ – في الجر (وهو أرجحها): سي: اسم (لا) منصوب، ما: زائدة، عملٍ: مضافٌ إليه مجرور.
ب – في الرفع: سي: اسم (لا) منصوب، ما: اسمٌ موصول في محل جر بالإضافة، عمل: خبرٌ لمبتدأ محذوف تقديره: هو عمل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب، والتقدير: لا مثلَ الذي هو عمل … موجود.
ج – في النصب: سي: اسم (لا) مبني على الفتح في محل نصب، ما: زائدة كافّة لـ (سي) عن الإضافة، عملاً: تمييزٌ لـ (سي) منصوب.
٢ – إن كان الاسم معرفة؛ جاز رفعه وجرّه على الوجهين السابقين، وامتنع نصبه على التمييز؛ لأن شرط التمييز أن يكون نكرة.
الأسئلة الشائعة
١) ما تعريف الاستثناء وما أركانه الأساسية مع أمثلة تطبيقية؟
الاستثناء هو إخراج ما بعد أداة الاستثناء من حكم ما قبلها، أي نقضُ عموم الحكم المسند إلى المستثنى منه عن عنصر مخصوص هو المستثنى. أركانه ثلاثة: المستثنى منه (المحكوم عليه ابتداءً)، وأداة الاستثناء (إلّا وأخواتها)، والمستثنى (العنصر المخرج). مثال: زارني الرفاقُ إلا زيداً. هنا: الرفاقُ مستثنى منه، إلا: أداة، زيداً: مستثنى. الحكم الأول (الزيارة) شمل الرفاق كافة، ثم أُخرِج منه زيد. وتنبني سلامة التحليل على تمييز تمام الكلام (وجود المستثنى منه صراحة) من عدمه، وعلى تحديد كون السياق موجباً أو منفيّاً أو شبيهاً بالنفي؛ إذ تتغيّر الأحكام الإعرابية تبعاً لذلك.
٢) ما الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع دلالةً وإعراباً؟
- من جهة الدلالة:
- المتصل: اتحاد جنس المستثنى والمستثنى منه، فيُفيد تخصيصاً بعد تعميم؛ نحو: نجح الطلابُ إلا سعداً. فالمعنى: حصل النجاح لعموم الطلاب ثم خُصّ منه سعد.
- المنقطع: اختلاف الجنس؛ فيُفيد استدراكاً لا تخصيصاً؛ نحو: وصل الطلابُ إلا كتبَهم. المعنى: وصل الطلاب، لكن الكتب لم تصل.
- من جهة الإعراب بإلّا:
- في المتصل: الإعراب يتنوع بحسب تمام الكلام ونفيه؛ فقد يجب النصب (في التام الموجب)، وقد يجوز الرفع على البدلية أو النصب (في التام المنفي أو شبهه).
- في المنقطع: المشهور وجوب نصب المستثنى، ويُروى جواز البدلية لغةً لبني تميم، كقولهم: في بلدةٍ بها أنيسٌ إلا اليعافيرُ وإلا العيسُ.
الفهم الدلالي الدقيق يوجّه الإعراب، ويمنع توهّم تخصيصٍ حيث لا اتحادَ جنس.
٣) متى يجب نصب المستثنى بإلا، ومتى يجوز الوجهان، ومتى يُعرب حسب العوامل؟
- يجب النصب على الاستثناء في ثلاثة مواضع:
- إذا كان الكلام تامّاً موجباً: جاء القومُ إلا زيداً.
- إذا تقدّم المستثنى على المستثنى منه، سواء أكان الكلام موجباً أم منفيّاً: جاءَ إلا سعيداً المسافرونَ، و”وما لي إلا آلَ أحمدَ شيعةٌ”.
- إذا كان الاستثناء منقطعاً: وصل المسافرونَ إلا حقائبَهم.
- يجوز الرفع أو النصب (البدلية أو الاستثناء) إذا وقع المستثنى بعد المستثنى منه في كلام تام منفي أو شبه منفي: ما جاء أحدٌ إلا زيدٌ/زيداً، وهل حضر أحدٌ إلا خالدٌ/خالدًا؟
- يُعرب حسب العوامل في الاستثناء المفرغ، حيث يُحذف المستثنى منه ويتقدّم نفي أو نهي أو استفهام: ما جاء إلا زيدٌ (زيد: فاعل)، لا تفعل إلا الخيرَ (الخير: مفعول به)، هل يفوز إلا المجدون؟ (المجدون: فاعل).
٤) ما الاستثناء المُفرَّغ؟ وما شروطه وأمثلته الدقيقة؟
الاستثناء المفرغ هو ما حُذف فيه المستثنى منه، وتقدّمه نفي أو شبهه (نهي، استفهام)، فتتفرّغ أداة الاستثناء للعمل فيما بعدها، ويُعرب الاسم الواقع بعد إلا على مقتضى موقعه من العامل السابق:
- في النفي: ما حضر إلا محمدٌ (محمد: فاعل).
- في النهي: لا تقلْ إلا الحقَّ (الحق: مفعول به).
- في الاستفهام: هل رأيتَ إلا عليّاً؟ (عليّاً: مفعول به).
شرطه الأساس: حضور أداة نفي أو نهي أو استفهام مع حذف المستثنى منه لفظاً. ووجه التسمية أن العامل قبل إلا تفرّغ فسلّط عمله على ما بعدها، فلا محلّ للاستثناء النحوي المعتاد، بل يُبنى الإعراب على العلاقات الأصلية بين العامل والاسم.
٥) كيف يكون الإعراب إذا جُرَّ المستثنى منه بحرف جرّ زائد؟ ولماذا لا يجوز الجر بعد إلا؟
إذا سُبق المستثنى منه بحرف جر زائد (كـ”من” مع النفي: ما جاءني من أحدٍ)، كان البدل بعد إلا من المحل لا من اللفظ، لأن زيادة الحرف تؤكد النفي في اللفظ لا في المحل الإعرابي. لذا يقال: ما جاء من أحدٍ إلا زيدٌ/زيداً؛ فالرفع على البدلية من محل “أحدٍ” فاعلاً، والنصب على الاستثناء. ولا يجوز الجر بعد إلا على البدلية من اللفظ؛ لأن ما بعد إلا مثبتٌ لا منفي، وزيادة حرف الجر لا تدخل على مثبت. فالأصل أن البدل يُنزل منزلة تكرار العامل، والعامل المثبت لا يجرّ الاسم بعدها بزيادة حرف.
٦) كيف يُستعمل “غير” و”سوى” في الاستثناء؟ وما الفرق بينهما وبين “إلا”؟
- “غير” و”سوى” في الأصل صفتان، ثم حُمِلتا على “إلا” فاستُثني بهما. ما بعدهما يُجرّ بالإضافة دائماً: غيرَ زيدٍ، سوى خالدٍ.
- يعربان إعراب المستثنى بإلا حكماً:
- في التام الموجب: جاء الصحبُ غيرَ زيدٍ (واجب النصب).
- مع التقدّم: ما جاءَ غيرَ زيدٍ الطلابُ (واجب النصب).
- في المنقطع: جاء المسافرون غيرَ أمتعتِهم (واجب النصب).
- في التام المنفي: ما جاء الصحبُ غيرُ/غيرَ زيدٍ (يجوز الرفع على البدلية أو النصب).
- في المفرغ: ما جاء غيرُ زيدٍ (غيرُ: فاعل).
- من جهة التصنيف: هما اسمان، وبعضهم يعدّ “سوى” ظرفاً مكانياً بمعنى “بدل/مكان”، لكن شيوع حملها على “غير” في باب الاستثناء أوضح وأيسر في التطبيق المدرسي. الفارق العملي عن “إلا” أن “غير/سوى” يدخلان في علاقات إعرابية بوصفهما اسماً متمكّناً، مع لزوم إضافة اللاحق لهما مجروراً.
٧) ما أوجه الاستثناء بـ”خلا، عدا، حاشا”؟ ومتى تُعدّ أفعالاً أو حروف جر؟
- يجوز فيهما وجهان:
- الجر: باعتبارها حروف جر شبيهة بالزائدة، نحو: جاء الرفاقُ خلا زيدٍ (زيدٍ: مجرور لفظاً، منصوب تقديراً على الاستثناء).
- النصب: باعتبارها أفعالاً ماضية، وفاعلها ضمير مستتر وجوباً، والمستثنى مفعول به: جاء الرفاقُ خلا زيداً، أي خالين من زيد.
- إذا اقترنت بـ”ما” المصدرية تعيّن كونها أفعالاً وامتنع الجر: تُسَلُّ الندامى ما عداني…؛ إذ لا يدخل حرف على حرف، فتكون “عدا” فعلاً ماضياً، والياء مفعولاً به، والجملة في محل حال.
- تختص “حاشا” بأنها قد تأتي للتنزيه والاستثناء: يُغرق الأطفالَ في الإيذاء حاشا زيداً، وقد تأتي للتنزيه الخالص: حاشَ للهِ/حاشا للهِ، فتعرب بحسب تركيبها (مفعولاً مطلقاً، أو يتعلّق بها جار ومجرور). وقد تُستعمل فعلاً متعدّياً بمعنى “أستثني”: ولا أُحاشي من الأقوام من أحدِ.
٨) ما ضابط استعمال “ليس” و”لا يكون” في باب الاستثناء؟ وكيف يكون إعرابهما؟
يرِدان على سبيل الاستثناء بمعنى “إلا” في سياق الجملة التامة: جاء الطلابُ ليس زيداً/لا يكون زيداً. هما فعلان ناقصان: يرفعان اسماً مستتراً وجوباً (هو)، وينتصب ما بعدهما على الخبر وجوباً، والجملة الفعلية في محل نصب حال من المستثنى منه. القيود الضابطة:
- لا يستعمل “يكون” هنا إلا بصيغة المضارع مع “لا” النافية: لا يكون.
- النصب لازم فيما بعدهما لأنه خبر الفعل الناقص، لا مستثنى اصطلاحاً في هذا التحليل.
وقد ذهب بعض النحاة إلى حرفية هذه الأدوات عند الاستثناء وأن المنصوب بعدها على الاستثناء مباشرة، غير أن جمهور البصريين يجرون على التحليل الفعلي الناقص.
٩) ما المقصود بالوصف بـ”إلا”؟ وكيف نميّزه من الاستثناء في السياق؟
قد تُحمَل “إلا” على “غير” فتكون في قوة الصفة، فيُجعل ما بعدها وصفاً لما قبلها: لو كان فيهما آلهةٌ إلا اللهُ لفسدتا؛ فـ”إلا اللهُ” في قوة “غيرِ الله”، ويتجه المعنى إلى نفي التعدّد. ومواضع الالتباس قد تحتمل الوجهين (الوصف والاستثناء)، كما في الحديث: الناس هلكى إلا العالمون…؛
- إن رفعت: كانت “إلا” وما بعدها في محل رفع نعتاً: الناسُ غيرُ العالمين هلكى.
- وإن نصبت: كان ما بعد “إلا” مستثنى منصوباً.
الترجيح دلالي وسياقي: إذا قصد نعت الجنس وتقييده، فالوصف أليق؛ وإذا قصد إخراج أفراد مخصوصة من حكم عام، فالاستثناء أولى.
١٠) ما معنى شبه الاستثناء؟ وكيف تُعرب “بيد” و”لا سيما”؟
- شبه الاستثناء تراكيب تؤدي معنى الترجيح أو الاستدراك القريب من الاستثناء دون أدواته الصريحة.
- “بيدَ”: بمعنى “غير”، وتلازم النصب، وتُضاف إلى مصدر مؤوّل من “أنَّ” ومعموليها: أنا أفصح العرب بيدَ أني من قريشٍ. لا تُستعمل للمنقطع، لأنها في معنى الوصف المقيد.
- “لا سيما”: تركيب للترجيح في حكم مشترك، مؤلف من “لا” النافية للجنس، و”سي” بمعنى “مثل”، مضافة إلى “ما”.
- إن كان الاسم بعدها نكرة: جاز الجر والرفع والنصب. أمثلة:
- الجر (أفصحها): أحبّ العملَ ولا سيَّما عملٍ نافعٍ.
- الرفع: أحبّ العلمَ ولا سيَّما علمٌ نافعٌ (على خبر لمبتدأ محذوف).
- النصب: أحبّ القراءةَ ولا سيَّما كتاباً نافعاً (تمييز لـ”سي”).
- إن كان معرفة: يَحسُن الجر والرفع، ويمتنع النصب على التمييز لشرط تنكيره.
المعيار: يُستحسن الجر مع النكرة لما فيه من سلاسة واطراد، ويُراعى في غيره مقتضى السياق.
- إن كان الاسم بعدها نكرة: جاز الجر والرفع والنصب. أمثلة: