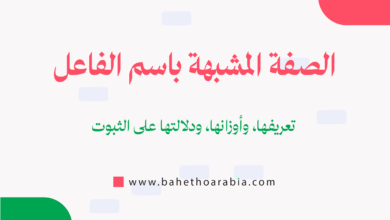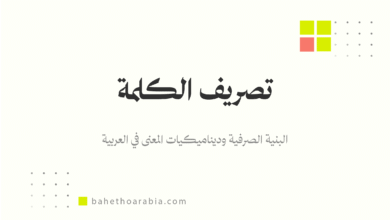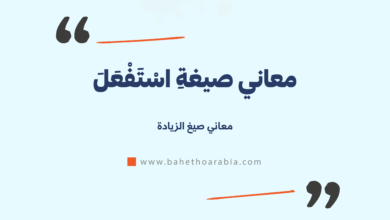اسم المفعول: تعريفه، وصياغته، وتحليل أبرز صوره
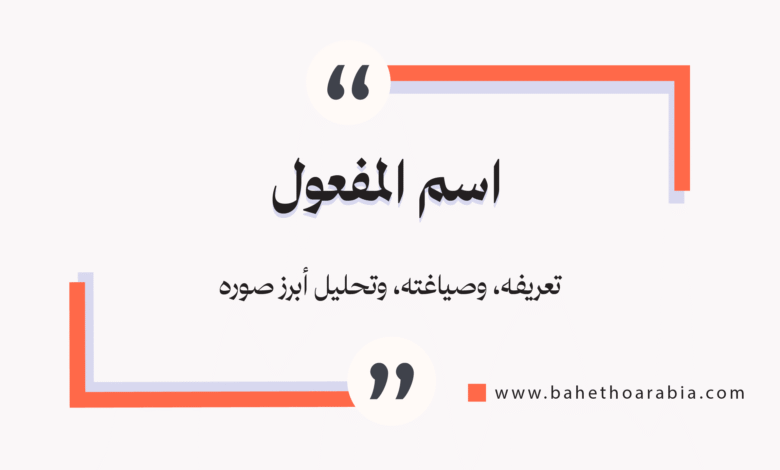
تعريف اسم المفعول ودلالته
يُعرَّف اسم المفعول بأنه وصف مشتق من مصدر الفعل المتصرف المبني للمجهول. وتتجلى دلالة اسم المفعول في الإشارة إلى الحدث ومن وقع عليه على وجه الحدوث لا الثبوت. على سبيل المثال، في جملة: (الباب مغلق)، فإن كلمة (مغلق)، وهي اسم مفعول، قد دلّت على حدث الإغلاق والشيء الذي وقع عليه وهو الباب، مع العلم بأن الإغلاق أمر عارض غير ثابت. ومن الأمثلة الأخرى على اسم المفعول ما يلي: مدفوع، مشكور، مسؤول، مُعَدٌّ، محطّمُ، منتخب، محتقر، ومستفاد.
صياغة اسم المفعول من الفعل الثلاثي
تتم صياغة اسم المفعول من مصدر الفعل الثلاثي على وزن (مفعول). ومن الأمثلة على هذا النوع من اسم المفعول: منصور، معلوم، مطرود، مردود، مسلوب.
صياغة اسم المفعول من الفعل فوق الثلاثي
أما فيما يخص اشتقاق اسم المفعول من مصدر الفعل الذي يتجاوز الثلاثي المجرد، فيكون على وزن فعله المضارع المبني للمجهول، مع استبدال حرف المضارعة بميم مضمومة وفتح الحرف قبل الأخير. وهذا النوع من اسم المفعول يتضح في الأمثلة التالية: مُكْرَم، مُعَاهَد، مُعَظّم، مُحْتَرم، مُزَعْزع، مُزَلْزَل.
تحليل البنية الصرفية لبعض صيغ اسم المفعول
ـ يُعدّ اسم المفعول (مَبِيْع) ذا وزن (مَفِعْل)، وهو مشتق من مصدر الفعل (باع). أصله الصرفي هو (مبيوع)، حيث حُذفت الواو وسُكّنت عين الكلمة، ثم كُسر ما قبلها لمناسبة الياء. وينطبق هذا التحليل على اسم المفعول في أمثلة أخرى مثل: مَهِيْب، مَقِيْس، مَدِيْن.
ـ وتقول: مقول وزنها مَفُعْل. والأصل مَقْوول، حذفت الواو، وسكنت عين الكلمة، وضم ما قبلها. ومن أمثلة اسم المفعول التي تتبع هذه القاعدة: مَصُون، مسوق، مَقُود، مصُوغ.
ـ بالنسبة لـ اسم المفعول (مستَعَان)، فوزنه الصرفي هو (مستَفْعل)، وأصله (مستعْوَن). حدث فيه إعلال بنقل حركة الفتحة إلى الحرف الساكن قبلها (العين)، ثم قُلبت الواو ألفًا. ومثال مشابه هو اسم المفعول (مستفاد)، الذي أصله (مُستفيَد)، حيث نُقلت الفتحة إلى ما قبل الياء، ثم قُلبت الياء ألفًا. ومن الأمثلة الأخرى على هذا النمط من اسم المفعول: مُعاد، مُراد، مُشاد، مُستطاع، مستطاب، مُستساغ، مختار، مُنقاد.
ـ في حالة اسم المفعول (مرميّ)، فإنه على وزن (مفعول) وأصله (مرموي). وقد اجتمعت فيه الواو والياء وكان أولهما ساكنًا، فقُلبت الواو ياءً وأُدغمت في الياء التالية. ومن أمثلته: مرضيّ عنه، ومنهي عنه، ومقويٌّ عليه.
ـ أما اسم المفعول (مدعوٌّ) فوزنه (مفعول) وأصله (مدعوْوٌ). وقد اجتمع فيه حرفان متماثلان (الواو)، أولهما ساكن، فأُدغم في الثاني. ومثال على ذلك: مشدوٌّ.
ـ كلمة (مُحَبٌّ) هي اسم مفعول على وزن (مُفْعَلٌ). أصلها (مُحْبَب) من الفعل المبني للمجهول (أُحِبَّ – يُحَبُّ). اجتمع فيها متماثلان (الباء)، فأُسكنت الباء الأولى أو نُقلت حركتها إلى ما قبلها، ثم أُدغمت في الباء الثانية. وينطبق هذا على أمثلة مثل: مُقَرّ، مُمَدّ، مُسْتَرَدّ، مُحْتَلٌّ.
حالات شاذة في صياغة اسم المفعول
وقد وردت بعض صيغ اسم المفعول من أفعال غير ثلاثية مجردة على وزن (مفعول) على غير القاعدة، وذلك على سبيل الشذوذ. ومن هذه الكلمات: (مخزون، مسعود، مجنون).
صيغ تنوب عن اسم المفعول
توجد خمس صيغ صرفية يمكن أن تنوب عن اسم المفعول وتؤدي معناه، مع تضمنها شيئًا من المبالغة. تُشتق هذه الصيغ من الفعل الثلاثي المجرد، ويستوي المذكر والمؤنث في أربع منها، وهي: (فعيل، فِعْل، فَعَل، فُعْلَة). أما صيغة (فعول) فإنها تُذكّر وتُؤنّث.
ـ صيغة (فَعِيْل): نحو: قتيل، جريح، صريع، أسير، جنين، طريد، ظنين، دفين، غسيل، سليب. وقد وردت بعض الكلمات التي تؤدي معنى اسم المفعول على هذه الصيغة من أفعال غير ثلاثية مجردة، ومنها: طليق، فريد، قَعيد، عليل، بديل.
ـ صيغة (فِعْل): نحو: طِرح (بمعنى مطروح)، ذِبْح (بمعنى مذبوح)، مِسْخ (بمعنى ممسوخ)، قِطْف (بمعنى مقطوف)، نِضْو (بمعنى منضوٌّ).
ـ صيغة (فَعَل): نحو: قَنَص (بمعنى مقنوص)، سَلَبٌ (بمعنى مسلوب)، وَلَد (بمعنى مولود)، حَلَبٌ (بمعنى محلوب)، عَدَدٌ (بمعنى معدود).
ـ صيغة (فُعْلَة): نحو: مُضْغَة (بمعنى ممضوغة)، غُرْفة (بمعنى مغروف)، نُسْخَة (بمعنى منسوخ)، ضُحكة (بمعنى مضحوك)، لُعْنة (بمعنى ملعون)، أُكْلة (بمعنى مأكول)، طُعْمَة (بمعنى مطعوم).
ـ صيغة (فَعُول): نحو: رَكوب (بمعنى مركوب)، حلوب (بمعنى محلوب)، غبوب (بمعنى مغبوب)، لبوس (بمعنى ملبوس)، صبوح (بمعنى مصبوح).
استخدامات خاصة بمعنى اسم المفعول
وقد جاءت بعض الكلمات على صيغة (فِعَال) حاملةً معنى اسم المفعول، مثل: كِتاب، وإله، ودِهاق. بالإضافة إلى ذلك، قد يُستخدم المصدر ويُراد به اسم المفعول، كما في الأمثلة التالية: أكل (بمعنى مأكول)، وشرب (بمعنى مشروب)، وعلم (بمعنى معلوم)، وعمل (بمعنى معمول).
ملاحظة حول اسم المفعول من الفعل اللازم
تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان الفعل المُشتق منه اسم المفعول فعلًا لازمًا، فإن اسم المفعول يحتاج إلى شبه جملة (جار ومجرور أو ظرف) ليتم معناه. ومن الأمثلة على ذلك: هذا الفراش منوم عليه، وهذا الشاب مأسوف عليه.
سؤال وجواب
١ – ما هو التعريف الدقيق لاسم المفعول، وما الفرق الجوهري بين دلالته ودلالة الصفة المشبهة؟
الإجابة: اسم المفعول هو وصف يُشتق من مصدر الفعل المتصرف المبني للمجهول ليدل على الحدث ومن وقع عليه. الفرق الجوهري بينه وبين الصفة المشبهة يكمن في الدلالة الزمنية؛ فاسم المفعول يدل على صفة طارئة ومتجددة مرتبطة بوقوع الحدث (وجه الحدوث)، مثل “الباب مُغْلَق”، فالإغلاق حدث وقع على الباب وهو قابل للتغيير. أما الصفة المشبهة، فتدل على صفة ثابتة أو شبه ثابتة في الموصوف (وجه الثبوت)، مثل “محمد كريمُ الخلقِ”، فالكرم صفة ملازمة له. إذن، اسم المفعول مرتبط بالحدوث والتجدد، بينما الصفة المشبهة مرتبطة بالثبوت والاستقرار.
٢ – ما هي القاعدة المتبعة لصياغة اسم المفعول من الأفعال فوق الثلاثية؟
الإجابة: تتم صياغة اسم المفعول من الفعل الذي يزيد على ثلاثة أحرف مجردة باتباع خطوات محددة ومنهجية؛ أولاً، يتم الإتيان بالفعل المضارع المبني للمجهول، ثم يُستبدل حرف المضارعة بميم مضمومة (مُـ)، ويُفتح الحرف قبل الأخير. على سبيل المثال، من الفعل “أَكْرَمَ”، مضارعه المبني للمجهول هو “يُكْرَمُ”، فيكون اسم المفعول منه “مُكْرَم”. وكذلك من الفعل “احْتَرَمَ”، مضارعه “يُحْتَرَمُ”، واسم المفعول هو “مُحْتَرَم”. ومن الفعل “استَخْرَجَ”، مضارعه “يُسْتَخْرَجُ”، واسم المفعول هو “مُسْتَخْرَج”.
٣ – لماذا تأتي أسماء المفعول مثل “مَبِيع” و”مَقُول” على غير وزن “مفعول” الظاهري؟
الإجابة: هذه الكلمات خضعت لظاهرة صرفية تُعرف بـ “الإعلال بالحذف”. الأصل الصرفي لكلمة “مَبِيع” من الفعل (باع، يبيع) هو “مَبْيُوع” على وزن “مفعول”. التقى فيها حرف العلة (الياء) مع واو “مفعول”، فحُذفت الواو منعًا للثقل، ثم كُسرت الباء لتناسب الياء، فأصبحت “مَبِيع” على وزن “مَفِعْل”. أما “مَقُول” من الفعل (قال، يقول)، فأصلها “مَقْوُول” على وزن “مفعول”. التقى فيها حرفان متماثلان (واوان)، فحُذفت الواو الثانية (واو “مفعول”)، ثم نُقلت ضمة الواو المحذوفة إلى القاف الساكنة قبلها، فأصبحت “مَقُول” على وزن “مَفُعْل”.
٤ – كيف يتم التعامل مع حرف العلة في نهاية الفعل عند صياغة اسم المفعول، كما في “مرميّ” و”مدعوّ”؟
الإجابة: يُعالج حرف العلة في نهاية الفعل (الفعل الناقص) من خلال الإعلال بالقلب ثم الإدغام. ففي كلمة “مرميّ” المشتقة من الفعل (رَمَى)، أصلها الصرفي هو “مَرْمُوي” على وزن “مفعول”. اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وكان أولهما ساكنًا، فقُلبت الواو ياءً ثم أُدغمت الياءان معًا مع تشديدها، فأصبحت “مرميّ”. أما في كلمة “مدعوّ” من الفعل (دَعَا)، فأصلها “مَدْعُوو” على وزن “مفعول”. اجتمع فيها حرفان متماثلان (واوان)، أولهما ساكن، فأُدغما معًا مع التشديد، فأصبحت “مدعوّ”.
٥ – ما هي الصيغ التي تنوب عن اسم المفعول، وما دلالتها الإضافية؟
الإجابة: تنوب خمس صيغ قياسية عن اسم المفعول في الدلالة على من وقع عليه الفعل، ولكنها تضيف معنى المبالغة. هذه الصيغ تُشتق من الفعل الثلاثي المجرد وهي:
- فَعِيْل: مثل “قتيل” بمعنى مقتول، و”جريح” بمعنى مجروح.
- فِعْل: مثل “ذِبْح” بمعنى مذبوح، و”طِرْح” بمعنى مطروح.
- فَعَل: مثل “سَلَب” بمعنى مسلوب، و”قَنَص” بمعنى مقنوص.
- فُعْلَة: مثل “أُكْلَة” بمعنى مأكولة، و”مُضْغَة” بمعنى ممضوغة.
- فَعُول: مثل “رَكُوب” بمعنى مركوب، و”حَلُوب” بمعنى محلوبة. وهذه الصيغة الأخيرة قد تُذكّر وتُؤنّث، بينما يستوي المذكر والمؤنث في الأربع الأولى غالبًا.
٦ – كيف يعمل اسم المفعول المشتق من فعل لازم؟
الإجابة: الفعل اللازم هو الذي لا ينصب مفعولًا به ويكتفي بفاعله. عند صياغة اسم المفعول منه، لا يكتمل معناه بنفسه لأنه لا يوجد من وقع عليه الفعل مباشرة. لذلك، فإنه يحتاج دائمًا إلى شبه جملة (جار ومجرور أو ظرف) تتعلق به لتوضيح المعنى وإتمامه. على سبيل المثال، من الفعل “وَقَفَ”، نقول: “المكان موقوفٌ فيه”، ومن الفعل “أَسِفَ”، نقول: “هذا الشاب مأسوفٌ عليه”. فشبه الجملة “فيه” و”عليه” أتمّت معنى اسم المفعول.
٧ – هل يمكن للمصدر أن يؤدي معنى اسم المفعول؟
الإجابة: نعم، في بعض السياقات البلاغية واللغوية، يمكن أن يُستخدم المصدر ويُراد به معنى اسم المفعول، وهو من أبواب الإيجاز والدقة في التعبير. في هذه الحالة، يكون المصدر دالًا على نتيجة الحدث أو الشيء الذي وقع عليه الفعل. من الأمثلة على ذلك قولنا: “هذا الشرابُ شِرْبُ فلان” أي مشروبُه، و”هذا الثوبُ عَمَلُ المصنع” أي معمولٌ فيه، و”هذا العلمُ معلومٌ” يمكن التعبير عنها بـ “هذا الأمرُ عِلْمٌ عند الجميع”.
٨ – ما هو التغيير الصرفي الذي يطرأ على اسم المفعول من فعل مضعّف فوق الثلاثي مثل “احتلّ”؟
الإجابة: عند صياغة اسم المفعول من فعل مضعّف فوق ثلاثي، يحدث إدغام للمثلين. فالفعل “احتلَّ” أصله (احتلل)، واسم المفعول منه يأتي على وزن مضارعه المبني للمجهول “يُحْتَلُّ”، فيكون “مُحْتَلَل”. ثم يجتمع متماثلان متحركان (اللامان)، فتُسكن اللام الأولى وتُدغم في الثانية، ليصبح اسم المفعول “مُحْتَلٌّ” على وزن “مُفْتَعَلٌ”. وينطبق هذا التحليل على أمثلة مشابهة مثل “مُسْتَرَدٌّ” من الفعل (استردّ)، و”مُمَدٌّ” من الفعل (أَمَدَّ).
٩ – هل هناك حالات شاذة لصياغة اسم المفعول من الفعل فوق الثلاثي؟
الإجابة: نعم، وردت في اللغة العربية بعض الكلمات التي اشتُقت من أفعال فوق ثلاثية، ولكن اسم المفعول منها جاء على وزن “مفعول” الخاص بالفعل الثلاثي، وذلك على غير القياس ويُعد شذوذًا صرفيًا يُحفظ ولا يُقاس عليه. من أشهر هذه الكلمات: “مجنون” من الفعل (جُنَّ) المبني للمجهول، وأصله (أَجَنَّهُ الله)، و”مسعود” من الفعل (أُسْعِدَ)، و”مخزون” من الفعل (أُخْزِنَ). القاعدة القياسية كانت تقتضي أن تكون “مُجَنّ”، “مُسْعَد”، و”مُخْزَن”.
١٠ – كيف يختلف إعلال اسم المفعول “مُسْتَعَان” عن إعلال “مَبِيع”؟
الإجابة: يختلف نوع الإعلال كليًا. في “مُسْتَعَان” (من الفعل استعان)، الإعلال هو “إعلال بالنقل والقلب”. أصلها “مُسْتَعْوَن” على وزن “مُسْتَفْعَل”. نُقلت حركة الواو (الفتحة) إلى العين الساكنة قبلها، فأصبحت “مُسْتَعَوَن”، ثم قُلبت الواو ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فصارت “مُسْتَعَان”. أما في “مَبِيع”، فالإعلال هو “إعلال بالحذف”. أصلها “مَبْيُوع”، حيث حُذفت واو “مفعول” للتخفيف، وليس الواو الأصلية للفعل، ثم كُسرت الباء لمناسبة الياء. فالأول إعلال في الحرف الأصلي (عين الكلمة)، والثاني حذف للحرف الزائد (واو مفعول).