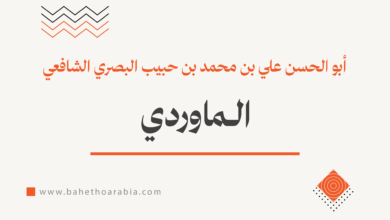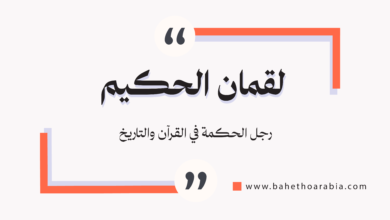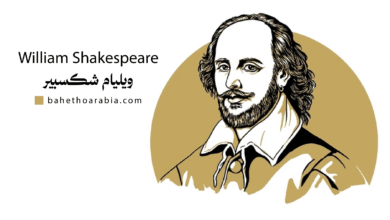زهير بن أبي سلمى: حياته، وشخصيته، وديوانه ومعلقته، وأغراض شعره وخصائصه الفنية
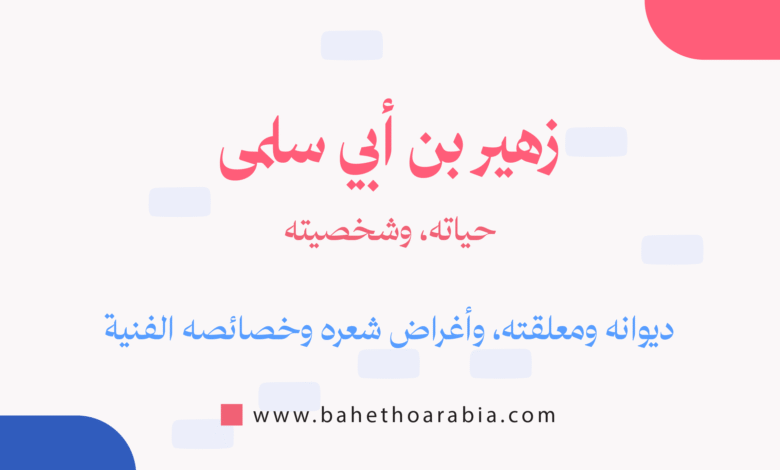
في سماء الشعر الجاهلي التي تزخر بالنجوم اللامعة، يبرز اسم زهير بن أبي سلمى ككوكب متفرد، لا يشع بوهج الفخر القبلي أو لهيب الغزل العابر فحسب، بل بنور الحكمة الساطع والعقل الراجح. هو الشاعر الذي صقلته تجارب الحياة القاسية، وشهد بأم عينيه ويلات حرب “داحس والغبراء” الطاحنة، فخرج من أتونها داعية سلام ومنادياً بقيم الحق والصلح. لم يكن زهير بن أبي سلمى مجرد ناظم للكلمات، بل كان فيلسوفاً يغزل من تجاربه قصائد خالدة، ومهندساً يبني نصوصه الشعرية بدقة متناهية وصبر أيوبي، حتى أصبحت “حولياته” مضرب المثل في التنقيح والجودة. تستعرض هذه المقالة سيرة وحياة الشاعر الكبير زهير بن أبي سلمى، وتغوص في أعماق شخصيته المتزنة، وتحلل ديوانه ومعلقته الشهيرة، وتستكشف أغراض شعره وخصائصه الفنية التي جعلته أحد أعظم شعراء العربية على مر العصور.
حياة زهير بن أبي سلمى وحرب داحس والغبراء
تذكر كتب الأدب نسباً مطوّلاً للشاعر الكبير زهير بن أبي سلمى، خلاصته أنه مُزَني الأب، ذبياني الأم. اسم أبيه ربيعة بن رباح وكنيته أبو سلمى، أما أمه فهي أخت الشاعر بشامة بن الغدير، وهي من بني سهم بن مرة الذبيانيين ثم الغطفانيين.
وتدل أخبار أبيه على أن أصهاره ظلموه فلم يعطوه حقه من غنيمة غنموها من طيئ، وأنه لم يطق الظلم فاحتمل بأهله، ونزل الحاجر من أرض نجد في مضارب أقاربه من بني عبد الله بن غطفان. وفي الحاجر قرب الرياض اليوم ولد زهير بن أبي سلمى (نحو ٥٢٠م). وهناك نشأ زهير بن أبي سلمى يتيماً. فتزوجت أمه الشاعر أوس بن حجر، فنشأه أوس على رواية الشعر وقرضه.
وربما كان أثر خاله بشامة في تثقيف زهير بن أبي سلمى لا يقل عن أثر أوس، فقد كان زهير بن أبي سلمى يعيش في كنف بشامة، ويأخذ عنه الشعر والحكمة وحصافة الرأي، وبعد النظر. ولما كان بشامة أبتر لا ولد له، فقد قسم للشاعر زهير بن أبي سلمى من ماله حين حضرته الوفاة. فعاش زهير بن أبي سلمى ميسوراً، وتزوج امرأتين: أولاهما أم أوفى التي يرد ذكرها في شعره، لكنها لم تكن له مواتية فطلقها، والثانية كبشة بنت عمار الغطفانية التي ولدت له كعباً وبجيرا وسالما.
كان زهير بن أبي سلمى موسراً، أتاه يساره من خاله الذي أورثه بعض ماله، ومن المال الذي كان يفيضه عليه هرم بن سنان وغيره من سراة قومه. ولا يعني ذلك أن الشاعر زهير بن أبي سلمى كان يتكسب بشعره تكسب النابغة، وإنما كان هرم معجباً به وبشعر زهير بن أبي سلمى لا يحبس عنه مالاً، ويعطيه قبل أن يسأله. وكان زهير بن أبي سلمى يقدر هرماً حق قدره لأنه استطاع مع الحارث بن عوف إقرار الصلح بين عبس وذبيان بعد أن مزقتهما حرب داحس والغبراء.
حرب داحس والغبراء
وقصة هذه الحرب أن قيس بن زهير العبسي راهن حذيفة بن بدر الفزاري الذبياني على سباق بين داحس والغبراء وهما من خيل قيس، والخطار والحنفاء وهما من خيل حذيفة. وتواضعا على أن يكون مدى السباق مائة غلوة (١٢ ميلا أو ١٨كم) بعد تضمير الخيل أربعين ليلة. وأقام حذيفة رجلاً من بني أسد في الطريق، وأمره أن يلقى داحساً في الطريق، فإن جاء سابقاً ردّ وجهه عن الغاية.
ثم إن حذيفة بن بدر وقيس بن زهير أتيا المدى ينظران إلى الخيل كيف خروجها منه… فلما أرسلت الخيل سبقها داحس سبقاً بيناً والناس ينظرون. فلما هبط داحس في الوادي عارضه الأسدي فلطم وجهه فألقاه في الماء، فكاد يغرق هو وراكبه، ولم يخرج إلا وقد فاتته الخيل. وأما راكب الغبراء فإنه خالف طريق داحس لما رآه قد أبطأ، ثم عاد إلى الطريق واجتمع مع فرسي حذيفة. ثم سقطت الحنفاء، وبقي الخطار والغبراء. ثمّ إن الغبراء جاءت سابقة، وتبعها الخطار ثم الحنفاء، ثم جاء داحس بعد ذلك والغلام يسير به على رسله. وأخبر الغلام قيساً بما صنع بفرسه، فأنكر حذيفة ذلك، وادعى السبق ظلماً وقال: جاء فرساي متتاليين. ومضى قيس وأصحابه حتى نظروا إلى القوم الذين ضربوا داحساً، وجاءه الأسدي نادماً على ضرب داحس واعترف لقيس بما صنع، وبما أمره به حذيفة.
وأبى بنو فزارة الذبيانيون أن يدفعوا خطر الرهان وهو عشرون جملا، وادعوا أنهم السابقون. ولجّ حذيفة في ظلمه وأرسل ابنه ندبة إلى قيس، فقال له: «يقول أبي: أعطني سبقي»، فتناول قيس الرمح، فطعنه، فدقّ صلبه، وعادت فرسه إلى أبيه عائرة، ونادى قيس يابني عبس: الرحيل، فرحلوا كلهم.
على هذا النحو بدأت الحرب بين عبس وذبيان، واستمرت زمناً طويلاً، واقتتل فيها فرسان القبيلتين وشعراؤهما كعنترة بن شداد وقيس بن زهير، والربيع بن زياد. وبعد حروب ضروس اصطلحوا وتعاقدوا على أن يحتسبوا القتلى، فيؤخذ الفضل ممن هو عليه، وحملت عنهم الديات فكانت ثلاثة آلاف بعير في ثلاث سنين. وكان من أبرز الساعين في الصلح الحارث بن عوف وهرم بن سنان، وكلاهما من ذبيان. وفيهما – وفي هرم على وجه الخصوص – قال زهير بن أبي سلمى أجود مدائحه.
شخصية زهير بن أبي سلمى
عايش زهير بن أبي سلمى حرب داحس والغبراء، فتركت أحداثها الدامية آثاراً واضحة في شخصيته، دفعته إلى بغض الشجاعة الحمقاء، والقتل الأرعن، وأفضت به إلى التفكر في أمور الحياة، وقاده هذا التفكر إلى النفور من الحمية الجاهلية، فآثر الجد على اللهو، والحلم على السفه ونبذ الشهوات التي تفقد صاحبها الوقار. فلم يؤثر عن زهير بن أبي سلمى أنه أدمن الخمر كالأعشى، أو فاخر بارتياد الحوانيت كطرفة، أو تبذل حين تغزل كامرئ القيس. بل جعل زهير بن أبي سلمى إنفاق المال في الخمر مفسدة لا مفخرة، فقال يصف بعض ممدوحيه:
أخي ثقةٍ لا تهلكُ الخمرُ ماله *** ولكنه قد يُهْلِكُ المالَ نائلُه
ولم يؤثر عنه الفحش أو غشيان مظانّ الفواحش، ولم يرو أنه قامر أو حرض على المقامرة، أو لها لهواً ينتقصه. ولم يخبرنا أحدٌ بأن زهير بن أبي سلمى كان فظّاً خشن المعاملة، بل كان يكره عجرفية البداوة، وخشونة المسلك، ومناجزة الناس ومخاصمتهم، فانصرفت نفسه عن الهجاء، وعافت الولغ في الأعراض، وأحسّ بالندم، لأنه هجا من لا يستحق الهجاء، فقال زهير بن أبي سلمى بلسان الندم والتوبة: «ماخرجت في ليلة ظلماء إلا خفت أن يصحبني الله بعقوبة لهجائي قوماً ظلمتهم».
وكان زهير بن أبي سلمى متواضعاً لا يتخلق بما كان أكثر الشعراء يتخلقون به من زهو وكبر وخيلاء، وإنما كان يعيش بين قومه لين الجانب موطأ الكنف، زاهداً في المفاخرة، فإذا اضطرته الحياة إلى شيء من الفخر لم يقده الفخر إلى العزة بالإثم، أو التباهي بالباطل، ولم ينتحل محامد لم تذكر له.
وذكر الألوسي أن عقله الراجح أفضى بـزهير بن أبي سلمى إلى الإيمان على نحو غامض بالبعث وبقدرة الله على إحياء الموتى، فكان إذا مر بشجرة أورقت بعد يبس قال: «لولا أن تسبني العرب لأمنت أن الذي أحياك بعد يبس سيحيي العظام وهي رميم». وذكر ابن قتيبة أن زهير بن أبي سلمى كان يتألّه، ويتعفّف في شعره، ويدلّ شعره على إيمانه بالبعث، وذلك كقوله:
فلا تكتُمُنَّ اللهَ ما في نفوسِكُمْ *** لِيَخْفَى، ومهما يُكْتَمِ اللهُ يَعْلَمِ
يُؤَخَّرْ فيُوضَعْ في كتابٍ فيُدَّخَرْ *** ليومِ الحسابِ أو يُعَجَّلْ فيُنْقَمِ
وفي رسالة الغفران ما يشير إلى أن أبا العلاء المعري وقف على إيمان زهير بن أبي سلمى ورجحه. ولذلك خصّه بقصر منيف من قصور الجنة، وأنطق ابن القارح حينما لقي زهير بن أبي سلمى في الفردوس بهذا السؤال: «بم غفر لك، وكنت في زمان الفترة والناسُ همل لا يحسن فيهم العمل؟»، وأنطق زهير بن أبي سلمى بهذا الجواب: «كانت نفسي من الباطل نفوراً، فصادفت ملكاً غفوراً، وكنت مؤمناً بالله العظيم… ولو أدركت محمّداً لكنت أوّل المؤمنين».
ديوان زهير بن أبي سلمى ومعلقته
للشاعر زهير بن أبي سلمى ديوان شعر، شرحه قديماً أكثر من عالم، ونشره حديثاً أكثر من ناشر عربي وأعجمي. وربما كان وليم بن الورد أول ناشريه من الأجانب إذ نشره سنة ١٨٧٠م. ثم ظهرت طبعة أخرى له في ليدن سنة ١٩٨٨م، وفي مصر طبع سنة ١٩٠٥م. وأهم ما في ديوان زهير بن أبي سلمى المعلّقة.
تقع معلقة زهير بن أبي سلمى في تسعة وخمسين بيتاً وفق روايتها في شرح التبريزي، وفي اثنين وستين بيتاً، وفق روايتها في شرح الزوزني، وتقسم إلى أربعة أقسام، هي: المقدمة الطللية، ومشاهد التحمّل والرحيل، والمدح، والحكمة.
يبدأ زهير بن أبي سلمى المقدمة الطللية – وأبياتها ستة – بذكر صاحبة الديار، وتحديد مكانها بحومانة الدراج فالمتثلم، حيث إن الدمنة هي آثار الديار، والحومانة هي ما غلظ من الأرض، بينما الدراج والمتثلم هما موضعان، وذلك على النحو الذي نجده في أكثر القصائد الجاهلية:
أمِنْ أمِّ أوفى دِمْنَةٌ لم تَكَلَّمِ *** بحَوْمانَةِ الدَّرَّاجِ فالمُتَثَلَّمِ
ثم يصف آثار الديار ومرابض الظباء التي ألفتها بعد أن هجرها أهلها، ويذكر كيف تعرفها بعد عشرين سنة، ويرسم صوراً لحجارة المواقد السوداء، والنؤي المتهدم. ويختم هذا القسم بإلقاء التحية على الدار بعد أن تعرفها.
وفي القسم الثاني – وأبياته تسعة – وصف مضمخ بأسلوب قصصي، يعرض فيه الشاعر زهير بن أبي سلمى مشهد الظعائن وهن متهاديات فوق الهضاب وعلى سفوح الجبال، وقد غطين المطايا بثياب وردية، وظهرت عليهن أمارات الترف، حتى أصبح منظرهن نزهة للبصر. وكن في أثناء سيرهن ينشرن قطع الصوف الأحمر، وهن يسرن إلى ماء بلغنه فأصبن منه، ثم رحلن مرة أخرى عابرات وادي السوبان بهوادجهن الزاهية.
وثالث الأقسام أطولها، إذ يقع في واحد وثلاثين بيتاً، أولها مدح هرم بن سنان والحارث بن عوف:
يميناً لنعمَ السَّيِّدَانِ وُجِدْتُما *** على كلِّ حالٍ من سَحِيْلٍ ومُبْرَمِ
وهنا يقصد زهير بن أبي سلمى بقوله “سحيل ومبرم” على كل حال من شدة الأمر وسهولته، حيث إن السحيل هو الخيط المفرد والمبرم هو الخيط المفتول. وفي هذا المدح يذكر الشاعر زهير بن أبي سلمى ما قام به الرجلان الكبيران من إعادة السلم إلى عبس وذبيان، ويطلب من بني ذبيان المتحالفين على إقرار السلم أن يحققوا ما تحالفوا عليه. ثم يصف جرائم الحرب بخمسة أبيات وهجو حصين بن ضمضم بضعة أبيات، فإذا فرغ منه عاد إلى المدح الذي شرع فيه.
وأما القسم الأخير – وعدة أبياته ستة عشر – فقد وقفه الشاعر زهير بن أبي سلمى على الحكمة، وعرض فيه آراءه في الحياة والموت والعلاقات الإنسانية، والمثل العليا عند العرب، كالشجاعة والكرم والوفاء والإيمان بالقوة، وتقديس العقل، وذم السفاهة، وتعظيم الفصاحة، والإلحاح على أن أنفس ما في الإنسان أصغراه قلبه ولسانه.
أغراض شعر زهير بن أبي سلمى
خاض زهير بن أبي سلمى في أكثر الأغراض التي خاض فيها شعراء الجاهلية، لكنه كان يؤثر غرضاً على غرض، ويحتكم في هذا الإيثار إلى شخصيته التي وقفنا على تكوينها وملامحها، وإلى بيئته التي ذكرنا أبرز عناصرها، وإلى ثقافته الفنية التي أشرنا إلى أصولها عند أوس بن حجر. وأهم أغراض شعر زهير بن أبي سلمى المدح والوصف والحكمة، وأقلها شأناً الغزل والهجاء والفخر.
الخصائص الفنية لشعر زهير بن أبي سلمى
كان بشامة بن الغدير خال زهير بن أبي سلمى، وكان زهير بن أبي سلمى منقطعاً إليه.. فأتاه فقال: يا خالاه لو قسمت لي من مالك. فقال: والله يابن أختي لقد قسمت لك أفضل ذلك وأجزله. قال: وما هو؟ قال: شعري ورثتنيه – وقد كان زهير بن أبي سلمى قبل ذلك قال الشعر. وقد كان أول ما قال – فقال له زهير: الشعر شيء ما قلته، فكيف تعتد به علي؟ فقال بشامة: ومن أين جئت بهذا الشعر؟ لعلك ترى أنك جئت به من مزينة. وقد علمت العرب أن حصاتها وعين مائها في الشعر لهذا الحي من غطفان، ثم لي منهم، وقد رويته عني.
وصدق بشامة، فإن شاعرية زهير بن أبي سلمى غطفانية لا مزنية. ومن يستقصي حياة زهير بن أبي سلمى يدرك أنه خرج من بيت وثيق الصلة بالشعر، وأن أصول زهير بن أبي سلمى وفروعه شجرة مزدهرة في دوح الشعر العربي، فزوج أمه شاعر، وأخته شاعرة، وابناه كعب وبجير شاعران، وأبناء كعب وأحفاده نظموا الشعر، ويبقى زهير بن أبي سلمى بين هؤلاء جميعاً واسطة العقد، وجوهرته النفيسة. فما أهم خصائصه الفنية؟
١ – الصنعة والتنقيح
كان الأصمعي يقول: زهير والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر لأنهم نقحوه، ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين، وزاد ابن جني هذا القول توضيحاً، فقال: «ألا ترى إلى ما يروى عن زهير بن أبي سلمى من أنه عمل سبع قصائد في سبع سنين، فكانت تسمى حوليات زهير». وإذا راق لبعض النقاد المحدثين أن ينكروا هذا الخبر، أو أن يفسروه تفسيراً آخر، فهو عندنا أقرب إلى الصحة لأنه يوافق ما عرف به زهير بن أبي سلمى من رجاحة العقل، والهدوء والصبر. قال الدكتور عبد الحميد سند الجندي: وربّما يكون المراد بكلمة حولية معاني أخرى، لأن من معاني كلمة «الحول» القوة، ومن معانيها الحذق وجودة النظر، والقدرة على التصرف. إن هذا التفسير قد ينقل دلالة «الحوليات» من إطار الزمان إلى إطار القوة، لكنه لا ينزع منها صفة الجودة والتنقيح، ولا ينكر عليها دقة الصنعة، وإحكام البنيان. وإذا لم يكن زهير بن أبي سلمى يتهدّى إلى المعاني العميقة في شعره كله، فإنه كان في أكثر هذا الشعر يحتكم إلى عقله ويجعله المسيطر على الخيال والحس. وربما كان هذا المذهب في النظم مرهقاً للشاعر، لكنه يريح القارئ، ويقدّم إليه القريض خالياً من الشوائب، بريئاً من التعقيد سليماً من العيوب التي أخذت على غيره.
٢ – التسلسل المنطقي
ومن خصائص النهج الذي انتهجه زهير بن أبي سلمى ترتيب الأفكار في القصيدة الواحدة ترتيباً منطقياً يجعل القصيدة كالمقالة، تبدأ بمقدمة كالغزل ووصف الأطلال، وتنتقل إلى موضوع يقصد إليه الشاعر كالمديح ووصف الحرب، وتنتهي بخاتمة كالحكمة التي تهذب النفس، وتحذر من الظلم والطغيان. ولعلّ معلّقة زهير بن أبي سلمى أكمل مثال لهذا التسلسل عنده، وأفضل ما يذكر في هذا الباب عند الشعراء الجاهليين على الإطلاق.
٣ – تأييد الأفكار بالأدلة
وسيطرة المنطق على الشاعر تفضي به إلى ظاهرة أخرى، تعمل على توضيح الأفكار، وهي تأييد الفكرة بدليل وشفع المعنى بحجة. وزهير بن أبي سلمى – إن لم يكن قد تأثر بمنطق كمنطق أرسطو – قادر على أن يشفع الرأي الذي يراه ببراهين مستمدة من الواقع. ذكر أن هرم بن سنان والحارث بن عوف أقاما الصلح بين المتحاربين، وربط مسلكها هذا بكرم موروث ومجد تليد، ثم أثبت رأيه بحجتين: أولاهما أن انتقال المجد إليهما كانتقال الصلابة والاستقامة من الشجر إلى الرماح المصنوعة من فروع الشجر. والثانية أنهما استمدا الشرف والعراقة من منبتهما الشريف العريق كما تستمد فسائل النخل نسخ الحياة من الأرض الطيبة، فقال:
فما يكُ من خيرٍ أتوه فإنما *** توارثه آباءُ آبائِهِمْ قبلُ
وهل يُنْبِتُ الخَطِّيَّ إلا وشيجهُ *** ونَغْرِسُ إلا في منابتها النخلُ
والمقصود بالخطي هو الرمح، والوشيج هو القنا الملتف في منبته. وهكذا أقام الشاعر الحجة على أن كرم الممدوحين فطرة موروثة، وطبع مغروس لا ادعاء وانتحال.
٤ – السهولة والوضوح
إذا قورن شعر زهير بن أبي سلمى بشعر الجاهليين كان على وجه العموم قليل الغريب سهل المفردات، لا يعروه غموض في عرض الأفكار، ولا التواء في تركيب الجمل، ولا يعبر عن معنى إلا إذا كان شديد الوضوح في فكره، ووضوح المعنى في فكره يجعل التعبير عنه واضحاً في شعره. وقد نوّه الأقدمون بهذه الظاهرة. قال ابن عباس: خرجت مع عمر في أول غزاة غزاها فقال لي ذات ليلة: يابن عباس أنشدني لشاعر الشعراء. قلت: ومن هو يا أمير المؤمنين؟ قال: ابن أبي سلمى. قلت: وبم صار كذلك؟ قال: لأنه لا يتبع حوشي الكلام، ولا يعاظل في المنطق، ولا يقول إلا ما يعرف. غير أن هذا الوضوح قد يفضي إلى نوع من السطحية والابتذال ويحرم القارئ لذة التفكير للوصول إلى المعاني المغلفة بالصور. ومن هذا الوضوح البالغ قول زهير بن أبي سلمى:
سئمتُ تكاليفَ الحياةِ، ومَنْ يعشْ *** ثمانينَ حولاً، لا أبا لكَ، يسأمِ
وأعلمُ علمَ اليومِ والأمسِ قبلَهُ *** ولكنني عن علمِ ما في غدٍ عَمِ
وقد دفعت هذه الظاهرة والظواهر الأخرى بعض الدارسين إلى اتهام شعر زهير بن أبي سلمى بجمود الشعر، فقال: «إن شعر زهير على اتزانه – قد اصطبغ بسبب كل ما تقدم، بشيء من الجمود، فقد قل ماؤه كما قل رواؤه، حتى لا تكاد تجد فيه أصداء لنزعات النفس وتوثب القلب».
٥ – الموسيقا
قال أبو عبيدة: فمن فضل زهيراً على جميع الشعراء يقول: إنه أمدح القوم، وأشدهم أسر شعر. وعقب الجندي على هذا القول، فقال: «لاشك أنه يعني هذه الناحية التي تأتي من ائتلاف اللفظ مع المعنى، ورصف الألفاظ وعذوبة الموسيقا وروعة الديباجة». ولعلك تلمس هذه الناحية الموسيقية في أبيات الحكم التي ختم بها مطولته (المعلقة) التي تبتدئ أبياتها بلفظ (ومن). وتستطيع أن تقرأ هذه الأبيات في معلقته لتعرف كيف أن هذا التقسيم إلى شرط وجواب في أبيات عدة أكسبها نغمة موسيقية. ولا تنفرد المعلقة بهذه الظاهرة، ففي شعر زهير بن أبي سلمى أمثلة كثيرة توضح هذا التقسيم، كقوله:
هنالك إن يُسْتَحْبَلُوا المالَ يُحْبِلُوا *** وإن يُسألوا يُعْطُوا، وإنْ يَأْسِرُوا يُغْلُوا
وفيه أشكال أخرى من التقسيم يشبه بعضها ما يسمى في علم البديع (الترصيع) الذي يحمل إيقاعاً عذباً إلى السمع، كقوله:
لِجيدِ مُغْزِلَةٍ، أَدْمَاءَ خاذِلَةٍ *** مِنَ الظِّباءِ تُراعِي شادِناً خَرِقا
وفي شعر زهير بن أبي سلمى خصائص فنية أخرى ذكرناها في حديثنا عن الوصف كالوصف الواقعي الحسي، وجمال التشخيص، ودقة الحركة. وهذه الخصائص مجتمعة تجعل شعره إلى الصنعة المتقنة أقرب منه إلى الطبع السمح المتدفق.
خاتمة
وهكذا، يتضح أن زهير بن أبي سلمى لم يكن مجرد شاعر مرّ في تاريخ الأدب العربي، بل كان مدرسة قائمة بذاتها؛ مدرسة العقلانية، والاتزان، والصنعة الشعرية المتقنة. لقد حوّل الشاعر تجربة الحرب المريرة إلى دعوة إنسانية خالدة للسلام، وجعل من شعره مرآة تعكس شخصيته الوقورة، وإيمانه العميق بالقيم الأخلاقية الرفيعة. من خلال معلقته التي تعد نموذجاً للتسلسل المنطقي والبناء المحكم، وأبياته التي تميزت بالوضوح والسهولة والموسيقا الهادئة، رسّخ زهير بن أبي سلمى مكانته كأحد “عبيد الشعر” الذين وهبوا فنهم وقتاً وجهداً لتنقيحه وتهذيبه. إن دراسة إرث زهير بن أبي سلمى لا تزال ضرورية لفهم عمق الفكر الجاهلي، وإدراك كيف يمكن للكلمة أن تصبح أداة للإصلاح الاجتماعي، ومنارة للحكمة التي لا يخفت نورها مع تقادم الزمن.
السؤالات الشائعة
١ – ما هو الأثر العميق الذي تركته حرب داحس والغبراء على شخصية وشعر زهير بن أبي سلمى؟
الإجابة: كان لحرب داحس والغبراء، التي عايشها زهير بن أبي سلمى، أثر محوري في تشكيل شخصيته ومنهجه الشعري. لقد دفعته مآسي الحرب ودمويتها إلى نبذ العنف والبطش الأرعن، وتكوين موقف فلسفي رافض للحمية الجاهلية المدمرة. تجلى هذا الأثر في شعره من خلال محورين رئيسيين: أولاً، مدحه الصادق للساعين في الصلح، وعلى رأسهم هرم بن سنان والحارث بن عوف، حيث لم يكن مديحه للتكسب بل تقديراً لفعلهما النبيل في حقن الدماء. ثانياً، ظهور الحكمة كغرض أساسي في شعره، حيث ضمن قصائده، وخاصة معلقته، أبياتاً خالدة تحذر من ويلات الحرب وتدعو إلى التروي والتفكير، مما رسخ صورته كشاعر السلام والحكمة في العصر الجاهلي.
٢ – ما المقصود بـ “حوليات زهير”، وما دلالتها على منهجه الشعري؟
الإجابة: “الحوليات” هو مصطلح نقدي أطلقه القدماء، وعلى رأسهم الأصمعي، على مجموعة من قصائد زهير بن أبي سلمى التي قيل إنه كان ينظمها في عام كامل (حول). كان يقضي أربعة أشهر في نظمها، وأربعة في تهذيبها وصقلها، وأربعة في عرضها على خواص الشعراء والنقاد. تدل هذه التسمية، سواء فُهمت حرفياً أو مجازياً، على المنهج الفني الذي اتبعه زهير، وهو منهج “الصنعة والتنقيح”. فهو لم يكن من الشعراء المطبوعين الذين يرتجلون الشعر، بل كان شاعراً متأنياً يحتكم إلى العقل والصبر، ويعيد النظر في شعره مراراً ليخرجه في أبهى صورة، خالياً من العيوب اللفظية والمعنوية، وهو ما جعله رائداً لمدرسة “عبيد الشعر”.
٣ – كيف يمكن تحليل البناء الهيكلي لمعلقة زهير بن أبي سلمى، وما هي أقسامها الرئيسية؟
الإجابة: تتميز معلقة زهير بن أبي سلمى ببناء هيكلي محكم وتسلسل منطقي واضح، يجعلها أشبه بعمل متكامل الأجزاء. يمكن تقسيمها أكاديمياً إلى أربعة أقسام رئيسية:
- المقدمة الطللية الغزلية: وتبدأ بالوقوف على أطلال ديار “أم أوفى”، وهو تقليد شعري راسخ، لكن زهير يوظفه ببراعة للانتقال إلى موضوعه الرئيسي.
- وصف رحلة الظعائن: قسم وصفي يرسم فيه الشاعر لوحة حسية متحركة للنساء الراحلات في هوادجهن، مظهراً قدرته على التصوير الدقيق.
- الموضوع الرئيسي (المديح): وهو قلب القصيدة، حيث يمدح السيدين هرم بن سنان والحارث بن عوف لدورهما في إحلال السلام، ويتناول ويلات الحرب ويدعو إلى الالتزام بالصلح.
- الخاتمة (الحكمة): وهي مجموعة من الأبيات التي أصبحت أمثالاً خالدة، يعرض فيها زهير بن أبي سلمى خلاصة تجاربه ونظرته للحياة والموت والأخلاق، مما يختم القصيدة بنبرة فلسفية تأملية.
٤ – ما أبرز الخصائص الفنية التي تميز شعر زهير بن أبي سلمى عن غيره من شعراء الجاهلية؟
الإجابة: يتميز شعر زهير بن أبي سلمى بمجموعة من الخصائص الفنية التي شكلت بصمته الخاصة، وأبرزها:
- الصنعة والتنقيح: كما يتضح من “حولياته”، كان شعره نتاج تأمل طويل وصقل دقيق.
- التسلسل المنطقي: قصائده مبنية بترتيب محكم ينتقل بسلاسة من المقدمة إلى الغرض الرئيسي ثم الخاتمة.
- السهولة والوضوح: كان يتجنب الألفاظ الغريبة (الحوشي) والتعقيد في التراكيب، مما جعل شعره مفهوماً وسهل التلقي، وهو ما أثنى عليه عمر بن الخطاب.
- تأييد الأفكار بالأدلة: كان يميل إلى دعم أفكاره بحجج منطقية وصور مستمدة من الواقع، كما فعل عند إثبات أصالة كرم ممدوحيه بتشبيهه بالرماح التي لا تنبت إلا من أصولها.
- الموسيقا الهادئة: يعتمد على التكرار والتقسيم المتوازن (الترصيع) لخلق إيقاع موسيقي رصين يتناسب مع جدية موضوعاته.
٥ – كيف اختلفت شخصية زهير بن أبي سلمى عن الصورة النمطية للشاعر الجاهلي؟
الإجابة: قدم زهير بن أبي سلمى نموذجاً مختلفاً لشخصية الشاعر الجاهلي. فبينما كانت الصورة النمطية ترتبط باللهو، وشرب الخمر، والمفاخرة بالبطش والنساء، كان زهير شخصية تتسم بالوقار، والاتزان، والجدية. لم يُعرف عنه إدمان الخمر كالأعشى، أو التبذل في الغزل كامرئ القيس، بل كان يرى إنفاق المال في غير محله مفسدة. كما ابتعد عن الهجاء المقذع، وشعر بالندم على من هجاهم، وكان متواضعاً يكره الخيلاء. هذه الشخصية الرصينة، التي تأثرت بعقله الراجح وتجربة الحرب، انعكست مباشرة على شعره الذي غلبت عليه الحكمة والاعتدال.
٦ – هل توجد في شعر زهير بن أبي سلمى إشارات تدل على إيمانه بالبعث والحساب؟
الإجابة: نعم، توجد في شعر زهير بن أبي سلمى، وتحديداً في معلقته، إشارات واضحة وقوية تدل على إيمان غامض بفكرة البعث والحساب والرقابة الإلهية. يتجلى ذلك في قوله الشهير: “فلا تكتُمُنَّ اللهَ ما في نفوسِكُمْ / لِيَخْفَى، ومهما يُكْتَمِ اللهُ يَعْلَمِ * يُؤَخَّرْ فيُوضَعْ في كتابٍ فيُدَّخَرْ / ليومِ الحسابِ أو يُعَجَّلْ فيُنْقَمِ”. وقد لفتت هذه الأبيات أنظار القدماء، حيث ذكر ابن قتيبة أنه كان “يتألّه ويتعفف في شعره”، كما أن أبا العلاء المعري في “رسالة الغفران” جعله من أهل الجنة لإيمانه بالله ونفوره من الباطل.
٧ – يُعرف شعر زهير بالوضوح، لكن بعض النقاد اعتبر ذلك “جموداً”. كيف يمكن الموازنة بين هذين الرأيين؟
الإجابة: الموازنة بين هذين الرأيين تتطلب فهماً لطبيعة شعر زهير بن أبي سلمى. فصفة الوضوح نابعة من منهجه العقلي الذي يفضل المعنى الجلي واللفظ السهل، وهو ما جعله “لا يعاظل في المنطق ولا يتبع حوشي الكلام” حسب قول القدماء، وهذه ميزة كبرى أكسبت شعره الخلود وسهولة الانتشار. أما النقد الموجه له بـ”الجمود”، فيأتي من منظور مقارنته بالشعراء الذين تغلب عليهم العاطفة المتدفقة والخيال الجامح. فشعر زهير، بسبب سيطرة العقل والتنقيح، قد يبدو أقل توهجاً عاطفياً أو “أقل ماء ورواءً”، لكن هذا ليس عيباً بقدر ما هو سمة أسلوبية تعكس شخصيته الهادئة ومنهجه الفني القائم على الإحكام والاتزان بدلاً من التدفق العاطفي.
٨ – من هم أبرز المؤثرين في تكوين زهير بن أبي سلمى الشعري والثقافي؟
الإجابة: يعود تكوين زهير بن أبي سلمى الشعري والثقافي إلى بيئة شعرية خصبة، ويبرز فيها مؤثران رئيسيان:
- خاله بشامة بن الغدير: كان شاعراً حكيماً وصاحب رأي، وقد عاش زهير في كنفه وتأثر بحكمته وشعره، حتى إنه ورث عنه جزءاً من ماله وشاعريته، فكانت شاعرية زهير “غطفانية” أصيلة وليست “مزنية”.
- زوج أمه أوس بن حجر: وهو من فحول شعراء الجاهلية، وقد نشأ زهير في رعايته بعد وفاة أبيه، فتتلمذ على يديه وتعلّم منه أصول قرض الشعر وروايته، مما صقل موهبته في مرحلة مبكرة.
٩ – ما الذي يميز غرض المديح عند زهير بن أبي سلمى، وهل كان شعراً للتكسب المادي؟
الإجابة: يتميز المديح عند زهير بن أبي سلمى بكونه مديحاً قيمياً وأخلاقياً وليس مديحاً للتكسب المادي الصرف. فعلى عكس شعراء آخرين كالنابغة، لم يكن زهير يتخذ من المديح حرفة لاستجداء العطايا، بل كان مدحه نابعاً من إعجاب حقيقي بفعال سامية. وخير دليل على ذلك مدحه لهرم بن سنان والحارث بن عوف، الذي جاء تقديراً لجهودهما في إنهاء حرب داحس والغبراء وتحملهما ديات القتلى. لذلك، جاء مديحه صادقاً، يركز على القيم العليا كالكرم والشجاعة في سبيل السلم، لا على المفاخر الشخصية الجوفاء.
١٠ – إلى أي مدى يمكن اعتبار المنطق والعقلانية محوراً أساسياً في بناء القصيدة لدى زهير بن أبي سلمى؟
الإجابة: يمكن اعتبار المنطق والعقلانية المحور الأساسي الذي يقوم عليه بناء القصيدة لدى زهير بن أبي سلمى. يتضح ذلك جلياً في التسلسل المنطقي المحكم لقصائده، وخاصة المعلقة، التي تنتقل من قسم إلى آخر بسلاسة وترابط فكري. كما تظهر عقلانيته في منهجه القائم على “تأييد الفكرة بالدليل”، حيث لا يطلق أحكاماً عامة، بل يدعمها بحجج وبراهين مستمدة من الواقع والطبيعة، مثل استدلاله على أصالة المجد بتشبيهه بالنخل الذي لا ينمو إلا في منابته الطيبة. هذه السيطرة العقلية تجعل من شعره تجربة فكرية منظمة بقدر ما هي تجربة فنية جمالية.