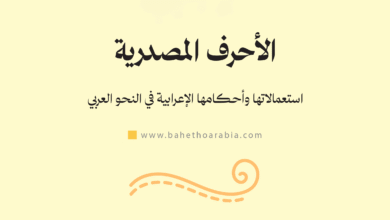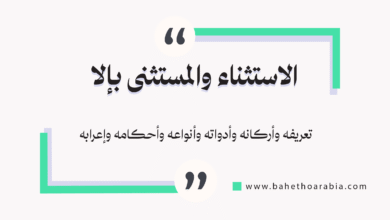الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر: دليل شامل للإعراب والاستخدام
فهم عميق لأفعال اليقين والرجحان والتحويل وكيفية تأثيرها على الجملة الاسمية
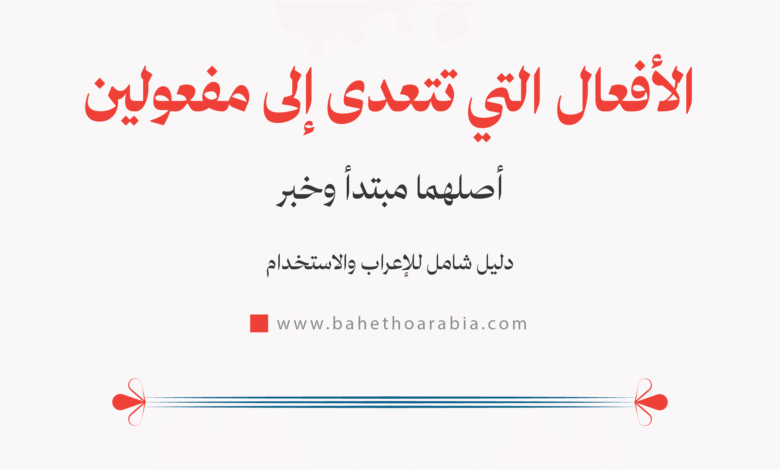
استكشف معنا عالم النحو العربي وقواعده الدقيقة، وتعرّف على واحدة من أهم المجموعات الفعلية التي تغير بنية الجملة الاسمية بالكامل، وهي الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. هذا الدليل الأكاديمي مصمم خصيصى للمبتدئين والطلاب وكل من يرغب في فهم هذا الباب النحوي الهام فهماً عميقاً ومفصلاً.
مقدمة: ما هي الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر؟
في بنية اللغة العربية، تنقسم الأفعال من حيث التعدي واللزوم إلى قسمين: فعل لازم يكتفي بفاعله، وفعل متعدٍ يتجاوز فاعله لينصب مفعولاً به أو أكثر. ومن بين الأفعال المتعدية، تبرز مجموعة فريدة تُعرف باسم “ظن وأخواتها”، وهي الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. هذا يعني أن هذين المفعولين كانا في الأصل جملة اسمية مستقلة مكونة من مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، وعند دخول أحد هذه الأفعال عليها، يتم نسخ حكمها الإعرابي، فيتحول المبتدأ إلى مفعول به أول منصوب، والخبر إلى مفعول به ثانٍ منصوب.
لفهم هذه العملية بشكل أوضح، لنأخذ الجملة الاسمية “العلمُ نورٌ”. تتكون هذه الجملة من مبتدأ (العلمُ) وخبر (نورٌ). إذا أدخلنا عليها فعلاً مثل “ظنَّ”، نقول: “ظننتُ العلمَ نوراً”. نلاحظ هنا أن “العلم” تحولت من مبتدأ مرفوع إلى مفعول به أول منصوب، و”نور” تحولت من خبر مرفوع إلى مفعول به ثانٍ منصوب. هذا التحول هو جوهر عمل الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، حيث تدخل على الجملة الاسمية فتغير وظيفتها الإعرابية بالكامل، وهذا هو سبب تسميتها بـ “الأفعال الناسخة” أيضاً، تماماً مثل “كان وأخواتها” و”إن وأخواتها”.
الأساس النحوي: من الجملة الاسمية إلى المفعولين
تكمن أهمية دراسة الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر في فهم آلية “النسخ” التي تقوم بها. هذه الأفعال لا تكتفي بنصب مفعول به واحد كما هو شائع، بل تحتاج إلى مفعولين ليتم معنى الجملة. والخاصية التي تميزها عن غيرها من الأفعال التي تنصب مفعولين (مثل: أعطى، كسا) هي أن مفعوليها يكونان جملة اسمية مفهومة إذا تم حذف الفعل والفاعل. ففي مثالنا “ظننتُ العلمَ نوراً”، إذا حذفنا الفعل “ظننتُ”، عادت الجملة إلى أصلها “العلمُ نورٌ”، وهي جملة صحيحة ومكتملة المعنى.
هذه الأفعال، التي يُطلق عليها غالباً “ظن وأخواتها”، تنقسم بشكل أساسي إلى فئتين من حيث المعنى: أفعال القلوب (Heart Verbs) وأفعال التحويل (Verbs of Transformation). أفعال القلوب سميت كذلك لأن معانيها تتعلق بالإدراك الداخلي والعمليات الذهنية والعقلية التي لا تُرى بالحواس، مثل اليقين والشك والظن. أما أفعال التحويل، فتدل على تغيير وتحويل شيء من حالة إلى أخرى. إن فهم هذه الدلالات المعنوية ضروري جداً لاستيعاب عمل الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر واستخدامها بشكل صحيح ودقيق.
التصنيف الأول: أفعال اليقين ودلالاتها
أفعال اليقين (Verbs of Certainty) هي أول أقسام أفعال القلوب، وهي تدل على الاعتقاد الجازم وتحقق وقوع الخبر في ذهن المتكلم. هذه الأفعال تؤكد أن الفاعل متيقن من العلاقة بين المفعول الأول (المبتدأ سابقاً) والمفعول الثاني (الخبر سابقاً). أشهر هذه الأفعال هي: رأى (القلبية)، عَلِمَ، وَجَدَ، ألفَى، دَرَى، وتعلَّمْ (بمعنى اعلمْ). عند استخدام أي من هذه الأفعال، فإنها تنقل للمستمع شعوراً بالثقة التامة في صحة المعلومة.
على سبيل المثال، في جملة “علمتُ الصدقَ منجاةً”، استخدم الفعل “عَلِمَ” ليدل على يقين الفاعل بأن الصدق هو سبيل النجاة. وأصل الجملة قبل دخول الفعل الناسخ هو “الصدقُ منجاةٌ”. وبالمثل، قوله تعالى “إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا”، فالفعل “نرى” هنا ليس بمعنى الرؤية البصرية، بل بمعنى العلم واليقين الجازم بقرب يوم القيامة. من المهم التفريق بين أنواع “رأى” المختلفة لفهم عملها بشكل صحيح:
- رأى القلبية (V. of the Heart): هي التي تنتمي إلى الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وتفيد اليقين العقلي أو البصيرة. مثال: “رأيتُ الحقَّ واضحًا”، فالرؤية هنا ليست بالعين المجردة بل بالفهم والإدراك.
- رأى البصرية (V. of Sight): هذه تتعدى إلى مفعول به واحد فقط، وتكون بمعنى “أبصرَ” أو “شاهدَ”. مثال: “رأيتُ الطائرةَ في السماء”، فكلمة “الطائرة” مفعول به، وما يأتي بعدها قد يكون حالاً منصوبة مثل “رأيت الطائرةَ محلقةً”.
- رأى الحُلْمية (V. of Dreaming): وهي التي تتعلق بما يراه النائم في منامه، وتُعامل معاملة “رأى القلبية” فتنصب مفعولين. مثال: “رأى يوسفُ أحدَ عشرَ كوكباً”.
التصنيف الثاني: أفعال الرجحان ودلالاتها
القسم الثاني من أفعال القلوب هو أفعال الرجحان أو الظن (Verbs of Preponderance/Supposition)، وهي تفيد غلبة الظن بترجيح وقوع الخبر، ولكن دون الوصول إلى درجة اليقين الجازم. هذه الأفعال تترك هامشاً من الشك أو الاحتمال. أشهر هذه الأفعال هي: ظنَّ، خالَ، حسِبَ، زَعَمَ، عدَّ، حَجَا، وهَبْ (بصيغة الأمر). استخدام هذه الأفعال يعكس حالة عدم التيقن لدى الفاعل، فهو يرجح أمراً على آخر لكنه لا يجزم به.
على سبيل المثال، جملة “ظننتُ الامتحانَ سهلاً” تعني أنني كنت أرجح أن يكون الامتحان سهلاً، ولكن قد يظهر الواقع عكس ذلك. وكذلك في قوله تعالى “يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ”، فالفعل “يحسب” هنا يدل على ظن غير مطابق للواقع. وتتميز بعض هذه الأفعال بدلالات خاصة؛ فالفعل “زعم” غالباً ما يستخدم للإشارة إلى قول أو ظن يغلب عليه الشك أو الكذب. إن فهم هذه الفروق الدقيقة يساعد في إتقان استخدام الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر للتعبير عن درجات متفاوتة من اليقين والشك.
التصنيف الثالث: أفعال التحويل والصيرورة ودلالاتها
تختلف أفعال التحويل أو الصيرورة (Verbs of Transformation) عن أفعال القلوب في أنها لا تتعلق بالإدراك الذهني، بل تدل على تغيير وتحويل المفعول الأول من حالة إلى حالة أخرى ليصبح على صفة المفعول الثاني. هذه الأفعال مادية وملموسة في الغالب، وتفيد معنى “صيّر” أو “حوّل”. أشهر هذه الأفعال هي: صيَّرَ، ردَّ، تركَ، اتَّخَذَ، تَخِذَ، جَعَلَ، وَهَبَ.
على سبيل المثال، في جملة “صيّرَ الخبّازُ الدقيقَ خبزاً”، نجد أن الفعل “صيّر” قد أفاد تحويل “الدقيق” (المفعول به الأول) إلى “خبز” (المفعول به الثاني). وكذلك في قوله تعالى “وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا”، حيث أفاد الفعل “اتخذ” تحويل إبراهيم إلى منزلة الخليل. من المهم ملاحظة أن هذه الأفعال هي من ضمن الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، فجملة “إبراهيمُ خليلٌ” هي جملة اسمية صحيحة. بعض هذه الأفعال لها استخدامات متعددة يجب الانتباه إليها:
- جَعَلَ: قد تأتي بمعنى “صيّر” فتكون من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، كما في قوله تعالى “وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ إِنَاثًا”. وقد تأتي بمعنى “خلق” أو “أوجد” فتتعدى إلى مفعول واحد فقط، كقوله تعالى “وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ”.
- تَرَكَ: تستخدم بمعنى “صيّر” لتنصب مفعولين، كما في قوله تعالى “وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ”، أي صيّرناهم في حالة يموجون فيها.
- اتَّخَذَ: تأتي دائماً بمعنى التصيير والتحويل، مثل “اتخذتُ الكتابَ صديقاً”، وأصلها “الكتابُ صديقٌ”.
الإعراب النموذجي لجملة تتضمن فعلاً من هذه الأفعال
يعد إتقان إعراب الجمل التي تحتوي على هذه الأفعال خطوة أساسية لفهمها بعمق. الإعراب يكشف عن الوظيفة النحوية لكل كلمة ويؤكد قاعدة تحويل المبتدأ والخبر إلى مفعولين. لنأخذ جملة “حَسِبَ الطفلُ الأمرَ هيّناً” كنموذج تفصيلي للإعراب. أصل هذه الجملة قبل دخول الفعل هو “الأمرُ هيّنٌ”.
الإعراب التفصيلي:
- حَسِبَ: فعل ماضٍ مبني على الفتح، وهو من أفعال الرجحان التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر.
- الطفلُ: فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره.
- الأمرَ: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
- هيّناً: مفعول به ثانٍ منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح الظاهر على آخره.
نلاحظ أن الفعل “حسب” استوفى فاعله (الطفل)، ثم نصب المفعولين (الأمر، هيناً) اللذين كانا في الأصل مبتدأ وخبراً. هذا النموذج الإعرابي ينطبق على جميع الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، مع مراعاة التغيرات في علامات الإعراب حسب نوع الكلمة (مفرد، مثنى، جمع، أسماء خمسة). على سبيل المثال، في جملة “خالَ الطالبُ المعلمين غائبين”، تُعرب “المعلمين” مفعولاً به أول منصوباً بالياء لأنه جمع مذكر سالم، و”غائبين” مفعولاً به ثانياً منصوباً بالياء أيضاً.
خصائص الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر
تتميز هذه المجموعة من الأفعال بخصائص فريدة تجعلها باباً مستقلاً في النحو العربي. فهم هذه الخصائص يساعد على التمييز بينها وبين أنواع الأفعال الأخرى ويعزز القدرة على استخدامها بشكل صحيح. إن معرفة هذه السمات تمنح الدارس نظرة شاملة على طبيعة عمل الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر.
من أبرز هذه الخصائص أنها أفعال ناسخة، أي أنها تبطل الحكم الإعرابي الأصلي للجملة الاسمية.8 كما أن معظمها أفعال قلبية تتعلق بالإدراك الذهني، مما يضيف بعداً دلالياً عميقاً للجملة. والعلاقة بين المفعولين هي علاقة إسناد أصلية (مبتدأ وخبر)، مما يميزها عن أفعال العطاء. وفيما يلي تلخيص لأهم هذه الخصائص:
- أفعال ناسخة: تدخل على الجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر، فتنسخ حكمهما الإعرابي (الرفع) وتحولهما إلى مفعولين منصوبين.
- أفعال قلبية أو تحويلية: تنقسم دلالياً إلى أفعال تتعلق بالإدراك القلبي (اليقين والرجحان) أو أفعال تدل على التغيير والتحويل (الصيرورة).
- إمكانية حذف الفعل والفاعل: عند حذف الفعل الناسخ وفاعله، يمكن للمفعولين أن يعودا إلى أصلهما كمبتدأ وخبر مرفوعين، مكونين جملة اسمية صحيحة ومستقلة.
قاعدة الإلغاء: متى يُبطل عمل هذه الأفعال؟
“الإلغاء” هو مصطلح نحوي خاص بأفعال القلوب (اليقين والرجحان)، ويعني إبطال عمل الفعل في المفعولين لفظاً ومحلاً، أي كأن الفعل لم يدخل على الجملة من الأساس. يحدث الإلغاء جوازاً (وليس وجوباً) عندما يتوسط الفعل بين المفعولين الأصليين، أو عندما يتأخر عنهما. هذه القاعدة لا تنطبق على أفعال التحويل ولا على الأفعال الجامدة مثل “هبْ” و”تعلَّمْ”.
الحالة الأولى هي توسط الفعل، مثل: “زيدٌ، ظننتُ، قائمٌ”. في هذا المثال، توسط الفعل “ظننتُ” بين المبتدأ “زيدٌ” والخبر “قائمٌ”. هنا يجوز لنا إلغاء عمل الفعل، فنعرب “زيدٌ” مبتدأ و”قائمٌ” خبراً، وتكون جملة “ظننتُ” اعتراضية. ويجوز أيضاً إعمال الفعل، فنقول: “زيداً، ظننتُ، قائماً” على أن “زيداً” مفعول به أول مقدم، و”قائماً” مفعول به ثان مؤخر. الحالة الثانية هي تأخر الفعل، مثل: “زيدٌ قائمٌ، ظننتُ”. هنا أيضاً يجوز الإلغاء (وهو الأرجح عند النحاة) فنعرب “زيدٌ قائمٌ” مبتدأ وخبراً، أو الإعمال فنقول: “زيداً قائماً، ظننتُ”. إن فهم قاعدة الإلغاء يوضح مرونة اللغة العربية وقدرتها على التقديم والتأخير مع الحفاظ على المعنى.
قاعدة التعليق: متى يتوقف عمل الأفعال لفظاً لا محلاً؟
“التعليق” (Suspension) هو قاعدة أخرى خاصة بأفعال القلوب، وتعني إبطال عمل الفعل في اللفظ فقط، مع بقاء عمله في المحل الإعرابي للجملة التي تليه. ويكون التعليق واجباً (وليس جائزاً كالإلغاء) إذا جاء بعد الفعل أحد الأدوات التي لها الصدارة في الكلام، مما يمنع الفعل من التسلط على ما بعدها مباشرة في اللفظ. هذه الأدوات “تعلّق” الفعل عن العمل ظاهرياً.
أسباب التعليق متعددة، وأشهرها: لام الابتداء، “ما” النافية، “لا” و “إنْ” النافيتان، وأدوات الاستفهام (الهمزة، هل، أسماء الاستفهام). على سبيل المثال، في جملة “علمتُ لمحمدٌ مسافرٌ”، نجد أن لام الابتداء (“لَـ”) اتصلت بالمبتدأ “محمدٌ”، فعلّقت الفعل “علم” عن العمل لفظاً. فلا نقول “لمحمداً مسافراً”. ولكن الجملة الاسمية “لمحمدٌ مسافرٌ” كلها تكون في محل نصب “سدّت مسدّ مفعولي علم”. مثال آخر مع الاستفهام: “لا أدري أيُّهم فائزٌ”، فاسم الاستفهام “أيُّ” له الصدارة، وقد علّق الفعل “أدري” عن العمل، والجملة الاستفهامية “أيُّهم فائزٌ” سدّت مسد المفعولين. إن قاعدة التعليق تبرز أهمية ترتيب الكلمات وأثر الأدوات المختلفة على بنية الجملة التي تتضمن الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر.
الفروق الدقيقة بين الإلغاء والتعليق
على الرغم من أن كلتا القاعدتين (الإلغاء والتعليق) تبطلان عمل أفعال القلوب، إلا أن بينهما فروقاً جوهرية يجب على الدارس إدراكها. أولاً، الإلغاء جائز، بينما التعليق واجب. هذا يعني أن للمتكلم الخيار في الإلغاء، لكنه مجبر على التعليق عند وجود سببه. ثانياً، الإلغاء هو إبطال للعمل في اللفظ والمحل معاً، أما التعليق فهو إبطال للعمل في اللفظ فقط مع بقائه في المحل.
الفرق الثالث يكمن في السبب؛ فالإلغاء يحدث بسبب موقع الفعل (توسطه أو تأخره)، بينما يحدث التعليق بسبب وجود أداة لها الصدارة بعد الفعل. رابعاً، الإلغاء يختص بأفعال القلوب المتصرفة فقط، أما التعليق فيشمل أفعال القلوب المتصرفة أيضاً، وكلاهما لا يدخلان على أفعال التحويل أو الأفعال الجامدة. إن التمييز بين هاتين القاعدتين هو من دقائق علم النحو، وهو يعكس مدى الدقة التي عالج بها العلماء بنية الجملة العربية وتفاعلات مكوناتها، وهو أمر أساسي لمن يريد إتقان الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر.
تطبيقات وأمثلة من القرآن الكريم والشعر العربي
يعد القرآن الكريم والشعر العربي الفصيح المصدر الأغنى لتطبيقات قواعد اللغة، ومنها الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر. هذه الأمثلة الحية تساعد على ترسيخ الفهم وتوضح جماليات استخدام هذه الأفعال في سياقات بليغة. ففي القرآن الكريم، نجد أمثلة عديدة تعكس دقة الاختيار الفعلي للمعنى المراد.
من أمثلة أفعال الرجحان قوله تعالى: “وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا”، حيث نصب الفعل “أظن” الكاف كمفعول به أول، و”مثبورًا” كمفعول به ثانٍ. ومن أمثلة أفعال التحويل قوله تعالى: “فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا”، حيث نصب الفعل “جعل” ضمير الهاء كمفعول أول، و”هباءً” كمفعول ثانٍ. أما في الشعر العربي، فيقول الشاعر: “رأيتُ الله أكبرَ كلِّ شيءٍ … محاولةً وأكثرَهم جنودا”، حيث جاء الفعل “رأى” قلبياً بمعنى “علمتُ وتيقنتُ”، ونصب لفظ الجلالة “الله” مفعولاً به أولاً، و”أكبرَ” مفعولاً به ثانياً. هذه الشواهد تبرهن على أن دراسة الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ليست مجرد دراسة نظرية، بل هي مفتاح لفهم أعمق للنصوص العربية الأصيلة.
أفعال تتعدى لمفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر
من الضروري جداً، في سياق الحديث عن الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، أن نميزها عن مجموعة أخرى من الأفعال التي تنصب مفعولين أيضاً، ولكن ليس أصلهما مبتدأ وخبراً. هذه المجموعة الثانية من الأفعال تعرف بـ “أفعال المنح والعطاء”، وأشهرها: أعطى، منح، كسا، ألبس، سأل، وهب، منع.
الفرق الجوهري يكمن في أنه إذا أخذنا المفعولين في جملة هذه الأفعال، فإنهما لا يكونان جملة اسمية مفيدة. على سبيل المثال، في جملة “أعطيتُ الفقيرَ ثوباً”، المفعول الأول هو “الفقيرَ” والمفعول الثاني هو “ثوباً”. إذا حاولنا تكوين جملة اسمية منهما (“الفقيرُ ثوبٌ”)، نجد أن المعنى غير مستقيم ولا مفهوم. لذلك، يُطلق على المفعول الأول في هذا الباب “فاعل في المعنى”، فكأن الفقير هو من أخذ الثوب. إن هذا التمييز أساسي لتجنب الخلط بين البابين، وللتأكيد على الخصيصة الفريدة التي تتمتع بها الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر.
خاتمة: أهمية فهم الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر
في ختام هذا المقال الشامل، نؤكد أن فهم وإتقان باب الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر ليس مجرد ترفٍ نحوي، بل هو ضرورة لكل طالب علم وباحث في اللغة العربية. هذه الأفعال، المعروفة بـ “ظن وأخواتها”، تمثل جسراً بين الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وتكشف عن عمق ومرونة البنية النحوية العربية. من خلال أقسامها الثلاثة (اليقين، الرجحان، التحويل)، وقواعدها الخاصة (الإلغاء والتعليق)، تقدم هذه الأفعال للمتكلم أدوات دقيقة للتعبير عن درجات مختلفة من الإدراك والتغيير.
إن القدرة على تحليل جملة تحتوي على فعل من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وإعرابها إعراباً صحيحاً، والتمييز بينها وبين الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، هي مهارة أساسية تفتح آفاقاً أوسع لفهم النصوص المتقدمة، من القرآن الكريم إلى الشعر العربي، وتزيد من تقدير الدارس لجمال ودقة اللغة العربية. لذا، فإن الممارسة المستمرة والتطبيق العملي لما تم تعلمه يظل هو السبيل الأمثل لترسيخ هذه القواعد في الذهن والوصول إلى درجة الإتقان.
سؤال وجواب
١. ما هي الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر؟
هي مجموعة من الأفعال الناسخة، تُعرف بـ “ظن وأخواتها”، تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويُسمى مفعولاً به أولاً، وتنصب الخبر ويُسمى مفعولاً به ثانياً.
٢. كيف يتم تصنيف هذه الأفعال؟
تُصنف إلى ثلاثة أقسام رئيسية حسب معناها: أفعال اليقين (مثل: عَلِمَ، رأى القلبية، وَجَدَ) التي تفيد الاعتقاد الجازم، وأفعال الرجحان (مثل: ظنَّ، حسِبَ، خالَ) التي تفيد غلبة الظن، وأفعال التحويل (مثل: صيَّرَ، جعلَ، اتخذَ) التي تفيد تغيير الشيء من حالة إلى أخرى.
٣. ما الفرق بينها وبين أفعال مثل “أعطى” و”كَسا”؟
الفرق الجوهري هو أن مفعولي “ظن وأخواتها” أصلهما مبتدأ وخبر، ويمكنهما تكوين جملة اسمية مفيدة عند حذف الفعل والفاعل (مثال: ظننتُ الجوَّ جميلاً ← الجوُّ جميلٌ). أما أفعال مثل “أعطى” و”كسا”، فمفعولاها ليس أصلهما مبتدأ وخبراً، ولا يكوّنان جملة مفيدة (مثال: أعطيتُ المحتاجَ مالاً ← المحتاجُ مالٌ، جملة غير صحيحة).
٤. ما هو “الإلغاء” في باب ظن وأخواتها؟
الإلغاء هو إبطال عمل أفعال القلوب (اليقين والرجحان) في اللفظ والمحل معاً، ويكون جائزاً إذا توسط الفعل بين المفعولين (زيدٌ ظننتُ قائمٌ) أو تأخر عنهما (زيدٌ قائمٌ ظننتُ).
٥. ما هو “التعليق” في باب ظن وأخواتها؟
التعليق هو إبطال عمل أفعال القلوب لفظاً فقط، مع بقاء عملها في المحل، ويكون واجباً إذا جاء بعد الفعل أداة لها الصدارة في الكلام، مثل لام الابتداء أو أدوات الاستفهام أو النفي (مثال: علمتُ لمحمدٌ مسافرٌ).
٦. ما الفرق الرئيسي بين الإلغاء والتعليق؟
الإلغاء جائز ويبطل العمل لفظاً ومحلاً، بينما التعليق واجب ويبطل العمل لفظاً فقط. الإلغاء سببه موقع الفعل، أما التعليق فسببه وجود أداة معينة بعد الفعل.
٧. هل كل أخوات “ظن” تقبل الإلغاء والتعليق؟
لا، فالإلغاء والتعليق يختصان بأفعال القلوب المتصرفة فقط (أفعال اليقين والرجحان). أما أفعال التحويل (مثل: صيّر، جعل) والأفعال الجامدة (مثل: هَبْ، تعلَّمْ) فلا يدخلها الإلغاء ولا التعليق.
٨. كيف تُعرب جملة “رأيتُ العلمَ نوراً”؟
رأيتُ: فعل ماضٍ مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل.
العلمَ: مفعول به أول منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
نوراً: مفعول به ثانٍ منصوب وعلامة نصبه الفتحة.
٩. هل يمكن أن يأتي المفعول الثاني جملة؟
نعم، يمكن أن يأتي المفعول الثاني جملة (اسمية أو فعلية) أو شبه جملة (ظرف أو جار ومجرور)، تماماً كما يأتي الخبر في الجملة الاسمية. مثال: “ظننتُ الطالبَ يقرأُ الدرسَ”، فجملة “يقرأ الدرس” في محل نصب مفعول به ثانٍ.
١٠. ما معنى “رأى القلبية” و”رأى البصرية”؟
“رأى القلبية” هي التي تفيد العلم واليقين، وهي من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر (مثال: رأيتُ الصدقَ منجاةً). أما “رأى البصرية” فتفيد المشاهدة بالعين، وتتعدى إلى مفعول به واحد فقط (مثال: رأيتُ الهلالَ في السماء).