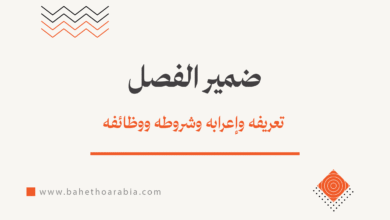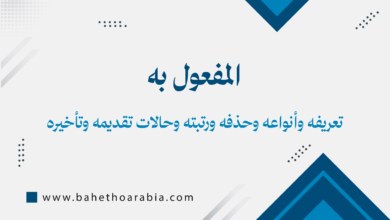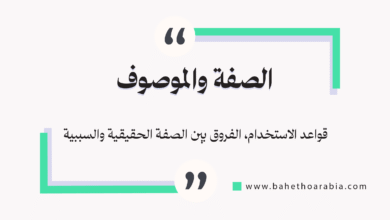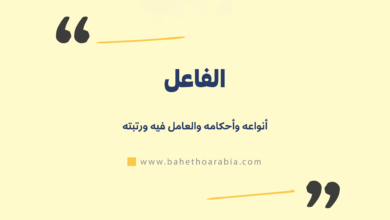تعريف الأداة في النحو العربي: كيف تطور مفهومها عبر العصور؟
ما الفرق بين الأداة وحرف المعنى في التطبيق النحوي؟
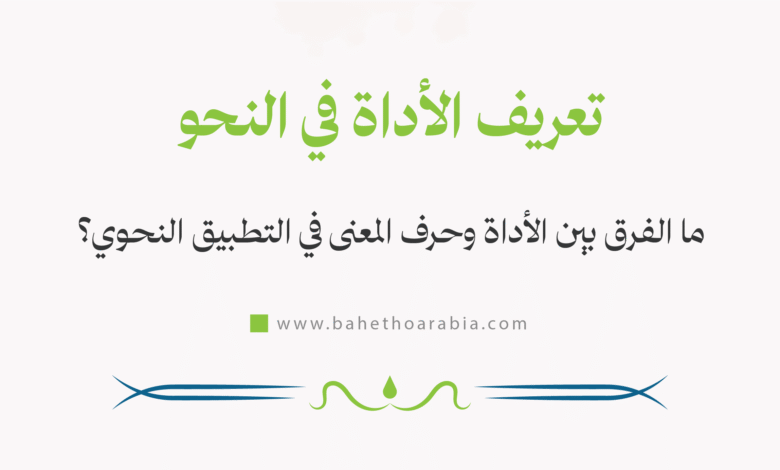
يمثل البحث في الأدوات النحوية أحد المحاور الجوهرية في دراسة اللغة العربية، إذ تشكل هذه المفردات الصغيرة جسوراً معنوية تربط بين أجزاء الكلام وتضفي عليه دلالات جديدة. ولقد شهد مفهوم الأداة تطوراً ملحوظاً منذ عصر النحاة الأوائل حتى استقر على ما هو عليه في كتب النحو المتأخرة.
المقدمة
تُعَدُّ الأدوات من أهم عناصر التركيب اللغوي في العربية، فهي تلك المفردات التي تؤدي وظائف نحوية ودلالية محددة في سياق الكلام. وقد اهتم النحويون العرب منذ القدم بدراسة هذه الأدوات وتصنيفها، بدءاً من تسميتها بحروف المعاني، ثم توسيع هذا المفهوم ليشمل بعض الأسماء والأفعال التي تؤدي وظائف مشابهة. ويكشف تتبع تطور مصطلح الأداة عن ثراء الفكر النحوي العربي وقدرته على التكيف مع متطلبات التحليل اللغوي. فما مفهوم الأداة في اللغة والاصطلاح؟ وكيف انتقل مصطلح الحرف إلى الأداة؟ وما العلاقة بين المصطلحين؟ هذه الأسئلة وغيرها سنحاول الإجابة عنها في هذه المقالة التي تستعرض تطور مفهوم الأداة من الاستخدام اللغوي إلى التطبيق النحوي.
مفهوم الأداة لغة واصطلاحاً
مفهوم الأداة في اللغة الآلة، قيل: لكل ذي حرفة أداة، وهي آلته، وجمعها أدوات. وتطلق أيضاً على ماكان يعرف لدى النحويين بـ (حروف المعاني) وحرف المعنى في الاصطلاح التي تقيم حرفته الحليم النحوي يشكل القسم الثالث المصادر إلى أن أول من قسّم الكلام إلى اسم، وفعل، وحرف، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – حيث قال (فالكلم اسم، وفعل، وحرف. فالاسم ما دلّ على المسمى، والفعل ما دل على الحركة، والحرفُ ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل) وقد ترسّخ هذا التقسيم عند سيبويه ومن جاء بعده من النحويين، فصارت هذه المصطلحات تعبر عن أقسام الكلام، ومنها الحرف، وانصبت جهود النحويين على تحديدها، وتعريفها، فما الحرف في اللغة؟ وكيف انتقل إلى المعنى النحوي؟
ويكشف التأمل في هذا المفهوم عن ارتباط وثيق بين المعنى اللغوي والاستخدام الاصطلاحي، فالأداة بوصفها آلة تؤدي وظيفة محددة في الحرفة، تماثل في وظيفتها النحوية تلك المفردات التي تربط بين أجزاء الكلام وتحدد العلاقات بينها. وهذا الانتقال من المعنى اللغوي إلى المعنى النحوي يعكس براعة النحاة في اختيار المصطلحات المعبرة عن المفاهيم المقصودة. ولقد أدرك النحويون الأوائل أهمية هذا القسم من الكلام، فأفردوا له دراسات مستفيضة، وحاولوا تحديد معالمه بدقة.
الحرف بين المعنى اللغوي والاصطلاح النحوي
للحرف معان أصلية، أهمها أنه حدُّ الشيء وطرفه، وناحيته ومنه قولهم: حرفُ الجبل، أي طرفه، وهو أعلاه المحدد. وناقةٌ حرفٌ. أي: ضامر تحددت أعطافها بالضمر والهزال. ومن معانيه التغيُّر. وهو مسيل الماء، أن الماء قد سال عنه، فانحرف منه: الحرف ولم يستقم، فيثبت عليه. والتحريف في الكلام تغييره عن معناه، كانه ميل والتحريف في به إلى غيره قال تعالى في صفة اليهود (يُحَرِّفُونَ الكَلِم عن مواضِعِه): أي يغيرون معاني التوراة بالتمويهات والتشبيهات.
ثم انتقل الحرف من هذه المعاني إلى معان اصطلاحية أخرى: فمن ذلك إطلاقه على الحرف الهجائي: أن الحرف حد منقطع الصوت، وطرفه وقد نُسب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي كتاب سماه (الحروف) يعني به حروف الهجاء بين فيه ما يعنيه اسم كل حرف. والحرف يعني (اللغة) أو (اللهجة). قال عليه الصلاة والسلام: (إن هذا القرآن أُنزِلَ على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه) ومن دلالاته (القراءة) تقول: هذا في حرف ابن مسعود، أي: في قراءة ابن مسعود.
استخدامات مصطلح الحرف في التراث النحوي
سمى النحويون الأوائل الأسماء، والأفعال، حروفاً. فالخليل يسمِّي: سمعتُ، وقرأت، ووجدت، وكتبت، حروفاً في الكتاب الذي نسب إليه، وفعل مثله خلف الأحمر (ت ۱۸۰ هـ) فعمم مصطلح الحرف على الأسماء والأفعال ويتفشى هذا التعميم عند سيبويه أيضاً. قال: تقول عرفته زيداً، ثم تقول: عرفته بزید، فهو سوی، فإنَّما تدخل في سمّيت، وكنَّيت، على حد ما دخلت في عرَّفته فهذه الحروف كان أصلها في الاستعمال أن توصل بحرف الإضافة. ويشير محمد بن السرّي أبو بكر ابن السراج إلى هذا التعميم عند الكوفيين الأوائل الذين يخلطون الأسماء بالحروف، قال ويخلطون الأسماء بالحروف، فيقولون: حروف الخفض: أمام، وقدام، وخلف وقبل… ومع، وعن، وفي، وعلى، ومِن، وإلى، وحذاء، وإزاء.
وتكشف هذه الاستخدامات المتعددة لمصطلح الحرف عن مرحلة من عدم الاستقرار في المصطلح النحوي، حيث كان النحاة يبحثون عن التسمية الأدق للتعبير عن المفاهيم النحوية. ثم أخذ مفهوم الحرف يتحدد عند نحويي القرن الثالث أو ما تلاه والمطلق فكانوا يضيفون كلمة (المعنى) إلى الحرفة تمييزاً م على حرف المعنى إلى الحرف تمييزاً له من باقي الدلالات. إن انتقال الحرف من المعنى اللغوي إلى المعنى النحوي له ما يسوِّغه، فهو يعبر عن موقعه ومعناه بشكل دقيق.
تحديد مفهوم حرف المعنى ووظيفته
فحرف المعنى يقع على طرف الأسماء والأفعال، وهو بدخوله على المفردات والجمل يضفي معاني جديدة لم تكن من قبل، فابن السراج وغيره من النحويين يرون أن حرف المعنى يُغير المعنى في الكلام فموقع الحرف ووظيفته أمليا على النحويين أن يطلقوه مصطلحاً نحوياً، وأن يجعلوه قسماً ثالثاً للكلم. بدأ مفهوم حرف المعنى بسيطاً، فسیبویه حدّه بأنه حرف جاء المعنى، ليس باسم، ولا فعل ثم أوضح دلالته بالأمثلة فقال: “وأما ما جاء لمعنى وليس باسم، ولا فعل فنحو: ثمَّ، وسوف، وواو القسم، ولام الإضافة ونحوها.
إن هذا التعريف الذي وضِّح بالأمثلة جعل النحويين التالين يحدونه بحدود كثيرة، فقد رأى بعضهم أن الحرف هو ما ارتبط معناه بغيره، وذهب بعضهم إلى أن الحرف مالم يصلح أن يكون أحد طرفي الإسناد، ورأى آخرون أنه ما تجرد من أدلة الاسم والفعل. وتشير المصادر النحوية إلى أن النحويين لم يلتزموا بالمصطلح التزاماً حرفياً: لأنهم وجدوا في التطبيق بعض الأسماء والأفعال تشاكل الحرف، وتتضمن معناه، فوسعوا دلالة حروف المعاني لتشمل أسماء وأفعالاً، فالخليل يسمي بعض الأسماء الظرفية وغير الظرفية حروفاً في الشرط.
التضمين والمشابهة في حروف المعاني
ويشير سيبويه صراحةً إلى تضمُّن بعض الأسماء والأفعال معنى حرف من حروف المعاني، فقال: “فحرف الاستثناء (إلا) وما جاء من الأسماء فيه معنى (إلا) فغير وسوى… وما جاء من الأفعال فيه معنى (إلا) فلا يكون، وليس، وعدا، وخلا، وما فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة فحاشا وخلا في بعض اللغات. وقد تنبه النحويون جميعاً على هذا التضمين، فوقفوا عنده. وأشاروا إليه، ووضحوه. إلا أنهم وسعوا مفهومه، فصار يعني عندهم المشابهة، وصار التضمين أحد أشكال المشابهة.
وتشير هذه المصادر أيضاً إلى أنهم وسعوا مفهوم حرف المعنى ليشمل بعض الحروف التي تدخل في علم الصرف، كحروف المضارعة، والإعراب والزيادة، والتأنيث، والتثنية، والجمع، والتنوين، فلا نكاد نحظى بإشارة منهم تفرِّق بين الصنفين سوى تلك الإشارة التي أوردها أحمد بن عبد النور المالقي (ت ۷۰۲ هـ)، وبين فيها أن من الحروف ما ليس له علاقة بحروف المعاني، بل يدخل في علم التصريف. وكان من نتيجة ذلك أن جمع النحويون في كتبهم حروف المعاني وما تضمن معناها، مقرونة بالأسماء والأفعال التي شاكلتها، كما أوردوا بعض حروف التصريف في سياقها.
ظهور مصطلح الأدوات وتطوره
إنّ توسيع مفهوم حرف المعنى الذي طبّقه النحويون في كتبهم يجعلنا نعتقد أنهم تنبهوا على قصوره عن استيعاب تلك المفردات التي تضمنت معناه، وأدت وظيفته في التركيب وأنهم وجدوا أنه يصلح لقسمة الكلم نظرياً إلا أنهم وجدوا في التطبيق بعض الأسماء والأفعال تصلح أسماء، وأفعالاً، وتصلح حروفاً: أنها شابهت الحرف وتضمنت معناه لذلك بدأ النحويون يستخدمون مصطلح (الأدوات). يبدو أن سيبويه أول من استخدم مصطلح الأدوات للدلالة على عمل الحروف ومعانيها، قال: “وللقَسَم والمُقْسَم به أدوات في حروف الجرِّ لكنّه لم يعد إلى ذكرها مرة أخرى، لأنه اكتفى بمدلول الحرف.
أما خلف الأحمر فإنه يطلقه على حروف المعاني العاملة، وما عمل عملها، قال: “العربية على ثلاثة: اسم، وفعل، وحرف جاء لمعنى، وهذا الحرف هو الأداة التي ترفع، وتنصب، وتخفض الاسم، وتجزم الفعل. وعبَّر المُبَرِّدْ محمد بن يزيد وإبراهيم بن السري الزجاج عن الأدوات بمدلولها اللغوي، فالأدوات عندهما آلات يتوصل بوساطتها إلى المعاني المقصودة في السياق، ولها عملها، وتشتمل على حروف المعاني وغيرها من الأسماء والأفعال، يقول المبرد: “ونذكر من الآلات التي على ثلاثة أحرف ما يدل على ما بعده ثم يذكر (عند ولكن، وأمان) ويذكر صراحة أن القسم أدوات توصل الحلف إلى المقسم به، وحروف النفي عند الزجاج آلات أيضاً، يقول: “وآلة الجَحْدِ: لا، وما، ولم، ولن، وليس) فقرن (ليس). وهي فعل، بالحروف. ويسمي ابن السراج حروف المعاني أدوات؛ لأنها تغير ولا تتغيرُ.
استخدام مصطلح الأدوات عند النحاة المتأخرين
ويشير ابن جني إلى أن حروف المعاني أدوات؛ لأنها تقع في أوائل الكلام وأواخره، فهي كالحدود والحروف له. وذهب الهروي علي بن محمد مذهب ابن جنِّي، فسمى حروف المعاني أدوات، قال: وجميع الألفات التي في أوائل الأدوات هي ألفات القطع نحو (إلى، وإلا، وإما، وإن، وأن، وما أشبه ذلك). ورأى النحويون الآخرون أن الأدوات ترادف في معناها حروف المعاني، وتعم لتشمل عدداً من المفردات الاسميّة والفعلية. ويلاحظ أن أغلبهم ظل ملتزماً بقسمة الكلِم من حيث هو: اسم وفعل، وحرف جاء لمعنى واكتفوا بذكر مصطلح الأدوات إشارة أو تلويحاً.
وتشير كتب التراجم إلى أن بعض النحويين قد ألفوا كتباً خاصة بالحروف والأدوات فجمعوا المصطلحين، فالميداني أحمد بن محمد النيسابوري (ت ٥١٨ هـ) صنف كتاباً سماه (الهادي في الحروف والأدوات) وابن القيم محمد بن أبي بكر (ت ٕ٧٥١ هـ) ألف (معاني الأدوات والحروف).
وتذكر كتب التراجم أيضاً أن آخرين من النحويين وضعوا كتباً بعنوان (الأدوات) أو (الأدوات في النحو)، دون الإشارة إلى مصطلح الحروف مثل كتاب (الأدوات في النحو) لمحمد بن أحمد بن الأزهر (ت ٤٣٧ هـ). وكتاب (الأدوات) لمحمد بن علي الذي يعرف بابن حميدة (ت ٥٥٠ هـ). وكتاب (الأدوات) لأبي الحسن محمد بن محمد الخاوراني الخلاطي (ت ٥٧١ هـ). نستنتج من ذلك أن مصطلح الأدوات قد استخدم مرادفاً لحروف المعاني عند النحويين القدماء كسيبويه ومن جاء بعده وأنه انتشر في الكتب النحوية ولاسيما التي ألفت في القرن الرابع وما تلاه، فما مفهوم الأداة؟
مفهوم الأداة عند النحويين وعلاقتها بالحرف
اهتم النحويون اهتماماً بالغاً بحرف المعنى، فحدوه، وساقوا الأدلة التي تميزه من أقسام الكلم. يشهد على ذلك الحدود والتعريفات الكثيرة التي تحفل بها مصادر النحو. إلا أن هذا الاهتمام بمفهوم حرف المعنى كان يقابله إعراض وتجاهل لمفهوم الأداة سوى تلك الإشارات التي أبداها بعضهم، والتي تدل على أن معنى الأداة غالباً ما يرادف معنى الحرف، فكأن اهتمامهم بالحرف قد أغناهم من توضيح مفهوم الأداة، فاكتفوا بما بذلوه في تحديد مفهوم الحرف، أو أن مفهوم الحرف عندهم ينطبق على مفهوم الأداة. يدل على ذلك أنهم كما وسعوا مفهوم الحرف وسعوا مفهوم الأداة.
فالنحويون الذين وضعوا كتباً خاصة بحروف المعاني والأدوات ضمنوا كتبهم الحروف، وما شابهها من الأسماء والأفعال فذكروا أسماء الأفعال، والأسماء الموصولة، وبعض حروف التصريف، وغير ذلك. وقد عبر ابن هشام الأنصاري في (مغني اللبيب) عن ذلك. فاستخدم مصطلح المفردات – وهو مصطلح جديد لم يسبق إليه للدلالة على الحروف، وما تضمن معناها، أو شاكلها، فكأنه أراد أن يبين قصور حرف المعنى والأداة عن اشتمال ما أورده في (المغني). يقول في تفسير المفردات، وذكر أحكامها: “وأعني بالمفردات الحروف. وما تضمن معناها من الأسماء والظروف فإنها المحتاجة إلى ذلك، وقد رتبتها على حروف المعجم ليسهل تناولها، وربما ذكرت أسماء غير ذلك، وأفعالاً ليس الحاجة إلى شرحها.
ابن هشام والسيوطي ومفهوم المفردات والأدوات
ويستدل من المفردات التي أوردها ابن هشام أن مفهوم الحرف عنده يتسع ليشمل أسماء وأفعالاً، بعضها يتضمن معنى الحرف، أو يشاكله، فهو يذكر (قط، وكلا، وكلتا، وبعضها لا يتضمنه مع وعند، وثم) وبعض أسماء الأفعال، والضمائر، وغير ذلك. مع العلم أنه ذكر مصطلح (الأدوات) مراراً، ولم يشر إلى ما يخالف النحويين بشأن مرادفة الأدوات الحروف المعاني، وأنه ذهب مذهبهم في تحديد حرف المعنى.
ومما يؤكد هذا الأمر أن جلال الدين السيوطي قد عكس هذا التصور في المفهوم، فهو يشير صراحة إلى أن الأدوات تعني الحروف، وما شاكلها من الأسماء والأفعال، قال: “النوع الأربعون في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، وأعني بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء، والأفعال، والظروف. وقد أفرد هذا النوع بالتصنيف خلائق من المتقدمين كالهروي في الأزهية، والمتأخرين كابن أم قاسم في الجنى ثم أورد الأدوات التي عناها تطبيقاً لتعريفه، وبين السابق، فجمع بين حروف المعاني، وما تضمن معناها أو ما شابهها كالأسماء الموصولة، والظروف، وأسماء الأفعال، وغير ذلك كما أورد أسماء وأفعالاً ليس لها علاقة بالحروف والأدوات مثل (ظنَّ. وجعل، وأَحدٌ، واللهمّ. وسواء، والآن، وتبارك).
رؤية السيوطي الشاملة للأدوات
فالسيوطي يرى أن كتابي (الأزهية في علم الحروف) و(الجني الداني) كتابا أدوات وأن الأدوات تتسع لتشمل ما شاكل الحروف من الأسماء والأفعال، والمشاكلة أعم من التضمين. إن هذا التعميم الذي انساق إليه النحويون جعلهم يقحمون طوائف من الأسماء والأفعال لا تندرج في مفهوم الحرف، ولا تنسلك فيما تضمن معناه، لأنها تدل على تلك المشابهة التي حصرها النحويون في أوجه ستة هي:
أوجه المشابهة الستة بين الأسماء والأفعال والحروف
١- الشبه الوضعي: وهو أن يكون الاسم على حرف أو حرفين مثل (التاء) في قمت، و(نا) من (قمنا) فإنهما أشبها لام الجر وفاء العطف وقد، وهل، وبل، في عدد الحروف.
٢- الشبه المعنوي أو التضميني: وهو أن يتضمن اسم أو فعل معنى من حروف المعاني، فيصير مؤدياً لوظيفته ومعناه مثل: أسماء الشرط التي تضمنت معنى (إن)، وأسماء الاستفهام التي تضمنت معنى همزة الاستفهام، وأسماء الاستثناء وأفعاله التي تضمنت معنى (إلا).
٣- الشبه الافتقاري: وهو أن يكون الاسم مفتقراً إلى ما بعده لتوضيح معناه كالأسماء الموصولة، والظروف.
٤- الشبه الاستعمالي: مثل أسماء الأفعال التي تعمل عمل الأفعال، ولا تتأثر في العوامل، ولا تقبل أدلة الفعل.
٥- الشبه الافتراضي: مثل أسماء الإشارة، فإنها تتضمن معنى الإشارة، وهذا المعنى لم تضع العرب له حرفاً.. ولكنه من المعاني التي يفترض أن تؤدى بالحرف.
٦- الشبه الإهمالي: وهو أن الاسم غير عامل، ولا معمول، كالحروف المهملة في فواتح السور.
التحديد الدقيق لمفهوم الأداة
إن الذي دفع النحويين إلى استقصاء أوجه المشابهة تلك هو محاولتهم تعليل البناء والجمود في طائفة من المفردات الاسمية والفعلية، لذلك أرى أن تحديد مفهوم الأداة بالتضمين أمر ضروري للتخلص من تعميم النحويين الذي أدى إلى إضاعة الحدود بين ما تضمن معنى الحرف، وبين ما شاكله فالأدوات التي سيبنى عليها هذا الكتاب هي: حروف المعاني والأسماء والأفعال التي تضمنت معنى حرف من حروف المعاني فقط.
وبناء على ذلك سوف تستبعد الأسماء والأفعال التي شابهت الحروف، سواء أكانت المشابهة وضعية، أم افتقارية أم افتراضية أم إهمالية أم استعمالية، كما تستبعد الحروف التي لا تؤدي معنى تركيبياً: لأن ميدانها علم الصرف، وهذا التحديد يتفق وتقسيم النحويين للكلم، وينسجم ونظرتهم إلى مواقع الأدوات ووظيفتها في التركيب.
الخاتمة
لقد شهد مفهوم الأداة في التراث النحوي العربي تطوراً تدريجياً بدأ من التسمية البسيطة لحروف المعاني، ثم توسع ليشمل ما تضمن معناها من الأسماء والأفعال. وقد عكست هذه الرحلة المصطلحية عمق التفكير النحوي عند علماء العربية وقدرتهم على التكيف مع متطلبات التحليل اللغوي. ويمكن القول إن التمييز بين الحرف والأداة لم يكن واضحاً عند أغلب النحويين، إذ كانوا يستخدمون المصطلحين بمعنى واحد في كثير من الأحيان.
وتبقى الأداة في جوهرها تلك المفردة الصغيرة التي تؤدي وظيفة نحوية كبيرة في التركيب اللغوي، سواء أكانت حرفاً خالصاً، أم اسماً أو فعلاً تضمن معنى الحرف. ولعل من أهم ما يمكن استخلاصه من هذا العرض هو ضرورة التحديد الدقيق لمفهوم الأداة بالاعتماد على معيار التضمين، مما يسهم في توضيح الحدود بين الأدوات الحقيقية وبين ما شابهها من المفردات دون أن يتضمن معناها. وبهذا التحديد نستطيع فهم الأدوات فهماً دقيقاً يخدم الدرس النحوي والتطبيق اللغوي السليم.
الأسئلة الشائعة
١. ما الفرق الجوهري بين الأداة وحرف المعنى في النحو العربي؟
الأداة مصطلح أوسع من حرف المعنى، فهي تشمل حروف المعاني بالإضافة إلى الأسماء والأفعال التي تضمنت معنى حرف من حروف المعاني. بينما حرف المعنى هو ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل فقط. وقد استخدم النحويون المصطلحين بمعنى واحد في كثير من الأحيان، لكن التطبيق العملي أظهر حاجتهم لمصطلح الأدوات لاستيعاب المفردات التي تؤدي وظيفة الحرف دون أن تكون حرفاً خالصاً.
٢. من أول من قسّم الكلام إلى اسم وفعل وحرف في التراث النحوي؟
تشير المصادر النحوية إلى أن أول من قسّم الكلام إلى اسم وفعل وحرف هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث قال: فالكلم اسم وفعل وحرف، فالاسم ما دلّ على المسمى، والفعل ما دل على الحركة، والحرف ما جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل. وقد ترسّخ هذا التقسيم عند سيبويه ومن جاء بعده من النحويين.
٣. لماذا أضاف النحويون كلمة المعنى إلى الحرف ليصبح حرف المعنى؟
أضاف النحويون كلمة المعنى إلى الحرف تمييزاً له من باقي الدلالات الأخرى للحرف، فالحرف يطلق على الحرف الهجائي، وعلى اللغة أو اللهجة، وعلى القراءة، كما كان النحويون الأوائل يسمون الأسماء والأفعال حروفاً. فجاءت إضافة كلمة المعنى للتمييز بين هذه الاستخدامات المتعددة، وللدلالة على القسم الثالث من أقسام الكلم الذي يؤدي معنى نحوياً محدداً.
٤. ما المقصود بالتضمين في حروف المعاني؟
التضمين هو أن يتضمن اسم أو فعل معنى حرف من حروف المعاني، فيصير مؤدياً لوظيفته ومعناه في التركيب. ومن أمثلته أسماء الشرط التي تضمنت معنى إن، وأسماء الاستفهام التي تضمنت معنى همزة الاستفهام، وأسماء الاستثناء وأفعاله التي تضمنت معنى إلا. وقد تنبه النحويون جميعاً على هذا التضمين ووضحوه، ثم وسعوا مفهومه ليشمل المشابهة بشكل عام.
٥. ما أوجه المشابهة الستة بين الأسماء والأفعال والحروف؟
أوجه المشابهة الستة هي: الشبه الوضعي وهو أن يكون الاسم على حرف أو حرفين، والشبه المعنوي أو التضميني وهو تضمين معنى حرف، والشبه الافتقاري وهو افتقار الاسم إلى ما بعده لتوضيح معناه، والشبه الاستعمالي كأسماء الأفعال التي تعمل عمل الأفعال، والشبه الافتراضي كأسماء الإشارة، والشبه الإهمالي وهو أن الاسم غير عامل ولا معمول. وقد حصر النحويون هذه الأوجه لتعليل البناء والجمود.
٦. من أول من استخدم مصطلح الأدوات في النحو العربي؟
يبدو أن سيبويه أول من استخدم مصطلح الأدوات للدلالة على عمل الحروف ومعانيها، حيث قال: وللقسم والمقسم به أدوات في حروف الجر. لكنه لم يعد إلى ذكرها مرة أخرى لأنه اكتفى بمدلول الحرف. ثم توسع استخدام المصطلح عند خلف الأحمر الذي أطلقه على حروف المعاني العاملة وما عمل عملها، وانتشر في الكتب النحوية بعد القرن الرابع الهجري.
٧. كيف عبر المبرد والزجاج عن مفهوم الأدوات؟
عبّر المبرد محمد بن يزيد والزجاج إبراهيم بن السري عن الأدوات بمدلولها اللغوي، فالأدوات عندهما آلات يتوصل بوساطتها إلى المعاني المقصودة في السياق، ولها عملها، وتشتمل على حروف المعاني وغيرها من الأسماء والأفعال. فالمبرد يسمي بعض الآلات أدوات، والزجاج يسمي حروف النفي آلات للجحد، وقد قرن ليس وهي فعل بالحروف في هذا السياق.
٨. ما المصطلح الجديد الذي استخدمه ابن هشام في مغني اللبيب؟
استخدم ابن هشام الأنصاري في مغني اللبيب مصطلح المفردات، وهو مصطلح جديد لم يسبق إليه للدلالة على الحروف وما تضمن معناها أو شاكلها. فقال: وأعني بالمفردات الحروف وما تضمن معناها من الأسماء والظروف فإنها المحتاجة إلى ذلك. وقد رتبها على حروف المعجم ليسهل تناولها، وذكر أسماء وأفعالاً أخرى ليس الحاجة إلى شرحها.
٩. كيف حدد السيوطي مفهوم الأدوات في كتبه؟
حدد جلال الدين السيوطي مفهوم الأدوات بأنها الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف. وقال: النوع الأربعون في معرفة معاني الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، وأعني بالأدوات الحروف وما شاكلها من الأسماء والأفعال والظروف. ثم أورد الأدوات تطبيقاً لتعريفه فجمع بين حروف المعاني وما تضمن معناها أو ما شابهها، بل أورد أسماء وأفعالاً ليس لها علاقة بالحروف.
١٠. ما الكتب المؤلفة في الحروف والأدوات في التراث النحوي؟
ألف النحويون كتباً عديدة في هذا الموضوع منها: كتاب الهادي في الحروف والأدوات للميداني أحمد بن محمد النيسابوري، ومعاني الأدوات والحروف لابن القيم محمد بن أبي بكر، والأدوات في النحو لمحمد بن أحمد بن الأزهر، والأدوات لمحمد بن علي ابن حميدة، والأدوات لأبي الحسن محمد بن محمد الخاوراني الخلاطي، والأزهية في علم الحروف للهروي، والجني الداني لابن أم قاسم.