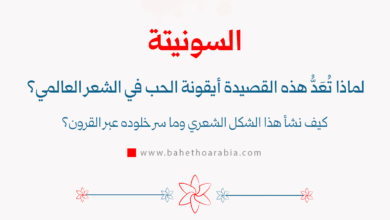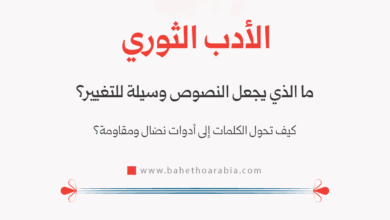الأدبية: جوهر الإبداع الفني في اللغة والنقد الحديث
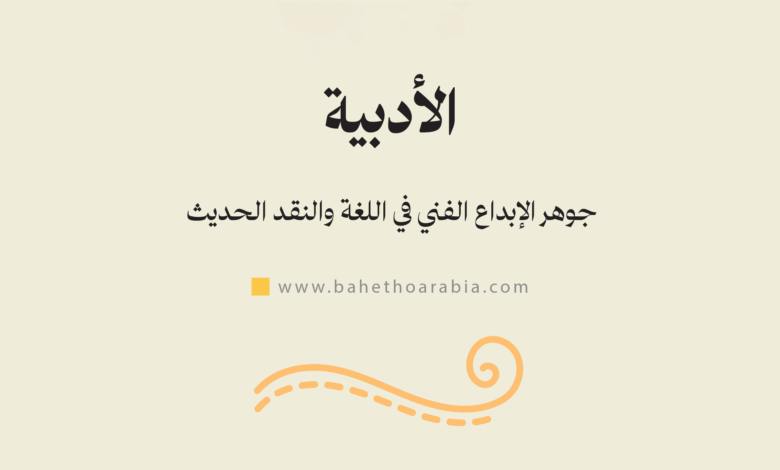
تُعد “الأدبية” (Literariness) مصطلحاً محورياً في النقد الأدبي الحديث، وتحديداً ضمن مصطلحات “النقد الجديد” و”الشكلانية الروسية”. يُطلق هذا المفهوم على مجموعة الخصائص اللغوية والبلاغية التي تُميز النص الأدبي عن غيره من النصوص، والتي يتحول بها الكلام من خطاب عادي إلى ممارسة فنية إبداعية. إنها السمة الجوهرية التي تجعل عملاً معيناً عملاً أدبياً بامتياز. هذه الخصائص تتجلى في استخدام أدوات فنية محددة، مثل الوزن والقافية والبنية والبنى الصوتية والتكرار، التي تُخرج اللغة من نطاقها اليومي المألوف إلى نطاق فني يحقق التأثير والإعجاب لدى المتلقي.
لقد قدم الشكلاني الروسي رومان ياكوبسون مصطلح “الأدبية” لأول مرة في عام 1921، معلناً في عمله “الشعر الروسي الحديث” أن “موضوع علم الأدب ليس الأدب بل الأدبية، أي ما يجعل عملاً معيناً عملاً أدبياً”. هذا الإعلان لم يكن مجرد تحديد لمصطلح جديد، بل كان بمثابة تحول جذري في كيفية مقاربة الأدب ودراسته. قبل ظهور الشكلانية الروسية، كان الأدب يُعامل في الغالب على أنه انعكاس لسيرة المؤلف وخلفيته، أو توثيق تاريخي أو اجتماعي. كان التركيز منصباً على العوامل الخارجية للنص، مثل الظروف التاريخية أو الاجتماعية التي أُنتج فيها، أو الجوانب النفسية للمؤلف.
غير أن الشكلانيين الروس والنقد الجديد رفضوا هذا التوجه، وأعلنوا أن الأدب “منتج له استقلاليته وخصوصيته”. لقد سعوا إلى منهج علمي وموضوعي لتحليل النصوص الأدبية، مؤكدين على الخصائص الجوهرية للغة الشعرية بحد ذاتها. هذا التحول الباراديغمي نحو استقلالية الأدب يعني نقل التركيز من “ماذا يقول النص؟” أو “من كتب النص؟” إلى “كيف يعمل النص؟” و”ما الذي يجعله أدباً؟”. هذا التغيير الجذري لم يكن مجرد تعديل منهجي، بل كان بمثابة إرساء أسس “علم النقد”. لقد منح هذا التوجه دراسة الأدب شرعية كفرع أكاديمي مستقل بذاته، له موضوعه ومنهجيته الخاصة، بدلاً من أن يكون مجرد تابع لتخصصات أخرى كالتاريخ أو علم النفس. هذا الاستقلال سمح بتطوير أدوات تحليلية دقيقة تركز على البنية الداخلية للغة الأدبية، مما أثر بعمق على تطور النقد الأدبي في القرن العشرين.
الشكلانية الروسية: التأسيس ومفهوم “التغريب”
ظهرت الشكلانية الروسية كمدرسة مؤثرة في النظرية الأدبية في روسيا من عشرينيات إلى ثلاثينيات القرن الماضي، ممثلة بثورتها في النقد الأدبي من خلال إرساء خصوصية واستقلالية اللغة الشعرية والأدب. لقد أثرت هذه المدرسة بشكل كبير على مفكرين مثل ميخائيل باختين ويوري لوتمان، وعلى البنيوية ككل. كان هدفهم الأساسي هو تحديد مجموعة من الخصائص المحددة للغة الشعرية، سواء كانت شعراً أو نثراً، والتي يمكن التعرف عليها من خلال “فنّيتها”، وبالتالي تحليلها على هذا النحو. شملت هذه المدرسة مجموعة من العلماء الروس والسوفييت المؤثرين مثل فيكتور شكلوفسكي، يوري تينيانوف، فلاديمير بروب، بوريس إيخنباوم، ورومان ياكوبسون.
يُعد “التغريب” (Ostranenie) مفهوماً أساسياً في الشكلانية الروسية، ويرتبط بشكل خاص بفيكتور شكلوفسكي. يشير هذا المفهوم إلى التقنية الفنية لتقديم الأشياء المألوفة بطريقة غير مألوفة أو غريبة لتعزيز إدراك المألوف. ففي روتين الكلام اليومي، تصبح تصوراتنا واستجاباتنا للواقع باهتة، بليدة، و”آلية” كما يقول الشكلانيون. الأدب، من خلال إجبارنا على وعي درامي باللغة، ينعش هذه الاستجابات المعتادة ويجعل الأشياء أكثر إدراكاً. وصف رومان ياكوبسون الأدب بأنه “عنف منظم يرتكب على الكلام العادي”، مما يعني أن الأدب ينحرف عن الكلام العادي لتكثيف أنماط الكلام اليومية وتنشيطها وغربتها. الهدف من هذا التغريب هو منع الإدراك الآلي للأشياء، وإجبار القارئ على التفاعل مع النص بطريقة أكثر وعياً وتأملاً.
تطورت الشكلانية الروسية عبر عدة مراحل، بدءاً من:
- الشكلانية الميكانيكية: ركزت هذه المرحلة، التي قادها فيكتور شكلوفسكي، بشكل أساسي على المنهج الشكلي والتقنية والأداة. اعتبر شكلوفسكي العمل الأدبي كآلة، ناتج عن نشاط بشري متعمد يحول المادة الخام إلى آلية معقدة لغرض معين. هذه المنهجية جردت الأدب من ارتباطه بالمؤلف والقارئ والخلفية التاريخية، مؤكدة أن الفن هو تفاعل الأدوات الأدبية والفنية التي يستخدمها الفنان.
- الشكلانية العضوية: رداً على القيود التي فرضتها الشكلانية الميكانيكية، اعتمد بعض الشكلانيين الروس النموذج العضوي، مستغلين أوجه الشبه بين الأجسام العضوية والظواهر الأدبية. رأى فلاديمير بروب العمل الفني ككل متكامل هرمياً، موسعاً تعريف الأداة ليشمل وظيفتها داخل النص.
- الشكلانية النظامية: أدخلت هذه المرحلة البعد الزمني في النقد الأدبي، حيث رأى يوري تينيانوف التطور الأدبي كصراع بين العناصر المتنافسة، وكون الأدب جزءاً من النظام الثقافي العام، يتفاعل مع الأنشطة البشرية الأخرى مثل التواصل اللغوي.
- الشكلانية اللغوية: اهتم رومان ياكوبسون وليف ياكوبينسكي باللغة الشعرية كأساس لدراستهم، مميزين بين اللغة العملية (للتواصل اليومي) واللغة الشعرية التي تكتسب فيها التراكيب اللغوية قيمة في حد ذاتها.
أحد أشهر الثنائيات التي قدمها الشكلانيون الميكانيكيون هو التمييز بين القصة (fabula) والحبكة (syuzhet). القصة هي التسلسل الزمني للأحداث، بينما الحبكة هي الترتيب الفني للأحداث في النص، والتي يمكن أن تتكشف بترتيب غير زمني من خلال أدوات مثل التكرار والتوازي والتدرج والإبطاء.
يُظهر التطور الداخلي للشكلانية، بدءاً من منهج “ميكانيكي” صارم يركز على الأدوات بمعزل عن السياق، ثم إدراك شكلوفسكي نفسه للحاجة إلى توسيع هذا النموذج ليشمل التقاليد الأدبية المتزامنة والديالكتيكية ، كيف أن حتى المنهج الأكثر تركيزاً على النص أدرك قيوده. هذا التطور إلى “الشكلانية العضوية” و”النظامية” يكشف عن توتر مبكر بين الرغبة في عزل النص لدراسته علمياً، والحاجة إلى الاعتراف بتفاعله مع السياقات الأوسع (الزمنية والثقافية). هذا التوتر يمهد الطريق للانتقادات اللاحقة التي وجهت للشكلانية والنقد الجديد، والتي أعادت إدخال دور المؤلف والقارئ والسياق، مما يدل على أن البحث عن “الأدبية” ليس ثابتاً بل هو عملية ديناميكية تتكيف مع الفهم المتزايد لتعقيد الظاهرة الأدبية.
النقد الجديد (New Criticism): النص ككيان مستقل
كان النقد الجديد حركة شكلانية في النظرية الأدبية هيمنت على النقد الأدبي الأمريكي في منتصف القرن العشرين. نشأ هذا التيار كرد فعل على المدارس النقدية القديمة التي ركزت على تاريخ ومعنى الكلمات الفردية وعلاقتها باللغات الأجنبية القديمة، والمصادر المقارنة، والظروف البيوغرافية للمؤلفين. اعتقد النقاد الجدد أن هذا النهج يشتت الانتباه عن النص ومعناه ويتجاهل تماماً خصائصه الجمالية. كما انتقدوا المدرسة التي تركز على تقدير الأدب لكونها ذاتية وعاطفية بشكل مفرط، حيث كانت تركز فقط على “جماليات” النص وجوانبه الأخلاقية، وهو ما اعتبروه شكلاً من أشكال الرومانسية، وسعوا بدلاً من ذلك إلى منهج أكثر منهجية وموضوعية.
شدد النقد الجديد على “القراءة المتأنية” (Close Reading)، خاصة للشعر، لاكتشاف كيف يعمل العمل الأدبي ككائن جمالي مكتفٍ بذاته ومرجعي ذاتي. تضمنت دراسة مقطع من النثر أو الشعر بأسلوب النقد الجديد فحصاً دقيقاً ومفصلاً للمقطع نفسه. تم استخدام العناصر الشكلية مثل القافية، الوزن، الإعداد، التوصيف، والحبكة لتحديد موضوع النص. بالإضافة إلى الموضوع، بحث النقاد الجدد أيضاً عن التناقض، الغموض، السخرية، والتوتر للمساعدة في تحديد التفسير الأوحد والأكثر توحيداً للنص.
لإعادة تركيز الدراسات الأدبية على تحليل النصوص، هدف النقاد الجدد إلى استبعاد استجابة القارئ، وقصد المؤلف، والسياقات التاريخية والثقافية، والتحيز الأخلاقي من تحليلهم. وقد تجسد هذا الرفض في مفهومين رئيسيين:
- مغالطة القصد (Intentional Fallacy): في مقالهم الكلاسيكي “مغالطة القصد” (1946)، جادل ويليام ك. ويمسات ومونرو بيردزلي بشدة ضد أهمية قصد المؤلف أو “المعنى المقصود” في تحليل العمل الأدبي. بالنسبة لهما، الكلمات على الصفحة هي كل ما يهم؛ استيراد المعاني من خارج النص كان يعتبر غير ذي صلة ومشتتاً محتملاً.
- مغالطة التأثير (Affective Fallacy): في مقال مصاحب، رفضا رد فعل القارئ الشخصي أو العاطفي على العمل الأدبي كطريقة صالحة للتحليل النصي.
ركز النقد الجديد على النص كـ “كيان مستقل” وسعى إلى “تفسير موحد” عبر رفض قاطع لدور المؤلف (مغالطة القصد) والقارئ (مغالطة التأثير). هذا النهج، بينما كان يهدف إلى الموضوعية العلمية، أدى إلى إطار تحليلي صارم. هذه الصلابة المنهجية، التي أهملت عمداً الأبعاد الخارجية للنص، خلقت فراغاً نقدياً وتحديات. فالفن لا يوجد في فراغ، والقارئ ليس مجرد متلقٍ سلبي. هذا الإقصاء المنهجي للمؤلف والقارئ والسياق التاريخي والثقافي أدى بشكل مباشر إلى ظهور نظريات نقدية لاحقة، مثل نظرية التلقي ونقد ما بعد البنيوية، التي سعت إلى إعادة دمج هذه العناصر، مما يشير إلى أن محاولة عزل الأدب بشكل كامل عن تفاعلاته الإنسانية والثقافية كانت غير مستدامة على المدى الطويل.
الخصائص اللغوية والبلاغية للأدبية في اللغة العربية
تتميز اللغة العربية بخصائص فريدة تعزز من أدبيتها وقدرتها على التعبير الفني العميق. من أبرز هذه السمات:
- الاشتقاق والتصريف: تتميز اللغة العربية بنظام الاشتقاق الذي يمكن من اشتقاق كلمات جديدة من جذور ثابتة، مما يمنحها قدرة هائلة على توليد مفردات متنوعة من جذور ثلاثية ورباعية. هذا الغنى في المفردات يساعد المتحدث على التعبير بدقة عن أدق المشاعر والتفاصيل.
- الإعراب: يُعد الإعراب من أهم الخصائص المميزة للغة العربية، حيث يعبر عن التغيرات النحوية التي تطرأ على أواخر الكلمات وفقاً لموقعها في الجملة، سواء كانت مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة. يسهم الإعراب في توضيح المعنى الدقيق للكلمة في السياق، مما يعزز فهم الجملة بوضوح.
- المرونة والتعبير: تتميز اللغة العربية بمرونة تركيب الجمل وتعدد الأساليب اللغوية التي يمكن استخدامها للتعبير عن فكرة واحدة دون الإخلال بالمعنى. هذا يمنح المتحدث خيارات متعددة للتعبير بأسلوبه الخاص.
- الأصوات والحروف: تحتوي اللغة العربية على 28 حرفاً، وتتميز بتنوع أصواتها وحروفها، بما في ذلك أصوات خاصة لا توجد في كثير من اللغات الأخرى مثل الضاد والقاف. يسهم تنوع الأصوات في القدرة على التعبير بدقة عن المعاني المختلفة، كما أن تكرار الحروف المتشابهة يعزز إيقاع اللغة وجمالها.
- الفصاحة والبيان: تتمتع اللغة العربية بفصاحة عالية تجعلها وسيلة مثالية لنقل الأفكار والمشاعر بأسلوب واضح وجميل. النصوص القرآنية والأدبية القديمة تعد مثالاً حياً على الفصاحة والبيان الذي تحمله هذه اللغة.
تتجسد الأدبية في اللغة العربية بشكل خاص من خلال الأساليب البلاغية المتنوعة التي تضفي عمقاً وجمالاً على النصوص:
- التشبيه (Simile): يستخدم لإجراء مقارنات بين شيئين مختلفين، مما يجعل المعنى أكثر وضوحاً وتأثيراً.
- الاستعارة (Metaphor): تتضمن استخدام كلمة أو عبارة تدل حرفياً على نوع واحد من الكائنات أو الأفكار بدلاً من أخرى للإشارة إلى تشابه أو مقارنة بينهما. تعد الاستعارة مهمة لخلق “التغريب”.
- الكناية (Metonymy): تتضمن الإشارة إلى شيء بذكر سمة أو مفهوم ذي صلة بدلاً من تسميته مباشرة، مما يضيف دقة وثراءً للتعبير.
- الجناس (Pun): يشير إلى استخدام كلمات متشابهة في الصوت ولكن مختلفة في المعنى، مما يخلق تلاعباً بالكلمات يضيف عمقاً وسحراً للنص.
- المجاز (Figurative Language): فئة واسعة تشمل أشكالاً مختلفة من التعبير غير الحرفي، حيث تستخدم الكلمات بطريقة تنحرف عن معناها التقليدي لتحقيق تأثير خاص.
- التغريب (Defamiliarization): يتحقق من خلال أساليب مثل التشبيه والاستعارة والتجسيد (Personification).
- التجسيد (Personification): منح عناصر بشرية لأشياء غير بشرية.
- الإيجاز وجوامع الكلم: قدرة على التعبير عن معانٍ كبيرة بألفاظ قليلة.
- مساواة الألفاظ للمعاني: الألفاظ لا تزيد عن المعاني ولا تقل عنها، فكل لفظ يعبر بدقة عن المعنى المقصود.
- الإيقاع الموسيقي والبنى الصوتية: يعزز الإيقاع الموسيقي من جمال النص الأدبي ، وتكرار الحروف المتشابهة يعزز إيقاع اللغة.
يتكون النص الأدبي من عناصر كبرى مثل اللفظ، الأفكار، الخيال، العاطفة، والمعاني، ويجب أن تتسم الأفكار بالأصالة والجمال والطلاقة والقيمة لضمان التناسق بين عناصر النص الأدبي.
تُظهر هذه السمات أن الأدبية في اللغة العربية متأصلة في بنية اللغة نفسها. فاللغة العربية تتمتع بخصائص جوهرية مثل الاشتقاق والإعراب والمرونة اللغوية ، بالإضافة إلى ثراءها بالمفردات والأساليب البلاغية المتنوعة. هذه الخصائص ليست مجرد إضافات، بل هي جزء لا يتجزأ من بنية اللغة نفسها. هذا يعني أن “الفنية” أو “الأدبية” في اللغة العربية ليست مجرد طبقة سطحية يضيفها الكاتب، بل هي متأصلة في تركيبها النحوي والصرفي والبلاغي. هذا قد يجعل عملية “التغريب” أكثر سلاسة أو حتى تلقائية في العربية مقارنة بلغات أخرى قد تفتقر إلى هذا المستوى من المرونة اللغوية والاشتقاقية. وبالتالي، فإن الأدبية في العربية قد تكون أعمق وأكثر تغلغلاً في النص، مما يمنحها قوة تعبيرية وجمالية فريدة.
لتوضيح هذه الخصائص بشكل عملي، يمكن النظر إلى الجدول التالي الذي يوضح أبرز الأساليب البلاغية العربية ودورها في خلق الأدبية:
الخصائص البلاغية العربية ودورها في الأدبية
| الجهاز البلاغي | التعريف | مثال (من النصوص الأدبية/الحديث النبوي) | إسهامه في الأدبية |
|---|---|---|---|
| التشبيه | مقارنة بين شيئين مختلفين لإبراز معنى أو صفة مشتركة. | قول النبي صلى الله عليه وسلم: “مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة”. | يوضح الفكرة بتقريب المعاني إلى الأذهان، ويخلق صوراً حسية تزيد من التأثير الجمالي. |
| الاستعارة | استخدام كلمة أو عبارة للدلالة على معنى غير معناها الحرفي، لإيجاد علاقة تشابه غير مباشرة. | قول الشاعر: “العشق يوسف في الجمال بحسنه”. | تضفي عمقاً وجمالاً على النصوص، وتخلق صوراً ذهنية جديدة تسهم في التغريب. |
| الكناية | الإشارة إلى شيء بذكر صفة أو لازم من لوازمه بدلاً من ذكره مباشرة. | “فلان كثير الرماد” كناية عن الكرم. | تضيف دقة وثراءً للتعبير، وتجعل المعنى أكثر إيحاءً وتأثيراً. |
| الجناس | استخدام كلمات متشابهة في اللفظ ومختلفة في المعنى. | “صليت المغرب في المغرب”. | يخلق تلاعباً بالكلمات يضيف عمقاً وسحراً للنص، ويعزز الإيقاع اللغوي. |
| الإيجاز وجوامع الكلم | التعبير عن معانٍ كبيرة بألفاظ قليلة. | قول النبي صلى الله عليه وسلم: “الندم توبة”. | يمنح النص قوة وعمقاً، ويجعله سهل الحفظ والتداول كالأمثال والحكم. |
| التجسيد (الاستعارة المكنية) | إعطاء صفات أو أفعال بشرية لأشياء غير عاقلة أو مفاهيم مجردة. | “هذه البحر التي تكشف صدرها للقمر”. | يغرب المفاهيم المألوفة ويجعلها تبدو جديدة وغير مألوفة، مما يعمق تفاعل القارئ. |
| مساواة الألفاظ للمعاني | الألفاظ تعبر بدقة عن المعاني المقصودة دون زيادة أو نقصان. | قول النبي صلى الله عليه وسلم: “نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ”. | يضمن وضوح المعنى ودقته، ويجعل النص مؤثراً بتركيزه على الجوهر. |
| الإيقاع الموسيقي | التناغم الصوتي الناتج عن تكرار الحروف أو الأوزان والقوافي. | الوزن والقافية في الشعر، وتكرار الحروف المتشابهة في النثر. | يعزز جمال النص وجاذبيته، ويساهم في خلق تجربة حسية وموسيقية للقارئ. |
تطبيقات الأدبية في الأنواع الأدبية المختلفة
تتجلى الأدبية بأشكال متنوعة عبر الأنواع الأدبية المختلفة، حيث تتكيف مع خصائص كل نوع لإنتاج تأثير فني فريد.
في الشعر
تظهر الأدبية في الشعر بشكل أساسي من خلال الوزن والقافية والبنى الصوتية والتكرار. فاللغة الشعرية، على عكس اللغة العادية، تجعل للارتباطات اللغوية قيمة ذاتية، حيث لا يكون الهدف العملي هو الأساس، بل تكتسب التراكيب اللغوية قيمة في حد ذاتها. هذا التركيز على اللغة لذاتها يؤدي إلى “التغريب” ويجعل القارئ يتأمل النص بعمق أكبر.
في الشعر المسرحي، تتسم لغة الحوار بالإيقاعية، وتكون المشاعر المعبر عنها قوية وكثيفة. يعتمد الشعر المسرحي بشكل مباشر على الغموض، مما يعزز سيطرة الإيحاء على المسرحية ويجعل التصوير غير المحسوس وغير المرئي أكثر حضوراً من النثر.
أمثلة تطبيقية في الشعر:
- شعر درامي (مثال المظلوم): يستخدم صوراً قوية وموضوعات العدل والقضاء الإلهي، مثل قول أحد المظلومين على خشبة المسرح: “أيـا ظـالـمي إنَّ الـخـصـومَةَ دائمَـة | وجَــبَ امـتثالُك للقـضايا القائمَـة”.
- شعر الغزل (مثال العاشق): ينقل الشوق العميق وألم الفراق باستخدام استعارات مرتبطة بالطبيعة وصور دينية، مثل: “صوت الصّبـاح يقوله العصفــورْ | والليل يهمـسُ إذْ يـغيـبُ الـنـورْ”.
- شعر الحزن: يتعمق في موضوعات الحزن والندم والألم العاطفي، مثل: “ما خـاب ظـن الـلـيل فـي أحـزاني | تـتـرى تُـنـادم مـُهجـتي وبـياني”.
- التغريب في الشعر: يمكن أن يتحقق من خلال التلاعب بالقافية والوزن، أو استخدام كلمات غير مألوفة، أو صور شعرية غير تقليدية. مثال على ذلك قصيدة إيميلي ديكنسون “الأمل هو الشيء ذو الريش” (Hope is the thing with feathers)، حيث تجسد الأمل كطائر، مما يغرب المفهوم ويجعل القارئ يتفاعل مع الأمل بطريقة جديدة.
في النثر
تظهر الأدبية في النثر من خلال التلاعب بالحبكة، وتغريب السرد، واستخدام الوصف التفصيلي. يرى الشكلانيون أن الحبكة (syuzhet) هي تشويه للقصة الزمنية العادية (fabula)، مما يخلق التغريب ويدفع القارئ لإدراك الأحداث بطريقة غير مألوفة.
أمثلة تطبيقية في النثر:
- تغيير الإعدادات المألوفة: يتم ذلك بوصف مساحة عادية بطريقة غير عادية أو غير متوقعة، مثل غرفة نوم بلا جدران أو سقف، أو أثاث يطفو في الهواء. هذا يكسر التوقعات ويجعل القارئ يعيد النظر في المألوف.
- تغريب اللغة: يمكن أن يتم التلاعب بالقواعد النحوية، وبناء الجملة، واختيار الكلمات لخلق شعور بالارتباك والمفاجأة، مما يجبر القارئ على التباطؤ والتركيز بعمق أكبر على النص.
- أمثلة من الروايات:
- “التحول” لفرانز كافكا: تحول البطل إلى حشرة عملاقة يغرب مفهوم الاستيقاظ اليومي، مما يترك القارئ مضطرباً ومفتوناً.
- “مائة عام من العزلة” لغابرييل غارسيا ماركيز: يطمس الحدود بين الواقع والخيال، ويغرب تصوراتنا عن الزمن والموت من خلال أحداث سحرية واقعية.
- “مزرعة الحيوان” لجورج أورويل: الحيوانات تثور على مالكها وتؤسس حكومتها الخاصة، مما يغرب مفهوم القيادة والسلطة السياسية.
- “رحلات غوليفر”: التفاوت الواضح بين الشخصيات (غوليفر والليليبتيين) كمثال على التغريب من العالم الحقيقي، مما يلفت الانتباه إلى الحجم غير العادي للشخصيات.
- “تريسترام شاندي”: تباطؤ أو تسريع الأحداث المألوفة بشكل متعمد وغريب، مما يكسر السرد الزمني التقليدي.
في المسرح
يُعد الشعر المسرحي فناً صعباً لأنه يعمل ضمن مجالين: المسرح والشعر. يتطلب نجاحه عناصر مسرحية قوية وشعراً متميزاً. تتسم اللغة في المسرحية الشعرية بالإيقاعية، وتكون المشاعر قوية وكثيفة. يعتمد الشعر المسرحي بشكل مباشر على الغموض، مما يعزز سيطرة الإيحاء على المسرحية.
أمثلة تطبيقية في المسرح:
- مسرحيات أحمد شوقي مثل “مصرع كليوباترا” و”مجنون ليلى”.
- مسرحية توفيق الحكيم “الملك أوديب” وصلاح عبد الصبور “مأساة الحلاج”.
- مسرحية ويليام شكسبير “روميو وجولييت”.
- التغريب في المسرح: يمكن أن يتحقق من خلال استخدام كلمات جديدة (neologism) كما فعل شكسبير بكلمة “barefaced” (بلا حياء)، مما يجعل الجمهور يتفاعل مع الفكرة بطريقة جديدة وغير مألوفة. كما يمكن أن يتم التغريب من خلال التلاعب بالحبكة.
تُظهر هذه التطبيقات أن الأدبية تتجلى بشكل مختلف في الشعر والنثر والدراما. ففي الشعر، تبرز من خلال الوزن والقافية والصور ، بينما في النثر، يمكن أن تكون عبر التلاعب بالحبكة وتغريب السرد. وفي المسرح، قد تؤدي قيود الحوار إلى تفضيل النثر على الشعر في بعض الحالات. هذا التكيّف يوضح أن الأدبية ليست مجرد مجموعة ثابتة من “الأدوات” التي تُطبق عالمياً، بل هي مبدأ فني مرن يتشكل ويتغير بناءً على خصائص وقيود كل نوع أدبي. هذا يعني أن “الفنية” ليست مادة خام تُضاف، بل هي كيفية تفاعل اللغة مع شكلها ومحتواها المحدد في سياق نوعي معين، مما يوسع فهمنا لمدى تعقيد مفهوم الأدبية وتطبيقاته.
لتسهيل فهم هذه التطبيقات، يمكن تلخيصها في الجدول التالي:
تطبيقات الأدبية في الأنواع الأدبية الرئيسية
| النوع الأدبي | الخصائص الرئيسية للأدبية فيه | أمثلة تطبيقية (نصوص/أعمال) | الأدوات المستخدمة لخلق الأدبية |
|---|---|---|---|
| الشعر | الوزن والقافية، البنى الصوتية، التكرار، اللغة الإيقاعية، كثافة المشاعر، الغموض، التصوير غير المحسوس. | قصائد الغزل والحزن والدراما (أمثلة المظلوم والعاشق والحزين). قصيدة “الأمل هو الشيء ذو الريش” لإيميلي ديكنسون. | الاستعارة، التشبيه، التجسيد، التغريب، الإيقاع، القافية، الوزن. |
| النثر | تلاعب الحبكة، تغريب السرد، الوصف التفصيلي، تغيير الإعدادات المألوفة، تغريب اللغة. | “التحول” لفرانز كافكا. “مائة عام من العزلة” لماركيز. “مزرعة الحيوان” لأورويل. “رحلات غوليفر”. | تلاعب الحبكة (القصة مقابل الحبكة)، التغريب (عبر الوصف أو اللغة)، الاستعارة، التجسيد. |
| المسرح | لغة حوار إيقاعية، قوة وكثافة المشاعر، الاعتماد على الغموض والإيحاء، دمج الشعر بالنثر. | مسرحيات أحمد شوقي (“مصرع كليوباترا”، “مجنون ليلى”). “الملك أوديب” لتوفيق الحكيم. “روميو وجولييت” لشكسبير. | اللغة الإيقاعية، الاستعارة، التجسيد، التغريب (عبر الكلمات الجديدة أو الحبكة). |
وظائف الأدبية: الجمالية والتأثيرية
تتجاوز الأدبية كونها مجرد مجموعة من الخصائص اللغوية والشكلية لتؤدي وظائف عميقة، جمالية وتأثيرية، تسهم في إثراء التجربة الإنسانية.
كيف تسهم الأدبية في تحقيق القيمة الجمالية والإنسانية للنص
الأدب المتوازن بين الجمالية والتأثيرية يتناول المشاعر ويعالجها من خلال التركيز والتكثيف والتلميح والتصريح والتجريد والتجسيد، مع الاهتمام بالشكل والمضمون في آن واحد. هذا التوازن يصنع من العمل الأدبي قيمة إنسانية أخلاقية جمالية إيجابية. إنها تعبر وتكثف الإحساس بالخير والحقيقة والحب والجمال، وتنظم العواطف والرغبات، مما يسهم في إثراء وعي القارئ وتدعيم مكتسباته الثقافية. الأدبية، من خلال فنّيتها، تمنح الحياة معنى، وتربطنا بأسرارها، وتحول الروح وفقاً لرغباتها، ناقلة إياها من حالة إلى أخرى. إنها تخلق عالماً من المعاني للروح، يتماشى مع شوقها الدائم للمجهول والحقيقة المجازية.
تأثير الأدبية على المتلقي
تنتزع الأدبية من نفوسنا كل أحاسيس الصراع أو التمزق لتترك توافقاً رائعاً بين هذا العمل وبين الوعي الذاتي والإحساس، مما يؤدي إلى شعور بالهدوء والأمان النفسي. إنها تمنح الروح متعة المجهول، وهي بحد ذاتها متعة مجهولة، فالروح قلقة ومتغيرة، لا تسعى إلى المجهول الخالص ولا إلى المعلوم الخالص، بل إلى حالة مناسبة بين الاثنين، حيث قد ينشأ القلق أو يهدأ.
تتجاوز الوظيفة الشعرية في الأدب مجرد التواصل لتصل إلى مرحلة السيطرة على مشاعر القارئ ومزاجه، فتجعله يعيش بين إحساسه وإحساس الكاتب أيضاً. كما أن الأدبية تدفع القارئ دائماً نحو نوع محدد من التأويل؛ لأنها تجعله يصنع أفق توقع ويكشف فجوات في النص عليه ملؤها، مما يحفزه على التفاعل النشط مع العمل الأدبي.
تُظهر هذه الجوانب أن الأدبية لا تقتصر على الجمال الشكلي فحسب، بل تمتد لتشمل وظائف تأثيرية عميقة: خلق قيمة إنسانية وأخلاقية ، تنظيم العواطف ، إثراء الوعي ، والسيطرة على مشاعر القارئ ومزاجه. هذا يعني أن الأدبية ليست غاية في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق تأثير أعمق على المتلقي. إنها تحوّل النص من مجرد مجموعة من الكلمات إلى تجربة إنسانية معقدة، قادرة على إثارة التأمل، وتوسيع الإدراك، وحتى تحقيق نوع من “التوافق النفسي”. هذا يؤكد أن الأدب، من خلال الأدبية، يمتلك قوة تحويلية تتجاوز الوظيفة التواصلية البسيطة، ليصبح أداة للتفاعل المعقد مع الوعي البشري والعالم.
جدالات نقدية معاصرة حول مفهوم الأدبية
على الرغم من الأهمية المحورية لمفهوم الأدبية في النقد الأدبي، إلا أنه ظل ولا يزال محل جدل ونقاش مستمر، خاصة مع ظهور مدارس نقدية جديدة تحدت الرؤى الشكلانية الأولية.
الانتقادات الموجهة للشكلانية والنقد الجديد
واجهت الشكلانية الروسية والنقد الجديد انتقادات كبيرة. فقد فشلت الشكلانية الميكانيكية في تفسير التغيرات الأدبية التي تؤثر على الأدوات ووظائفها والأنواع الأدبية. كما تجاهلت الشكلانية التاريخ وعلاقة المبدع بالنص وبيئته، وقللت من الذات والوعي بالانغلاق داخل بنية النص وعزله عن سياقاته الاجتماعية والنفسية والتاريخية التي أنتجته. وبالمثل، رفضت البنيوية، التي تأثرت بالشكلانية، قراءة النص الأدبي باعتبار عرق الكاتب ووسطه، ورفضت دور المؤلف. النقد الجديد، على الرغم من أهميته في ترسيخ القراءة المتأنية، لم يعد نموذجاً نظرياً مهيمناً في الجامعات الأمريكية، على الرغم من أن بعض أساليبه لا تزال أدوات أساسية في التحليل الأدبي.
نظرية التلقي (Reader-Response Theory) ودور القارئ
ظهرت نظرية التلقي في النصف الثاني من القرن العشرين، ورفضت حصر المعنى في النص فقط، ولم تجعل دور القارئ محصوراً في الكشف عن المعنى بل في بنائه وإنتاجه. تؤكد هذه النظرية على دور القارئ في خلق المعنى من النص، وأن القراءة هي تفاعل ديناميكي بين القارئ والنص، ولا يوجد تفسير واحد صحيح. تتأثر تفسيرات القارئ بتجاربه الشخصية، وعواطفه، وخلفيته الثقافية، مما يسمح بتفسيرات متعددة للعمل الواحد. لقد تحدت نظرية التلقي النقد الجديد من خلال تحويل التركيز من التحليل البنيوي الصارم للنصوص إلى دور القارئ وتفاعله مع النص.
نقد ما بعد البنيوية (Post-Structuralism) وتحدي ثبات المعنى
ظهرت ما بعد البنيوية في أواخر القرن العشرين كرد فعل على البنيوية، حيث جادلت بأن الثقافة والمعنى لا ينفصلان، وشددت على سيولة العلاقات التي تشكل الواقع الاجتماعي. ينتقد مفكرون مثل جاك دريدا ورولان بارت فكرة المعاني الثابتة والمؤلف السلطوي، ويقترحون أن القارئ يلعب دوراً مركزياً في تفسير النصوص. تؤكد ما بعد البنيوية على عدم استقرار المعنى، مسلطة الضوء على أن النصوص لا يمكن أن تحتوي أبداً على تفسير واحد متماسك بسبب التناقضات والغموض المتأصل في اللغة نفسها.
تطور مفهوم الأدب في النقد العربي المعاصر
يتناول النقد العربي المعاصر العلاقة بين الأدب والنقد، ويلاحظ أن معظم الدراسات النقدية ركزت على تحديد ماهية الأدب ووظيفته. يبرز المقال مشكلة اختلاف آراء النقاد وجهودهم في تعريف الأدب وتحديد خصوصياته التي تتغير حسب المراحل المختلفة التي مر بها. يعكس النقد الحديث تحولات كبيرة في فهم الأدب والنصوص عبر الزمن، متجهاً نحو التجديد والتحليل العلمي.
بدأت الشكلانية والنقد الجديد بمحاولة إرساء تعريف موضوعي ومستقل للأدبية، يركز على الخصائص النصية الداخلية بمعزل عن المؤلف والقارئ والسياق. لكن هذا النهج واجه انتقادات أدت إلى ظهور نظريات مثل نظرية التلقي وما بعد البنيوية، التي أعادت التأكيد على دور القارئ كـ “خالق للمعنى” وعلى “عدم استقرار المعنى”. هذا التحول يعكس جدلاً فلسفياً أوسع في العلوم الإنسانية، وهو الانتقال من محاولة إيجاد “حقيقة موضوعية” للنص إلى الاعتراف بالطبيعة الذاتية والتفسيرية للمعنى. فمفهوم الأدبية لم يعد كياناً ثابتاً يمكن قياسه بمعايير محددة فقط، بل أصبح مفهوماً ديناميكياً يتشكل ويتغير بناءً على التفاعل بين النص والقارئ والسياق الثقافي والزمني. هذا يطرح سؤالاً جوهرياً: هل يمكن للأدبية أن تكون “علمية” وموضوعية حقاً، أم أنها تظل بطبيعتها تجربة ذاتية متغيرة؟ هذا الجدل يثري فهمنا للأدب كظاهرة إنسانية معقدة.
خاتمة: الأدبية كجوهر متجدد للإبداع
تُعد الأدبية جوهر الإبداع الفني في اللغة، وهي السمة المميزة التي تحول الكلام العادي إلى فن. لقد أثرت النظريات النقدية مثل الشكلانية الروسية والنقد الجديد بشكل عميق في فهمنا لكيفية عمل الأدبية من خلال التركيز على الخصائص الداخلية للنص وآليات مثل “التغريب”. تتجلى الأدبية عبر خصائص لغوية وبلاغية غنية، خاصة في اللغة العربية بمرونتها واشتقاقاتها وأساليبها البلاغية المتنوعة التي تمنحها قوة تعبيرية وجمالية فريدة. إنها تؤدي وظائف جمالية وتأثيرية عميقة، تتجاوز مجرد التواصل لتصل إلى إثارة المشاعر وتشكيل الإدراك، وتحقيق توافق نفسي لدى المتلقي.
على الرغم من التطورات الكبيرة في فهم الأدبية، لا يزال المفهوم محل جدل ونقاش مستمر في النقد المعاصر، خاصة مع ظهور نظريات مثل نظرية التلقي وما بعد البنيوية التي أعادت التأكيد على دور القارئ وعدم ثبات المعنى. هذه الجدالات لا تقلل من قيمة الأدبية، بل تؤكد على تعقيدها وديناميكيتها كظاهرة إنسانية وفنية.
لقد تتبع هذا التقرير تطور مفهوم الأدبية من تعريفها الأولي كخصائص لغوية وشكلية إلى تبلورها في الشكلانية والنقد الجديد كدراسة داخلية للنص. ثم تناول كيف تحدت نظريات لاحقة، مثل نظرية التلقي وما بعد البنيوية، هذا التركيز، مؤكدة على دور القارئ والسياق وسيولة المعنى. هذا المسار التاريخي للجدالات النقدية حول الأدبية يُظهر أنها ليست حقيقة ثابتة أو تعريفاً نهائياً، بل هي “مفهوم ديناميكي” يخضع لإعادة التفسير والتحدي المستمر. إن استمرارية النقاش حول الأدبية تعكس مرونتها وقدرتها على التكيف مع التغيرات الفكرية والثقافية، مما يجعلها جوهراً متجدداً للإبداع الأدبي، وليس مجرد مصطلح أكاديمي. هذا يعني أن “البحث عن الأدبية” هو في حد ذاته عملية إبداعية ونقدية مستمرة، مما يضمن حيوية الأدب والنقد على حد سواء.