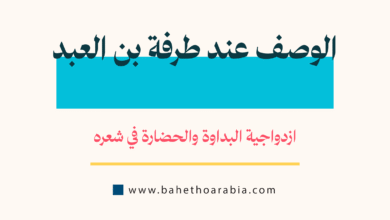الوصف في الأدب الجاهلي: فن التصوير والمحاورة في ديوان العرب
استكشاف براعة العرب في رسم الطبيعة والإنسان وأثر السجع في حفظ التراث

يعد الأدب الجاهلي مرآة عكست حياة العرب بكل تفاصيلها، حيث كان للكلمة قدرة فريدة على الرسم والنطق. نستكشف في هذا المقال كيف تجلى فن الوصف والمحاورة في هذا الإرث الأدبي العريق.
مقدمة
يمثل الشعر في الثقافة العربية قمة التعبير الفني وأرقاه، فهو الوعاء الذي صب فيه العرب أفكارهم ومشاعرهم، مستفيدين من قدرته الفائقة على التصوير والموسيقا والعمق. إذا كانت الفنون المختلفة تعبيراً فنياً عن أفكار الإنسان ومشاعره، فالشعر أرقى هذه الفنون، وأقدرها على البوح لما امتاز به من تصوير وموسيقا وعمق. فلا عجب أن يستأثر بعقول العرب، وأن يفوق قسيمه النثر، الذي ظل في مرتبة تالية رغم أهميته، حيث تُظهر دراسة البلاغة القرآنية أثر الأساليب الفنية في الكلام. إن فهم طبيعة الوصف في الأدب الجاهلي يفتح لنا نافذة على العقلية العربية وقدرتها على التفاعل مع بيئتها وتخليدها بالكلمات.
مكانة الوصف والمحاورة في الأدب الجاهلي
على الرغم من سيادة الشعر، فإن بعض أشكال النثر استطاعت أن تلحق به أو تحاول مجاراته في التأثير والجمال. غير أن بعض النثر قد يلحق بالشعر أو يحاول، وهو يجاريه، أن يلحق به، فيتخفف من الفكر الثقيل، ويريش الفاظه بالصور القادرة على التحليق. ويبرز من بين هذه الأشكال فنان رئيسان، حيث يُعد الوصف والمحاورة من أقدر أنواع النثر على مجاراة الشعر؛ لأن صور الوصف أمد الصور النثرية أجنحة، وأكثرها عناية بالجمال، ولأن المحاورة في الأدب الجاهلي تبث في الكلام حياة متدفقة تحول الأفكار المجردة إلى مشاهد مسرحية متحركة، وهو ما نجده أيضاً في تحليل البلاغة النبوية.
إن هذه القدرة على الخلق الفني هي التي ميزت أديبًا عن آخر. ولا يخطئ من يدعي أن التفاضل بين الأدباء مرهون بتفاضلهم في القدرة على التصوير أي في براعتهم في الوصف الحي. يتجلى هذا المعيار بوضوح في العديد من المواقف التاريخية التي كانت فيها البلاغة والفصاحة سبيلاً للدفاع عن القبيلة أو إثبات الجدارة، ما يؤكد على أهمية الوصف في الأدب الجاهلي كأداة فنية ومعيار للقوة الأدبية.
البراعة في الوصف كمعيار للتفاضل بين الأدباء
كانت القدرة على الوصف الدقيق والحي مقياساً لجودة الأديب ومكانته في قومه، وهذا ما يفسر الاختبار الذي خضع له الشاعر لبيد بن ربيعة. ولذلك حينما أراد بنو عامر أن يندبوا لبيداً للدفاع عن القبيلة بين يدي ملك الحيرة اختبروا ملكته، وطلبوا منه أن يصف بقلة قميئة حقيرة تدعى التربَّة. لم يكن الاختبار مجرد تمرين بلاغي، بل كان فحصاً لقدرته على إيجاد الجمال والتعبير حتى في أبسط الأشياء وأحقرها. وقد أظهر لبيد براعة فائقة في هذا التحدي، حيث قدم صورة حية ودقيقة لهذه البقلة، مبرزاً خصائصها بأسلوب بليغ.
لقد نجح لبيد في تقديم وصف متكامل يعكس قوة ملاحظته وملَكَته اللغوية، مما أهّله لتمثيل قبيلته. فقال في صفتها:
- هذه التربة التي لا تذكي ناراً، ولا تؤهل داراً، ولا تسر جاراً.
- عودها ضئيل، وفرعها كليل، وخيرها قليل.
- شر البقول مرعى وأقصرها فرعاً، فتعساً لها، وجدعاً.
ولا يعنينا الحكم على لبيد أو له، وإنما يعنينا ما أسفر عنه الامتحان، فقد نجح لبيد وقدمه قومه – وهو فتى – على الكهول الفحول، فتكلم وأجاد. إن هذا الموقف يؤكد أن الوصف في الأدب الجاهلي لم يكن مجرد حلية لفظية، بل كان دليلاً على الفطنة والقدرة على الإقناع، وهي مهارات كانت ضرورية في مجتمع يعتمد على الكلمة الفصيحة في إدارة شؤونه.
روائع الوصف في الأدب الجاهلي: لوحات فنية من الطبيعة
عندما نتجاوز وصف الأشياء الصغيرة إلى الآفاق الرحبة، نجد أن الوصف في الأدب الجاهلي يصل إلى ذروته في تصوير الطبيعة. ولما كانت هذه البقلة الضئيلة الهزيلة شحيحة بالصور التي تضعها بين عيني الواصف فإننا نؤثر التماس الصور في آفاق رحيبة، يجد الواصف بين جنباتها مرادا لخياله، ومنسرحاً لملكته وإليك هذه الألواح التي رسمها رادة المراعي. أجدبت بلاد مذحج، فأرسلوا رواداً، من كل بطن رجلاً. فبعثت بنو زبيد رائداً، وبعثت النخع رائداً، وبعثت جعفي رائداً، فلما رجع الرواد قيل لرائد بني زبيد: ما وراءك؟ قال: رأيت أرضاً موشمة(١) البقاع، ناتحة(٢) النقاع(٣)، مستحلسة(٤) الغيطان(٥)، ضاحكة القريان(٦)، واعدة وأخر بوفائها، راضية أرضها عن سمائها(٧). وقيل لرائد جعفي: ما وراءك؟ قال: رأيت أرضاً جمعت السماء أقطارها، فأمرعت أصبارها(٨)، ودينت(١٠) أوعارها، فبطنانها(١١) عمقة، وظهرانها(١٣) غدقة(١٤)، ورياضها مستوسقة(١٥). ورقاقها(١٦) رائخ، وواطئها سائخ(١٨)، وماشيها(١٩) مسرور، ومصرمها(٢٠) محسور. وقيل للنخعي ما وراءك؟ فقال: مداحي(٢١) سيل، وزهاء(٢٢) ليل وغيل(٢٣) يواصي(٢٤) غيلا، قد ارتقت أجرازها(٢٥)، ودمث(٢٦) عزازها(٢٧)، والتبدت أقوازها(٢٨)، فرائدها(١٧) أنق(١) وراعيها سنق(٢). فلا قضض(٣) ولا رمض(٤) عازبها(٥) لا يفزع، وواردها لا ينكع(٦) فاختاروا مراد(٧) النخعي.
فلماذا آثروه، وزهدوا في غيره؟ ألأنّه أخصب من البقاع التي رآها الزبيدي والجعفي؟ يغلب على ظننا أنهم لم يؤثروه لخصبه بل لخصب الخيال الذي وصفه، وهو ما يميز الفن في العصر الحديدي. فقد تكون البقاع التي رآها الرائدان الآخران أكثف نباتاً، وأطيب هواء، وأعذب ماء، لكنها لم يبلغا صاحبهما في دقة الرسم، فغلبت الملكة المصوّرة جارحة البصر، فانظر كيف سحر البيان الساحر نفوس العرب، وكيف ينصاعون لما يسمعون؟ إن هذا المثال يبرهن على أن المحاورة في الأدب الجاهلي كانت إطاراً فنياً لاستعراض براعة الوصف، وهو ما شهدته أيضاً حضارات أخرى مثل حضارة العصر البرونزي.
(١) أوشمت الأرض بدا فيها شيء من النبات.
(٢) راشحة
(٣) ج نقع وهو الأرض الحرة الطين يستنقع فيها الماء.
(٤) استجلس النبت: غطى الأرض أو كاد.
(٥) المطمئن الواسع من الأرض.
(٦) مجاري المياه من الربا إلى الرياض.
(٧) مطرها (٨) أخصيت (٩) نواحيها.
(١٠) لينت.
(١١) ج بطن وهو المطمئن من الأرض.
(١٢) ندية.
(١٣) ج ظهر وهو ما ارتفع من الأرض يسيراً.
(١٤) غدقة كثيرة البلل والماء.
(١٥) منتظمة.
(١٦) الأرض اللينة من غير رمل.
(١٧) مفرط اللين.
(١٨) تسوخ رجلاه في الأرض للينها.
(١٩) صاحب الماشية.
(٢٠) فقيرها.
(٢١) ج مدحى والمدحى اسم مكان ودحا الأرض بسطها.
(٢٢) شخص وجعل نبتها زهاء ليل لشدة خضرته.
(٢٣) ماء جار على وجه الأرض.
(٢٤) يواصل.
(٢٥) ج جرز وهي التي لم يصبها المطر أو التي لا نبت فيها.
(٢٦) دمث لين.
(٢٧) أرضها الصلبة.
(٢٨) ج قوز وهو المستدير من الرمل.
(١) معجب. (٢) بشم. (٣) حصى صغار يريد أن النبت غطى الأرض فلا ترى حصاها.
(٤) حر (٥) الذي يبعد بإبله في المرعى. (٦) لا يمنع. (٧) مرعى
تصوير الجمال الإنساني: دقة الرسم الواقعي
لم يبرع العرب في وصف الطبيعة فحسب، بل برعوا في تصوير الإنسان، ووصف جماله براعة يسبقون بها كبار الرسامين في أوربا ممن اتخذوا الواقعية مذهباً لهم في نقل ما يرون من كمال الجسم البشري، . ومن أجمل ما رسم العرب صورة رسمتها عصام الكندية لربة الجمال في عصرها أم إياس بنت عوف بن محلم، رسمت هذه الصورة للحارث بن عمرو ملك كندة حينما سألها عنها. هذه اللوحة الكلامية تبرز القيمة العالية لفن الوصف في الأدب الجاهلي، حيث تتحول الكلمات إلى فرشاة ترسم أدق الملامح.
قالت عصام في وصفها الدقيق الذي يجمع بين الحسية والجمال:
- ملامح الوجه: رأيتُ جبهة كالمرآة المصقولة، يزينها شعر حالك كأذناب الخيل، إن أرسلته خلته سلاسل، وإن مشطته قلت عناقيد جلاها الوابل، وحاجبين كأنهما خطا بقلم، أو سودا بحمم، تقوّسا على مثل عين الظبية العبهرة(٨)، بينهما أنف كحد السيف المصقول حفت به وجنتان كالأرجوان، في بياض كالجمان شق فيه فم كالخاتم، لذيذ المبسم، فيه ثنايا غُرّ ذات أشر(٩)، تقلب فيه لساناً بفصاحة وبيان بعقل وافر، وجواب حاضر، تلتقي دونه شفتان حمراوان تحلبان ريقاً كالشهد.
- الجيد والصدر: ذلك في رقبة بيضاء كالغضة، ركبت في صدر كصدر تمثال دمية، وعضدان مدمجان، يتصل بهما ذراعان ليس فيهما عظم يمس، ولا عرق يجس، ركبت فيهما كفان دقيق قصبهما، لين عصبهما، يعقد إن شئت منها الأنامل، نثأ في ذلك الصدر ثديان كالرمانتين، يخرقان عليها ثيابها.
- بقية الجسد: تحت ذلك بطن كطي القباطي المدمجة. كسي عكناً كالقراطيس المدرجة، تحيط تلك العكن بسرة كالمدهن المجلو. خلف ذلك ظهر كالجدول، ينتهي ذلك إلى خصر لولا رحمة الله لانبتر، لها كفل يقعدها إذا قامت، ويُقيمها إذا قعدت، كأنه دعص الرمل، لبده سقوط الطل. تحملها فخذان لفاوان، كأنهما قفلتا على نضد جمان، تحتهما ساقان خدلتان كالبردتين شيبنا بشعر أسود، كأنه حلق الزرد يحمل ذلك قدمان كحذو اللسان، فتبارك الله مع صغرهما كيف يطيقان ما فوقهما. .
(٨) الممتلئة الجسم أو الجامعة للحسن في الجسم.
(٩) تعزيز يكون فيها خلقة.
الخصائص الفنية للنثر الجاهلي وأهمية السجع
في الأدب الجاهلي ألواح متقنة الرسم، تتصف بالخيال الصريح، والصور الحسية، والمحاورات الرشيقة، والأسلوب المسجوع، وهو ما أثرى فن المحاورة في الأدب الجاهلي. فكان السجع حلية عامة تقرب النثر من الشعر، ولا يجد فيه عرب الجاهلية شيئاً من التكلف، أو كأنه خاصة من خصائص اللغة العربية، لا تنفر من وقعه الأذن، ولا يمجه الذوق، ولا يعيبه أحد ممن يسمعونه، كما يعيبه نفر من نقاد العصر الحاضر.
هذه الخصائص الفنية لم تكن مجرد زخارف، بل كانت جزءاً لا يتجزأ من بنية النص وغايته. وقد يغلو بنا الظن، فنذهب إلى أن السجع في كلام الجاهليين كان شكلاً من أشكال الكفاح في سبيل البقاء. هذا الفهم العميق للغة كوسيلة للحفظ يوازي أهمية فهم التاريخ.
السجع كوسيلة لحفظ الذاكرة الثقافية
إن تأويل هذا الظن أن عرب الجاهلية كانوا شعباً حافظاً يخزن تاريخه ما بين قلبه ولسانه، لا شعباً كاتباً ينقش تاريخه على جدران المعابد. لقد كانت طبيعة حياتهم سبباً رئيساً في اعتمادهم على الذاكرة الشفهية، حيث شكلت هذه الإستراتيجية الثقافية هويتهم. ويمكن تلخيص الأسباب التي دفعتهم إلى ذلك في النقاط التالية:
- الطبيعة الشفهية للمجتمع: كانوا أمة أجبرتها الطبيعة القاسية على السفر الدائم بين أطراف جزيرة تكنفها دول مستقرة مثل دولة الكنترة، مما جعل التدوين المادي صعباً.
- غياب وسائل التدوين المستقرة: على عكس الحضارات المجاورة، لم تكن لديهم بنى تحتية لحفظ السجلات المكتوبة. فالمصريون القدماء كتبوا ما حرصوا على بقائه في أوراق البردي، وحفظوا الأوراق في قصور وأهرام شوامخ تدفع عنها عوادي الزمن، وشعب إيبلا نقش تاريخه على ألواح الفخار، وعرضها على النار، فجف الطين، واستحجرت الكتابة، ثم حفظ ما نقش في أقباء ومكتبات ومدافن.
- الحاجة إلى مكتبات متنقلة: أما العرب فأقلهم من أهل القرى، وأكثرهم – وهم أرباب الفصاحة – من البدو الذين ألفوا الترحل، وزهدوا في الكتابة. وهبهم رغبوا في الكتابة وكتبوا، فأين يحفظون ما يكتبون، وهم ما عاشوا على سفر؟ لذلك كان الحل الأمثل الذي اهتدوا إليه بالفطرة أن يخترعوا مكتبات جوالة، يحملونها معهم إذا ارتحلوا، فكانت مكتباتهم صدورهم، وكان أسلوبهم الأثير أقدر أنماط الكلام على العلوق بالذاكرة، فمالوا إلى الشعر أولاً وإلى النثر المسجوع الفقرات، أو المتوازن النبرات بعد ذلك، لأن هذين الفنين أسير وأفشى، وأرسخ في الصدور. وهكذا يقودنا زعمنا إلى القول: ان السجع في نثر الجاهليين سور حمى تاريخهم من إغارة النسيان، لكنه على رسوخه وشموخه كان دون سور الشعر الذي وصف بأنه ديوان العرب والديوان كما جاء في اللسان – مجتمع الصحف، أي: الشعر مكتبة العرب، وحافظ ثقافتهم وتاريخهم. فإذا جاز لنا أن نلحق بهذا الديوان الضخم دفتراً صغيراً يكمله فلنلحق به النثر المسجوع.
خاتمة
في الختام، يتضح أن الوصف في الأدب الجاهلي والمحاورة في الأدب الجاهلي لم يكونا مجرد أدوات فنية للتعبير، بل كانا ركيزتين أساسيتين في بناء الذاكرة الثقافية للأمة العربية. فمن خلال الوصف الدقيق للطبيعة والإنسان، رسم العرب لوحات خالدة تعبر عن رؤيتهم للعالم، وعبر المحاورات المسجوعة، حفظوا تاريخهم وقيمهم في صدورهم. وهكذا، يظل النثر الجاهلي، وخاصة بفنيه الوصف والمحاورة، جزءاً لا يتجزأ من ديوان العرب، وشاهداً على عبقرية لغوية وفنية استطاعت أن تحول الكلمة إلى سجل خالد للحياة والتاريخ.
سؤال وجواب
١. ما هي مكانة الشعر مقارنة بالنثر في الأدب الجاهلي؟
يُعد الشعر أرقى الفنون الأدبية وأقدرها على التعبير في العصر الجاهلي، حيث فاق النثر بفضل ما تميز به من تصوير وموسيقا وعمق، واستأثر بعقول العرب.
٢. كيف استطاع النثر الجاهلي مجاراة الشعر؟
استطاع النثر مجاراة الشعر من خلال فنون محددة مثل الوصف والمحاورة. فالوصف أمدّ الصور النثرية قدرة على التحليق، بينما بثت المحاورة حياة في الكلام وحولت الأفكار إلى مشاهد حية.
٣. ما هو المعيار الرئيس للتفاضل بين الأدباء في العصر الجاهلي؟
كان المعيار الرئيس للتفاضل بين الأدباء مرهوناً بقدرتهم على التصوير، أي براعتهم في فن الوصف الحي والدقيق، كما حدث في اختبار لبيد بن ربيعة.
٤. لماذا فُضِّل وصف الرائد النخعي للمرعى على وصف غيره؟
فُضِّل وصف النخعي ليس بالضرورة لخصوبة الأرض التي رآها، بل لخصوبة خياله وقدرته الفائقة على الرسم الدقيق بالكلمات، مما سحر نفوس مستمعيه وجعل ملكته المصوِّرة تتغلب على جارحة البصر.
٥. ما أبرز سمات وصف الجمال الإنساني في النثر الجاهلي كما ورد في وصف أم إياس؟
تميز وصف الجمال الإنساني بالدقة الواقعية والتفصيل الحسي الشديد، حيث قُدِّمت صورة متكاملة للمرأة من رأسها حتى قدميها باستخدام تشبيهات مستمدة من البيئة كالمراة المصقولة وأذناب الخيل.
٦. ما هي الخصائص الفنية الرئيسة للنثر في الأدب الجاهلي؟
يتصف النثر الجاهلي بخصائص عدة تشمل الخيال الصريح، والصور الحسية، والمحاورات الرشيقة، بالإضافة إلى الأسلوب المسجوع الذي كان حلية عامة تقربه من الشعر.
٧. ما الدور الذي لعبه السجع في النثر الجاهلي؟
كان السجع بمثابة سور حمى تاريخ الجاهليين وثقافتهم من النسيان. فطبيعته الإيقاعية سهّلت حفظ النصوص وتناقلها شفهياً في مجتمع بدوي مترحل يفتقر إلى وسائل التدوين المستقرة.
٨. لماذا اعتمد عرب الجاهلية على الذاكرة والحفظ بدلاً من الكتابة والتدوين؟
اعتمدوا على الحفظ لأنهم كانوا شعباً مترحلاً بطبيعته، مما جعل من الصعب إنشاء مكتبات أو أماكن مستقرة لحفظ المدوّنات المكتوبة، فكانت صدورهم هي مكتباتهم الجوالة.
٩. ماذا يعني مصطلح “ديوان العرب”؟
مصطلح “ديوان العرب” يشير إلى الشعر الجاهلي، حيث كان بمثابة السجل الشامل والمكتبة الحافظة لتاريخ العرب وثقافتهم وأنسابهم وأيامهم، وهو ما يجعله المصدر الأهم لدراسة تلك الحقبة.
١٠. هل يمكن اعتبار النثر المسجوع جزءاً من ديوان العرب؟
على الرغم من أن الشعر هو “ديوان العرب” الأصلي والأشمل، يمكن إلحاق النثر المسجوع به كدفتر صغير مكمل له، نظراً لدوره الهام في حفظ جزء من تاريخهم وثقافتهم.