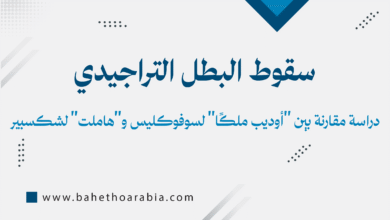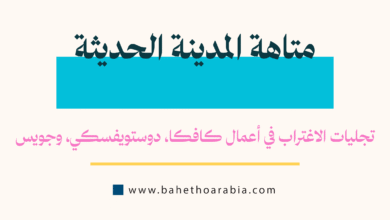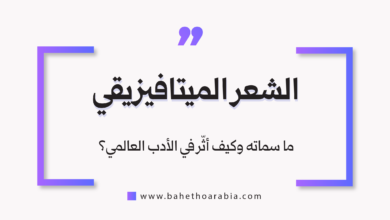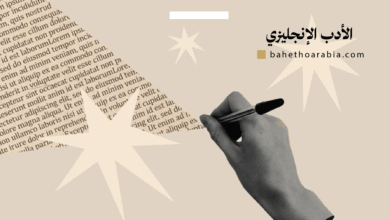من جلجامش إلى "أوميروس": تتبع تحولات الشكل الملحمي عبر العصور
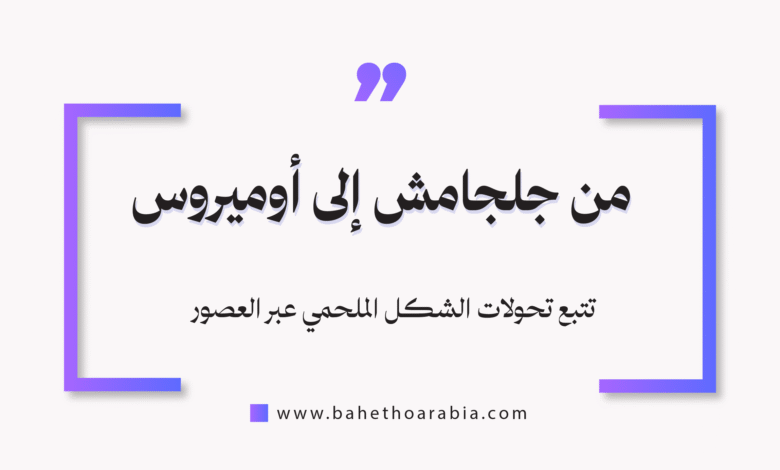
في هذا المقال، تُدرس الملحمة بوصفها شكلاً أدبياً متحوّلاً يتكثّف فيه الوعي الجماعي، ويُعاد فيه تركيب الزمن والهوية والأسطورة، من ألواح الطين الرافدية إلى مقاطع الشعر الكاريبي. يمرّ المسار عبر نقاط مفصلية: شفاهية التكوين، وسياسات الإمبراطورية، وتديين الخطاب الملحمي، وتفكيكه الحداثي، وإحيائه ما بعد الكولونيالي. من جلجامش إلى “أوميروس” لوالكوت، لا تتوقف الملحمة عن تبديل قناعها لتتكلم بلسان عصرها.
إشكالية التعريف والمنهج: ما الذي يجعل النص ملحمة؟
يقتضي تتبّع تحوّلات الشكل الملحمي ضبط إطار مفهومي يميّز الملحمة عن غيرها من الأجناس. في التصورات الكلاسيكية، تتسم الملحمة بطولها، واتساع فضائها الجمعي، وبطلها النموذجي، وارتفاع أسلوبها، وتوظيفها لتقنيات مخصوصة مثل الاستهلال بالدعاء للإلهام، والتعدادات، والتشبيه الملحمي الممتد، والولوج في منتصف الحدث (in medias res)، والانتقالات الزمنية المتواترة. بهذا المعنى، ليست الملحمة مجرد حكاية بطولية، بل سردية لائقة بتمثيل الكلّ الاجتماعي والتاريخي، تتعالق فيها الذاكرة والأسطورة والسياسة.
على المستوى النظري، يلفت ميخائيل باختين إلى أنّ الملحمة محكومة بماضٍ مغلق ومكتمل، يُروى من مسافة مهابة وبصوت لا يُنازع. في مقابل ذلك، ينفتح جنس الرواية على الحاضر والمستقبل، ويتسامح مع التعدّد واللايقين. أما الدراسات الشفاهية لدى ميلمان باري وألبرت لورد فتكشف أنّ كثيراً من الخصائص الأسلوبية التي رآها النقد لاحقاً “ملحمية” هي في الأصل حلول تركيبية لضمان الحفظ والإنشاد: الأنساق الصيغية، والألقاب المثبتة، وإيقاع البحر السداسي الدكتِيلي عند اليونان، والجناس في الشعر الجرماني القديم. يضاف إلى ذلك منظور إريك أويرباخ حول تمثيل الواقع، حيث تُظهر الملحمة الكلاسيكية ميلاً إلى الشمول والوضوح والعلنية، في حين تنزع نصوص العهد القديم ثم الرواية الحديثة إلى مستويات من الإيحاء والطباق الدلالي.
منهجياً، يقتضي هذا التتبع الجمع بين تحليل داخلي للشكل والإيقاع والرواية، وبين قراءة سياقية تربط التحوّلات الشعرية بتحولات البنى السياسية والدينية ووسائط التلقي. فكل انزياح في “لغة” الملحمة يستجيب لانزياح في وظيفتها: من تثبيت السيادة، إلى ترسيخ الدين، إلى تخييل الأمة، إلى تفكيك سرديات المركز من أطرافها.
جذور ملحمية في بلاد الرافدين: جلجامش بين الطين والخلود
تُعدّ ملحمة جلجامش أقدم نصّ ملحمي متكامل وصلنا، وقد رُكّبت صيغتها البابلية القياسية على يد ناسخين أمثال سين-لقي-أونّيني انطلاقاً من حكايات سومرية أقدم. ليس في الملحمة وزنٌ يتّصل بمشيئة البحر الدكتِيلي، لكن فيها إيقاع التكرار والتوازي، وإحكام في بنية اللوح، وصيغ شفاهية ملموسة: أفعال افتتاحية ثابتة، نداءات، توكيدات، وحِكمٌ مسكوكة. تفتتح الملحمة بعبارة “هو الذي رأى الأعماق”، في إشارة إلى خبرة معرفة تُنتزع عبر الألم والفقد، لا تُمنح عطيةً سماوية.
تعمل حبكة جلجامش على محورين كبيرين: محور الصداقة والفقد (جلجامش/إنكيدو)، ومحور السعي إلى الخلود (جلجامش/أوتنابشتيم). بينهما تتشعّب موتيفات ملحمية ستغدو نموذجاً لاحقاً: صراع مع الوحوش (خمبابا)، رفض غواية الإلهة (عشتار)، نزول بدئي إلى حدود الموت (عبور مياه الموت مع أورشنابي)، واستعارة تأسيسية للطوفان. من حيث وظيفة الخطاب، تقدّم الملحمة تصوراً مدينياً للحضارة: من البرية (إنكيدو) إلى المدينة (أوروك)، من الغريزة إلى القانون، ومن القوة العمياء إلى الذاكرة المؤسسية المرمّزة بأسوار أوروك. حين يفشل جلجامش في أن يُمسك بنبتة الشبيبة التي تسرقها الأفعى، لا يُغلق النص على يأس، بل يعيد توجيه نظر البطل إلى ما يبقى: العمل المحفور في الحجر، والمدينة المشيّدة، أي الخلود الرمزي.
على صعيد الشكل، تشتغل الملحمة بتوازي السرد والأنشودات الحكمية، وتستخدم أحلاماً تُقرأ شفراتها في جماعة، وتبني معرفة عبر الجدال والسؤال لا الوحي. في هذا، تضع جلجامش نموذجاً لملحمة لا تؤسس فقط بطولة فردية، بل تشكّل وعياً جمعياً بمحدودية الإنسان وحاجته إلى المعنى.
الملحمة الهوميرية: من جلال الحرب إلى دهاء العودة
تُنسب الإلياذة والأوديسة إلى هوميروس، وقد حُفِظتا عبر تقليد شفهي طويل انتظمت فيه الصيغ التركيبية والألقاب الملحقة بالأسماء (“سريع القدمين”، “ذات الأصابع الوردية”) مع البحر السداسي الدكتِيلي، ما يوفّر للإلقاء ركيزة إيقاعية تحفظ وتولّد. إلى جانب ذلك، تُظهر الملحمتان منظومة فنية مكتملة: دعاء إلى الموزة، افتتاح في منتصف الحدث، تشبيهات ملحمية ممتدة تربط الحرب بعالم الطبيعة والعمل، قوائم (قائمة السفن)، ووصف تصويري (درع أخيل).
تقدم الإلياذة، ظاهرياً، قصيدة عن غضب أخيل وحصار طروادة، لكنها في جوهرها تفكك معنى الكرامة والبطولة في قبيلة محاربين تعمل وفق اقتصاد الشرف والعطاء. إنّ موت باتروكلوس هو اللحظة التي تقلب أفق الرؤية: يتهشم ميثاق الجماعة، وتُطرح حدود الغضب الفردي واستعادته في وجه جثمان العدو. ترسم الأوديسة بدورها ملحمة الذكاء والعودة (نوستوس)، وتُظهر نوعاً آخر من البطولة: الحيلة والقدرة على التمثّل والتخفّي والتفاوض، مقابل البطولة العارية في ساحة القتال. يتداخل البشري والإلهي هنا حتى التمازج: تتدخل الآلهة كقوى فاعلة وكمبادئ أخلاقية وجمالية، وتنتشر النبوءات والأحلام بوصفها محطات في الخطة السردية.
استقبال الملحمتين في الثقافة اليونانية-الرومانية أسّس نموذجاً يتجاوز موضوعيهما: بنية ثلاثية الصوت بين راوي عارف، وبطل متكلّم، وجوقة/مشهد؛ لغة شعرية اصطناعية تشكّل “لهجة ملحمية” مركبة من أيونية وأيولية؛ ورؤية للعالم قوامها التوتر بين القدر والاختيار. هذه العناصر ستصبح مادةً للتناص والاختلاف لدى شعراء العصور اللاحقة.
من هوميروس إلى فيرجيل: تحويل الملحمة إلى سرد إمبراطوري
تمثّل الإنيادة لفيرجيل (القرن الأول قبل الميلاد) لحظة نقلٍ ملحمية محورية: من مدينة-دولة يونانية متشظية إلى إمبراطورية رومانية تُشيّد سرديتها الجامعة في ظل أغسطس. تقنياً، تجمع الإنيادة بين بنيتي الإلياذة والأوديسة: ستة كتب للرحلة والمحنة (أوديسية)، وستة للحرب والتأسيس (إلياذية). في المضمون، تؤسس لبطولة جديدة: ليس غضب أخيلياً ولا دهاء أوديسياً، بل “تقوى” إينياس (pietas)، أي التزامه المبدئي بوعد للآلهة وللمستقبل الروماني.
تُعيد الإنيادة توظيف التشبيهات الملحمية والوصف التصويري (درع إينياس) في أفق غائي واضح، حيث تُقرأ الأحداث بوصفها درجات في صيرورة قدرٍ تاريخي. يزور إينياس العالم السفلي ليرى موكب الأرواح التي ستصبح رجالات روما، في ذروة استشفاء الماضي للمستقبل. من منظور التناص، تُبنى القصيدة على “مشاهد مرآوية” لهوميروس، لكنّها تغيّر زاوية النظر: النساء، مثل ديدو، تتحول إلى عقدة أخلاقية وسياسية تضع البطل أمام محكّ بين الحب والواجب؛ العدو ترنوس يُقدَّم بكرامة، لكن النهاية تصفع القارئ بعنف غير متوازن، في إيماءة إلى ثمن التأسيس الإمبراطوري.
إنّ الإنيادة بهذا المعنى ليست مجرد حكاية تأسيس، بل إعادة صياغة للشكل الملحمي في خدمة دولة مركزية، مع تحويل في وظيفة الآلهة من فواعل مت capricious إلى رموز سياسية وقوى قانونية تُنتج شرعية. هذا التحويل سيؤثر في معظم الملاحم اللاحقة ذات الطابع القومي أو الإمبراطوري.
بين الهلنستية وأواخر العصور القديمة: البذخ والأسلبة والتشظي
في السياق الهلنستي، تتغير أولويات الملحمة. أرغونوتيكا لأبولونيوس الرودسي تعيد سرد رحلة ياسون طلباً للصوف الذهبي، لكنها تُدخل نفساً جديداً: سيكولوجيا الحب (ميديا)، التفاصيل الدقيقة، الإقلال من تدخل الآلهة المباشر. يرقّ السرد، ويصبح التركيز على الداخل لا على غضب جماعة محاربين. لاحقاً، يأخذ نونّوس في ديونيسيّاكا (48 كتاباً) الملحمة إلى أقصى البذخ: زخرفة لغوية، تضخيم صور، وتعدد مشاهد مفرط، في زمن يوازي تنامي المسيحية وتحول الذائقة. إنّ كتابة نونّوس لبارافراز إنجيل يوحنا إلى يونانية شعرية تعكس لحظة تواشج بين الملحمي والأسفار الدينية، وتؤكد تغير وظيفة الملحمة: من نصّ تأسيسي للأمة/المدينة إلى حقل يتبارى فيه الشاعر مع تراث لغوي/أسطوري مركّب.
في هذه المرحلة، تتضخم بعض التقاليد الأسلوبية (التشبيهات، الأوصاف، الاستطرادات)، وتتراجع عناصر الحرب الصرف لصالح الرحلة والطقس والكرنفال. هذا الانزياح الأسلوبي سيُقرأ لاحقاً بوصفه علامة تعب للملحمة الكلاسيكية، لكنه أيضاً فتح مسارات للانصهار النوعي سيستثمرها شعراء القرون الوسطى.
الملحمة والديانات التوحيدية: تديين الملحمة أو تمليح الدين
مع صعود المسيحية ثم الإسلام، يتغيّر موقع الملحمة اللغة والوظيفة. فالنصوص المقدسة ليست “ملاحم” بمعنى هوميري، لكنها تتضمن سرديات كبرى للخلق والنبوة والقيامة، وتؤسس أفقاً أخلاقياً ومعرفياً جديداً. في الفضاء البيزنطي والسرياني والعربي، ظهرت محاولات لكتابة قصائد مطوّلة في سِيَر الأنبياء أو في فضائل الخلفاء والفتوحات، دون أن تتبلور في شكل ملحمي معتمد على نمط واحد. لاحقاً، ستندفع الملحمة المسيحية الغربية إلى إعادة تأويل قصة الخلق والسقوط، بينما يتولّد في المجال الإسلامي شكل قريب من الملحمة في السير الشعبية، بمزج نثري-شعري وبتحكيم الحكاية الإطارية والإنشاد العامّي.
هذا التديين أو “تمليح الدين” يعني أنّ الملحمة تفقد كثيراً من تعدد الآلهة ودينامياتها الرمزية، لكنها تكسب محكّاً أخلاقياً متعالياً يفرض على السرد مواجهة أسئلة الخير والشر والخلاص على مستوى كوني. هنا تتأسس شروط ملحمة جديدة، كما سيتضح في دانتي وميلتون.
القرون الوسطى الأوروبية: من أغنية المآثر إلى تأسيس نَسَب قومي
في أوروبا الغربية، تتجلى الملاحم الوسيطة في طيف من النصوص. بيولف، في شعر إنجلو-سكسوني مرتكز على الجناس، تمزج بين عالم وثني (وحوش، تقدير للقوة) وأخلاقيات مسيحية (قدرية، تواضع، وعي بالخطيئة). أنشودة رولان، بألازاتٍ تعتمد التوافق الصوتي، تؤسس نموذج الفارس المسيحي المدافع عن الإيمان في مواجهة “الآخر”. نشيد النيبلونغن يعيد تركيب أساطير جرمانية في إطار بلاط إمبراطوري، حيث الشرف والانتقام والمكيدة تشتبك في تراجيديا دموية.
يحضر في هذه النصوص تحوّل حاسم: من ميثولوجيا الآلهة إلى سياسة البلاط، من الحرب بوصفها اقتصاد شرف إلى الحرب بوصفها واجب ديني أو تاريخي. بنيوياً، يتراجع دور الاستطراد الكوني لصالح حدثية أكثر اختزالاً، لكن تقنيات الملحمة تبقى: الاستهلال والحضور الجماعي والتعداد والإيقاع القوي. كذلك، يسهم التحول اللغوي إلى العاميات الأوروبية في هيكلة “أدب قومي”، تتصاعد فيه الحاجة إلى سرديات أصل ونَسَب.
الملاحم خارج المتوسط: الهند وفارس وأفريقيا
أنتجت أحياز ثقافية أخرى ملاحم كبرى ذات منظومات جمالية مختلفة. في الهند، تتّسم المهابهاراتا والرامايانا بامتدادٍ زمني ومكاني هائلين، وببنية سرديّة تضم حِكماً وشروحات لاهوتية وفلسفية (مثل البهغفاد غيتا). الإيقاع قائم على “الشلوكا”، والقصص تتبدّل بوصفها خزّاناً لِسِيَرٍ ومثلٍ أخلاقيةِ الدَّرما. في فارس، تكتب الشاهنامة لفيروزي (الفردوسي) ملحمة قومية في بحر مستوي الإيقاع، بالشعر المثنوي الموزون، تجمع بين الأسطورة والتاريخ، وتبني “هوية إيرانية” عبر أخبار رستم وسهراب وزال والإسكندر.
في أفريقيا الغربية، تُنشد سيرة سوندياتا كيتا على لسان الجريّو، مؤدي الذاكرة، بمرافقة آلة الكورا، في شكل شفهي يتكئ على التكرار والاستدعاء التناوبي بين الراوي والجمهور. هنا تؤدي الملحمة وظيفة تأسيس الجماعة، حيث تمثّل السيرة دستوراً أخلاقياً وتاريخاً شفاهياً.
على صعيد البنية، تلك الملاحم لا تقل “ملحمية” عن نظيراتها المتوسطية: ثمة بطل، ثمة تأسيس جماعة، ثمة لغة شعرية وإيقاع، وثمة رؤية كونية للعدالة. لكنها تُظهر أنّ الملحمة ليست قالباً واحداً، بل طيف من أشكال يتكيّف مع وسائل الحفظ (شفاهية/كتابية)، ومع اللغات (فارسية، سنسكريتية، ماندينغ)، ومع تصوّرات العدالة والبطولة.
السير الشعبية العربية: ملحمة الجماعة في فضاء الحكواتي
في المجال العربي الإسلامي، تتجسد الملحمية في “السير الشعبية” الكبرى: سيرة بني هلال، سيرة عنترة، سيرة سيف بن ذي يزن، سيرة الظاهر بيبرس، وغيرها. تُروى هذه السير في صيغة هجينة بين النثر المُسجّع والقصيد، ويؤديها حكواتي في فضاء عمومي (قهوة، سوق)، مع قابلية للتوسيع والتعديل وفق تجاوب الجمهور. من منظور الشكل، تُستثمر تقنيات ملحمية: مقابسات شعرية، حوارات حكمية، تكرار صيغ افتتاحية، ألقاب للمحاربين، سرد نسبيّ للأحداث يؤمّن للأبطال أنساقاً أخلاقية وأصلية.
وظيفياً، تُقيم السيرة ملحمة جماعية، لا قومية مركزية: البطولات موزعة بين أبطال كثر، والعالم الرحب (من جزيرة العرب إلى المغرب والسودان) يُختزل في شبكة من الولاءات والكرامات. يتداخل الديني والأسطوري، وتظهر الكرامات إلى جانب القتال، في انعكاس لتصوّر العالم وفتوحته. ورغم غياب “الوزن” الكلاسيكي الموحد، يمنح الأداء الشفهي والإيقاع المصاحب الملحمة العربية شعبية وتمدد زمن.
دانتي والكوميديا الإلهية: ملحمة الرؤيا واللغة القومية
تمثل الكوميديا الإلهية قطيعة وصل: تستخدم قالباً بعيداً عن الحرب والرحلة البحرية لتصوغ ملحمة “رحلة النفس”، مركباً بين ملحمي ورؤيوي ولاهوتي. بنيوياً، تبنى القصيدة على 100 نشيد موزع على ثلاثة أقسام (جحيم، مطهر، فردوس)، وبلغة إيطاليةعامية مؤسِّسة، وتيرتسا ريما (سلاسل ثلاثية مترابطة القوافي) تُحدث تدفقاً سردياً متداخلاً. يقود فيرجيل (العقل والشعر الوثني) دانتي في جزأين، ثم تتولّى بياتريتشي (النعمة) الدفة في الفردوس، في إخراج درامي للمعرفة.
تحتوي الكوميديا موسوعية العالم الوسيط: تاريخ، جغرافيا، لاهوت، سياسة، أدب. وهي في الوقت نفسه “ملحمة” تقيس العالم بمقياس الخلاص. يعيد دانتي تعريف البطولة: ليست في الفتك، بل في التمييز الأخلاقي والمعرفة. من ناحية التلقي، تؤسس الكوميديا لغة قومية إيطالية أدبية، وتضع سابقةً لملحمة لا تقوم على الحرب بل على السمو الروحي والفكري، ستغري لاحقاً شعراء كثر بإعادة كتابة الماورائي كتابة ملحمية.
عصر النهضة وبناء الإمبراطوريات: أريوستو، تاسّو، كامويش
تشهد النهضة الأوروبية استعادة واعية للملحمة الكلاسيكية وتطويعها لخدمة سياقات معاصرة. “أورلاندو الغاضب” لأريوستو هي ملحمة-رومانس متشابكة بخيوط حب وحرب وسحر، مكتوبة في “الأوتافا ريما” (ثمانيات مقفاة)، وتلعب بالانتقال السريع بين مشاهد عديدة. “تحرير القدس” لتاسّو يعيد قصة الحروب الصليبية، موازنًا بين رفعة الأسلوب والرهان الديني والسياسي، وبأوتافا ريما تضبط السرد في إيقاعات متوازنة. أما “اللوسياد” لكامويش فتُحوّل اكتشافات البرتغاليين إلى ملحمة بحرية، حيث تؤدي الآلهة الوثنية القديمة أدواراً رمزية في خدمة مشروع مسيحي إمبراطوري، ويظهر مجاز البحر مسرحاً للتاريخ والمجد الوطني.
هذه النصوص تحافظ على كثير من أدوات الملحمة (الاستدعاء، التشبيهات، القوائم، الوصف المصوّر)، لكنها تُدخل أيضاً الانبهار بالبحر وبالخرائط وبالعالم المكتشف حديثاً، وتعيد رسم البطولة بحيث تتضمن المغامرة الاستكشافية والسياسة البحرية. إنها ملاحم تأسيس فائق، تُضمر مشروع دولة-أمة صاعدة أو إمبراطورية في الأفق.
ملتون والفردوس المفقود: الملحمة اللاهوتية الحديثة
يجلب جون ملتون الملحمة إلى قلب اللاهوت البروتستانتي، ويكتب “الفردوس المفقود” شعراً مرسلاً بلا قافية، في جلال لغوي وصور كونية. إعادة كتابة قصة السقوط والحرب في السماء لا تُقدَّم بوصفها قصة ماضٍ متعالٍ فحسب، بل بوصفها جدلاً أخلاقياً وسياسياً عن الحرية والطاعة، وعن اللغة والتأويل. تستعاد تقنيات الملحمة (دعاء إلى “الموزة السماوية”، وصف الأسلحة، التشبيهات الممتدة)، لكن الملحمة هنا تُعاش كصراع داخل اللغة ذاتها، حيث تغري شخصية الشيطان القارئ ببلاغتها، ما فتح سؤال “من البطل حقاً؟”.
يؤسّس ملتون تصوراً لملحمة يمكن أن تُكتب في لغة معاصرة وثقافة توحيدية دون فقدان الجلال، عبر استبدال الآلهة الوثنية ببنية لاهوتية رمزية، واستبدال تأسيس المدن بتأسيس أخلاقي للإنسان في التاريخ. إنه انعطاف يفتح للأزمنة اللاحقة مسار “ملحمة الأفكار”.
القرن الثامن عشر: الملحمة الساخرة وصعود الرواية
يتحوّل الذوق في القرن الثامن عشر نحو التعقّل والاعتدال، وتبرز الملحمة الساخرة (mock-epic) التي تحطّ الأسلوب الملحمي على وقائع صغيرة، كما في “اغتصاب خصلة الشعر” لألكسندر بوب، حيث تُستبدل المعارك بالكؤوس والمراوح، وتُستثمر أدوات الملحمة (الدعاء، المعجم الرفيع، التدخّلات) لإنتاج أثر كوميدي نقدي. هذا التلاعب يكشف تراجع صلاحية الملحمة التقليدية لتمثيل عالم برجوازي ناشئ، متعدد المصالح والأصوات.
في الوقت نفسه، تتسع الرواية كجنس قادر على استيعاب العالم الحديث، كما لاحظ باختين: زمن مفتوح، أبطال عاديون، لغة متعدّدة المستويات، وقدرة على دمج أصوات مختلفة في نص واحد. سيظهر منذ هذه المرحلة “حلم الملحمة الروائية”: أن تُكتب رواية بحمولات وامتداد ملحميين، وهو ما سيبلغ مداه في القرن التاسع عشر والحداثة.
القرن التاسع عشر: بناء الملاحم القومية وتدوين الشفهي
تحت مطلب الدولة-الأمة، تتكاثر مشاريع “الملحمة القومية”: تدوين “الكاليفالا” الفنلندية من أغاني كاريلية شفوية، كتابة “بان تاديوش” لميكيفيتش كملحمة قومية بولندية في أزمنة الاحتلال، وتخليق نصوص أميركية تطمح إلى الملحمية مثل “أغنية هياواثا” للونغفلو، حيث يُحاكى الإيقاع الهنودي أميركياً في مشروع ثقافيّ ملتبس. في العالم اللاتيني، يكتب نيرودا لاحقاً “نشيد عام” كملحمة قارة وأيديولوجيا.
يتوازى هذا المسار مع عناية بتدوين الملاحم الشفوية الأفريقية والآسيوية، كجزء من إثنографيا استعمارية أيضاً. سيرة سوندياتا، وغيرها، تُنقل إلى الكتابة، فتتحوّل البنية الشفوية. هنا تبرز إشكالات الأصالة والتحرير: هل يُجمّد النص الحيّ؟ أم يحفظه؟ لكنها لحظة أثبتت أنّ الملحمة ليست ملكاً لثقافة واحدة، وأنّ أشكالها تتعدد وفق الاقتصاد الثقافي.
الحداثة: تفكيك الملحمة وإعادة تركيبها
تدخل الحداثة النص الملحمي عبر التفكيك والتركيب. “الأناشيد” لعزرا باوند تُقيم ملحمة من القصاصات: إقتباسات متعددة اللغات، تواريخ، أساطير، اقتصاد نقدي، مونتاج شظايا. “الأرض الخراب” لإليوت تُقرأ أحياناً ملحمة للخراب، حيث تَحلّ الأساطير وتحولات المواسم محل التاريخ البطولي. في الرواية، يكتب جيمس جويس “يوليسيس”، محوّلاً يوم رجل عادي في دبلن إلى ملحمة مضادة تُعيد ترميز الأوديسة عبر خرائط المدينة واللغة.
من جهة الشكل، تُخلخل الحداثة فكرة السرد الواحد؛ تتعدد الأصوات، يتشظى الزمن، وتصبح الملحمة مشروعاً لتمثيل الذاكرة الجماعية والمأزق الحضاري لا الانتصار. ويغدو سؤال “من يحق له أن يكتب الملحمة؟” سؤالاً عن المركز والأطراف، عن اللغات الكبرى والأقليات. هنا يدخل ما بعد الكولونيالية إلى المشهد.
ما بعد الكولونيالية وإعادة كتابة المركز من الأطراف
في سياقات ما بعد الاستعمار، لم تعد الملحمة استعادة نموذج أوروبي فحسب، بل وسيلة لتفكيكه وإعادة قراءته. يُعاد توطين الأساطير في جغرافيا جديدة: تُقرأ الملاحم اليونانية بوصفها تراثاً عالمياً، لكن يُستعاد عبر لغات عامية وخبرات عبودية ومهجر. تتقدّم البحر والهجرة والشتات بوصفها فضاءات ملحمية. تُصبح “الجزيرة” منصةً لاستعادات كونية، واللغة هجينة، تتناوب بين الفصحى والدارجة، بين الاستعارة المحلية والتناص الكلاسيكي.
هكذا، لا تكون الملحمة الجديدة مشروع تمجيد إمبراطوري، بل نقداً للهيمنة، واستعادة للذاكرة المضطهدة، وتخيّلاً لمجتمع متعدّد. في هذا الأفق، تندرج “أوميروس” لديريك والكوت بوصفها ذروةً فنية لهذا النوع من التوسّع وإعادة التوطين.
“أوميروس” لوالكوت: سياق ومرجعيات
نُشرت “أوميروس” عام 1990، ويمثل عنوانها نفسه تلاعباً وتحيةً: أوميروس (هوميروس) وقد بات اسماً يتكلم بلكنة كاريبية. ينتمي والكوت، شاعر سان لوتشيا الحائز جائزة نوبل، إلى حقل لغوي وثقافي هجين، يجمع بين الإنجليزية والمعجم الكريولي، وبين إرث الاستعمار البريطاني والذاكرة الأفريقية والهندية الكاريبية. في “أوميروس”، لا يكتب والكوت “نسخة جديدة” من الإلياذة والأوديسة، بل يعرّف الملحمة بوصفها طريقة لرؤية العالم، ويضعها في جزيرة كاريبية صغيرة، بين صِيادين وأحياء فقيرة وضباط استعمار متقاعدين.
تنتظم القصيدة في مقاطع ثلاثية الأسطر (قريبة من التيرتسا ريما في الإيحاء لا في الالتزام الصارم)، ويتناوب فيها صوت الراوي الشاعر مع أصوات الشخصيات والمشهد ذاته (البحر، الأشجار، الجبال). شخصياتها الأساسية تحمل أسماء هوميرية بإزاحة: أشيل وهكتور وصديقهم فيلوكتيت، والمرأة هيلين، والميجور بلانكِت وزوجته مود، وشخصيات أخرى منها “سبعة بحار” الذي يستحضر صورة الشاعر الأعمى/الرائي. تمتد جغرافيا القصيدة من سان لوتشيا إلى أفريقيا إلى الولايات المتحدة وأيرلندا، في مسار يعكس تشتت الهوية الكاريبية وصلاتها.
المرجعيات كثيفة: الأسطورة الإغريقية، نصوص الكتاب المقدس، استعادات من ملحمة جلجامش في سؤال الخلود والاسم، أشعار كولريدج ونيرودا وبايرون، وذاكرة العبودية والعتق. لكن المرجعية الأكبر هي البحر: “الموزة” التي تُستدعى في الإلياذة/الأوديسة هنا تتجسد في “بحر يتكلم”، يعزف أمواجه على قيثارة الجزر.
بنية “أوميروس”: تعددية الأصوات، الزمن المركّب، والشكل الهجين
تتبنى “أوميروس” تركيبة سردية متشظية، لا تُبنى على حبكة خطية واحدة بل على أنساق من “مشاهد-حراب” تعود وتلتقي. قصة أشيل وهكتور تتخذ شكلاً ملحمياً مضاداً: صِدام الصيادَين على امرأة (هيلين) لا ينتهي بحصار مدينة، بل بحوادث عادية ومأسوية (موت هكتور في حادث سيارة بعد أن أصبح سائق أجرة، جراح فيلوكتيت المستمرة التي تبرأ بالعودة إلى طب الأعشاب المحلي). في الآن نفسه، ينطلق الراوي في رحلات داخلية وخارجية، إلى أفريقيا (حيث يرى أشيل سلفه في حلم/عودة متخيلة) وإلى شمال الأطلسي، وصولاً إلى مناخات أيرلندية تُضاعف معنى الاستيطان والذاكرة.
زمن القصيدة مركّب: يعيد الماضي الحاضر، لا بوصفه نموذجاً متعالياً بل بوصفه مادة تتملكها الجزيرة. تتكرر المشاهد وتتغاير، كما لو أن القصيدة تمارس “تكراراً ملحمياً” دون صيغ ثابتة، بل عبر استعادات صورية وأسطورية. شكل المقاطع الثلاثية يمنح السرد إيقاعاً يتدرّج بين الهدوء والعصف، ويتيح للوصف الملحمي (للطبيعة، للقوارب، للمدن) أن يصير عصباً للسرد، لا استطراداً زخرفياً.
من منظور الصوت، لا يحتكر الراوي الكلام: الشخصيات تتكلم، والبحر يتكلم، والمكان يشهد. هذه التعددية تنقل الملحمة من خطاب راوي-عارف إلى نصّ كوكبيّ يعترف بتعدد وجهات النظر، فتقترب “أوميروس” من حساسية الرواية الحديثة دون التخلي عن شعريتها العالية.
اللغة والصورة في “أوميروس”: من التشبيه الملحمي إلى استعارة الجزيرة
يحافظ والكوت على تقليد التشبيه الملحمي، لكنّه يزرع جذوره في الطبيعة الكاريبية: البحر يلمع كابتسامة قرش، الأمواج كتلاميذ، الجبال كأكتاف عبيد قدامى. تتحول الكثافة الاستعارية إلى مِجسّ تاريخي، يعيد وصل الطبيعة بالذاكرة، واللغة الملحمية بالعامية. يتناوب المعجم الرفيع مع الكلمات الكريولية، وتتقاطع السخرية الرهيفة مع الجدّ الأخلاقي، في ما يشبه إزاحة متواصلة لتوقعات القارئ.
لا يقدم والكوت “قوائم سفن”، لكنه يكتب “قوائم أسماء” لأدوات صيد، لأشجار، لطيور، كأنما يقول: هذا العالم الذي كان يُستبعَد من الملحمة التقليدية يملك نصابه في جلال اللغة. تظهر أيضاً وصفية مصوّرة (ekphrasis) للبحر والقوارب والمشاهد، لكنها لا تظلّ واقفة على السطح، بل تعبر إلى الداخل: إلى جرح فيلوكتيت الذي يعيد تمثّل الجرح التاريخي للعبودية والاستعمار.
البطل والبطولة: من الفرد الاستثنائي إلى الجماعة المجروحة
في “أوميروس”، تُعاد صياغة مفهوم البطل. أشيل ليس قاتلاً أسطورياً بل صياداً يتقن عمله؛ هكتور ليس قائد جيش بل عامل صار سائقاً؛ فيلوكتيت ليس آتياً من أسطورة هرقليسية بل إنسان يحمل جرحاً لا يندمل، يُداويه معالج شعبي. هيلين ليست سبب حرب عالمية، بل امرأة لها وجود خاص وفاعلية رمزية (هي الجزيرة أيضاً، وهي الجمال والسوق والفتنة).
تنتفي البطولة الفردية المتعالية لصالح بطولة يومية جماعية: القدرة على الاحتمال، على الحبّ، على البقاء، على تسمية الأشياء. يعيد هذا التحديد السلطة إلى “الهامشي”، ويحوّل الملحمة من سجل انتصارات إلى سجل حياة. في هذا الإطار، يبدو الراوي نفسه متورطاً: ليس راوياً محايداً، بل ذاتاً تاريخية تسائل جذورها، وتزور أمكنة العبودية وممراتها، وتفاوض معنى الكتابة بالإنجليزية من جزيرة ما بعد استعمارية.
الذاكرة والجرح والبحر: ملحمة الأطلسي الأسود
تدور “أوميروس” حول جرحين متداخلين: الجرح الفردي (فيلوكتيت) والجرح التاريخي (العبودية). يشتغل النص على استعارة الجرح التي تُشفى لا بالعلم الحديث وحده، بل بالعودة إلى معرفة محلية، وبالتصالح مع التاريخ. البحر، الذي كان في الملحمة الكلاسيكية فضاء المغامرة، يصبح هنا فضاء الذاكرة المؤلمة: مسرح “المرور الأوسط” الذي حمل العبيد. لكنه أيضاً فضاء كرم: بحر يطعم الصيادين ويُغني البلاغة.
من الناحية الجغرافية-الرمزية، تشكل الجزيرة “عقدة” للطرق: الماضي الأفريقي، الحاضر الأميركي، الأثر الأوروبي. يمارس والكوت “خرائط معاكسة”: يعبر الأطلسي ليعيد كتابة مساراته من الجنوب إلى الشمال، من الأطراف إلى المركز، ويستعيد الأسماء ليحوّلها: “أخيل” و”هكتور” يصيران أسماءً كاريبية، لا استعارات عن حضور يوناني محض. هذا التوطين يحيل إلى سياسة نصية: تحويل المركز عبر اللغة.
من جلجامش إلى أوميروس: خطوط تحوّل الشكل والرؤية
إذا وضعنا جلجامش مقابل أوميروس، تتبدّى خطوط تحول كبرى. زمن جلجامش يُكتب على ألواح طين بحروف مسمارية ويُبنى على تكرار وصيغ شفوية، يمتح من أسطورة متعددة الآلهة ويبحث في محدودية الإنسان أمام الموت، ليثبت في النهاية خلوداً رمزياً عبر المدينة والعمل. زمن أوميروس يُكتب في عالم ما بعد كولونيالي، بلغة إنجليزية مثقوبة بلكنة كريولية، يستعيد أسطورة متعددة الآلهة ليكتب عبرها قصة جزيرة أفرادها مجروحون، ويقترح خلوداً من نوع آخر: أن تُسمّى الأشياء وأن تُحفظ الذاكرة وأن تُرى الكينونة اليومية بجلال ملحمي.
بنيوياً، انتقلت الملحمة من راوي عارف يمسك بخيوط سرد موجه إلى راوٍ شريك يفتح النص على تعدد. انتقل البطل من استثنائي مؤله إلى فرد عادي تتوزع البطولة على جماعة. تحوّلت الآلهة من فواعل إلى استعارات، ومن رموز لشرعية الإمبراطورية إلى محركات للوعي والذاكرة. تغيّر الإيقاع من أبحر مقيسة إلى مقاطع مرنة هجينة. وتحوّلت الوظيفة من تمجيد السيادة إلى نقد الهيمنة، ومن تثبيت الهوية إلى تخيّلها وفكّ استعمارها.
في العمق، النواة ثابتة: ملحمة هي طريقة لقول “نحن” بلغة القصيدة الطويلة. لكن “نحن” تتغير: من مدينة إلى إمبراطورية، إلى أمة، إلى قارة، إلى جزيرة، إلى جماعة هامشية. هذا التحول يكشف قدرة الملحمة على البقاء حية، عبر قدرتها على تغيير مركزها البلاغي ومعجمها الأخلاقي.
ترددات عربية حديثة: بين استعادة الإرث وتخليق الملحمة الشعرية
في الشعر العربي الحديث، لم تتبلور “ملحمة” بمعنى تقني صارم، لكن ظهرت قصائد طويلة مشروطة برؤية ملحمية: موسوعية التقاط العالم، واحتشاد الذاكرة الجمعية، وتوتر اللغة بين الفصيح والرمزي والشعبي. أعمال محمود درويش في مراحل لاحقة (مثل “مديح الظل العالي” و”أحد عشر كوكباً”) تحمل أنفاساً ملحمية في تخييل فلسطين ومآزق الهوية والمنفى. مجازات المطر وتموز عند بدر شاكر السياب تستعيد أساطير ما بين النهرين في مصهر حداثي. تُقرأ السير الشعبية كذلك بوصفها مخزوناً ملحمياً حياً يستعاد في المسرح والشعر والرواية.
في الرواية، يشتغل نجيب محفوظ في “ملحمة الحرافيش” على سجل طويل لأسرة وحارة هما صورة لمجتمع، بما يلمح إلى طموح ملحمي روائي. تحضر محاولات تأصيل “ملاحم قومية” في الكتابة التاريخية والشعرية، لكنها تظل في الغالب رهناً بتناقضات الدولة-الأمة واللغة والإعلام. في كل ذلك، يتبدّى أن الملحمية العربية الحديثة ماثلة في الجمع بين الذات والجماعة، بين المدينة والتاريخ، أكثر من تمثل قالبٍ وزنيّ موحد.
وسائط جديدة وامتدادات: السينما والرواية والألعاب
تجاوزت الملحمة حدود الشعر المكتوب إلى وسائط تمثيل أخرى. السينما أنتجت “ملاحم” بصرية، تتكئ على السرد الطويل والتصوير المهيب والموسيقى، مثل ملاحم تاريخية وحربية، كما أعادت السلاسل الروائية الخيالية (على غرار عوالم الفانتازيا) تصور الملحمة بصيغ شعبية. الألعاب التفاعلية بدورها تُنشئ سرديات طويلة متعددة النهايات، حيث يستعيد اللاعب وظيفة “الجوقة” و”البطل” في آن، ويشارك في كتابة المصير. هذه الوسائط لا تُلغِي الملحمة الشعرية، لكنها تدل على أن وظيفة الملحمة – تمثيل الذاكرة الجماعية وتخيّل المصير – قادرة على استيطان أشكالٍ متنوعة.
مع ذلك، يبقى للشعر الطويل منزلة خاصة: الاقتصاد في اللغة، الكثافة المجازية، قدرة الإيقاع على صنع “زمن ملحمي” غير زمني الواقع. هذا ما يجعل “أوميروس” نموذجاً يصعب استبداله بنظير بصري، رغم تأثيراتها الصورية الواسعة.
خاتمة: ملحمة تتغيّر لتبقى
من جلجامش إلى “أوميروس”، يطول خيطٌ واحد ويتلوّن: ملحمة هي فنّ بناء ذاكرة كبرى، تُكتَب بوسائط مختلفة ولغات متعددة، لكنها تبحث دائماً عن جواب لسؤال “من نحن؟”. تغيّر معنى “نحن” في كل محطة: أهل أوروك، محاربون أخيليون، رومان يؤسسون عاصمة العالم، فرسان مسيحيون، أمم ناشئة، جزر محيطية مفصولة وموصولة ببحرٍ من الذاكرة. تحوّلت الآلهة إلى استعارات، والأسوار إلى لغات، والأسلحة إلى أدوات صيد أو سيارات أجرة، لكن ظلّت الملحمة قادرة على رفع اليومي إلى مقام الجليل.
في عالم اليوم، حيث تتنازع السرديات الكبرى مع الحقائق الجزئية، تبدو الملحمة – حين تُكتب بوعي نقدي – أداة لفهم التعقيد لا لتبسيطه، لاستعادة التاريخ لا لتبريره. “أوميروس” تقدّم نموذجاً: ملحمة من الأطراف لا تُقلّد المركز بل تحاوره وتعيد كتابته؛ ملحمة لا تمجّد حرباً ولا إمبراطورية، بل تُنصت إلى عالم صغير وتجعله ذاكرة كونية. في هذا الأفق، لن تموت الملحمة ما دامت قادرة على تبديل شكلها وفق حاجات العصور: قد تأتي غداً في قصيدة طويلة عن تغيّر المناخ، أو في رواية تعددية الأصوات عن مدن غارقة، أو في إنشادٍ رقميّ تفاعلي. المهم أن تظل قادرة على أن تقول لجماعة ما: هذا أنتِ، بما لكِ وما عليكِ، في مرآة لغة تتّسع للتاريخ والجرح والحلم.