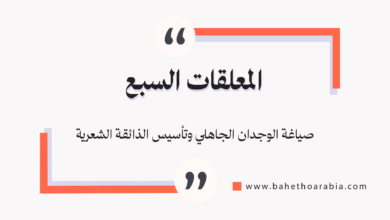تقسيم موضوعات الشعر الجاهلي بين القدماء والمحدثين

تمثل دراسة موضوعات الشعر الجاهلي أحد المداخل الأساسية لفهم البنية الفنية والمعرفية للشعر العربي قبل الإسلام، كما تتيح إعادة قراءة تراث النقد العربي في ضوء قضايا التصنيف والمنهج. ويأتي هذا العمل في إطار مراجعة نقدية موسّعة لمسألة تقسيم موضوعات الشعر الجاهلي بين القدماء والمحدثين، بهدف اختبار وجاهة الأطروحات، وحدود المناهج، وأثر الخلفيات الفكرية في بناء خرائط الموضوعات.
وتغطي هذه الدراسة العناصر الآتية: جهود القدماء (ابن سلام، أبو تمام، العسكري)، مناقشة “الاعتذار”، رأي بروكلمان، علاقة الشعر بالكهانة، أسبقية الموضوعات الحسية. وتكشف العودة الدقيقة إلى مدونات الأدب ودواوين الشعر عن أن معظم المصنفين والرواة الأوائل كانوا أكثر حرصاً على الجمع والتدوين من حرصهم على بناء منهج تصنيفي دقيق لـ موضوعات الشعر الجاهلي؛ كما أن ما ظهر من محاولات تصنيفية موجّهة للموضوعات بقي في الغالب جزئياً أو متداخلاً أو غير محكم الحدود.
يتتبع هذا البحث جهود ثلاثة من الأعلام عند القدماء: محمد بن سلاّم الجمحي، وأبي تمام، وأبي هلال العسكري، بوصفهم محطات متصاعدة في الوعي بالمحاور الموضوعية، ويوازنها برؤية حديثة يمثلها كارل بروكلمان. ويتأمل، تبعاً لذلك، علاقة الشعر بالكهانة والسحر، وكيفية تداخلهما في الاستعمال الاجتماعي للقول الشعري، تمهيداً لبناء تصور نقدي لتاريخ موضوعات الشعر الجاهلي.
كما يناقش البحث رأي بروكلمان في نشأة القول الشعري وصلته بالبُعد السحري والطقسي، وما يترتب عليه من اختبار أسبقية الموضوعات الحسية أو الموضوعات المجردة، مع إبداء احترازات منهجية مفادها أن البرهنة التاريخية على أسبقيات موضوعية ليست يسيرة، وأن الأدلة النصيّة والأنثروبولوجية تحتاج إلى مواءمة حذرة.
وتخلص الدراسة إلى أن الاتفاق على تقسيم صارم لـ موضوعات الشعر الجاهلي عسير لأسباب نصية ومنهجية وسياقية، وأن أكثر المحاولات القديمة والحديثة ظلت تتردد بين التصنيف بحسب الأغراض الكبرى وبين تداخل الخطابات الوظيفية والاجتماعية للشعر.
وتُعد هذه الورقة تمهيداً نظرياً موسعاً يُهيّئ لعمل تطبيقي لاحق على مختارات ونصوص مخصوصة، بحيث تتضح مسارات التحليل عبر أمثلة دقيقة من صلب موضوعات الشعر الجاهلي، قبل الانتقال إلى “التطبيق الوصفي” الموعود.
تقسيم الشعر الجاهلي
إذا رجعنا إلى دواوين الشعر وإلى كتب الأدب التي صنّفها قدماء الرواة والمصنّفين لا نعثر على تقسيم منهجي محكم ينتظم موضوعات الشعر الجاهلي؛ فالأولوية عند أكثرهم كانت للتدوين والجمع والحفظ، لا لبناء خارطةٍ تصنيفية مفصّلة. وحتى حين يُقترح تقسيم ما، نجده يميل إلى تقييم الشعراء وطبقاتهم لا إلى ضبط تقسيم موضوعات الشعر الجاهلي على نحو مانعٍ جامع.
ومن ثمّ اتجه بعضهم إلى الترتيب الطبقي بحسب الفحولة والتفاضل، كما فعل محمد بن سلّام الجمحي (ت: ٢٣١هـ)، وهو تقسيم يقوم على المكانة الشعرية والنقدية لا على بنية الأغراض والموضوعات. وبهذا المعنى، ظل الوعي الموضوعي عند هؤلاء مشفوعاً بهمّ التوثيق والاختيار، أكثر منه بمشروع تصنيف داخلي لمدوّنة القصيدة.
أما من فَطِنَ إلى الموضوعات، فلم يكن دائماً دقيقاً في الفرز والتبويب، ولا في جمع القصائد المتشاكلة في موضع واحد. فقد حاول أبو تمام حبيب بن أوس الطائي (ت: ٢٣٢هـ) تنظيم حماسته في أبواب موضوعية، فبلغت أكثر من عشرة أبواب، وهي:
- الحماسة
- المراثي
- الأدب
- النسيب
- الهجاء
- الأضياف
- المديح
- الصفات
- السير
- النعاس
- المُلح
- مذمّة النساء
غير أنّ تمييزه بين هذه الأبواب ليس دائماً دقيقاً؛ فـ“مذمّة النساء” ضرب من “الهجاء”، و“الأضياف” يتأرجح بين “الفخر” و“المديح”، وانضواؤه تحت أحدهما يُصلح التصنيف ولا يفسده. وهذا يشي بأنّ تداخل الأغراض في التجربة النصية والوظيفة الاجتماعية للشعر يُربك أي محاولة لتقنين صارم لحدود موضوعات الشعر الجاهلي.
وقد يكون المتأخرون أدقّ تقسيماً من المتقدمين حين اختصروا الأبواب ودمجوا المتقارب منها، كما صنع أبو هلال العسكري (ت: ٣٩٥هـ) إذ قال: إن أقسام الشعر في الجاهلية خمسة: المديح، والهجاء، والوصف، والتشبيب، والمراثي، حتى زاد النابغة فيه قسماً سادساً وهو “الاعتذار”، وقد أحسن فيه. ومع ذلك، فثمة نظرٌ يرد على هذا التقسيم؛ إذ يمكن أن يُلحق “الاعتذار” بالمديح بوصفه شكلاً من أشكاله، كما يمكن إضافة أبواب أخرى مؤثرة في مدوّنة القول، وفي مقدمتها “الحماسة”، ولعلّ العسكري طواها في “المديح” أو “الوصف”، وهو ما يستدعي إعادة فحص حدوده وحدود غيره من أبواب موضوعات الشعر الجاهلي.
رأي بروكلمان في البدايات وعلاقة الشعر بالكهانة
في العصر الحديث، اقترح كارل بروكلمان تحديد الموضوعات الأولى في الشعر الجاهلي بالاستناد إلى أبحاث غربية سابقة، وانتهى إلى أن البدايات اقترنت بالسحر والطقس وأن “الهجاء” كان في يد الشاعر بمنزلة فعلٍ سحري يرمي إلى تعطيل قوى الخصم بتأثيرٍ غيبي. ويُروى أنه إذا همّ الشاعر بإطلاق ذلك اللعن ارتدى زياً مخصوصاً شبيهاً بزيّ الكاهن، ومن هنا أيضاً تسميته بالشاعر، أي صاحب العلم الماورائي.
ومما يُسند هذا التصور اقتران القول الشعري بالكهانة في المتخيّل العربي القديم؛ إذ كذّب القرآنُ الكريمُ من نسب الوحيَ إلى شاعرٍ أو كاهن، فقال تعالى: {إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلاً ما تذكّرون تنزيل من رب العالمين). غير أن الاستئناس بهذا الإطار الثقافي لا يكفي وحده للحكم بأسبقية موضوعٍ بعينه ضمن تاريخ موضوعات الشعر الجاهلي، ولا ينهض دليلاً قاطعاً على أن الهجاء هو الأسبق زمناً.
بل قد يصح القول إن شعر الحكمة والتأمل أقرب إلى سجع الكهان وإلى الأفق الديني منه إلى الهجاء والمديح؛ فإذا كانت الكهانة والديانة والحكمة توائم خرجت من رحمٍ فكري واحد، أمكن ترجيح أن التأمل أسبق من الهجاء، لكنه ترجيحٌ مشروط، لا يصحّ إلا إذا ثبت أن الشعر ربيب الكهانة حقّاً. وعندئذٍ، يظل الحُكم بأقدمية أي فرعٍ من موضوعات الشعر الجاهلي رهناً بدليلٍ تاريخي ولساني أقوى.
الجدل حول أسبقية الحسّي والمجرّد ومقارنة بالفنون
يُخيّل إلينا أن نضج الكهانة، وما تستبطنه من مقام التأمل، يقتضي طوراً من الارتقاء اللغوي والمعرفي ينقل اللغة من المحسوس إلى المجرد، ويرفع الفكر من تحسّس الظواهر إلى تصوّر ما وراءها. وضمن هذا الأفق، يُتاح أن نقارب موضوع التأمل في إطار موضوعات الشعر الجاهلي لا بوصفه طارئاً، بل باعتباره مفصلاً من مفاصل التكوين المعرفي للنص.
وبهذا الاعتبار، يميل الترجيح إلى سبق الموضوعات الحسية للموضوعات المجردة؛ فالوصف قد يتقدم الهجاء والمراثي، لأن الوعي الجمالي بالطبيعة والبيئة والإنسان يسبق عادة صوغ التجربة في قوالب أخلاقية وجدلية. وهذا الترجيح لا يلغي احتمال التداخل والتزامن، لكنه يضبط النقاش حول ترتيب موضوعات الشعر الجاهلي بين الحسّي والمجرّد بضوابط معرفية ولسانية.
ولأجل مزيدٍ من الإيضاح، يمكن القياس على تجارب الشعوب في الفنون الأخرى، كالنحت والرسم، حيث عالجت الأعمال الفنية الأولى تصوير الطبيعة على الحجر والجدران. ومن ثمّ لا يمتنع أن يكون البدويّ الجاهلي بدأ بتصوير ما يراه: النخلة، والناقة، والمرأة، تماماً كما صنع الإنسان القديم في مصر واليونان؛ وهو قياس يساعد، على نحوٍ مقارن، في تصور نشأة موضوعات الشعر الجاهلي واتجاهها من المحسوس إلى المجرد.
خلاصة: صعوبة الاتفاق وحدود الطرح التاريخي
الخلاصة أن النقاد القدماء لم يجتمعوا على تقسيمٍ محكمٍ نهائي لمدوّنة الأغراض، وأن التقسيم التاريخي لظهور الموضوعات بقي محدود الجدوى، مع استثناء ملحوظ هو موضوع “الاعتذار” الذي تبلور على يد النابغة الذبياني. وعلى هذا الأساس، يتعين التعامل مع أي سردية لتاريخ موضوعات الشعر الجاهلي بوصفها فرضية قابلة للمراجعة وفق الأدلة النصية والمقارنات الداخلية والخارجية.
وبذلك، تتضح حدود الطرح التاريخي حين يقارب تعاقب الأغراض بحسب فرضيات النشأة: سحر، كهانة، حكمة، وصف، هجاء، رثاء… وهي حدودٌ تدفع إلى التريث في بناء تصنيفات قاطعة أو إطلاق أحكامٍ نهائية على خريطة موضوعات الشعر الجاهلي.
خاتمة
أظهرت هذه الدراسة أن الرحلة بين جهود القدماء ورؤى المحدثين تكشف مسالك متعددة في بناء خرائط موضوعات الشعر الجاهلي، وأن كل مسلك يرتكز إلى مقولات نقدية ومعرفية خاصة: من الجمع والتدوين عند الأوائل، إلى التبويب المجرّب في حماسة أبي تمام، إلى الاختزال النسبي عند أبي هلال العسكري، وصولاً إلى الأطروحات الأنثروبولوجية المقارنة عند بروكلمان.
وإذا كان سحر القول، ووظائف الشعر الاجتماعية، ومقام الكهانة، عناصرَ تستأنس بها القراءة، فإنها لا تكفي وحدها لإرساء ترتيبٍ تاريخي حاسم؛ ومن ثَمّ يبقى التصنيف أداة عملٍ مرنة تتكيّف مع طبيعة النصوص، حتى حين يُراد لها أن تُحكِم مقاربة موضوعات الشعر الجاهلي وتستكشف أنساقها الدلالية.
لقد حاولنا هنا التوفيق بين المقاربة التاريخية والمقاربة النصية، وبين النظر المقارن والقراءة الداخلية، بما يُعين على إبراز تداخل الأغراض وتساندها. ومع اتساع المادة وتعدد التأويلات، تظلّ قابلية المراجعة والتصحيح شرطاً منهجياً لازماً لاستمرار البحث في موضوعات الشعر الجاهلي بمنهج علمي رصين.
وتأكيداً لوحدة المشروع، تأتي هذه الخاتمة تمهيداً نظرياً لما بعدها: خاتمة قصيرة تمهد للانتقال من “الإطار النظري” إلى “التطبيق الوصفي” في المقال التالي، حيث سنباشر تحليل نماذج نصيّة بعينها، ونقيس صلاحية التصنيفات المقترحة على شواهد حيّة من موضوعات الشعر الجاهلي.
الأسئلة الشائعة
١) ما المقصود بـ“التقسيم الموضوعاتي” في سياق الشعر الجاهلي؟
- هو بناء تصنيفي يُدرِج القصائد والنتف الشعرية في حقول دلالية ووظيفية متمايزة، كالهجاء والمديح والوصف والرثاء والتشبيب والحماسة، مع مراعاة تداخل الحدود. ويهدف هذا البناء إلى تيسير قراءة تطوّر موضوعات الشعر الجاهلي في ضوء السياقات اللغوية والاجتماعية. ومن خلاله يمكن قياس درجة التمايز بين الحقول، ورصد العناصر المشتركة، وتحديد ما إذا كان لبعض موضوعات الشعر الجاهلي قابلية الاستقلال أو الاندماج.
٢) لماذا لم ينجز القدماء تصنيفاً دقيقاً ونهائياً للأغراض؟
- لأن عنايتهم الأولى انصرفت إلى الجمع والرواية والتوثيق، وإلى التمييز بين الشعراء بحسب الطبقات والفحولة، لا إلى استحداث منظومات تصنيفية صارمة؛ ولأن طبيعة القصيدة الجاهلية نفسها تُظهر تداخلاً وظيفياً بين الأغراض يصعب معه الفصل القاطع، وهو ما يعقّد أي محاولة لترسيم حدود ثابتة لـ موضوعات الشعر الجاهلي في صورة قوالب جامدة.
٣) كيف نفرق بين “الاعتذار” و“المديح” في التقسيم؟
- الاعتذار عند النابغة الذبياني مثال رفيع على خطاب يطلب الصفح ويستعطف، وغالب عناصره البلاغية تتساند مع بنية المديح من تعظيم شأن المخاطَب وتجميل صورته، ومن ثمّ رأى بعض النقاد إمكان إلحاقه بالمديح. ومع ذلك، قد تتطلب قراءة بعض النصوص جعله باباً مستقلاً ضمن موضوعات الشعر الجاهلي حين تتغلب وظائف الاستعطاف والدرء على وظائف التعظيم.
٤) ما وجاهة الربط بين الشعر والكهانة في البدايات؟
- الوجاهة في أن القول الشعري، في طوره الأقدم، قد شغل وظائف اجتماعية طقسية من لعنٍ ودفعٍ وجذبٍ واستنزالٍ، وهي وظائف تتقاطع مع مقام الكاهن والساحر. لكن هذا الربط، على أهميته التفسيرية، لا ينهض دليلاً قاطعاً على ترتيبٍ زمني لميلاد موضوعات الشعر الجاهلي؛ بل يجب تحكيم الشواهد النصية وقرائن الاستعمال قبل تقرير أسبقية موضوعٍ على آخر ضمن خريطة موضوعات الشعر الجاهلي.
٥) هل الهجاء أقدم موضوع في الشعر الجاهلي؟
- ليس ثمة دليل حاسم يثبت ذلك؛ فإمكان أسبقية الوصف والحكمة قائمٌ بالنظر إلى بداهة الالتفات إلى الطبيعة والذات قبل الدخول في سجالات الصراع. ويظلّ القول بأقدمية الهجاء فرضيةً تحتاج إلى شواهد دقيقة من تاريخ موضوعات الشعر الجاهلي وتداولها في الحياة القبلية.
٦) ما أثر المقارنة بالفنون البصرية على فهم التطور الموضوعي؟
- تفيد المقارنة في ترجيح بدء التعبير الفني من المحسوس إلى المجرد، وهو ما ينسجم مع تقدّم الوصف والتصوير على غيرهما في كثير من الثقافات. وهذا الترجيح لا يعني تقريراً نهائياً، بل توجيهاً منهجياً لقراءة تدرّج موضوعات الشعر الجاهلي في ضوء خبرات إنسانية أوسع.
٧) كيف نفسر غياب التصنيف الدقيق في دواوين مثل “الحماسة”؟
- لأن منظور الإنشاء جرى على اعتبار الذائقة والاختيار الموضوعي العام، لا على ترسيم حدودٍ مانعة بين الأغراض؛ وتاريخياً، كان همّ المُنْتخِب إبراز الجودة البلاغية والشاهد اللغوي، لا بناء نظام تصنيف نهائي، وهو ما يفسر التداخل بين أبوابٍ قريبة في موضوعات الشعر الجاهلي.
٨) ما القيمة العلمية للتاريخ الموضوعي مقابل التصنيف الموضوعاتي؟
- التاريخ الموضوعي يرصد التعاقب والتحول وارتباط القول بسياقات الصراع والسلم والدين والاقتصاد، بينما التصنيف الموضوعاتي يضبط الحقول الدلالية ووظائفها. والتكامل بينهما يثري فهم موضوعات الشعر الجاهلي ويمنح الباحث عدّةً مزدوجة لرؤية النسق والحدث معاً.
٩) كيف نجمع بين المقاربة الأنثروبولوجية والمقاربة البلاغية؟
- تُعين المقاربة الأنثروبولوجية على فهم الوظائف الاجتماعية والطقسية للقول، فيما تكشف البلاغة عن تقنيات الأداء والصناعة وحيل التصوير. والقراءة المثلى تجمع بينهما لتتبّع تشكّل موضوعات الشعر الجاهلي في الاستعمال والإنشاء، وتتحقق من مدى استمرار تلك الوظائف أو تحوّلها داخل موضوعات الشعر الجاهلي عبر الزمن.
١٠) ما آفاق البحث اللاحقة التي تقترحها الدراسة؟
- الانتقال إلى “التطبيق الوصفي” عبر تحليل نماذج محددة من النصوص، لفحص صلاحية التقسيمات المقترحة، وتتبع مناطق التداخل والتميّز. وسيكون من المفيد اختبار حقول مثل الوصف والحماسة والهجاء والرثاء والتشبيب على عيّنات ممثلة، بما يتيح بناء تصوّرٍ أدق لمسالك موضوعات الشعر الجاهلي وعلاقاتها الداخلية.