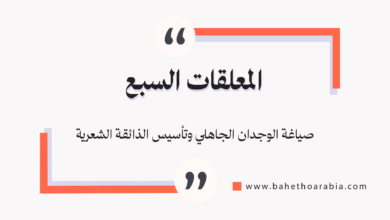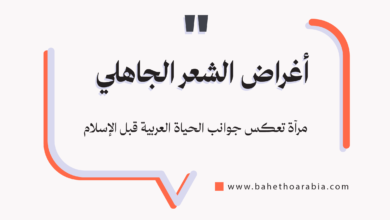غزل المطالع في الشعر الجاهلي: دراسة تحليلية في بنية القصيدة الجاهلية
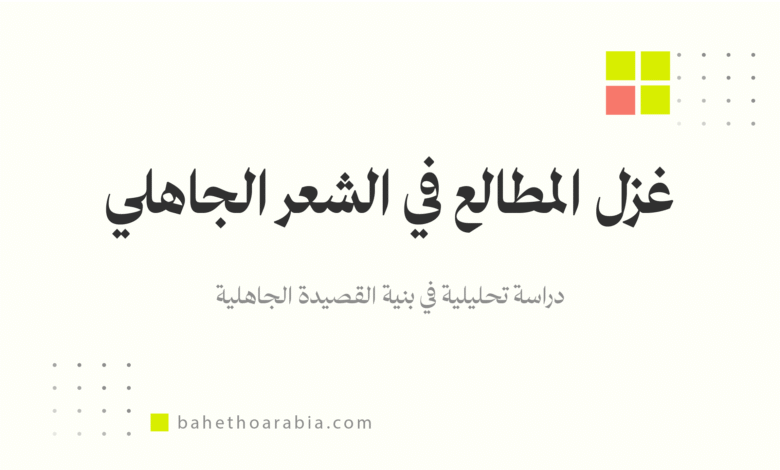
قبل أن ترتفع أصوات الفخر وحداء الإبل وقرع السيوف، كان هناك صوت آخر يفتتح القصيدة الجاهلية؛ صوت حنين يقف على أطلال ديار مهجورة، يستنطق حجارتها الصامتة، ويسترجع طيف حبيبة رحلت مع الظعائن. لم يكن هذا الوقوف مجرد عادة شعرية، بل كان المفتاح النفسي الذي يشرع أبواب القلوب، والمدخل الوجداني الذي يمهد الطريق لأعظم أغراض الشعر. في هذه الدراسة التحليلية، سنغوص في أعماق “غزل المطالع”، لنكشف كيف حوّل الشاعر الجاهلي وحشة الطلل إلى مسرح حي للحب والذكرى، وكيف نسج من خيوط الفراق والذاكرة بنية فنية خالدة أصبحت السمة الأبرز للقصيدة العربية.
مفهوم غزل المطالع ووظيفته في القصيدة الجاهلية
لقد أدرك الشعراء في العصر الجاهلي، من خلال حسهم وحدسهم الصادقين، الأفضلية التي يتمتع بها غزل المطالع في الشعر الجاهلي على سائر الأغراض الشعرية الأخرى؛ ونتيجةً لذلك، عمدوا إلى جعله مفتتحًا لقصائدهم بهدف لفت انتباه الأسماع، ومن ثم النفاذ من خلالها إلى القلوب دون عناء أو استئذان. إن الأهمية التأسيسية التي يحظى بها غزل المطالع في الشعر الجاهلي تكمن في كونه المدخل النفسي والعاطفي للقصيدة.
وفي سياق غزل المطالع في الشعر الجاهلي، قاموا بربط الطلل بالمحبوبة، فكان هذا الربط أصدق الأدلة على وفائهم للوطن والسكن، وعلى جعلهم المرأة أقوى الوشائج التي تشدهم إلى منابتهم في الحل والترحال. وفي إطار غزل المطالع في الشعر الجاهلي يبرز تساؤل جوهري: أيّ كلام أحبّ إلى العاشق المغترب من ذكر الأحبة والديار؟ وأيّ بدوي تقوم حياته على التّرحل الدائم ثم لا يعرض له الشوق والاغتراب؟ إن غزل المطالع في الشعر الجاهلي يجيب عن هذه التساؤلات.
وفي هذا السياق، يقدم ابن قتيبة رؤية تحليلية توضح فلسفة غزل المطالع في الشعر الجاهلي، حيث يقول: (سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيه بذكر الديار والدّمن والآثار، فبكى وشكا، وخاطب الربع، واستوقف الرفيق ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين، إذ كانت نازلة العَمَد في الحلول والظعن على خلاف ما عليه نازلة المدر لانتجاعهم الكلأ، وانتقالهم من ماء إلى ماء، وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان. ثم وصل ذلك بالنسيب، فشكا شدة الشوق، وألم الوجد والفراق، وفرط الصبابة، ليميل نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، ولسيتدعي به إصغاء الأسماع إليه). تُظهر هذه الرؤية أن منهجية غزل المطالع في الشعر الجاهلي كانت واعية ومقصودة.
الوقفة الطللية: بوابة الغزل والصراع النفسي
لقد كانت الأطلال —على ما فيها من وحشة وكآبة— المدخل الذي يفضي منه الشاعر الجاهلي إلى غزل المطالع في الشعر الجاهلي لارتباطها بأحبّته. ولمّا كان الطلل هو باب غزل المطالع في الشعر الجاهلي، فقد كان الشاعر يحييه، وهو في حقيقة الأمر لا يحيّي إلا حبيبته، ويدعو له بالسلامة من الآفات، ولا يرى السلامة إلا لمن كانت تعمره. ألا ترى امرأ القيس كيف حيّا ديار سلمى التي محت رسومها الأمطار الغزيرة، وكيف سخر من تحيته قبل أن يسخر منها أحد؟ وكيف يعقل أن تسمع التحية أو تنعم بالسلامة أرض قفر، ارتحل عنها أهلها من شهور؟ إن هذا المشهد يمثل جوهر غزل المطالع في الشعر الجاهلي.
ألا عِمْ صباحاً أيّها الطّلل البالي *** وهل يَعِمَنْ من كان في العُصُر الخالي
وهل يَعِمَنْ منْ كان أحداثُ عهدهِ *** ثلاثين شهراً في ثلاثة أحوالِ
ديار لسلمى عافياتٌ بذي خالِ *** ألحَّ عليها كلُّ أسحَمَ هطّالِ
وفي هذه الوقفة الطللية التي تعد ركناً أساسياً في غزل المطالع في الشعر الجاهلي، يختلط الحاضر بالماضي، ويمازج الفرح الحزن، ويساور القلق الاطمئنان، فلا يستطيع الشاعر أن يتبين في هذا الخليط من المشاعر المتداخلة الحقيقة من الوهم، فيستحضر صورة المحبوبة ليجريها بين الظباء والآرام، أو ليذكّرها ما كانت تصبو إليه. كانت سلمى تظن أن حياتها السعيدة مع امرئ القيس لن تنتهي، وأن الحال لن تحول، وهيهات هيهات!! فقد انطوت الأحلام وبقي الطلل شاهداً على تجربة غزل المطالع في الشعر الجاهلي.
وتحسب سلمى لا تزال ترى طلاً *** من الوحش أو بيضاً بميثاء محلال
وتحسِب سلمى لا تزال كعهدنا *** بوادي الخُزامى أو على رسٍّ أوعالِ
صحيح أن الطلل في غزل المطالع في الشعر الجاهلي يُصوَّر كأرض قفر، ومنازل مهجورة، لم يبق منها غير النؤي المتهدم، وحجارة المواقد السوداء، وأبعار الظباء المتناثرة، غير أنه —على ذلك كله— وطنٌ من أوطان حلّ بها الشاعر الجاهلي. يتصور الشاعر الطلل بلا أهل، أو المحبوبة بلا أرض تحمل خطاها إلى ذاكرته، وماضيها على حاضره، وشبابها الريان إلى كهولته، فإذا هو يخرج من وقار الكبار، ليرفل في حلل الفتيان، ويدعي الفتك والإغواء، وهذا التحول الدرامي هو من سمات غزل المطالع في الشعر الجاهلي.
ألا زعمَتْ بَسْبَاسةُ اليومَ أنني *** كبرت، وألاّ يُحْبسن اللّهو أمثالي
كذبت لقد أُصبي على المرء عِرسَهُ *** وأمنع عِرسي أن يُزنّ بها الخالي
وهكذا ينقلب المشهد في لحظات من أرض قفر إلى مسرح حيّ. فهل يستطيع أحد أن يتهم شعر الأطلال المرتبط بـغزل المطالع في الشعر الجاهلي بالجمود، وفيه هذا العالم الذاخر بالحياة والحب والغزل؟
وإذا كانت إنسانية العاطفة هي المحكّ الذي تضرب عليه العواطف ليعرف صادقها من الكاذب، فإن غزل المطالع في الشعر الجاهلي يجسد أقوى العواطف الإنسانية، وأوسعها شمولاً، وأعلقها بالنفوس، وألصقها بالغرائز. يحسُّها شباب الشعراء وكهولتهم، لكنها في الشباب تزداد عنفاً، وفي الكهولة تخبو ولا تنطفئ. إن غزل المطالع في الشعر الجاهلي يعبر عن هذه الحالة الإنسانية بصدق.
وقد أشار ابن قتيبة إلى هذه الطبيعة الفطرية في معرض حديثه عن أسباب شيوع غزل المطالع في الشعر الجاهلي بقوله: (التشبيب قريب من النفوس، لائط بالقلوب، لما قد جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل، وإلف النساء، فلا يكاد أحد يخلو من أن يكون متعلقاً منه بسبب، وضارباً فيه بسهم حلال أو حرام).
ورغم صدق هذا النمط من غزل المطالع في الشعر الجاهلي وشرف مقصده، فإنه لم ينجُ من سهام النقد، فقد ذهب قوم إلى أن ورود غزل المطالع في الشعر الجاهلي في استهلال القصائد المطولة هو دليل على أنه لم يكن أكثر من تقليد مرعي، وسنة متبعة، وعادة لا يستطيع الشاعر التملّص من شركها. وحجتهم الأولى في ذلك أن الشاعر كان يحلي به قصيدته سواء أكان شاباً أم كهلاً، عاشقاً أم غير عاشق. وهي حجة واهية، لأن الشاعر قد يستنكر التصابي وهو إلى اللهو تائق، وعلى الشباب متحسّر كما قال النابغة، في إطار غزل المطالع في الشعر الجاهلي ذاته:
دعاك الهوى واستهلتك المنازل *** وكيف تصابي المرء والسيب شامل؟
وحجتهم الثانية أنه قد يستنكر الهوى ليصرف فتيان القبيلة عن التخنث إلى المكارم. والحق أن ازدجار الشيخ أو إعراضه عن الغزل لا يعني أن غزل المطالع في الشعر الجاهلي هو غرضٌ ورسمٌ مرسوم على الشاعر لا انفعال فيه، وإنما هو تعبير عن صراع بين نقيضين هما: بقايا الشباب الراحل، ونُذُر الكهولة الوافدة، أو ثورة النفس الأمارة باللهو، على سلطة المجتمع الداعية إلى الوقار. وهذا الصراع جزء لا يتجزأ من تجربة غزل المطالع في الشعر الجاهلي.
تجليات الفراق والذكرى: من تحية الدار إلى مشهد الظعائن
ربما كان ارتباط المرأة بالأطلال في غزل المطالع في الشعر الجاهلي تعبيراً عن توق البداوة إلى الاستقرار، وضجر الإنسان من القلق الذي يلازم حياة الترحيل، ولهذا تتردد فيه أصوات النساء تدعو الرجال إلى المكث في الديار. فإذا ملّ الرجال الأسفار، ومروا بديار الأحبة أحسّوا نوعاً من السكينة والطمأنينة يخلع على غزلهم نبالةً وسموّاً لا مثيل لهما في أغراض الشعر الأخرى، وهذا السمو من خصائص غزل المطالع في الشعر الجاهلي. ومضوا يكلمون النؤى والأثافيّ، وهم يتمثلون اللواتي كُنَّ يرفلن في هذه المواضع، ويملأنها جمالاً ودلالاً وبهاءً ورواء، فإذا المرأة والوطن في إطار غزل المطالع في الشعر الجاهلي يصبحان كيانًا واحدًا.
إن مرّ عنترة بدار عبلة في (الجواء) حيّاها وكلّمها، ودعا لها بالسلامة، وما المقصود بالتحيات والدعوات في غزل المطالع في الشعر الجاهلي إلا عبلة:
يا دار عبلة بالجواء تكلّمي *** وعِمي صباحاً دار عبلة واسلمي
وإن رأى زهير (حومانة الدرّاج) سألها عن أم أوفى، إذ لا فضل لأرضٍ على أرض إلاّ في شيء واحد، وهو ارتباطها بالمحبوبة، وهذا هو محور غزل المطالع في الشعر الجاهلي:
أمن أمِّ أوفى دِمنةٌ لم تَكَلّمِ *** بحومانه الدّراج فالمتثلّمِ
وربما جعل الشاعر داره وآثار داره وشماً في يد المحبوبة، حتى تغدو المرأة وطن الوطن، لا بعض الساكنين فيه، كما يتجلى في غزل المطالع في الشعر الجاهلي. قال طرفة:
لخولة أطلالٌ ببرقة ثهمدِ *** تلوحُ كباقي الوشم في ظاهر اليدِ
أو ربما أحسّ الشاعر العجز عن الوفاء بحق المحبوبة فاستعان بمن يعينه على الوفاء بالبكاء، فإذا هو خاشع ضارع، أو صامت قانت يبكي ويستبكي كأنه في محراب عبادة يكفّر عن خطاياه. وهذه الحالة الشعورية من أعمق صور غزل المطالع في الشعر الجاهلي. قال امرؤ القيس:
قفا نبكِ من ذكرى حبيب ومنزلِ *** بسِقْط اللِّوى بين الدَّخُول فحَوْملِ
وما بكاء العاشق على الطلل الدارس والمحبوبة النائية بأعظم من بكاء المعشوقة على العاشق المفارق؛ لهذا ألحّ الشاعر في هذا النمط من غزل المطالع في الشعر الجاهلي على تصوّر صاحبته باكية، وحمّله هذا التصوّر حسرات لا تفارقه، فكلّما خلا إلى نفسه وافاه طيف المحبوبة يعاتبه، وخُيّل إليه أنه يراها شاكية باكية، تنهمر العبرات من عينيها الحوراوين على خدّيها الأسيلين. قال بشامة بن الغدير:
هجرتَ أُمامةَ هجراً طويلاً *** وحمَّلكَ النَّايُ عِبئاً ثقيلاً
وحُمِّلتَ منها على نأيها *** خيالاً يُوافي، ونَيْلاً قليلا
أتتنا تُسائلُ: ما بَثُّنا *** فقلنا لها: قد عزمنا الرَّحيلا
فبادرَتاها بمستعجِلٍ *** من الدّمع ينصحُ خدّاً أسيلا
ولما كان أساس غزل المطالع في الشعر الجاهلي هو التصور والتذكر، وبث الحياة في الماضي لعله يعود حاضراً —هيهات!— فقد كثر فيه ذكر المواضع التي مرّت بها المحبوبة، وبهتت الصور، وتقطّعت، لأن خطوطها وألوانها وحركاتها تستمد من الذاكرة، والذاكرة لا تحمل إلى الشاعر ما تحمله العين من صور واضحة مشرقة، بل تحمل إليه أبعاضاً من صور متنافرة، تتصل برحيل المحبوبة، وتقبّلها بين أطراف الأرض، وبياض بشرتها، وسحر حديثها، كما تحمل إليه معنى يُرضي غروره، وهو حرص المحبوبة على بقاء الشاعر إلى جوارها، وخوفها عليه من المهالك، وهذا التصور جزء لا يتجزأ من غزل المطالع في الشعر الجاهلي. قال النابغة:
بانت سعادُ وأمسى حَبْلُها انجذما *** واحتلَّت الشّرع فالأجزاعَ من إضما
غرّاءُ أكملُ من يمشي على قدمٍ *** حسناً، وأملحً من حاورته الكلما
قالت: أراك أخا رَحْلٍ وراحلةٍ *** تغشى متالفَ لن يُنْظرنَك الهرما
والراحلة التي ترحل بالشاعر لا تعدّ ذات خطر إذا قيست بالراحلة التي تنأى بالمحبوبة. إنّ صورة الظعائن في غزل المطالع في الشعر الجاهلي البدويّ أوضح الصور، وأبقاها في الذهن. فالشاعر بعد أن يتعرف الطلل، ويحدد مكانه، وزمان الرحيل عنه تعود به الذاكرة إلى الماضي، فيقبض إليه طرفه الذي أرسله بين النؤي والأثافي، وينكفئ إلى يوم الفراق الذي ودّع فيه أحبته، فيخيل إليه أنه يبصر الهوادج تحمل حبيبته، ثم تبتعد عن المضارب متئدة، كأنها سفن تعوم فوق أمواج دجلة. ويبرع غزل المطالع في الشعر الجاهلي في تصوير هذا المشهد. قال عبيد بن الأبرص:
تبصّر خليلي هل ترى من ظعائن *** يمانيّة، قد تغتدي وتروحُ
كعومِ سفين في غوارب لجةٍ *** تُكفِّئها في وسط دجلة ريحُ
وأثر الفراق في نفوس الظعائن لا يقل عن أثره في نفوس الشعراء، ولهذا كانت كلّ ظعينة تثقب نسيج كلّتها لترسل بصرها إلى الديار يتملّى ويودّع، وكان المثقب العبدي يرى أحداق الظعائن براقة خلف الثقوب، كما يرى أطواق الذهب على نحورهن وترائبهن البيضاء الصقلية، فيقول ضمن غزل المطالع في الشعر الجاهلي:
ظَهَرْنَ بِكِلّة وسَدَلْنَ رقما *** وثقبْنَ الوصَاوِص للعيونِ
ومن ذهب يلوح على تريبٍ *** كلونِ العاجِ ليسَ بذي غضونِ
وأصعب أنواع الفراق ما فاجأ الشاعر، ولهذا كاد علقمة بن عبدة يصعق حينما أبصر قوم محبوبته عند الفجر، يردّون الإبل عن مراتعها، ويشدُّون في أعناقها الأزِمَّة، ويحملون عليها الهوادج مجللة بالوشي الأحمر الذي يخدع الطير، فتحط على الهوادج متوهمة أنها علّقت على جوانبها قطع لحم غريض ينزف دماً. وأما صاحبة علقمة فقد كانت حبيسة هودج من هذه الهوادج، يفوح منها طيب، لا يفارق أنف الشاعر ما عاش، وهذا التصوير الحسي من روائع غزل المطالع في الشعر الجاهلي:
لم أدر بالبين حتى أزمعوا ظعناً *** كلّ الجمال قبيل الصبح مزموم
ردّ الإماءُ جمالَ الحيّ، فاحتملوا *** فكلّها بالتزيديات معكومُ
عقلاً ورقماً تظلّ الطيرُ تخْطُفهُ *** كأن من دم الأجواف مدموم
يحملن أترجة تضخ العبير بها *** كأن تطيابها في الأنف مشموم
البنية المنهجية والتفرد الشعري في غزل المطالع
ويبدو من استعراض القصائد التي بلغتنا أن الظعائن كن حريصات على اتخاذ زينتهن ساعة الرحيل لتكون صورهن في نفوس من يودعهن أجمل وأكمل وأرقى، وأبقى. فيطرقن أعناقهن البيض بعقود الياقوت الأحمر، ويضعن على ترائبهن قلائد الذهب الأصفر، ويضفن إلى ذلك كله الخرز اليماني واللؤلؤ البراق فيخطفن بصر شاعر عاشق كالمرقش الأصغر، مما يثري تجربة غزل المطالع في الشعر الجاهلي، فيقول:
تحلّين ياقوتاً وشذراً وصيغة *** وجزعاً ظفارياً ودُرّاً توائماً
أو يلقين جنوبهن البضة اللينة على حوايا وحشايا تزيدهن بضاضةً وليناً. فمتى سارت الإبل اشرأبت أعناقهن المضمّخة بالطيوب كما تشرئب أعناق الظباء إلى أغصان الأراك، فيخيل إلى امرئ القيس ضمن غزل المطالع في الشعر الجاهلي فيقول:
جعلن حوايا، واقتعدن قعائداً *** وحفّفن من حواكِ العراق المنمّق
وفوق الحوايا غِزْلةٌ وجاذرُ *** تضمّخن من مسكٍ ذكيّ وزنبقِ
وفي بعض المطولات يطغى مشهد الظعائن على هذا النمط من غزل المطالع في الشعر الجاهلي، حتّى يغدو وصفاً جميل الصور، فاتر العواطف، تشرق فيه الصور ويبرد الحس. وأوضح الأمثلة على ذلك تسعة الأبيات التي وصف فيها زهير مطعن أم أوفى في معلقته، حين مضى يعدد الأمكنة التي سلكتها قافلة الظعائن، ويصف الكلل الحمر، ونثار الصوف الساقط منها على الأرض، فلا يعرف الشاعر المفارق كثيرٌ ولا قليلٌ من ألم الفراق بل يمتع بصره بمرأى النسوة المتأنقات، كأنه عابر سبيل يشهد عرائس تزف إلى أزواجهن، فيقول:
وفيهن ملهى للطيف ومنظرٌ *** أنيقٌ لعين النّاظر المتوسِّم
وعلة ذلك عندنا أن زهيراً قال ما قال وفوق كتفيه ٨٠ عاماً، جف فيها العصب، وخمدت الصبوة، وآض عرام الغريزة المتسعّر رماداً بارداً كالشيب الذي يغمر رأسه، مما أثر على طبيعة غزل المطالع في الشعر الجاهلي لديه.
ومما عرضنا يظهر أن هذا الضرب من غزل المطالع في الشعر الجاهلي هو منهج وأفكار وصور متشابهة، لا تختلف كثيراً باختلاف الشعراء. يبدأ الشاعر بتعرف الأطلال والبكاء عليها، ثم يصف ما فعلته الأنواء فيها، وما أبقاه الزمان من آثارها، وبعد ذلك يتذكر محبوبته، فيصف جمالها وصفاً سريعاً، يعتمد على التذكر، ويختم هذا الغزل بوصف الظعائن، وهذه هي البنية الكلاسيكية التي يقوم عليها غزل المطالع في الشعر الجاهلي.
وإذا وقع شيء من الاختلاف بين الشعراء فهو اختلاف محدود مردود إلى مقدار ما يوليه من العناية كلّ شاعر لكلّ معنى، وإلى ما يعروه من المشاعر في كلّ موقف. فبعض الشعراء يطيل في وصف المحاسن وبعضهم يطيل في تصوير موكب الظعائن وبعضهم يغمره حزن يبكيه، وبعضهم يتسلّى بالجمال المتخيل عن الألم الملم. وبهذا الاختلاف يكتسب غزل المطالع في الشعر الجاهلي تنوّعاً وثراءً يتمثلان في بروز السمات الخاصة بكل شاعر، وطغيان النوازع الشخصية على المنهج العام.
وهذه الظاهرة تعني أن غزل المطالع في الشعر الجاهلي ليس تقليدياً، يمحق الشخصية، ولا نافلة من القول يؤديها الشاعر على نحو فاتر، وإنّما هو تعبير عن بيئة فعلت فعلها في الشعراء. فكان لهذا الفعل مظهر اجتماعي عام تلقاه في المنهج الواحد، والمعاني المتشابهة، ومظهر فردي خاص تلقاه في أنماط الاستجابة لهذه البيئة، وطرائق التعبير عنها. فلا يغمر العامُّ الخاصَّ، ولا تلغي التقاليد المشتركة النوازع الشخصية في فن غزل المطالع في الشعر الجاهلي.
خاتمة
وهكذا، يتضح أن غزل المطالع ليس مجرد تقليد أعمى أو مقدمة شكلية، بل هو جوهر التجربة الإنسانية في الصحراء؛ إنه صراع الذاكرة ضد النسيان، وتشبث الشاعر بآخر خيوط الوصل بينه وبين ماضيه السعيد. من الوقفة الخاشعة أمام الطلل البالي، مروراً باستحضار صورة المحبوبة بكل بهائها، وانتهاءً بمشهد الظعائن الحزين الذي يقطع كل أمل في اللقاء، يرسم الشاعر الجاهلي ملحمة وجدانية متكاملة. لقد أثبت هذا الفن أن القصيدة لم تكن مجرد كلمات، بل كانت وطناً متنقلاً يحمل فيه الشاعر دياره وأحبته أينما حل وارتحل، ليظل غزل المطالع شاهداً خالداً على عبقرية ربطت بين الإنسان، والمكان، والعاطفة في نسيج شعري فريد لا يبلى.