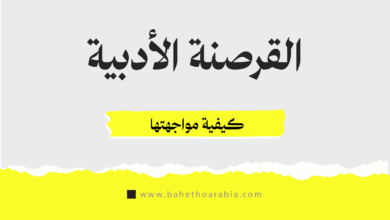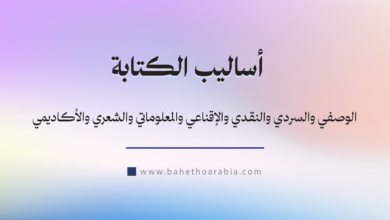غياب الأب وتأثيره على مفهوم الحب في الرواية النسوية: تفكيك السلطة وإعادة تعريف الذات

تستكشف هذه المقالة الأبعاد النفسية والأدبية لغياب الأب وتأثيره على مفهوم الحب في الرواية النسوية، محللةً كيف تستخدم الكاتبات هذه التيمة لتفكيك البنى الأبوية وإعادة صياغة مفاهيم الحب والعلاقة والذات.
إن شخصية الأب، سواء بحضورها الطاغي أو بغيابها المدوي، تمثل حجر الزاوية في البناء النفسي للفرد والنسيج الاجتماعي للأسرة. وفي عالم الأدب، لم تكن هذه الشخصية مجرد عنصر سردي، بل رمزاً مكثفاً للسلطة، والأمان، والهوية، أو نقي كل شيء. لقد وجدت الرواية النسوية، في سعيها لتشريح وتفكيك البنى الأبوية (البطريركية)، ضالتها في استجواب شخصية الأب. يتحول غياب الأب في هذا السياق من مجرد حدث عائلي إلى استعارة كبرى لفراغ السلطة أو طغيانها، مما يترك أثراً عميقاً لا يُمحى على شخصيات الرواية، وبشكل خاص على بناتهن ومفهومهن للحب. تسعى هذه المقالة الأكاديمية إلى تتبع وتحليل غياب الأب وتأثيره على مفهوم الحب في الرواية النسوية، مستكشفة كيف تعيد الكاتبات تشكيل هذا المفهوم بعيداً عن القوالب التقليدية، عبر رحلة تمتد من البحث عن الأب المفقود في وجوه العشاق، وصولاً إلى اكتشاف الذات كبديل ومصدر نهائي للحب والأمان. بالاستناد إلى رؤى التحليل النفسي والنقد النسوي، وباستخدام نماذج من الأدبين الغربي والعربي، سنوضح كيف يصبح غياب الأب أداة فنية وفكرية لإعادة تعريف الحب كفعل من أفعال المقاومة والتحرر الذاتي.
الإطار النفسي لغياب الأب: من جرح الأبوة إلى تشكيل العلاقات
قبل الخوض في التحليل الأدبي، لا بد من تأسيس فهم نفسي لتأثير غياب الأب على الأنثى. إن العلاقة مع الأب تشكل النموذج الأول لعلاقة الفتاة بالرجل، وهي التي تضع حجر الأساس في نظرتها للثقة والأمان والقيمة الذاتية. عندما يغيب هذا النموذج، سواء بالغياب المادي (كالوفاة أو الهجر) أو الغياب المعنوي (كالإهمال العاطفي أو القسوة)، فإنه يخلق ما يسميه علماء النفس “جرح الأبوة” (Father Wound)، وهو فراغ عاطفي عميق تسعى الفتاة لملئه طوال حياتها. هذا الجرح لا يلتئم بسهولة، بل يتجلى في سلوكيات وأنماط علاقات معقدة في مرحلة البلوغ. يشير المعالجون النفسيون إلى أن النساء اللواتي نشأن في ظل غياب الأب غالباً ما يعانين من تدني احترام الذات، وشعور دفين بأنهن غير جديرات بالحب. هذا الشعور بالنقص يدفعهن، بشكل واعٍ أو غير واعٍ، إلى البحث عن القبول والتقدير في علاقاتهن العاطفية، مما يجعلهن أكثر عرضة للدخول في علاقات سامة.
إن غياب الأب يُفقد الفتاة الشعور بأنها محبوبة ومقدّرة، مما قد يؤدي إلى اعتقادها بأن الآخرين سيرفضونها أيضاً. هذا الخوف من الهجر يصبح دافعاً قوياً للبقاء في علاقات مؤذية، فقط لتجنب الشعور بالوحدة الذي يذكرها بالفقد الأول. والأخطر من ذلك، هو الميل اللاواعي لتكرار النمط العلاقي الأول؛ فقد تنجذب المرأة إلى شركاء يشبهون والدها الغائب أو المهمل أو المسيء، في محاولة يائسة لإصلاح العلاقة الأولى والحصول على الحب الذي لم تنله في طفولتها. هذا الانجذاب اللاواعي هو ما يفسر تكرار دخول بعض النساء في علاقات مؤذية على الرغم من وعيهن بضررها. إن غياب نموذج صحي للعلاقة مع رجل، والذي يمثله الأب عادةً، يترك الفتاة دون بوصلة واضحة في عالم العلاقات، فتصبح فريسة سهلة لشخصيات متلاعبة أو نرجسية تستغل حاجتها المفرطة للاهتمام والحب.
يمكن تلخيص الآثار النفسية الرئيسية لغياب الأب على مفهوم الحب لدى المرأة في النقاط التالية:
- مشكلات في تقدير الذات والشعور بالاستحقاق: غالباً ما تلوم الفتاة نفسها على غياب والدها، وتستنتج أنها لم تكن محبوبة بما يكفي، مما يؤدي إلى تدني احترامها لذاتها وشعورها بأنها لا تستحق السعادة أو الحب الصحي.
- الخوف من الهجر والتعلق غير الآمن: يترك غياب الأب شعوراً دائماً بالخوف من الفقد، مما يدفع المرأة إما إلى التشبث بعلاقات غير صحية خوفاً من الوحدة، أو إلى تجنب العلاقات الوثيقة تماماً لحماية نفسها من ألم الفقد المحتمل.
- البحث عن “بديل الأب”: قد تبحث المرأة بشكل غير واعٍ عن شريك يجسد صورة الأب المفقود، إما كشخصية حامية ومثالية، أو كشخصية مسيئة تسعى من خلالها إلى “الفوز” بالحب الذي حُرمت منه، وهو ما يُعرف أحياناً بـ “عقدة الأب” (Father Complex).
- صعوبة في بناء الثقة: إن خيانة الثقة الأولى من قبل الأب تجعل من الصعب على المرأة أن تثق بالرجال في علاقاتها المستقبلية، وقد تتوقع دائماً أن يتم التخلي عنها أو إيذاؤها.
الرواية النسوية كأداة لتفكيك السلطة الأبوية
تتجاوز الرواية النسوية مجرد سرد حكايات النساء لتصبح مشروعاً فكرياً وجمالياً يهدف إلى مقاومة الهيمنة الذكورية وتفكيك البنى الثقافية والاجتماعية التي رسختها. وفي قلب هذه البنى تتربع “السلطة الأبوية” (Patriarchy)، وهي نظام لا يقتصر على هيمنة الرجل في الأسرة، بل يمتد ليشمل كافة مؤسسات المجتمع وقيمه. لقد أدركت الكاتبات النسويات أن شخصية الأب في الأدب هي التجسيد الرمزي لهذه السلطة، وأن مساءلة هذه الشخصية وتعرية غيابها أو فشلها هي الخطوة الأولى نحو تقويض النظام بأكمله. إن غياب الأب وتأثيره على مفهوم الحب في الرواية النسوية لا يُقرأ كأزمة شخصية فحسب، بل كأزمة نظام اجتماعي وثقافي.
عندما تصور الرواية النسوية أباً غائباً، فهي لا تتحدث عن فرد واحد، بل تشير إلى فراغ في بنية الحماية والأمان التي من المفترض أن يوفرها النظام الأبوي للمرأة. وعندما تصور أباً مستبداً أو مسيئاً، فهي تكشف عن الوجه القبيح لهذه السلطة التي تمارس القهر تحت مسميات الحماية والتقاليد. من خلال هذه التمثيلات، يتحول السرد الروائي إلى ساحة محاكمة رمزية للأبوية، حيث يتم الكشف عن تناقضاتها وفشلها في تحقيق العدل أو السعادة. وتصبح كتابة المرأة عن تجربتها مع هذا الغياب فعلاً من أفعال استعادة الصوت والهوية، ومحاولة لرسم خرائط جديدة للوجود الأنثوي خارج حدود السلطة الذكورية.
في هذا السياق، يصبح الحب نفسه قضية سياسية. فالرواية النسوية لا تكتفي بتصوير كيف يؤثر غياب الأب على اختيارات المرأة العاطفية، بل تتساءل عن طبيعة الحب نفسه الذي يقدمه المجتمع الأبوي. هل هو حب قائم على التملك والسيطرة؟ هل هو علاقة غير متكافئة تكون فيها المرأة “الآخر” الهامشي والتابع للرجل “الذات” المهيمنة؟ من خلال شخصيات نسائية تتخبط في علاقات مؤذية، أو ترفض الزواج التقليدي، أو تبحث عن أشكال بديلة من المودة (كالصداقة النسائية أو حب الذات)، تقوم الرواية النسوية بتحدي مفهوم الحب الرومانسي التقليدي وتفكيكه، وتقدم بدلاً منه رؤى أكثر تعقيداً وواقعية. إنها تكشف كيف أن البحث عن الحب قد يكون في جوهره بحثاً عن الذات المفقودة في ظل غياب الاعتراف الأبوي، وكيف أن التحرر الحقيقي لا يكمن في العثور على “الرجل المناسب”، بل في بناء هوية مستقلة قادرة على تعريف الحب ومنحه لنفسها أولاً.
نماذج من الأدب الغربي: البحث عن الحب في فراغ الأبوة
لقد برع الأدب النسوي الغربي في تشريح الآثار النفسية العميقة لغياب الأب، مقدماً شخصيات نسائية خالدة تتلمس طريقها في عالم مشوه بفعل هذا الفقد. روايتا “إلى المنارة” لفرجينيا وولف و”العين الأكثر زرقة” لتوني موريسون تقدمان نموذجين مختلفين لكنهما متكاملان لهذه المعالجة الفنية.
في رواية “إلى المنارة” (To the Lighthouse) لفرجينيا وولف، لا نجد أباً غائباً بالمعنى المادي، بل أباً حاضراً بجسده وغائباً بعاطفته. يمثل السيد رامزي، الفيلسوف المتمركز حول ذاته، السلطة الأبوية الفكرية القاسية. إنه حاضر كقوة قامعة، يفرض منطقه الجاف على أحلام أطفاله، ويستنزف طاقة زوجته العاطفية، السيدة رامزي، التي تعمل كـ “منارة” حقيقية للعائلة، تضيء عالمهم بالدفء والحنان الذي يعجز هو عن تقديمه. إن رفضه القاطع للذهاب في رحلة إلى المنارة في بداية الرواية بحجة سوء الطقس هو ليس مجرد توقع للأحوال الجوية، بل هو رمز لرفضه الانخراط في عالم المشاعر والأحلام، وهو ما يخلق شرخاً عميقاً في علاقته بابنه جيمس. غياب الأب هنا هو غياب للتعاطف والتشجيع، وهو ما يترك الأبناء، وخاصة الفنانة الطموحة ليلي بريسكو، في حالة من الشك الذاتي والبحث عن مصادقة لن تأتي أبداً من السلطة الأبوية. بعد وفاة السيدة رامزي، التي تمثل قلب الأسرة، يصبح غياب الحب أكثر وضوحاً. الرحلة التي يقوم بها الأب مع ابنيه المتبقيين إلى المنارة في نهاية الرواية ليست مجرد تحقيق لوعد قديم، بل هي رحلة رمزية نحو التصالح المتأخر مع إرث الأب المعقد. الحب الذي يتم اكتشافه في النهاية ليس حباً رومانسياً، بل هو لحظة فهم وتواصل هش بين الأب وأبنائه، والأهم من ذلك، هو الحب الذي تجده ليلي بريسكو في إكمال لوحتها، أي في تحقيق ذاتها الفنية بعيداً عن الحاجة إلى مصادقة الرجل.
أما في رواية “العين الأكثر زرقة” (The Bluest Eye) لتوني موريسون، فإن غياب الأب يتخذ شكلاً أكثر تدميراً. بيكولا بريدلوف ليست مجرد فتاة تعاني من أب مهمل، بل هي ضحية أب مسيء أخلاقياً وجسدياً، أب يفشل في حمايتها بل ويصبح هو مصدر تدميرها. غياب الأب هنا هو غياب للحماية والقيمة الإنسانية، ويتفاقم هذا الغياب بفعل السياق الاجتماعي العنصري الذي يعلم بيكولا أن تكره ذاتها. إن أمنيتها المأساوية في الحصول على عيون زرقاء هي صرخة يائسة للبحث عن الحب والقبول في عالم يربط الجمال بالقيمة، والقيمة بالبياض. الرواية تفكك مفهوم الحب بشكل جذري لتكشف كيف يمكن أن يتحول إلى نقيضه في ظل الفقر والعنصرية والعنف الأسري. الأب، تشولي بريدلوف، هو نفسه نتاج مجتمع عنصري حرمه من إنسانيته، فيقوم بتفريغ هذا الألم في أضعف كائن في عالمه: ابنته. هنا، لا يؤدي غياب الأب إلى بحث مشوه عن الحب، بل إلى التدمير الكامل للقدرة على الحب واستقباله. إن مصير بيكولا المأساوي، حيث تنسحب إلى عالم الجنون معتقدة أنها حصلت على عيونها الزرقاء، هو تعليق مرير على استحالة تحقق الحب في ظل غياب أبوي مدمر وتقاطعه مع أنظمة القهر الاجتماعي. موريسون لا تقدم أي أمل في حب رومانسي منقذ؛ الخلاص الوحيد، وإن كان جزئياً، يأتي من خلال التضامن النسائي البسيط والذاكرة التي تحتفظ بها كلوديا وصديقتها، اللتان تحاولان فهم مأساة بيكولا.
تجليات غياب الأب في الرواية النسوية العربية المعاصرة
في سياق الرواية النسوية العربية، يكتسب غياب الأب وتأثيره على مفهوم الحب في الرواية النسوية أبعاداً إضافية تتعلق بالبنى الاجتماعية والثقافية الخاصة بالمنطقة. فالأب هنا ليس مجرد رمز للسلطة الأبوية بمعناها العام، بل هو أيضاً حارس التقاليد والشرف، والمتحكم في مصير ابنته بشكل مباشر. وقد عالجت كاتبات عربيات بارزات هذه التيمة بجرأة وعمق، كاشفات عن أثر هذا الغياب أو الطغيان على هوية المرأة وعلاقاتها.
تبرز الكاتبة الجزائرية آسيا جبار كصوت فريد في هذا المجال، خاصة في أعمالها التي تحمل طابع السيرة الذاتية مثل “الحب، الفنتازيا” و”لا مكان لي في بيت أبي”. تقدم جبار صورة مركبة للأب، فهو ليس غائباً تماماً ولا حاضراً بشكل إيجابي مطلق. إنه الأب الذي يمثل مفارقة الحداثة والتقليد؛ فهو من جهة، المعلم الذي يأخذ ابنته بيده إلى المدرسة الفرنسية، فاتحاً لها أبواب المعرفة والعالم الخارجي، ومن جهة أخرى، هو نفسه الذي يفرض عليها قيود النظام الأبوي عندما تكبر، فيمنعها من ركوب الدراجة الهوائية مثلاً. هذا الأب المزدوج يرمز إلى التناقض الذي تعيشه المرأة العربية في مجتمع يتأرجح بين التحرر والتقييد. إن تأثير هذا الأب لا يظهر في بحث مباشر عن بديل له في علاقة عاطفية، بل في صراع داخلي مرير حول الهوية واللغة والانتماء. الحب عند جبار يتجاوز العلاقة الثنائية ليصبح بحثاً عن “مكان” في التاريخ واللغة، ومحاولة للمصالحة مع الذات المشتتة بين عالم الأب (الفرنسية، الحداثة) وعالم الأم (العربية، التقاليد). إنها تعيد تعريف الحب كفعل من أفعال “الترجمة” بين عالمين، وكوسيلة لاستعادة أصوات النساء المسكوت عنها في التاريخ.
من ناحية أخرى، تقدم كاتبات مثل الفلسطينية سحر خليفة والسورية غادة السمان نماذج مختلفة لكيفية تأثير العلاقة المعقدة مع السلطة الأبوية على مفهوم الحب.
سحر خليفة: في رواياتها مثل “لم نعد جواري لكم”، تطرح خليفة نقداً جذرياً لمؤسسة الزواج التي تعتبرها امتداداً للسلطة الأبوية. شخصية “سهى” في الرواية ترفض الزواج، لا لأنها لم تجد الحب، بل لأنها ترى في الزواج “عبودية” و”قيداً” يحد من حريتها وتحقيق ذاتها الفنية. هنا، غياب الأب الإيجابي أو حضوره السلبي لا يؤدي إلى البحث عن حب بديل، بل إلى رفض واعٍ للمفهوم التقليدي للحب المرتبط بالزواج. الحب الحقيقي بالنسبة لشخصيات خليفة يكمن في العمل، أو النضال الوطني، أو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والفكري. إنها تعيد تعريف الحب كشكل من أشكال التحرر الذاتي الذي قد لا يتضمن الرجل بالضرورة.
غادة السمان: تقدم السمان في أعمالها، مثل “عيناك قدري”، صورة أكثر تقلباً وقلقاً للرجل والحب. فالرجل في عالمها يتأرجح بين كونه نصف إله يُعشق ويُذاب فيه حتى فقدان الكيان، وبين كونه خصماً قاسياً ومخيباً للآمال. هذا التأرجح الحاد يعكس حالة عدم الاستقرار النفسي التي تخلفها علاقة غير صحية مع السلطة الأبوية. المرأة في روايات السمان تبحث عن الحب المطلق، الحب الذي يعوضها عن كل نقص، ولكنها غالباً ما تجد نفسها في علاقات مازوشية تتلذذ فيها بالألم، أو علاقات تتسم بالصراع والغيرة. الحب هنا ليس ملاذاً آمناً، بل ساحة معركة أخرى تعيد فيها المرأة تمثيل صراعها الأول مع السلطة. إن غياب الأب وتأثيره على مفهوم الحب في الرواية النسوية يظهر عند السمان في شكل بحث محموم عن حب متطرف ومطلق، حب قادر على أن يكون كل شيء، لأنه ينبع من فراغ هائل خلفه الغياب الأول.
إعادة تعريف الحب: من البحث عن بديل الأب إلى استكشاف الذات
يكشف التحليل عبر النماذج الروائية المختلفة، غربية وعربية، عن مسار مشترك تسلكه الشخصيات النسائية في تعاملها مع إرث الأب الغائب. يبدأ هذا المسار غالباً بمحاولة غير واعية لملء الفراغ الذي تركه الأب من خلال العلاقات العاطفية. تتجلى هذه المحاولة في البحث عن شريك يمثل “بديل الأب”، إما في صورته المثالية كحامٍ ومنقذ، أو في صورته السلبية كشخصية مسيطرة أو مهملة، في تكرار مأساوي للنمط العلاقي الأول. هذا البحث المحموم عن التعويض غالباً ما يقود إلى خيبات أمل متكررة وعلاقات مؤذية، لأن الشريك الرومانسي لا يمكنه أن يشفي “جرح الأبوة” الأصلي. إن غياب الأب وتأثيره على مفهوم الحب في الرواية النسوية يظهر بوضوح في هذه المرحلة كعامل أساسي في تشويه الحب وتحويله من علاقة ندية إلى علاقة اعتمادية قائمة على الحاجة والتعويض.
لكن الرواية النسوية لا تتوقف عند تشخيص هذا الخلل. إن قوتها تكمن في تجاوز هذه المرحلة والانتقال بالشخصية النسائية، وبالقارئ معها، نحو أفق جديد لإعادة تعريف الحب. النقطة المحورية في هذا التحول هي لحظة الوعي، عندما تدرك البطلة أن الحب الذي تبحث عنه في الخارج لن يأتي أبداً لإنقاذها، وأن الخلاص الحقيقي يكمن في الداخل. هنا، يتحول السرد من التركيز على “الآخر” (الحبيب/بديل الأب) إلى التركيز على “الذات”. تبدأ رحلة استكشاف الذات، وبناء الهوية المستقلة، والمصالحة مع الماضي. في رواية “إلى المنارة”، تجد ليلي بريسكو خلاصها ليس في الزواج أو في الحصول على تقدير السيد رامزي، بل في إكمال لوحتها، أي في تحقيق ذاتها الفنية. وفي روايات سحر خليفة، تختار البطلات الاستقلال والعمل على الارتباط برجل، معتبرات أن تحقيق الذات هو أسمى أشكال الحب.
بهذا المعنى، تقوم الرواية النسوية بعملية “إعادة تعريف” جذرية للحب. فالحب لم يعد يقتصر على المفهوم الرومانسي التقليدي المرتبط بالرجل والزواج. بل يتسع ليشمل أشكالاً أخرى من المودة والارتباط أكثر ديمومة وأصالة: حب الذات، والتضامن النسائي، وحب العمل والإبداع، وحب الحرية نفسها. إن غياب الأب، الذي كان في البداية مصدراً للألم والنقص، يصبح بشكل متناقض (مفارق) هو المحفز الذي يدفع المرأة إلى بناء عالمها الخاص وقيمها الخاصة، وإلى اكتشاف أنها قادرة على أن تكون هي نفسها “المنارة” التي تضيء حياتها، دون الحاجة إلى مصدر خارجي للنور أو الأمان. تصبح الرواية بذلك شهادة على قدرة المرأة على تحويل الجرح إلى قوة، والفراغ إلى فضاء للحرية والإبداع، وإعادة صياغة مفهوم الحب كفعل من أفعال امتلاك الذات والوجود في العالم بشروطها الخاصة.
خاتمة
في ختام هذا التحليل، يتضح أن غياب الأب وتأثيره على مفهوم الحب في الرواية النسوية ليس مجرد تيمة أدبية عابرة، بل هو استراتيجية سردية وفكرية عميقة تستخدمها الكاتبات لتشريح بنية السلطة الأبوية وكشف آثارها النفسية والاجتماعية المدمرة. انطلاقاً من الأسس النفسية التي تربط غياب الأب بتشوهات في تقدير الذات وأنماط العلاقات، استطاعت الرواية النسوية، سواء في نماذجها الغربية مثل أعمال فرجينيا وولف وتوني موريسون، أو في تجلياتها العربية لدى كاتبات مثل آسيا جبار وسحر خليفة وغادة السمان، أن تحول هذه التجربة المؤلمة إلى مختبر فني لاستكشاف الهوية الأنثوية.
لقد أظهرت هذه الروايات كيف أن البحث عن الحب لدى الشخصيات النسائية غالباً ما يبدأ كبحث عن تعويض للفقد الأبوي، ولكنه ينتهي في كثير من الأحيان برحلة نحو استكشاف الذات والتحرر. من خلال تفكيك مفهوم الحب الرومانسي التقليدي وتقديم بدائل له كحب الذات، والتضامن النسائي، والإبداع الفني، لا تقدم الرواية النسوية إجابات سهلة، بل تفتح الباب أمام أسئلة جوهرية حول معنى الحب والحرية والوجود في عالم لا يزال يتشكل تحت ظلال السلطة الأبوية، حتى في غياب الأب نفسه. وبهذا، تظل هذه الأعمال الأدبية شهادات حية على صراع المرأة من أجل إعادة كتابة قصتها الخاصة وتعريف الحب بشروطها هي.