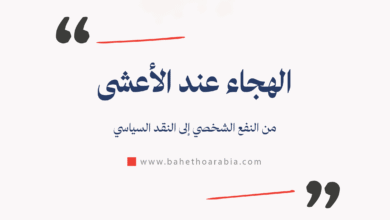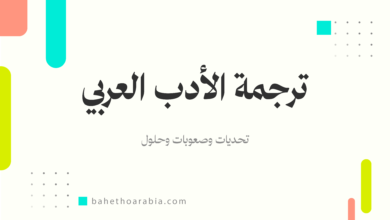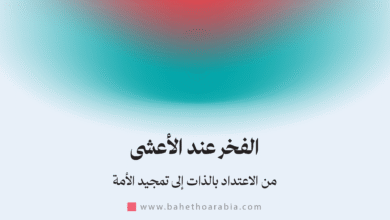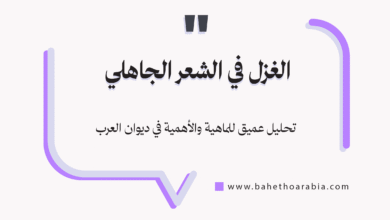الفخر والحماسة في الشعر الجاهلي: مفهومها وطبيعتها وعوامل ازدهارها وخصائصها
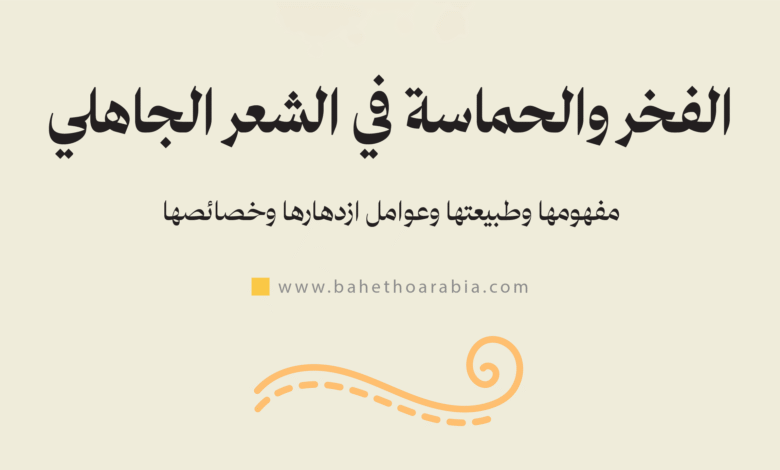
يتناول هذا التحليل الأكاديمي موضوع الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي، حيث يستعرض التعريف اللغوي والاصطلاحي، وطبيعة هذا الغرض الشعري وعوامل ازدهاره في العصر الجاهلي، مع التمييز بين الفخر الفردي والفخر القبلي وأهم معانيهما وصورهما، وصولًا إلى استخلاص الخصائص العامة التي تميزه.
الفخر والحماسة لغة واصطلاحاً
يُعرّف الفخر في اللغة بأنه التمدّح بالخصال، والافتخار، وعدّ القديم. أما التفاخر فيعني التعاظم، والتفخّر يدل على التعظم والتكبر، وهو نشر المناقب وذكر الكرام بصفات الكرم. أما الحماسة، وهي الركن الثاني لمفهوم الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي، فتعني في اللغة المنع والمحاربة، والتحمّس هو التشدّد، والحماسة هي الشجاعة. ويُطلق وصف الأحمس على الشجاع والشديد الصلب في الوغى والقتال، وقد سُميت قريش وكنانة “حُمساً” لتشددهم في دينهم خلال العصر الجاهلي.
وفي الاصطلاح النقدي، يُعد الفخر غرضًا من أغراض الشعر ينطوي على زهو الشاعر واعتزازه بنفسه وقومه، وهو وليد الأثرة والإعجاب بالذات. وإذا كان الإنسان مفطوراً على حبّ نفسه والإدلال بها وبمآثرها، فإن الشاعر، المتميز برهافة الحس وفصاحة اللسان وجمال التعبير والتصوير، هو الأقدر من سواه على التفاخر والأجدر به. ويقدم ابن رشيق تعريفًا دقيقًا يربط بين المدح ومفهوم الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي، حيث يقول: “الافتخار هو المدح نفسه إلا أن الشاعر يخص به نفسه وقومه، وكلّ ما حسن في المدح حسن في الافتخار، وكل ما قبح فيه قبح في الافتخار”.
طبيعة الفخر وعوامل ازدهاره في العصر الجاهلي
ربما كان لطبيعة المجتمع القبلي أثرها القوي في نزوع الشاعر الجاهلي إلى الفخر. ففي هذا المجتمع البدوي، يقدّر الناس الحمية والأنفة والعزة وقوة العضل والعصب والصبر على المكاره، ويتغنون بالشجاعة والاندفاع وحماية العرض والذود عن الحمى، فتتحول هذه المعاني والقيم إلى دستور أو ما يشبه الدستور يلتزمه البدو ويتواضعون على الأخذ به. إن هذه البيئة كانت الحاضنة الأساسية لظهور الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي.
وإذا كان الغزل متصلاً بغريزة الجنس، فإن الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي يرتبط بغريزة لا تقل عنها قوة، وهي حبّ البقاء والصراع في سبيل الحفاظ على الحياة. فالغزل يعبر عن حب البقاء من خلال حب المرأة، بينما يعبر الفخر عن هذا الحب من خلال حب النفس؛ فكلاهما نابع من التعلق بالحياة، ومسخّر للحفاظ عليها، ودائر في فلكها، وهادف إلى حمايتها من الضعف والانقراض.
لهذا السبب، نجد أن الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي يُعد من أبرز أغراض الشعر الجاهلي وأشدّها تأثيراً في الأغراض الأخرى كالمدح ووصف الحرب والرثاء. ونجده كذلك يطغى على هذه الأغراض ويطويها تحت ضِبْنه، كأنها أبعاض منه أو فروع له. وحسبنا دليلاً على ما نزعم أن المجموعات الشعرية التي عُنيت بجمع الشعر القديم سُميت باسم “الحماسة”، وهو ما يؤكد مركزية الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي، على ما فيها من تعدّد في الأغراض وتشعب في المعاني. وأشهر هذه الحماسات حماسة أبي تمام، وحماسة البحتري، والحماسة البصرية، وحماسة ابن فارس المحدثة، وما أغفلناه كثير. وأمّا المجموعات التي اختار لها رواتها وجامعوها عنوانات أخرى كالأصمعيات والمفضليات والوحشيات والمنصفات، فإن الحماسة والفخر يمثلان أبرز أغراضها، وأكثر قصائدها ومقطعاتها قدراً ومقداراً.
ومما ساعد على ازدهار هذا الغرض، الذي يمثل جوهر الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي، هو “أيام العرب”، وما كان يجري فيها من ملاحم يتطاحن فيها الفرسان وينبري فيها الشعراء للشعراء في مفاخرات ومنافرات لا تقل احتداماً واضطراماً عن المعارك التي تسبقها وتلحقها.
وإذا كان صدق الشاعر مرهوناً بعمق التجربة التي يصوّرها، فإن شعر الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي يُعد من أصدق الشعر العربي عاطفة لأنه من أعمقه تجربة، ولأن أكثر الشعراء الذين نظموا هذا الشعر هم فرسان أشدّاء يطاعنون بالأسنة والألسنة. بل إن كثيرين منهم كانوا يرتجلون المقطعات أو يرتجزون الأراجيز وهم في حلبات الصراع، يروعون بها الخصوم، ويستثيرون الحميّة، ويحرضون على الكر والفر، ويتغنون بالأمجاد تالدها والطريف، ثم يصبح ما يقولون مثلاً أعلى تقدّسه القبيلة غاية التقديس.
ولو خطر لك أن تستخلص الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي من دواوين الشعر الجاهلي ومجموعاته، لانتزعت من كلّ غرض أقوى ما فيه؛ فأنت مضطر إلى انتزاع ما يصور بطولة الممدوح، ومآثر المرثي، واندفاع الصياد، وجَلَد الجياد، وصلابة النوق، ومضاء السيوف، وطعان الأسنة. بل أنت مضطر الى استخلاص القيم والصور والمشاعر والمثل العليا التي بها تصبح المعاني المجردة فناً رفيعاً وشعراً عظيم التأثير. ولما كان هذا اللون من الشعر توأم البطولة، فقد تلقته نفوس الأعراب بالقبول، وحفظته قبل غيره، وناطت به وجودها واستمرار هذا الوجود، وجعلته السلك الذي ينتظم ماضيها وحاضرها، ويرسم السبل التي يسلكها مستقبلها. فشاعت بشيوعه روح الفروسية، وانطفأت بتوهّجه روح التحنث، وغدت كل قبيلة تنشئ ناشئتها على الأخذ به والتحلي بخصاله كالشهامة، والاستبسال، وإدراك الثأر، والأنفة من الذل، واحتقار الجبن، والتحرر من شركي الضعف والخوف.
وفي هذا اللون الشعري الذي يجسد الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي، يمتزج الفرد بالجماعة امتزاجاً تاماً، وتتضخم الذات، لكنها – على تضخمها – تذوب في الكيان العام للقبيلة، كما تندفع ألسنة اللهب من قمم البراكين متعالية أوّل الأمر، ثم تنساح على السفوح لتصل حممها إلى ما يحيط بها بعد ذلك، فتلهبه. وشعر الفخر ينبع من إعجاب الشاعر بنفسه، ويصب في المجرى القبلي الواسع، ولذلك كرهت العرب التكبر والخيلاء والصلف والعنجهية والعجرفية من الناس، وقبلتها من الشعراء، ولم تجد بأساً في مبالغات الفخر وانتفاخه، لأنها لو وجدت في ذلك كله أو بعضه غروراً بغيضاً لا تسيغه أو طموحاً عريضاً لا ترضى عنه لَخَضَدَ غيرها شوكتها، وهانت على الناس.
الفخر الفردي وأهم معانيه وصوره
يمكن تقسيم الفخر إلى قسمين: فخر فردي وفخر قبلي. أما الفخر الفردي فمبعثه إعجاب الشاعر بنفسه وادّعاؤه تفوقه على مَنْ حوله، وقدرته على تهديد الناس بسلاح لا يملكون مثله، يرفع به ويضع، ويعد ويتوعد. ويتمظهر هذا الشكل من الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي عبر عدة معانٍ وصور.
١ – الشعر والفصاحة
تُعد الفصاحة والشعر أولى المفاخر التي يعتز بها الشاعر، ويبزّ غيره من الناس بلسانه الذرب، وقوافيه المنقضة على الخصوم كالصواعق، وقدرته على أن يفري بلسانه ما لا يستطيع السيف أن يفريه. وكلما أصبح الشاعر ذا شهرة وتمكّن من فنه، كان سلطانه على الناس أشدّ، ونزاله في مضمار المنافرة أحرى. فإذا احتدم التفاخر بين شاعرين، بلغ اعتزاز الشاعر بشعره قمة العنف وغاية التحدي، لإدراكه أنه ينازل قرناً له مثل سلاحه، ونداً لديه الفصاحة في القول واللدّد في الخصومة. فاخر النابغة الذبياني يزيد بن عمرو بن الصعق، وكلاهما شاعر، فرماه بالضلال والزيغ عن الحقِّ، وبالعجز عن الفخر، وهدده بقوافيه القادرة على صعقه وسحقه. وأي شاعر يستطيع أن يفاخر النابغة، وهو شيخ عكاظ وفحل القصيد وخصمه أمامه كالفصيل الهزيل:
لعمرك ما خشيت على يزيدٍ *** من الفخر المُضَلَّل ما أتاني
فحسبك أن تُهاض بمُحكماتٍ *** يمر بها الرّويُّ على لساني
يصدّ الشّاعر الثّنيان عني *** صُدودَ البكر عن قَرْمٍ هجانِ
وإذا خالط الفخر بالشعر مدح العظماء، لان وانكسرت شرته، وآثر المسالمة على المخاصمة، وخلع الشاعر على فخره جناحين يطيران به إلى الممدوح، ويردان به الأسماع، وينشران ذكره في الآفاق. وهذا يبرز كيف يتجلى الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي حتى في سياق المديح. قال المسيب بن علس:
فلأُ هدينّ مع الرياح قصيدة *** مني مُغَلْقَلةٌ إلى القعقاع
تردّ المياهَ فما تزال غريبةً *** في القومِ بين تَمثُّلٍ وسَماعَ
إن الإدلال بالشعر، كأحد مظاهر الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي، حمل الشاعر على الإدلال بالعقل الذي ينظم الشعر، والرأي القادر على فهم المشكلات وحل المعضلات. قال عبدة بن الطيب:
وثنية من أمر قوم عَزَةٍ *** فرَجَتْ يداي فكان فيها المطلَعُ
وأحسن الرأي ما قمع الباطل ومحق الخرق. وأصحاب الرأي في مجتمع محارب كمجتمع الجاهلية قلة، ولذلك اعتد ثعلبة بن صعير بذكائه لأنه استطاع بمنطقه السليم أن يسكت المتفيهقين، فأخرج ما في قلوبهم من دخائل، ودحض ما في عقولهم من ترهات:
ولرب خصمٍ جاهدين ذوي شَذاً *** تقذي صدورهم بهترٍ هاترِ
لُدٍّ ظأرتُهمُ على ما ساءَهم *** وخسأتُ باطلهُمْ بحقٍّ ظاهر
والفخر بالشعر موصول النسب بحلاوة الحديث وطلاوة السمر، وقد يتخذ الشاعر الجاهلي مأثرته تلك شفيعاً له عند المحبوبة، أو زينة يتحلى بها ليفوز بإعجابها به وإيثارها له. ولبيد في هذا الموقف كان حريصاً على أن يكون المحدث الفصيح والسيد الكريم، يصل من يستحق القطيعة، ويبيت مع سماره في الليالي الهادئة، يحدثهم فيصفون، وينشدهم فيطربون، ويريق لهم الخمر فيشربون. إنه درة العقد في هذا المجلس الذي ينتظمه الشعر، فكيف لا يملأ عين نوار وقلبها؟
أولم تكن تدري نَوَارٌ بأنني *** وَصَالُ عَقدِ حبائل جَذَامُها
بل أنت لا تدرين كم من ليلةٍ *** طَلْقٍ لذيذٍ لهوُها ونِدامُها
قد بتّ سامرها وغاية تاجرٍ *** وافيتُ إذ رُفعت وعَزّ مُدامُها
٢ – صلة الخمر بالفخر
لا تُعد الخمرة مفخرة بذاتها، ولكن دلالتها على الكرم تجعلها جزءًا من منظومة الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي. وأحسن الشعراء مفاخرة بها عنترة بن شداد، فقد أدرك بفطرته السليمة ما تقود إليه أم الكبائر من سقوط في الفاحشة، وذهاب بالهيبة، وإضاعة للوقار، وثلم للشرف، ففخر منها بصلتها بالكرم، والتزم الحفاظ على الفضيلة بعد الصحو، فقال:
فإذا شربت فإني مستهلك *** مالي وعرضي وافر لم يكلم
وإذا صحوت فما أقصر عن ندى *** وكما علمتِ شمائلي وتكرمي
يُظهر عنترة فهمًا عميقًا لكيفية الموازنة بين اللذة وقيم الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي، وهو في هذا المضمار فوق طرفة بن العبد، لأن طرفة تباهى بملازمة الحانات فقال:
فإن تبغني في حلقة القوم تلقني *** وإن تلتمسني في الحوانيت تصطدِ
لأن طرفة أدمن الشراب حتى أغرق فيه الرجولة، وبدد المال، وقطع صلته بالناس، فنبذه قومه وتجنبوه كما يتجنبون المجذوم والأجرب:
ومازال تَشرابي الخمور ولذتي *** وبيعي وإنفاقي طريفي ومُتلدي
إلى أن تحامتني العشيرة كلها *** وأفردت إفراد البعير المعبد
أما عنترة فقد اعتصم من السكر بالصحو، ومن التبذير الممقوت بالكرم المحمود، وتجلد فحفظ له التجلد منزلته بين الناس.
٣ – الأنفة
إن الإعراض عن الخمر والتجلد أمام الشهوات هو ضرب من ضروب الأنفة التي تمثل صميم الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي. فالصبر على العسر من خصال الرجال، ودليل على قوة العصب واحتمال الصعاب. وعبيد الله ابن عبد العزى كان من زمرة الأشداء المفاخرين بالجلادة وطلاقة الوجه وتوازن الملكات والأنفة من السؤال، فخر بذلك فقال:
وإني لأستبقي إذا العسرُ مسّني *** بشاشة نفسي حين تُبلى المنافعُ
والزهادة في الغنائم مظهر آخر من مظاهر الرفعة واكتمال الرجولة. وأجدر المطامع بالانتباذ ما جرَّ على الطامع هواناً أو رماه بفاحشة، ولذلك أنف ابن عبد العزى من التهافت على الرغاب فقال:
وأعرضُ عن أشياء لو شئت نلتها *** حياة إذا ما كان فيها مقاذعُ
غير أن أنفة عنترة أدل على المروءة وألصق بالنخوة لارتباطها بالبطولة. فقد لفظ ما لم تكن العرب تلفظه، إذ أعرض عن الغنائم؛ فواجب الفارس عند عنترة هو حماية الضعفاء والدفاع عن العرض، لا الظفر بالسلب، وحظه من المعركة التضحية لا الربح:
هلا سألت الخيل يا بنةَ مالك *** إن كنت جاهلة بما لم تعلمي
يخبرك من شهد الوقائع أنّني *** أغشى الوغى وأعف عند المغنم
٤ – الكرم
يقودنا الحديث عن الأنفة مباشرة إلى الكرم، وهو من أعظم دعائم الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي. وللكرم في العصر الجاهلي صور كثيرة، أرقاها أن يكون الكرم إنقاذاً من الموت، أو حفاظاً على حياة الجائع، أو أن يجوع الكريم ليشبع المحتاج. رسم هذه الصورة السامية عروة بن الورد حين خيل إليه أنه يطعم العفاة قطعاً من جسده ويلهي معدته عن الطعام بجرعة من ماء بارد:
أقسّم جسمي في جسوم كثيرة *** وأحو قراحَ الماء والماء بارد
وبلغ الشاعر الجاهلي قيس بن عاصم قمة الجود حينما رفض أن يصيب من طعام لا يصيب معه منه جليس يؤاكله، فقال لزوجته:
إذا ما عملت الزّاد فالتمسي له *** أكيلاً فإنّي لستُ آكله وحدي
تتخذ المفاخرة بالكرم، وهي وجه ساطع من وجوه الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي، صورًا وآدابًا وشعائر التزمها شعراء العرب. أولها بشاشة الوجه، وملاطفة الضيف، وقرى الضيف بالكلام قبل الطعام، وإيناسه بالمسامرة وتجنيبه المن والأذى. قال عروة بن الورد:
سلي الطارق المعتر يا أم مالك *** إذا ما أتاني بين قدري ومجْزري
أيسفر وجهي؟ إنه أوّل القرى *** وأبدل معروفي له دون مُنكَري
والثانية الترحيب الصادق والإجابة السريعة وبذل الخير في غير بطء ولا تردد وبسط اليد إلى أقصى حد. قال إياس بن الأرت:
وإني لقوّال لعافي مرحباً *** وللطالب المعروف إنّك واجدُة
وإني لمن يبسط الكف بالندى *** إذا شَنِجت كفُّ البخيل وساعِدُة
والثالثة أن يستبدل الشاعر بالمال محمدة، وأن يربح بالعرض الزائل مفخرة لا تزول. قال المثلّم بن رياح المري:
إني مقسم ما ملكت فجاعلٌ *** أجراً لأخرة ودنيا تنفعُ
والرابعة أن يدعو الشاعر الجفّلى، وأن يعلن هذه الدعوة في الخافقين. ووسيلة الإعلان – على بساطتها – من أنجع الوسائل في اجتذاب الضيوف، وهي أن توقد النار على شرف وأن تركز عليها قدر ضخمة، فعمة يراها أهل الأرض كافة، فيقبلون. قال عوف بن الأحوص:
مُبرَّزةٌ لا يُجْعَلُ السِّتر دونها *** إذا أُخمِد النيرانُ لاح بشيرُها
ومن أغرب الصور التي يتراءى في قسماتها كرم الشاعر الجاهلي دعوته الذئاب الضواري إلى طعامه. فإذا أضرم النار، وشرع بشي اللحم، أقبل نحوه ذئب أطلس يعسل ويتلصص، ثم يغريه كرم الشاعر فيدنو من النار، حينئذ يستقبله الشاعر استقبال الضيف، ويجالسه ويلقي إليه فلذة من اللحم، ويسر بسروره، ويعجب بجراءته، ويراه بطلا عائداً من غزوة مظفرة. قال المرقش الأكبر:
ولما أضأنا النار عندَ شوائِنا *** عرَانا عليها أطلس اللونِ بائسُ
نبذتُ إليه حُزةً من شوائنا *** حياءً، وما فُحشي على من أجالسُ
فاضَ بها جذلانَ ينفضُ رأسهُ *** كما آب بالنَّهبِ الكميُّ المُحالِسُ
٥ – الشجاعة
من أبرز مفاخر الشعراء التي تُشكل عماد الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي هي الشجاعة. ولها في حياتهم دواع قوية تلحُّ عليهم إلحاحاً، وتملي عليهم نمط السلوك الذي تقتضيه طبيعة هذه الحياة. فأرضهم – على اتساعها – فلوات موات قليلة الأقوات، تخصب اليوم وتجدب غداً، والممرع منها مطمع الطامعين القادرين على حمايتها. ومن لم يجرد السيف دون حماه طرد منه إلى الأرض القفر، وسيقت أنعامه وسبيت نساؤه، ولزمه العار مدى الدهر. ولهذا كان العرب متحفزين للنزال تحفزاً دائماً، فمتى استنفر الشاعر منهم للذود عن حوضه نفر، ونزا على جواده متوشحاً بلجامه مستعداً للقتال. قال لبيد:
ولقد حميت الحي تحمل شكني *** فَرَطٌ، وشَاحي إذ غَدَوْتُ لجامُها
تتجلى قيمة حماية الحي عند عنترة كأحد أسمى معاني الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي، فهي مفخرة عظيمة تعدل الحسب والنسب أو تفوقها. إنها أصل من لا يقرُّ الناس بأصله، وشرفٌ يباهي به جُبَناءَ الأشراف من ذوي العمومة والخؤولة:
إني امرؤ من خير عبس منصباً *** شطري وأحمي سائري بالمنصلِ
وإذا الكتيبةُ أحجمتْ وتلاحظت *** أُلفيت خيراً من معمّ مخولِ
وربما كان الدفاع عن الظعائن أروع ما يفخر به الشاعر الجاهلي، وأعظم مظاهر الشجاعة توهجاً وإثارة للنخوة العربية؛ لأن الشاعر بدفاعه عن الظعينة يحمي عرضه، ويصرع خصمه، ويفوز بإعجاب محبوبته، فتخالط الشجاعة الحب. خرج دريد بن الصمة في فوارس من بني جشم يريد الغارة على بني كنانة. فلما كان بواد لبني كنانة، رفع له رجل من ناحية الوادي معه ظعينة، وتاقت نفسه إلى انتزاع الظعينة من حاميها ربيعة بن مكدم وهو لا يعرفه. فأرسل دريد فارساً تمن الظعينة، فقتله ربيعة ونجا بصاحبته. فأتبعه دريد فارساً ثانياً، فصرعه ربيعة وهو يرتجز:
خل سبيل الحرة المنيعة *** إنك لاق دونها ربيعة
في كفه خطية مطيعة *** أولا فخذها طعنة سريعة
فالطعن مني في الوغى شريعة
ثم أتبعه ثالثاً، فصرعه، ونجا بالظعينة حتى أبلغها مأمنها. فأعجب به درید ابن الصمة أي إعجاب. وكان العرب – على شجاعتهم – يكرهون أن يجوروا على الناس أو أن يجور عليهم الناس. يقول عامر بن الطفيل:
ألم تعلمي أني إذا الإلفُ قادني *** إلى الجور لا أنقاد والإلف جائر
لكنهم لم يكونوا يفرطون بحقهم أو يغفلون عن تِرّاتهم، بل كانوا يثأرون ويسرفون في الانتقام، وهو ما يعكس جانبًا عنيفًا من الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي. ومن الشعراء الذي فاخروا بالثأر من العدو باعث بن صريم اليشكري. فقد لبث – قبل أن يقتص من بني أسيد قتلة أخيه – يتميز من الغيظ، فانقض عليهم، وقتل قتلة أخيه، وأجرى من دمائهم ما يملأ الدلاء الواسعة ويفرغ الصدر من حقده المتسعّر:
سائل أسيد هل ثأرتُ بوائلٍ *** أم هل شفيتُ النفس من بَلْبالها
إذ أرسلوني مائحاً بدلائهم *** فملأتُها عَلَقاً إلى أسبالِها
وقصة الأخذ بالثأر سلسلة دامية الحلقات، يعقب بعضها بعضاً. وفي كل حدث من أحدائها المفجعة تراق دماء، وتذرف دموع، وتنشد قصائد ومقطعات. أشهرها مقتل كليب بن ربيعة برمح جساس بن مرة، ثم مقتل جسّاس بطعنة من رمح الهجرس ابن كليب. ومنها الدماء التي أريقت يوم داحس والغبراء، وما أعقب هذا السباق المشؤوم من إزهاق أرواح ونظم أشعار، تجد فيها الحزن طيّ الفخر، والندم يمازج التشفي، والحسرة تخالط الشماتة، لأن القاتل والمقتول من عبس وذبيان، فرعي غطفان. أصغ إلى قيس بن زهير كيف يفاخر بالثأر من ابني بدر، حمل وحذيفة، تدرك أن حزنه عليها يعدل شماتته بها. وأنى للمرء أن يفاخر ببتر إحدى يديه؟ إنها الجاهلية بقيمها المتناقضة، فهي لا تحتكم إلى أحلام تفكر، وروية تنظر في عواقب الأمور، بل إلى نفوس تجيش فيفضي بها جيشانها إلى الحمية الرعناء، فتقتل ثم تندم. يقول قيس:
شفيت النفسَ من حمل بن بدر *** وسيقي من حذيفة قد شفاني
شفيتُ بقتلهم لغليل صدري *** ولكنّي قطعت بهم بناني
وفي هذا المجتمع المتفجر حماسةً، كان يظهر أحياناً عقلاء يحاولون أن يقمعوا هذه الهيجة الغاضبة، كالحارث بن عوف وهرم بن سنان والحارث بن وعلة الجرمي. لكنهم لم يكونوا قادرين – وهم القلة العاقلة – على مجابهة الكثرة الجاهلة، إلا في أحيان قليلة. فالحارث بن وعلة فوق سهمه وأوشك يرمي به قتلة أخيه أميمة، ثم تذكر أن القتلة من قومه، فإن أطلقه كان كمن يطلق السهم من قوسه على نفسه، أو يبتر ساعده بسيفه، فأحجم، ووجد أن العفو من شيم الكرام. فقال:
قومي هم قتلوا أميم أخي *** فإذا رميت يُصيبني سهمي
فلئن عفوتُ لأعفوَنْ جللاً *** ولئنْ سطوت لأوهنَنْ عظمي
٦ – الفخر بمكارم الأخلاق
على الرغم من الصورة السائدة عن الجاهلية، فقد عرف المجتمع فضائل راقية شكلت أساسًا أخلاقيًا لـالفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي. وهذه الفضائل تبلغ الغاية في السمو والنبالة، وتمسح عن الوجه العربي غبار الصراع، ووضر الثأر، وتفتاً حيا الرعونة، وتهب هذا المجتمع شكلاً راقياً من أشكال الترابط الإنساني، والتوازن الخلقي، والاستقرار الاجتماعي، كالوفاء وحماية الجار. وهذه الفضائل مرتبطة بطبيعة الحياة البدوية، ففي البداوة مخاطر تخيف الضعيف، فتلجئه إلى القوي القادر على حمايته. وفي مثل هذا الموقف، تفوق الكلمة الحازمة التي يقطعها الشاعر على نفسه معاهدة أو حلقاً بين دولتين.
لجأ إلى الشاعر أبي حنبل الطائي رجل اسمه سيّار، ففتح له الشاعر قلبه وداره وبسط عليه جواره، فأمن سيّار بعد خوف، واستقر بعد تنقل. ففخر الطائي بذلك وقال:
لقد بلاني على ما كان من حَدَثٍ *** عند اختلاف زجاج القوم سيّارُ
قد كان سيرٌ فحلّوا عن حمولتكم *** إني لكلّ امرئ من جاره جارُ
وتُعد قصة وفاء السموءل مثالًا نادرًا يجسد أسمى قيم الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي، فهي قصة جديرة بالذكر، خلاصتها أن امرأ القيس لما أراد المضي إلى قيصر أودع عند السموءل دروعاً وأسلحة وأمتعة. فلما مات امرؤ القيس أرسل ملك كندة يطلب الدروع والأسلحة، فقال السموءل: “لا أدفعها إلا إلى مستحقها”. فقصده الملك بعسكره، فدخل السموءل حصنه وامتنع به. فأخذ الملك ولد السموءل رهينة، وهدده بقتله إن لم يدفع إليه دروع امرئ القيس وسلاحه، فأبى، فذبح الملك الولد. ولما جاء الموسم، وحضر ورثة امرئ القيس، دفع إليهم الشاعر الدروع والسلاح وقال مفاخراً:
وفيْتُ بأدرع الكنديّ، إنّي *** إذا ما خانَ أقوامٌ وفيْتُ
ومن المكارم التي فاخر بها الشعراء رجاحة العقل وسعة الصدر. ولا يقتصر الفخر بهما على الشيخ الوقور كزهير بن أبي سلمى، بل يعدوه إلى الفارس البطل كدريد ابن الصمة، والصعلوك المنبوذ كالشنفري. أما دريد فقد كان – على كرمه بماله – ضنيناً بعقله، لا يبدده في المراء والهراء:
ويبقى بعدَ حلمِ القوم حلمي *** ویفنی قبل زادِ القومِ زادي
وأما الشنفرى فكلام الحمقى لا يستخفّه، ولا يحمله على المشي بين القوم بالنميمة، بل يبقى من عقله على لسانه رقيب يضبطه:
ولا تزدهي الأجهال حلمي، ولا أرى *** سؤولاً بأعقاب الأحاديث أنملُ
وذو الإصبع العدواني لقي من ابن عمه عنتاً فاحتمله، وكيداً فتلقاه بالحلم، وهو على الردع قادر. فلم يلغ في عرض ابن عمه، وظل معتصماً بالصمت حفاظاً على الأواصر، ووفاء بحق النسب، لكنه في مفاخرته بهذا الخلق الكريم لم ينس – وهو العربي الأنف – أن يلوح بالتهديد الزاجر، فقال لابن عمه عمرو:
وما لساني على الأدنى بمنطلق *** بالمنكِّرات ولا تتكي بمأمونِ
عندي خلائق أقوام ذوي حسبٍ *** وآخرين كثير كلُّهم دوني
ولم يكن عفو ذي الإصبع عن ابن عمه خُلقاً غريباً في العصر الجاهلي، فإن عبيد بن عبد العزى جعل هذا المسلك مفخرة يعتز بها. فهو وإن بادره ابن عمه بالأذى، حريص على سلامته، يغتفر ذنبه، ويستر عيبه، ويقيل عثرته، ويجنبه مزالق الطريق لإيمانه بأن الجفوة إلى زوال وأن العفو كفيل بتوثيق عرى المودة بين ذوي القربي:
ولا أدفع ابن العم يمشي على شفا *** ولو بلغتني من أذاه الجنادعُ
ولكن أواسيه وأنسى ذنوبَه *** لترجعه يوماً إلى الرواجعُ
وأفرشه مالي وأحفظُ عيبَه *** ليسمع أني لا أجازيه سامع
وشبيه بهذا الضرب من الفخر تنويه حاتم الطائي بحفاظه على جارته؛ فهو لا يرصد خروجها في الظلام ليراودها عن نفسها، ولا يذكرها بسوء، ولا يخطر له أن ينظر إليها بعين مرتابة. إنه مؤتمن عليها، والشريف العفيف لا يخون الأمانة:
إذا ما بتُّ أختل عِرس جاري *** ليخفيني الظلام فلا خفيتُ
أأفضح جارتي وأخون جاري *** معاذ الله أفعلُ ما حييتُ
وهذا الضرب من الفخر، المتمثل في الحفاظ على الجارة، يُعد من أرقى تجليات الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي. وربما كان بيت عنترة أسْيَر من بيتي حاتم وأشهر، إذ لخص عنترة ببيته التالي عفة الشاعر الجاهلي وحرصه على عرض الجار، فأصبح كلامه المثل الأعلى في بابه:
وأغضّ طرفي إن بدت لي جارتي *** حتى يُواري جاري مأواها
ومع أن الشاعر الجاهلي كان يفاخر أحياناً بافتتان المرأة به وخضوعها له، كقول المرقش الأكبر:
يا خولَ ما يُدريك رُبّت حرّةٍ *** خّودٍ كريمة حيَّها ونسائها
قد بتُّ مالكها وشاربَ ريَّةٍ *** قبل الصياح كريمة بسبائِها
إلا أن هذه المفاخرة في أكثر الأحيان لا تحمل على التعهر والمجاهرة بالغواية، بل تحمل على الإدلال بالرجولة لإثارة الغيرة في نفس امرأة يخاطبها الشاعر. وقد كان الشاعر الجاهلي حريصاً على أن يكون السيد الشريف الحسيب، وأن يتجنب التبذل والتخنث. وإذا استثنينا الأعشى الكلف بالقيان والبغايا، وجدنا شعراء الجاهلية يفاخرون بشرف المرأة ونسبها، فهي كما قال المرقش الأكبر (حرة خود كريمة حيها ونسائها)، ويفاخرون بنسبهم ليكون شرف الرجل جديرا بشرف المرأة، ونسبه ضريع نسبها. بل يفاخرون بتسخير ما يملكون من مال لحماية العرض والنسب والذمة. قال المثقب العبدي:
أنا بيتي من معدّ في الذرى *** ولي الهامةُ والفرعُ الأشمْ
أجعلُ المال لعِرضي جُنّة *** إنّ خيرَ المالِ ما أدّى الذّمم
وفي المجتمع البدوي الموسوم بخشونة المسلك ووعورة الخلق، يغدو الكنف الموطأ والطبع الدمث واحة يفيء الناس إلى ظلها. وذو الإصبع العدواني فاخر صديقيه بشمائله الرقيقة، فقال:
لن تعقلا جَفرةً عليَّ ولم *** أوذِ نديماً ولم أنلْ طبعا
وعبد الله بن سلمة عدَّ لين الجانب مفخرة من مفاخره ودليلا على حكمته. إنّه بهذه الحكمة يستطيع أن يداوي حمق الأحمق، ويستل ضغن الحاقد:
ولقد ألين لكل باغي نعمةٍ *** ولقد أجازي أهل كلّ حَويسِ
ولقد أداوي داءَ كل معُبَّدٍ *** بِعَنيَّةٍ غلبتْ على النَّطيسِ
لقد عرضنا أهم المفاخر التي كان الشاعر الجاهلي يفاخر بها، وأغفلنا طائفة من المفاخر إما لأنها دون ما ذكرنا، وإما لأنها فروع من أصول، كصعود الجبال، ولعب الميسر، وامتلاك الأسلحة، واقتياد الجياد، والبراعة في الصيد، والإناخة في الأماكن المخوفة. غير أن ما ذكرنا يمثل أهم القيم التي انطوى عليها الفخر الفردي في العصر الجاهلي. ونحن – على ظهورها بالمظهر الفردي – لا نعتقد أنها كانت قاصرة على الشعراء الذين تغنوا بها، أو على الخاصة من عِلْية القوم. وإنّما نرى أنها مجموعة من الشيم والفضائل تواضع عرب الجاهلية على إكبارها، وعبّر عنها بضمير المتكلم الفرد كل شاعرٍ من الشعراء الذين ذكرنا منهم طائفة وأغفلنا طائفة. إن ما تم عرضه يمثل أبرز القيم التي انطوى عليها الفخر الفردي، والذي هو جزء لا يتجزأ من منظومة الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي. وإذا صح ما نذهب إليه، فهل يعني ذلك أن الفخر الفردي والقبلي فخر واحد؟
الفخر القبلي وأهم معانيه وصوره
كان ارتباط الفرد بالقبيلة مظهراً قوياً من مظاهر الحياة البدوية في العصر الجاهلي، فرضته شدة الصراع بين القبائل المختلفة، وضراوة التزاحم على الموارد والمراتع، وحاجة القبائل في هذا الصراع إلى التضامن الشديد وإلى استخدام الأسلحة المادية والمعنوية المختلفة. ولما كان الشعر الحماسي أهم الأسلحة المعنوية في سوح المعارك، فقد ندب الشعراء فنهم للقيام بهذا الواجب القبلي، وهذا ما جعل الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي ذا طابع جماعي في كثير من الأحيان. فبعثوا بأنفاسهم الملتهبة روح الحمية، وسعروا بصيحاتهم الغاضبة نار العصبية، ورغبوا أبناء القبيلة في الاندفاع إلى ميادين القتال مظلومين أو ظالمين، معتدين أو منتقمين. وافتخروا بشيم وقيم تزيدهم تلاحماً، ومن هذه القيم:
١ – القتال قبل السؤال
قبل كل صراع يحتدم، كان الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي هو الدافع الأساسي للنصر. وبعد كلّ معركة خاسرة، كان المحرض على الثأر، فيه تهدر صرخات الغضب، ومنه ينطلق زئير الوعيد، وبه يجبه الشاعر تهديد العدو بتهديد أشدّ منه. أراد بنو شيبان نفي بني مازن عن ماء لهم يقال له سفوان، وادعوا أنه لهم، فردّ عليهم وذاك بن ثميل المازني ردّاً عنيفاً، وتوعدهم بجياد عراب تلقاهم في سفوان يمتطيها فرسان أشداء مدججون بالسلاح، إذا استنفرهم الشاعر نفروا ولم يسألوا عن زمان المعركة ومكانها. قال ودّاك:
رويد بني شيبان بعض وعيدكُمْ *** تلاقوا غداً خيلي على سَفَوانِ
عليها الكماة الغر من آل مازن *** ليوثُ طِعانٍ عند كلِّ طَعانِ
إذا استنجدوا لم يسألوا من دعاهم *** لأية حرب أم بأي مكان
ومهما يبلغ حظ الشاعر من حصافة الفكر، فرأي القبيلة فوق رأيه، وعليه أن ينصاع للكثرة الغالبة، سواء أكانت على حق أم على باطل. أغار دريد بن الصمة وأخوه عبد الله في جمع من قومهما على غطفان، وساقوا إبلها، ثم نزلوا ليقتسموا، فأشار عليهم دريد بالسير قبل أن تدركهم غطفان، فأبَوْا. ونزل دريد عن رأيه، وأخذ برأي القوم. فما كادوا ينيخون ويشعلون النار حتى أدركتهم غطفان واستردت إبلها، وطعنت دريداً طعنة كادت تتلفه، وقتلت أخاه عبد الله. فقال دريد:
أمرتهم أمري بمنعرجِ اللّوى *** فلم يستبينوا الرّشدَ إلا ضُحى الغدِ
فلمّا عصوني كنتُ منهم وقد أرى *** غوايَتهم، وأنّني غير مهتدِ
وهل أنا إلا من غزيّة إن غوتْ *** غويتُ وإن تَرْشُد غزيّة أرشُدِ
٢ – النفرة الدائمة إلى الحرب والأخذ بالثأر
إن حالة القلق الدائم فرضت على الجاهليين التحفز للقتال، وهو ما غذّى بشكل مستمر الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي. فلما كانت حياة البدو قلقة لا تعرف الاستقرار، فإنّ الإحساس بالقلق فرض على الجاهليين أن يكونوا متحفزين للقتال على نحو دائم، واترين موتورین: واترين يطالبهم خصومهم بدماء أبنائهم، أو موتورين يطالبون غيرهم بدماء قتلاهم. عاهدوا السيوف على أن يطعموها من لحمهم أو من لحم أعدائهم. إن حياتهم قسمان: الأول الإغارة، والثاني ردّ الإغارة، فهي لشقاء دائم، وتوتر مستمر، وعنف موصول بعنف، وهم بذلك كله راضون. قال دريد بن الصمة:
فإما ترينا لا تزال دماؤنا *** لدى واتر يشقى بها آخر الدهر
فإنَّا لَلحْمُ السّيف غير نكيرةٍ *** ونلحَمه حيناً، وليس بذي نُكرِ
يغار علينا واترين فيُشْتَفى *** بنا إن أصبنا أو تغير على وتر
قسمنا بذاك الدّهر شطرين بيننا *** فما ينقضي إلا ونحن على شَطْر
هذه الأحداث الدامية غرست في نفوس العرب شجرة خبيثة، يصعب اجتثاثها أو تشذيب فروعها الشائكة، وهي الأخذ بالثأر. وإذا كانت الحضارة تستنكر هذه الخليقة البدوية، فهذه الخليقة لم تكن في العصر الجاهلي مستنكرة، بل كانت مأثرة من المآثر تعتز بها القبائل وتجد في التزامها غاية التماجد. أغارت بنو عبس على ربيعة بن مالك بن حنظلة، فأتى الصريخ بني يربوع، فأصرخوه وركبوا في طلب بني عبس، وجدوا في الطلب حتى أدركوهم، فوقعت بين الفريقين مقتلة عظيمة، ثأر فيها فريق من فريق. فقال شميث بن زنباع يفاخر بما فعله قومه، ويعدد أسماء الذين قتلوهم انتقاماً وشفاء لنفوسهم من الغل:
سائل بنا عبساً إذا ما لقيتها *** على أيّ حيّ بالصّرائم دُلّتِ
قتلنا بها صبراً شريحاً وجابراً *** وقد نهلت منها الرماح وقلت
فأبلغ أبا حُمْران أن رماحنا *** قضت وطراً من غالبٍ وتغلّت ِ
وما عقبنا به على الأخذ بالثأر في الفخر الفردي يمكن تعميمه على الفخر القبلي، وهو أن العرب بعد الاقتتال كانوا يندمون ويبكون قتلاهم، ويأسفون على الصلات التي تقطعت، والسلام الذي غالته الحرب، والقرابة التي غدت عداوة. حينئذ تنقلب المفخرة بالمجزرة إلى فاجعة موجعة. قال أنيف بن زبان النبهاني:
ولا عصينا بالسيوف تقطعت *** وسائلُ كانت قبل سِلْماً حبالُها
وربما كانت المنصفات أروع ما يعبر عن التناقضات داخل الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي، وأحفله بمشاعر إنسانية راقية، وأبعده عن الحقد والكراهية. في هذا النمط من الشعر تخفت أصوات الفخر، وتنسرب قصة الأخذ بالثأر في منسرب إنساني، وتضعف العصبية القبلية، وتمازج العداوة الصداقة والاحتقار الإكبار، ويُصوّر العدو اللدود بصورة الصديق الودود، ويضع الشاعر نفسه موضع خصمه، فيعبر عما في نفس الخصم، فإذا الذي يحسه الفريقان واحد. وإذا العداوة التي تلمع في الظّبا والأسنة برق خلّب، يومض ثم ينطفئ. وأشهر المنصفات قصيدة المفضل النكري في الحرب التي وقعت بين قومه بني لكيز وأعداء قومه بني لجيم، ولم تتمخض عن نصر لأحد الفريقين. وقد صور المفضل الحرب من بدايتها إلى نهايتها تصوير المؤرخ العادل المتجرد من الهوى، البريء من التعصب والحقد، فذكر أنّه قتل فيها من الفريقين سادة نجب، أكلت الضواري من لحومهم حتى أتخمت، وناحت عليهم نساء القبيلتين حتى شرقن بدموعهن وجفت حلوقهن. ثم انتهت المعركة نهايتها المفجعة، وهي الحسرة القاتلة والندم الشديد على ما قطعت الحرب من وشائج في صراع أرعن لم يستطع المتحاربون أن يدركوا رعونته إلا في نهاية المعركة. وحينها أدركوها، ندم قوم الشاعر وأبقوا على البقية الباقية من بني لجيم، أعدائهم الأصدقاء وأقربائهم الذين لهم عليهم حقوق. فكان نصرهم على أضغانهم أجدر بالفخر من نصرهم على إخوانهم. قال المفضل:
فأشبعنا السباع وأشبعوها *** فراحت كلها تئق يفوقُ
فأبكينا نساءَهم، وأبكوا *** نساء ما يسوغ لهنّ ريقُ
فلما استيقنوا بالصبر منا *** تُذكرت الأواصرُ والحقوق
فأبقينا، ولو شئنا تركنا *** لجيماً لا تقود ولا تسوق
٣ – السطوة على الملوك
يروق للقبائل العربية القوية أن تفاخر الملوك، وأن تجاهر بالخروج على سلطانهم، وتعدّ هذا المسلك من المفاخرة والمجاهرة ضرباً من الأنفة والحمية والعجرفية الجاهلية. وتعتبر هذا الخروج على السلطان ذروة الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي. كانت قبيلة تغلب من القبائل العزيزة، وكانت على خلاف مع بكر يعود إلى حرب البسوس. وقد حاول ملوك الحيرة أن يصلحوا بين القبيلتين الكبيرتين، وأن يبسطوا سلطانهم الرمزي وهيبتهم السياسية عليهما وعلى غيرهما من القبائل، فرفضت تغلب، وهبّ شاعرها جابر بن حني التغلبي يفاخر وينافر، ويزعم أن الملوك لا يجرؤون على أن ينتهكوا شرف تغلب لمنعتها وهيبتها المفروضة على الناس. فهذه القبيلة تحبّ أن تعايش الملوك معايشة الأنداد والأقران، تسالم العادل وتحارب الجائر وتستبيح دمه. وإذا خطر لملك من الملوك أن يحقرها أو يحاول إيذاءها، فليعلم أنها ستحييه تحية قاتلة، كما فعلت بأمثاله من قبل:
ألا تستحــي منــا ملوك وتـتـقـي *** محارمنا لا يَبْوُؤُ الدَّمُ بالدم
نُعاطي الملوك السلم ما قصدوا بنا *** وليس علينــا قتلهم بمحرم
وكائن أزرنا الموت من ذي تحية *** إذا ما ازدرانا أو أسف لمأثم
وربما كان الشاعر على حقّ، فقد كانت تغلب من أقوى القبائل العربية، وكان شاعرها عمرو بن كلثوم التغلبي من أعزّ العرب، ساد قومه وهو غلام، وقتل ملك الحيرة عمرو بن هند حينما حاولت أمّ الملك أن تستخدم أمه ليلى بنت المهلهل. فجاء فخر جابر موصولاً بفخر ابن كلثوم، على أن فخر ابن كلثوم ظل أعتى وأحرى من فخر جابر، لأنه ذكر أيام تغلب وثورتها على صاحب التاج عمرو بن هند. ووصف كيف قتل الملك، وترك الخيل بأعنتها وسروجها واقفة على جثته. وإذا عجز ابن هند عن حماية نفسه، فكيف كان يدعي القدرة على حماية من يلجأ إليه من المستجيرين؟ بل كيف كان يريد أن يبسط سلطانه على القبائل ويحبس في قصره الرهائن من أبنائها؟ قال ابن كلثوم:
وأيام لنا غُرٍّ طوال *** عصينا الملك فيـهـا أن ندينـا
وسيد معشر قد توّجوه *** بتاج الملك يحمي المحـجـريـنـا
تركنا الخيل عاكفة عليه *** مقلدة أعنتها صفونا
٤ – الأنساب والأمجاد
إن المفاخرة بالملوك تقود الشاعر الجاهلي إلى المفاخرة بالمجد القديم والحسب العريق، وهو بُعد آخر من أبعاد الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي. وربما كان هذا الضرب من الفخر نوعاً من الصراع بين النظامين الملكي والقبلي، أي نوعاً من الصراع بين القبائل التي تعودت الغزو، والملوك الذين يسعون إلى بسط سلطانهم على القبائل، أو بين وعورة الخلق عند الأعراب والمكر الذي يتخلق به الملوك. فاخر يزيد بن الخذاق الشني النعمان بن المنذر، فذكر تقلب النعمان وميله إلى المكر ومحاولته أن ينال من قوم الشاعر الذين ينتمون إلى بني نزار، أصحاب النسب الشريف والمجد المؤثل والأنفة الشديدة، فقال:
نعمان إنك خائنٌ خَدعٌ *** يُخفي ضميرك غير ما تبدي
فإذا بدا لك نَحْتُ أَثْلَتنا *** فعليكها إن كنتَ ذا حَرْدِ
يأبى لنا أنّا ذوو أنفٍ *** وأصولنا من مَحْتد المجدِ
ويبدو أنّ هذا المعنى من معاني الفخر كان يأتي رداً على استهانة الملوك بالسادة والقادة من رجال القبائل، فيردّ عليهم الشعراء ردّاً عنيفاً، فيفخرون بأنسابهم وأمجادهم. ومن هذا النمط ردّ عمرو بن كلثوم على عمرو بن هند، وفي ردّه سلسلة من الأسماء عرف أصحابها بالبطولة والأنفة، واقترنت شهرتهم بأعمال جليلة وانتصارات هامة، ورثها الأبناء عن الآباء. قال عمرو بن كلثوم:
ورثنا مجد علقمة بن سيف *** أباح لنا حصون المجـد دينـا
ورثتُ مُهلهلا والخير منه *** زهيراً نعم ذخر الذاخرينـا
وعتاباً وكلثوماً جميعاً *** بهم نلنا تراث الأكرميناه
وذا البُرةِ الذي حدثت عنهُ *** به نُحمى ونَحمي المحجرينا
ومنا قبله الساعي كليبُ *** فأيُّ المجدِ إلاّ قد وَلينا
٥ – السيادة وكثرة العدد والعتاد
إذا كانت الأعراب تكره أن يسطو عليها الملوك، فإن كل قبيلة كانت تفاخر بسيطرتها، وتدعي بسط سلطانها على الناس، وتربط السيطرة بالكثرة، والسيادة بالسلاح. وهذا يربط بين السيطرة والكثرة في إطار الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي. لقد شعر بشر بن أبي خازم المضري النزاري بنشوة غامرة وهو يسرد أسماء القبائل التي خضعت لسطوة قومه. ومنها: طيء، وبنو سبيع، والرباب، وبنو سعد. ومنها نمير التي فاجأتها قبيلة الشاعر بخيول أجلتها عن مضاربها، وبنو كلاب الذين طلبوا النجاة فلم يدركوها، وسليم التي راحت تمضغ خوفها وضعفها وهي خانعة، وقبيلة أشجع التي لا تعد في الرجال ولا في النساء، بل يحصى رجالها بين التيوس، كما يحصى بنو سليم بين الحمر. قال بشر:
ويُدِّلت الأباطحُ من نمير *** سنابك يستثار بها الغبار
وليس الحي حي بني كلاب *** بمنجيهم، وإن هربوا الفرار
وقد ضَمَزَت بِجِرَّتها سُليم *** مخافتنا كما ضمر الحمار
وأما أشجع الخنثى فولت *** تُيُوساً بالشَّظيّ لهم يُعارُ
وسلسلة القبائل طويلة، والشاعر لا يمل تعدادها لأن كل اسم يذكره يزيد في قامته شبراً، وهو يتطاول ويضيف إلى أنفه شمخة وهو يشرئب. والسطوة في شعر عمرو بن كلثوم اقترنت بكثرة تغلب عدداً وعدة، إذ استطاعت تغلب أن تغلب القبائل الأخرى بكثرة أبنائها الذين ملؤوا البر والبحر، وبأنفتها المغروزة في طباعها حتى إن الرضيع من أطفالها يُعَدُّ في الجبارين فيخضع له الناس من ذوي الجبروت:
ملأنا البر حتى ضاق عنا *** وماء البحر نملوه سفينـا
إذا بلغ الفطام لنا صبي *** تخر له الجبابر ساجدينا
وربما تجلت السيادة في القدرة على احتلال الأرض وإجلاء أهلها عنها، وفي بسط السلطان على مساقط الغيث. قال الأخنس بن شهاب التغلبي:
ونحن أناس لا حجاز بأرضنا *** مع الـغـيـب ما تلقى ومن هو غالب
وإلى هذا المعنى اتجه بشر بن أبي خازم حينما زعم أن قومه أغاروا على نجد واستباحوها، وسيطروا على أخصب مرابعها ومراتعها في أيام القحط واحتباس المطر:
كفينا من تغيَّب واستبحنا *** سنام الأرض إذ قَحِط القطارُ
وللسيادة في المجتمع القبلي المحارب آلاتها كالجياد والسيوف والدروع. ولذلك ألحّ الشعراء في فخرهم القبلي على التباهي بالخيل المضمرة الأصيلة النسب، القليلة الشعر، المعدة للنزال التي أورثها الآباء أبناءهم. قال عمرو بن كلثوم:
وتحملنا غداةَ الرُّوع جُرد *** عرفن لنا نقائذَ وافـتـُليـنـا
ورثناهن عن آباء صدقٍ *** ونُورتُها إذا متنـا البـنـيـنـا
وجعل شعراء الفخر القبلي سيوفهم المرهفة وسيوف قبائلهم المتنمرة للقتال مفخرة جليلة. فاخر بها السموءل، وجعلها مثلومة النصال لأنها ألفت مقارعة الدارعين، وذكر أنها لا تدخل الأغماد حتى تحقق النصر، وتستبيح حمى الأعداء، وتفرض الذلّ على القبائل التي تحاربها:
وأسيافنا في كل غرب ومشرق *** بها من قراع الدارعين فلول
مُعوّدة ألا تُسل نصالُها *** فَتُغْمَدَ حتى يُستباحَ قبيل
وأضاف عمرو بن كلثوم إلى سيوف تغلب أثراً آخر من آثار القتال، هو انحناؤها من الضرب الشديد، واعتز بالدروع الضافية البراقة التي يترك حديدها أخاديد في جسوم الأبطال وسواداً في جلودهم:
علينا البيض واليَلَبُ اليماني *** وأسياف يقمن ويَنْحَنينا
علينا كلُّ سابغة دلاصٍ *** ترى فوق النطاق لها غُضُونا
إذا وُضِعَتْ عن الأبطال يوماً *** رأيت لها جُلود القوم جُونا
٦ – الفخر بمكارم الأخلاق
كما في الفخر الفردي، تتجلى مكارم الأخلاق كعنصر أساسي في الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي على المستوى القبلي. لو قصدنا إلى الاستقصاء في الحديث عن مفاخر المجتمع الجاهلي وقيمه لازدحمت علينا المعاني والصور، وتشعب بنا الحديث، واضطررنا إلى الكلام على القيم والشيم التي صاغ منها العرب مثلهم العليا، واحتكموا إليها في سلوكهم كله، وظهرت آثارها في علاقاتهم القبلية ظهورها في السلوك الفردي. وباختصار شديد نقول: ما فاخر به الشعراء من شيم وخصال وهم يتحدثون عن أنفسهم، فاخروا به وهم يتحدثون عن قبائلهم. ومن هذه الخصال إجارة المضعوف، وإغاثة الملهوف، والوفاء، والأمانة، والعفة. فخر حجر بن خالد بقومه بني ثعلبة لأنهم ينشرون ظلال الأمن على من يستجير بهم، ولا يغدرون بالعهد الذي يقطعونه على أنفسهم. وكيف لا يفخر بهم وهو يرى القبائل الأخرى عاجزة عن حماية المستجيرين، فإذا عُيّرت بسوء الجوار تصاممت ولم تبال الذم:
ونحن الذين لا يروّعُ جارُنا *** وبعضُهم للغدر صمٌّ مسامِعُهْ
وفخر سلامة بن جندل بإغاثة الملهوف، فمتى استصرخ قومه خائف أصرخوه بعزم لا يعرف التردد ومضاء لا يصيبه الخور:
كنا إذا ما أتانا صارخ فزعٌ *** كان الصراخ له قرع الظنــابــيــبِ
ويرتبط بالإجارة والإغاثة وفاء القبيلة وأمانتها، لأن آية الإجارة القدرة على كف الأذى عن المولى والنية الصادقة على تنفيذ الكلمة المقطوعة واليمين المعقودة. قال عمرو بن كلثوم:
وتوجد نحن أمنعهم ذماراً *** وأوفاهم إذا عقدوا يمينـا
ومن أشنع المثالب التي تعيّر بها القبيلة نقض العهد، ولذلك كانت العرب تفضح نقض العهود في المحافل. فإذا غدرت قبيلة بعهد، رفعت لها بسوق عكاظ راية مُعْلَمة تعلن سقطتها في الموسم. قال الحادرة معتزاً بوفاء قبيلته غطفان:
أَسُمَّي ويْحكِ هل سمعت بغدرةٍ *** رُفِعَ اللّواءُ لنا بها في مجمعِ
والأمانة – كما يرى لبيد بن ربيعة – من أعظم الشيم التي تفاخر بها قبيلته بنو عامر، لأنّ الله مقسم الفضائل بين البشر، خصها بالحظ الأعظم من هذه الفضيلة:
وإذا الأمانة قسمت في معشر *** أوفى بأوفر حظنا قسامها
والأمانة تستلزم العفة وحسن الجوار، ولذلك جعل الحادرة بني غطفان زاهدین في المطامع، راغبين عن الكسب الحرام، مقيمين على عهد الجار، لا يأتون فعلة واحدة تدفع إلى الارتياب في مقاصدهم:
إنَّا نَعفُ فلا نُريبُ حليفنا *** ونكُفُّ شُح نفوسنا في المطمعِ
خصائص الفخر
قد يبدو البحث عن خصائص تميز الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي عن غيره من الأغراض ضربًا من التكلف لأنه بعض الشعر الجاهلي. ومع ذلك، فإنّ الباحث يستطيع أن يظفر بخصائص تسم الفخر بسمات يكاد يتفرد بها:
١ – من أهم خصائص الفخر – من الناحية الفكرية – مخالطته الأغراض الأخرى. فأنت لا تجد في الشعر الجاهلي قصيدة وقفها الشاعر على الفخر وحده، وإنما تجد الفخر حجراً في بناء القصيدة الجاهلية أو ركناً من أركانها. غير أنّ معلقة عمرو بن كلثوم تعد فريدة في بابها، فهي على طولها تكاد تكون فخراً قبلياً خالصاً. فإذا أسقطت مقدمتها الغزلية تحصل لك ثمانون بيتاً من الفخر المتفجر. وهذا العدد يجعلها أطول قصائد الفخر في العصر الجاهلي وأقرب قصائد هذا العصر إلى شعر الملاحم. وملابسة الفخر الأغراض الأخرى لا تفسد وحدة الموضوع في القصيدة الجاهلية، وإنما تشدُّ أواصرها، ويسبغ عليها الطابع الذاتي سواء أكانت مدحاً أم هجاء. والشاعر الجاهلي بارع في التنقل بين الفخر والموضوعات الأخرى، قادر على أن يسلك في أبيات القصيدة خيطاً فكرياً عاماً ينتظم معانيها الصغيرة في وحدة كبرى. غير أن معلقة عمرو بن كلثوم تُعد حالة فريدة، حيث إنها تكاد تكون تجسيدًا خالصًا لـالفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي.
٢ – والخاصة الفكرية الثانية هي تفلت الفخر من رقابة المنطق والعقل، وانطلاقه في آفاق لا تحد من المبالغات. ويُخيّل إلينا أنّ الذوق الفني في ذلك العصر لم يكن يستنكر الغلو، ولا يرفض الإفراط، ولا يجد حرجاً في تقبل مزاعم ابن كلثوم حين يزعم أن تغلب ملأت البحر سفناً والبر جيوشاً، وأن الرضيع من أبنائها يخر له الملوك سُجداً:
ملأنا البرّ حتّى ضاق عنّا *** وماء البحر نملؤه سفينا
إذا بلغ الفطام لنا صبي *** تخر له الجبابر ساجدينـا
ولا نستثني من هذه الخاصة إلا المنصفات التي أشرنا قبل إلى ما فيها من صدق وسمو ونزعة إنسانية واحتكام إلى صورة من صور المنطق على نحو من الأنحاء.
٣ – والخاصة الثالثة هي أن الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي يلتقي بالمدح في ملتقى واحد، هو اشتراك الغرضين في صياغة المثل الأعلى للإنسان العربي الجاهلي. فإذا استخلصت الفضائل والمآثر التي يباهي بها شعراء الفخر بنوعيه الفردي والقبلي، وضعت يدك على العناصر التي صنع منها الشعر الجاهلي الأخلاق والقيم التي ظلت تنتقل من جيل إلى جيل، والناس يتلقونها بالإكبار. ولا نبالغ إذا زعمنا أن كثيراً من القيم الجاهلية ظلت تعيش حتى العصر الحاضر في أعماق النفس العربية، وتشارك بصورة ظاهرة أو خفية في رسم السلوك العربي، وتميز الفضيلة من الرذيلة، وتحكم كثيراً من علاقاتنا الاجتماعية. حتى الفضائل التي يُخيل إلينا أن الحضارة أخرجتها من دائرة الفضيلة كالتعصب القبلي والأخذ بالثأر، بقيت لها في أنفسنا بذور وجذور تنبعث من مكامنها انبعاثاً عضوياً مفاجئاً بين الحين والحين.
٤ – ورابعة الخصائص الفكرية هي انطواء الفخر على أحداث كثيرة خطيرة في العصر الجاهلي، وعلى أسماء الأبطال الذين صنعوا هذه الأحداث. فهو في هذا الجانب يُعد مصدرا من مصادر التاريخ العربي، اختلطت فيه الحقائق بالأساطير والواقع بالخيال، ولذلك اتسعت آفاقه للحياة البدوية في سلمها وحربها، وحلها وترحالها، وحيوانها ونباتها وآلاتها.
٥ – ومن الناحية النفسية، يعدّ الفخر قمة التوتر العاطفي في الشعر الجاهلي. فيه ينظر الشاعر إلى نفسه وقبيلته مرسومتين على مرآة مقعرة فيراهما كبيرتين مزهوتين من العمالقة. فينتفخ وينفخ قومه، ويغضب ويثير الغضب في الناس، ويحقد ويدعو إلى شفاء الحقد بالانتقام، ويتعجرف ويحرّض قبيلته على العجرفية. أما الانفعال الذي يظهر في المنصفات فليس توازناً بين طرفين متوازنين، وإنما هو توازن بين فريقين متفجرين حماسة وتوتراً، كلاهما يثور ويغضب، ويفأ غضبه بإراقة الدماء ثم بالبكاء على من أريق دمه. فالمنصفات لم تخرج الفخر من العاطفة إلى العقل، ولم تشف النفوس من غيظها الكظيم.
٦ – وفي الجانب الفني، يتميز الفخر بالصور الحية المتحركة، وبالألوان الحادة الناطقة، وبالبراعة في وصف الحرب والخيل والأسلحة. فالرؤوس تتدحرج على الأرض كأنها كرات يقذفها غلمان أشداء على أرض صلبة:
بُدْهدونَ الرؤوس كما تُدَهْدي *** خَزاوِرة بأبطحها الكُريتا
والثياب تصبغ بلون أرجواني من الدماء التي تسيل عليها من جسوم المتحاربين:
كأنّ ثيابَنا منّا ومنهم *** خُضِينَ بِأَرْجُوانِ أو طُلينا
٧ – وهذه الألواح المصوّرة التي يطغى عليها لون الدم وبريق الدروع والأسنة، ولمعان السيوف وسواد الغبار الثائر، تحتاج إلى إيقاع لفظي قويّ، تقعقع أصداؤه، ويشتد جرْسُه، وتتدفق نبراته، كقول المفضل النكري:
رمينا في وجوههم برشقٍ *** تغصُّ به الحناجر والحلوقُ
بكل قرارةٍ منّا ومنهم *** بَنانُ فتى وجمجمةٌ فليقُ
والخلاصة أن هذا الغرض الحماسي، الذي يمثل الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي، توافرت فيه كثير من خصائص الشعر الملحمي والنفوس المستنفرة بصورة دائمة للقتال، مما يجعله أصدق الأغراض تعبيراً عن فروسية العصر الجاهلي.
الأسئلة الشائعة
١ – ما هو التعريف الأكاديمي لغرض الفخر والحماسة في الشعر الجاهلي؟
الإجابة: في الاصطلاح النقدي، يُعرّف الفخر بأنه غرض شعري يعبر فيه الشاعر عن اعتزازه بنفسه وقومه، وهو نابع من الإعجاب بالذات. أما الحماسة فتشير إلى الشجاعة والشدة في القتال. ويرتبط غرض الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي ارتباطًا وثيقًا، حيث يمثلان معًا تعبيرًا عن قيم الفروسية والقوة السائدة في المجتمع القبلي.
٢ – ما هي أبرز العوامل التي ساهمت في ازدهار هذا الغرض الشعري؟
الإجابة: ازدهر هذا الغرض بفعل عاملين رئيسيين: أولًا، طبيعة المجتمع القبلي التي تقدس قيم القوة، الحمية، والعصبية. ثانيًا، ارتباطه بغريزة حب البقاء والصراع من أجل الحياة، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي لعبته “أيام العرب” كساحة للتفاخر والمنافرة الشعرية.
٣ – ما الفرق الجوهري بين الفخر الفردي والفخر القبلي؟
الإجابة: الفخر الفردي ينبع من إعجاب الشاعر بصفاته الشخصية وقدراته الذاتية، مثل فصاحته، كرمه، وشجاعته. بينما يذوب الفخر القبلي في الكيان العام للجماعة، حيث يفتخر الشاعر بلسان قبيلته، متغنيًا بأمجادها، كثرة عددها، وقوتها العسكرية، مما يعكس تضامن الفرد مع القبيلة.
٤ – كيف استخدم الشاعر الجاهلي الفخر بشعره كأداة قوة؟
الإجابة: اعتبر الشاعر لسانه وفصاحته سلاحًا لا يقل أهمية عن السيف، فافتخر بقدرته على رفع شأن قومه والحط من قدر أعدائه بقوافيه التي شبهها بالصواعق. وكان شعره وسيلة لفرض الهيبة وتحقيق التفوق في مضمار المنافرات.
٥ – هل اقتصر الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي على القوة والقتال فقط؟
الإجابة: لا، بل شمل أيضًا الفخر بمكارم الأخلاق السامية مثل الكرم، حماية الجار، الوفاء بالعهد، الأنفة عن الدنايا، العفة، ورجاحة العقل. هذه القيم شكلت المثل الأعلى للشخصية العربية وصاغت جزءًا أساسيًا من هوية الفخر.
٦ – ما هي “المنصفات” وما أهميتها ضمن شعر الفخر؟
الإجابة: “المنصفات” هي قصائد فريدة يقف فيها الشاعر موقفًا عادلًا، فيعترف بقوة خصمه وشجاعته ويبكي قتلى الطرفين معًا. تكمن أهميتها في أنها تمثل نزعة إنسانية راقية تخفف من حدة العصبية القبلية وتوازن بين الفخر بالانتصار والحزن على الخسائر.
٧ – كيف تجلت علاقة القبائل العربية بالملوك في شعر الفخر؟
الإجابة: تجلت في صورة تحدٍ وعصيان، حيث فاخرت القبائل القوية، مثل تغلب، بقدرتها على مواجهة الملوك ورفض الخضوع لسلطانهم. واعتبر هذا الخروج على سلطة الملك ذروة الأنفة والعزة القبلية، كما يظهر بوضوح في معلقة عمرو بن كلثوم.
٨ – ما هي الخصائص الفنية الأبرز لشعر الفخر والحماسة؟
الإجابة: تميز هذا الشعر بخصائص فنية بارزة، منها: التوتر العاطفي العالي، المبالغة الشديدة (الغلو)، الصور الحية المتحركة التي تصف المعارك والأسلحة بدقة، والإيقاع اللفظي القوي والجرس الموسيقي الحاد الذي يناسب أجواء الحرب والحماسة.
٩ – لماذا تُعد معلقة عمرو بن كلثوم نموذجًا استثنائيًا للفخر القبلي؟
الإجابة: لأنها قصيدة طويلة تكاد تكون مخصصة بالكامل لموضوع الفخر في الشعر الجاهلي والحماسة في الشعر الجاهلي على المستوى القبلي. فهي تسرد أمجاد قبيلة تغلب، وتتحدى الملك عمرو بن هند، وتفيض بالعزة والأنفة، مما يجعلها أقرب إلى الملحمة الشعرية.
١٠ – هل يمكن اعتبار شعر الفخر مصدرًا تاريخيًا للعصر الجاهلي؟
الإجابة: نعم، يمكن اعتباره مصدرًا تاريخيًا مهمًا، وإن كان ممزوجًا بالخيال والأسطورة. فهو يؤرخ لـ”أيام العرب”، ويذكر أسماء الأبطال والقبائل، ويوثق القيم الاجتماعية، والعلاقات بين القبائل، وأساليب الحرب، مما يقدم صورة غنية عن الحياة في ذلك العصر.