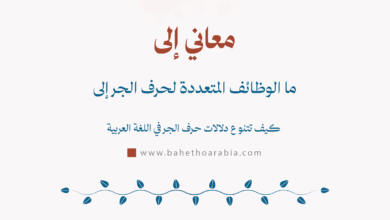الفرق بين الإضافة الحقيقية والإضافة اللفظية: وتمييز المضاف والمضاف إليه
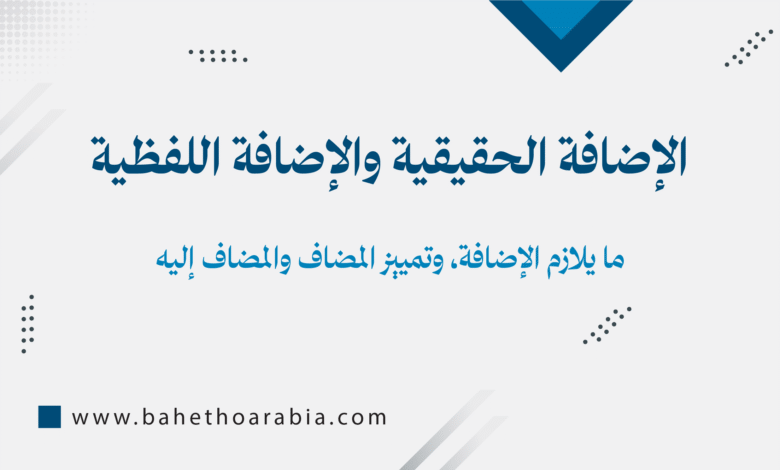
بين يديك دليلاً أكاديميّاً محكماً عن الإضافة في النحو العربي؛ نضبط فيه تعريف الإضافة وأنواعها الحقيقية واللفظية، ونفكّك معانيها الدلالية (اللام/من/في) وآثارها الإعرابية، مع بيان الشروط والقيود وما يلازم الإضافة، واكتساب التذكير والتأنيث، وحذف المضاف، والفصل بين المتضايفين. يزوّدك هذا المحتوى بخريطة واضحة للتمييز بين الإضافة المحضة وغير المحضة، وكيفيّة التعرف على المضاف والمضاف إليه، والجر بالإضافة، ومتى تجوز (أل) في الإضافة اللفظية، وكيف تُكسب الإضافة التعريف بالتسلسل. صيغت المادة بمنهج مباشر وأمثلة قرآنية وشعرية وتحليلات تطبيقية دقيقة تساعدك على تجنّب الأخطاء الشائعة وتوظيف الإضافة في كتابة عربية سليمة ورشيقة.
الإضافة
الأسماء التي تعمل عمل الحروف إمّا أن تعمل عمل حروف الجرّ، وإمّا أن تعمل عمل حروف الجزم؛ فعمل الجرّ في الأسماء يكون بالإضافة. وأصل الإضافة الإمالةُ والنِّسبة، وهي في الكلام على ضربين: حقيقية ولفظية. وفي هذا العرض نُفصّل أحكام الإضافة، وأنواع الإضافة، وآثار الإضافة في الإعراب، ومعاني الإضافة في السياق.
الإضافة الحقيقية
الإضافة الحقيقية: هي نسبة بين اسمين يتعرّف أوّلهما بالثاني إن كان الثاني معرفة، ويتخصّص به إن كان نكرة؛ تقول: هذا كتابُ خالدٍ، فقد تعرّف الكتاب لأنّه أُضيف إلى المعرفة، وهذا عالمُ نحوٍ، فقد تخصّص العالم لأنّه أُضيف إلى نكرة. تسمّى الإضافة التي تفيد التعريف أو التخصيص في هذا الباب الإضافة الحقيقية ضمن نظام الإضافة في العربية.
والإضافة الحقيقية تكون على معنى أحد أحرف الجرّ الثلاثة: اللام، من، في.
أ ـ اللام: الإضافة التي بمعنى اللام تُسمّى إضافة المِلْك أو الاختصاص؛ تقول: دارُ خالدٍ، والمعنى: دارٌ لخالدٍ، والإضافة إضافة مُلك، وتقول: سورُ المدينةِ، والمعنى سورٌ للمدينة، والإضافة إضافة اختصاص.
ب ـ مِنْ: وهي (مِنْ) البيانية التي تُبيّن الجنس، وغرض الإضافة التي بمعنى (من) البيانية بيانُ جنس المضاف بإضافته إلى جنسه، نحو: ثوبُ حريرٍ، وخاتمُ ذهبٍ، وبابُ خشبٍ، فالمعنى: ثوبٌ من حريرٍ، وخاتمٌ من ذهبٍ، وبابٌ من خشبٍ.
ج ـ في الظرفية: إذا كان المضاف إليه ظرفاً للمضاف، نحو: سيرُ الليلِ، ونومُ النهارِ، والمعنى: سيرٌ في الليل، ونومٌ في النهار. وقال تعالى: {بلْ مكْرُ الليلِ والنهار}. والمعنى: بل مكرٌ في الليل والنهار.
والإضافة إذا أُطلقت، كان المقصود بها الإضافة الحقيقية أو المعنوية التي تُفيد التعريف أو التخصيص، والتي تكون على معنى أحد أحرف الجر الثلاثة. والاسم المضاف عاملٌ في المضاف إليه الجرّ، ومن آثار الإضافة أن التنوين يُحذفُ من المضاف المفرد، وتُحذف النون من المثنّى وجمع المذكر السالم؛ تقول: جاء معلّمو المدرسة، وغاب معلّما الرياضة، وقال تعالى: {يا صاحبَيْ السِّجنِ، أأربابٌ متفرقون خيرٌ أم اللهُ الواحدِ القهار}. فقد حُذفت نون التثنية من المثنّى المضاف (صاحبي).
ولا يُضاف ما كان معرّفاً بـ(أل).
وهناك كلمات شديدة الإبهام مُغرِقة في التنكير، لا تتعرّف، وإن أُضيفت إلى معرفة، وهي (غير، مثل، شبه، نظير)، فتوصف بها النكرة، وإن أُضيفت إلى معرفة. تقول: جاءني رجلٌ غيرُك، وأعطني كتاباً مثل كتابِ خالدٍ. قال تعالى: {وهم يصطرخون فيها: ربّنا أخرجنا نعمل صالحاً غير الذي كنّا نعمل}. فقد أُضيفت (غير) إلى اسم الموصول، وهي صفة للنكرة (صالحاً).
الإضافة اللفظية
الإضافة اللفظية: غرضها التخفيف اللفظي بحذف التنوين من المفرد، والنون من المثنّى أو الجمع، وهي ليست على معنى أحد أحرف الجرّ الثلاثة، ولا يَكتسب المضافُ منها تعريفاً ولا تخصيصاً، وهي إضافة اسم الفاعل، أو اسم المفعول، أو الصفة المشبّهة إلى معموله؛ تقول: أنا تركُ العملِ، وأنت حلّالُ المعقّد من الأمور، ومررتُ برجلٍ ممزّقِ الثوب، ولي صديقٌ طيّبُ القلب. فالأصل في ذلك: تاركٌ العملَ، وحلّالٌ المعقّدَ، وممزّقٌ الثوبُ منه، وطيِّبُ قلبُه. والمعيار في الإضافة اللفظية أنّها لا تغيّر هوية التعريف، بل غايتها في الإضافة تخفيفُ الصيغة، ولذلك تبقى الإضافة هنا ذات بُعدٍ صوتيّ أكثر منه دلالياً.
وفي الإضافة اللفظية يجوز أن يكون المضاف مُحلّى بـ(أل) إن كان المضاف إليه مُحلّى بها، أو مضافاً إلى مُحلّى بها، أو ضميراً يعود على مُحلّى بها، أو إذا كان المضاف مثنّى أو جمعاً؛ تقول: زارني الصديقُ الحلوُ المعشرِ، المقدِّرُ عملِ الخيرِ، المحمودةُ أفعالُه. فالمضاف (الحلو) صفةٌ مشبّهة، وهو مُحلّى بـ(أل)، وأُضيف إلى معموله المُحلّى بـ(أل)، وأُضيف إلى معموله المُحلّى بـ(أل). والمضاف (المقدَّر) اسم فاعل أُضيف إلى مضافٍ إلى مُحلّى بـ(أل)، وهو عملُ الخير، والمضاف (المحمود) اسم مفعول معرّف بـ(أل)، وهو (الصديق). وقال تعالى: {والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة}. فقد أُضيف اسم الفاعل (المُقيمي) إلى معموله (الصلاة).
ويجوز أن يقع المضاف إضافة لفظية مواقع الاسم النكرة، وإنْ أُضيف إلى المعرفة.
قال جرير:
يا ربِّ غابِطِنا لَوْ يَطْلُبُكم *** لاقى مُبَاعَدةً مِنكًم وحِرمَانا
جاء اسم الفاعل (غابطِنا) مجروراً بـ(ربّ) التي لا تجرّ إلّا النكرات. ويمكن أن تُوصَف بالمشتقّ المضاف إلى معموله النكرة، وأن يُوصَف بها، وأن يكون حالاً. قال تعالى: {هذا عارضٌ ممطرُنا}. فاسم الفاعل (ممطر) مضافٌ إلى الضمير (نا)، وقد وُصفت به النكرة (عارض).
وقال الشاعر:
إذا ما جِئتُ زائرَهم دعاني *** شريدُهم وهلْ لهُمُ شريدُ
فاسم الفاعل المضاف إلى الضمير، وهو (زائرهم)، وقع حالاً، وصاحب الحال فاعل الفعل (جئت). وتقول: ربّ ناصرِنا، مؤيِّدٍ لنا قد أبدى استعداده لمساندتنا. فقد وُصف اسم الفاعل (ناصر)، وهو مضاف إلى الضمير بالنكرة (مؤيِّد).
ما يلازم الإضافة
ما يلازم الإضافة: ١ـ بعض الأسماء التي لا تُفارِق الإضافة إلى المفرد: وهي (كلّ، وكِلا، وكِلتا، وبعض، وأيّ، وغير، ومثل). وهذه الألفاظ ملازمة لبناء الإضافة وتظهر أحكام الإضافة معها بوضوح.
كلّ: تُضاف إلى المفرد النكرة، ويكون معناها الجمع؛ تقول: كلُّ رجلٍ، والمعنى كلُّ الرجال، وتُضاف إلى المعرفة، وإلى الضمير؛ تقول: جاء الطلّابُ كلُّهم، وجاء كلُّ الطلّاب، وتُقطع عن الإضافة فتُنَوَّن، ويُقدِّرون المحذوف ضميراً. قال تعالى: {وكلٌّ أتَوهُ داخِرين}. والتقدير: وكلُّهم أتَوهُ داخرين، فلمّا قُطعت عن الإضافة نُوّنت. ولفظها مفرد مذكّر، ومعناها بحسب ما تُضاف إليه؛ فإن أُضيفت إلى مذكّر فمعناها مذكّر، وإن أُضيفت إلى مؤنّث فمعناها مؤنّث؛ قال تعالى: {كلُّ نفسٍ بما كسبت رهينة}. أُضيفت إلى مؤنّث. والأحسن مراعاة لفظها إذا أُضيفت إلى معرفة، ومراعاة ما أُضيفت إليه إذا أُضيفت إلى نكرة؛ قال تعالى: {وكلُّهم آتيهِ يومَ القيامةِ فرداً}. روعي لفظُها، فعاد إليها الضمير مفرداً مذكّراً؛ لأنّها أُضيفت إلى معرفة، وقال تعالى: {كلُّ حزبٍ بما لديهم فرحون}. روعي معناها، فعاد إليها ضمير جماعة الذكور (لديهم فرحون). وقال عنترة:
جادت عليه كلُّ عينٍ ثرّةٍ *** فتركنَ كلَّ قرارةٍ كالدراهم
أُضيفت (كل) إلى النكرة المؤنّثة، فعاد إليها ضمير جماعة الإناث (فتركن). وإذا قُطعت عن الإضافة فالأحسن مراعاة معناها؛ قال تعالى: {كلٌّ إلينا راجعون}. والتقدير: كلُّهم إلينا راجعون.
كِلا وكلتا: إذا أُضيفتا إلى الضمير أُعرِبتا إعراب المثنّى؛ تقول: جاء أخواك كلاهما، وأختاك كلتاهما، ورأيت أخويك كليهما، وأختيك كلتيهما، وإذا أُضيفتا إلى الاسم الظاهر أُعرِبتا إعراب الاسم المقصور؛ قال تعالى: {كلتا الجنّتين آتت أُكُلَها ولم تَظلمْ منه شيئاً}. فقد أُضيفت (كلتا) إلى الاسم الظاهر (الجنّتين). ولذلك تُعرَب إعراب الاسم المقصور، فهي مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمّة المقدّرة على الألف للتعذّر. ولفظهما مفرد، ومعناهما مثنّى، والأحسن إعادة الضمير عليهما مفرداً، أو الإخبار عنهما بالمفرد مراعاةً للّفظ؛ تقول: كلانا ذاهب، وكلا الطالبين أجاد في بحثه.
بعض: تُضاف إلى النكرة والمعرفة، والظاهر والضمير، والمفرد والمثنّى والجمع، وتُقطع عن الإضافة فتُنَوَّن، ويُقدّرون المحذوفَ ضميراً، ولذلك لا تُوصَف، ولا يُوصَف بها؛ تقول: مررتُ ببعضٍ قائماً، وبعضٍ جالساً، ولفظها مفرد مذكّر.
أيّ: تُضاف إلا إذا كانت وصلةً لنداء ما فيه (أل)، نحو: (يا أيّها الناس) فـ(ها) للتنبيه؛ أمّا إذا كانت اسم استفهام، أو اسم موصول، أو اسم شرط، أو (أيّ) الكماليّة فتُضاف. وتُقطع عن الإضافة فتُنَوَّن؛ قال تعالى: {أياً ما تدعوا فله الأسماءُ الحسنى}. ويجوز تأنيث لفظها إن كانت دالّةً على مؤنّث؛ تقول: أيُّهُنّ المجدّة؟ وأيّتُهُنّ المجدّة؟
غير: من الألفاظ المبهمة التي لا تتعرّف بالإضافة، وتُقطع عن الإضافة بعد (ليس) و(لا)، فَتُبنى على الضمّ أو الفتح؛ تقول: قرأتُ خمسَ عشرةَ صفحةً ليس غيرَ، وسأعطيك مئةَ ليرةٍ لا غير.
مثل: من الألفاظ المبهمة التي لا تتعرّف بالإضافة، وإذا أُضيفت إلى مصدر غير صريح جاز فيها البناء على الفتح؛ قال تعالى: {وإنّه لحقٌّ مثلَ ما أنكن تنطقون}. فـ(مثل) صفة لـ(حقّ) مبنيّة على الفتح في محلّ رفع، وقد بُنيت لأنّها مضافة إلى مصدر مؤوّل، والتقدير: مثلُ نطقِكم، و(ما) زائدة.
بعض ما لا يفارق الإضافة إلى جملة
وهي (إذ، وإذا، وحيثُ، ومذ، ومنذ). و(إذ، وإذا، ومذ، ومنذ) أسماء زمان، و(حيث) اسم مكان غالباً. ويتجلّى أثر الإضافة هنا في ربط الأزمنة والأمكنة عبر جمل، وهو استعمال مخصوص من استعمالات الإضافة.
إذْ: تُضاف إلى الجملة الاسميّة، والجملة الفعليّة التي زمنها ماضٍ؛ قال تعالى: {واذكروا إذْ أنتم قليلٌ مستضعفون في الأرض}. فجملة (أنتم قليل) اسميّة في محلّ جرّ مضاف إليه، والمضاف اسم زمان (إذ). قال تعالى: {واذكرْ في الكتابِ مريمَ إذِ انتبذتْ من أهلها مكاناً شرقياً}. جملة (انتبذت) جملة فعليّة في محلّ جرّ مضاف إليه، والمضاف (إذْ). وتُحذَف الجملة ويُعَوَّض عنها بالتنوين الذي يُسمّى تنوين العِوَض؛ قال تعالى: {يومئذٍ تُحدّثُ أخبارَها}. والتقدير: يوم إذا زُلزلت. وحُذفت جملة (زُلزلت) وعُوّض عنها بالتنوين، ولا بدّ من دليل على الجملة المحذوفة، والدليل في الآية أول السورة: {إذا زُلزلتِ الأرضُ زلزالَها… يومئذٍ}.
إذا: تُضاف إلى الجملة الفعليّة سواء أكانت شرطيّةً أم ظرفيّة فقدت معنى الشرط، ولا تُضاف إلى الجملة الاسميّة؛ قال تعالى: {إذا جاء نصرُ اللهِ والفتحُ، ورأيتَ الناسَ يدخلون في دينِ اللهِ أفواجاً، فسبّح بحمدِ ربّك واستغفرْه إنّه كان توّاباً}. فجملة (جاء نصر الله) في محلّ جرّ بالإضافة، والمضاف اسم الشرط الظرفي (إذا).
حيث: تُضاف إلى الجملة الفعليّة والجملة الاسميّة؛ قال تعالى: {واقتلوهم حيثُ ثقفتموهم}. وتقول: سافرتُ إلى اللاذقية حيثُ الراحةُ والاستجمام. فـ(حيث) مضافة إلى الجملة الاسميّة المكوّنة من المبتدأ (الراحة)، والخبر المحذوف.
مذ ومنذ: إذا كانتا ظرفين أُضيفتا إلى الجملة الفعلية أو الاسمية؛ تقول: ما رأيتُه مذ كان عندي، ومنذ جاءني، ومنذ يومان. فقد أُضيفت (مذ) أو (منذ) في الأمثلة السابقة إلى الجملة الفعلية. وإعراب (يومان) فاعلٌ لفعل محذوف تقديره: (انقضى يومان). وقال الشاعر:
وما زلتُ أبغي الخيرَ مذ أنا يافعٌ *** وليداً وكهلاً حين شِبتُ وأمردا
فقد أُضيفت (مذ) إلى الجملة الاسميّة (أنا يافع). فإذا كانتا حرفي جرّ فبعدهما المفرد مجرور.
اكتساب المضاف من المضاف إليه التأنيث أو التذكير
مرّ هذا الموضوع في بحث الفاعل؛ فالمضاف يكتسب من المضاف إليه التذكيرَ أو التأنيث، إذا صحّ أن يقوم المضاف إليه مقام المضاف؛ قال تعالى: {ولا تُفسِدوا في الأرضِ بعد إصلاحِها وادعوه خوفاً وطمعاً إنّ رحمةَ اللهِ قريبٌ من المحسنين}. فجاء الخبر مذكّراً، والمبتدأ (رحمة٩) مؤنّث، لكن المبتدأ مضاف إلى مذكّر، فاكتسب منه التذكير؛ لأنّه يصحّ أن يقوم مقامه، فنقول: إنّ ربي قريبٌ من المحسنين.
وقال الأعشى:
وتشرقُ بالقولِ الذي قد أذعتَه *** كما شرِقتْ صدرُ القناةِ من الدمِ
فاتّصلت تاء التأنيث بالفعل (شرِق)؛ لأنّ الفاعل (صدر) اكتسب التأنيث من المضاف إليه (القناة٩)، ويمكن حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه من غير أن يتغيّر المعنى.
وقال مجنون عامر:
وما حبُّ الديارِ شغفْنَ قلبي *** ولكنْ حبُّ من سكنّ الديارا
فقد اتّصلت نونُ النسوة بالفعل (شغفن)، وهو يعود على (الحب)، لكن الحبّ اكتسب التأنيث من المضاف إليه (الديار).
وقال الأغلب العِجلي:
طولُ الليالي أسرعتْ في نقضي *** طوينَ طولي وطوينَ عرضي
حذف المضاف
يجوز حذف المضاف، فيقوم المضاف إليه مقامه، ولكن لا بدّ من قرينة تدلّ على المضاف المحذوف؛ قال تعالى: {واسألِ القريةَ التي كنّا فيها، والعيرَ التي أقبلنا فيها وإنّا لصادقون}. والتقدير: واسأل أهلَ القرية وأصحابَ العير. وقال تعالى: {وأُشربوا في قلوبِهم العجلَ بكفرِهم}. والمعنى: وأُشربوا في قلوبهم حبَّ العجل. ويُحذَف المضاف إذا سبق له ذكرٌ في الكلام؛ يقولون: ما كلُّ بيضاء شَحمةٌ ولا سوداءُ تمرةٌ، والمعنى: ولا كلُّ سوداء. وقال أبو داؤود الإيادي:
أكلَّ امرئٍ تحسبين امرأً *** ونارٍ توقّدُ بالليلِ نارا
والتقدير: وكلُّ نارٍ توقّدُ بالليل تحسبين نارا.
الفصل بين المتضايفين بمضاف آخر
الفصل بمضافٍ آخر ضعيفٌ جدّاً، ويأتي في الضرورة الشعريّة؛ قال الفرزدق:
يا مَنْ رأى عارضاً أُسَرُّ به *** بين ذراعي وجبهةِ الأسدِ
والأصل: بين ذراعي الأسد وجبهته. ولا يُقال في النثر: جاء رئيس وأساتذة الجامعة، بل الصحيح: جاء رئيسُ الجامعة وأساتذتها.
الأسئلة الشائعة
ما هي أنواع الإضافة؟
- الإضافة نوعان:
- الإضافة الحقيقية (وتسمّى أيضاً المعنوية أو المحضة): تفيد التعريف إن أُضيفت إلى معرفة، أو التخصيص إن أُضيفت إلى نكرة، وتكون على معنى أحد الأحرف: اللام (ملك/اختصاص)، من البيانية (بيان الجنس)، في (الظرفية). مثال: دارُ خالدٍ، ثوبُ حريرٍ، سيرُ الليلِ.
- الإضافة اللفظية (وتسمّى غير المحضة): غايتها التخفيف الصوتي بحذف التنوين/النون، ولا تفيد تعريفاً ولا تخصيصاً، وتكون غالباً بإضافة اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبّهة إلى معمولها. مثال: حُلَّالُ المشكلاتِ، ممزِّقُ الثوبِ، طيِّبُ القلبِ.
كيف أعرف الإضافة؟
- قرائن التعريف:
- تتابُعُ اسمين، الثاني مجرور لفظاً أو نيابةً، والأوّل خالٍ من التنوين (وفي المثنّى وجمع المذكر السالم تُحذف النون: صاحبا المدرسةِ، معلّمو المعهدِ).
- إمكانُ إعادة العلاقة بأحد الأحرف الثلاثة (اللام/من/في) يدلّ على إضافةٍ حقيقية.
- عدم دخول (أل) على المضاف في الإضافة الحقيقية، ويجوز دخولها في الإضافة اللفظية بشروط.
- عدم الفصل بين المتضايفين، إلا لضرورة شعرية نادرة.
ما هو تعريف الإضافة؟
- هي نسبةٌ بنيوية بين اسمين: الأوّل مضاف، والثاني مضافٌ إليه مجرور، تُحدث رابطاً دلالياً (ملك/اختصاص، بيان جنس، ظرفية) في الإضافة الحقيقية، أو رابطاً صوتياً صرفياً للتخفيف في الإضافة اللفظية. وأصلها في اللغة الإمالةُ والنِّسبة.
ما هي أمثلة الإضافة اللفظية والمعنوية؟
- الإضافة الحقيقية/المعنوية:
- دارُ خالدٍ (لام الملك/الاختصاص).
- خاتمُ ذهبٍ، بابُ خشبٍ (من البيانية/بيان الجنس).
- نومُ النهارِ، سيرُ الليلِ (في الظرفية).
- الإضافة اللفظية/غير المحضة:
- زارني الصديقُ الحلوُ المعشرِ.
- مررتُ برجلٍ ممزِّقِ الثوبِ.
- أنت مُقدِّرُ عملِ الخيرِ.
- هذا طيِّبُ القلبِ.
كيف أعرف المضاف في الجملة؟
- هو الاسم الأوّل من المتضايفين:
- يُعرَب بحسب موقعه في الجملة (رفع/نصب/جرّ).
- يُمنَع من التنوين في المفرد، وتُحذف نونه في المثنّى وجمع المذكر السالم.
- لا يدخل عليه (أل) في الإضافة الحقيقية، ويجوز دخولها في اللفظية وفق الشروط.
- يدلّ مع المضاف إليه على معنى اللام أو من أو في في الإضافة الحقيقية.
ما هي أسماء الإضافة؟
- يُقصد بها في الاستعمال النحوي الشائع:
- ألفاظٌ تلازم الإضافة إلى المفرد: كل، كلا، كلتا، بعض، أيّ، غير، مثل.
- ألفاظٌ تلازم الإضافة إلى الجملة: إذ، إذا، حيثُ، مذ، منذ.
- وهذه الألفاظ تُظهِر أحكام الإضافة من جرّ الثاني، ومنع التنوين في الأوّل، وغير ذلك.
ما هي شروط الإضافة؟
- في الإضافة الحقيقية:
- أن يكون المضاف والمضاف إليه اسمين.
- جرّ المضاف إليه، ومنع تنوين المضاف (وحذف نون المثنّى والجمع السالم).
- امتناع دخول (أل) على المضاف.
- إفادة معنى من معاني: اللام/من/في.
- عدم الفصل بين المتضايفين.
- في الإضافة اللفظية:
- أن يكون المضاف مشتقّاً عاملاً غالباً (اسم فاعل/اسم مفعول/صفة مشبّهة) مضافاً إلى معموله.
- لا تفيد تعريفاً ولا تخصيصاً.
- يجوز أن يُحلّى المضاف بـ(أل) إذا كان المضاف إليه مُحلّى بها، أو مضافاً إلى محلاّة، أو ضميراً عائداً على محلاّة، أو كان المضاف مثنّى/جمعاً.
ما هي أنواع المعرفة بالإضافة؟
- يصير المضاف معرفة إذا أُضيف إلى:
- ضمير: كتابي، ربُّنا.
- عَلَم: دارُ خالدٍ.
- اسمٍ مُحلّى بـ(أل): سورةُ البقرةِ.
- اسم إشارة: بابُ هذا.
- اسم موصول: وعدُ الذين آمنوا.
- مضافٍ إلى معرفة (سلسلة إضافة تنتهي بمعرفة): بابُ بيتِ الطالبِ.
ما هي أمثلة الجر بالإضافة في اللغة العربية؟
- وصلْتُ بابَ البيتِ.
- قرأتُ كتابَ الطالبِ.
- حضر معلّمو المدرسةِ، وغابَ معلّما الرياضةِ.
- استمعتُ إلى حديثِ صديقي.
- أعجبتُ بصفاتِ القائدِ الحكيمِ.
- مررتُ بأختِهِ، وتكلّمتُ مع صاحبِها.
ما هو معنى الإضافة؟
- لها معنيان اصطلاحيان:
- معنى بنيوي عام: نسبة بين اسمين على وجه التقييد، يُجرّ فيها الثاني ويُمنع تنوين الأوّل.
- معنى دلالي في الحقيقية: تدلّ على أحد المعاني الثلاثة:
- اللام: ملك/اختصاص (ثوبُ زيدٍ = ثوبٌ لزيدٍ).
- من البيانية: بيان الجنس (خاتمُ ذهبٍ = خاتمٌ من ذهبٍ).
- في الظرفية: وعاء زمان/مكان (سيرُ الليلِ = سيرٌ في الليل).
ما هي أدوات الإضافة؟
- المقصود معانيها التي تُعادِل أدوات الجر:
- اللام (للملك/الاختصاص).
- من البيانية (لبيان الجنس).
- في (للظرفية).
- كما تُعَدّ الألفاظ الملازمة للإضافة (كل، غير، مثل، …) أدوات إجرائية تُظهِر بناء الإضافة في الاستعمال.
ماذا يُحذف أثناء الإضافة؟
- في البناء الإعرابي:
- حذفُ التنوين من المضاف المفرد.
- حذفُ النون من المثنّى وجمع المذكر السالم: معلّما المدرسةِ، معلّمو المعهدِ.
- في مواضع مخصوصة:
- قد يُحذف المضاف ويُقام المضاف إليه مقامه مع قرينة: واسألِ القريةَ = أهلَ القريةِ.
- تنوين العِوَض في نحو: يومئذٍ (عوضاً عن جملة مضافة إلى إذ).
ما يلزم الإضافة إلى الجملة؟
- الألفاظ: إذ، إذا، حيثُ، مذ، منذ.
- إذ: تُضاف إلى جملة ماضية اسمية/فعلية.
- إذا: تُضاف إلى جملة فعلية (شرطية أو ظرفية).
- حيثُ: تُضاف إلى جملة فعلية أو اسمية.
- مذ/منذ: إذا كانتا ظرفين أُضيفتا إلى جملة، وإذا كانتا حرفي جر جُرّ بعدهما المفرد.
ما هو الاسم المضاف إلى ياء المتكلم؟
- هو اسمٌ لحقته ياء المتكلّم بوصفها ضميراً متصلاً في محل جرّ مضاف إليه، فيصير الاسم معرفةً بالإضافة: كتابي، قلمي، صديقي.
- أحكامه:
- يمنع تنوينه، وتُقدّر حركته الإعرابية قبل الياء لاشتغال المحلّ بحركة المناسبة: جاء صديقي (مرفوع بضمة مقدّرة)، رأيتُ صديقي (منصوب بفتحة مقدّرة)، مررتُ بصديقي (مجرور بكسرة مقدّرة).
ما هو الفرق بين الإضافة المحضة وغير المحضة؟
- الإضافة المحضة (الحقيقية/المعنوية):
- تفيد التعريف أو التخصيص.
- لا يدخل (أل) على المضاف.
- تدلّ على معنى اللام/من/في.
- تغيّر حكم التعريف للمضاف تبعاً للمضاف إليه.
- الإضافة غير المحضة (اللفظية):
- لا تفيد تعريفاً ولا تخصيصاً، غايتها التخفيف.
- يجوز دخول (أل) على المضاف بشروط.
- تكون غالباً مع مشتقات عاملة (اسم فاعل/مفعول/صفة مشبّهة) مضافة إلى معمولها.
- لا يكتسب المضاف تعريفاً من المضاف إليه.