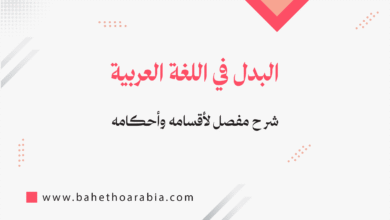الأسماء الفرعية وأنواعها في اللغة العربية: دراسة شاملة

تتناول هذه المقالة الأسماء الفرعية بوصفها إطاراً وصفياً صارماً يربط البنية الصرفية بالأداء الإعرابي عند دراسة الاسم من جهة آخره. وتُوظّف الأسماء الفرعية هنا باعتبارها مفهوماً جامعاً يُبيّن كيف يغيّر موقع الحرف الأخير—صحيحاً كان أو معتلّاً أو مهموزاً أو محذوفاً—وجه الإعراب وسلوك العلامات. ومن ثمّ تُقرأ الأسماء الفرعية قراءة منهجية تستند إلى التعريف الدقيق، والتمييز بين الأصول والفروع، والتقعيد الذي يراعي القياس والاستعمال معاً. ويقوم بناء العرض على تحليل أقسام الاسم، بما يجلّي أن الأسماء الفرعية ليست تسميةً تجميعية، بل أداة إجرائية تكشف انتظام الظواهر وتُقاربها في إطارٍ معيارِي واحد.
ينحصر نطاق الدراسة في ستة أقسام وُضعت لتصنيف الأسماء الفرعية بحسب لفظ الآخر: الصحيح، وشبه الصحيح، والمنقوص، والمقصور، والممدود، والمحذوف الآخر. وتعرض المقالة لكل قسمٍ تعريفاً محكماً، وتُبرز خصائصه الصوتية والصرفية والدلالية، وتبيّن انعكاسها الإعرابي بضبط مواضع التقدير وظهور العلامات، وبتعليل أحكام الهمزة والألف والياء والواو والحذف والتعويض. ويُستثمر مفهوم الأسماء الفرعية لتقديم أمثلة معيارية تُظهر الفروق بين الأقسام، وتعين الطالب والباحث على تقويم اللفظ، واستنباط الحكم، ومضاهاة القياس بالسماع، بما يرسّخ قيمة الأسماء الفرعية في تنظيم المعرفة النحوية والصرفية وتيسير تعليمها وتطبيقها.
تمهيد حول الأسماء الفرعية
في الصناعة النحوية يُعدّ الأصل في الاسم أن يأتي مفرداً، مذكّراً، نكرةً، غير مُصغَّرٍ، وغير منسوب. فإذا لحقه التأنيث، أو التثنية، أو الجمع، أو التصغير، أو النسبة عُدّ خارجاً عن أصله وصار فرعاً. وهذه الصور تُسمّى في اصطلاح النحاة الأسماء الفرعية؛ فكل خروجٍ عن الأصل المذكور يُدرَج في باب الأسماء الفرعية من جهة البنية والدلالة. وبذلك تُدرَس الأسماء الفرعية في مقابلة الأسماء الأصلية بوصفها ظواهر صرفية ونحوية محدَّدة، ويجري تناول الأسماء الفرعية ضمن إطارٍ منهجي يميّز بين الأصل والفرع.
أقسام الاسم بحسب لفظ آخره ضمن الأسماء الفرعية
ينقسم الاسم، من حيث لفظ آخره، إلى ستة أقسام: الصحيح، وشبه الصحيح، والمنقوص، والمقصور، والممدود، والمحذوف الآخر. وسيُعرَّف كل قسم تعريفاً مضبوطاً، مع إيراد ما يتصل به من أحكام موجزة ضمن مبحث الأسماء الفرعية، بحيث يخدم تحليل الأسماء الفرعية ويستوفي مقاصد هذا الباب.
١ – الصحيح من الأسماء الفرعية
الصحيح: هو الاسم المعرب الذي لا ينتهي بحرف علّة، ولا بهمزةٍ تعقب ألفاً زائدة، نحو: جبل، نهر، بيت، جدال، امرؤ، داء، ماء، شيء، ضوء، غرفة، فتاة، غالية. ويمثّل هذا القسم أساساً في تصنيف الأسماء الفرعية من جهة سلامة الآخر؛ ولذلك يُعتمَد عليه عند استقراء ظواهر الإعراب ضمن الأسماء الفرعية بما يطابق أحكام هذا الباب.
٢ – شبه الصحيح من الأسماء الفرعية
شبه الصحيح: هو الاسم المعرب الذي آخره واو أو ياء قبلها سكون، نحو: دلو، لهو، شأو، بهو، جِرو، جوٌّ، عدوٌّ، علُوٌّ، مهجوٌّ، ثدي، هَدْي، عليٌّ، غنيٌّ، رضيٌّ، أميٌّ، كرسيٌّ. وسُمّي بهذا الاسم لظهور العلامات الإعرابية على آخره كظهورها في الصحيح. ويُدرَس هذا النوع داخل منظومة الأسماء الفرعية بوصفه حالة صوتية مخصوصة؛ إذ يبرز أثر السكون السابق للواو أو الياء في تحديد الإعراب وفق قواعد الأسماء الفرعية، ويُسهم ذلك في ترسيخ ضوابط الأسماء الفرعية.
٣ – المنقوص من الأسماء الفرعية
المنقوص: هو الاسم المعرب الذي ياؤه مفردة، قبلها كسرة، نحو: الساعي، الداعي، المحامي، المتعدُّي. وسُمّي منقوصاً لأن بعض الحركات لا تظهر على آخره للثقل، كالضمة والكسرة. ويُعالَج هذا القسم في إطار الأسماء الفرعية لخصوصية الياء في حالتي الرفع والجر؛ إذ يُقدَّر الإعراب منعاً للثقل، فيغدو مثالاً بارزاً داخل الأسماء الفرعية، ويرتبط استعماله بتصرّف الأواخر في منظومة الأسماء الفرعية.
٤ – المقصور من الأسماء الفرعية
المقصور: هو الاسم المعرب الذي آخره ألفٌ لازمة، نحو: فتى، هدى، لِحىً، هَوى، عصا، رضا، سلمى، مبنى، مصطفى، مستشفى. وسُمّي مقصوراً لأن حركات الإعراب تتعذّر على الألف فلا تظهر. ويُبحَث هذا القسم ضمن الأسماء الفرعية لأن الألف اللازمة تحجب العلامات، مما يجعله بنيةً محورية في الأسماء الفرعية ويكشف الصلة الوثيقة بين الصرف والإعراب في سياق الأسماء الفرعية.
والألف في آخره قد تكون:
- أصليةً منقلبةً عن واوٍ أو ياء، نحو: عِدا، عُلا، شذا، منتهى، مرتضى.
- زائدةً للإلحاق، نحو: أرطى، مِعْزَى.
- زائدةً للتأنيث، نحو: حُبْلى، سكرى، فُضلى.
- زائدةً للتأنيث والجمع، نحو: صحاري، عذارى، سكارى.
- زائدةً للتكثير، نحو: كُمّثْرى.
وتُظهِر هذه الأنماط صيغ الألف في المقصور ضمن الأسماء الفرعية وتطبيقاتها العملية في الأسماء الفرعية.
٥ – الممدود من الأسماء الفرعية
الممدود: هو الاسم المعرب الذي آخره همزةٌ بعد ألفٍ زائدة، نحو: بناء، رداء، سماء، سوداء، أنبياء. وسُمّي ممدوداً لأن الألف تتلوها همزةٌ تمكّن المد. وقد تكون الهمزة: أصلية، نحو: هناء، ضياء، إنشاء؛ أو مبدلةً من ألفٍ أصلها واوٌ أو ياء، نحو: سماء، دعاء، لقاء؛ أو زائدةً للإلحاق، نحو: حرباء، علباء؛ أو مبدلةً من ألفٍ زائدةٍ للتأنيث، نحو: حمراء، صفراء، حمقاء؛ أو زائدةً للتأنيث والجمع، نحو: جبناء، أقرباء، أسماء. ويُعَدّ هذا القسم ركناً رئيساً في دراسة الأسماء الفرعية بسبب تغاير أحكام الهمزة؛ إذ تُعالَج أنماطه تصريفياً ضمن مباحث الأسماء الفرعية، وتتضح أمثلته في الأسماء الفرعية تبعاً لأصل الهمزة أو زيادتها.
٦ – المحذوف الآخر من الأسماء الفرعية
المحذوف الآخر: هو الاسم المعرب الذي حُذف من آخره حرفٌ أو أكثر على غير قياس، وقد يُعوَّض عن المحذوف بحرفٍ آخر، نحو: اسم، ابن، ابنة، سنة، شفة، لغة، مئة، رئة، فئة، شاة. وقد يُترك بلا تعويض، نحو: أب، أخ، حم، فم، يد، دم، غد. ويُبحَث هذا الباب في سياق الأسماء الفرعية لمخالفته القياس في صورة الآخر؛ فالتعويضُ وعدمه ظاهرتان موصوفتان ضمن الأسماء الفرعية، وتدل أمثلته على مرونة البنية الصرفية في إطار الأسماء الفرعية.
خاتمة حول الأسماء الفرعية
تُقدّم الأقسام الستة المتقدمة إطاراً وصفياً محكماً لتحليل صيغ الاسم من جهة آخره ضمن مبحث الأسماء الفرعية، وتأتي التعاريف والأمثلة متسقة مع ما تقرّره الأسماء الفرعية في بابي الصرف والإعراب. وتُظهر المعالجة أن الأسماء الفرعية ليست مجرّد تسمية، بل منهج عمل يضبط الظواهر وييسّر تصنيف المفردات ويصل بين القياس والاستعمال عند تناول الأسماء الفرعية. ومن ثمّ تظل الأسماء الفرعية مرجعاً عملياً للطالب والباحث، وتبقى الأسماء الفرعية مدخلاً تطبيقياً نافذاً لتأطير الظواهر وتفسيرها.
الخاتمة
أظهرت المعالجة أن تصنيف الأسماء الفرعية بحسب لفظ الآخر يوفّر طريقاً عملياً لفهم علاقة الصرف بالإعراب؛ إذ تكشف الأسماء الفرعية عن أثر بنية الآخر في ضبط العلامات بين الظهور والتقدير، وعن علل الهمزة والألف والياء والواو، وعن مواضع الحذف والتعويض. وقد برهنت الأقسام الستة على أن الأسماء الفرعية بنيةٌ تفسيرية تجمع بين الدقة الوصفية والكفاية الإجرائية؛ فهي تمكّن من تفكيك الظاهرة، وتحديد القاعدة، وتعيين الاستثناء، وإسناد الحكم إلى أصله الصوتي أو الصرفي أو القياسي.
وبذلك تتجاوز الأسماء الفرعية حدود التقسيم التعليمي إلى وظيفة منهجية تُنظّم المفردات وتردّ الاستخدام إلى أصوله، وتوفّر للمتعلمين والباحثين أداةً موحّدة للاختبار والمقارنة والتقويم. إن الإطار الذي تقدّمه الأسماء الفرعية يعزّز القراءة التحليلية للنصوص، ويقوّي القدرة على الاستدلال الإعرابي، ويُسهِم في بناء كفاياتٍ تطبيقية في الدرس اللغوي والبحث المصطلحي، بما يرسّخ مكانة الأسماء الفرعية مرجعاً موثوقاً ورافعةً للتعلم والبحث معاً.
الأسئلة الشائعة
١ – ما المقصود بمصطلح الأسماء الفرعية، وما علاقته بالأصل في الاسم؟
الأسماء الفرعية اصطلاح نحوي-صرفي يُطلق على كل اسم خرج عن أصلٍ مقرّر في الصناعة النحوية؛ إذ الأصل في الاسم أن يكون مفرداً، مذكّراً، نكرة، غير مُصغَّر، وغير منسوب. فإذا دخل الاسم باب التأنيث أو التثنية أو الجمع أو التصغير أو النسبة، أو طرأ على آخره تغيّرٌ صوتي/صرفي (كالألف أو الياء أو الواو أو الهمزة أو الحذف)، انتقل إلى دائرة الأسماء الفرعية.
بهذه الرؤية، تعمل الأسماء الفرعية إطاراً تفسيرياً يربط البنية الصرفية بالسلوك الإعرابي؛ فالتحوّل في آخر الاسم يؤثّر في ظهور العلامات أو تقديرها، وفي إمكان التنوين أو منعه، وفي أحكام الرسم والضبط.
وتقوم الأسماء الفرعية على مبدأ مقابلة الفرع بالأصل، فتُعرِّف الظاهرة بوصفها خروجاً مضبوطاً لا شذوذاً عشوائياً؛ ومن ثمّ تُوظَّف الأسماء الفرعية في التحليل التطبيقي للنصوص، وفي تعليم القواعد بصورةٍ تُظهر علاقة الصرف بالإعراب وتُيسّر تصنيف الأسماء بحسب خصائص آخرها.
هكذا تغدو الأسماء الفرعية أداةً منهجية لالتقاط الفروق الدقيقة التي لا يلحظها التقسيم العام للأسماء، وتمنح الدارس معياراً عملياً يوازن بين القياس والسماع عند الحكم على بنية الاسم.
٢ – كيف تُقسَّم الأسماء الفرعية بحسب لفظ الآخر، وما المعايير الفارقة بين الأقسام الستة؟
تقسّم الأسماء الفرعية من جهة آخرها إلى ستة أقسام: الصحيح، وشبه الصحيح، والمنقوص، والمقصور، والممدود، والمحذوف الآخر. معيار الصحيح في الأسماء الفرعية أن ينتهي بغير حرف علّة وألا تقع همزةٌ بعد ألفٍ زائدة؛ فتظهر العلامات على آخره بلا عائق. أمّا شبه الصحيح في الأسماء الفرعية فآخره واو أو ياء قبلها سكون، كدلو وكرسيّ، وتظهر العلامات عليه كالصحّيح لسلامة الموقع الصوتي.
والمنقوص في الأسماء الفرعية ما كانت ياؤه مفردة قبلها كسرة، كالساعي والداعي، فتُقدَّر الضمة والكسرة للثقل وتظهر الفتحة. والمقصور في الأسماء الفرعية ما آخره ألف لازمة، كفتى وعصا، فتُقدَّر الحركات لتعذّرها على الألف، وتُكتب تنوين الفتح بلا ألف زائدة. والممدود في الأسماء الفرعية ما آخره همزة بعد ألف زائدة، كبناء وسماء، وتختلف أحكامه باختلاف نوع الهمزة (أصلية، منقلبة، مزيدة، همزة تأنيث).
وأخيراً المحذوف الآخر في الأسماء الفرعية ما حُذف من آخره حرف أو أكثر على غير قياس، مع التعويض أو بدونه، كاسم وابن وأب. يوفّر هذا التصنيف في الأسماء الفرعية خريطة تشغيلية دقيقة لربط الصوتي بالصرفي بالإعرابي.
٣ – ما الفروق العملية بين الصحيح وشبه الصحيح من حيث الإعراب والضبط؟
كلاهما في الأسماء الفرعية يظهر عليه الإعراب ظاهراً، لكن مناط الفرق صوتيٌّ صرفي. في الصحيح من الأسماء الفرعية ينتهي الاسم بحرفٍ صحيح لا علّة فيه، فتجري علامات الإعراب على الحرف الأخير مباشرة: رفعاً بالضمة، نصباً بالفتحة، جرّاً بالكسرة، مع انتظام التنوين.
في شبه الصحيح من الأسماء الفرعية ينتهي الاسم بواوٍ أو ياء ساكنة مسبوقتين بسكون، فيُراعى ثقل الساكنين في الضبط الإملائي والصوتي دون أن يحجب ذلك العلامات؛ فتقول: هذا عدوٌّ، رأيتُ عدوّاً، مررتُ بعدوٍّ؛ وهذا عليٌّ، رأيتُ عليّاً، مررتُ بعليٍّ.
بهذا يظلّ شبه الصحيح في الأسماء الفرعية أقرب الأقسام إلى الصحيح أداءً إعرابياً، غير أنّ التضعيف أو اجتماع السواكن يقتضي عناية بالضبط الصوتي. والأثر التعليمي هنا أن الأسماء الفرعية في هذا الباب تُمرّن الدارس على تمييز الظاهرة الصوتية من دون الخلط بينها وبين أحكام تقدير العلامات في المقصور والمنقوص، ما يعمّق فهمه لعمل الأسماء الفرعية بوصفه منظومة متكاملة.
٤ – ما أحكام المنقوص في حالتي التعريف والتنكير، وما أثر ذلك على التنوين والوقف؟
المنقوص في الأسماء الفرعية آخره ياءٌ مفردة قبلها كسرة، فتثقُل عليه الضمة والكسرة. عند التعريف بأل أو بالإضافة تثبت الياء ويُقدَّر الرفع والجرّ: جاء الداعِيُ، مررتُ بالداعِيِ؛ وتظهر الفتحة نصباً: رأيتُ الداعِيَ.
أمّا مع التنكير في الأسماء الفرعية فالياء تُحذف لفظاً وخطّاً رفعاً وجرّاً ويُعوَّض عنها بتنوين كسر: جاء داعٍ، مررتُ بداعٍ؛ وتثبت الياء في النصب: رأيتُ داعياً. وفي الوقف، يُراعى في الأسماء الفرعية أنّ المنقوص يُوقف عليه بالياء: هذا قاضيْ، مع سكون الياء.
ويُلحق بذلك باب الجمع: جمع المنقوص السالم (قاضون/قاضين) يُحافظ على قاعدة تقدير الحركات على الياء في حالات التعريف، ويجري حذفها أو إثباتها بحسب التنكير ونوع العلامة. هذه القواعد تُظهر كيف تُنظّم الأسماء الفرعية العلاقة بين الخفّة والثقل في الطرف، وتدلّ على أن تقدير العلامات ليس تعسّفاً بل استجابة لصوتيات البنية في الأسماء الفرعية، وهو ما يجعل المنقوص نموذجاً بليغاً في التدريب الإعرابي.
٥ – ما أحكام المقصور من جهة الإعراب والرسم، وكيف يُعامل في التثنية والجمع والنسبة والتصغير؟
المقصور في الأسماء الفرعية ما آخره ألف لازمة، فلا تظهر الحركات عليه لتعذّرها؛ فتُقدّر الضمة والكسرة والفتحة، ويُنَوَّن تنوين الفتح بلا زيادة ألف بعد الألف المقصورة: فَتًى، هُدًى. في الرسم تُكتب علامة تنوين الفتح على الحرف السابق مع بقاء الألف المقصورة دون زيادة.
في التثنية ضمن الأسماء الفرعية تُقلب الألف ياءً: فَتَيان/فَتَيين، عَصَوان/عَصَوَين بحسب أصل الألف؛ فإن كانت منقلبة عن واو جاز الواوان، وإن كانت عن ياء غلّبت الياء.
وفي الجمع السالم للمذكر تُقلب الألف ياءً: مصطفى → مصطفَون/مصطفَين. وفي النسبة داخل الأسماء الفرعية تُردّ الألف إلى أصلها على الأغلب مع ياء النسب المشددة: فَتًى → فَتَوِيّ أو فِتْيَوِيّ بحسب المذهب الإملائي، صحراء (ليست مقصوراً لكن قياساً) → صحراويّ. وفي التصغير يُردّ المقصور إلى بناء فُعَيِّل مع قلبٍ يناسب الأصل: عَصا → عُصَيَّة، فَتًى → فُتَيّ.
تكشف هذه العمليات أن الأسماء الفرعية تضبط انتقالات البنية عبر المراحل الاشتقاقية، وأن المقصور محورٌ يُظهر تلازم الصوتي بالصرفي في الحكم.
٦ – ما أنواع همزة الممدود، وما أثرها على الصرف ومنع الصرف والنسبة؟
الممدود في الأسماء الفرعية ما آخره همزة بعد ألف زائدة، وتتنوع همزته: ١) همزة أصلية: هَنَاء، ضِياء؛ ٢) همزة مبدلة من ألف أصلها واو/ياء: سماء، لقاء؛ ٣) همزة زائدة للإلحاق: حرباء؛ ٤) همزة تأنيث ممدودة: حمراء، صحراء؛ ٥) همزة زائدة للتأنيث مع الجمع: جبناء، أقرباء. الأثر الصرفي في الأسماء الفرعية يتبدّى في ثلاثة مواضع:
- الإعراب: تجري العلامات ظاهرة على الهمزة: هذا بِنَاءٌ، رأيتُ بِنَاءً، مررتُ ببِنَاءٍ.
- منع الصرف: إذا كانت الهمزة همزة تأنيث ممدودة في صفة على فَعْلاء (حمراء) أو اسم مؤنث على هذا البناء (صحراء)، مُنِع من الصرف فامتنع التنوين وجُرَّ بالفتحة نكرةً: مررتُ بصحراءَ، ويُجرّ بالكسرة مع أل أو الإضافة: بالصحراءِ.
- النسبة: في الأسماء الفرعية يختلف مسلك النسبة باختلاف الهمزة؛ فذو همزة التأنيث الممدودة يُنسب إليه بردّ الصفة إلى مذكّرها إن وُجد: حمراء → أحمر → أحمريّ، أو بإبقاء الصيغة مع زوائد: صحراويّ. أمّا إذا كانت الهمزة أصلية أو للإلحاق فلا يمنع ذلك من النسبة المباشرة: بناء → بنائيّ، ضياء → ضيائيّ. هذه الفروق توضح كيف تعالج الأسماء الفرعية أحكام الهمزة تصريفياً وإعرابياً.
٧ – ما المقصود بالمحذوف الآخر، وما ضوابط الحذف والتعويض إملائياً وصرفياً؟
المحذوف الآخر في الأسماء الفرعية ما حُذف من آخره حرف أو أكثر على غير قياس، وقد يُعوّض عنه أو لا. من أمثلته مع التعويض: اسم (أصلها سِمْوٌ)، ابن، ابنة، سنة، شفة، مئة (أصلها مائة)، رئة، فئة، شاة؛ وبدون تعويض: أب، أخ، حم، فم، يد، دم، غد. تُعنى الأسماء الفرعية هنا ببيان أثر الحذف في الإعراب والرسم:
- الإعراب: تجري العلامات على الصورة الباقية: جاء أبٌ، رأيتُ أباً، مررتُ بأبٍ، وتستقيم في الإضافة: أبو، أبي، أبا ضمن الأسماء الخمسة بشروطها.
- الرسم: تُحذف همزة الوصل كتابةً في ابن/ابنة إذا وقعت بين علمين ثانيهما والد الأول، ولم تقع في أول السطر، ولم تُفصل بفاصل: عمرُ بنُ الخطاب. وتُكتب الهمزة إذا اختلّ شرط.
- الجمع: تُظهر الأسماء الفرعية كيف يعاد بناء الصيغة عند الجمع: اسم → أسماء، ابن → أبناء، سنة → سنوات/سنون، بحسب القياس والسماع.
يتكشّف من ذلك أن الأسماء الفرعية ترصد مرونة البنية العربية بين الحذف والتعويض، وتربط الإملائي بالصرفي لضبط الرسم مع السلامة الإعرابية.
٨ – كيف نتعامل مع التنوين في الأسماء الفرعية بين الظهور والتقدير والعِوَض؟
التنوين علامة صرفية وإعرابية تتأثر ببنية الطرف؛ ففي الصحيح وشبه الصحيح من الأسماء الفرعية يظهر التنوين بأنواعه الثلاثة من غير عائق. في المنقوص من الأسماء الفرعية يُحذف آخره (الياء) رفعاً وجرّاً في النكرة ويُعوَّض عنها بتنوين كسر: داعٍ، قاضٍ؛ ويثبت في النصب: داعياً.
في المقصور من الأسماء الفرعية يُنوّن تنوين فتح دون زيادة ألف بعد الألف المقصورة: فَتًى، هُدًى. في الممدود من الأسماء الفرعية يظهر التنوين على الهمزة إن لم يمنع صرفُ الصيغة: بناءٌ/بناءً/بناءٍ؛ أمّا ما كانت همزته للتأنيث الممدود فيُمنَع من الصرف فلا تنوين فيه: صحراءُ (مرفوعة بلا تنوين)، مررتُ بصحراءَ (مجرورة نكرة بالفتحة).
في المحذوف الآخر من الأسماء الفرعية يُراعى ما آل إليه اللفظ: أبٌ، أخٌ، دمٌ، على القياس. يبيّن هذا أن الأسماء الفرعية تضبط التنوين في ثلاثة مسالك: ظهورٌ، تقديرٌ، أو عِوَض، تبعاً لطبيعة الطرف، وهو ما يقدّم للدارس معياراً تشغيلياً دقيقاً عند الضبط.
٩ – ما أثر الأصول الصوتية للألف والواو والياء في المقصور والمنقوص عند الاشتقاق والنسبة؟
تُظهر الأسماء الفرعية اعتماد الحكم على أصل الحركة والحرف. في المقصور من الأسماء الفرعية تُعاد الألف إلى أصلها (واو/ياء) عند التثنية والجمع والنسبة والتصغير بحسب ما يقتضيه القياس:
فتى (أصلها فَتَيٌ) → فَتَيان/فَتَيين، فُتَيّ (تصغير)، فَتَوِيّ/فِتْيَوِيّ (نسبة).
عصا (أصلها عصوٌ) → عَصَوَان/عَصَوَيْن، عُصَيَّة (تصغير)، عَصَوِيّ (نسبة).
في المنقوص من الأسماء الفرعية، للياء أثرٌ مباشر في تقدير الحركات رفعاً وجرّاً، ويظهر أصلها عند الاشتقاق: الساعي → سَعْيٌ (مصدر)، سَعَوِيّ/سَعْوِيّ غير قياسي؛ ويُرجّح في النسبة إبقاء الياء: قاضي → قَضائيّ.
هذه القواعد تعلّمنا أن الأسماء الفرعية ليست تصنيفاً شكلياً فحسب، بل هي قراءة لأصول الأصوات في الصيغة، وأن استحضار الأصل (الواو/الياء) يمكّن من اختيار البناء القياسي الصحيح في جميع أبواب الاشتقاق.
١٠ – ما المنهج العملي لتشخيص القسم المناسب لأي اسم جديد ضمن الأسماء الفرعية؟
يقوم التشخيص في الأسماء الفرعية على خطوات مرتّبة:
- فحص الطرف: هل ينتهي بحرف علّة؟ بهمزة بعد ألف زائدة؟ بياء قبلها كسرة؟ بواو/ياء قبلها سكون؟ بحذفٍ ظاهر؟
- تطبيق القاعدة:
• إذا خلا من علّة وهمزة بعد ألف زائدة فهو صحيح ضمن الأسماء الفرعية.
• إذا كان آخره واواً/ياءً مسبوقاً بسكون فهو شبه صحيح في الأسماء الفرعية.
• إذا كانت ياؤه مفردة قبلها كسرة فهو منقوص في الأسماء الفرعية.
• إذا كان آخره ألفاً لازمة فهو مقصور في الأسماء الفرعية.
• إذا كان آخره همزة بعد ألف زائدة فهو ممدود في الأسماء الفرعية.
• إذا ظهر حذفٌ في الآخر على غير قياس فهو محذوف الآخر في الأسماء الفرعية. - اختبار الإعراب: هل العلامة ظاهرة، مُقدَّرة، أو مجراة على العِوَض؟
- الاختبار التطبيقي: جرّب التثنية، الجمع، التنوين، والنسبة؛ فإن استقامت وفق أحكام الأسماء الفرعية في الباب المختار فالتشخيص سليم.
هذا المنهج الإجرائي يجعل الأسماء الفرعية أداة فحصٍ موثوقة، ويُكسب الدارس قدرةً على استنباط الحكم من البنية، وعلى تصويب الضبط والرسم معاً، بما يرسّخ الكفاية التحليلية في معالجة نصوص العربية.