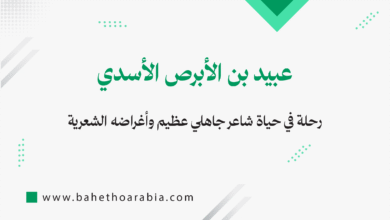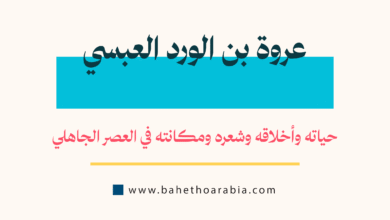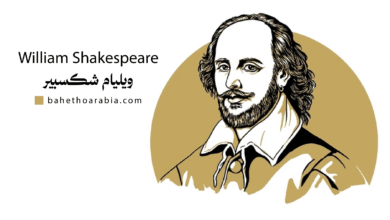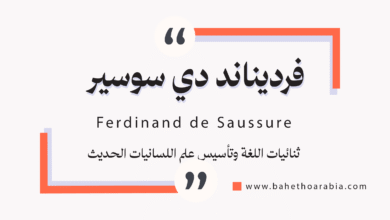عمرو بن كلثوم: حياته وشعره ومعلقته، دراسة شاملة
دراسة شاملة في سيرة الشاعر الجاهلي وخصائصه الفنية
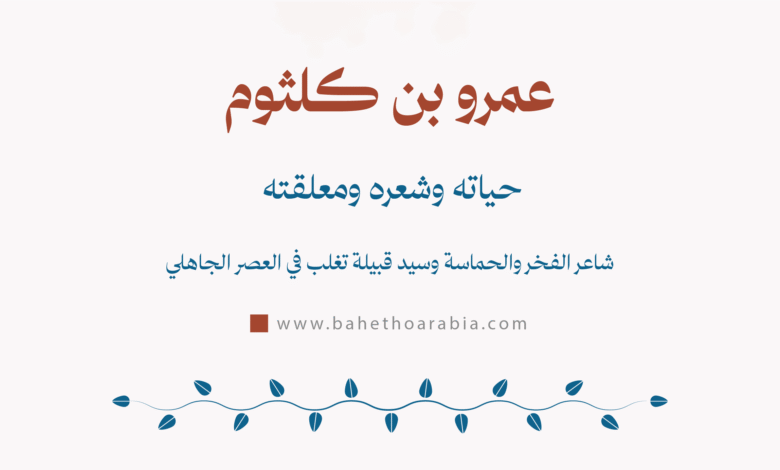
يعد عمرو بن كلثوم من أبرز شعراء العصر الجاهلي الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الأدب العربي من خلال معلقته الشهيرة التي جسدت روح الفخر والاعتزاز القبلي. وقد جمع هذا الشاعر بين الشجاعة والفروسية والقدرة على صياغة الشعر بأسلوب متدفق يحمل طابعاً حماسياً مميزاً.
المقدمة
تمثل شخصية عمرو بن كلثوم نموذجاً فريداً للشاعر الفارس في العصر الجاهلي، فقد عاش بين عامي ٥١٢م أو ٥١٤م حتى ٦١٠م أو ٦١٢م، وترك إرثاً أدبياً خالداً يتمثل في معلقته التي عدها النقاد من أجود المعلقات السبع. وقد اجتمعت في شخصيته صفات القيادة والشجاعة والموهبة الشعرية، مما جعله محط أنظار المؤرخين والأدباء على مر العصور، حيث سجل في شعره تاريخ قبيلته وحروبها وانتصاراتها بأسلوب يجمع بين القوة والتدفق العاطفي.
نسب عمرو بن كلثوم وانتماؤه القبلي
ينتمي عمرو بن كلثوم من ناحيتي أبيه وأمه إلى تغلب إحدى قبائل ربيعة وأخت قبيلتي بكر وعنز، وهذه القبيلة الكبيرة كانت تقطن الجزيرة الفراتية في شمالي الشام والعراق. وتفرض سلطانها على بقاع شاسعة تكتنف ضفتي الفرات، وحسبها منعة أن العرب قالت فيها: «لو أبطأ الإسلام قليلاً لأكلت تغلب الناس». وقد كان هذا الانتماء القبلي العريق مصدر فخر واعتزاز للشاعر، وشكّل المحور الرئيس لمعظم أشعاره وقصائده.
ذكر ابن سلام نسبه مفصلاً، فقال: «هو عمرو بن كلثوم بن مالك بن عتاب… بن تغلب». وذكر صاحب الأغاني نسب أمّه، فقال: «وأم عمرو بن كلثوم ليلى بنت مهلهل أخي كليب». وهذا النسب الشريف من جهة الأم يضاف إلى نسبه الشريف من جهة الأب، مما جعل عمرو بن كلثوم يحمل في عروقه دماء أعرق البيوتات العربية في الشجاعة والكرم والمجد.
عمره المديد وسيادته المبكرة
وبالغ المؤرخون في وصفه بالسيادة المبكرة والعمر المديد فزعموا أنه ساد وهو ابن خمسة عشر ومات وله مائة وخمسون سنة. غير أن أستاذنا الدكتور عمر فروخ شك في صحة هذا القول، فقال: «ولد عمرو بن كلثوم في مطلع القرن السادس للميلاد، وساد قومه صغيراً – زعموا ابن خمس عشرة سنة – وكان فارساً شجاعاً ذا حمية معجباً بنفسه … ولعلّه أوفى على المائة، ثم مات قبل انتهاء القرن السادس للميلاد».
ونقل صاحب الأغاني عن الرواة أنه كان لعمرو أخ يقال له مرة بن كلثوم، فقتل المنذر بن النعمان وأخاه كما ذكر أنه كان له ابن يقال له عباد، وهو قاتل بشر بن عمرو بن عدس. وذكر غيره أنه كان له ثلاثة أبناء، وأنه كان يكنى بأبي الأسود، وبأبي عمير، وبأبي عبّاد، مما يدل على كثرة ذريته وامتداد نسله في قبيلة تغلب.
حروب عمرو بن كلثوم وانتصاراته
أهم ما في حياة ابن كلثوم الحروب التي هزم فيها الغساسنة مرة والمناذرة أخرى. وأبرز ما في خلقه العزّة التي بلغت عنده وعند أمه الغاية، وجعلته من أرباب الفخر في العصر الجاهلي. وقد شكلت هذه الحروب المحطات الرئيسة في حياته، وكانت مادة دسمة لشعره الحماسي الذي يفيض بالفخر والاعتزاز بالانتصارات.
تتلخص حروبه مع الغساسنة والمناذرة في الأحداث التالية:
- الحرب مع الغساسنة: أن الحارث بن أبي شمر الغساني زار شطر تغلب، فلم يخفوا لاستقباله وتكريمه، فكاد يتميز من الغيظ، فظهرت تغلب وفتكت بغسان وقتلت أخا الحارث، وعدداً من فرسان غسان فشمت عمرو بن كلثوم بخصمه قائلاً: “هلّا عطفتَ عَلى أَخِيكَ إذا دعا بالثّكل ويلَ أبيكَ يا بنَ أبي شَمِرْ”
- الحرب مع المناذرة: لعل ظهور تغلب على غسان أقلق المناذرة، فأرسل أمير الحيرة أبو قابوس بن المنذر جيشاً يقوده ولده المنذر ليقهر تغلب في جزيرتها، فظهرت تغلب كرة أخرى وقتل مرة بن كلثوم أخو الشاعر قائد المناذرة المنذر بن النعمان
- النتيجة: علا شأن تغلب وطغت وبغت على الناس بعد هذه الانتصارات المتتالية على الغساسنة والمناذرة، مما رفع من مكانة عمرو بن كلثوم وقبيلته في الجزيرة العربية
هزيمة عمرو بن كلثوم ووقوعه في الأسر
غير أن حياة عمرو بن كلثوم لم تكن انتصارات متتابعة، فقد غلبه – وهو مزهو بنفسه بعد غزاة مظفرة – من كان دون الغساسنة والمناذرة. وخلاصة الخبر أن عمرو بن كلثوم أغار على بني تميم في البحرين وعلى بعض قيس بن ثعلبة، فغنم وأسر وسبى وأطغاه النصر فعطف على اليمامة ليغير على بني حنيفة. فنهد له بنو سحيم، يقودهم يزيد بن عمرو بن شمر، وكان شديداً جسيماً، أيداً، فحمل على عمرو بن كلثوم حملة صادقة، فألقاه عن فرسه وأسره وقيده.
ثم قال يزيد: أنت الذي تقول: “متى تعقد قَرِينَتَنا بِحَبْل نجذّ الحَبْلَ أَو تقِص القرينا”، أما إني سأقرنك إلى ناقتي هذه، فأطرد كما جميعاً. فعز على عمرو بن كلثوم أن يحقر ويهان، فصاح: يالربيعة أَمْثُلَه!!؟ فاجتمع قوم يزيد، فنهوه، ولم يكن يريد ذلك. وقد كانت هذه الهزيمة نقطة تحول في حياة الشاعر، حيث كسرت من غروره وعجرفته، وجعلته يعيد النظر في تصرفاته وأفعاله.
مقتل عمرو بن هند والعزة التي بلغت الغاية
وأما عزّته فقد حملته على قتل أمير الحيرة عمرو بن هند وقصته مشهورة خلاصتها: أن عمرو بن هند قال ذات يوم لندمائه: هل تعلمون أحداً من العرب تأنف أمه من خدمة أمي؟ فقالوا: نعم أم عمرو بن كلثوم. قال: ولم؟ قالوا: لأن أباها مهلهل بن ربيعة وعمّها كليب وائل أعزّ العرب، وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب، وابنها عمرو وهو سيد قومه. فدعا ابن هند ابن كلثوم وأمه، وجعل خيمة النساء قرب خيمة الرجال، وأمر أمه أن تستخدم ليلى أم عمرو بن كلثوم فرفضت.
ليلى وردت على أم ابن هند ردّها المشهور “لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها” وصاحت “واذلاه يا لتغلب” فوثب ابن كلثوم إلى سيف معلق بخيمة ابن هند، وقطع رأسه، ثم أمر بني تغلب، فانتهبوا ما في الرواق، وساقوا نجائبه. وهذه الحادثة تعكس مدى العزة والأنفة التي تميز بها عمرو بن كلثوم وأمه، وكيف أنهما لم يقبلا الذل والهوان حتى لو كان ثمن ذلك حياة ملك من ملوك العرب.
وصية عمرو بن كلثوم لأبنائه
من الأخبار التي لخصناها تبين لنا أن أهم ما في حياة الشاعر الفخر والحماسة. ولذلك شقّ عليه أن يأسره يزيد بن عمرو الحنفي، وأن يتلعب به ويزدريه، فأكبّ على الخمر يغرق فيها غيظه حتى أغرقته، إذ ظل يعب الخمر صرفاً إلى أن مات، فهو أحد الأشراف الذين قتلتهم الخمر. ونحن نظن أن وقوعه في الأسر كسر شِرَّته، وأن تجاربه العديدة في حياته المديدة أطفأت عجرفيته، وكفكفت من طغيانه وغلوائه.
فلما حضرته الوفاة أوصى بنيه بوصية خلت من الكبر، ونزعت إلى الحكمة وفي هذه الوصية يقول: “يا بني، قد بلغت من العمر ما لم يبلغه أحد من آبائي، ولابد أن ينزل بي ما نزل بهم من الموت، وإني والله ما عيّرت أحداً بشيء إلا عُيِّرت بمثله، إن كان حقاً فحقاً، وإن كان باطلاً فباطلاً ومَنْ سَبَ سُبَّ، فكفوا عن الشتم فإنه أسلم لكم، وأحسنوا جواركم يحسن ثناؤكم”. وهذه الوصية تدل على نضج فكري واكتساب حكمة من تجارب الحياة الطويلة.
شعر عمرو بن كلثوم ومعلقته الخالدة
سلك الأصمعي عمرو بن كلثوم في أصحاب الواحدة، والحق أن ما بلغنا من شعره غير المعلقة أقل من القليل، لكنه – على قلة شعره – استطاع أن يجوز طبقته، وأن يحاذي بواحدته الفحول المكثرين. تضارع معلقة ابن كلثوم معلّقة طرفة في الطول، إذ تبلغ عدة أبياتها – كما وردت في شرح الزوزني – مائة وثلاثة أبيات تخير لها الشاعر الوافر وزناً، والنون روياً، والفخر غرضاً.
في مطلع المعلقة (١ـ٧) استسقى الشاعر صاحبته الخمر، وتحدث عن أثر الخمر في شاربها، وسمّى الأماكن التي شربها فيها ثم عرض ما دار بينه وبين حبيبته الطاعنة من حديث، ووصف جسدها الريان باللين وضمور الخصر، ونهود الصدر، وضحل الردف (٩ – ١٨). وبين صور الغزل الضاحكة حشر حكمتين واجمتين عن القدر (٨- ١٢) كما تجد شيئاً من الشكوى والحزن والألم لبعد الأحبة في ثلاثة أبيات (١٩ – ٢١) ووصفاً لقرى اليمامة في بيت واحد (٢٢).
بنية المعلقة وموضوعاتها الفنية
لك أن تعدّ هذه الأبيات كلها مقدمة طويلة أو مجموعة مقدمات تمهد للموضوع الأول، وهو الفخر العنيف المتفجر، والاعتزاز بمنعة تغلب والتغني بمقتل عمرو بن هند الذي روينا خبره. وقد ذكر بعض الرواة أنّ هذه القصيدة كانت ألف بيت، وأن ذاكرة الزمان لم تحفظ إلا عشرها، وأن عمرو بن كلثوم أنشأها منجمة، أو نظم شطراً منها حينما احتكمت تغلب وبكر إلى عمرو بن هند، ونظم شطرها الآخر بعد مصرع ابن هند.
وخلاصة الخبر ـ كما يروى في كتب الأدب – أن الملك المنذر والد عمرو بن هند أصلح بين عشيرتي بكر وتغلب بعد حرب البسوس التي دامت أربعين سنة، ولكنه خشي أن تحترب العشيرتان بعد أن اصطلحتا فأخذ منهما مائة غلام رهائن، فإذا بغت إحداهما على الأخرى أقاد من رهائن الطائفة المعتدية. ثم جاء عمرو بن هند، فاقتدى بأبيه، وسير ركباً من تغلب وبكر إلى جبال طيء، فأجلى البكريون التغلبيين عن الماء، فضلوا في الفلوات حتى قتلهم الظمأ ومضت تغلب تطلب ديات أبنائها، فأبت بكر، فاحتكمت تغلب إلى عمرو بن هند وندبت عمرو بن كلثوم للدفاع عنها، وندبت بكر النعمان بن هرم وحينما احتدم الجدال بين ابن هند وابن هرم غضب الأمير، وطرد مندوب بكر، فأنشد عمرو شطر معلّقته. وأما الشطر الآخر فقد أنشده إثر مصرع عمرو بن هند على النحو الذي ذكرناه قبل، في حديثنا عن حياة عمرو بن كلثوم.
مكانة المعلقة عند النقاد والرواة
ظفرت هذه المعلّقة بعناية الرواة والنقاد، ونالت قدراً وافراً من الحظوة عندهم، لا لما فيها من فنّ وتصوير، بل لارتباطها بأحداث خطيرة، ولانطوائها على دلالات اجتماعية وإشارات تاريخية. فقد ذكر صاحب الأغاني أن عمرو بن كلثوم قام بها خطيباً بسوق عكاظ في الموسم. وجاء في الجمهرة أنّ واحدة ابن كلثوم أجود من سبعهم (سبع المعلقات). وقال ابن شرف القيرواني: (وجعلتها تغلب قبلتها التي تصلي إليها، وملتها، التي تعتمد عليها فلم يتركوا إعادتها ولا خلعوا عبادتها، إلا بعد قول القائل:
“ألهى بنِي تَغْلِب عَنْ كُلِّ مَكْرُمَةٍ *** قصيدةٌ قالهــا عمرو بن كلثوم”
وقال المستشرق نالينو: “وما تنفرد به معلقة الحارث وعمرو من أغلب سائر قصائد الجاهلية أن معظمها يدور على الموضوع الأساسي، فلا يبقى فيهما للغزل والوصف وسائر لواحق القصائد إلا أبيات قليلة جداً”. هذا التقدير النقدي يؤكد أهمية المعلقة في الأدب الجاهلي ومكانتها الرفيعة بين المعلقات السبع، حيث تميزت بالتركيز على موضوعها الأساسي دون تشتت.
أغراض شعر عمرو بن كلثوم
لا يجد الباحث في كتب الأدب من شعر عمرو بن كلثوم إلا مقطعات قليلة، يضيفها إلى معلقته، وأكثر هذه المقطعات يندرج في المعلقة فكراً وأسلوباً ووزناً. ولا يجد في شعره كله غير غرض واحد بارز هو الفخر وغرضين ينطويان في الفخر أو يمهدان له هما الغزل والخمر. وهذا التركيز على غرض محدد يعكس طبيعة شخصية الشاعر المنشغلة بالسيادة والقيادة، والتي لم تجد متسعاً للتفنن في أغراض الشعر المتعددة كما فعل غيره من الشعراء الجاهليين.
كل ما تحصل لنا من غزل ابن كلثوم في المعلّقة وفي غير المعلقة، أحد عشر بيتاً. وهذا القدر اليسير لا يسمح للباحث بالنظر والاستنباط والحكم على الشاعر، ونحن نزعم أن شاباً ساد قومه منذ احتلم لا تترك السيادة في قلبه إلّا موضعاً ضيقاً للنساء. وأن ناشئاً تلقى على كاهله تبعات قبيلة كبرى كبني تغلب لا يبرع في الغزل، ولا يفرغ له، ومن ينظر في الأبيات التي عرض فيها الشاعر للمرأة لا يجد لوعة المحب، ولا حنين المفارق ولا غيرة العاشق وإنما يجد صور الجمال وعرام الشهوة وقسمات الفن الحسي الفطري.
الغزل في شعر عمرو بن كلثوم
شبّه المرأة بالقمر في قوله بعد أن لعبت به الخمر، وهو أسير بني حنيفة:
“أأجْمَعَ صَحْبَتِي السَّحَرَ ارتحالا وَلَمْ أَشْعُرُ بِبَيْنِ مِنْكِ هالا
ولم أرَ مثل هالةَ في مَعَدٍ أشبهُ حسنها إلا الهِلالا”
وقد اقترنت المرأة عنده بالخمر فكأنّ حبّه لم يكن أكثر من شهوة تشعل الخمر أوارها. ولهذا عاتب الشاعر صاحبته أم عمرو – وهي تدير أقداح الراح ـ حينما صرفت الكأس عنه إلى غيره، وزعم أنه أكرم من صاحبيه الأثيرين عند الساقية، وأحق منهما بالشراب قائلاً:
“صبنْتِ الكَأْسَ عَنَّا أُمَّ عَمْرِو وكَانَ الكَأْسُ مَجْراهَا اليَمِينا
وَمَا شَرُّ الثلاثةِ أمَ عَمْرِو بِصَاحِبك الذي لا تصبحينا”
فأنت تحس كيف يطل الفخر من نافذة الغزل، وكيف تطغى شخصية الشاعر المزهوة بنفسها على شخصية المحبوبة، فإذا انصرف الشاعر عن الخمر والفخر استوقف صاحبته ليحاورها، فيظن السامع أنه سيشكو الصبابة والأرق ولواعج الحب، فإذا هو يسألها عن الحب سؤال المرتاب في إخلاصها، ويخبرها عن الحرب إخبار المفتون بالمعارك، وإذا هو يمن عليها لأنه قهر أعداءه، وبلغها ما تتمنى، وأسبغ عليها نعمة النصر:
“قفي قَبْلَ التَّفَرُّقِ يَا ظَعِينا نُخَبركِ اليَقِينَ وَتُخْبِرِينا
قفي نسْأَلُكِ هَلْ أَحْدَثْـتِ صَرْماً لوَشْكِ البَيْنِ أَو خُنْتِ الْأَمِينا
بيومِ كريهةٍ ضرباً وَطَعْناً أقرَّ به مَوَالِيكِ العُيونا”
الصور الحسية في الغزل
وليس كل غزله مشوباً بالفخر، ولا شكلاً من أشكال عشق الذات. وإنما فيه بعض الصور الحسية التي يرسم فيها الشاعر جمال المحبوبة كما يراها، وكما يجب أن تكون. فهي ضخمة الورك، ناحلة القد، ذات ساقين بيضاوين مكتنزتين كأنهما عمودا رخام، إذا سارت بهما أطربك جرس خلاخيلهما:
“وَمَأكَمَةً يَضِيقُ البَابُ عَنْها وكشحاً قَدْ جُنِنْتُ بِهِ جُنُونا
وساقيتي بلنطٍ أَوْ رُخامٍ يرِنُّ خَشَاشُ حَلْيهما رَنِينا”
وفي هذا الغزل شيء من التواجد يصوره الشاعر تصويراً بدوياً يستعيره من شوق الناقة إلى ولدها ومن وجد الأعرابية على بنيها فيزعم أن فراق محبوبته أحزنه حزن ناقة ضيعت ولدها فمضت تثغو وتلغو، وحزن ثكلى أنجبت تسعة أولاد اختطفتهم يد المنية، وابتلعتهم أشداق القبور:
“فما وَجَدَتْ كَوَجْدِي أَمْ سَقْبٍ أَضَلَّهُ، فَرَجَعَتِ الحَنِينا
ولا شمطاءُ لم يُتركْ شَقَاها لها مِنْ تِسْعَةٍ إِلا جَنِينا”
إن غزل ابن كلثوم مزيج من شهوة تشعلها الخمر، وغلمة يلهبها الردف والنهد والساق، ومن تواجد يعقب الفراق، ثم ينطفئ الحب، ويفتر الوجد ويعود الشاعر إلى الفخر شاغله الأول، فما جوهر الفخر عنده؟
الفخر عند عمرو بن كلثوم
رأينا قبل كيف امتزج غزل الشاعر بفخره وأصغينا إليه وهو يعاتب صاحبته لأنها قدمت عليه من لا يبلغ مبلغه وفي هذا العتاب أشار ابن كلثوم إلى مكانته في قومه، فإذا الدافع إلى فخره دافع فردي تمليه الأثرة، ويصوغ معانيه افتتان الشاعر بشجاعته ومكانته، فقد ساد قومه وهو يافع الطلعة، ورأى الكبراء ينزلون عند حكمه ويصدعون بأمره، فكيف لا يقول:
“إذا بلغ القِطَامَ لَنَا صَبِي تخِرُّ له الجبابرُ ساجدینا”
غير أن الشاعر لم يسرف في هذا الضرب من الفخر، ولم يحمله العجب على الجبروت، وإنما عرف كيف يرضي نفسه، ويرضي قومه على طريقة السياسي المحنك الذي يمجد الأمة ويعني نفسه ويتغنى بالشعب ليحمله على الانصياع له، ويعتز بأبناء وطنه جميعاً ليعتزوا به وحده، ويشركهم في جلائل أعماله ليرددوا ذكرها وذكره صباح مساء واهمين أنهم شركاؤه في المحمدة وهم في حقيقة الأمر يسبحون له. صرع الشاعر ملك الحيرة عمرو بن هند بيده، لكنه حينما فخر بهذه المأثرة أشرك فيها قومه فقال لقد قتلنا الملك المتوج الذي كان يحمي الرهائن ويعجز عن حماية نفسه، وحبسنا جيادنا العراب عليه، فوقفت حول داره صافنة مطمئنة وقوفها في ديارنا:
“وسيِّدِ معشرٍ قَدْ تَوَّجُوهُ بتاجِ المُلْكِ يَحْمِي المُحْجَرينا
تركنا الخيلَ عاكِفَةً عَلَيْهِ مقلَّدة أُعِنِّتها صُفُونا”
بناء القصيدة وضمير الجماعة
وإذا جاز لنا في دراسة الشعر القديم أن نحتكم إلى النقد الحديث، فنستعير من الدراسات اللسانية (Linguistic Studies) والبنيوية (Structuralism) ما يعيننا على إثبات ما نزعم قلنا: إن بناء القصيدة يبين لنا كيف يبتلع الكلي الجزئي، ويمتزج الخاص بالعام، ويفنى الفرد في الجماعة، ويطغى ضمير القوم (نحن) على ضمير الزعيم الفرد (أنا)، حتى إن ضمير المجموع يتكرر ست مرات في أربعة أبيات متعاقبة، يتغنّى فيها ابن كلثوم بمنعة تغلب ووفائها بالعهد، وتقديمها العون إلى النزاريين في محاربتهم أهل اليمن وفي فرضها هيبتها على الناس، وانتقامها ممن يخرج على طاعتها، ثمّ في إعراضها عما تكره، وبلوغها ما تحب:
“وَنُوجَدُ نَحْنُ أَمْنَعَهُمْ ذِمَاراً وَأَوْفَاهُمْ إِذا عَقَدُوا يَمِينا
وَنَحْنُ غَداةَ أُوقِدَ في خَزَارى رَفَدْنَا فَوْقَ رِفْدِ الرافدينا
ونَحْنُ الحَاكِمُونَ إِذا أُطِعْنا ونَحْنُ العَارِمُونَ إِذا عُصِينا
ونَحْنُ الـتـاركونَ لما سَخِطْنا وَنَحْنُ الآخِذون لما رَضينا”
فجوهر فخره تعظيم القبيلة الذي ينطوي على تعظيم الذات.
معاني الفخر في شعر عمرو بن كلثوم
أما معاني هذا الفخر فهي المعاني الشائعة في الشعر الجاهلي كله، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- الأنفة والعزة: التي سمعت صيحتها تجلجل في حنجرة أمه، فتحرك ساعده بالسيف المعلق، فيهوي به على الملك ليلقي رأسه عن عنقه، وهذه الأنفة كانت من أبرز السمات التي ميزت عمرو بن كلثوم وقبيلته
- الشجاعة والبسالة: التي تجعل بني تغلب قادرين على سحق الأعداء، وحماية الظعائن، وتجعل نساءهم أشجع منهم، لأنهن يدفعن أزواجهن إلى الموت ليكونوا جديرين بهن، إذ يقتن جيادنا، ويقلن: “لَسْتُمْ بعُولَتَنا إِذا لَمْ تمْنَعُونَا”
- المجد التليد والنسب الشريف: فتغلب الغلباء وريثة المجد العريق، ورجالها أبطال عرفوا بالنجدة والكرم والقوة، فعلقمة فتح أمنع الحصون، وعتاب وكلثوم أورثا القبيلة أعرق المجد، وذو البرة كان الكريم المشهود له بسعة الإنفاق على العائدين به، وكليب بن وائل كان الفارس المعلم في حرب الضروس
وعلى هذا النحو يمضي ابن كلثوم في معلّقته يبدى، ويعيد، ويردد مفاخرته بالشجاعة والكرم والأنفة، وسابقة المجد، وتفوق تغلب على قبائل العرب. فهو يقول متغنياً بأمجاد أجداده:
“وَرِثْنَا تَجْدَ عَلْقَمَةَ بن سيفٍ أباحَ لنا حُصُونَ المَجْدِ دِينا
وَعَتَّاباً وَكَلْثُومَاً جَميعاً بهم نلْنَا تُراث الأكرمينا
وذا البُرَةِ الذي حُدِّثتَ عَنْهُ به نُحمى ونَحْمِي المُحْجَرينا
ومنّا قَبْلَهُ السَّاعِي كَلَيْبٌ فأيُّ المجد إلا قد وَلينا”
الخصائص الفنية لشعر عمرو بن كلثوم
وقف النقاد الأقدمون والدارسون المحدثون على ما يزين شعر ابن كلثوم من طبع ولين وتدفق، وما يشينه من هلهلة وتكرار وسطحية، فوضعوه حيث يجب أن يوضع. وضعه صاحب الطبقات في الطبقة السادسة مع الحارث بن حلزة، وعنترة بن شداد، وسويد بن أبي كاهل. وقال فيه أستاذنا الدكتور عمر فروخ: «إنه شاعر مطبوع مقل». وقرنه صاحب أدباء العرب بجده المهلهل ورمى شعره بالتفكك والتكرار، وإنصافاً للشاعر نقول: إنّ شعره يتسم بسمات فنية واضحة تميزه من شعراء عصره.
أهم هذه الخصائص هي التدفق العاطفي، فقد جُبلت شخصية عمرو بن كلثوم بالغضب والحم والجموح، فضعف سلطان المنطق على شعره، وجاءت معانيه سطحية مكرورة. ولذلك يستطيع الباحث أن يسقط نصف معلقته فلا ينقص من أفكارها شيء. أما السهولة واللين فتبرز في أسلوب الشاعر – على ما في شخصيته من قوة – إذ يتميز بالعذوبة والسلاسة ولين الألفاظ، ووضوح المعاني، ويستطيع أن يثير الحماسة ويهيمن على السامع والقارئ بإيقاع حاد النبرات متدفق النغمات، ولا يشينه إلا إغفال التحكيك والتثقيف، ولذلك تشيع في أسلوبه ظاهرة التكرار تكرار الألفاظ، وتكرار العبارات في أبيات متجاورة كقوله: ((بأي مشيئة عمرو بن هند نكون)) و ((بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع)).
الخيال والصورة الشعرية
خيال ابن كلثوم، بدوي، واضح الصور مقصوص الجناح وصوره مجموعة من تشبيهات في غاية البساطة. فقد شبه السيوف الحديدية بسيوف الخشب التي يلهو بها الأطفال، فقال:
“كأنَّ سيوفنا مِنَّا وَمِنْهُمْ مخارِيقٌ بأيدي لاعبينا”
وكأن نفس الشاعر المتفجرة، وحماسته المشتعلة، وغريزته الغالبة على عقله لم تكن تخلي بينه وبين شعره، فيقرض الشعر على البديهة، ولا يعمل فيه يد الفنّ الصناع التي تركب الصور والألوان الفنية. وربما وجدت الصورة الواحدة تعاد في مواضع مختلفة من معلقته ففي البيت الثلاثين شبه الشاعر قومه برحى تسحق أعداءه، وتجعلهم طحيناً تذروه الرياح، فقال:
“متى ننقلْ إلى قومٍ رحـانا يكونوا في اللّقاءِ لها طحينا”
ثم كرر الصورة نفسها في البيت الثاني والثلاثين، فقال:
“قَرَيْناكُمْ فَعَجَّلْنَا قِرَاكُمْ قبَيْلَ الصُّبْحِ مِرْدَاةٌ طَحُونا”
وهذا التكرار في الصور يدل على محدودية الخيال وضيق الأفق الفني عند الشاعر، رغم قوة العاطفة والتدفق الحماسي في شعره.
الوزن والموسيقى الشعرية
من الظواهر اللافتة في الشعر العربي أن بعض الشعراء يطربون لأوزان بعينها ويلتزمونها في أغلب قصائدهم، ويرى النقاد أن هذا الطرب ينبع من ملاءمة البحر الشعري للموضوع والعاطفة التي يعبر عنها الشاعر.
وعمرو بن كلثوم يمثل نموذجاً واضحاً لهذه الظاهرة، فقد استخدم في جميع الأبيات التي استشهدنا بها من شعره بحراً واحداً هو الوافر، باستثناء بيت واحد فقط.
ولهذا الالتزام الوزني تفسيران:
التفسير الإيجابي: يمكن القول إن اختيار عمرو بن كلثوم للوافر اختيار موفق، لأن هذا البحر يتميز بالتدفق والانهمار في نغماته المتعاقبة، مما يجعله ملائماً تماماً لأغراض الحماسة والفخر التي برع فيها الشاعر.
التفسير السلبي: يمكن أن نعزو رتابة الوزن إلى أحادية الموضوع عند الشاعر، فرتابة الموسيقى انعكاس طبيعي للنطاق الضيق الذي يدور فيه فكره وخياله. ولو أنه طرق أبواب الشعر المتنوعة كالوصف والطرد والهجاء والرثاء، لتعددت أوزانه بتعدد أغراضه.
١. من هو عمرو بن كلثوم؟
هو شاعر جاهلي من قبيلة تغلب، ولد عام ٥١٢م أو ٥١٤م وتوفي عام ٦١٠م أو ٦١٢م، ساد قومه في سن مبكرة وعرف بالشجاعة والفخر. ينتمي من ناحيتي أبيه وأمه إلى تغلب إحدى قبائل ربيعة التي كانت تقطن الجزيرة الفراتية في شمالي الشام والعراق. أمه ليلى بنت مهلهل أخي كليب، وقد عاش حياة مديدة قد تكون تجاوزت المائة عام.
٢. ما هي أهم الأحداث في حياة عمرو بن كلثوم؟
أهم الأحداث هي حروبه مع الغساسنة والمناذرة التي انتصر فيها، وقتله لعمرو بن هند ملك الحيرة دفاعا عن شرف أمه وقبيلته. كما وقع أسيرا في يد يزيد بن عمرو الحنفي بعد غزوة على بني حنيفة، مما كسر شرته وأثر في نفسيته. تميزت حياته بالعزة والأنفة التي ورثها عن أمه ليلى بنت مهلهل.
٣. لماذا قتل عمرو بن كلثوم عمرو بن هند؟
قتله دفاعا عن شرف أمه حين حاول عمرو بن هند إذلالها بطلب خدمة أمه من أم عمرو بن كلثوم. رفضت ليلى ذلك وصاحت واذلاه يا لتغلب، فوثب ابن كلثوم إلى سيف معلق في الخيمة وقطع رأس عمرو بن هند. كانت هذه الحادثة تعبيرا عن الأنفة والعزة التي بلغت عنده وعند أمه الغاية، وجعلته من أرباب الفخر في العصر الجاهلي.
٤. ما هي معلقة عمرو بن كلثوم؟
هي قصيدة طويلة من مائة وثلاثة أبيات من بحر الوافر برواية النون، تعد من المعلقات السبع. موضوعها الأساسي الفخر بقبيلة تغلب والاعتزاز بمنعتها، مع مقدمة في الخمر والغزل. ذكر بعض الرواة أن القصيدة كانت ألف بيت لم يحفظ منها إلا عشرها، وأنها نظمت منجمة في مناسبات مختلفة تتعلق بالصراع مع عمرو بن هند.
٥. كم عدد أبيات معلقة عمرو بن كلثوم؟
تبلغ عدة أبياتها مائة وثلاثة أبيات كما وردت في شرح الزوزني، وهي بذلك تضارع معلقة طرفة في الطول. اختار لها الشاعر بحر الوافر وزنا والنون رويا والفخر غرضا رئيسيا. تحظى هذه المعلقة بعناية كبيرة من الرواة والنقاد لارتباطها بأحداث خطيرة ولانطوائها على دلالات اجتماعية وإشارات تاريخية مهمة.
٦. ما هي الأغراض الشعرية عند عمرو بن كلثوم؟
الفخر هو الغرض الرئيسي والبارز في شعره، يليه الغزل والخمر اللذان يمهدان للفخر أو يندرجان فيه. غزله حسي فطري يصور جمال المرأة وعرام الشهوة دون لوعة المحب أو حنين المفارق. أما الخمر فتقترن عنده بالمرأة والفخر. لم يبرع في الغزل لأن السيادة المبكرة لم تترك في قلبه موضعا واسعا للنساء.
٧. ما هي خصائص شعر عمرو بن كلثوم الفنية؟
يتسم شعره بالتدفق العاطفي نتيجة شخصيته المجبولة بالغضب والحمية، والسهولة واللين في الأسلوب مع عذوبة الألفاظ ووضوح المعاني. كما يتميز بإسفاف الخيال وبساطة الصور، ورتوب الوزن حيث استخدم الوافر في معظم شعره. يعيب شعره التكرار في الألفاظ والمعاني والصور، والهلهلة والسطحية في بعض الأحيان.
٨. ما هي قبيلة عمرو بن كلثوم؟
ينتمي إلى قبيلة تغلب إحدى قبائل ربيعة وأخت قبيلتي بكر وعنز، وهي قبيلة كبيرة كانت تقطن الجزيرة الفراتية في شمالي الشام والعراق. كانت تفرض سلطانها على بقاع شاسعة تكتنف ضفتي الفرات، حتى قال العرب فيها لو أبطأ الإسلام قليلا لأكلت تغلب الناس. عرفت بالمنعة والقوة والشجاعة.
٩. كيف مات عمرو بن كلثوم؟
مات بسبب الخمر بعد أن وقع أسيرا في يد يزيد بن عمرو الحنفي الذي أذله وازدراه. كسر هذا الأسر شرته وأثر في نفسه المزهوة بذاتها، فأكب على الخمر يغرق فيها غيظه حتى أغرقته. ظل يعب الخمر صرفا إلى أن مات، فهو أحد الأشراف الذين قتلتهم الخمر في العصر الجاهلي.
١٠. ما هي أهم مميزات معلقة عمرو بن كلثوم؟
تتميز بتركيزها على الموضوع الأساسي وهو الفخر، مع قلة الاستطرادات في الغزل والوصف. نالت حظوة كبيرة عند النقاد حتى قال البعض إنها أجود من سبع المعلقات. اتخذتها تغلب قبلتها التي تصلي إليها لما فيها من تمجيد لمآثرها. تتسم بالإيقاع الحاد والنغمات المتدفقة التي تثير الحماسة، وبطول النفس في الفخر القبلي.