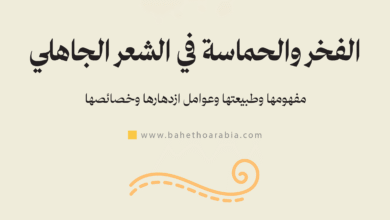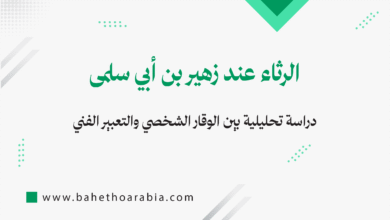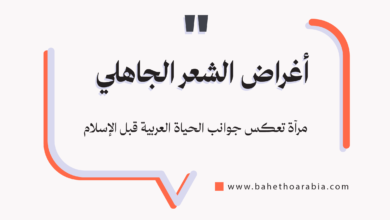الأمثال: أصلها، أنواعها، خصائصها، وأشهر نماذجها في التراث العربي
دليل شامل لفهم الأمثال العربية وقيمتها البلاغية والثقافية
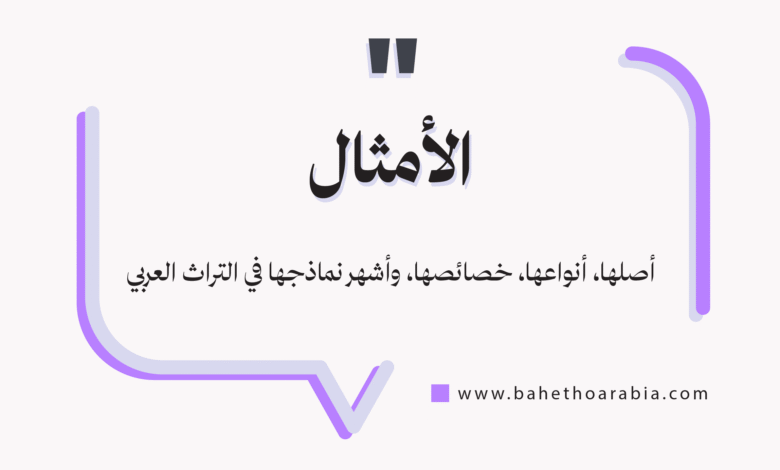
تُعد الأمثال خلاصة تجارب الشعوب ومرآة لثقافتهم، فهي كبسولات لغوية تحمل في طياتها الحكمة والبلاغة. وفي هذا المقال، نغوص في عالم الأمثال العربية (Proverbs) لاستكشاف أسرارها وقيمتها.
مقدمة
تمثل الأمثال جزءاً لا يتجزأ من التراث الثقافي واللغوي لأي أمة، وهي في الثقافة العربية تحتل مكانة مرموقة؛ إذ تعد من أبلغ صور التعبير وأكثرها إيجازاً وقدرة على النفاذ إلى العقل والوجدان. إنها ليست مجرد كلمات سائرة، بل هي عصارة الحكمة وخلاصة التجارب الإنسانية التي صاغتها الأجيال عبر العصور في قوالب لغوية بديعة. من خلال هذا المقال، سنستعرض رحلة الأمثال منذ نشأتها اللغوية، مروراً بجهود العلماء في جمعها وتدوينها، وصولاً إلى تحليل أنواعها وخصائصها التي جعلتها جوهرة من جواهر الأدب العربي، مع تقديم نماذج حية توضح عمقها وأصالتها.
أصل الأمثال ومعناها اللغوي والبلاغي
قال أحمد بن فارس: الميم والثاء واللام : أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشيء. وهذا مثل هذا أي نظيره. والمثل المضروب مأخوذ من هذا، لأنه يذكر مورى به عن مثله في المعنى. وعرف السيوطي المثل مقتبساً تعريفه من كلام المرزوقي في شرح الفصيح، فقال: «المثل جملة من القول مقتضبة من أصلها، أو مرسلة في ذاتها. فتتسم بالقبول، وتشتهر بالتداول، فتنقل عما وردت فيه إلى كل ما يصح قصده بها من غير تغيير يلحقها في لفظها، وعما يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المعاني. فلذلك تضرب، وإن جهلت أسبابها التي خرجت عليها.
وهذا الكلام يعني أن للأمثال صيغاً جوامد، لا تتبدل بتبدل المخاطبين بها، وتراكيب لا يعروها ما يعر وغيرها من مراعاة مقتضى الأحوال. حتى قواعد النحو تظل عاجزة عن السيطرة عليها. فأنت تقول: أعط القوس باريها بسكون الياء وحقها ظهور الفتحة، وتقول: «الصيف ضيعت اللبن بناء مكسورة في مخاطبة المذكر والمؤنث والمثنى والجمع. وذهب المستشرق (زلهايم) إلى أن أصل كلمة (مثل) سامي، وأن العربية كأخواتها الساميات استخدمت جذره اللغوي وفروعه المشتقة للدلالة على معان متقاربة. ورأى أن العرب والساميين قد ضربوا الأمثال، قبل أن يسموها بهذا الاسم. ووجد في استخدامه دليلاً على ميل الشعوب السامية إلى التجريد، وإلى الرغبة في عقد المقارنات التصويرية بين الأوضاع المتقاربة. وللبلاغيين في المثل والتمثيل مفهوم آخر، إذ يرون أن المثل شكل من أشكال الصور البيانية، فهو إما تشبيه وإما استعارة، لأن ضربه يمني تشبيه حال بحال.
تاريخ التأليف في الأمثال العربية
بلغت العرب في ضرب الأمثال شأواً بعيداً، وشاعت في كلامهم، إذ كانوا يسوقونها في الخطب والوصايا. قال الجاحظ: كان الرجل من العرب يقف الموقف فيرسل عدة أمثال سائرة، ولم يكن الناس جميعاً ليتمثلوا بها إلا لماماً لما فيها من المرفق والانتفاع. ولما تلقاها علماء اللغة من السن الرواة والحفظة، وجدوا فيها ثروة لغوية ضخمة فأكبوا عليها يجمعونها وينسقونها، يشرحونها، ويحاولون في هذا الشرح أن يشفعوا كل مثل بما يناسبه من توضيح، أو بما يكمله من أخبار وقصص.
ثم انتقلت العناية بالأمثال العربية من المؤلفين القدماء إلى الباحثين الأوربيين المعنيين بدراسة الأدب العربي والتراث العربي، وقد ظهرت هذه العناية في فترة مبكرة إذ بدأ الاهتمام بها وينشرها منذ عام ١٥٩١م وقوي مع قوة حركة الاستشراق. فما بداية التأليف في الأمثال وكيف تطورت بعد ذلك؟ يرجع الدارسون المحدثون التأليف في الأمثال إلى القرن الهجري الأول، ويذكرون أن عبيد بن شرية الجرهمي، وعلاقة بن كريم الكلابي، وصحار بن عياش العبدي ألفوا كتباً في الأمثال وفقدت هذه الكتب منذ عصر مبكر. وذكر العسكري أن هذه الحكم والأمثال كانت مدونة منذ الجاهلية، وبقيت إلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر كذلك أن عمران بن حصين قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب – وكان قد قرأ الكتب – إن من الحكمة: إن منه ضعفاً. فغضب عمران بن حصين، وقال: أحدثك بما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثني عن صحفك هذه الخبيثة.
وربما كان كتاب (الأمثال) للمفضل بن محمد الضبي (ت نحو: ۱۷۰ هـ) أقدم كتاب بلغنا مما ألفه الأقدمون في الأمثال، وفيه مجموعة من الحكايات والنتف التاريخية والخرافات التي تنتهي بعبارة يقولها بطل القصة أو من يعارضه، فتذهب مثلاً. ومن كتب الأمثال القديمة التي حفظها لنا التاريخ كتاب ألفه أبو فيد مؤرج السدوسي (ت) نحو (١٩٥هـ) وعنايته بالتفسير اللغوي واضحة، وكتاب لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت) نحو (٢٢٤هـ) وفيه جمع بين شرحين الشرح اللغوي والشرح. ومن أشهر الكتب المتداولة على نطاق واسع كتاب (الفاخر للمفضل بن سلمة الضبي (ت: ۲۹۰ (هـ) ويجمع الأمثال والأقوال السائرة. وكتاب (الدرة الفاخرة) لحمزة الأصفهاني (ت بعد: (٣٥٠) وهذه الدرة مجموعة من الأمثال أولها لفظ على وزن (أفعل) ومن أكبر كتب الأمثال (مجمع الأمثال) للميداني أبي الفضل أحمد بن محمد (ت: ١٥٨ هـ) وهو مرتب على أوائل الأمثال وفق الترتيب المعجمي، ومع كل مثل ما يوضح لغته، ويعرب تركيبه، ويدل على أصله، ويشفع التفسير بتعليل.
وفي خاتمة كل باب من أبوابه ما جاء من أمثال الباب على وزن أفعل، ثم ما قال المولدون من أقوال ذهبت مذهب الأمثال. وكتاب المستقصي في الأمثال لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت: ٥٣٨ هـ) لا يقل شأناً عن كتاب الميداني. ولم تكن عناية الدارسين المحدثين بالأمثال بأقل من عناية المتقدمين، ومن المعنيين بها المستشرق الألماني رودلف زلهايم الذي ألف كتاب (الأمثال العربية القديمة) واستقصى ما ألفه الأقدمون، فوجد أن مجموع ما ألف في الأمثال (٤٢) كتاباً بين مطبوع ومخطوط وضائع. ووجد أن في بعض هذه الكتب خلطاً بين الأمثال وغيرها من العبارات الدائرة على الألسن، الحكم السائرة، كما وجد أن بعض المؤلفين لم يفرق بين الحقائق التاريخية والأساطير التي حكيت حول الأمثال. وفي كتاب زلهايم إحصاء لأمثال العرب، ولعدد الأمثال في بعض الكتب المشهورة مثل كتاب مجمع الأمثال للميداني. فقد وجد هذا المستشرق أن كتاب الميداني أوسع الكتب في بابه، وأن عدد الأمثال التي تضمنها (٥٦٣٨) ويقول: وإذا احتسبنا بعد ذلك (۲۱۷) يوماً من أيام العرب ذكرها الميداني في الباب التاسع والعشرين، و (۲۲۸) مثلاً تنسب للرسول وغيره . . . فإننا نصل إلى (٦٠٠٠) مثل ونيف كما ذكر الميداني في مقدمته.
أنواع الأمثال في الثقافة العربية
لم نجد في كتب الأقدمين تقسيماً واضحاً، يجعل الأمثال أنواعاً بحسب الأفكار والصور. ووجدنا من المصنعين من يميز الأمثال القديمة من أمثال المولدين، والأمثال المبدوءة بلفظ على وزن (أفعل) من سواها، أما المستشرق الهايم فقد وجد أربعة أنواع في أمثال العرب، وهي:
١. المثل التصويري: ومعناه عنده التعبير غير المباشر عن تجربة بلفظ موجز، وتشبيه حسن كقول العرب: ونعم كلب في بؤس أهله، وقولهم: ولا يجتمع السيفان في عمده وقولهم : وقد بين الصبح لذي عينين، ومن الواضح أن المثل الأول يجعل اللثيم النهار كلباً، والثاني يشبه البطلين بسيفين والثالث يقرن الحق بالصبح .
٢. التعبير المثلي: وهذا النوع ولا يعرض أخباراً معينة عن طريق حالة بعينها ولكنه يبرز أحوال الحياة المتكررة، والعلاقات الإنسانية في صورة يمكن أن تكون جزءاً من جملة ومن أمثلته : سكت ألفاً ونطق خلفاء وجاء تضب لثته، وهذا النوع يثري التعبير ويوضحه، ومن هذا النوع ما جاء في صدره لفظ على وزن أفعل مثل : أظلم من حية و أبصر من غراب وما وقع فيه شيء من ألفاظ الإتباع مثل: وجاؤوا قضهم بقضيضهم، ولا يخلو هذا النوع من التشبيه أو المبالغة فيه كتشبيه البصير بالغراب والمتشابهين بأسنان الحمار في قولهم : ( سواسية كأسنان الحمار ).
٣. المثل الحكمي: وهو تعبير موجز شديد الإيجاز، يصوغ الحكمة بلفظ مجرد ويتضمن قيمة من القيم أو يدعو إلى مبدأ من المبادئ كقول العرب: «السر أمانة والعدة عطية، وكقولهم: «انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً.
٤. العبارة التقليدية المتداولة: والعرب تكثر من استعمال هذا النوع في الدعاء والخطاب والتحية، ويتضمن عبارات يصقلها الاستعمال، وتتلقفها الألسنة، كقولهم: بلغ الله بك أكلا العمر» و «لا أرقا الله دمعته» و «رماه بأقحاف رأسه.
خصائص الأمثال العربية وقيمتها الفريدة
تتميز الأمثال بخصائص اقتضتها طبيعة اللغة العربية أولاً، والمواقف التي اكتنفت صياغتها ثانياً، وأهم هذه الخصائص:
١. الإيجاز: إذا كان الإيجاز ظاهرة تميز اللغة العربية فهو في الأمثال شديد التركيز والتكثيف، ولذلك شاع في الأمثال الحذف واضطر النحاة إلى التأويل والتقدير في إعرابها.
٢. التصوير: في أكثر الأمثال العربية استعارات وكنايات وتشبيهات بلغت الغاية في الجمال والرقة تقول العرب: إياك أن يضرب لسانك عنقك، وقولهم: لو ذات سوار لطمتني وقولهم: «إنه لأجبن من صافر والصافر الطائر الصغير الذي يصفر.
٣. الموسيقا: زين العرب أمثالهم بتوقيعات صوتية جميلة تيسر تداولها، وتفتح لها القلوب والأسماع، كالسجع، والتوازن، والإتباع. وربما توافر لبعضها الوزن الشعري العروضي إما لورودها في قصائد ومقطعات، وإما لأن الحس الرهيف الذي شارك في صوغها أطلقها موزونة مثل:
إلا حظية فلا الية
وجاء بأم الربيق على أريق
والعاشية تهيج الأبية
ومن أمثالهم الموزونة
سقط العشاء به على سرحان
وإن الجبان حتفه من فوقه
وأما أهمية الأمثال فتبدو في إجماع الأدباء والنقاد قدمائهم والمحدثين على الإعجاب بها للأمور التالية:
١. بلاغتها: فقد رأى عبد الله بن المقفع أنها «آنق للسمع، من أضرب الكلام الأخرى، وقال النظام إنها نهاية البلاغة ورأى الفارابي أنها من أبلغ الحكمة، ولو جمعت ما قيل في إطراء الأمثال لظفرت بقدر وافر من أقوال الأدباء بدل على مكانتها الفنية والفكرية.
٢. سيرورتها: شاعت الأمثال فيما يكتب الناس ويتحدثون، واتخذ بعضها حججاً وبراهين. قال ابن عبد ربه إنها أبقى من الشعر وأشرف من الخطابة، لم يسر شيء مسيرها، ولا عم عمومها، حتى قبل أسير من مثل.
٣. تعبيرها عن الأمة العربية: لما كانت الأمثال خلاصات تجارب، فقد حفلت بكثير من ثقافة العرب وقيمهم وخلقهم وواكبت تطورهم. قال الدكتور رمضان عبد التواب: إنها مرآة صافية لحياة الشعوب تنعكس عليها عادات تلك الشعوب وتقاليدها وعقائدها، وسلوك أفرادها ومجتمعاتها. وهي ميزان دقيق لتلك الشعوب في رقيها وانحطاطها وبؤسها ونعيمها وآدابها ولغاتها، وقال زلهايم: إنها «الأنغام اللغوية الصغيرة للشعوب، ينعكس فيها الشعور والتفكير وعادات الأفراد وتقاليدهم.
٤. صلتها بالقصة: يبالغ بعض المعجبين بالأمثال، فيذهب إلى أنها تعد جذوراً للقصة العربية في العصر الجاهلي لارتباط أكثرها بأحداث وشخوص وتجارب.
نماذجات من أشهر الأمثال وتفسيرها
أشرنا قبل إلى كثرة الأمثال في أدبنا العربي، وقلنا: إن (مجمع الأمثال) وحده حوى أكثر من ستة آلاف مثل، فإذا ألحقت بهذا المقدار الكبير أمثال المولدين تحصل لك تراث ضخم. وفي هذا الكتاب اجتزأنا بنموذجات من الأمثال الجاهلية، بعضها مفسر تفسيراً مفصلاً، وبعضها مشفوع بيها وضع له.
١. أسعد أم سعيد؟
٢. الحديث ذو شجون
٣. سبق السيف العذل
فسر المفضل بن سلمة هذه الأمثال، فقال: أول من تكلم بها ضبة بن أد بن طابخة. وكان من حديث ذلك فيها ذكره المفضل الضبي: أن ضبة كان له ابنان يقال لأحدهما سعد وللآخر سعيد، فنفرت إبل ضبة تحت الليل، وهما معها، فخرجا يطلبانها، فتفرقا في طلبها، فوجدها سعد، أما سعيد فذهب ولم يرجع، فجعل ضبة يقول بعد ذلك إذا رأى سواداً تحت الليل: أسعد أم سعيد. فذهب قوله مثلا، ثم أتى على ذلك ما شاء الله لا يجيء سعيد، ولا يعلم له بخبر. ثم إن ضبة بعد ذلك بينا هو يسير، والحارث بن كعب في الأشهر الحرم، وهما يتحدثان إذ مرا على سرحة بمكان، فقال له الحارث : أترى هذا المكان، فإني لقيت فيه شاباً من هيئته كذا وكذا ووصف صفة سعيد – فقتلته، وأخذت برداً كان عليه من صفة البرد كذا ، فوصف صفة البرد، وسيفاً كان عليه، فقال ضبة : ما صفة السيف؟ قال: ها هو ذا علي . قال : فأرنيه فأراه إياه، فعرفه ضبة، ثم قال : إن الحديث لذو شجون فذهبت مثلا فضربه به حتى قتله، فلامه الناس فقالوا : أقتلت رجلاً في الأشهر الحرم ؟ قال ضبة : سبق السيف العذل فأرسلها مثلاً .
٤. وافق شن طبقة: قال ابن الكلبي في تفسيره: طبقة قبيلة من إياد، كانت لا تطاق فوقعت بها شن، وهو شن بن أقصى.. فانتصفت منها، وأصابت فيها، فضربنا مثلاً للمتفقين في الشدة. وغيرها. وقال الشرقي بن القطامي: كان رجل من دهاة العرب وعقلائهم يقال له شن، فقال: والله لأطوفن حتى أجد امرأة مثلي، فأتزوجها فبينا هو في بعض مسيره إذ وافقه رجل في الطريق، فسأله شنّ: أين تريد؟ فقال: موضع كذا، يريد القرية التي يقصد لها شن، فرافقه. فلما أخذا في مسيرهما، قال له شنّ: أتحملني أم أحملك؟ فقال له الرجل: يا جاهل أنا راكب وأنت راكب، فكيف أحملك أو تحملني؟ فسكت عنه شن و سارا حتى إذا قربا من القرية إذا هما بزرع قد استحصد، فقال له شن: أترى هذا الزرع أكل أم لا ؟ فقال له الرجل: يا جاهل ترى نبتاً مستحصداً، فتقول: أتراه أكل أم لا؟ فسكت عنه: حتى إذا دخلا القرية لقيتهما جنازة، فقال شن: أترى صاحب هذا النعش حياً أم ميتا؟ فقال له الرجل: ما رأيت أجهل منك، ترى جنازة فتسأل عنها: أميت صاحبها أم حي؟ فسكت عنه شن، وأراد مفارقته، فأبى الرجل أن يتركه، حتى يصير به إلى منزله، فمضى معه، وكانت للرجل ابنة يقال لها طبقة. فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه، فأخبرها بمرافقته إياه، وشكا إليها جهله، وحدثها بحديثه. فقالت: يا أبه، ما هذا بجاهل أما قوله: أتحملني أم أحملك فأراد: استحدثني ام أحدثك حتى نقطع طريقنا. أما قوله: أترى هذا الزرع أكل أم لا فإنما أراد: أباعه أهله، فأكلوا ثمنه أم لا. أما قوله في الجنازة فأراد: هل ترك عقباً يحيا بهم ذكره أم لا. فخرج الرجل فقعد مع شن، فحادثه ساعة، ثم قال له: أتحب أن أفسر لك ما سألتني عنه؟ قال : نعم، ففسره فقال شن : ما هذا من كلامك فأخبرني من صاحبه؟ قال : ابنة لي، فخطبها إليه، فزوجه إياه، وحملها إلى أهله. فلما رأوهما قالوا: وافق شن طبقة. فذهبت مثلاً.
٥. مرعى ولا كالسعدان: كان سبب هذا المثل أن امرأ القيس كان مفرَّكاً لا يكاد يحظى عند امرأة، فتزوج امرأة ثيباً، فجعلت لا تقبل عليه، ولا تريه من نفسها شيئاً مما يجب. فقال لها ذات يوم: أين أنا من زوجك الذي كان قبلي؟ فقالت: مرعى ولا كالسعدان: فأرسلتها مثلا والسعدان نبت تسمن الإبل عليه، وليس في كل ما يرعى مثله.
٦. رب ساع القاعد: يُقال إن أول من قال ذلك النابغة الذبياني. وكان قد وفد إلى النعمان بن المنذر وفود من العرب، فيهم رجل من بني عبس، يقال له: شقيق، فيمات عنده. فلما حبا النعمان الوفود بعث الى أهل شقيق بمثل حباء الوفد، فقال النابغة حين بلغه ذلك: رب ساع لقاعد».
٧. إذا عز أخوك فَهُنْ: مياسرتك الصديق خُلق حسن لا غضاضة فيه.
٨. إذا ترضيت أخاك فلا أخالك: إذا ألجأك أخوك أن تترضاه فليس بأخ لك..
٩. إنّ غداً لناظره قريب: يضرب للتريث والانتظار لوقوع المأمول.
١٠. تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها: يضرب في صيانة المرء نفسه عن خسيس المكاسب.
١١. رب عجلة تهب ريثاً: يضرب للرجل يشتد حرصه على حاجته، ويخرق فيها حتى تذهب كلها .
١٢. مكره أخاك لا بطل: يضرب لمن يحمل على ما يكره.
١٣. فلان لا يصطلى بناره: يضرب للعزيز الممتنع .
١٤. جاء بخفي حنين: يضرب لكل خائب أو خاسر.
١٥. من حبَّ طبَّ: يضرب لمن ألجأته الحاجة إلى أن يكون فطناً يحتال لنفسه
١٦. الصيف ضيعت اللبن: يضرب لمن يفرط في الأمر في وقته، ويطلبه في غير وقته.
١٧. حلب الدهر أشطره: يضرب لمن أنت عليه كل حال من شدة ورخاء .
١٨. كل فتاة بأبيها معجبة: يضرب لمن يعجب بما يخصه .
خاتمة
في الختام، يتضح أن الأمثال ليست مجرد أقوال عابرة، بل هي سجل حافل بحكمة الأمة وتجاربها، ومرآة تعكس قيمها وثقافتها ولغتها. من خلال استعراض أصلها وتاريخ تدوينها، وأنواعها المتعددة، وخصائصها البلاغية الفريدة، ندرك القيمة العظيمة التي تحملها هذه الجمل الموجزة. إن فهم الأمثال ودراستها يفتح نافذة واسعة على عقلية الإنسان العربي وتاريخه، ويؤكد أنها ستبقى كنزاً أدبياً وثقافياً لا ينضب، تتناقله الأجيال شاهداً على بلاغة اللغة وعمق التجربة الإنسانية.
سؤال وجواب
١. ما هو الأصل اللغوي لكلمة “مثل”؟
الأصل اللغوي، كما ذكر أحمد بن فارس، يدل على مناظرة الشيء للشيء، أي نظيره. والمثل المضروب يُشتق من هذا المعنى لأنه يذكر حالة ليرمز بها إلى حالة أخرى تشبهها في المعنى.
٢. كيف تتعامل الأمثال مع قواعد النحو التقليدية؟
للأمثال صيغ ثابتة لا تتغير بتغير المخاطب، وغالباً ما تتجاوز قواعد النحو المعتادة. فمثلاً، عبارة “الصيف ضيعتِ اللبن” تُقال للمذكر والمؤنث والمثنى والجمع بصيغة المؤنث المفرد المخاطب المكسورة.
٣. متى بدأ التأليف والتدوين في الأمثال العربية؟
يرجع الدارسون المحدثون بداية التأليف في الأمثال إلى القرن الهجري الأول، حيث يُذكر أن شخصيات مثل عبيد بن شرية الجرهمي قد ألفوا كتباً فيها، لكن أقدم كتاب وصل إلينا هو “الأمثال” للمفضل الضبي.
٤. ما هي أشهر كتب الأمثال القديمة؟
من أشهر الكتب المتداولة كتاب “الفاخر” للمفضل بن سلمة، و”الدرة الفاخرة” لحمزة الأصفهاني، ومن أكبر المصنفات كتاب “مجمع الأمثال” للميداني، وكتاب “المستقصي في الأمثال” للزمخشري.
٥. ما هي الأنواع الرئيسة للأمثال حسب تصنيف المستشرق زلهايم؟
صنف المستشرق زلهايم الأمثال إلى أربعة أنواع رئيسة، هي: المثل التصويري، والتعبير المثلي، والمثل الحكمي، والعبارة التقليدية المتداولة.
٦. بماذا تتميز الأمثال العربية من الناحية الفنية؟
تتميز الأمثال بثلاث خصائص رئيسة: الإيجاز الشديد والتكثيف، والتصوير البلاغي المعتمد على الاستعارة والتشبيه، والموسيقا الصوتية الناتجة عن السجع والتوازن والوزن الشعري أحياناً.
٧. ما القيمة الثقافية والتاريخية للأمثال؟
تعتبر الأمثال مرآة صافية لحياة الشعوب، تعكس عاداتهم وتقاليدهم وقيمهم، وهي سجل لتجاربهم وحكمتهم. كما أنها تمثل قمة البلاغة اللغوية، وقد اعتبرها البعض جذوراً للقصة العربية القديمة.
٨. ما القصة وراء المثل القائل “سبق السيف العذل”؟
قيل هذا المثل على لسان ضبة بن أد عندما قتل الحارث بن كعب ثأراً لابنه سعيد، وقد فعل ذلك في الأشهر الحرم. فلما لامه الناس على فعله، قال: “سبق السيف العذل”، أي أن الفعل قد تم ولا مجال للتراجع أو اللوم.
٩. على ماذا يدل المثل “وافق شن طبقة”؟
يُضرب هذا المثل للشخصين المتوافقين تماماً في الدهاء والعقل أو في أي صفة أخرى. وقصته تدور حول رجل ذكي اسمه “شن” تزوج من امرأة ذكية اسمها “طبقة” بعد أن فهمت ألغازه التي عجز عنها والدها.
١٠. ما هو تفسير المثل “مرعى ولا كالسعدان”؟
يُضرب هذا المثل للمفاضلة بين شيئين، وبيان أن أحدهما جيد ولكن لا يُقارن بالآخر الأكثر جودة. والسعدان هو نبت تسمن عليه الإبل ويُعد من أفضل المراعي، فقالت المرأة ذلك لزوجها الجديد مقارنة بزوجها السابق.