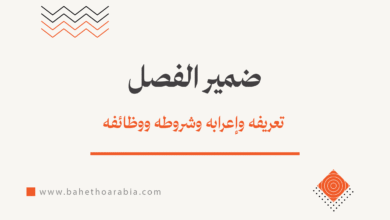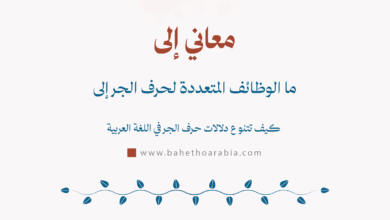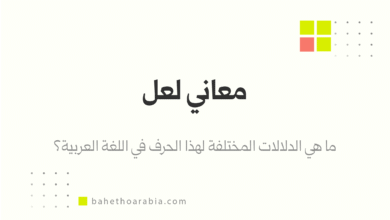ما هي الضمائر المنفصلة وما أنواعها وتعريفها؟

في بنية اللغة العربية، تقف الضمائر شامخة كأصغر الألفاظ حجمًا وأعظمها دلالةً. فهي ليست مجرد بدائل للأسماء، بل هي جوهر التعريف وقلبه النابض، حتى اعتُبرت بحق “أعرف المعارف”. ومن بين هذه الكيانات اللغوية الفريدة، يبرز الضمير المنفصل بصفته بنية مستقلة، ورمزًا للوضوح النحوي والقوة البلاغية. إن انفصاله ليس مجرد شكل كتابي، بل هو إعلان عن استقلالية دلالية تمنحه وظائف لا يمكن لغيره تأديتها، بدءًا من الابتداء بالكلام وانتهاءً بتحقيق أغراض بلاغية عليا كالحصر والتوكيد. تسعى هذه المقالة إلى الغوص في أعماق هذا المبحث الدقيق، مستعرضةً تعريفه، وأنواعه، وأبعاده الإعرابية، كاشفةً عن الخلافات النحوية التي دارت حوله، ومبينةً كيف يشكل هذا “المُضمَر” المستقل ركنًا أساسيًا في فصاحة البيان العربي.
تعريف الضمير وأقسامه
يُطلق على الضمير في الاصطلاح النحوي مصطلح “المضمر”، وهذه هي تسمية نحاة البصرة، في حين يُطلق عليه نحاة الكوفة اسم “الكناية” أو “المكني”. ويُعد الضمير، الذي يُعرف اصطلاحًا بـ “المضمر” عند نحاة البصرة و**”الكناية”** عند نحاة الكوفة، حجر الزاوية في دراسة أبواب المعرفة. ويبدأ النحاة به عند تناول أنواع المعرفة، لأنه يُعد أعرفها على الإطلاق وأشدها وضوحًا، متجاوزًا بذلك أي اسم نكرة في درجة التعريف.
وقد اشتُقت تسمية “المضمر” من قولهم “أضمرت الشيء”، أي أخفيته في النفس، أو من “الضمور” الذي يعني الهُزال، وذلك لقلة عدد حروفه غالبًا. ويُضاف إلى ذلك، كما ورد في شرح المفصل، أن استخدام المضمرات يهدف إلى تحقيق الإيجاز وتجنب اللبس، مما يمنحه درجة عالية من المعرفة تميزه عن أي اسم نكرة. ويُقسم هذا النوع الأساسي من أنواع المعرفة إلى أقسام متعددة، وهي:
أ – بارز ومستتر.
ب – منفصل ومتصل.
ج – ضمائر رفع، ونصب، وجرّ.
وتتميز جميع هذه الضمائر، باعتبارها أساسًا في باب المعرفة، بأنها مبنية لشبهها بالحرف في الوضع، وهي بصفتها كيانًا معرفيًا لا تقبل التثنية أو الجمع أو التصغير، بعكس ما قد يحدث لاسم نكرة. وفي هذا السياق، يبرز الضمير المنفصل كبنية لغوية مستقلة بذاتها، تحمل دلالات عميقة ووظائف نحوية وبلاغية فريدة، تجعله محورًا أساسيًا لفهم جوهر المعرفة في اللغة العربية.
الطبيعة الاصطلاحية للضمير
يُعرَّف الضمير لغويًا من الفعل “أضمر”، أي ستر وأخفى، ويُطلق عليه أيضًا “المكني”. وقد رأى بعض النحاة أنه لا فرق بين “المضمر” و”المكني”، معتبرين إياهما من قبيل المترادفات. بينما رأى آخرون أن المضمرات هي نوع خاص من الكنايات، فكل مضمر هو مكني وليس العكس. فالكناية هي إقامة اسم مقام اسم آخر للتورية والإيجاز، وقد تكون بالأسماء الظاهرة مثل “فلان” و”كذا”، وحينئذٍ تكون اسم نكرة مبهمًا. وبما أن الكناية تشمل الأسماء الظاهرة والمضمرة، فإن المضمرات تُعد نوعًا منها. وتسميته “ضميرًا” أو “مضمرًا” تعد الأنسب قياسًا، لأنه من “أضمرته”، أي أخفيته.
أما في الاصطلاح النحوي، فيُعرَّف الضمير بأنه لفظ ذو بنية صغيرة، جامد ومبني، يدل باختلاف صيغته على معانٍ متباينة كالتكلم أو الخطاب أو الغيبة، مثل (أنا) للشخص الذي يتكلم، و(أنت) للشخص الذي تخاطبه، و(هو) للشخص الذي يُحكى عنه، أو لمخاطب تارة ولغائب أخرى مثل الألف والواو والنون في (اعملا، وعملا، واعملوا، وعملوا، واعملن، وعملن). وبسبب كونه مبنيًا، فإن الضمير لا يُثنى ولا يُجمع، وإنما يدل بلفظه وتكوين صيغته على المعنى المراد من تذكير أو تأنيث، وإفراد أو تثنية أو جمع، وهو بذلك يمثل أعلى درجات المعرفة.
مفسر الضمير
لا بد للضمير من مفسر يبين ما يُراد به، فإذا كان للمتكلم أو المخاطب، فمفسره هو حضور ذلك المتكلم أو المخاطب. أما إذا كان لغائب، فمفسره نوعان: لفظي وغير لفظي.
فالمفسر اللفظي هو ما يتقدم على الضمير، نحو قوله تعالى: (وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ) [يس: ٣٩]. والمعنى: قدرنا له منازل، فحذف الخافض، فتقدم (القمر) في اللفظ والتقدير، وعاد الضمير الذي هو معرفة عليه. وقد يتقدم الضمير في اللفظ دون التقدير، كقوله تعالى: (وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ) [البقرة: ١٢٤]، فـ”إبراهيم” مفعول به، فهو في نية التأخير. وقد يتقدم الضمير في التقدير دون اللفظ، كقوله تعالى: (فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ) [طه: ٦٧]، فـ”موسى” فاعل وهو في نية التقدير.
أما المفسر غير اللفظي، فمثاله قوله تعالى: (إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ) [القدر: ١]، أي أنزلنا القرآن، فالضمير “الهاء” يعود على مفهوم معلوم لدى السامع وهو القرآن الكريم، فهو في غنى عن التفسير اللفظي، مما يدل على قوة هذه المعرفة. ويدخل ضمن هذا النوع الضمير المؤخر في اللفظ والرتبة كضمير الشأن (هو) و(هي)، كما في قوله تعالى: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) [الإخلاص: ١]. ومنه أيضًا الضمير المخبر عنه بمفسره، كقوله تعالى: (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا) [المؤمنون: ٣٧]. وكذلك الضمير في باب “نعم” و”بئس”، كقوله تعالى: (بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا) [الكهف: ٥٠]، فإنه مفسر بالتمييز “بدلًا”، وهذا التمييز غالبًا ما يكون اسم نكرة.
وظيفة الضمير
تتمثل الوظيفة الأساسية للضمير في تحقيق الاختصار والإيجاز، حيث يُعد علامة على التكثيف في النص اللغوي. فاستعمال الضمير، الذي هو معرفة خالصة، يغني عن تكرار الاسم الظاهر الذي قد يكون اسم نكرة أو معرفة أخرى. وقد يكون الضمير على صورة الحرف دالًا على الاسم الظاهر ومؤديًا دلالته، وقد يدل على مسميات متعددة. قال تعالى: (قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ) [النمل: ٣٢]. فقد أغنى الضمير (نحن) عن ذكر الأسماء والألقاب والكُنى. كما أن الضمائر، ككاف الخطاب وياء المخاطبة، أغنت بدورها عن ذكر الاسم الظاهر.
ومن وظائف الضمائر الأسلوبية أنها تجنبنا التكرار الذي قد يشوه جمال العبارة، وترفع عنها الالتباس. فالأسماء الظاهرة، سواء كانت نكرة أم معرفة، كثيرة الاشتراك بعضها ببعض، واستعمال الضمير بدلاً منها ينفي هذا الاشتراك ويحدد المقصود على وجه الدقة.
تصنيفات الضمائر
أولًا: تُصنف الضمائر بحسب مدلولاتها إلى أنواع كثيرة؛ منها ما يدل على المتكلم مفرداً أو مجموعاً، ومنها ما يدل على المخاطب، ومنها ما يدل على الغائب. ومنها ما يُستعمل للمذكر أو المؤنث، وكلها تعد من باب المعرفة.
ثانيًا: تنقسم الضمائر بحسب اتصالها أو انفصالها إلى ضمائر منفصلة وضمائر متصلة، ويخدم كل نوع منها غرضًا بلاغيًا ونحويًا محددًا، على عكس الاسم النكرة الذي لا يتصف بذلك.
ثالثًا: تنقسم بحسب اختصاصها بالعاقل وحده أو بغيره؛ فمنها ما يختص بالعاقل وحده كضمائر المتكلم والمخاطب. ومنها ما هو مشترك بين ما يعقل وما لا يعقل كضمائر الغيبة، ما عدا واو الجماعة وضمير (هم) فيختصان بالعاقل.
ضمائر الرفع المنفصلة
تُعرَّف ضمائر الرفع المنفصلة بأنها تلك الضمائر التي تُكتب مستقلة عن غيرها من الكلمات وتأتي غالبًا في محل رفع. وقد تم البدء بها هنا، على غير المألوف عند كثير من النحويين، نظرًا لاستقلاليتها التامة وعدم حاجتها إلى عامل تتصل به. يبلغ عدد هذه الضمائر، التي تمثل قمة هرم المعرفة ودرجة المعرفة المطلقة، اثني عشر ضميرًا، وتُصنف على النحو الآتي:
١ – للمتكلم: أنا، نحن.
٢ – للمخاطب: أنتَ، أنتِ، أنتما، أنتم، أنتن.
٣ – للغائب: هو، هي، هما، هم، هن.
وقد سميت هذه الضمائر ضمائر رفع لأنها تقع غالبًا في محل رفع، ووُصفت بأنها منفصلة لأنها تُكتب مستقلة بنفسها، ولا تحتاج إلى كلمة تتصل بها، سواء كانت اسمًا أم فعلًا، فهي معرفة قائمة بذاتها. وتتسم هذه الضمائر بخصائص دقيقة تزيد من ثراء دلالتها باعتبارها معرفة محضة:
• في المتكلم: الضمير “أنا” يصلح للمذكر والمؤنث المتحدث عن نفسه. وفيما يتعلق بضمير المتكلم (أنا)، يرى نحاة البصرة أن الضمير الحقيقي هو “أنَ” بنون مفتوحة دون ألف، وينطبق الأمر ذاته على ضمائر الخطاب. وعلى النقيض من ذلك، يذهب الفراء إلى أن الضمير هو الكلمة الكاملة “أنا” و”أنت”، وهو الرأي الذي قد يُعد الأقوى والأثبت كما يُستشف من شرح المفصل. هذا التباين يوضح دقة التحليل في بنية هذه المعرفة الأساسية، التي تختلف جذريًا عن أي اسم نكرة. أما “نحن” فيصلح للذكور والإناث، ولما يكون مثنى أو جمعًا، كقولك: نحن مؤمنون، نحن مؤمنات. وإذا استُعمل في المفرد، فإنما يكون لمن يُعظِّم نفسه، كقولك: نحن نكرم الضيف، وأنت تريد تعظيم نفسك لا الجمع.
• في المخاطب: “أنتما” للمخاطبين أو المخاطبتين.
• في الغائب: “هما” للغائبين أو الغائبتين. وفيما يخص ضمير الغائبين (هم)، ذهب ابن عقيل إلى أنه يُستعمل في مواضع الرفع والنصب والجر، مستشهدًا بأمثلة مثل: (هم قائمون)، و(أكرمتهم)، و(لهم). غير أن في هذا الرأي نظرًا؛ فالصواب أن (هم) هو ضمير رفع بحد ذاته. أما في حالتي النصب والجر كما في (أكرمتهم) و(لهم)، فإن الضمير الذي يمثل المعرفة الحقيقية هو الهاء، في حين أن الميم تُعد حرفًا دالًا على الجمع وليست جزءًا أصيلًا من الضمير، وهو ما يؤكده ما ورد في همع الهوامع. وهذا التفصيل الدقيق يميز بنية المعرفة في الضمائر عن بنية الاسم النكرة.
ضمائر النصب المنفصلة
تأتي ضمائر النصب المنفصلة دائمًا في محل نصب، وتتميز أيضًا باستقلاليتها الكتابية واللفظية، مما يجعلها معرفة لا لبس فيها. يبلغ عددها اثني عشر ضميرًا أيضًا، وتُقسم على النحو الآتي:
١ – للمتكلم: إيايَ، إيانا.
٢ – للمخاطب: إياكَ، إياكِ، إياكما، إياكم، إيَّاكُن.
٣ – للغائب: إياهُ، إياها، إياهما، إياهم، إيَّاهُنَّ.
وقد سُميت ضمائر نصب لأنها تقع دائمًا في محل نصب، ووُصفت بأنها منفصلة لأنها تُكتب مستقلة بنفسها ولا تحتاج إلى ما تتصل به، فهي معرفة تامة. ويُلاحظ على هذه الضمائر ما يأتي:
• في المتكلم: “إيّايَ” يصلح للمتكلم مذكراً كان أو مؤنثاً. “إيانا” ويصلح للمتكلّم مذكراً كان أو مؤنثاً، في حالتي التثنية والجمع، كما يصلح للمُعَظِّم نَفْسَه، فتقول: إيانا تنادي، وأنت تريد المفرد المتكلم.
• في المخاطب: “إياكما” يصلح للمثنى المذكر والمثنى المؤنث.
• في الغائب: “إيَّاهما” يصلح للمثنى المذكر والمثنى المؤنث.
إن استخدام هذا النوع من الضمائر، الذي يمثل معرفة تامة، ليس خيارًا عشوائيًا، بل هو ضرورة بلاغية ونحوية في كثير من الأحيان. ففي قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥]، أدى تقديم الضمير المنفصل “إياك” إلى تحقيق معنى الحصر والقصر، أي لا نعبد إلا أنت. وهذا المعنى الدقيق كان سيضيع لو استُخدم الضمير المتصل “نعبدك”، الذي يقدم الحدث (العبادة) على المعبود. إن هذا الاختيار الدقيق لشكل المعرفة يبرز الفارق الجوهري بينها وبين أي اسم نكرة.
الخلاف في حقيقة ضمير النصب المنفصل
أثارت بنية ضمير النصب المنفصل خلافًا عميقًا بين النحاة، مما يدل على الأهمية التي أولوها لتحليل هذه المعرفة الفريدة. ويمكن تلخيص أبرز الآراء في النقاط الآتية:
١ – أن الضمير هو “إيّا”، وأن اللواحق المتصلة به (الكاف، الهاء، الياء) هي حروف تبين حال المتكلم أو المخاطب أو الغائب. وهذا هو مذهب سيبويه والفارسي والأخفش، وقد رجحه أبو حيان ونسب تصحيحه إلى أصحابه وشيوخه.
٢ – أن الضمير هو “إيّا” وقد أُضيفت إليه أسماء مضمرة أخرى مثل “نا” في “إيانا” والياء في “إياي”. وهذا هو مذهب الخليل بن أحمد والمازني وابن مالك، مما يجعل بنية هذه المعرفة مركبة.
٣ – أن هذه اللواحق هي الضمائر الحقيقية، وأن “إيّا” ما هي إلا حرف دعامة أو عماد تعتمد عليه هذه اللواحق لتظهر. وهذا هو مذهب الفراء، وهو تحليل يختلف في تحديد أصل المعرفة.
٤ – أن الضمير هو مجموع “إيّا” ولواحقها كوحدة كاملة (“إياك”، “إياه”). وهذا هو مذهب الكوفيين. وإلى جانب هذه الآراء، توجد تفصيلات أخرى في هذا الخلاف. ويُرجَّح هذا الرأي في التطبيق الإعرابي لكونه أيسر وأسهل، بالإضافة إلى أن الأصل في بنية الكلمات، سواء كانت معرفة أم نكرة، هو البساطة لا التركيب.
الأبعاد الإعرابية والبلاغية للضمير المنفصل
لا يقتصر دور الضمير المنفصل على كونه مجرد بديل للاسم الظاهر، بل هو أداة نحوية وبلاغية قوية. فإلى جانب دلالته على المعرفة المطلقة، فإنه يؤدي وظائف لا يمكن للضمير المتصل القيام بها.
• التوكيد: يُستخدم ضمير الرفع المنفصل لتوكيد الضمير المستتر، كما في قوله تعالى:
﴿اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾ [البقرة: ٣٥]فكلمة “أنت” هنا، وهي معرفة صريحة، جاءت لتوكيد الضمير المستتر “أنت” في الفعل “اسكن”، وهو شرط أساسي للعطف عليه.
• الابتداء: غالبًا ما يأتي ضمير الرفع المنفصل في محل رفع مبتدأ، مكونًا جملة اسمية واضحة المعالم، على عكس ما يمكن أن يبدأ به اسم نكرة.
﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الإخلاص: ١]فـ “هو” ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، وهو معرفة لا تحتاج إلى مفسر لفظي.
• الحصر والتقديم: يُستخدم ضمير النصب المنفصل لتحقيق معنى الحصر، أو لضرورة التقديم عندما لا يمكن اتصال الضمير بالعامل، كما في قوله تعالى:
﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾ [الإسراء: ٢٣]هنا، منع وجود أداة الحصر “إلا” من استخدام الضمير المتصل، فكان لا بد من الإتيان بالضمير المنفصل “إياه”، وهو معرفة مؤكدة.
إن كل هذه الاستخدامات تبرهن على أن الضمير المنفصل ليس مجرد معرفة، بل هو معرفة ذات استقلالية تمنحها قوة تعبيرية تتجاوز أي اسم نكرة. فهو كيان لغوي قائم بذاته، يرفض الاندماج ليحافظ على دلالته الخاصة.
وقد نظم الإمام ابن مالك في ألفيته هذه القواعد المتعلقة بالضمائر المنفصلة بنوعيها ببراعة فائقة حين قال:
وذو ارتفاعٍ وانفصالٍ: أنا هو *** وأنتَ، والفروعُ لا تشتبهُ
وذو انتصابٍ في انفصالٍ جُعِلا *** إيايَ، والتفريعُ ليسَ مُشكِلَا
وهكذا، يظل الضمير المنفصل شاهدًا على عبقرية اللغة العربية في بناء نظام متكامل من المعارف، حيث لكل شكل من أشكال المعرفة وظيفته التي تميزه عن غيره، وتجعله أبعد ما يكون عن غموض أي اسم نكرة.
خاتمة
يتضح مما سبق أن الضمير المنفصل ليس مجرد باب من أبواب النحو، بل هو عالم قائم بذاته يعكس عمق الفكر اللغوي العربي. فمن استقلاليته في اللفظ، إلى تربعه على عرش المعارف، مرورًا بالجدل النحوي الثري حول بنيته، وصولًا إلى وظائفه البلاغية الحاسمة في التوكيد والحصر والاختصار؛ يكشف الضمير المنفصل عن عبقرية اللغة العربية في نحت أدوات لغوية تجمع بين الإيجاز الشديد والوضوح التام. لم يكن الضمير المنفصل في نظر النحاة مجرد مكون نحوي جامد، بل هو مفتاح لفهم دقة الصياغة وقوة التعبير. وهكذا، فإنه ليس مجرد بديل عن اسم، بل هو هوية لغوية مستقلة، وشاهد حي على أن أصغر الكلمات قد تحمل أعمق الدلالات، وتظل ركنًا أصيلًا في فهم أسرار البيان العربي وإعجازه.
الأسئلة الشائعة
١ – ما الفرق الدقيق بين مصطلحي “المضمر” و”الكناية” عند النحاة؟
الإجابة: الفرق بين المصطلحين يعكس اختلافًا بين المدارس النحوية ورؤيتها للتصنيف. “المضمر” هو مصطلح نحاة البصرة، وهو مشتق من الإضمار أي الإخفاء، ويركز على طبيعة الضمير كلفظ يخفي الاسم الظاهر ويحل محله. أما “الكناية” فهو مصطلح نحاة الكوفة، وهو أعم وأشمل. فالعلاقة بينهما هي علاقة عموم وخصوص؛ إذ يرى بعض المحققين أن “كل مضمر هو مكني، وليس كل مكني مضمرًا”. فالكناية تشمل أي لفظ يُكنى به عن اسم آخر للإيجاز أو التورية، وهذا قد يشمل أسماء ظاهرة مبهمة مثل “فلان” و”كذا”، وهي أسماء نكرات. أما المضمر (الضمير) فهو نوع خاص من الكناية، يتميز بكونه مبنيًا ويمثل أعلى درجات التعريف، بينما الكنايات الأخرى قد تكون نكرات. لذا، فمصطلح “المضمر” أكثر تحديدًا ودقة في وصف الضمائر المعروفة (أنا، هو، إياك…).
٢ – لماذا يُعد الضمير “أعرف المعارف”، متجاوزًا حتى اسم العلم؟
الإجابة: يُعتبر الضمير “أعرف المعارف” لأنه الأكثر تحديدًا والأقل احتمالاً للبس والاشتراك. فدلالته تتحدد بشكل قاطع وحصري من خلال السياق المباشر. فضمائر المتكلم (“أنا”، “نحن”) والمخاطب (“أنتَ”، “أنتِ”…) تدل على ذوات حاضرة في مقام الخطاب، مما ينفي أي احتمال للغموض. أما اسم العلم، مثل “محمد”، فقد يشترك فيه آلاف الأشخاص، ولا يتم تعيين المقصود به إلا بقرائن إضافية. وحتى ضمير الغائب (“هو”)، على الرغم من أنه يحتاج إلى مفسر، فإنه بمجرد ارتباطه بمرجعه يصبح شديد الوضوح ومحصورًا فيه داخل النص. هذه الطبيعة الأحادية والحصرية في الدلالة هي التي تمنح الضمير المرتبة الأعلى في سلم التعريف، وتجعله أداة لغوية فائقة الدقة.
٣ – كيف يحلل النحاة بنية ضمير مثل “هم” في حالات الإعراب المختلفة؟
الإجابة: أثار تحليل ضمير مثل “هم” نقاشًا دقيقًا. فبينما ذهب ابن عقيل إلى أنه يُستخدم في محل رفع ونصب وجر، مستشهدًا بأمثلة مثل “هم قائمون”، “أكرمتهم”، “لهم”، فإن الرأي النحوي الأكثر دقة وتحقيقًا يفرق في بنية الضمير حسب موقعه. فالصواب أن “هم” بكاملها هي ضمير رفع منفصل. أما في حالتي النصب والجر، كما في “أكرمتهم” و”لهم”، فإن الضمير الحقيقي هو حرف الهاء فقط (ـهـ)، وهو الذي يقع في محل نصب أو جر. أما الميم (ـم) فهي ليست جزءًا أصيلاً من الضمير، بل هي حرف زائد جيء به للدلالة على جمع الذكور العقلاء، ولا محل له من الإعراب. هذا التحليل الدقيق يوضح أن بنية الضمير تتغير وظيفيًا، ويفصل بين ما هو ضمير أصلي وما هو مجرد علامة صرفية.
٤ – ما هي أبرز الآراء في الخلاف النحوي حول بنية ضمير النصب المنفصل مثل “إياك”؟
الإجابة: يعد الخلاف حول بنية ضمير النصب المنفصل من أشهر المسائل الخلافية بين النحاة، ويمكن تلخيص أبرز الآراء في أربعة مذاهب رئيسية:
- مذهب سيبويه وجمهور البصريين: يرى أن الضمير هو المقطع “إيّا” وحده، أما اللواحق (الكاف، الهاء، الياء…) فهي مجرد حروف لا محل لها من الإعراب، جيء بها لبيان حالة المخاطب أو الغائب أو المتكلم.
- مذهب الخليل بن أحمد وابن مالك: يرى أن الضمير مركب من جزأين؛ “إيّا” وهي اسم مضمر، أُضيفت إليه أسماء مضمرة أخرى هي الكاف والهاء والياء. فبنية الضمير هنا مركبة من مضاف ومضاف إليه.
- مذهب الفراء وبعض الكوفيين: يرى العكس تمامًا؛ فالضمائر الحقيقية هي اللواحق (الكاف، الهاء، الياء)، أما “إيّا” فليست ضميرًا ولا اسمًا، بل هي مجرد “دعامة” أو “عماد” تتكئ عليه هذه الضمائر لتظهر منفصلة.
- مذهب الكوفيين: يرى أن الضمير هو الكلمة بأكملها (“إياك”، “إياه”) كوحدة واحدة غير قابلة للتجزئة. ويُعد هذا الرأي هو الأسهل والأيسر في التطبيق الإعرابي، ويُرجَّح عمليًا لأن الأصل في بنية الكلمات هو البساطة لا التركيب.
٥ – ما هي الحالات التي يجب فيها استخدام الضمير المنفصل بدلًا من المتصل؟
الإجابة: يجب استخدام الضمير المنفصل في حالات لا يصح فيها نحويًا أو بلاغيًا استخدام الضمير المتصل، وأبرز هذه الحالات:
- عند الابتداء: لا يمكن بدء الكلام بضمير متصل، لذا يُستخدم ضمير الرفع المنفصل ليكون مبتدأ، مثل: “هو الغفور الرحيم”.
- بعد أداة الحصر “إلا”: لا يتصل الضمير بما قبله لوجود فاصل، فيجب انفصاله، مثل قوله تعالى: “وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ”.
- للتوكيد اللفظي: يُستخدم ضمير الرفع المنفصل لتوكيد ضمير مستتر أو متصل، مثل: “اسكن أنتَ وزوجك الجنة”، فـ”أنتَ” توكيد للضمير المستتر في “اسكن”.
- عند تقديم المعمول على عامله: إذا قُدِّم الضمير (المفعول به) على فعله لغرض بلاغي كالحصر والاختصاص، وجب انفصاله، مثل: “إياك نعبد”، ولو تأخر لاتصل (“نعبدك”).
- عند عدم وجود عامل يتصل به: إذا حذف العامل وبقي المعمول، وجب انفصال الضمير، كأن تسأل: “من أكرمت؟” فتجيب: “إياك”، والتقدير: “أكرمت إياك”.
٦ – ما القيمة البلاغية لتقديم ضمير النصب المنفصل في قوله تعالى “إِيَّاكَ نَعْبُدُ”؟
الإجابة: القيمة البلاغية هنا عظيمة وتكمن في أسلوب “التقديم والحصر”. فالأصل في الجملة الفعلية أن يأتي الفعل ثم المفعول به (“نعبدك”). لكن بتقديم المفعول به، وهو الضمير المنفصل “إياك”، على فعله “نعبد”، يتحقق معنى “الحصر والقصر”. فالمعنى لا يصبح مجرد إخبار بأننا نعبد الله، بل يصبح إقرارًا بأننا نعبد الله وحده دون سواه، ونقصر العبادة عليه حصرًا. هذا الأسلوب ينفي العبادة عن كل ما سوى الله قبل إثباتها له، مما يجعله أبلغ وأقوى في التعبير عن التوحيد الخالص. لو قيلت “نعبدك”، لأدت المعنى الأصلي للعبادة، لكنها تفتقر إلى قوة النفي الضمني والحصر المؤكد الذي أضافه التقديم.
٧ – لماذا كان استخدام الضمير المنفصل “أنت” ضروريًا في آية “اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ”؟
الإجابة: كان استخدام الضمير المنفصل “أنتَ” ضروريًا لسببين، أحدهما بلاغي والآخر نحوي إلزامي. بلاغيًا، جاء الضمير لتوكيد الخطاب وتخصيصه لآدم عليه السلام، فهو توكيد لفظي للضمير المستتر وجوبًا في فعل الأمر “اسكن” والذي تقديره “أنت”. أما السبب النحوي الإلزامي، فهو أنه لا يجوز في اللغة العربية الفصيحة العطف على الضمير المستتر مباشرة، فلا يصح أن يقال: “اسكن وزوجك الجنة”. لذلك، كان لا بد من إبراز الضمير المستتر بضمير منفصل ظاهر (“أنتَ”) ليصح العطف عليه، فيكون “زوجك” معطوفًا على الضمير الظاهر المؤكِّد، وليس على الضمير المستتر.
٨ – ما هو “مفسّر الضمير”، وما الفرق بين مفسره اللفظي وغير اللفظي؟
الإجابة: مفسّر الضمير هو المرجع أو العائد الذي يوضح دلالة ضمير الغائب ويزيل إبهامه. وينقسم إلى نوعين:
- المفسّر اللفظي: وهو اسم ظاهر مذكور صراحة في الكلام يسبق الضمير رتبةً، سواء سبقه لفظًا أم لا. ومثاله قوله تعالى: “وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ”، فالضمير “الهاء” في “قدرناه” يعود على “القمر” المذكور قبله. وقد يتقدم الضمير لفظًا وتتأخر رتبته، كما في “وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ”، فالضمير “الهاء” في “ربه” يعود على “إبراهيم” المتأخر لفظًا ولكنه متقدم رتبةً لأنه مفعول به.
- المفسّر غير اللفظي (المقامي): وهو ما يُفهم من سياق الكلام ومقامه دون أن يُذكر لفظه، لأن المقام يدل عليه بوضوح. ومثاله قوله تعالى: “إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ”، فالضمير “الهاء” يعود على القرآن الكريم، وهو أمر معلوم لدى السامع من مقام الحديث عن نزول الوحي، فلا حاجة لذكره لفظًا. ويدخل في هذا الباب “ضمير الشأن” مثل “هو” في “قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ”.
٩ – ما العلة النحوية في كون جميع الضمائر مبنية وليست معربة؟
الإجابة: العلة الأساسية في بناء الضمائر هي “شبهها بالحرف”، وهو شبه أصيل في بنيتها. هذا الشبه يتجلى في عدة جوانب، أبرزها “الشبه الوضعي”، أي أنها وُضعت في الأصل على حرف واحد (مثل تاء الفاعل) أو حرفين (مثل “نا” الفاعلين)، تمامًا مثل حروف المعاني (كالباء والواو). ولأن الحروف كلها مبنية، فإن كل ما أشبهها من الأسماء أخذ حكمها وهو البناء. بالإضافة إلى ذلك، الضمائر ألفاظ جامدة لا تتصرف، ودلالتها على الإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث تأتي من أصل صيغتها وهيئتها، وليس من خلال علامات إعرابية تلحق آخرها، مما يجعل الإعراب غير ضروري وظيفيًا لها.
١٠ – كيف يسهم استخدام الضمائر في تحقيق الإيجاز وتجنب التكرار في النص؟
الإجابة: تمثل الضمائر أداة أساسية لتحقيق الإيجاز والاختصار، وهي من أهم سمات البلاغة العربية. فبدلًا من تكرار الاسم الظاهر في كل مرة يُشار إليه، وهو ما قد يسبب ثقلاً في اللفظ ورتابة في الأسلوب، يأتي الضمير ليقوم مقامه بلفظ موجز ومختصر. على سبيل المثال، في قوله تعالى: “قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ…”، أغنى الضمير “نحن” عن إعادة ذكر أسماء القوم وألقابهم وصفاتهم. كما أن استخدام الضمير يرفع الالتباس الذي قد ينشأ عن تكرار الأسماء المشتركة. فبإحالته على مرجع محدد، يضمن الضمير دقة المعنى واستمرارية الترابط بين أجزاء النص دون الحاجة إلى التكرار اللفظي الذي قد يشوه جمال العبارة ويبطئ إيقاعها.