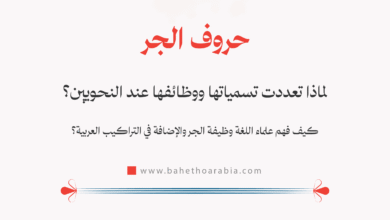أسلوب العطف: شرح أكاديمي لأحرف العطف وقواعده المتقدمة
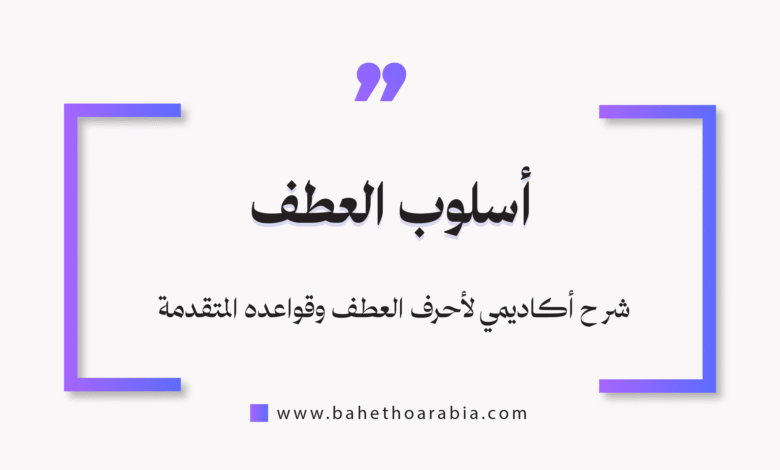
تعد اللغة العربية بحرًا زاخرًا بالدقة والبلاغة، ولا يمكن الإبحار في هذا البحر دون فهم أدوات الربط التي تمنح الجمل ترابطها ومنطقها وقوتها التعبيرية. وفي قلب هذه الأدوات يتربع أسلوب العطف، فهو ليس مجرد قاعدة نحوية، بل هو فن الربط بين الكلمات والجمل، الذي يتيح لنا الجمع والمقارنة والاستدراك والتخيير بدقة متناهية. هذا المقال ليس مجرد سرد للقواعد، بل هو رحلة أكاديمية معمقة لاستكشاف كل جوانب العطف، من أبسط أحرفه ودلالاتها، إلى أكثر تطبيقاته النحوية والبلاغية تعقيدًا، مما يمكّن القارئ من استيعاب هذا الباب الأساسي في النحو العربي استيعابًا كاملاً ووافيًا.
مفهوم العطف وأحرفه الأساسية
تُعَدّ أحرف العطف أدوات ربط أساسية في اللغة العربية، وهي: الواو، الفاء، وثمّ، وحتى، وأم، وأو، وبل، ولكن، ولا. ويمكن تصنيف أحرف العطف هذه إلى قسمين رئيسيين: قسم يجعل المعطوف مشاركاً للمعطوف عليه في المعنى والحكم الإعرابي، ويشمل هذا القسم أحرف العطف التالية: (الواو، والفاء، وثمّ، وحتى، وأم، وأو). أما القسم الثاني، فهو يجعل المعطوف مخالفاً للمعطوف عليه في المعنى والحكم، ويضم أحرف العطف الآتية: (بل، ولكن، ولا). ومن الجدير بالذكر أن جميع أحرف العطف تشترط إشراك المتعاطفين في الحركة الإعرابية، وهو من ثوابت أسلوب العطف.
معاني أحرف العطف ودلالاتها
١- الواو: يتمثل المعنى الأساسي للواو في عملية العطف في الجمع بين المتعاطفين، وإشراكهما في حكم العطف من غير دلالة على معانٍ أخرى كالترتيب، أو المصاحبة، أو التعقيب، أو السببية، أو غير ذلك من الدلالات. ولذلك، أقرّ النحويون بأنها تفيد مطلق الجمع في أسلوب العطف. ومثال ذلك قولك: سنحمي الوحدة والحرية والاشتراكية. فالواو هنا عطفت الحرية على الوحدة، وعطفت الاشتراكية على الوحدة. وهنا، لا يدل العطف بالواو على ترتيب في الحماية، فقد نحمي الاشتراكية أولاً، والحرية ثانياً، والوحدة ثالثاً، وقد نفعل غير ذلك. كما أنها لا تدل على المصاحبة، فقد نحمي هذه الأهداف معاً، وقد نحمي بعضها قبل بعضها الآخر. ومثال آخر: جاء خالد وعلي. فهذه الجملة تحتمل مجيء خالدٍ أولاً وعليٍّ ثانياً، وتحتمل العكس، وتحتمل مجيئهما معاً، فلا دلالة لواحدة من هذه الاحتمالات. وقال تعالى: (إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا). فقد عطف (نحيا)، وهو المتقدم، على (نموت)، وهو المتأخر، مما يؤكد أن هذا العطف لا يفيد الترتيب.
٢- الفاء: تفيد الفاء في سياق العطف معنيين أساسيين هما الترتيب والتعقيب. ويتمثل معنى الترتيب في العطف بالفاء في أن المعطوف عليه يسبق المعطوف في الرتبة، وأن المعطوف يأتي مقصوداً بعد المعطوف عليه مباشرة، فلا توجد مهلة زمنية بينهما. ومثال ذلك قولك: (أُلقيت محاضرة النحو فالبلاغة). فمحاضرة النحو أُلقيت قبل محاضرة البلاغة، وجاء إلقاء محاضرة البلاغة عقب إلقاء محاضرة النحو مباشرة، والفترة بينهما قصيرةٌ جداً، أو بلا مهلة. وتقول: دخل المدرس فوقف الطلاب. فالفاء هنا دلّت على الترتيب والتعقيب في هذا التركيب من العطف. إضافة إلى ذلك، قد تحمل الفاء في بعض تراكيب العطف معنى ثالثاً وهو السببية، حيث يكون المعطوف مسبباً عن المعطوف عليه. مثال ذلك قولك: (إنكم لمدافعون عن الحق فمنتصرون، فمكافئون على انتصاركم)، فالنصر سببه الدفاع عن الحق، والمكافأة سببها النصر.
٣- ثم: تُستخدم (ثمّ) في العطف للدلالة على الترتيب مع المهلة الزمنية، فهي تشبه الفاء في الدلالة على الترتيب، ولكنها تخالفها في الدلالة على وجود مهلة. ومعنى المهلة أن بين المتعاطفين تراخياً في الزمن، ولذلك يقول النحويون: إنها للترتيب والتراخي. ومثال ذلك: (ذهبت إلى الخدمة الإلزامية، ثم سُرِّحتُ منها، ثم دُعيت إلى الخدمة الاحتياطية). فالترتيب والتراخي واضح بين المتعاطفات في هذا الأسلوب من العطف. وقال تعالى: {مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ، ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ، ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ}. فالمتعاطفات التي بينها مهلة كانت أداة العطف المستخدمة هي (ثم)، ولمّا لم يكن بين الموت والقبر مهلة جاء العطف بالفاء. وقال الشاعر:
وعَدَتْك ثُمّةَ أخلفت موعودها *** ولعلّ ما منعتك ليس بضائر
٤- حتى: يُعد استخدام (حتى) كأداة العطف قليلاً نسبياً، وحينما تُستخدم في العطف، فإنها تعطف المفردات لا الجمل، وتُعرب حرف غاية وعطف. فهي تدل على المشاركة في الحكم، وعلى أن المعطوف في هذا النوع من العطف يمثل غاية للمعطوف عليه. ولذلك يُشترط فيها أن يكون المعطوف بعضاً من المعطوف عليه، وغاية له. مثال ذلك قولك: (شارك في المهرجان الناسُ حتى الأطفالُ)، و(يُحترم أصحاب الرأي الصحيح حتى الصغار). فالأطفال بعض الناس وغاية لهم، والصغار بعض أصحاب الرأي الصحيح وغاية لهم.
٥- أم: لا تؤدي (أم) وظيفة العطف إلا إذا جاءت بعد همزة الاستفهام الظاهرة أو المقدرة، وأريدَ بها وبهمزة الاستفهام تعيين أحد المتعاطفين أو التسوية بينهما، وإلا فإنها تُعتبر (أم) المنقطعة، التي لا تُصنف ضمن أحرف العطف بل كحرف إضراب. مثال ذلك قولك: أقريب تحقيقُ الآمال أم بعيد؟ أصعبُ نجاحنا أم سهل؟ وما أدري اجاهل عدوّنا أم متجاهلُ؟ وقال الشاعر:
فقُمتُ للّطيْفِ مُرْتَاعاً فأرّقني *** فقلتُ: أهْي سَرَت أم عادني حُلُمُ
والمطلوب في الجمل السابقة تعيين أحد الشيئين المتعاطفين، ولا بدّ في الإجابة من تعيين أحدهما. وقال تعالى: {وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ}. فقد قُصِد بالهمزة و(أم) في الآية التسوية، والدليل على ذلك الخبر (سواء). وقال الشاعر:
ولستُ أُبالي بَعدَ فَقْدي مالكاً *** أمَوْتي ناءٍ أمْ هو الآنَ واقِعُ؟
وقد تُحذف الهمزة، وتدل عليها (أم)، كما في قول الشاعر:
فوالله ما أدري وإنْ كُنتُ داريا *** بسبْعٍ رَمَين الجمرَ أمْ بثمانِ؟
والتقدير هو: أبسبع رمين الجمر أم بثمان؟
٦- أو: يتمحور المعنى الأساسي للحرف (أو) في أسلوب العطف حول الدلالة على أحد الشيئين المتعاطفين، حيث يكون أحدهما هو المقصود بالحكم. وقد ذكر لها النحويون معاني تفصيلية كثيرة، منها:
أ- التخيير: ومثاله: (كن بحاراً أو طيّاراً، واهتمّ بالعلم أو التجارة). فالجمع بين المتعاطفين صعب أو محال، ولذلك يختار المخاطب أحدهما.
ب- الإباحة: ومثاله: (شارك في بناء الوطن بالسيف أو بالقلم، وأسهم في المعركة بالدم أو المال). فالجمع بين المتعاطفين ممكن، ويُباح للمخاطب الاكتفاء بأحدهما، ويمكن له أن يؤديهما معاً.
ويتضح مما سبق أن الفرق بين الإباحة والتخيير في العطف باستخدام (أو) هو أن المتعاطفين يجوز الجمع بينهما في الإباحة، ولا يجوز الجمع بينهما في التخيير.
ج- التقسيم: ومثاله: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، والزمن ليلٌ أو نهار.
٧- لكن: تختص (لكن) في باب العطف بعطف المفردات دون الجمل، وإذا سُبقت بالواو فإن الواو هي التي تقوم بمهمة العطف، وتكون هي حرف استدراك. ولكي تؤدي وظيفتها في العطف، لا بد أن تُسبق بالنفي أو النهي، كقولك: (ما حاولنا ذلاً لكن عزّاً). فالمعنى هنا هو إثبات النفي لما قبلها، فنحن لم نحاول الذلّ، أما ما بعدها فالحكم له ثابت وليس منفياً، فلقد حاولنا عزّاً. وتقول: (لا تجرب فساداً لكنْ إصلاحاً). فالمعنى هو النهي عن تجريب الإفساد، والأمر بتجريب الإصلاح. فإن سُبقت بالواو، فالواو هي العاطفة، وتبقى (لكن) حرف استدراك، وكذلك إذا جاء بعدها جملة فهي حرف استدراك، كما في قول الشاعر:
إنّ ابنَ وَرْقاء لا تُخشى غوائله *** لكن وقائعه في الحرب تنتظر
وإذا سُبقت بغير النفي أو النهي فهي ليست حرف العطف، بل هي حرف ابتداء واستدراك.
٨- بل: تُستخدم (بل) في العطف للمفردات، وتُسبَق بكلام مثبت أو منفي أو بأسلوب الأمر أو النهي. فإذا سُبقت بالكلام المثبت أو بأسلوب الأمر؛ فإنها تؤدي وظيفة الإضراب في العطف، حيث تثبت الحكم لما بعدها وتنفيه عما قبلها. مثال ذلك: (سأكرم الخطباء بل الفدائيين)، و(حي المواطن بل المناضلَ لتحقيق أهداف أمته المضحّى بدمه). فقد أضربت في الجملة الأولى عن إكرام الخطباء، وأثبتّه للفدائيين، وأضربت في الجملة الثانية عن تحية المواطن، وأثبتّ التحية للمناضل المضحي بدمه. وقال الشاعر:
أصبحتُ منْ حُبِّ لبنى بلْ تذكّرِها *** في كربةٍِ ففُؤادي اليومَ مشغُولُ
وإذا سُبقت بالنفي أو النهي فإنها تثبت النفي أو النهي لما قبلها، أما ما بعدها فالحكم له ثابت من غير نفي أو نهي. ومثاله: (لا نؤيد التكاسل بل الجدّ والعمل). فمعنى الجملة نفي تأييد الكسل، وتأييد الجد والعمل. وتقول: (لا تصدّق الأكاذيب بل قولَ الحقَّ). ومعنى الجملة النهي عن تصديق الكذب، والمطالبة بتصديق قول الحق.
٩- لا: تُستعمل (لا) في العطف لربط المفردات حصراً وليس الجمل. وتُعتبر أداة العطف هذه فعالة إذا سُبقت بكلام مثبت أو بأسلوب الأمر، فيصبح ما بعدها منفياً، ويؤكد ثبوت ما قبلها. مثال ذلك: قمت بواجبي حباً لا كرهاً، وأكرمُ الطيبين لا الأشرار، وعاقب المذنب لا البريء. وقال الشاعر:
فقالت: لقد أزرى بك الدهرُ بعدنا *** فقلتُ: معاذ الله، بل أنت لا الدهرُ
قواعد المطابقة في العطف
أ- العطف بين الأفعال (عطف الفعل على الفعل): يُشترط في هذا النوع من العطف أن يتّحد الفعلان في الدلالة على الزمن، وإن كان أحدهما بصيغة الماضي والآخر بصيغة المضارع. قال تعالى: {وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ}. فالفعلان المتعاطفان زمنهما هو المستقبل، وصيغتهما هي صيغة الفعل المضارع. وقال تعالى: {وَإِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا}. فالفعلان المتعاطفان مختلفان في الصيغة، ولكنهما متفقان في الدلالة على الزمن المستقبل بدلالة (إنْ).
ب- العطف بين الفعل والاسم: يجوز هذا النوع من العطف إذا كان الاسم من المشتقات؛ لأن فيها دلالة على الفعل والزمن. قال تعالى: {فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا}. فقد عطف الفعل (أثرن) على اسم الفاعل (المغيرات). وقال تعالى: {أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ}. فقد عطف الفعل أو الجملة الفعلية (يقبضن) على اسم الفاعل (صافات). ويُعد العطف للاسم على الفعل قليلاً، ومثاله: خرجت اجرُّ ثوبي ومختالاً. فقد عُطِف الاسم (مختالاً) على جملة (أجر).
أحكام العطف على الضمير
١- العطف على الضمير المرفوع: لا يصح العطف على ضمير الرفع المتصل أو المستتر إلا بعد الفصل بين المتعاطفين بفاصل أو بضمير مؤكد. قال تعالى: {اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ}. فقد عطف الاسم (زوجك) على ضمير الرفع المستتر، وهو فاعل الفعل (اسكن)، بعد أن جاء الضمير المؤكد (أنت). وقال تعالى: {مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا}. عطف الاسم (آباؤنا) على الضمير (نا)، وهو في محل رفع فاعل، وقد فُصل بين المتعاطفين بفاصل هو (لا).
٢- العطف على الضمير المجرور: تقتضي قاعدة العطف في هذه الحالة إعادة الجار سواء أكان حرف جر أم مضافاً. قال تعالى: {فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا}. فقد أعيد حرف الجر اللام في (للأرض)؛ لأن العطف تم على الضمير المجرور في (لها). وقال تعالى: {قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ}.
٣- العطف على الضمير المنصوب: يجيز النحاة العطف بالاسم الظاهر على الضمير المنصوب بلا شروط. قال الشاعر:
فلمّا تفرّقنا كأني ومالكاً *** لطول اجتماعٍ لم نبت ليلةً معا
فقد عطف (مالكاً) على اسم (إنّ) وهو ياء المتكلم.
العطف بين المصادر: المؤول والصريح
يجوز في قواعد العطف أن يُعطف المصدر المؤول على المصدر الصريح. قال تعالى: {اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ}. فقد تم العطف هنا بالمصدر المؤول على المصدر الصريح، والتقدير: اذكروا نعمتي وتفضيلي.
الحذف في أسلوب العطف
يُمكن في بعض سياقات العطف حذف حرف العطف والمعطوف معاً إذا دلّ المعنى عليهما، ويكون ذلك في أحرف العطف (الفاء) و(الواو) و(أم). قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}. فقد تم حذف حرف العطف (الفاء) والجملة التي بعده، والتقدير: (من كان منكم مريضاً أو على سفر، فأفطر، فعِدّة من أيام أخر). وقد دلّ المعنى على هذا الحذف. وقال الشاعر:
فما كان بين الخير لو جاء سالماً *** أبو حَجَرٍ إلا ليالٍ قلائل
والمعنى هو: فما كان بين الخير وبيني، وقد دلّ الظرف (بين) والمعنى على حرف العطف والظرف المعطوف المحذوفين. وقال الشاعر:
دعاني إليها القلب، إني لأمره *** سميعٌ، فما أدري أرُشدٌ طلابُها
فقد حذف حرف العطف (أم) والاسم المعطوف، والتقدير: أرشدٌ طلابها أم غيٌّ.
العطف على المحل الإعرابي
عندما يكون للمعطوف عليه محل إعرابي، وحركة لفظية مغايرة لحركة محلّه الإعرابي، يجوز في العطف مراعاة اللفظ أو مراعاة المحل. ومثال ذلك: ليس خالدٌ ببخيل ولا جباناً. فقد عطف (جباناً) بالنصب على محل (بخيل)، وهو مجرور لفظاً مرفوع محلاً. ويندرج تحت هذا النوع من العطف حالات العطف على المجرور بحرف جر زائد، والعطف على المضاف إلى اسم الفاعل، والعطف على المضاف إلى المصدر. قال الشاعر:
معاويُّ إننا بَشَرٌ فأسجِجِ *** فلسْنا بالجبالِ ولا الحديدا
هنا تم عطف الاسم المنصوب (الحديدا) على خبر (ليس) المجرور بحرف الجر الزائد الباء (بالجبال). وقال تعالى: {وَجَاعِلِ اللَّيْلِ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا}. فقد عطف الاسم المنصوب (الشمس) على المضاف إلى اسم الفاعل (الليل). وتقول: (عجبت له من ضربِ زيدٍ وعمراً). فقد عطف الاسم المنصوب (عمراً) على المضاف إلى المصدر (زيد)، وهو مفعول به في المعنى.
العطف على التوهم: حالة خاصة
يُمثل العطف على التوهم نمطاً خاصاً وقليلاً من العطف، وقد ورد في الشعر العربي، وهو يعتمد على كثرة مجيء المعطوف على صورة معينة لها حركة إعرابية، ولكن المعطوف لم يتبع هذه الصورة في تركيب العطف الفعلي. قال الشاعر:
بدا لي أني لست مدركَ ما مضى *** ولا سابقٍ شيئاً إذا كان جائيا
فالشاعر هنا عطف الاسم (سابق) مجروراً على (مدرك)، وهو خبر (ليس) منصوب، والسبب في ذلك أن خبر (ليس) يكثر أن يأتي مجروراً بحرف الجر الزائد (الباء)، فقد توهم الشاعر أن المعطوف عليه مجرور بحرف الجر الزائد، فعطف عليه الاسم مجروراً.
خاتمة
بعد هذه الجولة التحليلية في عالم العطف، بدءًا من تعريف أحرفه الأساسية واستعراض معانيها الدقيقة، وصولًا إلى تطبيقاته المتقدمة كالعطف على المحل والعطف على التوهم، يتضح أن العطف ليس مجرد قاعدة نحوية جامدة، بل هو أداة حية تمنح النص مرونة فائقة ودقة متناهية وجمالًا بيانيًا. إن إتقان أساليب العطف هو بمثابة امتلاك مفتاح من مفاتيح البلاغة، وهو السبيل لفهم أعمق لترابط النصوص القرآنية والشعرية والنثرية، ويفتح الباب أمام تعبير أكثر نضجًا وعمقًا، مما يؤكد عظمة اللغة العربية وقدرتها اللامتناهية على التعبير.