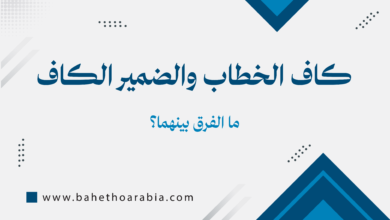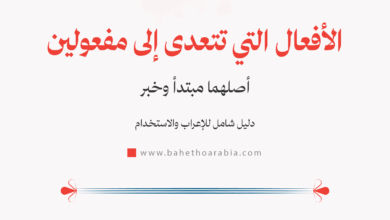ضمير الفصل: تعريفه وإعرابه وشروطه ووظائفه
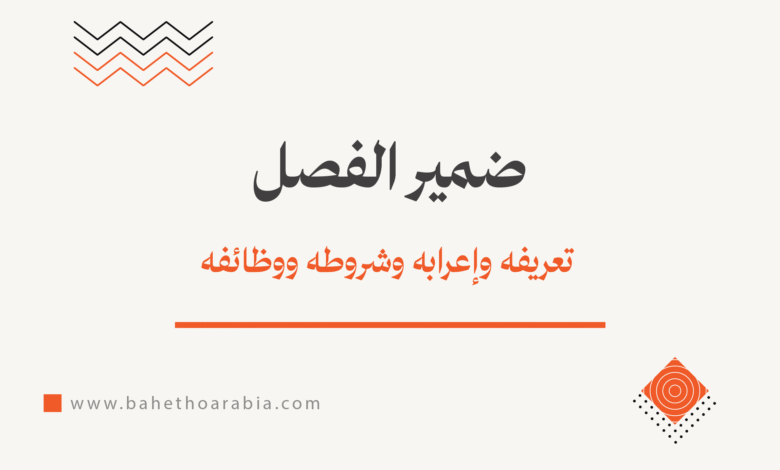
تزخر اللغة العربية بظواهر نحوية دقيقة وأساليب تركيبية فريدة، تعمل على إثراء المعنى وتحديد الدلالة ومنع اللبس. ويُعَدُّ “ضمير الفصل” أحد هذه الأساليب التي حظيت بعناية النحويين والبلاغيين على مر العصور، نظراً لدوره المزدوج في البنية التركيبية والدلالة البلاغية. وقد شكّل هذا التركيب النحوي محوراً للنقاش بين المدرستين البصرية والكوفية، سواء في تسميته أم في تحديد طبيعته النحوية وإعرابه. تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل أكاديمي شامل لضمير الفصل، مستعرضةً تعريفه اللغوي والاصطلاحي، والخلافات التاريخية حول تسميته، والجدل القائم حول كونه اسماً أم حرفاً، بالإضافة إلى استعراض الآراء المختلفة في إعرابه. كما ستتناول الدراسة بالتفصيل الشروط الدقيقة لاستعماله، وتُبرز وظائفه المتعددة التي تتجاوز الفصل النحوي لتشمل أغراضاً بلاغية رفيعة كالتقوية والتوكيد والقصر، معتمدةً في ذلك على الشواهد القرآنية الكريمة التي تُعد المصدر الأسمى للاستدلال اللغوي.
تعريف ضمير الفصل
يُعرَّف “الضمير” في اللغة بأنه الإخفاء والستر، فيُقال: أضمر الشيء، أي أخفاه. ويُقال: أضمر شيئاً في نفسه، أي عزم عليه بقلبه. ويُطلق عليه عند أهل الكوفة مصطلح “الكناية”، وهي كلمة تحمل أيضاً معنى الخفاء والستر. أما “الفصل” لغةً، فهو مصدر الفعل “فَصَلَ”، وقد ورد في قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَينَهُمْ}، بمعنى يقضي ويحكم.
ضمير الفصل في الاصطلاح النحوي
يُعرَّف ضمير الفصل اصطلاحاً بأنه صيغة ضمير رفع منفصل يتوسط بين عنصرين، وهما:
أ – المبتدأ والخبر، ومثاله قوله تعالى: {أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقّاً}.
ب – ما كان أصله مبتدأً وخبراً، كما في اسم وخبر “كان” وأخواتها، واسم وخبر “إن” وأخواتها، ومفعولي “ظن” وأخواتها. ومن أمثلته قوله تعالى: {وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا هُمُ الظَّالِمِينَ}، وقوله تعالى: {إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}، وقوله تعالى: {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ}.
تسميات ضمير الفصل عند العلماء
يُعد الخليل بن أحمد الفراهيدي أول من أطلق على ضمير الفصل هذا الاسم، وقد تبعه في ذلك سيبويه الذي عقد باباً في كتابه بعنوان: “هذا باب ما يكون فيه (هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن) فصلاً”. ويُعتبر مصطلح “ضمير الفصل” من مصطلحات البصريين، أما الكوفيون فقد أطلقوا عليه اسم “العماد” أو “الدعامة”. وفي هذا السياق يقول ابن مالك: “من المضمرات المسمى عند البصريين فصلاً، وعند الكوفيين عماداً”. بينما أطلق عليه الأخفش تسمية “صلة زائدة”.
سبب تسمية ضمير الفصل
تتعدد التفسيرات لسبب تسمية ضمير الفصل وفقاً للمصطلح المستخدم:
أ – ضمير الفصل: أطلق عليه البصريون هذا الاسم لأنه يرفع الإبهام ويزيل اللبس المحتمل، إذ يوضح أن ما بعده هو خبر لما قبله وليس تابعاً له. وقيل أيضاً إنه سُمي فصلاً لكونه يفصل بين الخبر والصفة. ويرى ابن مالك أنه سُمي بذلك لأنه يفصل بين شيئين لا يستغني أحدهما عن الآخر.
ب – ضمير العماد: أطلق عليه الكوفيون هذا الاسم لأنه يُعتمد عليه في تحقيق الفائدة وتأدية المعنى، فشُبِّه بالعماد في البيت الذي يحفظ السقف من السقوط. وتسميته “دعامة” تأتي من أن الكلام يُدَّعَم به، أي يقوى ويُؤكَّد، حيث يُعد التوكيد إحدى فوائد وروده.
ويُعتبر مصطلح “ضمير الفصل” هو الراجح بين هذه التسميات.
الطبيعة النحوية لضمير الفصل: اسم أم حرف؟
انقسم النحويون في تحديد الطبيعة النحوية لضمير الفصل إلى رأيين:
الفريق الأول: يرى أن ضمير الفصل اسم، وذلك لدلالته على مسمى، وهو قول منسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي.
الفريق الثاني: يرى أنه حرف، وهو رأي جمهور النحويين، وحجتهم في ذلك أن هذا الضمير قد جيء به لمعنى في غيره، وهو الفصل بين ما هو خبر وما هو تابع، مما يجعله شديد الشبه بالحرف.
إعراب ضمير الفصل
توجد وجهتا نظر رئيسيتان في إعراب ضمير الفصل:
الرأي الأول: يذهب جمهور البصريين إلى أن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. وتستند حجتهم إلى الأدلة التالية:
١ – أن مجيئه لغرض محدد، وهو الإعلام بأن ما بعده خبر لا تابع، يجعله شبيهاً بالحرف، والحروف لا محل لها من الإعراب.
٢ – أن عدم تغير حركة ضمير الفصل بتغير العوامل الداخلة على ما قبله دليل على أنه لا موضع له من الإعراب.
٣ – أن خلو ضمير الفصل من الإعراب ليس أمراً مستنكراً في اللغة، فله نظائر، مثل (ال) الموصولة، والكاف في اسمي الإشارة (ذلك) و(أولئك).
الرأي الثاني: يرى الكوفيون أن لضمير الفصل محلاً من الإعراب، لكنهم اختلفوا في تحديد هذا المحل. فالفراء يرى أن محله الإعرابي يتبع ما قبله، بينما يرى الكسائي أن محله يتبع ما بعده.
على سبيل المثال، في قوله تعالى: {فَلَمَّا تَوَفَّيتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيهِمْ}.
بناءً على رأي الفراء، يكون محل الضمير (أنت) رفعاً على التوكيد. أما على رأي الكسائي، فيكون محله نصباً على التوكيد.
والرأي الراجح هو قول جمهور البصريين بأنه لا محل له من الإعراب، وذلك للأسباب الآتية:
١ – لأن الاسم الواقع بعد ضمير الفصل يُعرب حسب حاجة ما قبله من العوامل، دون الالتفات إلى ضمير الفصل وكأنه غير موجود.
٢ – لأن عدم إعراب ضمير الفصل هو الاستعمال الأكثر شيوعاً في اللهجات العربية.
٣ – لأن إهمال ضمير الفصل وعدم إعرابه هو ما ورد في قراءات جمهور القراء السبعة، بينما ورد إعماله في قراءات شاذة. ومما قُرئ في هذا الشأن قوله تعالى: {وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ}، حيث قرأ الأعمش وزيد بن علي كلمة (الحقُ) بالرفع.
شروط ضمير الفصل
أورد ابن هشام في كتابه “مغني اللبيب” ستة شروط لضمير الفصل، وهي: شرطان يتعلقان بما قبله، وشرطان بما بعده، وشرطان في الضمير نفسه.
أولاً: شرطان فيما قبله
١ – أن يكون ما قبله مبتدأ في الحال، كقوله تعالى: {وُأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}، أو ما كان أصله مبتدأ، كاسم (كان) وأخواتها، واسم (إن) وأخواتها، والمفعول الأول لـ (ظن) وأخواتها. ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: {فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ}، وقوله تعالى: {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ}، وقوله عز وجل: {وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْراً وَأَعْظَمَ أَجْراً}.
٢ – أن يكون معرفة، كما يتضح في الآيات السابقة، وكقوله تعالى: {وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا}. وقد أجاز بعض الكوفيين أن يكون ما قبله نكرة، واستشهدوا على ذلك بقوله تعالى: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ}، حيث أعربوا وقدّروا كلمة (أربى) منصوبة.
ثانياً: شرطان فيما بعده
يُشترط فيما يأتي بعد ضمير الفصل شرطان، هما:
١ – أن يكون خبراً لمبتدأ في الحال أو في الأصل، كما في الأمثلة المذكورة سابقاً.
٢ – أن يكون معرفة، كما في الآيات السابقة، أو ما يشبه المعرفة في كونه لا يقبل (ال) التعريف، ومن ذلك قوله تعالى: {إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً وَوَلَداً}. فكلمة (أقل)، وهي أفعل تفضيل، تشبه المعرفة في أنها إذا جاءت مع (مِن) التفضيلية لا تجوز إضافتها ولا دخول (ال) عليها.
ثالثاً: شرطان في نفسه
١ – أن يكون أحد ضمائر الرفع المنفصلة، أي على صيغة المرفوع، مثل: هو، هم، أنا، أنت، نحن. ومثاله قوله تعالى: {فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ}، وقوله: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ}.
٢ – أن يكون مطابقاً للاسم الذي قبله في التكلم والخطاب والغيبة، وفي الإفراد والتثنية والجمع، وفي التذكير والتأنيث. وفيما يلي تفصيل ذلك:
أ – المطابقة في التكلم والخطاب والغيبة:
- في التكلم، كقوله تعالى: {إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ}.
- في الخطاب، كقوله تعالى: {وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ}.
- في الغيبة، كقوله تعالى: {أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونُ}.
ب – المطابقة في الإفراد والتثنية والجمع: في الإفراد، كقوله تعالى: {إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ}. وفي الجمع، كقوله تعالى: {أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْفَائِزُونَ}. ولم يرد في القرآن الكريم مثال على التثنية.
ج – المطابقة في التذكير والتأنيث: من أمثلة التذكير قوله تعالى: {إَنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ}. ومن أمثلة التأنيث قوله تعالى: {وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ}.
وظائف ضمير الفصل
يؤدي ضمير الفصل عدة وظائف بلاغية ونحوية، من أبرزها:
أولاً: التوكيد والتقوية
يأتي ضمير الفصل لتوكيد المعنى وتقويته. ومثاله قوله تعالى: {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}. فقد ورد ضمير الفصل في هذه الآية بعد دعوة إلى أمر يشق على النفس، وهو دفع السيئة بالحسنة، فناسب ذلك ذكر الضمير لتوكيد الأمر وتعظيمه.
ومثال آخر قوله تعالى: {الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ * وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ * وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ * وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ}.
يُلاحظ في هذه الآيات أن ضمير الفصل (هو) قد ظهر مع أفعال الهداية، والإطعام، والإسقاء، والشفاء، بينما لم يُذكر مع الأفعال الثلاثة الأخرى، وهي الخلق، والإماتة، والإحياء. والسر البلاغي في هذا الذكر والحذف يكمن في أن ضمير الفصل قد جيء به في المواضع التي قد يُتوهم فيها وجود شريك لله، كما في الهداية والإطعام والشفاء، إذ قد يدعي مخلوق القدرة عليها. لذلك، جاء التعبير القرآني بضمير الفصل مع تلك الأفعال ليؤكد نسبتها إلى الله وحده ويخصصها به. أما أفعال الخلق والإماتة والإحياء، فلا يُتوهم فيها الشراكة، ولا يمكن لأحد أن يدعيها لنفسه، بل هي من خصائص الله تعالى دون منازع، ولهذا لم تكن هناك ضرورة بلاغية للإتيان بضمير الفصل معها.
ثانياً: الحصر والقصر والاختصاص
يُفيد ضمير الفصل قصر المسند على المسند إليه، حيث يُعد من أساليب القصر التي أقرها البلاغيون. والقصر في حقيقته هو توكيد مضاعف، إذ يدمج المتكلم جملتين في جملة واحدة.
من أمثلته قوله تعالى: {قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى}.
فضمير الغيبة (هو) في الآية هو ضمير فصل، والتعريف في كلمة (الهدى) هو تعريف الجنس الدال على الاستغراق. وبذلك اجتمع في الآية أسلوبان من أساليب الحصر، وهما: ضمير الفصل وتعريف طرفي الجملة (المبتدأ والخبر)، وفي الجمع بينهما تحقيق لمعنى القصر وتأكيد له إظهاراً للعناية به.
ومن أمثلة القصر أيضاً قوله تعالى: {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ * وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ}.
فضمير الفصل (نحن) في الآيتين يفيد الحصر، أي أنهم هم الصافون في مواقف العبودية لا غيرهم، وأنهم هم المسبحون لا غيرهم. ويهدف هذا القصر، كما يذكر أبو السعود، إلى إبراز أن هذا الفعل يصدر عنهم بكامل الزينة والنشاط، وهو ما تقتضيه جزالة التنزيل.
ثالثاً: التمييز بين الخبر والتابع أو الصفة
تتمثل هذه الوظيفة اللفظية في الإعلام بأن ما بعد الضمير هو خبر لا تابع (كنعت أو بدل). ومثاله قوله تعالى: {وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ}. فلو جُرّدت هذه الآية من ضمير الفصل (هو)، لكان من الممكن أن يُتوهم أن كلمة (الغني) هي مجرد صفة للفظ الجلالة، وأن الخبر لم يأتِ بعد. فضمير الفصل هو الذي يرفع هذا الوهم واللبس، ويبيّن أن ما بعده هو الخبر.
خاتمة
وفي ختام هذه الدراسة، يتضح أن ضمير الفصل ليس مجرد أداة لغوية عابرة، بل هو عنصر تركيبي ذو وظائف متعددة الأبعاد، يؤدي دوراً محورياً في بنية الجملة العربية. لقد أبرز البحث الجدل النحوي التاريخي حول طبيعته وإعرابه، حيث تميل الأدلة إلى ترجيح رأي البصريين القائل بأنه حرف لا محل له من الإعراب، جاء لمعنى الفصل والتمييز. كما تبين أن وظائفه تتجاوز الجانب الإعرابي الصرف، لتشمل أبعاداً بلاغية بالغة الأهمية؛ فهو أداة للتوكيد وتقوية المعنى، وأسلوب من أساليب القصر والاختصاص، فضلاً عن وظيفته الأساسية في رفع اللبس المحتمل بين الخبر والتابع. إن دراسة ضمير الفصل عبر شواهده، وخصوصاً في النص القرآني، تكشف عن عمق الترابط بين البنية النحوية والدلالة البلاغية في اللغة العربية، مما يجعله شاهداً على دقة النظام اللغوي العربي وقدرته الفائقة على التعبير بأوجز الألفاظ وأوضحها.
الأسئلة الشائعة
١ – ما هو ضمير الفصل تحديداً، وما الذي يميزه عن الضمير الشخصي العادي الذي يقع مبتدأً أو فاعلاً؟
الإجابة:
ضمير الفصل هو صيغة ضمير رفع منفصل (مثل: هو، هي، هم، أنا، أنت)، لكنه لا يؤدي الوظيفة النحوية التقليدية للضمائر كأن يكون مبتدأً أو فاعلاً، بل يأتي لغرض وظيفي محدد. ما يميزه عن الضمير الشخصي العادي يكمن في ثلاثة جوانب رئيسية:
- الوظيفة الإعرابية: الضمير الشخصي العادي له محل من الإعراب (مبتدأ، فاعل، توكيد لفظي له محل…). أما ضمير الفصل، على الرأي الراجح لجمهور البصريين، فهو حرف جاء لمعنى الفصل، وبالتالي لا محل له من الإعراب. إنه يتوسط بين ركني الجملة (المبتدأ والخبر أو ما أصلهما) دون أن يشغل موقعاً إعرابياً.
- الوظيفة الدلالية: الضمير العادي يدل على ذات المتكلم أو المخاطب أو الغائب. بينما ضمير الفصل، وإن كان يحمل صورة الضمير، فإن وظيفته الأساسية ليست الإحالة إلى ذات، بل هي وظيفة نحوية-بلاغية تتمثل في الفصل بين الخبر والتابع، أو توكيد النسبة، أو قصر الحكم.
- الموقع في الجملة: الضمير العادي يمكن أن يبدأ به الكلام (كأن يكون مبتدأً)، أما ضمير الفصل فلا يأتي إلا متوسطاً بين معرفتين، يكون أولهما مبتدأً (أو ما في حكمه) وثانيهما خبراً له.
ففي جملة “هو مجتهد”، الضمير “هو” مبتدأ له محل من الإعراب. أما في قوله تعالى {أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ}، فالضمير “هم” هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، جاء ليفصل بين المبتدأ “أولئك” والخبر “المفلحون”، وليؤكد ويقصر الفلاح عليهم.
٢ – لماذا تعددت تسميات ضمير الفصل بين “فصل” و”عماد”؟ وما دلالة كل تسمية؟
الإجابة:
يعكس تعدد التسميات اختلاف الزاوية التي نظر بها النحويون إلى وظيفة هذا العنصر اللغوي، ويمثل الانقسام التقليدي بين مدرستي البصرة والكوفة.
- تسمية البصريين (فصل): أطلق عليه الخليل بن أحمد وسيبويه ومن تبعهما من البصريين اسم “ضمير الفصل”. هذه التسمية تركز على وظيفته النحوية المباشرة، وهي الفصل والتمييز. فهو يفصل بين ما بعده (الخبر) وما قبله (المبتدأ)، ليرفع أي لبس محتمل قد يجعل السامع يظن أن الكلمة الثانية هي تابع (صفة أو بدل) وليست خبراً. ففي جملة “زيدٌ الفاضلُ”، قد تكون “الفاضل” صفة لزيد والخبر منتظر. لكن عند قولنا “زيدٌ هو الفاضلُ”، فإن “هو” قطعت الطريق على هذا الوهم وأعلمت السامع بأن “الفاضل” هو الخبر.
- تسمية الكوفيين (عماد ودعامة): أطلق عليه الكوفيون اسم “العماد” أو “الدعامة”. هذه التسمية تركز على وظيفته المعنوية والبلاغية. فهم يرون أن الكلام يعتمد عليه في تقوية المعنى وتوكيده، تماماً كما يعتمد سقف البيت على العماد ليقيه من السقوط. فكلمة “دعامة” تشير إلى أن الجملة تُدعَّم به فتزداد قوة وتأكيداً.
والخلاصة أن البصريين نظروا إلى وظيفته الشكلية (الفصل)، بينما نظر الكوفيون إلى أثره المعنوي (التقوية والاعتماد). وعلى الرغم من أن كلا الوصفين صحيح، فإن تسمية “ضمير الفصل” هي التي سادت واشتهرت لدى جمهور النحويين.
٣ – ما هو الخلاف الجوهري بين النحويين حول طبيعة ضمير الفصل كاسم أو حرف، وما حجة كل فريق؟
الإجابة:
يعد تحديد الطبيعة النحوية لضمير الفصل (أهو اسم أم حرف؟) من المسائل الخلافية العميقة بين النحويين، وحجة كل فريق تنبني على فلسفته في التحليل النحوي.
- الفريق الأول (يرى أنه اسم): وهو قول يُنسب إلى الخليل بن أحمد وبعض النحويين. حجتهم أن ضمير الفصل له صورة الاسم (صيغة ضمير رفع)، ولأنه يدل على مسمى يتطابق مع ما قبله (في التذكير والتأنيث والإفراد…). فالأسماء هي ما دل على مسمى، وهذا الضمير يؤدي هذا الدور ظاهرياً.
- الفريق الثاني (يرى أنه حرف): وهو رأي جمهور النحويين، خاصة البصريين. حجتهم أقوى وتستند إلى جوهر الوظيفة لا إلى الشكل. فهم يرون أن ضمير الفصل لا يؤدي وظيفة الأسماء الأصلية (كالإسناد إليه أو الإخبار عنه)، بل جيء به لمعنى في غيره، وهذا هو تعريف الحرف. فمعناه ليس في ذاته، بل في العلاقة التي ينشئها بين طرفي الجملة، وهي علاقة الفصل والتوكيد. وبما أنه لا يتأثر بالعوامل الداخلة على الجملة ولا يؤثر إعرابياً فيما بعده، فقد اشتد شبهه بالحروف التي لا محل لها من الإعراب، مثل حروف الجر أو حروف العطف. وهذا الرأي هو الراجح لقوة تعليله.
٤ – كيف يُعرَب ضمير الفصل؟ ولماذا يُعد الرأي القائل بأنه “لا محل له من الإعراب” هو الراجح؟
الإجابة:
إعراب ضمير الفصل هو نتيجة مباشرة للخلاف حول طبيعته (اسم أم حرف)، وانقسم النحويون فيه إلى رأيين رئيسيين:
- الرأي الأول (لا محل له من الإعراب): وهو مذهب جمهور البصريين. وحجتهم أنه إذا كان ضمير الفصل حرفاً جاء لمعنى، فمن الطبيعي ألا يكون له محل من الإعراب، لأن الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب. الاسم الذي يليه يُعرب حسب موقعه في الجملة وكأن ضمير الفصل غير موجود. ففي قوله تعالى {إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ}، تُعرب “هو” ضمير فصل لا محل له من الإعراب، و”التوابُ” خبر “إن” مرفوع.
- الرأي الثاني (له محل من الإعراب): وهو مذهب الكوفيين، لكنهم اختلفوا في تحديد محله. فالفراء يرى أن محله يتبع ما قبله (فيكون في محل رفع أو نصب توكيداً لما قبله)، بينما يرى الكسائي أن محله يتبع ما بعده.
يُعد رأي البصريين هو الراجح لعدة أسباب قوية:
١. الاتساق النظري: يتماشى مع القول بحرفيته، وهو التحليل الأقوى لوظيفته.
٢. الشيوع والاستعمال: إهمال إعرابه هو السائد في كلام العرب وفي القراءات القرآنية المتواترة.
٣. سهولة التحليل: يجعل الإعراب أكثر سلاسة، حيث يُعرب ما بعده مباشرة خبراً أو مفعولاً ثانياً دون الحاجة إلى تقديرات معقدة.
٤. الشواهد: القراءات التي أعربت ما بعده على أنه تابع (كقراءة الرفع في {هوَ الحقُّ} في آية {إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ}) هي قراءات شاذة، والشاذ لا يُقاس عليه.
٥ – هل يمكن استخدام ضمير الفصل في أي جملة؟ أم أن هناك شروطاً محددة تحكم وروده؟
الإجابة:
لا، لا يمكن استخدام ضمير الفصل عشوائياً. لقد وضع النحويون، كما فصّل ابن هشام، شروطاً دقيقة لاستعماله تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
١. شروط فيما قبله:
* أن يكون مبتدأ أو ما أصله مبتدأ: أي أن يسبقه مبتدأ، أو اسم “كان” وأخواتها، أو اسم “إن” وأخواتها، أو المفعول الأول لـ”ظن” وأخواتها.
* أن يكون معرفة: وهذا هو الغالب والأصل، فلا يقال: “رجل هو الفاضل”.
٢. شروط فيما بعده:
* أن يكون خبراً لما قبله (أو ما أصله خبر): فلا يأتي قبل الفاعل أو المضاف إليه مثلاً.
* أن يكون معرفة أو شبه معرفة: كأن يكون معرفاً بـ(ال) أو اسم علم، أو أفعل تفضيل مقترناً بـ(مِن) الذي يشبه المعرفة في امتناعه عن قبول (ال) والإضافة، كقوله تعالى: {أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ مَالاً}.
٣. شروط في الضمير نفسه:
* أن يكون بصيغة الرفع المنفصل: فلا يأتي ضمير نصب أو جر.
* أن يكون مطابقاً لما قبله: في التكلم والخطاب والغيبة، وفي الإفراد والتثنية والجمع، وفي التذكير والتأنيث. فيقال “أنا هو الفائز” خطأ، والصواب “أنا الفائز”. ويقال “فاطمة هي الفائزة”، ولا يقال “فاطمة هو الفائزة”.
هذه الشروط تضمن أن يؤدي ضمير الفصل وظيفته النحوية والبلاغية بشكل سليم دون أن يخل ببنية الجملة.
٦ – ما الفرق الدقيق بين ضمير الفصل والضمير المستخدم للتوكيد اللفظي؟
الإجابة:
هذه نقطة دقيقة جداً ويقع فيها لبس كثير. الفرق بينهما جوهري ويظهر في الوظيفة والإعراب والشروط:
| وجه المقارنة | ضمير الفصل | ضمير التوكيد اللفظي |
|---|---|---|
| الوظيفة الأساسية | الفصل بين الخبر والتابع، ومنع اللبس، مع إفادة التوكيد والقصر. | تكرار اللفظ لتقوية المعنى وتثبيته في ذهن السامع. |
| الإعراب | لا محل له من الإعراب (على الراجح). | يتبع المؤكَّد في إعرابه (له محل من الإعراب). |
| ما بعده | يكون معرفة أو شبه معرفة، ويُعرب خبراً أو مفعولاً به ثانياً. | لا يُشترط شيء معين بعده، فهو مجرد تكرار. |
| مثال توضيحي | زيدٌ هو القائمُ: “هو” ضمير فصل لا محل له، “القائمُ” خبر مرفوع. | جاء زيدٌ هو: “هو” ضمير منفصل في محل رفع توكيد لفظي للفاعل المستتر في “جاء” أو للفاعل “زيد”. |
| الأثر | يمنع أن تكون “القائم” صفة، ويقصر القيام على زيد. | يؤكد فقط مجيء زيد. |
باختصار، ضمير الفصل جزء من بنية الجملة الاسمية يوضح العلاقة بين ركنيها، بينما التوكيد اللفظي هو تكرار لعنصر موجود بالفعل بهدف التقوية فقط، ويمكن حذفه دون أن يتأثر فهم أصل العلاقة الإسنادية.
٧ – كيف يساهم ضمير الفصل في تحقيق معنى “القصر والحصر” في البلاغة العربية؟
الإجابة:
يعتبر البلاغيون أن ضمير الفصل هو أحد أساليب القصر القوية، والقصر هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص. مساهمته في تحقيق هذا المعنى تأتي من طبيعة وظيفته:
عندما يتوسط ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر، فإنه لا يؤكد الحكم فقط، بل يحصره في المبتدأ وينفيه ضمناً عما عداه. ففي قوله تعالى {قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى}، لم يكن المعنى مجرد إثبات أن هدى الله هدى، بل قصر جنس الهداية الحقيقية الكاملة على هدى الله وحده، ونفي صفة الهداية الحقة عن أي هدى آخر يدعيه البشر.
كذلك في قوله تعالى {وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ}، ضمير الفصل “نحن” يفيد حصر صفة “الصافون” على المتكلمين (الملائكة)، بمعنى أنهم هم المختصون بهذه الصفة على وجه الكمال، لا غيرهم. وبهذا، يتحول الإخبار البسيط إلى حكم قاطع وحصري، مما يضيف قوة هائلة للمعنى المقصود، وهذا من أسمى الأغراض البلاغية التي يؤديها.
٨ – هل يمكن توضيح أثر وجود ضمير الفصل أو حذفه في جملة بسيطة؟
الإجابة:
نعم، يمكن توضيح الأثر الفارق من خلال المثال التالي:
لنتأمل جملة: “عليٌّ الشجاعُ”.
هذه الجملة تحتمل معنيين:
١. المعنى الأول (الشجاع صفة): قد تكون كلمة “الشجاع” مجرد صفة لـ”عليّ”، والخبر لم يأتِ بعد. وتقدير الكلام: “عليٌ الشجاعُ قادمٌ” أو “عليٌ الشجاعُ محبوبٌ”. هنا الجملة ناقصة.
٢. المعنى الثاني (الشجاع خبر): قد تكون “الشجاع” هي الخبر، والمعنى أنك تخبر عن عليّ بأنه هو الشجاع.
هنا يأتي دور ضمير الفصل ليزيل هذا اللبس ويحدد المعنى بشكل قاطع. فعندما نقول:
“عليٌّ هو الشجاعُ”.
- الأثر النحوي: وجود “هو” قطع احتمال أن تكون “الشجاع” صفة، وأعلم السامع يقيناً أنها الخبر. لقد فصل بين وظيفة الخبر ووظيفة الصفة.
- الأثر البلاغي: الجملة لم تعد مجرد إخبار، بل اكتسبت قوة التوكيد (عليّ شجاع حقاً) والقصر (الشجاعة الحقيقية مقصورة على عليّ، أو هو الأحق بها من غيره).
فحذف ضمير الفصل يترك الجملة عرضة للبس ويضعف دلالتها، بينما وجوده يمنحها وضوحاً نحوياً وقوة بلاغية.
٩ – لماذا لم يرد مثال لضمير الفصل مع المثنى في القرآن الكريم؟
الإجابة:
عدم ورود مثال لضمير الفصل مع المثنى في القرآن الكريم (مثل: هما) هو مجرد واقع استقرائي، ولا يعني أبداً عدم جوازه أو عدم فصاحته في اللغة العربية. اللغة وقواعدها أوسع من الشواهد القرآنية وإن كانت هي الأعلى حجة.
يمكن تفسير هذا الغياب بعدة احتمالات:
- طبيعة السياقات القرآنية: قد تكون السياقات التي وردت في القرآن لم تستدعِ بلاغياً أو دلالياً استخدام ضمير الفصل مع المثنى. فالقرآن يختار الألفاظ والأساليب التي تخدم الغرض الدلالي في كل موضع بدقة متناهية.
- قلة دوران المثنى: بشكل عام، تردد صيغ المثنى في اللغة أقل من تردد صيغ الإفراد والجمع، وهذا قد ينعكس طبيعياً على تراكيب معينة مثل ضمير الفصل.
- المصادفة المحضة: قد يكون الأمر مجرد مصادفة استقرائية لا تحمل وراءها سبباً نحوياً أو بلاغياً عميقاً.
والشاهد على جوازه وصحته هو وروده في كلام العرب الفصيح وفي أشعارهم، ويمكن بناء جملة فصيحة تماماً مثل: “الزيدان هما الفائزان”، وهي جملة صحيحة نحوياً وبلاغياً، حيث يفصل الضمير “هما” بين المبتدأ والخبر ويؤكد الحكم ويقصره عليهما.
١٠ – بالنظر إلى شروطه ووظائفه، هل يُعَد ضمير الفصل عنصراً ضرورياً في الجملة أم مجرد إضافة تحسينية؟
الإجابة:
هذا سؤال يقع في قلب فلسفة اللغة بين الضرورة والاختيار. يمكن الإجابة عليه من مستويين:
- من المستوى النحوي الأساسي: ضمير الفصل ليس عنصراً ضرورياً لصحة الجملة نحوياً. فيمكن لجملة “زيدٌ القائمُ” أن تكون صحيحة نحوياً إذا فُهم أن “القائم” هو الخبر. أي أن غيابه لا يفسد الجملة بالضرورة، لكنه قد يعرضها للبس.
- من المستوى البلاغي والدلالي: يصبح ضمير الفصل ضرورياً لتحقيق غرض بلاغي معين لا يمكن تحقيقه بدونه بنفس القوة. فإذا أراد المتكلم رفع اللبس بشكل قاطع، أو توكيد الحكم توكيداً قوياً، أو قصر الصفة على الموصوف، فإن الإتيان بضمير الفصل يصبح ضرورة بلاغية لتحقيق مراده الدلالي بدقة.
إذن، هو ليس ضرورياً لـ”أصل الصحة”، ولكنه ضروري لـ”كمال المعنى ودقته”. يمكن تشبيهه في هذا السياق بأساليب التوكيد الأخرى؛ يمكنك قول “جاء زيد” وهي جملة صحيحة، ولكن إذا أردت إزالة شك السامع، يصبح قول “إن زيداً قد جاء” ضرورة تواصلية. فضمير الفصل هو أداة اختيارية من حيث الصنعة النحوية، ولكنه يصبح ضرورياً حين يقتضيه المقام وتستدعيه دقة المعنى المراد.