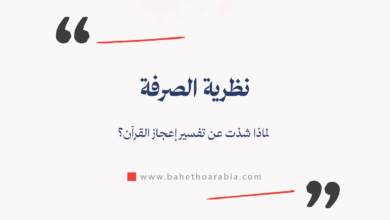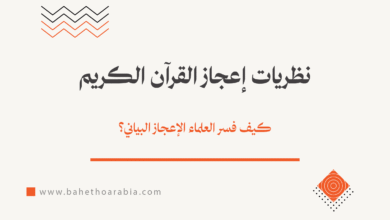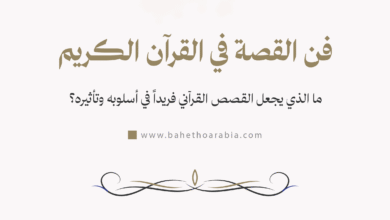التصوير في القرآن الكريم: كيف يرسم القرآن المعاني كأنها مشاهد حية؟
هل يقتصر الأسلوب القرآني على التعبير الذهني المجرد؟
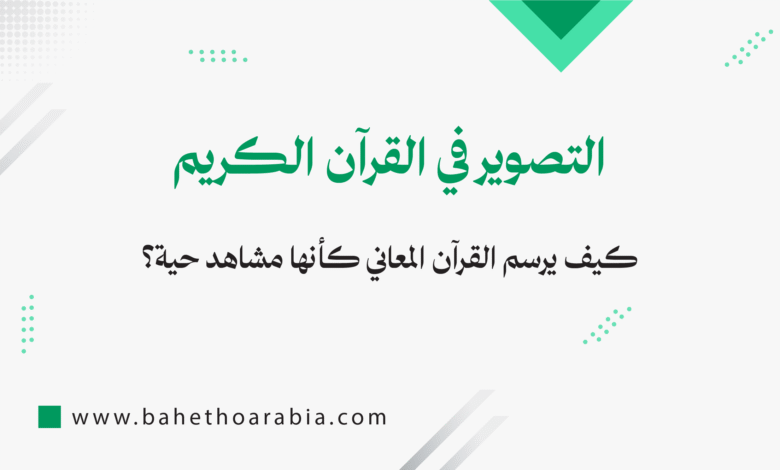
يمتاز القرآن الكريم بأسلوب فني فريد يجعل المعاني الذهنية والحالات النفسية تتجسد أمام القارئ في صور حسية متحركة، فتخاطب العقل والوجدان معاً في تناغم بديع. هذه الطريقة المتميزة في البيان جعلت للموضوعات القرآنية حضوراً خاصاً يتغلغل في أعماق النفس البشرية ويحشد نوازع الخير فيها.
المقدمة
للقرآن الكريم طريقة فريدة ومتميزة في التعبير، يتخذها وسيلته في أداء جميع الأغراض على السواء، حتى أغراض البرهنة والجدل، تلك هي طريقة التصوير التشخيصي بوساطة التخييل والتجسيم. هذه الطريقة هي التي جعلت للمعاني والأغراض والموضوعات القرآنية هذه الصورة كانت قيمتها الكبرى، فهي في هذه صورتها التي نراها، ومن الصورة غيرها في أية صورة أخرى.
يتجه القرآن لهذا الإنسان فيخاطبه بكليته، وذاته كلها: عقله وفكره، نفسه ووجدانه، يخاطب كينونة الإنسان كلها، وذلك بأسلوبه العجيب: أسلوب التصوير الحي. يوجه القرآن كلمه للإنسان فيثير في خياله صوراً تخاطب الحواس بكل ما يلائمها من عناصر الطبيعة والحياة، فتترك في الأفكار والضمائر تأثيرات وانفعالات قوية عميقة، تحشد نوازع الخير في العقل والنفس، وفي الوجدان والإرادة، فتنطلق بذلك مؤمنة بعقيدة القرآن مستمسكة بهديه عبادة وخلقاً وشريعة، وتجاهد في سبيل حمايته، وإعلاء رايته.
السمة الأولى للتعبير القرآني في التصوير
لقد كانت السمة الأولى للتعبير القرآني هي اتباع طريقة تصوير المعاني الذهنية والحالات النفسية وإبرازها في صور حسية، والسير على طريقة تصوير المشاهد الطبيعية، والحوادث الماضية، والقصص المروية، والأمثال القصصية، ومشاهد القيامة وصور النعيم والعذاب، والنماذج الإنسانية.. كأنها كلها حاضرة شاخصة. بالتخييل الحسي الذي يفعمها بالحركة المتخيلة.
ولهذه الطريقة فضلها ولا شك في أداء الدعوة لكل عقيدة، ولكننا إنما ننظر إليها هنا من الوجهة الفنية البحتة، وإن لها من هذه الوجهة لشأناً، فوظيفة الفن الأولى هي إثارة الانفعالات الوجدانية، وإشاعة اللذة الفنية بهذه الإثارة، وإجاشة الحياة الكامنة بهذه الانفعالات، وتغذية الخيال بالصور لتحقيق هذا جميعه.. وكل أولئك تكفله طريقة التصوير والتشخيص للفن الجميل.
أمثلة توضيحية على التصوير في القرآن الكريم
وهذه أمثلة توضح لك ما ذكرناه:
١ – معنى النفور الشديد من دعوة الإيمان ينتقل إليك في صورته التجريدية هكذا: إنهم لينفرون أشد النفرة من دعوة الإيمان. فيمتلئ الذهن وحده معنى النفور في برود وسكون. ثم ينقل إليك في هذه الصورة العجيبة: «فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حُمرٌ مستنفرة فرَّت من قسورة»، فتشترك مع الذهن حاسة النظر، وملكة الخيال، وانفعال السخرية، وشعور بالجمال: السخرية من هؤلاء الذين يفرون كما تفر حمر الوحش من الأسد، لا لشيء إلا لأنهم يدعون إلى الإيمان! والجمال الذي يرتسم في حركة الصورة حينما يتملاها الخيال في إطار من الطبيعة، تشرد فيه هذه الحمر يتبعها «قسورة» المرهوب! فللتعبير هنا ظلال حوله، تزيد في مساحته النفسية – إذا صح هذا التعبير!
٢ – ومعنى عجز الآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله، يمكن أن يؤدى بعدة تعبيرات ذهنية مجردة، كأن يقال: إن ما تعبدون من دون الله لأعجز عن خلق أحقر الأشياء. فيصل المعنى إلى الذهن مجرداً باهتاً. ولكن التعبير التصويري يؤديه في هذه الصورة: «إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه. ضعُف الطالب والمطلوب». فيشخص هذا المعنى ويبرز في تلك الصور المتحركة المتعاقبة: «لن يخلقوا ذباباً» هذه درجة. «ولو اجتمعوا له»، وهذه أخرى. «وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه»، وهذه ثالثة. أرأيت إلى تصوير الضعف المزري، وإلى التدرج في تصويره، بما يثير في النفس السخرية اللاذعة، والاحتقار المهين؟ ولكن. أهذه مبالغة؟ وهل البلاغة فيها هي الغلو؟
كلا! فهذه حقيقة واقعة بسيطة. إن هؤلاء الآلهة «لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له»، والذباب صغير حقير؛ ولكن الإعجاز في خلقه هو الإعجاز في خلق الجمل والفيل. إنها معجزة الحياة يستوي فيها الجسيم والهزيل. فليست المعجزة في صميمها هي خلق الهائل من الأحياء. إنما هي خلق الخلية الصغيرة كالهباء. ولكن الإبداع الفني هنا هو في عرض هذه الحقيقة في صورة تلقي ظلال الضعف عن خلق أحقر الأشياء، والجمال الفني هنا هو في تلك الظلال التي تضيفها محتويات الصورة: وفي الحركة التخييلية في محاولة الخلق، وفي التجمع له، ثم في محاولة الطيران خلف الذباب لاستنقاذ ما يسلبه، وهم وأتباعهم عاجزون عن هذا الاستنقاذ!
٣ – ويعبر عن حالة تخلي الأولياء عن أوليائهم أمام هول القيامة بهذه الصيغة التجريدية: لقد تناكر الأصفياء، وتنابز الأولياء، وتخلى المتبوعون عن التابعين حينما شاهدوا الهول يوم الدين. فيكون من أدق التعبيرات التي تصاغ. ولكن أين هذا التعبير الذهني من هذا الاستعراض المفعم بالحياة: «وبرزوا لله جميعاً. فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنّا لكم تبعاً، فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم. سواءٌ علينا أجزعنا أم صبرنا مالنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي! فلا تلوموني ولوموا أنفسكم! ما أنا بمصرخكم، وما أنتم بمصرخي: إني كفرت بما أشركتمون من قبل. إن الظالمين لهم عذاب أليم».
ففي هذا الاستعراض يتجسم للخيال مشهد من ثلاث فرق: الضعفاء. الذين كانوا ذيولاً للأقوياء وهم وما يزالون في ضعفهم، وقصر عقولهم، وخور نفوسهم. يلجأون إلى الذين استكبروا في الدنيا، يسألونهم الخلاص من هذا الموقف، ويعتبون عليهم إغواءهم في الحياة، متمشين في هذا مع طبيعتهم الهزيلة وضعفهم المعروف. والذين استكبروا. وقد ذلّت كبرياؤهم، وواجهوا مصيرهم. وهم ضيقو الصدور بهؤلاء الضعفاء، الذين لا يكفيهم ما يرونهم فيه من ذلة وعذاب، فيسألونهم الخلاص، وهم لا يملكون لذات أنفسهم خلاصاً، أو يذكرونهم بجريمة إغوائهم لهم حيث لا تنفع الذكرى. فما يزيدون على أن يقولوا لهم في سأم وضيق: «لو هدانا الله لهديناكم»!
والشيطان. بكل ما في شخصيته من مراوغة ومغالطة، واستهتار وتبجح ومكر «وشيطنة». يعترف لأتباعه – الآن فقط – بأن الله وعدهم وعد الحق، وأنه هو وعدهم فأخلفهم. ثم يمضّهم ويؤلمهم، وهو ينفض يديه من تبعاتهم فيقول: «وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم». لا بل يزيد في تبجحه، فيقول: «إني كفرت بما أشركتمون من قبل». حقاً. إنه لشيطان! وإن هذا الإبداع في تصوير الموقف الفريد، الذي يتخلى فيه التابع عن المتبوع، ويتنكر المتبوع للتابع. حيث لا يجدي أحداً منهم أن يتخلى أو يستمسك، ولكنها طبيعة كل فريق، تبرز عارية أمام الهول العظيم. وإن الشيطان هذا المنطقي مع نفسه، ومع الصورة التي يرسمها القرآن له.. وإلا فما يكون شيطاناً بغير هذا التلاعب والتبجح والإنكار. وهكذا تصل إلى النفس تلك الأصداء كلها، وتلك الظلال جميعها، من وراء التعبير المصور المشخص. فأين يقع التعبير الذهني، من هذا التصوير الفني؟
٤ – ويقال: إن أعمال الذين كفروا لا حساب لها ولا وزن، وإنهم يخدعون أنفسهم حين يظنونها شيئاً، أو إنهم في ضلال دائم، لا مخرج لهم منه، ولا هادي لهم فيه. فيؤدي المعنى إلى الذهن حيث يركد هناك. ولكنه يحيا ويتحرك، ويجيش به الحس والخيال، حين يؤدى في هذه الهيئة التصويرية: «والذين كفروا، أعمالهم كسراب بقيعة، يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً ووجد الله عنده، فوفاه حسابه. والله سريع الحساب». «أو كظلمات في بحر لجيٍّ، يغشاه موجٌ، من فوقه موجٌ، من فوقه سحابٌ. ظلماتٌ بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن لم يجعل الله له نوراً، فما له من نور».
هنا صور فنية ساحرة، فيها روح القصة، وفيها تخييل قوي.. وهي بعد في حاجة إلى ريشة مبدعة، لو أريد تصويرها بالألوان، وإلى عدسة يقظة، لو أريد تصويرها بالحركات. بل أين هي الريشة، أو أين هي العدسة، التي تستطيع أن تبرز هذه الظلمات: «في بحر لجي يغشاه موجٌ، من فوقه موجٌ من فوقه سحابٌ. ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها»؟ أو تصور الظمآن، يسير وراء السراب «حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، ووجد مفاجأة عجيبة – لم تكد تخطر له على بال – «وجد الله عنده»، وفي سرعة خاطفة تناوله «فوفاه حسابه»؟ فإذا ذكرنا الغرض الديني الذي رسمت له هذه الصورة، فلنذكر معه المتاع الفني الطريف، في هذا التصوير الحي الجميل.
طبيعة التصوير في القرآن الكريم وخصائصه
لو استعرضت القرآن من بدايته إلى تمامه فستجد طريقة خاصة بالتعبير الفني تكسو أسلوب القرآن حتى يصطبغ بألوانها البراقة الزاهية، فإنك لن تجد فيه بياناً مجرداً لمعنى ذهني، أو حالة نفسية أو حادث مادي أو مشهد منظور… أو طبيعة آدمية، أو موقف من مواقف يوم الحساب، بل تجده بصورة محسوسة متخيلة، حاضرة شاخصة، صورها بالألوان أو الحركات أو الإيقاع، ومزج بها جرس الكلمات ونعم العبارات، حتى تسري في أوصالها الحياة وتدب في جنباتها الحركة، فإذا خلع عليها الحوار فقد نفخ فيها الروح فاكتملت فيها كل عناصر التخييل الحسي والتشخيص الحية حتى تربك ساحة الحوادث على بساط الطبيعة والواقع.
وليس أسلوب التصوير في القرآن كمثل فن من فنون البلاغة، تجده حيناً في بعض العبارات وتفقده أحياناً كثيرة، بل إن التصوير هو الأداة المفضلة في أسلوب القرآن – كما أثبته صاحب كتاب التصوير الفني، فهو يعبر بالصورة المحسوسة المتخيلة عن المعنى الذهني والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن النموذج الإنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالصورة التي يرسمها فيمنحها الحياة الشاخصة، أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني.. هيئة أو حركة وإذا الحالة النفسية لوحة أو مشهد، وإذا النموذج الإنساني شاخص حي، وإذا الطبيعة مجسمة مرئية.
أما الحوادث والمشاهد والقصص والمناظر فيردها شاخصة حاضرة فيها الحياة وفيها الحركة فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر التخييل فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظارة وحتى ينقلهم نقلاً إلى مسرح الحوادث الأول الذي وقعت فيه أو ستقع، حيث تتوالى المناظر، وتتجدد الحركات وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى ومثل يضرب، ويتخيل أنه منظر يعرض وحادث يقع أمامه، فهذه شخوص تروح على المسرح وتغدو، وهذه سمات الانفعال بشتى الوجدانات المنبعثة من الموقف، المتساوقة مع الحوادث، وهذه كلمات تتحرك بها الألسنة فتنم عن الأحاسيس المضمرة. إنها الحياة هنا وليست حكاية الحياة.
الأداة المعجزة في التصوير في القرآن الكريم
فإذا ذكرنا أن الأداة التي تصور المعنى الذهني، والحالة النفسية، تشخص النموذج الإنساني، أو الحادث المرئي، إنما هي ألفاظ جامدة، لا ألوان تصور، ولا شخوص تعبر أدركنا موضع الإعجاز في تعبير القرآن. وبوسعنا أن نقول أن هذه النتيجة التي انتهى إليها صاحب البحث في التصوير الفني لعلها كما قال الدكتور صبحي الصالح: «أن تكون أصدق ترجمة لمفهومنا الحديث لإعجاز القرآن، لأنها تساعد جيلنا الجديد على استرواح الجمال الفني الخالص في كتاب الله، وتمكن الدارسين من استخلاص ذلك بأنفسهم، والاستمتاع به بوجدانهم وشعورهم، ولا ريب أن العرب المعاصرين للقرآن دهشوا قبل كل شيء بأسلوبه الذي حاولوا أن يعارضوه فما استطاعوا، حتى إذا فهموه أدركوا جماله، ومس قلوبهم بتأثيره».
ونضيف إلى ما ذكره الدكتور الصالح قضية أخرى أهم وأجل، وأعلى وأرفع، تلك هي أن نظرية التصوير الفني تأتي مكملة لما قدمه الأقدمون بدراساتهم البلاغية التحليلية المفصلة الدقيقة، التي تدقق النظر في كل حرف، وكل كلمة، ثم كل جملة وتركيب، وتمعن البحث في أساليب التعبير اللغوي، وفنون ألوان البلاغة، فتأتي نظرية التصوير لكي تنتظم في أصولها كل تلك الدراسات في فلسفة أدبية حديثة تحقق أغراضاً رئيسة هامة جداً، نذكر منها هنا:
الأغراض الرئيسة لنظرية التصوير الفني
١ – تفسير إعجاز القرآن بمقياس معاصر سليم.
٢ – جمع شمل تلك الدراسات وتأليفها إلى بعضها لتكون عناصر حية تحقق كلاً متكاملاً هو التصوير، وليست نظرية التصوير الفني استغناء عن فنون البلاغة وعلومها كما توهم كثير من دارسي الأدب السطحيين – وإن كانت قد تسهل تذوق الجمال الفني للقاصرين في تلك الفنون – بل إن نظرية التصوير الفني ارتقاء بتلك الفنون يتطلب مزيداً من العمق فيها والإدراك الدقيق للغاية الفنية التي يؤديها كل واحد من أساليب التعبير وفنون البلاغة، يتحول به الدارس من الإدراك الساذج والحس الغامض بالجمال، إلى تملي مواضع الجمال والانفعال بها.
٣ – وضع مقياس نقدي حديث نميز به بين الإجادة في استعمال أنواع التعبير اللغوي، واستخدام فنون البلاغة، وبين التكلف والتصنع المستكره الذي يحيلها إلى هياكل لا جمال لها، ولا روح فيها.
سعة طرق التصوير في القرآن الكريم
وليست طرق التصوير الفني في القرآن قاصرة كما قد يتوهمه بعض الناس على طرق معينة، من تشبيه مركب أو بسيط، أو من استعارة تخييلية أو غير تخييلية، أو مجاز أو نحوه مما قد يقع في خاطر الدارس قبل التمعن والتروي، هذا ظن الذين يغلطون فيحسبون الأدب صناعة كصناعات الحرف والحديد والخشب، وهم بذلك يفقدون الأدب حيويته ويحنطونه جثماناً فاقداً لروحه، فالأدب والفن أوسع من أن تحيط به القوالب أو تحده الحدود، فكيف بمعجزة الأدب، وفن التصوير فيها.
وها نحن نقدم بعض طرق التصوير في القرآن، لمزيد الإيضاح وبيان سعة هذا الفن في القرآن الكريم.
استعمال ظرف الزمان إذ في سياق القصص والحوادث
في حنايا قصة بني إسرائيل، صور لنا القرآن حصول المعجزة التي أكرم الله بها موسى وقومه، قال الله تعالى: «وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين». ها هم بنو إسرائيل في صحراء قاحلة مجدبة، رمال وسماء، لا ماء ولا زرع، وقد بلغ بهم الضنك غايته وأخذهم الظمأ من مجامع أفئدتهم، إذ أجرى الله لرسولهم موسى معجزة خارقة لقوانين الطبيعة وخواص المادة، فأكرمهم بالمياه الدافقة. فقد أمر الله نبيه موسى عليه السلام أن يضرب الصخر الأصم بعصاه، وماذا تفعل العصا في جلمود الصخر؟! ما لها إلا أن تتهشم عليه! لكن قدرة الله الواسعة وعنايته ورحمته ورأفته بعباده المؤمنين، هيأت من وراء هذا السبب اليسير الخير الكثير، فانفجرت من الصخر اثنتا عشرة عيناً، على عدد أسباط بني إسرائيل، لكل منهم عين خاصة بهم «قد علم كل أناس مشربهم».
صورهم القرآن وهم في لوعة إلى الماء، فألجأهم الظمأ إلى رسولهم، فلجأ موسى إلى ربه يستعطفه ويسترحمه أن يمن عليهم فيسقيهم. رسم القرآن صورتهم في زمانها وظروفها صورة حية شاخصة متفجرة العيون دافقة المياه، قد اجتمع شمل كل من قبائلهم على عين ينهلون من مائها رياً وطمأنينة وبهجة. لقد أمرهم الله أن يقابلوا إنعامه العظيم وإحسانه الجزيل بالتقوى والاحتراز عما تؤديه السعة في غير أهل الإيمان من كفران النعم وبطر وأشر وعصيان وتماد في الفساد «كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين». فالآية استقبلتك بقوله تعالى: «وإذ استسقى…» فصار إيراد الظرف «إذ» للتذكير بالحادث وتصويره في زمانه وأحواله. ولا يحصل نظير هذا لو استعملت بديلاً عنه، مثل لفظ «لقد». وجاء الإيجاز في «فانفجرت» والتقدير، فضرب فانفجرت، لتزيد قوة التصوير حتى كأنك أمام الحدث تشاهده.
و «إذ» ظرف الماضي الزمان، فهي ظرف متعلق بمحذوف تقديره: «واذكر» وهو الراجح عند المفسرين، وعليه فإن تقدير الكلام في الآية: «واذكر حين استسقى موسى لقومه…» و «إذ» قيدت التذكر والتصور في ظرف محدد وحال معينة، وهي حال استسقاء موسى لقومه العطاش. وفي التذكر تصور الأمر مضى من قبل. وبنفس التحليل يمكنك أن تدرس صورة بناء إبراهيم وولده إسماعيل للكعبة، وأن تلاحظ طيب النفس والإخلاص وحسن الطوية وسلامة القصد ومجافاتهما للغرور وحظوظ النفس؛ في ضراعتهما أثناء تشييد البناء. قال الله تعالى في تصوير حالهما: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم».
تعريف المسند إليه باسم الموصول
يقصد القرآن أن يرسم في الذهن صورة من تحدث عنه، ويثير الخيال بإيحاءاتها. ومن ذلك: أن الله لمّا وبّخ المشركين على عبادة الأصنام واعتقادهم ألوهيتها أشعر المشركين بفادح خطئهم، إذ عبر عن الأصنام بقوله: «إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين». أسقط الله عن معبوداتهم صفة الألوهية وأثبت عدم استحقاقها للعبادة، إذ عرفها بالاسم الموصول بقوله: «إن الذين تدعون من دون الله»، فرسم في الذهن صورتها فاستوعب معناها، فهي من جملة مخلوقات الله المفتقرة إليه، فأثار في النفس استصغار شأنها واستنكار عبادتها، مع أنه لم يذكر اسمها صراحة، فلم يقل «إن أصنامكم»، وعول على هذه الطريقة في التصوير في آيات كثيرة، فجاءت الصورة في الذهن تعاضد الاستدلال على صحة ما صححه القرآن وبطلان ما أبطله، وحملت النفوس على قبوله والتسليم به، لذلك ناسب أن يعقب ههنا بقوله: «إن الذين تدعون من دون الله عبادٌ أمثالكم»، هي مملوكة لله خاضعة لعظمته مسخرة لسلطانه، عاجزة لا تملك لنفسها ولا لغيرها ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً.
هذه التي زعمتم ألوهيتها هي مثلكم. لكن كيف شبهها بهم مع أن عجزها أظهر وأقوى من عجزهم تلك نكتة لطيفة، فإنهم يعترفون بعجز أنفسهم، والذي يدعوهم إلى عبادتها والاستعانة بها توهمهم قدرتها على الخلق والهداية والتأييد والنصر. ولكن غاية المبالغة في شأنها بعد أن بين انحطاطها عن رتبة الألوهية؛ أن يقال لهم عنها: إنها مثلكم، فصار في ذلك من الاستدلال المفحم على بطلان عبادتها والعياذ بها ما لا قبل لهم برده، خاصة وأنه تعالى قرن عبدية الأصنام بتحدي المشركين وتبكيتهم بقوله: «فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين».
وضع الاسم الظاهر موضع الضمير
وهو أسلوب قوي في استحضار الصورة جلية إلى الذهن، وهو كثير في القرآن المجيد، كقوله تعالى: «قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون». صورت الآية تجدد حزن الرسول لاستمرار عناد المشركين وتكذيبهم بدلائل النبوة وآيات الله الباهرات، وواست الآية رسول الله مفيدة بلوغ الرسول من جلالة القدر ورفعة الشأن ما قضى بنفي التكذيب له، وأنهم إنما كانوا يكذبون آيات الله. لكن الآية وضعت الاسم الظاهر «الظالمين» موضع الضمير، إذ قال تعالى: «ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون»، ولم يقل ولكنهم. وهذا فن من فنون القرآن، أحضر إلى ذهنك صورة المشركين ورسوخهم في الظلم بالتكبر والتجبر وجحود الحق المبين. فاستقر في النفس أن القوم عتاة مردوا على الضلال ومجافاة أمر الله.
ومن هذا القبيل أيضاً وضع اسم الإشارة موضع الضمير كما في قوله تعالى في مطلع سورة البقرة: «الم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون». فقد صورت لنا الآيات صورة المتقين المستمسكين بالكتاب المبين. ثم أثارت الصورة مرة ثانية واستحضرتها في الذهن باسم الإشارة «أولئك على هدى من ربهم» فصاروا ماثلين في الخيال بصفاتهم المذكورة إيماناً بالغيب وإقامة للصلاة وإنفاقاً من أموالهم ويقيناً بشرائع الله المنزلة على المرسلين، فأشعرت القارئ بكمال تميزهم عن الناس بهذه الأوصاف التي نقلها اسم الإشارة إلى الذهن من حيز المعقول إلى نطاق المحسوس المشاهد، إذ أعانك اسم الإشارة على أن تتملاها بناظريك ثانية، ونبهك إلى علو منزلتهم ورفعة مقامهم بالإشارة للبعيد «أولئك».
وأراكهم في رحلة الحياة الدنيا لا يمتطون راحلة تتعثر ولا جواداً يكبو ولا سفينة تعصف بها الرياح وتتقاذفها الأمواج في لجج البحار، ولكنهم امتطوا خيراً من ذلك، إذ تمسكوا بالهدى وتمكنوا منه واستقروا عليه. فصورتهم الآية كمن اعتلى شيئاً، وحذفت المشبه به على طريق الاستعارة المكنية، فأفادت رسوخهم في الهداية، وجاء اسم الإشارة ثانية يستحضر في الذهن صورتهم بأوصافهم «وأولئك هم المفلحون»، ليدل على استحقاقهم الفوز والظفر بنعيم الآخرة وجدارتهم به، مع تصويرهم وهم يشقون طريقهم للفوز، كما توحي به مادة «فلح».
التصوير بالاستعارة
وقد سبر الأقدمون أغوار هذا اليم الخضم، وفيه جوانب لم تزل بحاجة إلى التأمل والدراسة والاستنتاج، فالبحث جليل ممتع متعدد الألوان، نقتصر منه على هذا النموذج الموحي. قال الله تعالى: «فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين». الصدع: الشقُّ في الشيء الصلب كالزجاجة والحائط وغيرهما. وتأويل الصدع في الزجاج أن يبين بعضه من بعض. وقوله تعالى: «يومئذ يصدعون» قال الزجّاج: معناه: يتفرقون فيصيرون فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وعليه فإن الصدع يعني: الإبانة والتمييز، ومنه صدع بالأمر؛ أصاب به موضعه وجاهر به، وصدع بالحجة: تكلم بها جهاراً.
فالله تعالى يأمر محمداً صلى الله عليه وسلم في هذه الآية: اجهر يا رسول الله بما أمرك الله به من الشرائع المنزلة عليك في كتابه العظيم، أو فرق برسالة الله بين الهدى والضلال، وميز بها الحق من الباطل، واعتمد على الله وحده، ولا تبال بالمشركين، ولا تأبه لأقوالهم وتصرفاتهم. وقد ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفياً بالدعوة، حتى أنزل الله هذه الآية، فخرج هو وأصحابه وأعلنوا الدعوة غير عابئين بالمشركين. وقال ابن الأعرابي: «فاصدع بما تؤمر» شق جماعتهم بالتوحيد. وذهب ابن أبي الأصبع المصري إلى بيان الاستعارة على النحو التالي: «فاصدع بما تؤمر» فالمستعار منه الزجاجة، والمستعار الصدع، وهو: الشق، والمستعار له عقول المكلفين، والمعنى صرح بجميع ما أوحي إليك، وبين كل ما أمرت ببيانه، وإن شق ذلك على بعض القلوب فانصدعت، والمشابهة بينهما فيما يؤثره التصديع في القلوب، فيظهر أثر ذلك على ظاهر الوجوه من التقبض والانبساط، ويلوح عليها من علامات الإنكار والاستبشار، كما يظهر ذلك على ظاهر الزجاجة المصدوعة من المطروقة في باطنها.
وهذا اللون هو من نوع استعارة المحسوس للمعقول، ويمكنك أن تقول: إن المستعار منه: كسر الزجاجة، وهو حسي، والمستعار له: تبليغ الرسالة ونشرها، وهو أمر عقلي. والجامع بينهما: التأثير الذي لا يمكن معه رد الشيء إلى ما كان عليه سابقاً. فكسر الزجاجة وتفريق أجزائها لا يجبر ولا يلتئم، وتبليغ رسالة الله للناس وإعلانها عليهم وما ينجم عن ذلك أمر لا عودة بعده إلى الخفاء، كما لا عودة لأجزاء الزجاجة المصدوعة إلى الالتئام. ويقال في إجراء الاستعارة: شبه نشر رسالة الله وتبليغها تبليغاً قوياً جلياً بالصدع؛ بجامع التأثير في كل منهما. ولا ريب أن عماد الاستعارة «فاصدع» تلك الكلمة الموحية المعبرة، التي ترف بالمعاني الغزيرة.
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وبالعكس
حين يحدثنا القرآن عن أمور مستقبلة؛ فما أكثر ما ينبه على تحقق حدوثها قطعاً؛ بتصوير وقوعها وانقضائه سابقاً، إذ يعبر عنها بصيغة الماضي بدل المستقبل. وربما يحدثنا عن أمر ماضٍ فيصوره لنا حاضراً يجري أمامنا لنتأمل ما فيه من عجب مدهش. صور الله حالة المشركين وموقفهم من دعوة رسول الله وتجافيهم عن رسول الله إليهم، فقال جل جلاله: «ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنّة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، حتى إذا جاؤوك يجادلونك، يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون». هذه صورة كاملة لموقف المشركين من رسالة الله ودلائلها ومن رسوله الكريم. صورة بارعة النقل من الحياة البشرية الكاملة بحواسها وحوارها وحركتها، وركوب الإنسان متن الهوى إصراراً وعناداً، على الرغم من انبلاج الصبح ووضوح الطريق.
هذه الصورة لواقع المشركين في الدنيا قابلها الله بذكر صورة لواقع المشركين في الآخرة. ولئلا ينأى بك مستقبل الزمان عما سيحيق بهم؛ عدل القرآن العظيم عن التعبير بصيغة المضارع إلى الماضي، فالعقاب واقع بهم لا محالة، ها هو أمام ناظريك، فتأمله ملياً: «ولو ترى إذ وقفوا على النار، فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين». خاطبك النص القرآني إذ وجه الخطاب إلى غير معين، فوجهه إليك وإلى كل عاقل أهل لتلقي الخطاب، فإن سوء حال المشركين قد بلغت من الشناعة مبلغاً مريعاً فاضحاً، حتى صارت مكشوفة أمام الجميع لا يختص بمشاهدتها راءٍ دون آخر. هلّا نظرت إليهم: ها هم بخيلائهم وكبرهم؛ بجبروتهم وتكذيبهم، قد انقلبوا تماماً، انظر إليهم وقد حبسوا على النار لا يستطيعون إفلاتاً ولا تحولاً، وانكشفت لهم حقائق الأمور، رأوا شدائد وأهوال العذاب، فتملكهم فزع رهيب، وبدا عليهم الخزي والاستخذاء، ونطقت أفواههم بالحسرات والندم «ولو ترى إذ وقفوا على النار..» هذا سر التعبير ومدلوله. وقد كان متوقعاً أن يقول: «ولو ترى حين يقفون على النار حتى يعاينوها..» شتان شتان بين ما ينصرف إليه نبوغ البشر وما أنزله خالق البشر في قرآنه المجيد!!
لقد أورد القرآن التعبير عن المستقبل بصيغة الماضي إشعاراً بتحقق وقوع الحدث حتماً، وتصويره للذهن بصورته الواقعية وظروفها المادية والمعنوية. وأورد البيان الرباني «لو» شرطية وأغفل ذكر جوابها لتذهب نفسك عند قراءتها كل مذهب في ارتقاب أمر الأهوال، فصار حذف جوابها أبلغ في إدخال الهول على النفس البشرية، وتقديره: «ولو ترى إذ وقفوا على النار…» لرأيت هولاً رعيباً لا يحيط به نطاق التعبير. وقد استعار القرآن المبين لفظ الماضي للمضارع؛ بناءً على تشبيه المستقبل المحقق قطعاً بالحدث الماضي الواقع فعلاً؛ بجامع تحقق الوقوع في كل منهما.
التعبير عن الماضي بلفظ المضارع في التصوير القرآني
ويعبر القرآن أحياناً عن الماضي بلفظ المضارع: فقد اختلف بنو إسرائيل فيمن الذي يكفل السيدة مريم لما ولدتها أمها، ولجأوا أخيراً إلى القرعة، ففاز بها زكريا عليه السلام، فصاغ الله تعالى الخبر عن هذا بهذه الآية: «وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون».
فجاء التعبير بالمضارع – في الفعلين: «يلقون – يختصمون» بدلاً عن الماضي بمزيد تنبيه للحدث المذكور، حتى يجعل الصورة العجيبة الغريبة تجري أمامك في ساحة الحادثة، فتشارك القوم في قرعتهم، وفي اختلافهم.. براعة فائقة في التصوير، أثارت الخيال واستحوذت عليه بغرابة الصورة المعروضة، حتى يكاد المرء يحسب أنه يراها رأي العين. وهكذا استعير لفظ المضارع للماضي؛ بناءً على تشبيه غير الحاضر بالحاضر، لاستحضار صورته الماضية، لما فيها من غرابة وعجب!
الخاتمة
هكذا يتبين لنا أن التصوير في القرآن الكريم ليس مجرد أسلوب بلاغي عابر، بل هو منهج متكامل يخاطب الإنسان بجميع ملكاته وقدراته، فيحول المعاني المجردة إلى مشاهد حية نابضة بالحركة والحياة. إن هذه الطريقة الفريدة في البيان القرآني تجعل القارئ لا يكتفي بفهم المعنى عقلياً، بل يعيشه وجدانياً ويتفاعل معه حسياً، فتنطبع الصورة في ذهنه وقلبه معاً، وتحفزه للعمل والاستجابة. ولعل هذا من أعظم أسرار إعجاز القرآن الكريم وخلوده، إذ يظل قادراً في كل عصر على مخاطبة الإنسان بلغة تستوعبها فطرته وتستجيب لها مشاعره، مهما تطورت وسائل التعبير والتصوير البشرية. فالتصوير القرآني يبقى المعيار الأسمى والنموذج الأكمل للبيان الذي يجمع بين عمق المعنى وجمال الصورة وقوة التأثير، في تناسق بديع يشهد بأن هذا الكلام من عند خالق الإنسان العليم بخبايا نفسه وأسرار وجدانه.
سؤال وجواب
التصوير في القرآن الكريم هو طريقة فريدة في التعبير تعتمد على التشخيص والتخييل والتجسيم، حيث يحول المعاني الذهنية والحالات النفسية إلى صور حسية متحركة تخاطب العقل والوجدان معاً. هذا الأسلوب يجعل الموضوعات القرآنية حاضرة شاخصة أمام القارئ كأنه يشاهدها رأي العين.
٢. كيف يختلف التصوير القرآني عن الأساليب البلاغية التقليدية؟
التصوير القرآني ليس فناً من فنون البلاغة يظهر أحياناً ويغيب أحياناً أخرى، بل هو الأداة المفضلة والمنهج المتكامل في أسلوب القرآن كله. فهو يتجاوز التشبيه والاستعارة المجردة إلى خلق مشاهد حية نابضة بالحركة والحياة تخاطب كينونة الإنسان كلها.
٣. ما أهمية استخدام ظرف الزمان إذ في التصوير القرآني؟
يستخدم القرآن الكريم ظرف الزمان إذ لاستحضار الحوادث الماضية وتصويرها في زمانها وأحوالها، مما يجعل القارئ يعيش الحدث كأنه يشاهده مباشرة. هذا الأسلوب يحول السرد التاريخي إلى مشهد حي متحرك يثير الخيال ويحشد المشاعر والانفعالات.
٤. لماذا يعبر القرآن عن المستقبل بصيغة الماضي؟
يعبر القرآن عن الأمور المستقبلة بصيغة الماضي للإشعار بتحقق وقوعها حتماً، فيصور الحدث المستقبلي وكأنه قد وقع فعلاً وانقضى. هذا التصوير يجعل المشهد واقعياً أمام الذهن بكل ظروفه المادية والمعنوية، مما يزيد من قوة التأثير والتحذير.
٥. ما الفرق بين التعبير الذهني المجرد والتعبير التصويري في القرآن؟
التعبير الذهني المجرد يصل إلى العقل فقط ويركد هناك في برود وسكون، بينما التعبير التصويري القرآني يثير الحواس والخيال والانفعالات الوجدانية معاً. فالتصوير يحول المعنى إلى مشهد متحرك تشترك فيه حاسة النظر وملكة الخيال والمشاعر المختلفة.
٦. كيف يساهم التصوير القرآني في تحقيق الهداية والإيمان؟
يخاطب التصوير القرآني الإنسان بكليته عقلاً ووجداناً ونفساً، فيثير في خياله صوراً حسية تترك تأثيرات وانفعالات قوية عميقة تحشد نوازع الخير في العقل والنفس. هذا التأثير الشامل يجعل الإنسان ينطلق مؤمناً بعقيدة القرآن مستمسكاً بهديه عبادة وخلقاً وشريعة.
٧. ما دور الاستعارة في التصوير القرآني؟
تلعب الاستعارة دوراً محورياً في التصوير القرآني من خلال استعارة المحسوس للمعقول، مما يجعل المعاني المجردة ملموسة ومتخيلة. كما في قوله تعالى فاصدع بما تؤمر حيث شبه تبليغ الرسالة بصدع الزجاجة، بجامع التأثير القوي الذي لا رجعة فيه.
٨. لماذا يضع القرآن الاسم الظاهر موضع الضمير؟
يضع القرآن الاسم الظاهر موضع الضمير لاستحضار الصورة جلية إلى الذهن مع كل صفاتها وخصائصها. كقوله تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بدلاً من ولكنهم، ليرسخ في النفس صورة المشركين ورسوخهم في الظلم والجحود.
٩. ما أهمية نظرية التصوير الفني في فهم إعجاز القرآن؟
تساعد نظرية التصوير الفني على تفسير إعجاز القرآن بمقياس معاصر سليم، وتجمع الدراسات البلاغية المتفرقة في فلسفة أدبية متكاملة. كما توضع مقياساً نقدياً يميز بين الإجادة في استعمال التعبير اللغوي وبين التكلف والتصنع المستكره.
١٠. كيف يحول التصوير القرآني المستمع إلى مشاهد للأحداث؟
يستخدم القرآن الحوار والحركة والتخييل الحسي فيحيل المستمعين نظارة ينقلهم إلى مسرح الحوادث الأول، حيث تتوالى المناظر وتتجدد الحركات وينسى المستمع أن هذا كلام يتلى ويتخيل أنه منظر يعرض وحادث يقع أمامه مباشرة.