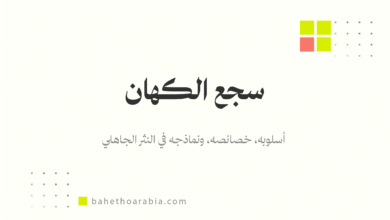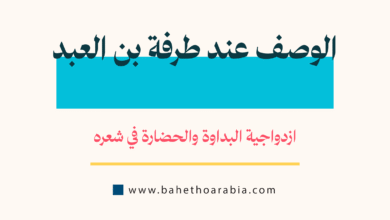الطيور في الشعر الجاهلي بين الشؤم والفخر والحنين: النعامة إلى القطا

تمثّل الطيور في الشعر الجاهلي حقلاً دلالياً وثقافياً ثريّاً تتداخل فيه الرموز والدلالات بين الشؤم والفخر والحنين. تسعى هذه المقالة إلى تفكيك حضور الطيور في الشعر الجاهلي من خلال قراءة نصوصٍ مختارة تبرز وظائف الصورة الطيرية في بناء المعنى الشعري، من تشبيه السرعة والفروسية، إلى نُذُر الفقد والتطيّر، إلى الأنس والوجدان. وتعرض الدراسة خريطةً نوعية تشمل النعامة والغراب والبوم والرخم والعقاب والنسر والصقر والحمام والقطا، موضّحة كيف يُعاد تركيب الواقع الطبيعي في المخيال الشعري ليغدو جهازاً بلاغياً يعبّر عن قيم المجتمع الجاهلي وممارساته الحربية والوجدانية.
تعتمد المقالة مقاربةً نصّية وثقافية تستند إلى الأثر الشعري وروايات اللغة والأمثال كما في لسان العرب والجاحظ، وتُحلّل عناصر اللون والصوت والحركة في صياغة الصورة. وتبرز شواهد لامعة لامرئ القيس وعنترة وطرفة والنابغة وعبيد بن الأبرص والمنخل اليشكري والسّود بن يعفر وثعلبة بن صغير، لتبيّن كيف تُسهم الطيور في الشعر الجاهلي في تشكيل مجازات القوة، وتوطين الحسّ العاطفي، وصياغة السرد الثقافي من النعامة إلى القطا.
النعامة في المثل واللغة والتشبيه
في جزيرة العرب تنتشر أنواع من ذوات الأجنحة أشهرها النعامة، وذكرها الظليم؛ وعلى الرغم من أن النعامة من أضخم الطير فإن قِصَر جناحيها يحول دون طيرانها، لكنها إذا نشرت جناحيها وانطلقت كانت بالغة السرعة، حتى ضربت العرب بها المثل في العَدْو فقالت: (أعدى من النعامة). وهذه الصورة الدالة تُجسّد حضور الطيور في الشعر الجاهلي.
قال عامر بن الطفيل وهو يفاخر بانتصار قومه، ويصوّر خصومهم كأنهم سرب نعام مذعور:
قتلنا كبشهم فنجَوْا شلالاً * كما نفّرْتَ بالطّرد النعاما
ويكشف هذا الفخر الحربي عن وظائف الطيور في الشعر الجاهلي في بناء صورة الانتصار.
ومن مأثور كلامهم: (ركب فلان جناحي نعامة) إذا جَدَّ في أمره، وتقول العرب للقوم إذا ظعنوا مسرعين: (خفت نعامتهم، وشالت نعامتهم). قال ذو الإصبع العدواني يندّد بالخلاف القبلي الذي فرّق قومه:
أزرى بنا أننا شالت نعامتنا * فخالني دونه وخلته دوني
وهذا التداول الأمثالي مفتاح لقراءة الطيور في الشعر الجاهلي في سياقات الحماسة والرحلة. ويتبدّى هنا أثر الطيور في الشعر الجاهلي في تصوير الظعن والفرقة.
وجاء في لسان العرب: (العرب تقول: أصمّ من نعامة، وذلك أنها لا تلوي على شيء إذا جفلت. ويقولون: أموق من نعامة، وأشرد من نعامة، وموقُها تركها بيضها، وحضنها بيض غيرها). ومن أمثالهم: (من يجمع بين الأروى والنعام)؛ لأن مساكن الأروى شعاف الجبال، ومساكن النعام السهول، فهما لا يجتمعان أبداً. وتعكس هذه الشواهد اللغوية والمنثورة حضور الطيور في الشعر الجاهلي بوصفها مرجعاً دلالياً وثقافياً.
وقال الجاحظ: (تزعم الأعراب أن النعامة ذهبت تطلب قرنين، فرجعت مقطوعة الأذنين، فلذلك يسمونه الظليم). ويمثّل هذا الخبر إحدى طرائف الطيور في الشعر الجاهلي حين تتقاطع الأسطورة بالوصف.
ومن أجمل القصائد وصفاً للنعامة أبيات لتعلبة بن صغير يصف فيها ناقته السريعة، فيشبّهها بظليم يبارز نعامة؛ فإذا انطلقت الناقة بما فوق ظهرها من أمتعة تهتز على جانبيها ظننتها ظليماً مبسوط الجناحين يباري نعامة، يتساقط ريش جناحيها من شدّة المباراة كما يتساقط الليف من نخلة يشذبها آبرها. وأثناء الجري تتذكّر النعامة بيضها الذي تركته نضيداً في موطنها، وتتذكّر صغيرها الذي خلّفته يأكل من ثمر الآء وثمر الحنظل الرّيّان الغليظ. ثم يرسم الشاعر صورة أخرى للسرعة، فيجعل الظليم والنعامة دفعةً من المطر القويّ ترسله السماء إلى الأرض، ويختم المشهد بصورة هادئة للنعامة مساءً وقد ربضت على بيضها، وبسطت حوله جناحيها كخيمة، حتى يُخيّل لمن يراها أنها امرأة قرشيّة انحسر جانب من قناعها عن وجهها:
وكأن عيبتها وفضل فتانها * فننان من كنفي ظليم نافر
يبري لرائحة يساقط ريشها * مرُّ النّجاء سقاط ليف الآبرِ
فتذكرت ثَقَلاً رئيداً بعدما * ألقت ذُكاءُ يمينها في كافر
طَرفت مراودها وغرّد سقبُها * بالآءِ والحدج الرِّواء الحادر
فتروحا أصُلاً بشدّ مُهذِبٍ * ثرّ كشؤبوب العشي الماطر
فبنت عليه مع الظلام خباءها * كالأحْمسية في النصيف الحاسر
ومهما يكن حظ النعامة من السرعة فإنها لا تملك من ذوات الأجنحة غير القدرة على النفرة والفرار، ولا تستطيع أن تقرن نفسها بالجوارح كالنسور والصقور، ولا بالأوالف كالحمام واليمام.
صور القوة والعطف والحنين والشؤم
تتعدد الصور الفنية للطير في النتاج، فيوحي بعضها بالقوة والسلطان، ويشيع من بعضها العطف والإيناس، ويرتبط بعضها بالحنين إلى الوطن، وبعضها بالشؤم والفرقة؛ وهذه البانوراما تمثّل خرائط الطيور في الشعر الجاهلي. ومن ثم تتوزّع الموضوعات بين الفخر والرثاء والغزل والوصف، وكلّها تستدعي الطيور في الشعر الجاهلي بوصفها علامات ثقافية. وتتضافر الدوال الصوتية واللونية والحركية لتصنع مشاهد الطيور في الشعر الجاهلي ومقاصدها البلاغية. وعلى هذا الأساس يمثّل الغراب والبوم والرخم والعقاب والنسر والصقر والحمام والقطا عصب الطيور في الشعر الجاهلي.
الغراب: صورة الشؤم والفرقة
ربما كان الغراب أشأم الطير في المخيال، وشؤمه مغروس فيه غرساً اشتقاقياً؛ فهو صنو الغربة والاغتراب والتغرّب والغروب. ويكثر ذكره في معرض التطيّر، ونعيبه من أقبح الأصوات، وسواده قرين الحزن؛ وهذا التأثيث الرمزي أحد أوضح مسارات الطيور في الشعر الجاهلي. وعلى هذا النحو جعله عنترة بن شدّاد علامة شؤم وفراق، ودليلاً على وقوع ما يخشاه من ابتعاد أحبته:
ظعنَ الذين فراقَهُم أتوقّع * وجرى ببينهم الغرابُ الأبقعُ
خرقُ الجناح كأنّ لَحْيَيْ رأسه * جَلَمانِ بالأخبار هشّ مولعُ
وهكذا يستكمل الغراب دوره في رسم خرائط الفقد ضمن الطيور في الشعر الجاهلي، حيث تلتقي دلالات اللون والصوت والحركة. وتتجلّى هذه البنية الرمزية كلما استُحضر الغراب في سياق الطيور في الشعر الجاهلي، إذ يغذّي صور الفراق والبين.
البوم: مخاوف الليل والقفار
البوم شبيه بالغراب في الدلالة على الشؤم عند العرب، لكنه عند بعض الأعاجم من طير الخير. قال الجاحظ: (البوم عند أهل الري وأهل مرو يُتفاءل به. وأهل البصرة يتطيرون منه). ومن أقوال العرب: (إن لئام الطير ثلاثة: الغربان، والبوم، والرخم). ولعلّ علّة التطيّر من البوم منظرُه الكئيب، وصوتُه الحزين، وظهورُه في الليل، وأماكنُ سكنه المهجورة، وهو ما أشار إليه باحثون كالدكتور نوري القيسي. وهذه الخلفية الثقافية تُدرج البوم في شبكة الطيور في الشعر الجاهلي.
وذكر البوم في الشعر مقترناً بالمخاوف والقفار. وقد ذكر السّود بن يعفر البوم حين وصف ناقته السريعة وهي تجوز فلاة لا ماء فيها ولا شجر، تشقّها الرياح، وتسرح فيها أخبث الحيوانات والطيور كالثعالب وذكور البوم، فقال:
وسمحة المشي شملال قطعت بها * أرضاً يحار بها الهادون ديموما
مهامهاً وخروقاً لا أنيس بها * إلاّ الضوابحَ والأصداءَ والبوما
وكان العرب يكرهون هذا الطائر لفساد خُلقه وبغيه على بغاث الطير. قال الجاحظ: (يدخل بالليل على كل طائر في بيته، ويخرجه منه، ويأكل فراخه وبيضه). وتكشف هذه المرويات عن طبائع منسوبة للبوم داخل مدوّنة الطيور في الشعر الجاهلي.
الرخم: آكلة الجيف ومطاردة الجيوش
من جوارح الطير الرخم، وهي من آكلة الجيف، وتمتاز بأنها أكثرها كَلَفاً بنقر عيون القتلى، وأشدّها تعقّباً للجيوش طمعاً في الظفر بالجثث. قال طرفة بن العبد مفاخراً بشجاعة قومه وقتلهم خصومهم وتركهم أشلاءهم طعاماً للرخم:
تذر الأبطال صرعى بينها * تعكِفُ العقبان فيها والرّخَمْ
ومن طباع الرخم ـ كما يذكر الجاحظ ـ اختيارها لسكنها وبيضها أعلى القمم وأشدّها وعورة، ولذا صار بيضها المنجحر في صدوع الصخور على الذرى الشاهقة مضرب المثل في الامتناع. ومع ذلك لم تكن محبّبة للشعراء لقذارتها ولؤمها، وأكثر ما يرد ذكرها فيه الهجاء، وهو مسار مخصوص من مسارات الطيور في الشعر الجاهلي.
العقاب: رمز الفروسية والهجوم الخاطف
تُعَدّ العقاب من الجوارح الطويلة الأعمار، مرهفة السمع، قويّة المخالب، قادرة على احتمال الثعالب والأرانب والظباء، وربما ضربت بمخالبها حُمُر الوحش فشقّت جلودها، وإذا أبصرت الطيور الأخرى ذلك لزمت أوكارها خوفاً، بل ربما انصبّت على الذئاب كالصواعق المدمّرة. وحين وصف امرؤ القيس سرعة فرسه، لم يجد أقوى من تشبيهها بانقضاض العقاب على الذئب؛ فصوّرها منقضّةً من كبد السماء، والذئب مرتبك مذعور يطلب مأمناً فلا يجده، والعقاب تهوي عليه هويّ الصواعق من بين السحب، وتعصف به عصف الرياح بالعشب، فينطلق بكل ما بقي في أعصابه من قوةٍ ونفرة، غير أنها تحط على ظهره وتُرسل في متنه الأزل مخالبها الحادّة:
ويلمُها من هواء الجو طالبة * ولا كهذا الذي في الأرض مطلوب
كالبرق والريح شدّاً منهما عجباً * ما في اجتهادٍ عن الإسراع تغبيبُ
فأدركته فنالته مخالبها * فانسل من تحتها والدّف منقوب
يلوذ بالصخر منها بعدما فترت * منها ومنه على العقب الشابيبُ
ولم يكتف امرؤ القيس بالجانب الحسّي من الإغارة، بل لحق بالذئب إلى ملاذه يحلّل ما تركته مخالب العقاب في نفسه من جراح غير مرئية؛ إذ صار الذئب مفزّعاً مروّعاً، رضي من المعركة بالنجاة بعد أن ساوره الموت، ولم يفصله عن حتفه إلا شعرة:
ما أخطأته المنايا قيس أنملةٍ * ولا تحرّز إلا وهو مكروب
فظل منجحراً منها يراقبها * ويرقب العيش، إن العيش محبوب
وتدل هذه المشاهد على حضورٍ مميّز للعقاب في بناء معجم الطيور في الشعر الجاهلي بوصفها أيقونة الشجاعة. ويبدو أنّ العرب لم يتشاءموا من العقاب؛ فقد شبّهوا الفرسان الشجعان بالعقبان، وأطلقوا لفظ العقاب على الراية، وهي رمز يعتز به كلّ جيش ويجعل خفقانها برهاناً على النصر، وهو ما يرسّخ مكانتها في الطيور في الشعر الجاهلي. قال عبيد بن الأبرص وهو يصف الراية الخفّاقة فوق الجيش الجرّار:
بمعضل لجب كأن عقابه * في رأس خُرصٍ طائر يتقلّبُ
وبذلك تتّضح وظيفة العقاب في معماريّة الطيور في الشعر الجاهلي.
النسر: طول العمر وصور الحرب
النسر من كرام الطير، وهو من سباعها لا من جوارحها؛ إذ لا مخالب له، وتكمن قوته في أظافره ومنقاره وقوة جسمه، لكنه عاجز عن احتمال الفرائس الثقال. ومن دقيق تصوير النسور اللوح المشهور الذي رسمه النابغة وعلّقه فوق جيش الغساسنة وخلفه؛ فيه نسورٌ محوِّمة فوق الجيش، أسرابٌ يلحق بعضها بعضاً، تصاحب الجيش في إغارته لتصاب من جثث القتلى ما ألفته بعد دربة طويلة بالولوغ في الدماء. وإذا هبط النظر من أعلى اللوح إلى وسطه، رُئيت النسور رابضة وراء الجيش على رؤوس الجبال، تنظر بمآخير عيونها الضيّقة متلهّفة إلى الدماء، متلفّفة بريشها الكثيف كما يتدثّر الشيوخ بأكسية الفرو:
إذا ما غزوا بالجيش حلّق فوقهم * عصائب طير تهتدي بعصائب
يصاحبنهم حتى يُغرْنَ مُغارَهم * من الضاريات بالدماء الدوارب
تراهنّ خلف القوم خُزاراً عيونها * جلوسَ الشيوخ في ثياب المرانب
ومما وصف به الجاحظ النسر قوله: (النسر طير ثقيل عظيم شره رغيب نهم، فإذا سقط على الجيفة وتملّأ لم يستطع الطيران حتى يثب وثبات). وذكر عن العرب أنّهم يضربون بالنسر المثل في امتداد العمر؛ يدلّك على ذلك أنّ طرفة سخر ممن يرغب في البقاء، لأن لقمان بن عاد عاش دهراً طويلاً يعدل أعمار نسور متعاقبة، ثم قضى نحبه:
ألم تر لقمان بن عاد تتابعت * عليه النّسور ثم غابت كواكبه
وتُظهِر هذه الأمثلة كيف تُستثمر صورة النسر ضمن الطيور في الشعر الجاهلي لبناء مجازات الحرب والعمر.
الصقر: كرام الجوارح والتشبيه بالفرسان
الصقر آخر ما نتحدّث عنه من الجوارح في هذا السياق. تسميه العرب الأكدر والأجدل، ويمتاز باستجابته للتدريب واستخدامه في الصيد. ولهذا قرنه العرب بالفرسان الشجعان الذين ينقضّون على خصومهم ويقنصونهم. قال عنترة:
فعليه أقتحمُ الهياج تقحُّماً * فيها، وأنقضُّ انقضاضَ الأجدل
والصقر عند العرب من كرام الجوارح؛ ولذلك قرنه الجاحظ بالملوك فقال: (والباز والفهد من جوارح الملوك، والشاهين والصقر). إلا أنّ الصقر أكرم من البازي عند الجاحظ (لأنّ الباز عندهم أعجمي، والصقر عربي). وهذه المكانة تُضفي على الصقر بعداً خاصاً في معجم الطيور في الشعر الجاهلي.
ولما كان الصقر عربيّ النسب شريف الحسب شبّه الشعراء به أحبَّ المخلوقات إليهم كالناقة والحصان. من ذلك بيت لعامر بن الطفيل يصف فيه سرعة جواد عنترة (الأغر)، فيراه في انطلاقه إلى غايته صقراً ينقضّ من علّ:
ونجا بعنترة الأغرّ من الرّدى * يهوي على عجلٍ هُويَّ الأجدلِ
وهكذا يستقيم قياس الشجاعة والكرم في سياق الطيور في الشعر الجاهلي.
الحمام: الأنس والشفقة والحنين
ما ذكر من الجوارح لا يعني أنّ بلاد العرب خلت من أوالف الطير النواعم، ولا أنّ نفوس الشعراء رغبت عن وصفها وآثرت عليها سباع الطير. ففي بلاد العرب الحمام واليمام والقطا والعصافير، وفي نفوس الشعراء من الرأفة والرقة مثل ما فيها من الحميّة والبأس، وربما كان أشدّ الفرسان بأساً في الحرب أشدَّهم أنساً في السلم. ولذلك قد يكون الحمام أحبّ إلى الفرسان العتاة من الجوارح؛ لأنه يردّ إليهم ما تجبرهم خشونة البداوة على إغفاله وهم عليه مفطورون. قال الجاحظ: (والناس يقولون: آمن من حمامة مكة. وهذا شائع على جميع الألسنة، ولا يردّ ذلك أحدٌ ممن يعرف الأمثال والشواهد). غير أنّ ميل الحمام إلى السلام بلغ حدّ الخرق والتفريط بالبيض والفراخ؛ فهو يبني أعشاشه فوق الأغصان اللدنة المترنّحة مع ذيول الريح بناءً غير محكم، حتى غدت أعشاشه مضرب المثل في الضعف، وهي ملاحظة تتكامل مع وظيفة الحمام ضمن الطيور في الشعر الجاهلي.
وحين وصف عبيد بن الأبرص بني أسد بالتواكل والضعف والغفلة، لم يجد ما ينقل هذه الصفات من المعاني المجرّدة إلى الباصرة خيراً من عش الحمام المصنوع من قشٍّ وأعواد:
برمت بنو أسدٍ كما * بَرَمتْ ببيضتها الحمامهْ
جَعَلت لها عُودين من * نشَمٍ وآخر من ثُمامه
وفي الحمامة صفة من صفات البشر هي حبّ الاجتماع والاشتراك في الطيران؛ فإذا حوّمت حمائم قليلة لحقتها صويحباتها، ثم انضمّت إليها أخريات، وانتظمن جميعاً في سرب واحد. قال النابغة الذبياني يصف سرباً:
قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا * إلى حمامتنا أو نصفه فقد
فحسّبوه، فألفوهُ كما حسَبتْ * تسعاً وتسعين لم تنقص ولم تزدِ
وفي المدونة يَقترن ذكر الحمام بالشجن والحزن، ويستثير هديله في نفوس أشدّ الأبطال كامن الحنين؛ حتى ليبعث صوت حمامة على شجرة شاعراً جَلْداً على البكاء كعنترة:
طال الثَّواءُ على رسوم المنزل * بين اللكيكِ وبين ذات الحرملِ
أفمن بكاء حمامةٍ في أيكةٍ * ذرفتْ دموعك فوق ظهر المحملِ
وأشيع الصور التي استوحى الشعراء خطوطها وألوانها من الحمام تشبيه الأثافي ـ وهي موقد من ثلاثة أحجار تضرب إلى السواد من أثر الوقود ـ بثلاث حمامات سود. قال عديّ بن زيد:
وثلاث كالحمامات بها * بين مجناهنّ توشيم الحمم
وتدل هذه النماذج على أنّ الحمام يمدّ الطيف العاطفي في الطيور في الشعر الجاهلي، حيث يمتزج الأنس بالشجن والذكرى. وتتوالى الاستدعاءات لتجعل من الحمام ركناً بلاغياً في بناء صور الطيور في الشعر الجاهلي. وإذ تتجاور مفردات الألفة والنوح، فإن ذلك يعمّق محتوى الطيور في الشعر الجاهلي باعتبار الحمام صوتاً وجدانياً أصيلاً.
القطا: الظمأ والهداية وصور الغزل
الضرب الثاني من الطير غير الجارح القطا، وهو شبيه بالحمام حجماً وشكلاً؛ حتى عدّه ابن قتيبة فرعاً من الحمام فقال: (القطا من الحمام). وقال الدميري: (القطا نوعان: كدري وجوني … فالكدري غبر اللون رقش البطون والظهر، صفر الجلود… والجونية سود بطون الأجنحة والقوادم، وظهرها أغبر أرقط تعلوه صفرة، وهي أكبر من الكدري). وسُمّي القطا بهذا الاسم بسبب صوته؛ لأنه إذا هدل سُمِع منه ما يشبه صوت القاف والطاء. والعرب تضرب المثل في القطاة بالهداية؛ لأنها تبيض في القفر، وتسقي أولادها من البعد ليلَ نهار، فتجيء في الليالي المظلمة وفي حواصلها الماء، فإذا صارت حيال أولادها صاحت: قطا قطا، فلا تُخطئ بلا علَم ولا إشارة ولا شجرة. ومن هنا يتشكّل بُعد الهداية والظمأ في تمثيلات الطيور في الشعر الجاهلي.
ويكثر ذكر القطا في سياق الورود بعد الظمأ. ولعل أجمل ما قيل في ذلك لوحٌ دقيق الخطوط رسمته ريشة الشنفرى: غديرٌ وردته أسراب من القطا الكُدري بعد أن قطعت مسيرة يوم، وأحشاؤها اليابسة تصلصل من العطش؛ ووافق وصولها وصول الشنفرى، ولعله أظمأ منها، لكنه بعد أن تهيّأ للورود، وكانت شفتُه تلامس شفة الغدير، زجر نفسه وخلّى الغدير للقطا؛ فدنَت منه وأرسلت فيه مناقيرها حتى غاصت ذقونها وامتلأت حواصلُها، وهي تهدل هديلًا مبغوماً مختلط الإيقاع، كأنها قوافل من قبائل مختلفة أناخت حول الغدير وهي تلغو وتلهو وتشرب وتَشغَب:
وتشرب آساري القطا الكدر بعدما * سرت قرباً أحناؤها تتصلصل
هممت وهمّتْ وابتدرنا، وأسدلت * وشمّر منّي فارط متمهلُ
فولّيت عنها، وهي تكبو لعقره * يباشره منها ذُقون وحوصل
كأنّ وغاها حَجْرتيه وحوله * أضاميمُ من سَفْر القبائل نُزّل
وقد ينقل الشاعر صورة القطا إلى ميدان الغزل، لكن الظمأ إلى الماء يظلّ ظلاً ملازماً للصورة؛ كأن اللسان البدوي الظامئ لا يجد ريّه إلا في الشعر العذب. ومن أجمل الغزل المنسوب إلى المنخل اليشكري تلك الرائية الراقصة الحركات والكلمات، الرافلة بين الفتاة والقطاة:
ولقد دخلت على الفتا * ة الخدر في اليوم المطير
الكاعب الحسناء تر * فل في الدّمقس وفي الحرير
فدفعتها، فتدافعت * مشي القطا إلى الغدير
وربما قرن الشعراء القطا بالخيل على بُعد ما بينهما؛ فكأن الظمأ الذي ذكّر اليشكري الظامئ إلى الحب بالقطاة الظامئة إلى الماء هو الذي دفع امرأ القيس إلى الجمع بين الخيل والقطا، فجعل جماعات الخيل الظامئة كرجال الجراد مرّة، وأسراب القطا أخرى، وهنّ جميعاً يَهِمْن ورود الماء:
إذ هًنَّ أقساط كرجل الدَّبى * أو كقطا كاظمة النّاهل
وبذلك تمتد صورة القطا بوصفها رمزاً للورود والحنين ضمن الطيور في الشعر الجاهلي.
خاتمة
إنّ الإحاطة بصور الطبيعة الحيّة في الشعر الجاهلي مطلب صعب في كتاب، ولذلك اجتُزئ العرضُ بالشهير الشائع منها وأغفل ما تُوهِّم أنّه قليل الذيوع باهت الجمال كصور الجراد والحجل والغنم واليمام والعصافير والضِّباب والحَرابيّ والحشرات المختلفة ممّا يكثر ذكره ولا يبهر سحره. ويكفي ممّا تقدّم أنّه أبرز ملامح مركزية الطيور في الشعر الجاهلي في بناء لوحات الشؤم والفخر والحنين، من النعامة إلى القطا.