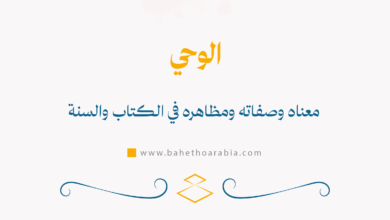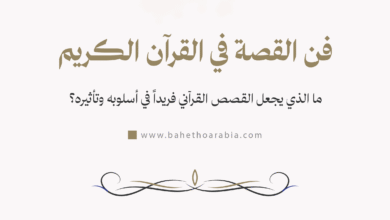تنجيم نزول القرآن الكريم: لماذا كان نزول القرآن منجماً
فهم كيفية نزول القرآن الكريم مفرقًا، والحكمة من وراء هذا التنزيل الإلهي الفريد.

يمثل تنجيم نزول القرآن الكريم معجزة فريدة تميز بها القرآن عن سائر الكتب السماوية، حيث اقتضت الحكمة الإلهية أن ينزل مفرقاً على مدى ثلاث وعشرين سنة. وقد اشتمل هذا النزول المنجم على حكم بالغة وأسرار عظيمة تكشف عن عناية الله تعالى بهذه الأمة وتربيتها.
المقدمة
إن تنجيم نزول القرآن الكريم يعد من أبرز الخصائص التي تفرد بها القرآن الكريم، فقد نزل على دفعات متعددة بحسب المناسبات والأحداث، مما جعله حياً متفاعلاً مع واقع المسلمين. وفي هذا النزول المفرق حكم جليلة وأسرار بديعة تجلت في تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وتربية الأمة، ومواجهة الشبهات، وإظهار وجوه الإعجاز القرآني. ولقد تولى الله تعالى بنفسه الإجابة عن تساؤلات المشركين حول هذه الخاصية، مبيناً الحكم العظيمة التي اقتضت نزول القرآن منجماً، مما يدل على عظمة هذا الكتاب المبين وإحكام تنزيله.
تميز القرآن الكريم في نزوله منجماً
تميز القرآن الكريم واختص من بين الكتب السماوية في نزوله من عند الله تعالى بأنه نزل منجماً، أي مفرقا على دفعات كثيرة، بحسب المناسبات واقتضاء الحال، فكثيرا ما كانت تنزل خمس آيات، أو عشر آيات، أو أقل أو أكثر، وقد صح نزول عشر آيات قصار في أول سورة المؤمنون. ونزلت عشر آيات طوال في قصة الإفك من سورة النور. وقد ينزل بعض آية كقوله تعالى: «وان خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء …» الى آخر الآية، نزل بعد نزول أول الآية: (يا أيها الذين آمنوا انها المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاميهم هذا) (٣٨)، وكان تأخير نزول القسم الاخير منها أن يصادف تخوف المسلمين من اخراج المشركين من مكة على مصالحهم، فيزيل هذا التخوف، فيكون أعظم أثرا في شفاء النفوس من القلق.
وقد استمر نزول القرآن ثلاثا وعشرين سنة منذ بدء الوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سن الاربعين، الى أن لحق بالرفيق الأعلى وهو في الثالثة والستين من عمره الشريف كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وقد كان هذا النزول المتدرج يحمل في طياته حكماً عظيمة ومقاصد جليلة تتناسب مع طبيعة الدعوة الإسلامية ومراحل بنائها، كما تتناسب مع حاجات الأمة وظروفها المتجددة.
أول وآخر ما نزل من القرآن الكريم
وكان أول ما نزل من القرآن على الاطلاق هو مطلع سورة العلق «اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم». كما ثبت في الحديث الصحيح. وكان هذا افتتاحا جليلا يؤذن بنقلة العالم الى العلم والحضارة. حتى إن الخطباء والأدباء، والكتاب والمفكرين لا يفترون من القول فيه وفي دلالات الافتتاح الحكيم للوحي به.
وأما آخر ما نزل من القرآن مطلقا فالراجح الثابت أنه قوله تعالى: ” واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون). ولا يخفى عظم موقع هذه الآية في اختتام الوحي بها، فان تأثير الدنيا والمال على الانسان عظيم، حتى قيل: «المال شقيق الروح، فكان اختتام الوحي بهذه الآية في غاية المناسبة لوعظ الناس، بتذكيرهم زوال الدنيا والرجوع الى الله تعالى في الآخرة، وجاءت عبارتها في غاية القوة والتأثير حيث عبر بقوله ثم توفى كل نفس ما كسبت)، هكذا بالإفراد تلقى ربها ويحاسبها. وعبر بقوله «وهم لا يظلمون» بالجمع، لأن العقوبة شملتهم. وصرح بنفي الظلم لأن المعاقبين وإن كانت عقوباتهم عظيمة مؤبدة فانهم غير مظلومين لأنه من قبل أنفسهم، وبما كسبت أيديهم.
الأولية والآخرية المقيدة في نزول القرآن
هذا ويجب التنبيه الى أن ثمة أوليّة وآخريّة من نوع آخر عني بهما العلماء، هي الأولية المقيدة أي النسبية، بالنسبة لموضوع معين، أو ناحية معينة. والآخريّة المقيدة أي النسبية بالنسبة لموضوع معين أو ناحية معينة كذلك. وهذا النوع من التقييد يساعد الباحثين والدارسين على فهم تدرج التشريع وتطور الأحكام بحسب المراحل والظروف.
ومن أمثلة أول ما نزل من القرآن مقيداً:
١ – أول سورة نزلت بتمامها سورة الفاتحة.
٢ – أول ما نزل في تحريم الخمر: «يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما».
ومن أمثلة آخر ما نزل من القرآن مقيدا:
١ – آخر ما نزل في المواريث آية الكلالة في آخر سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة …
٢ – آخر سورة نزلت بتمامها من القرآن: (إذا جاء نصر الله والفتح.
الحكمة من نزول القرآن منجماً
أثار أعداء القرآن من المشركين واليهود وغيرهم، السؤال: لماذا لم ينزل القرآن جملة واحدة، كما نزلت الكتب التي قبله؟ وهذا سؤال تولى الله تعالى الاجابة عنه في موضعين من قرآنه: قال تعالى: (وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل الا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا). وقال أيضاً: «وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا).
فبين القرآن حكما وأسرارا غفل عنها المتطفلون باقتراحهم، اقتضت نزول القرآن مفرقا، وبالنظر الى عبارات الآيات القرآنية نستطيع عرضها من خلال أربعة جوانب، يستدل عليها من الآيات السابقة. وهذه الحكم العظيمة تكشف عن عناية الله تعالى بنبيه وأمته، وعن دقة التشريع الإلهي وحكمته البالغة في اختيار طريقة النزول المنجم التي تناسب طبيعة الرسالة الخاتمة.
تثبيت فؤاد النبي وتقوية قلبه
وهذا أهم ما يحتاج اليه داعية الاصلاح، فكيف وقد بعث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوم جفاة شديدة عداوتهم، كما قال تعالى « وتنذر به قوما لدا ». وكانوا لا يكادون ينتهون من حملة أو مكيدة حتى يشرعوا في تدبير أخرى مثلها أو أشد أو أمر، فكانت تنزلات القرآن بين الفينة والأخرى تواسيه وتسليه، وتشد أزره وعزيمته على تحمل الشدائد والمكاره، لما فيها أولا من تجديد الاتصال بالملأ الأعلى كلما ادلهم الأمر أو نزل الخطب، مما يثلج القلب ويشرح الصدر، ويقوي العزم ويجدد الأمل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لاستمرار مواصلة الوحي، كما أن كثرة النزول بدفعات تجدد التحدي والاعجاز وظهور العجز والقصور، مما يبعث الهمة ويضاعف النشاط، مما فيه رد كيد الاعداء في نجورهم وظهور عجزهم المرة بعد الأخرى، فضلا عما يتضمنه التنزيل من ألوان التثبيت: ببيان سنة الله في الأنبياء قبله: « فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل » : « فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا » ، « وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ».
وبالوعد بالنصر له والظهور على أعدائه: «سيهزم الجمع ويولون الدُّبر.. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنَّهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم». وبالتذكير بالأسوة بالأنبياء السابقين وأحوالهم مع أقوامهم كما قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك). ويستطيع القارئ، تبين هذه الحكمة بسهولة ويسر لدى مراجعة قصص القرآن، كأن يقوم باستعراض سريع لسورة هود مثلا، وما فيها من بيان مواقف الامم من أنبيائها، وتحمل الأنبياء والمؤمنين معهم، وصبرهم حتى ينزل الله تعالى نقمته على أعدائهم، ويكرم المؤمنين بالفوز والنجاة، مما له أثره البالغ في تثبيت المؤمنين وزلزلة قلوب الكافرين لتكرار ذلك في كل موقف، ثم التفنن في تصويره في سور كثيرة، حتى كان لذلك أثره في تربية خلق الصبر والثبات على الاسلام، وترسيخ أسباب البقاء والصمود أمام عوامل الفناء، حتى ضربت الامة الاسلامية المثل البالغ حيث تعرضت لهزات وأعاصير أباد جزء منها أمماً وأذاب شعوباً وحضارات، فثبتت الامة الاسلامية، بل سجلت في هذا المضمار ما هو معجز، حيث إنها حافظت على نفسها ودينها وحضارتها ليس هذا فحسب، بل امتصت القوى التي جاءت لإفنائها وجعلتها هي تتحول لتكون من أسباب قوتها، كما حصل من الانقلاب الكبير للصليبيين بعد احتكاكهم بالمسلمين، والعبرة الأكبر في التتار الذين دخلوا الاسلام واعتنقوه، مما يبرز لنا أهمية التربية الاسلامية، وأسلوبها في غرس هذه العوامل بوسائل كثيرة منها أسلوب قصص الامم السابقة ولهذا ندرك أيضا موقع هذا الاختتام العظيم لسورة هود بهذه الآيات: « وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السموات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون).
ثم لا يخفى على الناظر ما في توالي الإنزال من كريم اعتناء وكبير شرف للرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن كثير: (حيث كان يأتيه الوحي من الله بالقرآن صباحا ومساء، ليلا ونهارا، سفرا وحضرا، فكل مرة يأتيه الملك بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة، فهذا المقام أعلى وأجل، وأعظم مكانة من سائر اخوانه من الأنبياء – صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه أعظم نبي أرسله الله. وقد جمع الله للقرآن الصفتين معا، ففي الملأ الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ الى بيت العزة في سماء الدنيا، ثم نزل بعد ذلك منجما بحسب الوقائع والحوادث».
مواجهة الحوادث والأمور الطارئة
وأهم ذلك ما يثيره المبطلون من الاعتراضات أو الشبهات، وهو الأصل الذي صرحت به الآية الكريمة: « ولا يأتونك » أي لا يأتونك بسؤال عجيب أو شبهة يعارضون بها القرآن بباطلهم العجيب « الا جئناك بالحق » بما هو الحق في نفس الأمر، الدامغ له، وهو أحسن بيانا وأوضح، وأحسن كشفا لما بعثت له، وكان جبريل واقف بالمرصاد يشرع سهم القرآن في صدور المشركين كلما أجمعوا أمرهم وألقوا سؤالهم أو حزبوا لنصرة الباطل أمثالهم.
هذا أبي بن خلف من رؤساء الشرك جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يده عظم رميم وهو يفتته ويذريه في الهواء وهو يقول: يا محمد أتزعم أن الله يبعث هذا؟ فقال: نعم، يميتك الله تعالى، ثم يبعثك، ثم يحشرك إلى النار، ونزلت هذه الآيات من آخر سورة يس « أولم ير الانسان أنا خلقناه من نطفة فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا فاذا أنتم منه توقدون». أي أولم يستدل هذا الانسان المنكر للحشر يوم القيامة بالبدء على الإعادة، فان الله ابتدأ خلق الانسان من سلالة من ماء مهين فخلقه من شيء حقير ضعيف مهين فالذي خلقه من هذه النطفة الضعيفة، أليس بقادر على اعادته بعد موته.
كذلك كانوا يلقون عليه أسئلة اختبار للتثبت من نبوَّته، كما روي في سبب نزول سورة الكهف أن قريشا سألت اليهود في المدينة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت لهم أحبار اليهود: سلوه عن ثلاث، فان أخبركم بهن فهو نبي مرسل. فنزلت في الاجابة عن الاسئلة الثلاثة سورة الكهف بشأن الفتية أصحاب الكهف وبقصة ذي القرنين، ونزلت آية الاسراء (يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الاَّ قليلا). وقد جاء مع هذا الجواب التوجيه الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم يعتب عليه أن قال لهم:(أخبركم غدا)، ولم يستثن، أي لم يقل ان شاء الله فأبطأ عليه الوحي خمسة عشر يوما وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه الوحي بالإجابات ونزل قوله تعالى: « ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا».
وكان المسلمون كذلك يسألون عما يهمهم من أمر دينهم، كالأسئلة عن النفقة «يسألونك ماذا ينفقون قل العفو» وعن الأهلة (ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، والحيض (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض». ولا شك أن الاسئلة لم تكن في وقت واحد بل كانت في أوقات متفرقة مختلفة، فكان لابد من نزول القرآن منجماً. ويدخل في هذا الجانب متابعة الوقائع والأحداث في وقتها ينزل الوحي بشأنها ببيان التوجيه الالهي كما في غزوة بدر ومسألة الأنفال، ومصيبة المسلمين يوم أحد ونزول القرآن بالدروس والعبر التي نجعت فيهم مدى حياتهم مع تسلية أحزانهم ومواساتهم. أو ينزل القرآن ببيان الحكم الالهي كما في آيات الزنا والطلاق والعدة والأيمان. ولم يكن من الممكن أبدا أن ينزل القرآن جملة واحدة يتحدث عن أشياء لابد منها في الدين وستقع لها مناسبات في المستقبل وتقتضي الحكمة التعليق عليها، كما سنذكر في أسباب النزول، لشرحها وبيان أسبابها ونتائجها، وبيان ما دبر للمسلمين في الخفاء من الأعداء الظاهرين، والمنافقين الباطنين وفي هذا نزل كثير من القرآن في أحكام شرعية وتوجيهات اسلامية إيمانية وعسكرية أو غير ذلك.
وهذه غزوات الرسول الكريم وحدها مثل غزوة بدر وأحد والخندق وتبوك وحنين مثال ناطق بهذه الحكمة الجليلة التي تقتضي نزول القرآن في مناسبتها «وبالحق أنزلناه وبالحق نزل». إن تنجيم نزول القرآن الكريم كان الوسيلة المثلى لمعالجة القضايا المستجدة والإجابة على التساؤلات الطارئة، مما جعل القرآن دستوراً حياً ينبض بالحياة ويتفاعل مع الواقع.
تعهد الأمة وتربيتها
ومن مظاهر هذا الجانب أنهم كانوا قوما أميين لا يحسنون القراءة والكتابة فكانت الذاكرة عمدتهم الرئيسة فلو نزل القرآن جملة واحدة لعجزوا عن حفظه. فأنزل الله قرآنه مفرقا ليقرأه الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم على تمهل فيسهل عليهم حفظه ويتيسر فهمه ودرسه كذلك. ثم ان الامة العربية التي خوطبت بالقرآن أولا قبل سائر الأمم كانت لها عقائد راسخة وعادات موروثة وأخلاق مأثورة عن أسلافهم يتباهون بها ويتفاخرون، ويتبارون في التمسك بها ويتسابقون، على عنجهية لم تعرفها أمة غيرهم ذاك، فكان كما قال الامام مكي بن طالب: « أدعى الى قبوله اذا نزل على التدريج، بخلاف ما لو نزل جملة واحدة فانه كان ينفر من قبوله كثير من الناس، لكثرة ما فيه من الفرائض والمناهي».
لهذا سلك القرآن الكريم معهم مسلك التربية الحكيمة، وهو مسلك التدرج في التشريع من حكم الى حكم. والتأني في نقلهم من حال الى حال، ومن خلق الى خلق، وهكذا بلغ الغاية في تخليهم عن عقائدهم الباطلة، وعاداتهم المسترذلة، وسما بهم الى عقائد القرآن وأخلاقه وعباداته وأحكامه. ويصور لنا هذه الحكمة التربوية ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبداً ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبداً».
وهكذا كانت تنزل الفرائض: تنزل الفريضة حتى اذا تمكنت في النفوس نزلت الاخرى وكذلك المحرمات، بل إن التدرج في أحيان كثيرة كان يقع في الحكم الواحد، مثل فرائض النفقات والجهاد، وحقوق المرأة والميراث وتحريم الخمر، حتى أثمرت تلك التربية الربانية (خير أمة أخرجت للناس» وحتى كان في وقائع امتثالها ما تباهي أرقى الدول في هذا العصر في محاولتها إصلاح مجتمعها، وما قصة تحريم الخمر المشهورة ومحاولة بعض الدول الكبرى في معالجتها ببعيدة عنا، فقد كان الفشل ذريعا بل تسبب باستفحال المشكلة حتى انجر الكثيرون الى الامعان والزيادة في الشراب من الأنواع الأشد رداءة مما يعطينا العبرة في اعجاز التربية القرآنية التي كان التدرج في نزول الوحي بالأحكام من أنجع وسائلها.
إعجاز القرآن في ترتيبه وتناسبه
وإليه الاشارة بقوله: «كذلك لنثبت به فؤادك» فعبر بقوله «كذلك» اي مثل ذلك التنزيل العجيب الشأن البالغ الغاية في الحكمة والأحكام، ثم تذييل الآية بقوله (ورتلناه ترتيلا) وأصل الترتيل: التنضيد. وكذلك يشير اليه قوله تعالى في الآية الأخرى: «ونزلناه تنزيلا». بيان ذلك أننا إذا ما لاحظنا أن القرآن نزل مفرقا على حسب أحداث ووقائع لم تكن على ترتيب أو نسق معين ثم قد وضعت كل آية أو مجموعة آيات نزلت في مكان خاص بها من سورة يأمر الوحي بوضع الآية أو الآيات فيها، ويتناول ذلك عدة سور في آن واحد، حتى أن سورة البقرة كانت أول ما نزل من القرآن في المدينة واستمر نزولها يتتابع فكان فيها آخر ما تنزل من القرآن قاطبة، وهي أطول سورة في القرآن.
ثم يقرأ القارئ المتدبر هذا القرآن بعد ذلك فيجد فيه الترابط المحكم والاتساق العجيب، وكأن السورة الطويلة أيا كانت لوحة جميلة متناسقة الألوان والظلال والمشاهد، أو بناء محكم الترابط تام التكوين. قال الامام الشاطبي: «إنّ السورة الواحدة مهما تعددت قضاياها فهي تكون قضية واحدة». أي تدور على موضوع واحد. مما يدل دلالة قاطعة على أن هذا القرآن تنزيل حكيم عليم، أحاط علمه بما هو كائن فهو ينزل كلامه منجماً، ثم يكون منه تلك الصورة البالغة غاية الاحكام، كما قال تعالى:« قل أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض انه كان غفورا رحيما». وإلا فأي عاقل يمكن أن يبني إنشاء أمر على مثل ما بني عليه شأن هذا القرآن من تأليف كتاب يكتبه حسب الوقائع جزءاً، جزءاً. أو صنع شيء من أجزاء متفرقة على تلك الطريقة، ثم يأتي بعمل غاية في العظمة لا يأتي أحد بمثله.
وهذا هو مجال الاختبار مفتوح لمن يود، في الحديث الصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم لو اجتمع أئمة البيان والبلاغة كي يصوغوا منه كتابا متألفا مترابط الأجزاء دون أي تصرف بألفاظه وتراكيبه، ولا أي تغيير في عباراته أو في مفتتح كل حديث واختتامه لوجدوا أنهم يحاولون محالاً، ويطلبون ما لا يجدون اليه سبيلا. وقد عني فحول العلماء بفن التناسب والارتباط في القرآن وأبدوا في ذلك من ضروب المناسبات وأوجه التخلص بين الموضوعات ما يدهش اللبيب لعظمة هذا الجانب في القرآن مما حفلت به كتب التفسير، كتفسير الآلوسي، والرازي، وابن حيان وغيرها، بل انهم صنفوا في هذا الفن كتبا مفردة به مثل نهاية التأميل في أسرار التنزيل للزملكاني ومناسبات ترتيب السور لأبي جعفر بن الزبير الاندلسي، ونظم الدرر في تناسب الآي والسور لبرهان الدين البقاعي وهو مرجع حفيل في عشرين مجلدا أو يزيد.
نموذج تطبيقي في سورة لقمان
وهذا مثال مدروس نقدمه لجلاء هذا الفن من أساليب القرآن، وهو سورة لقمان، نبين فيه أوجه الارتباط والتناسب من بين آيات هذه السورة بإيجاز. وسورة لقمان: مكية، نزلت في مكة المكرمة حين كان الاسلام في مرحلة تأسيس قواعد الايمان في القلوب، ومن هنا كان من الطبيعي أن يدور محور السورة على الدعوة وترسيخ الايمان. وهكذا نجد المحور الذي تدور عليه السورة هو نظام الايمان وشؤونه الفكرية والعلمية.
وتفتتح السورة بهذه الآيات: «الم. تلك آيات الكتاب الحكيم. هدى ورحمة للمحسنين. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون». فافتتحت السورة بهذه الاحرف المقطعة (الم) اشارة الى إعجاز القرآن، لأنه مركب من هذه الحروف ومثيلاتها من حروف الهجاء، وكلامكم أيها العرب متركب منها أيضا، فان كنتم صادقين في زعمكم أنه كلام بشر فأتوا بمثله، لأنكم فرسان البلاغة والبيان، وإذ عجزتم عن أولكم وآخركم فتبين أنه كلام رب القوى والقدر. هذا القرآن المعجز حكيم مشتمل على الحكمة البالغة في أسلوبه وخطابه وفي عقيدته وأحكامه، وفي مقاصده وأهدافه، وهو بهذه الحكمة هدى ورحمة لمن يريدون الاحسان والخير.
وجاء هذا الافتتاح بهذه الأوصاف للقرآن ولا سيما وصف الحكمة مناسبا هدف السورة، لان السورة تبرز اتفاق الحكمة مع دعوة القرآن، وقد بينت سورة لقمان وصف من تقبلوا هذه الحكمة بأنهم المحسنون، أي الفاعلون للحسنات، وهي حسنات شاملة للقلب والقالب للفرد والمجتمع «يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون». وبعد أن بينت سورة لقمان وصف المحسنين المستجيبين لدعوة الحكمة القائمة على الهداية والرحمة أخذت تصور فريقا آخر على الضد من الأول قد رفض الحكمة والهداية والرحمة فبماذا أخذ هذا الفريق من الناس، لقد أخذ بدلا من تلك الآيات الحكيمة « لهو الحديث » أي سفاسف الأمور، وهزل القول، وإثارة الشهوات، ومطرب الغناء ليصد الناس بها عن سبيل الله « بغير علم، فهو مهما ادعى الفهم والعلم فليس من العلم في شيء، وهو يتبع أساليب الجهل وسوء الأدب حيث يواجه الحكمة بالاستهزاء، ويصم أذنه عنها، استكبارا على دعوتها « كأن في أذنيه وقرا ». لذلك قابل ذلك بهذا الاستهزاء «فبشره بعذاب أليم».
وهنا جاءت المناسبة لبيان ثواب المؤمنين، وهو جنات النعيم وعدهم بها الله العزيز الحكيم. وهكذا جاء في صدر سورة لقمان الوعد والوعيد ووصف العزيز الحكيم الله تعالى، فعقبت السورة ذلك فذكرت دلائل عزته تعالى وحكمته في عجائب مخلوقاته « خلق السموات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم …» ومهدت بذلك لما يأتي من دلائل التوحيد. وهنا أوردت السورة قصة لقمان ووصاياه لابنه، ولقمان رجل آتاه الله الحكمة وهي غاية الصواب والسداد في القول والعمل فتوصل بحكمته الى وجوب شكر الله تعالى لأنه المنعم بكل النعم، ووجوب عبادته وتوحيده وتنزيهه عن أن يعبد غيره، أو يخضع الانسان لأحد سواه. ومن ثم راح يوصي ابنه بأصول الواجبات ومكارم الاخلاق التي تجعله كاملا في نفسه مكملا لغيره. وتتناسب قصة لقمان مع السورة لأنها صدرت بوصف القرآن بالحكيم، كما تناسب ما سبقها من الدلائل على عزة الله وحكمته، لأنها تعبر عن نتيجة تلك الدلائل وهي وجوب توحيد الله تعالى والخضوع له وحده دون سواه.
ومن ثم راحت سورة لقمان تستعرض من مظاهر الكون دلائل على إنعام الله على الانسان، وقدرته وحكمته في هذه الآيات: «ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الارض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة …» وهكذا حتى الآيات الخاتمة للسورة ” يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً». وقد افتتحت هذه الفقرة الكبيرة من السورة بذكر نعمه تعالى وأنها شاملة ومتنوعة (وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» مما يوجب شكر الله وعبادته وتوحيده، وجاء في عرض هذه النعم بقاعدة علمية معجزة هي «وسخر لكم ما في السموات وما في الأرض» هكذا بهذا الشمول الآفاق السماء، وأكناف الأرض. يواجه القرآن العالم بهذه الحقيقة في وقت كان هذا الانسان على مختلف أديانه ومعتقداته بل لا يزال كثير من الناس حتى يومنا هذا يعتقدون ان الشمس والقمر والنجوم تتصرف في شؤونهم، وتؤثر في مقاديرهم، حتى قد وجدت أمم تعبد الأفلاك والكواكب ولا تزال منها حتى الآن.
ويعقب القرآن كل دلالة من هذه الادلة بالوعد والوعيد الالزام بالحجة، والتسجيل على المعاندين مخالفتهم لكل دليل صحيح من الكون والسموات والأرض ومن أنفسهم هم أيضا. فعقب مثلا دلالة النعمة بتسخير ما في السموات والأرض بقوله « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير». وقد عرضت السورة دلائل تسخير ما في السموات وما في الأرض، ثم إقرار الكفرة إذا سئلوا أن الله هو خالق السموات والارض، وعرضت صورة الكون وقد تحول الى جهاز يكتب علوم الله تعالى فلا يحيط بجزء منها «ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله …». ثم دوران الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر، وأخيرا آية البحر الذي سخره الله لهذا الانسان:
«ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيتهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا الا كل ختار كفور». وهنا اختتمت السورة بهاتين الآيتين: «يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنّكم الحياة الدنيا ولا يغرنّكم بالله الغرور». «إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير».
ويقع هذا الاختتام على غاية المناسبة لما سبق من مضمون السورة العام، كما جاء على غاية المناسبة مع آية البحر. أما التناسب مع مضمون السورة العام فان السورة بعدما عرضت ما يوجب من الإيمان بالله وتوحيده وشكره وعبادته والانقياد له وأوردت دلائل ذلك إنعام الله تعالى ودلائل حكمته وقدرته اتجهت في الختام بخطاب قوي الى الناس تأمر بالتقوى وتحذر من أهوال القيامة، فجاء ذلك مرتبطا تماما بمضمون السورة لأنه بمثابة التأكيد والترسيخ لما طالبت به السورة. وأما التناسب مع آية البحر فإنها لما ذكرت خوف الناس من هول البحر ونسيانهم كفرهم بسببه (دعوا الله مخلصين له الدين » أوردت التحذير من يوم القيامة، لتشير بذلك الى أنه اذا كان هذا حالكم في مثل هذا الخوف الصغير فاحسبوا حساب ذلك الخوف الأعظم الذي لا يعد هول البحر مهما عظم شيئا مذكورا بالنسبة اليه.
بل إن ثمة وجها آخر دقيقا ولطيفا جدا من التناسب بين الآية الأخيرة في سورة لقمان ومطلع السورة، ذلك أن هذه الآية الخاتمة سجلت قصور علم الانسان عن الإحاطة بأهم شأنه وأخصه به. فهو لا يعرف متى نهاية عالمه. ولا متى نهايته هو. بل مهما أعمل حيله «ما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت». فأرسلت بهذا فكر الانسان يسبح الى ما لا نهاية له في علم الله العظيم، وأنه يجب أن يلوذ في العلم والعقيدة ونظام حياته وحضارته بعلم الله الخبير الحكيم يتلقى كل ذلك منه، وذلك بالأخذ بآيات كتابه الحكيم الذي أنزله هدى ورحمة للمحسنين. وبهذا نجد الارتباط بين أجزاء سورة لقمان قويا متناسبا، مع تعدد الافكار التي عرضت لها السورة وتنوعها، لكنها بهذا الارتباط بنيان واحد متماسك جد التماسك. وكذلك شأن سور القرآن كله في ترابطها وتناسبها، وعود آخرها بالارتباط الى أولها. وتناسب القرآن مع بعضه البعض حتى إنه يعتبر كله قضية واحدة.
الخاتمة
لقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة الشاملة أن تنجيم نزول القرآن الكريم لم يكن أمراً عشوائياً أو اعتباطياً، بل كان تدبيراً إلهياً محكماً اشتمل على حكم عظيمة وأسرار بالغة. فقد جاء النزول المنجم ليثبت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ويواجه الشبهات والاعتراضات، ويتعهد الأمة بالتربية التدريجية الحكيمة، ويظهر وجهاً من أعظم وجوه الإعجاز القرآني في الترابط والتناسب رغم تفرق النزول. وهذه الخصيصة الفريدة للقرآن الكريم تؤكد أنه كلام الله تعالى المنزل على خاتم أنبيائه، وأنه دستور خالد للبشرية جمعاء، يصلح لكل زمان ومكان، ويعالج القضايا بحكمة بالغة وعلم محيط. ويبقى تنجيم نزول القرآن الكريم شاهداً على عظمة هذا الكتاب المبين، ودليلاً قاطعاً على مصدره الرباني، ومنهجاً تربوياً فريداً يستحق الدراسة والتأمل من كل طالب علم وباحث عن الحقيقة.