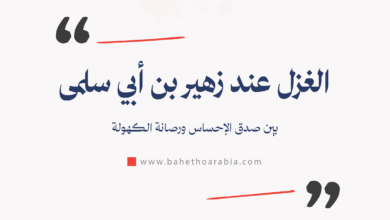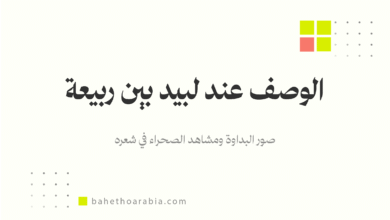القصص في العصر الجاهلي: نشأتها، أنواعها، وخصائصها الفنية
دليل شامل لاستكشاف جذور الفن القصصي العربي وأنواعه المختلفة قبل الإسلام.
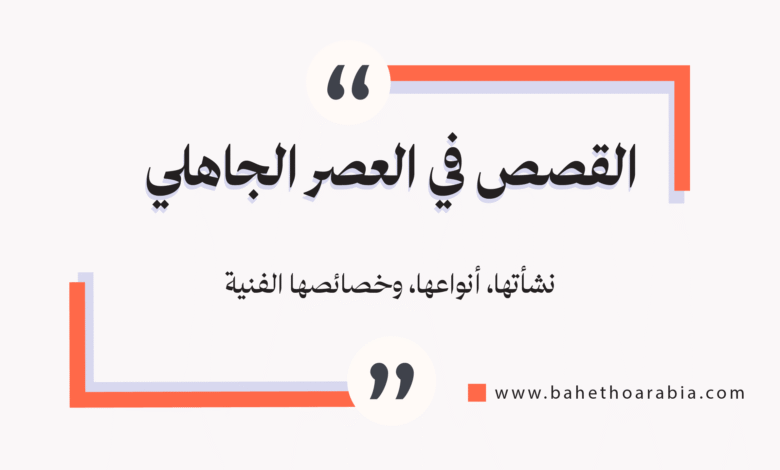
هل تساءلت يومًا عن أصول الحكايات العربية؟ انضم إلينا في رحلة عميقة لاستكشاف عالم القصص في العصر الجاهلي وأهميته في تشكيل الوجدان العربي.
مقدمة
يُعد فن القصص أحد أقدم الأشكال التعبيرية التي عرفتها البشرية، فهو وعاء الذاكرة الجماعية للشعوب، ومرآة تعكس قيمها وعاداتها وأحلامها. وفي التراث العربي، تحتل القصص مكانة فريدة، حيث كانت الوسيلة الرئيسة لنقل الأخبار والأنساب والمفاخر عبر الأجيال. تستهدف هذه المقالة الغوص في أعماق تاريخ القصص العربية، متتبعةً نشأتها في العصر الجاهلي، ومستعرضةً أنواعها المتعددة وخصائصها الفنية، لنقدم فهمًا شاملاً لهذا الفن الأدبي الأصيل الذي شكل جزءًا لا يتجزأ من هوية الأمة الثقافية.
نشأة القصص وتأصيلها في التراث العربي
أصل القص التتبع. قال أحمد بن فارس: «القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء. من ذلك قولهم: اقتصصت الأثر، إذا تتبعته، ثم نقل المعنى من تتبع الشيء إلى تتبع خبره، فكانت القصة. قال ابن فارس: ومن الباب القصة والقصص كل ذلك يتتبع فيذكر، وقال الأزهري: وقص عليه الخبر: أعلمه به وأخبره. والقرآن الكريم استعمل اللفظة بهذا المعنى في آيات عديدة منها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» و «نحن نقص عليك أحسن القصص» ومنها «فلما جاءه وقص عليه القصص.
والعرب – كغيرهم من شعوب الأرض – كان لهم قصص قديم شغفوا به ، وتناقلوه قال بروكلمان : ولم يكن الشاعر وحده هو الذي تهفو له النفوس، وتسمو إليه الأعين في الجاهلية، بل كان القاص يقوم أيضاً مقاماً هاماً إلى جانب الشاعر في سمر الليل بين مضارب الخيام لقبائل البدو المتنقلة، وفي مجالس أهل القرى والحضر. وليس هناك بطبيعة الحال تسجيلات معاصرة لهذه الأقاصيص». وذهب المستشرق نالينو إلى مثل ما ذهب إليه بروكلمان، فأقر بأن عرب الجاهلية كان لهم تراثهم القصصي المتعلق بأنسابهم وغزوهم وأيامهم، وذكر أن العرب كانوا يسردون قصصهم في المواسم والأسمار.. وغلب على ظنه أنهم كانوا يحفظون شيئاً من تاريخ الأمم المجاورة لهم كالفرس وأهل تدمر، وأن طائفة من هذه القصص مازجتها الأحاديث الخرافية وأساطير الأولين قبسوها من أهل الكتاب، أو حملها معهم التجار العائدون من الشام والعراق.
أدلة وجود القصص في العصر الجاهلي
آثر بعض المستشرقين التشكيك في التراث القصصي الجاهلي، قال بلاشير: وتجدر الإشارة من جهة أخرى إلى أن الانتحال لا يبقى محصوراً في الشعر بل يتناول النشر، حتى لتستطيع الجزم أنه ليس لدينا باستثناء القرآن سطر واحد من النشر، يرجع تاريخه إلى هذا العهد، وأغفل جولدزبهر القصة الجاهلية، وأرجع بداية الفن القصصي إلى العصر الإسلامي. والنظر الدقيق يرجح كفة بروكلمان ونالينو للأمور التالية:
١. القصة ظاهرة إنسانية عرفتها الشعوب القديمة والعرب من هذه الشعوب الموغلة في القدم، فلماذا يعرفها جيران العرب، ويجهلها العرب؟
٢. نص القرآن الكريم في مواضع كثيرة على شيوع القصص بين الناس، وأشار إلى أن قصص الأنبياء كانت معروفة على نحو ما فجاءهم القرآن الكريم بالوجوه الصحيحة لهذه القصص، ولأخبار الصالحين. ومن جملة الأحداث أو القصص التي رواها القرآن قصص جرت أحداثها خارج الجزيرة العربية كقصة ذي القرنين، وقصص جرت أحداثها في الجزيرة العربية، وتناقلت شيئاً منها الذاكرة العربية كقصة سبأ، وعاد، وثمود، ومدين، وأصحاب الفيل، قال تعالى: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد.» وقال أيضا: إن هذا لهو القصص الحق، فالقصص كانت معروفة، والقرآن الكريم صحح ما عراها من مبالغة وتشويه وافتراء.
٣. في الأدب الموروث عن العصر الجاهلي قصص كثيرة ولا موضع للخلاف في صحة هذه القصص، بل الخلاف في الزمان الذي تنتمي إليه. ولا يضيرها عزوها إلى الطور الثالث من تاريخ العرب، وهذا الطور – على تأخر العهد به – جاهلي لا إسلامي، وهو طور العرب المستعربة، وهم الذين يسميهم بعض المؤرخين: العدنانيين أو الإسماعيليين. والقصص التي تحدرت إلينا من هذه الفترة أخلاط من قصص الملوك والرحلات والحروب والأساطير، وأخبار المجان، والنوادر والخرافات.
٤. الشك في حفاظها على بنائها الفني الذي سبق الطور الثالث لا يلغيها، وإذا صح أنه أصابها تغيير فهذا التغيير لم يخرجها عن أصالتها وانتمائها إلى عرب الجاهلية. وهب التحريف أصابها في عصر صدر الإسلام فأصلها ثابت، وعزوها إلى العصر الجاهلي حق لأبناء ذلك العصر.
٥. ذكرت كتب الأدب أن نفراً من القصاصين الجاهليين المشهورين قد أدركوا الإسلام، فكيف تنكر على العصر الجاهلي الذي أنبتهم فن القصة، وبضاعتهم كلها منه؟ وأشهرهم: النضر بن الحارث، وتميم الداري، والأسود بن سريع.
٦. قد تضعف الرواية المحفوظة في الصدور ثقة القارئ في انتماء النصوص كلها إلى الجاهلية الأولى، لكنها لا تضعف انتهاء القصة كاملة إلى العصر الجاهلي المتأخر. لأن طائفة كبيرة من هذه القصص تتصل بأيام العرب وأنسابهم، والعرب حراص على مفاخرهم لا يفرطون فيها، والرواة الذين نقلوها ثقات لم يوصفوا بالانتحال والوضع والتزيد. قال الجاحظ: فالعلماء الذين اتسعوا في علم العرب حتى صاروا إذا أخبروا عنهم بخبر كانوا الثقات فيما بيننا، وهم الذين نقلوا إلينا، وسواء علينا جعلوه كلاماً وحديثاً منثوراً، أم جعلوه رجزاً أو قصيداً موزوناً.
تدوين القصص وبدايات التأليف
إن عصر التأليف في هذا اللون من الأدب هو عصر التأليف في الألوان الأخرى وهو – وإن تأخر بضع سنين – فتأخره لا يشكك في صحة التراث القصصي. ذكر بروكلمان أن أول من ألف في هذا الفن أبو عبد الله محمد بن القاسم المعروف بأبي العيناء (ت: ٢٨٣ هـ) إذ صنف كتاباً في قصص الحمقى وأقوالهم وأفعالهم.
ثم أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري [ت: ٣٣٣ هـ] إذ صنف كتاباً فيه مجموعة من قصص وحكايات ونوادر طريفة، وكتاباً آخر هو كتاب المجالسة وجواهر العلم وفيه قصص وأحاديث. ويمكن أن نلحق بهذه الكتب كتاب الأوراق لأبي بكر محمد بن يحيى الصولي [ت: ٣٣٥ هـ] فإن فيه قصصاً لم تُعز إلى أصحابها، لكنها أصابت حظاً من الفن القصصي غير يسير.
أنواع القصص في العصر الجاهلي
زخر العصر الجاهلي بقصص وحكايات لا تظهر منزلتها بالنظر في مقدار ما بلغنا منها، بل لابد من تقسيمها إلى أنواع، وعرض كل نوع ليتبين لنا أن عرب الجاهلية لم يعيوا بفن القصة، ولم تكن أذهانهم شحيحة، إذ أكثرت ونوعت، وسلكت القصة في جوانب الحياة المختلفة، وأهم أنواع القصة الجاهلية:
١. الأوابد: بذكر القلقشندي في سفره الضخم صبح الأعشى أوابد العرب وفسر معناها، وربطها بالقصص التي وضعت لها، فقال: هي أمور كانت العرب عليها في الجاهلية بعضها يجري مجرى الديانات، وبعضها يجري مجرى الاصطلاحات والعادات وبعضها يجري مجرى الخرافات. وجاء الإسلام بإبطالها. وهي عدة أمور الكهانة والزجر، والطيرة، والميسر، والأزلام، والبحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام، وإعلاق الظهر … ورمي البعرة، ووأد البنات … والهامة، وتأخير البكاء على الميت للأخذ بثأره والغول، وضرب الثور لتشرب البقر، وتعليق سن الثعلب، وسن الهرة. ورمي من الصبي المثغر وتعليق الحلى على السليم …. وكي السليم ليبرأ الأجرب … في الشمس …. ولكل واحدة من هذه الأوابد قصة نسجت حولها، وشاعت وتداولها الناس، فعاشت بينهم أفعالاً وكلاماً، وظنوها أبدية العيش فسموها الأوابد ثم جاء الاسلام فنسخها، فلم يبق منها غير القصص التي نسجت للكشف عن أصولها.
٢. قصص الملوك: يخطئ من يتصور جزيرة العرب أرضاً قفراً تجوبها القبائل والقوافل. فقد شهدت هذه الجزيرة حضارات وممالك، ونسجت حول الملوك قصص ومن هذه القصص قصة حجر الملقب آكل المرار مع زياد بن الهبولة الغساني، أو الحارث بن الأيهم بن الحارث الغساني، في رواية أخرى. وخلاصتها أن حجر بن عمرو بن معاوية الكندي قد أغار في كندة وربيعة على البحرين، فبلغ زياد بن الهبولة خبرهم، فسار إلى كندة وربيعة وأموالهم، وهم خلوف ورجالهم في غزاتهم المذكورة، فأخذ الحريم والأموال، وسبى منهم هند بنت ظالم زوج حجر.
٣. قصص الأسفار والحروب: كانت للعرب في جاهليتهم أسفار ورحلات كثيرة لا تهدأ، وهذه الأسفار تمخضت عن حكايات وقصص كثيرة صورت أهوال الأسفار ومشاق الطرق، والمخاوف التي تعترض سبلهم، وتحدثت عن قوة الجن ومخاطر الخيلان والسعالي. ومن أبرز أسفارهم رحلة عير كسرى إلى اليمن المسماة يوم الصفقة، وقصة فتكة البراض، وقصة الأعشى وتابعه الجني مسحل وقصة أولاد نزار بن معد مع الأفعى بن الأفعى الجرهمي، ورحلة أبي طالب إلى الشام والبشرى التي زقها له بحيرى الراهب.
٤. الأساطير: حاول ابن فارس أن يربط الأساطير بتسطير الكلام، وأن يفهم من هذا التسطير الاختلاق والافتراء، فقال: «السين والطاء والراء أصل مطرد يدل على ” اصطفاف الشيء كالكتاب والشجر، وكل شيء. فأما الأساطير فكأنها أشياء كتبت من الباطل، فصار ذلك اسماً لها، مخصوصاً بها. يقال سطر فلان علينا تسطيراً إذا جاء بالأباطيل وواحد الأساطير إسطار وأسطورة.
٥. الخرافات: الحرف في اللغة «فساد العقل من الكبر وأصل الخرافة كما جاء في لسان العرب والحديث المستملح من الكذب، وقالوا: حديث خرافة. ذكر ابن الكلبي في قولهم: حديث خرافة: أن خرافة من بني عذرة أو من جهينة، اختطفته الجن، ثم رجع إلى قومه، فكان يحدث بأحاديث مما رأى يعجب منها الناس، فكذبوه، فجرى على ألسن الناس..
٦. قصص المجون: في التراث العربي القصصي نوع من القصص لحمته وسداه صلة الرجال بالنساء، وما يعرو هذه الصلة من خلاعة ولهو وفسوق، وما يدور في مجالس الشراب من عبث ورفت. وأكثر الأبطال في هذه القصص من الخلعاء الفتاك، وأقلهم من كبراء القوم الذي يجدون في الشباب والفراغ والجدة متسعاً عن الكد، فيلهون ويقصفون، وتروى أخبار لهوهم على سبيل الإمتاع.
٧. النوادر: كان كثير من الملوك والأشراف يستمتعون في مجالسهم بما يروى من قصص الفكاهة، واتخذ بعض الملوك ندماء عرفوا برواية النوادر أو اختراعها، كنوادر سعد القرقرة هازل النعمان بن المنذر ملك الحيرة.
نماذج من القصص الجاهلية: الملوك والحروب
وسمع حجر بغارة زياد فطلبه، وصحبه من أشراف ربيعة: عوف بن محلم بن ذهل بن شيبان، وعمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان وغيرهما. فأدركوا زياداُ بالبردان، وقد أمن الطلب، فنزل حجر في سفح الجبل، ونزلت بكر وتغلب وكندة مع حجر دون الجبل، فتعجل عوف بن محلم، وعمرو بن أبي ربيعة، وقالا الحجر: إنا متعجلان إلى زياد، ولعلنا نأخذ منه بعض ما أصاب منا، فسارا إليه، وكان بينه وبين عوف إخاء، فدخل عليه، وقال له: يا خير الفتيان اردد عليّ امرأتي أمامة، فردها عليه وهي حامل. ثم إن عمرو بن أبي ربيعة قال لزياد: يا خير الفتيان، اردد علّي ما أخذت من إبلي، فردها عليه، وفيها فحلها، فنازعه الفحل إلى الإبل، فصرعه عمرو، فقال له زياد: يا عمرو، لو صرعتم يا بني شيبان الرجال كما تصرعون الأبل لكنتم أنتم أنتم. فقال عمرو: لقد أعطيت قليلاً، وسميت جليلاً، وجررت على نفسك ويلا طويلا، ولتجدن منه، ولا والله لا تبرح حتى أروي سناني من دمك، ثم ركض فرسه حتى صار إلى حجر، فأخبره الخبر، فأقبل حجر في أصحابه، حتى إذا كان بمكان يقال له الحفير أرسل سدوس بن شيبان وصليع بن غنم يتجسسان له الخبر، ويعلمان علم العسكر. فخرجا حتى هجما على عسكره ليلاً، وقد قسم الغنيمة وأطعم الناس تمراً وسمناً. فلما أكل نادى: من جاء بحزمة حطب فله قدرة تمر، فجاء سدوس وصليع بحطب، فناولهما تمراً، وجلسا قريباً من كتبته، ثم انصرف صليح إلى حجر، فأخبره بعسكر زياد، وأراه النمر. أما سدوس فقال: لا أبرح حتى آتيه بأمر جلي، وجلس مع القوم يتسمع ما يقولون، وهند امرأة حجر خلف زياد، فقالت: إن هذا التمر أهدي إلى حجر من هجر، والسمن من دومة الجندل. ثم تفرق أصحاب زياد عنه، فضرب سدوس يده إلى جليس له، وقال له من أنت؟ مخافة أن يستنكره الرجل: فقال: أنا فلان بن فلان ودنا سدوس من قبة زياد بحيث يسمع كلامه، ودنا زياد من هند امرأة حجر، فقال لها: ما ظنك الآن بحجر؟ فقالت: ما هو ظن، ولكنه يقين، وإنه والله لن يدع طلبك حتى يطالع القصور الحمر – تعني قصور الشام – وكأني به في فوارس شيبان، يذمرهم ويذمرونه، وهو شديد الكلب تزيد شفتاه وكأنه بعير أكل مرار، فالنجاء النجاء فإن وراءك طالباً حثيثاً، وجمعاً كثيفاً، وكيداً متيناً، ورأياً صليباً، فرفع يده، فلطمها، ثم قال لها : ما قلت هذا إلا من عجبك به، وحبك له، فقالت: والله ما بغضت ذا نسمة قط بغضي له، ولا رأيت رجلاً أحزم منه نائماً ومستيقظاً، إن كان لتنام عيناه فبعض أعضائه مستيقظ. وكان إذا أراد النوم أمرني أن أجعل عنده عساً من لبن، فبينما هو ذات ليلة نائم وأنا قريب منه أنظر إليه إذ أقبل أسود سالخ إلى رأسه، فنحى رأسه فمال إلى يده، فقبضها، فمال إلى رجله فقبضها، فمال إلى العس، فشربه ثم تجه، فقلت: يستيقظ، فيشربه، فيموت، فأستريح منه فانتبه من نومه، فقال: علي بالإناء، فأتيته به فشمه ثم ألقاه، فهريق، فقال إلى أين ذهب الأسود، فقلت ما رأيته، فقال: كذبت والله – وذلك كله بأذن سدوس – فلما نامت الأحراس، خرج يسري ليلته حتى صبح حجراً فقال:
أتاك المرجفونَ برجمِ غيبٍ على دهشٍ، وَجِئْتُكَ بِالْيُقينِ
فَمَنْ يَكُ قَدْ أَتاك بأمر ليس فقد أتي بأمر مستيينِ
ثم قص عليه ما سمع به فأسف ونادى بالرحيل، فساروا حتى انتهوا إلى عسكر ابن الهبولة، فاقتتلوا قتالاً شديداً، فانهزم أصحاب ابن المهبولة، وقتلوا قتلا ذريعاً، واستنقذت بكر وكندة ما كان بأيديهم من الغنائم والسبي وعرف سدوس زياداً فحمل عليه، فاعتنقه وصرعه وأخذه أسيراً، فلما رآه عمرو بن أبي ربيعة حسده. فطعن زياداً، فقتله، فغضب سدوس، وقال: قتلت أسيري، وديته دية ملك، فتحاكما إلى حجر، فحكم على عمرو وقومه لسدوس بدية ملك، وأعانهم من ماله، وأخذ حجر زوجته هند، فربطها إلى فرسين، ثم ركضهما، حتى قطعاها، وقال فيها:
إنّ منْ غرَّه النِّساء بشيءٍ بهد هندٍ لجاهلٌ مغْرورُ
حلوة العين والحديث، ومُرٌّ كلُّ شيءٍ أجَنَّ عنها الضّميرُ
كلُّ أنثى وإنْ بدا لكَ منها آيةُ الحبِّ حُبُّها خيتعورُ
ومن هذا النوع القصص التي تروي أخبار ملوك الخيرة، كقصة النعمان الأعور، وبنائه قصر الخورنق وغدره بسنمار وقصة المنذر بن ماء السماء في حربه مع الحساسنة وقصص ملوك الغساسنة، وكتب الأدب زاخرة بها. لكن قصص الحروب تبقى أهم من قصص الأسفار وأطول، فقد شهدت جزيرة العرب حروباً قبلية طويلة كحرب البسوس، وتعد هذه الحرب – على ما فيها من مبالغة – من أشهر الملاحم العربية، وتعد أحداثها وقصصها من أجمل الأحداث والقصص، وأشدها ارتباطاً بطبيعة الأمة العربية في العصر الجاهلي، ومهما يكن حظها من الغلو قليلاً أو كثيراً فإن النفس تطمئن إليها أكثر مما تطمئن إلى الإلياذة والأوديسة. وقد أشرنا قبل إلى طائفة من حكاياتها في حديثنا عن الرثاء، ومن طلب الاستزادة فعليه بكتاب أيام العرب، ويكتب الأدب الأخرى التي عنيت بإبرازها وروايتها مشفوعة بالشعر الحماسي. ومن هذا النوع قصة داحس والغبراء، وحروب الأوس والخزرج.
الأساطير والخرافات: نافذة على الخيال الجاهلي
ومعنى الأسطورة، كما ورد في المعجم الفلسفي، هو أنها قصة خيالية ذات أصل شعبي، تمثل فيها قوى الطبيعة بأشخاص يكون لأفعالهم ومغامراتهم معان رمزية، فالأسطورة لها أصل من التاريخ، أو من تراث الشعب، لكن هذا الأصل امتزج بالخيال وداخلته قوى غير مرئية كالجن والشياطين والأمور الغيبية الخارقة. وأساطير الجاهليين عن الجن متعددة الأشكال والألوان. وهذه الأساطير والمخارق لا يمكن أن تكون صحيحة في واقع حياتهم لاستحالة ذلك عقلاً. فهي لا تعدو أن تكون من نسج خيالهم وتزيد أوهامهم. وإن كان بعضها قد بني على شيء من التاريخ والواقع. وقد علل الجاحظ نشأة الأساطير وشيوعها في العصر الجاهلي، فقال : كان أبو إسحاق يقول في الذي تذكر الأعراب من عزيف الجنان، وتغوّل الغيلان : أصل هذا الأمر وابتداؤه أن القوم لما نزلوا بلاد الوحش عملت فيهم الوحشة. ومن انفرد وطال مقامه في البلاد والخلاء والبعد عن الإنس استوحش، ولا سيما مع قلة الأشغال والمذاكرين … وإذا استوحش الإنسان تمثل له الشيء الصغير في صورة الكبير، وارتاب وتفرق ذهنه، وانتقضت أخلاطه فرأى مالا يرى وسمع مالا يسمع، وتوهم على الشيء اليسير الحقير أنه عظيم جليل. ثم جعلوا ما تصور لهم من ذلك شعراً تناشدوه، وأحاديث توارثوها، فازدادوا بذلك إيماناً، ونشأ عليه الناشئ، وربي به الطفل. فصار أحدهم حين يتوسط الفيافي، وتشتمل عليه الغيطان في الليالي الحنادس، فعند أول وحشة وفزعة، وعند صياح بومة، ومجاوبة صدى، وقد رأى كل باطل وتوهم كل زور وربما كان في أصل الخلق والطبيعة نفاجاً وصاحب تشنيع وتهويل، فيقول في ذلك من الشعر، على حسب هذه الصفة. فعند ذلك يقول: رأيت الغيلان، وسمعت السعلاة ثم يتجاوز ذلك إلى أن يقول: رافقتها تزوجتها …. ومما زادهم في هذا الباب وأغراهم به، ومد لهم فيه أنهم ليس يلقون بهذه الأشعار وبهذه الأخبار إلا أعرابياً مثلهم، وإلا عامياً لم يأخذ نفسه قط بتمييز ما يستوجب التكذيب والتصديق والشك. هذه هي الأسس النفسية والاجتماعية لأساطير العرب في الجاهلية. وأشهر الأساطير، قصة طسم وجديس، وقصة مصرع الزباء، وقصة علقمة بن صفوان وشق ابن الجن، وقصة إساف ونائلة. ومن أساطير العرب ما عزي إلى الأجرام السماوية لتفسير أوضاعها، ومنها وأن الدبران خطب الثريا، وأراد القمر أن يزوجه بها، فأبت عليه ودلت عنه، وقالت للقمر: ما أصنع بهذا السبروت الذي لا مال له؟ فجمع الدبران قلاصه ” يتجول بها، فهو يتبعها حيث توجهت يسوق صداقها قدامه. ومنها وأن الشعرى اليمانية كانت مع الشعرى الشامية، ففارقتها، وعبرت المجرة، فسميت الشعرى العبور، فلما رأت الشعرى اليمانية فراقها إياها بكت عليها، حتى غمصت عينها، فسميت الشعري الغميصاء. هذا يسير من كثير من أساطير العرب التي طمستها أساطير اليونان لأنه لم يتح لها من يخرجها من مكامنها.
ثم انتقل معنى الخرافة من الدلالة على باطل الأحاديث ومصفوفها إلى الدلالة على القصص الموضوعة على ألسنة الحيوانات والنباتات والجمادات. والغاية من هذه القصص التربية والوعظ، وتقديم النصح بقالب قصصي جذاب. وهذا الضرب من القصص كثير قديم، كان شائعاً بين الشعوب المختلفة كقصة السبع والسنور المصرية القديمة التي وجدت مكتوبة على ورقة من أوراق البردي، وكليلة ودمنة السنسكريتية الأصل، وحكايات إيسوبوس اليونانية. ومنها في العربية حكاية الأرنب والثعلب حينما احتكما إلى الضب. وخلاصتها كما رواها الميداني: تما زعمت العرب على ألسن البهائم قالوا: إن الأرنب التقطت ثمرة، فاختلسها الثعلب، فأكله، فانطلقا يختصمان إلى الضّب فقالت الأرنب: يا أبا الحسل. فقال الضب: سميعاً دعوت: قالت. أتيناك لنختصم إليك. قال: عادلاً حكمتها. قالت : فاخرج إلينا . قال : في بيته يؤتى الحكم . قالت : إنّي وجدت ثمرة . قال : حلوة فكليها . قالت : فاختلسها الثعلب . قال : لنفسه بغى الخير. قالت: فلطمته. قال: بحقك أخذت قالت : فلطمني قال : حر انتصف قالت: فاقض بيننا. قال قد قضيت … ومنها قصة ذات الصفا التي نظمها النابغة الذبياني شعراً، وقصة الضب والضفدع.
المجون والنوادر: جوانب أخرى من القصص العربية
من هذه القصص قصة عدي بن نصر، وجذيمة بن مالك، وقصة تأبط شراً مع امرأة من بني فهم، وقصة دارة جلجل) التي أشرنا إليها في الحديث عن حياة امرىء القيس، وقصة المنخل والمتجردة. فإذا انتقلت من قصور الملوك إلى خيام السوقة سمعت النوادر وأخبار الحمقى تقص، ومنها قصة نسوة لم يكن لهن رجل، فزوجن إحداهن رجلاً، كان ينام الضحى، فإذا أتينه بصبوح قلن: قم فاصطبح، فيقول: لو نبهتنني العادية.
فلما رأين ذلك قال بعضهن البعض: إن صاحبنا لشجاع، فتعالين حتى نجربه، فأتينه كما كن يأتينه، فأيقظنه فقال: لو لعادية نبهتنني فقلن: هذه نواصي الخيل، فجعل يقول: الخيل الخيل!؟ ويضرط حتى مات. فضرب به المثل في الجبن فقيل أجبن من المنزوف ضرطاً، وكتب الأدب تزخر بقصص كثيرة تروي نوادر العرب، وأخبار النوكى.
الخصائص الفنية للقصص في العصر الجاهلي
قبل الحديث عن خصائص القصة في العصر الجاهلي يجب أن نفرد القصة على أنها جنس من الأجناس الأدبية، كالقصيدة، والخطبة، والرسالة، وبعد ذلك ننظر في المستوى الذي بلغته. ومما يجعلنا حراصاً على ذلك أن بعض الدارسين المحدثين حاول أن ينفي القصة العربية القديمة، أو أن ينفي قيمتها الفنية، وأن ينأى بها عن أن تكون فناً متميزاً، وحجته في موقفه هذا أن القصة الجاهلية لم تتوافر لها العناصر الفنية التي حددها أرسطو، ولم توافق في مبناها ومضمونها مبنى القصة الأوروبية الحديثة ومضمونها، وفي هذا الموقف الذي يحاول صاحبه أن يتزيا بزي العلم مجانبة صريحة للأساليب العلمية في البحث. إن لكل أمة أدباً يُدرس وفق قيم هذه الأمة ومقاييسها، لأنه يعبر عمن كتبه، وعمن كتب له وعنه. فأصول الأدب اليوناني أصدق محل للكشف عن جوهر الأدب اليوناني، وقواعد النقد الغربي أشرف محكمة يحتكم إليها في دراسة الأدب الغربي، فليس لنا أن نحاكم الأدبين اليوناني القديم والغربي الحديث بمعايير الجرجاني وشوقي ضيف، وليست جودة الأدب العربي مرهونة باقترابه من معايير النقد الغربي الحديث. وما الذي جعل مقياس الإحسان أو الإساءة في أدبنا – كما يرى الدكتور علي عبد الحليم محمود – تابعاً لمقاييس الأجانب؟ أهو الانبهار بحضارة الغرب التي تنتمي الى حضارة الإغريق واللاتين، أم ولع المغلوب بتقليد الغالب، أم الغزو الفكري نتيجة اتصالنا بالحضارة الأوروبية؟ ومهما يكن حظ القصة العربية القديمة من التحليق أو الإسفاف فإن لها سمات فنية يحسن تحديدها قبل الحكم على القصة، وأهم هذه السمات:
١. القدم: القصة كما يرى الباحثون المنصفون سبقت الشعر، لأنها لا تحتاج إلى جهد فني أو فكري.
٢. تعبيرها عن الإنسان العربي: استطاعت القصة القديمة – على بساطتها – أن تكشف عن طباع العرب وأفكارهم وأهوائهم، وأن تريح أعصابهم من التوتر، وأن تستوعب ما فيها من هموم وأوهام، وأن تخلق نوعاً من التلاؤم بينهم وبين أسرار الطبيعة، وأن تروي ظمأهم إلى المعرفة، وشوقهم الى اكتشاف المجهول.
٣. المشاركة في صنع القيم: شاركت القصة الشعر وغيره من فنون الأدب في صياغة المثل العليا، وتحديد القيم، وتوضيح العلاقات بين القبائل، وبين الفرد والقبيلة، فكانت بذلك شكلا من أشكال الأعراف والقوانين غير المكتوبة التي تنتظم الحياة الاجتماعية والسياسية.
٤. تصوير البطل الرمز: اختارت القصة القديمة شخصيات مرموقة، جعلتها رموزاً للفضائل فالسموءل يمثل الوفاء، وعنترة يصوّر أعلى درجات الشجاعة، وحاتم غاية الكرم. ولا يعنينا هنا أن تكون أحداث القصص المروية عنهم واقعية أم مجانبة للواقع. فالمثل الأعلى يجب أن يكون قمة يرقى إليها التواقون إلى السمو، لا هضبة سهلة المرتقى، يصعدها العامة والأعمار.
٥. بساطة البنية الفنية: توافر للقصة العربية ما توافر لغيرها من القصص الإنسانية من عناصر فنية، لكن هذه العناصر من أحداث وسرد وبيئة وفكرة وهدف وشخصيات غير ناضجة، فالحبكة يعوزها الترابط المحكم، والشخصية – على ما فيها من مثالية ومبالغة -بسيطة ذات صفة واحدة لا تعقيد فيها، ويمكن أن توصف بأنها شخصية نمطية، والأحداث لا تلتزم الواقعية، والبيئة لا ترسم واضحة المكان والزمان في بعض الأحيان، ولا يتم التفاعل بينها وبين الأحداث والشخصيات. وهذه السمات لا تنال من القصة الجاهلية، بل توفيها حقها، وتجعلها صورة صادقة لما يجب أن يكون عليه الفن القصصي في مجتمع تغلب عليه البداوة ببساطتها وفطريتها ووضوحها.
خاتمة
في ختام هذه الرحلة المعرفية، يتضح لنا أن القصص في العصر الجاهلي لم تكن مجرد حكايات للتسلية، بل كانت جزءًا حيويًا من النسيج الاجتماعي والثقافي. لقد حملت في طياتها تاريخ العرب وأنسابهم وحروبهم، وصاغت مُثلهم العليا وقيمهم الأخلاقية، وعبّرت عن خيالاتهم وتصوراتهم للكون. ورغم بساطة بنيتها الفنية مقارنة بالمعايير الحديثة، إلا أن هذه البساطة هي سر قوتها وصدقها، فهي تعكس بوضوح طبيعة الحياة في ذلك العصر. إن دراسة هذه القصص وفهم خصائصها لا يثري معرفتنا الأدبية فحسب، بل يمنحنا نافذة فريدة نطل منها على جذور هويتنا الثقافية.
سؤال وجواب
١- ما هو الأصل اللغوي لكلمة “القصص”؟
الجواب: يعود الأصل اللغوي لكلمة القصص إلى الجذر (ق ص ص) الذي يدل على التتبع، ومنه “اقتصاص الأثر”. وقد تطور المعنى ليشمل تتبع الأخبار وروايتها، وهو المعنى الذي استُخدم في القرآن الكريم وفي الأدب العربي.
٢- هل هناك دليل قاطع على وجود فن القصص قبل الإسلام؟
الجواب: نعم، هناك أدلة عدة ترجح وجوده، منها إشارة القرآن الكريم إلى قصص كانت شائعة بين الناس، ووجود قصاصين جاهليين مشهورين أدركوا الإسلام مثل النضر بن الحارث، بالإضافة إلى ارتباط كثير من القصص بأيام العرب وأنسابهم التي حرصوا على تناقلها.
٣- ما هي أبرز أنواع القصص التي شاعت في العصر الجاهلي؟
الجواب: شملت القصص الجاهلية أنواعاً متعددة أهمها: الأوابد (المرتبطة بالمعتقدات والعادات)، وقصص الملوك، وقصص الأسفار والحروب، والأساطير، والخرافات (التي تجري على ألسنة الحيوانات)، وقصص المجون، والنوادر الفكاهية.
٤- ما الفرق بين الأسطورة والخرافة في التراث الجاهلي؟
الجواب: الأسطورة هي قصة خيالية ذات أصل شعبي تمثل فيها قوى الطبيعة أو قوى غيبية بأشخاص، بينما الخرافة تشير إلى الحديث الكاذب، ثم أصبحت تدل خصيصى على القصص الموضوعة على ألسنة الحيوانات والجمادات لغاية وعظية أو تربوية.
٥- ما هي الخصائص الفنية الرئيسة للقصة الجاهلية؟
الجواب: تتميز القصة الجاهلية بالقدم، وتعبيرها الصادق عن الإنسان العربي وقيمه، ومشاركتها في صياغة الأعراف الاجتماعية، وتصويرها للبطل الرمز. أما بنيتها الفنية، فتتسم بالبساطة، حيث تكون الحبكة غير محكمة، والشخصيات نمطية ذات بعد واحد.
٦- كيف يجب تقييم القصة العربية القديمة من منظور نقدي؟
الجواب: يجب أن تُقيّم القصة القديمة وفقاً للمعايير والقيم الخاصة بالبيئة التي نشأت فيها، وليس استناداً إلى مقاييس النقد الأدبي الأوروبي الحديث. قيمتها تكمن في أصالتها وقدرتها على تصوير مجتمعها بصدق.
٧- هل كان للقصة دور اجتماعي في ذلك العصر؟
الجواب: نعم، لقد شاركت القصة في صياغة المُثل العليا وتحديد القيم، وتوضيح العلاقات بين القبائل والأفراد، فكانت بذلك بمثابة أعراف وقوانين غير مكتوبة تسهم في تنظيم الحياة الاجتماعية والسياسية.
٨- متى بدأت عملية تدوين القصص العربية بشكل منظم؟
الجواب: بدأ تدوين هذا اللون من الأدب في العصر الإسلامي، ويُذكر أن من أوائل من ألفوا فيه أبو العيناء (ت: ٢٨٣ هـ) في قصص الحمقى، وأبو بكر الدينوري (ت: ٣٣٣ هـ) في مجموعات قصصية ومنوعة.
٩- ما المقصود بمصطلح “البطل الرمز” في القصص الجاهلية؟
الجواب: يقصد به اختيار شخصيات مرموقة وجعلها رموزاً لفضائل محددة، فالسموءل يمثل الوفاء، وعنترة يمثل الشجاعة، وحاتم الطائي يمثل الكرم، بحيث تصبح قصصهم مثلاً أعلى يحتذى به.
١٠- كيف علل الجاحظ نشأة الأساطير لدى العرب؟
الجواب: أرجع الجاحظ نشأتها إلى الوحشة التي يشعر بها الإنسان في الصحراء والبعد عن الناس، مما يجعله يتوهم الأشياء الصغيرة كبيرة، فيرى ويسمع ما لا وجود له، ثم يصوغ هذه الأوهام في شعر وقصص تتوارثها الأجيال.