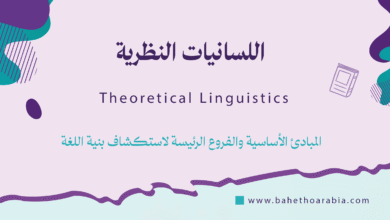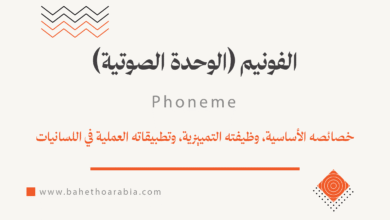الكلام: خصائصه الجوهرية، أبعاده الإنجازية ودينامياته في السياق التواصلي
تحليل لساني معمق لمفهوم الكلام الفردي (Parole) وعلاقته بالنظام اللغوي المجرد (Langue)

يمثل الكلام جوهر التفاعل الإنساني والوسيلة الأساسية للتعبير عن الذات. في هذا المقال، نخوض رحلة أكاديمية لاستكشاف أبعاد هذا المفهوم اللساني المعقد.
مقدمة
يحتل مفهوم الكلام (Speech / Parole) مكانة محورية في الدراسات اللسانية الحديثة، حيث يمثل التجلي الفعلي والملموس للغة في استخدامها اليومي. على الرغم من أن اللغة تبدو ككيان واحد متكامل في أذهان العامة، إلا أن اللسانيات البنيوية، وتحديداً مع فردينان دو سوسير (Ferdinand de Saussure)، قد أرست تمييزاً منهجياً دقيقاً بين النظام اللغوي المجرد (Langue) والتحقق الفردي لهذا النظام، وهو ما يُعرف اصطلاحاً بمصطلح الكلام. يمثل “اللسان” أو النظام، مجموعة القواعد والمفردات والبنى التركيبية المشتركة بين أفراد جماعة لغوية معينة؛ إنه الجانب الاجتماعي والمستقر من اللغة، والذي يكتسبه الفرد بشكل غير واعٍ. في المقابل، فإن الكلام هو الفعل الفردي والإرادي الذي يقوم من خلاله المتكلم بتفعيل هذا النظام لإنتاج رسائل منطوقة في سياقات محددة.
إن هذا التمييز ليس مجرد تصنيف نظري، بل هو أساس لفهم طبيعة اللغة البشرية بأكملها، حيث لا يمكن لأحدهما أن يوجد دون الآخر. فالنظام اللغوي لا يكتسب وجوده إلا من خلال ممارسات الكلام المتكررة للأفراد، وفي الوقت نفسه، لا يمكن لفعل الكلام أن يكون مفهوماً أو ذا معنى دون استناده إلى ذلك النظام المشترك. تسعى هذه المقالة إلى تفكيك مفهوم الكلام، واستعراض خصائصه الأساسية، وتحليل أبعاده النفسية والاجتماعية والإنجازية، وبيان دوره الحيوي في تشكيل الخطاب والتفاعل الإنساني، مع التركيز على أهمية دراسة الكلام لفهم الديناميكيات المعقدة للتواصل البشري.
الكلام بين النظام اللغوي والتجلي الفردي
إن العلاقة بين النظام اللغوي المجرد (Langue) والتجلي الفردي له (Parole) هي علاقة جدلية وتكاملية في آن واحد، وقد شكلت حجر الزاوية في اللسانيات السوسيرية. اعتبر سوسير أن موضوع اللسانيات الحقيقي يجب أن يكون النظام (Langue) لأنه يتميز بالثبات والاجتماعية، مما يجعله قابلاً للدراسة العلمية المنهجية، بينما رأى أن الكلام متغير وفوضوي وفردي إلى حد كبير. ومع ذلك، فإن النظرة المعاصرة قد تجاوزت هذا الفصل الحاد، مدركة أن فهم أحدهما يستلزم بالضرورة فهم الآخر. فالنظام اللغوي ليس كياناً ميتافيزيقياً منفصلاً عن مستخدميه، بل هو بنية تتشكل وتتطور وتتغير باستمرار من خلال أفعال الكلام الفردية. كل جملة جديدة، وكل استخدام استعاري مبتكر، وكل تغيير طفيف في النطق هو في جوهره فعل من أفعال الكلام قد يساهم، إذا ما انتشر وقُبل، في تعديل النظام اللغوي الكلي على المدى الطويل. من هنا، يُنظر إلى الكلام على أنه المحرك الديناميكي للتغيير اللغوي، والمختبر الذي تُجرّب فيه الإمكانيات الإبداعية للغة.
يتسم الكلام بطبيعته النفسية-الفيزيائية (Psycho-physical)، فهو عملية تبدأ في ذهن المتكلم كفكرة أو قصد تواصلي، ثم تخضع لعمليات معرفية معقدة من التخطيط والتشفير، حيث يتم اختيار المفردات المناسبة وتطبيق القواعد النحوية والصرفية لتكوين بنية لغوية مجردة. بعد ذلك، تنتقل هذه البنية إلى مرحلة التنفيذ الفيزيائي، حيث تقوم الأعضاء النطقية (الحنجرة، اللسان، الشفاه، إلخ) بترجمة الإشارات العصبية إلى موجات صوتية ملموسة تنتقل عبر الهواء. هذا الجانب المادي للكلام هو ما يجعله قابلاً للملاحظة والتحليل الصوتي (Acoustic analysis). إن دراسة هذا المسار المعقد من الفكرة إلى الصوت تكشف عن أن الكلام ليس مجرد انعكاس بسيط للنظام، بل هو عملية إنتاجية نشطة ومعقدة تتأثر بحالة المتكلم النفسية، وقدراته المعرفية، وسياق الموقف التواصلي. إن فهم هذه الآليات يسلط الضوء على الطبيعة المتفردة لكل فعل من أفعال الكلام.
علاوة على ذلك، فإن الكلام هو الذي يمنح اللغة بعدها الإنساني الحي. فبينما يمثل النظام الهيكل العظمي المجرد للغة، فإن الكلام هو اللحم والدم الذي يبث فيه الحياة. من خلال الكلام، نعبر عن مشاعرنا، نبني علاقاتنا الاجتماعية، نتفاوض حول المعاني، ونمارس القوة والتأثير. كل فعل كلام يحمل بصمة المتكلم الفريدة، ليس فقط في صوته ونبرته، بل أيضاً في اختياراته الأسلوبية، ودرجة التزامه بالقواعد أو انحرافه عنها، والأهداف الخفية التي يسعى لتحقيقها. لذلك، فإن تحليل الكلام لا يقتصر على التحقق من مطابقته لقواعد النظام، بل يمتد ليشمل فهم كيفية استخدام الأفراد لهذا النظام لتحقيق أغراض تواصلية متنوعة في مواقف حياتية حقيقية. إن هذه النظرة الوظيفية للكلام هي ما مهد الطريق لظهور فروع لسانية هامة مثل التداولية (Pragmatics) وتحليل الخطاب (Discourse Analysis).
الخصائص الجوهرية للكلام
لكي نفهم طبيعة الكلام بشكل أعمق، لا بد من تحديد مجموعة من الخصائص الأساسية التي تميزه عن النظام اللغوي المجرد وعن أشكال التواصل الأخرى كالكتابة. هذه الخصائص متداخلة وتعمل معاً لتشكيل التجربة الفريدة للتواصل الشفهي. إن إدراك هذه السمات ضروري لتحليل أي فعل من أفعال الكلام تحليلاً دقيقاً.
- الفردية والتفرد (Individuality and Uniqueness):
كل فعل كلام هو حدث فريد لا يتكرر. إنه صادر عن فرد معين، في لحظة زمنية محددة، وفي مكان معين. يحمل الكلام بصمات بيولوجية واجتماعية للمتكلم، مثل نبرة صوته (Timbre)، وسرعة حديثه، ولهجته (Accent)، واستخدامه لمفردات وتراكيب معينة تعكس خلفيته التعليمية والاجتماعية. حتى لو نطق شخصان الجملة ذاتها، فإن التحليل الصوتي الدقيق سيظهر اختلافات جوهرية في خصائص الكلام المنتج. هذه الفردية تجعل من الكلام مصدراً غنياً للمعلومات حول هوية المتكلم وحالته النفسية والعاطفية، وهو ما تستغله مجالات مثل علم اللغة الجنائي (Forensic Linguistics). - الآنية والزوال (Immediacy and Evanescence):
على عكس النص المكتوب الذي يتميز بالثبات والاستمرارية، فإن الكلام بطبيعته آني وزائل. إنه يوجد فقط في لحظة إنتاجه ثم يتلاشى في الهواء، ما لم يتم تسجيله. هذه الخاصية تفرض قيوداً وتحديات على كل من المتكلم والمستمع. فالمتكلم ينتج الكلام في الزمن الحقيقي (Real-time)، مما يعني أنه قد يرتكب أخطاء، أو يتوقف، أو يعيد صياغة جمله (Hesitations and repairs). والمستمع بدوره يجب أن يعالج ويفهم الكلام فور وروده، معتمداً بشكل كبير على ذاكرته العاملة (Working Memory). هذه الطبيعة الآنية تجعل الكلام أكثر عفوية وأقل تخطيطاً من الكتابة، وتسمح بالتفاعل المباشر والفوري بين المتحاورين. - السياقية الشديدة (High Context-Dependency):
يعتمد فهم الكلام بشكل كبير على السياق الذي يتم إنتاجه فيه. هذا السياق لا يقتصر على الكلمات والجمل السابقة واللاحقة (السياق اللغوي)، بل يشمل أيضاً السياق الموقفي (Situational Context) مثل المكان والزمان، وهوية المشاركين وعلاقتهم ببعضهم البعض، والمعرفة المشتركة بينهم، وحتى الإشارات غير اللفظية المصاحبة للكلام كلغة الجسد وتعبيرات الوجه. جملة مثل “الجو حار هنا” قد تكون مجرد وصف للحالة الجوية، أو طلباً ضمنياً بفتح النافذة، أو تعليقاً ساخراً في يوم بارد. لا يمكن تحديد المعنى المقصود إلا بالرجوع إلى سياق الكلام الكلي، مما يجعل التداولية عنصراً لا غنى عنه في تحليل الكلام. - التفاعلية والحوارية (Interactivity and Dialogism):
يحدث معظم الكلام في سياقات حوارية تفاعلية، حيث يتبادل المشاركون أدوار المتكلم والمستمع. هذا يعني أن إنتاج الكلام لدى طرف ما يتأثر بشكل مباشر بالكلام الذي ينتجه الطرف الآخر. بنية المحادثة، من خلال آليات مثل أخذ الدور (Turn-taking)، وتقديم التغذية الراجعة (Feedback)، والتصحيح المشترك للمعنى، تظهر أن الكلام ليس مجرد سلسلة من المونولوجات المنفصلة، بل هو بناء مشترك للمعنى بين المشاركين. هذا البعد التفاعلي هو جوهر الطبيعة الاجتماعية للكلام.
الكلام بوصفه فعلاً إنجازياً
لقد أحدثت نظرية أفعال الكلام (Speech Act Theory)، التي طورها الفيلسوف جون أوستن (J. L. Austin) ثم وسعها تلميذه جون سيرل (John Searle)، ثورة في النظرة إلى اللغة والكلام. قبل هذه النظرية، كان يُنظر إلى الجمل بشكل أساسي على أنها أدوات لوصف الواقع، ويمكن الحكم عليها بالصدق أو الكذب. لكن أوستن لاحظ أننا نستخدم الكلام في كثير من الأحيان ليس فقط للقول، بل “للفعل”. عندما يقول شخص “أعدك بالحضور غداً”، فهو لا يصف وعداً، بل يقوم بفعل الوعد نفسه من خلال عملية الكلام. هذا التحول من التركيز على البنية النحوية للجمل إلى وظيفتها العملية في التواصل فتح آفاقاً جديدة لفهم طبيعة الكلام ودوره في الحياة الاجتماعية. لقد أصبح تحليل الكلام يعني تحليل الأفعال التي ينجزها المتكلمون من خلال تلفظهم بالكلمات.
قسم أوستن فعل الكلام الواحد إلى ثلاثة أفعال متزامنة ومترابطة. أولاً، هناك الفعل اللفظي (Locutionary Act)، وهو ببساطة فعل نطق سلسلة من الأصوات والكلمات ذات معنى ودلالة محددة وفقاً لقواعد اللغة. إنه الجانب المادي والشكلي لإنتاج الكلام. ثانياً، وهو الأهم، الفعل الإنجازي (Illocutionary Act)، والذي يمثل القصد أو الغرض الذي يكمن وراء الكلام. إنه الفعل الذي ينجزه المتكلم “في” قوله شيئاً ما. على سبيل المثال، يمكن أن يكون الفعل الإنجازي لجملة “هناك ثور هائج خلفك” هو التحذير. الأفعال الإنجازية تتنوع بشكل كبير وتشمل الطلب، الأمر، السؤال، الوعد، الاعتذار، الشكر، التهديد، وغيرها الكثير. إن القوة الإنجازية (Illocutionary force) للكلام هي ما يحدد طبيعة الفعل التواصلي.
ثالثاً، هناك الفعل التأثيري (Perlocutionary Act)، وهو الأثر أو النتيجة التي يحدثها الكلام في المستمع. إنه الفعل الذي ينجزه المتكلم “بـ” قوله شيئاً ما. في مثال الثور الهائج، قد يكون الفعل التأثيري هو إخافة المستمع أو دفعه إلى الهرب. من المهم ملاحظة أن الفعل التأثيري ليس تحت السيطرة الكاملة للمتكلم؛ فقد يقصد المتكلم تحذير المستمع (فعل إنجازي)، ولكن الأخير قد لا يصدقه ولا يشعر بالخوف (فشل الفعل التأثيري). إن فهم هذه المستويات الثلاثة يسمح بتحليل دقيق ومفصل لما يحدث فعلياً عندما يتم إنتاج الكلام. لم يعد الكلام مجرد نقل للمعلومات، بل أصبح أداة فعالة للتأثير في الآخرين وتغيير الواقع الاجتماعي. هذه الرؤية تؤكد على أن دراسة الكلام لا يمكن أن تكتمل دون النظر في نوايا المتكلمين وتأثيرات أقوالهم في سياقاتها التفاعلية.
الأبعاد النفسية والاجتماعية للكلام
يمثل الكلام جسراً يربط بين العالم الداخلي للفرد (عملياته المعرفية والنفسية) والعالم الخارجي (البنى والتفاعلات الاجتماعية). لذلك، فإن دراسته تتطلب منظوراً متعدد التخصصات يدمج بين علم اللغة النفسي (Psycholinguistics) وعلم اللغة الاجتماعي (Sociolinguistics). إن تحليل الكلام من هاتين الزاويتين يكشف عن مدى تعقيده ودوره في تشكيل الهوية الفردية والجماعية.
- الأبعاد النفسية-المعرفية للكلام:
يستكشف علم اللغة النفسي العمليات الذهنية التي تكمن وراء إنتاج وفهم الكلام. هذه العمليات تحدث بسرعة فائقة وبشكل تلقائي إلى حد كبير، ولكن يمكن تفكيكها إلى مراحل رئيسية:- التصوّر (Conceptualization): هي المرحلة الأولى التي تتشكل فيها الفكرة أو الرسالة غير اللغوية التي يرغب المتكلم في التعبير عنها.
- الصياغة (Formulation): يتم في هذه المرحلة ترجمة الفكرة المجردة إلى شكل لغوي. تتضمن هذه العملية اختيار الكلمات المناسبة من المعجم الذهني (Lexical selection) وبناء الجمل وفقاً للقواعد النحوية (Syntactic structuring).
- التشفير الصوتي (Phonological Encoding): يتم تحويل البنية النحوية والمعجمية إلى تمثيل صوتي أو خطة نطقية.
- النطق (Articulation): هي المرحلة الأخيرة والحركية التي تقوم فيها أعضاء النطق بتنفيذ الخطة الصوتية لإنتاج موجات الكلام المادية.
إن دراسة الأخطاء وزلات اللسان (Slips of the tongue) التي تحدث أثناء إنتاج الكلام تقدم دليلاً قوياً على وجود هذه المراحل واستقلاليتها النسبية، وتوفر نافذة فريدة على كيفية تنظيم اللغة في الدماغ.
- الأبعاد الاجتماعية-الثقافية للكلام:
من ناحية أخرى، يبحث علم اللغة الاجتماعي في كيفية تأثر الكلام بالعوامل الاجتماعية وكيف يؤثر هو بدوره في البنية الاجتماعية.- الكلام كعلامة على الهوية (Speech as an Identity Marker): يعمل الكلام كبطاقة تعريف اجتماعية. فاللهجة، واللكنة، واختيار المفردات (استخدام العامية أو اللغة الرسمية)، وحتى السمات الصوتية مثل طبقة الصوت، يمكن أن تشير إلى الأصل الجغرافي للمتكلم، وطبقته الاجتماعية، ومستواه التعليمي، وانتمائه لمجموعة معينة. الأفراد غالباً ما يعدلون من طريقة الكلام لديهم (Code-switching/Style-shifting) للتأكيد على هويات مختلفة في سياقات مختلفة.
- الكلام والسلطة (Speech and Power): لا يتمتع كل أشكال الكلام بنفس القدر من القيمة أو السلطة في المجتمع. هناك أساليب كلام “معيارية” أو “مرموقة” ترتبط بالطبقات المهيمنة، بينما قد تُوصم أساليب أخرى بأنها “غير صحيحة” أو “متدنية”. يمكن استخدام الكلام لفرض السلطة، أو تحديها، أو التفاوض حولها. تحليل الكلام في مؤسسات مثل المحاكم أو الفصول الدراسية يكشف عن كيفية توزيع أدوار القوة والهيمنة من خلال الأنماط التفاعلية.
- الكلام والتفاعل الاجتماعي (Speech and Social Interaction): يخضع الكلام لقواعد اجتماعية غير مكتوبة تنظم التفاعل، مثل قواعد الأدب والمجاملة (Politeness theory)، وكيفية بدء وإنهاء المحادثات، وكيفية سرد القصص. إن إتقان هذه القواعد لا يقل أهمية عن إتقان القواعد النحوية لتحقيق تواصل ناجح. إن تحليل هذه الأبعاد يظهر أن الكلام ليس مجرد أداة محايدة، بل هو ممارسة اجتماعية متجذرة بعمق في نسيج المجتمع.
تحليل الخطاب ودور الكلام
بينما تركز بعض فروع اللسانيات على دراسة اللغة على مستوى الصوت (الفونولوجيا) أو الكلمة (المورفولوجيا) أو الجملة (النحو)، فإن تحليل الخطاب (Discourse Analysis) يهتم بدراسة اللغة في استخدامها الفعلي على مستوى “ما فوق الجملة”. المادة الخام لتحليل الخطاب هي في الغالب تسجيلات للكلام الحي أو نصوص مكتوبة. يسعى هذا المجال إلى فهم كيف يبني الناس عوالم اجتماعية ومعاني مشتركة من خلال سلاسل مترابطة من أفعال الكلام. بدلاً من النظر إلى كل جملة ككيان مستقل، يركز تحليل الخطاب على كيفية ارتباط أجزاء الكلام ببعضها البعض لتشكيل كل متماسك وذي معنى، مثل محادثة، أو قصة، أو مقابلة، أو خطبة سياسية. إن أهمية الكلام في هذا المجال تكمن في كونه الوسيلة الأساسية التي يتجلى من خلالها الخطاب.
أحد الجوانب الأساسية التي يدرسها تحليل الخطاب هو كيفية تحقيق التماسك (Cohesion) والترابط (Coherence) في الكلام. يشير التماسك إلى الروابط اللغوية السطحية التي تربط أجزاء النص ببعضها، مثل استخدام الضمائر، وأدوات الربط، والتكرار المعجمي. أما الترابط، فهو مفهوم أعمق يتعلق بالمنطق الدلالي الذي يجعل المستمع يشعر بأن أجزاء الكلام تشكل كلاً ذا معنى، حتى في غياب روابط لغوية صريحة. يعتمد تحقيق الترابط بشكل كبير على المعرفة الخلفية المشتركة بين المتحاورين وقدرتهم على استنتاج المعاني الضمنية (Implicatures) من الكلام. إن تحليل كيفية بناء المتكلمين لنصوص متماسكة ومترابطة يكشف عن الاستراتيجيات المعرفية والتفاعلية التي يستخدمونها لجعل كلامهم مفهوماً ومقنعاً.
جانب آخر مهم هو دراسة بنية المحادثة (Conversation Analysis). يكشف هذا المنهج الدقيق أن الكلام الحواري، الذي قد يبدو عشوائياً وفوضوياً للوهلة الأولى، هو في الواقع منظم بشكل دقيق. هناك آليات معقدة لإدارة الأدوار (Turn-taking)، حيث يعرف المشاركون متى يبدأون الكلام ومتى يتوقفون لإعطاء المجال للآخر، باستخدام إشارات دقيقة في النبرة والإيقاع والنحو. كما يدرس هذا المنهج كيفية قيام المتحدثين بتنفيذ “أزواج متجاورة” (Adjacency pairs) مثل (سؤال-جواب)، (تحية-رد التحية)، (عرض-قبول/رفض)، والتي تشكل اللبنات الأساسية للتفاعل المنظم. إن دراسة هذه البنى الدقيقة للكلام التفاعلي تظهر أنه نظام معقد قائم بذاته، له قواعده الخاصة التي تتجاوز قواعد بناء الجملة التقليدية، وهو ما يؤكد على أن جوهر الكلام يكمن في طبيعته التفاعلية.
الخاتمة
في ختام هذا التحليل المستفيض، يتضح أن مفهوم الكلام (Parole) أبعد ما يكون عن كونه مجرد تنفيذ عشوائي لنظام لغوي مجرد. إنه الظاهرة اللغوية في صورتها الحية والديناميكية، وهو الساحة التي تتفاعل فيها البنى المعرفية الفردية مع القوى الاجتماعية والثقافية. لقد انطلقنا من التمييز السوسيري الأساسي بين النظام والكلام، ورأينا كيف أن هذه الثنائية، على أهميتها، قد تطورت إلى فهم أكثر تكاملية يرى في الكلام المحرك الفعلي للتغيير اللغوي والمصدر الذي يستمد منه النظام وجوده وحيويته. إن الخصائص الجوهرية للكلام، من فردية وآنية وسياقية وتفاعلية، تجعله ظاهرة متعددة الأوجه وغنية بالمعنى.
لقد غيرت نظرية أفعال الكلام من فهمنا لطبيعة الكلام، حيث لم يعد يُنظر إليه كوسيلة لوصف الواقع فحسب، بل كأداة لإنجاز أفعال حقيقية تؤثر في العالم والعلاقات الاجتماعية. كما أن استكشاف الأبعاد النفسية والاجتماعية للكلام كشف عن دوره المزدوج كنافذة على العمليات العقلية لإنتاج اللغة، وكمرآة تعكس الهويات والبنى الاجتماعية. وأخيراً، أظهر لنا تحليل الخطاب أن الكلام هو المادة الخام التي تُبنى منها نصوص حياتنا اليومية، من أبسط المحادثات إلى أعقد الخطابات، وفقاً لأنظمة وقواعد تفاعلية دقيقة. إن دراسة الكلام ليست مجرد فرع من فروع اللسانيات، بل هي مفتاح أساسي لفهم جوهر التواصل البشري، وكيف يستخدم الإنسان اللغة ليس فقط للتعبير عن أفكاره، بل لصياغة واقعه وتشكيل عالمه. لذلك، يبقى تحليل الكلام مجالاً خصباً للبحث، يعد بالكشف المستمر عن أسرار العلاقة المعقدة بين اللغة والفكر والمجتمع.
سؤال وجواب
1. ما هو الفرق الجوهري بين “اللسان” (Langue) و”الكلام” (Parole) عند سوسير؟
اللسان (Langue) هو النظام اللغوي المجرد والمشترك بين أفراد جماعة لغوية معينة؛ إنه الجانب الاجتماعي والمستقر من اللغة الذي يتضمن القواعد والمفردات. أما الكلام (Parole) فهو التحقق الفعلي والفردي لهذا النظام، أي فعل استخدام اللغة في مواقف تواصلية محددة، وهو يتميز بالتغير والتفرد.
2. لماذا يُعتبر الكلام المحرك الأساسي للتغيير اللغوي؟
لأن النظام اللغوي في حد ذاته كيان ثابت نسبياً، والتغيير لا يحدث إلا من خلال الاستخدام الفعلي للغة. أفعال الكلام الفردية هي التي تدخل استخدامات جديدة، أو تغيرات في النطق، أو تحولات دلالية. عندما تنتشر هذه الممارسات الفردية وتُقبل اجتماعياً، فإنها تصبح جزءاً من النظام اللغوي الكلي وتعدله على المدى الطويل.
3. كيف يكتسب الكلام معناه الكامل من خلال السياق؟
لا يكمن معنى الكلام في الكلمات وحدها، بل يتم بناؤه من خلال تفاعل النص اللغوي مع السياق المحيط به. يشمل السياق هوية المشاركين، وعلاقتهم، والمعرفة المشتركة بينهم، والزمان والمكان، والإشارات غير اللفظية. هذه العوامل تساعد على تحديد القصد الإنجازي للمتكلم وحل أي غموض محتمل في رسالته.
4. ما هي القوة الإنجازية (Illocutionary Force) لفعل الكلام؟
القوة الإنجازية هي القصد أو الغرض التواصلي الذي يكمن وراء التلفظ بجملة ما. إنها الفعل الذي ينجزه المتكلم “في” قوله شيئاً. على سبيل المثال، القوة الإنجازية لجملة “سأكون هناك في الخامسة” هي “الوعد”، بينما القوة الإنجازية لجملة “هل يمكنك تمرير الملح؟” هي “الطلب”.
5. ما الفرق بين الفعل الإنجازي والفعل التأثيري في نظرية أفعال الكلام؟
الفعل الإنجازي هو نية المتكلم أو الفعل المقصود (مثل التحذير، الطلب، الوعد). أما الفعل التأثيري فهو الأثر الفعلي الذي يحدثه الكلام في المستمع (مثل شعوره بالخوف، أو قيامه بتمرير الملح). المتكلم يتحكم في فعله الإنجازي، لكنه لا يضمن بالضرورة تحقيق الفعل التأثيري المرغوب.
6. كيف يدرس علم اللغة النفسي عملية إنتاج الكلام؟
يدرسها كعملية معرفية متعددة المراحل تبدأ بالتصور (تكوين الفكرة)، ثم الصياغة (اختيار الكلمات والقواعد النحوية)، ثم التشفير الصوتي (تحويل البنية إلى خطة نطق)، وتنتهي بالنطق (التنفيذ الحركي). تُعد زلات اللسان والأخطاء العفوية دليلاً على وجود هذه المراحل المستقلة نسبياً.
7. كيف يعكس الكلام الهوية الاجتماعية للمتكلم؟
يعكس الكلام الهوية الاجتماعية من خلال عدة مؤشرات مثل اللهجة التي تشير إلى الأصل الجغرافي، واللكنة، واختيار المفردات (الأسلوب الرسمي أو العامي)، والسمات فوق المقطعية كالنبرة والإيقاع. كل هذه العناصر مجتمعة تشكل بصمة لغوية تكشف عن انتماءات الفرد الاجتماعية والطبقية والثقافية.
8. هل يُعتبر الكلام ظاهرة فوضوية أم منظمة؟
على الرغم من أن الكلام قد يبدو عفوياً وغير منظم للوهلة الأولى، إلا أن تحليل المحادثات يكشف عن وجود نظام دقيق يحكمه. توجد قواعد ضمنية لتنظيم آليات مثل أخذ الدور في الحديث (Turn-taking)، والأزواج المتجاورة (Adjacency pairs)، واستراتيجيات بدء وإنهاء الحوار، مما يجعله ظاهرة منظمة للغاية.
9. ما هو الدور الذي يلعبه الكلام في تحليل الخطاب؟
في تحليل الخطاب، يمثل الكلام المادة الخام للدراسة. لا يُنظر إليه كمجرد جمل منفصلة، بل كسلسلة من الأفعال اللغوية المترابطة التي تبني المعنى وتؤسس للواقع الاجتماعي. يحلل الخطاب كيفية استخدام الكلام لتحقيق التماسك والترابط، وسرد القصص، وممارسة السلطة، وبناء الهويات.
10. هل الكتابة هي شكل من أشكال الكلام (Parole)؟
بالمعنى الواسع، نعم، فالكتابة هي تحقق فردي للنظام اللغوي (Langue). لكن في السياق السوسيري الأصلي، يرتبط مصطلح “Parole” بشكل وثيق بالطبيعة الصوتية والآنية والزائلة للتواصل الشفهي. لذا، يرى الكثيرون أن الكتابة، بفضل ثباتها وقابليتها للتخطيط والمراجعة، تمثل ظاهرة موازية للكلام ولكنها ذات خصائص مميزة.