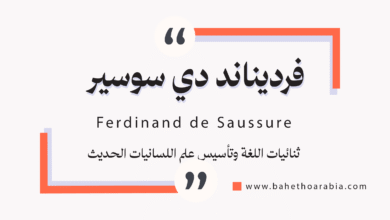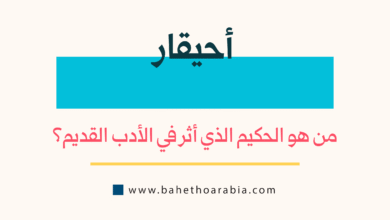عبيد بن الأبرص: رحلة في حياة شاعر جاهلي عظيم وأغراضه الشعرية
دراسة شاملة لحياة الشاعر الجاهلي عبيد بن الأبرص ومعلقته ومنزلته الأدبية
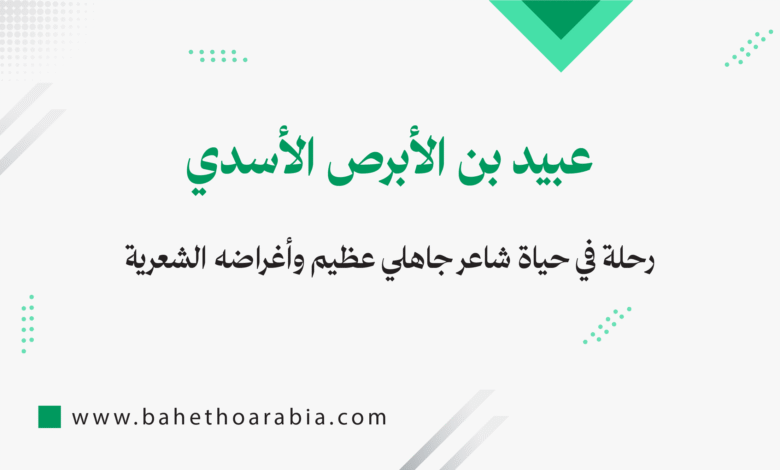
يُعد عبيد بن الأبرص الأسدي أحد أبرز شعراء العصر الجاهلي الذين تركوا بصمة واضحة في تاريخ الأدب العربي، حيث عاش بين عامي ٤٥٥ و٥٤٥ ميلادية، وكان شاعراً قديماً عظيم الذكر والشهرة. تتناول هذه الدراسة حياته وشعره ومعلقته وأغراضه الشعرية المتنوعة، مع تسليط الضوء على منزلته الأدبية وخصائصه الفنية المميزة.
حياة عبيد بن الأبرص الأسدي
ذكر ابن سلام عبيد بن الأبرص بين شعراء الطبقة الرابعة مع طرفة بن العبد، وعلقمة بن عبدة، وعدي بن زيد. وقال: هو قديم عظيم الذكر، عظيم الشهرة وشعره مضطرب ذاهب. ونسبه كما ورد في أكثر المصادر: عبيد بن الأبرص بن جشم … الأسدي. فقد كان عبيد إذن شاعراً ذا شأن، وكان لشعره شيوع وسيرورة، أما قبيلته بنو أسد فقد كانت تعيش في نجد بين شمالي الحجاز وجنوبي الشام وشرقي طريق التجارة الذي يصل الشام باليمن، وغربي جبلي طيء: أجأ وسلمى.
ربما أدى قرب بني أسد من طيء إلى نوع من الاتصال بالطائيين. وهذا الموضع يعني أنهم كانوا جيران الغساسنة، ولذلك كانت أسد أولى القبائل غير اليمنية التي كان الملك الغساني يحاربها لتأديبها، وكف غزواتها عن ملكه، وعن بلاد الرومان. وفي أخبار عبيد ما يشبه الأساطير، فقد قيل: إن سبب قوله الشعر أنه أتاه آت في منامه تحت شجرات بالعراء بكبة من شعر، فألقاها في فيه، وقال: قل ما بدا لك، فأنت أشعر العرب، وأمجد العرب. وقيل: إنه عمر ثلاثمائة سنة، وإنه صحب النابغة الذبياني وبشر بن أبي خازم حينما ذهبا إلى حاتم الطائي، في أثناء وفودهم على النعمان آخر المناذرة.
وقد درس أستاذنا الدكتور عمر فروخ مكانة عبيد في بني أسد، وصلة قوية حجرين بحجر بن الحارث والد امرىء القيس الشاعر فقال: شهد عبيد تملك حجر بن الحارث الكندي على بن أسد سنة ١٢٢ ق. هـ (٥٠٠م) فاختار أن يتصل به وينادمه وفي سنة ٩٢ في. هـ (٥٣٠م) عاد شيء من القوة إلى بني أسد، فأبوا أن يستقر حكم حجر فيهم، فأعلنوا عصيانهم بالامتناع عن أداء الإتاوة (الضرائب)، فسار إليهم حجر، وأساء معاملتهم، ثم قتل نفراً من رؤسائهم، وشرد طائفة منهم عن نجد إلى تهامة ساحل البحر الأحمر لكنه عاد فعفا عنهم بشفاعة عبيد الذي كان في المشرفين أيضاً.
فلما رجع المشردون بعد بضعة أيام انضموا إلى إخوانهم، وحاربوا حجراً بقيادة علباء بن الحارث الكاهلي، وقتلوه. وبذلك انتهى حكم كندة على بني أسد. ثم اجتمعت بنو أسد بعد قتلهم حجر بن عمرو والد امرىء القيس إلى أمري القيس ابنه على أن يعطوه ألف بعير دية أبيه، أو يقيدوه من أي رجل شاء من بني أسد. أو يمهلهم حولاً، فقال: أما الدية فما ظننت أنكم تعرضونها على مثلي، وأما القود فلو قيد إلى ألف رجل من بني أسد ما رضيتهم، ولا رأيتهم كفواً الحجر. وأما النظرة فلكم. ثم إنكم ستعرفونني في فرسان قحطان أحكم فيكم ظبا السيوف وشبا الأسنة حتى أشفي نفسي، وأنال ثأري.
وقال عبيد بن الأبرص في ذلك:
نحن العُلا فاجمعْ جُمو عَكَ، ثمَّ وَجَّهْهُمْ إلينَا
واعلَمْ بأنَّ جِيادنا آلَينَ لا يَقْضين دَيْنا
ولقد أبحنا ما حَمَيْـ ـت، ولا مُبيحَ لما حَمَينا
وأخفق امرؤ القيس في مسعاه، ولم ينل من بني أسد، وشمخ عبيد بما قال بين العرب، وعلا شأنه، وأصبح شاعر أسد. وكان عبيد بن الأبرص يتردد على بلاط المناذرة في الحيرة، ثم زاد تردده هذا بعد مقتل حجر، ولعل صلة امرىء القيس بن حجر بعبيد بن الأبرص لم تبدأ قبل ثورة بني أسد على حكم كندة ومقتل حجر. وحينما شاخ عبيد وافتقر ساءت صلته بزوجته، فجعلت تتكرّهه، وتغاضبه وتعرّض بضعفه وشيخوخته فقال فيها:
تِلْكَ عِرْسي غَضْبَى تُريد زيالي ألبَيْنٍ تُريدُ أَمْ لِدَلالِ
إن يكنْ طِبُّكَ الفِراقُ فلا أحـ ـفلُ أنْ تعطفي صدورَ الجمالِ
ولم نظفر بخبر عن وفاته. ويقدر الدكتور عمر فروخ أنه توفى سنة ٥٤٥ أو بعد ذلك بقليل.
شعر عبيد بن الأبرص ومعلقته الشهيرة
لعبيد بن الأبرص ديوان طبع مرات، ولعل أفضل طبعاته تلك التي حققها استاذنا الدكتور حسين نصار، ونشرتها مكتبة البابي الحلبي بمصر سنة ١٩٥٧م. وتعد هذه الطبعة خيراً من سواها لأن المحقق أفاد من طبعة المستشرق (سير تشارلس ليال) ثم تما وجده من شعر عبيد مخطوطاً في كتاب منتهى الطلب، ولأن المحقق خرج القصائد، وذكر المصادر، وشفع القصائد الكبرى بمقدمات تشير إلى أسباب النظم، وختم الديوان بفهارس فنية جيدة.
من يستعرض ديوان عبيد يجد أن في معظم شعره وقار الكهولة، وحكمة الشيخوخة، والبكاء على الشباب الراحل. فإما أن يكون قدر من شعره المنظوم في فترة الشباب قد ضاع، وإما أن يكون الشاعر قد اكتملت عبقريته وحصفت ملكاته في آخرة، فكثر شعره في الكهولة. وقد أولى النقاد القدماء بائيته التي مطلعها:
أَقْفَرَ مِنْ أَهْلِهِ مُلْحُوبُ فالقُطّبّياتُ فالذُّنوبُ
عناية خاصة. فابن قتيبة جعلها أجود شعره، والتبريزي ذكرها بين القصائد العشر الطوال، وأبو زيد القرشي صدر بها جمهرته. ونحن – على تقديرنا آراء القدماء – لا نجد في هذه القصيدة من القيم الفنية ما يرقى بها إلى منزلة المعلقات لأسباب منها أن وزنها غريب لا تألفه الأذن العربية. وقد نبه على ذلك المستشرق ليال، فقال: وبحرها نادر غير مألوف، لا نراه إلا في قصيدة أخرى لامرىء القيس.
ومنها أن هذا الوزن النادر تعروه علل وزحافات كثيرة تفسد اتساق الإيقاع، وتجري فيه أنماطاً من الاضطراب والخلل، حتى كادت – في رأي بعض النقاد – تخرج كلام عبيد من المنظوم إلى المنثور. وفى ذلك الرأى شطط، لأننا لو تجاوزنا الأبيات المختلة إلى السائغة لوجدنا أن وزنها مستفعلن فأعلن فعولن وهو المعروف بمعلم البسيط. ومن هذه الأسباب أن في المعلقة أفكاراً إسلامية تحمل على الشك في بعض أبياتها، مثل:
مَن يَسْأَلِ النَّاسِ يَحْرِمُوهُ وَسَائِلُ الله لا تخيبُ
والله لَيْسَ لَهُ شَرِيكُ عَلَّامُ مَا أَخْفَتِ القُلُوبُ
والمصادر التي بين أيدينا لم تحدد أسباب نظم المعلقة ولا الظروف التي اكتنفت الشاعر حينما نظمها. ويظن الدكتور حسين نصار أنها قيلت بعد إحدى غارات الحارث الأعرج ملك غسان على بني أسد.
عدة أبيات المعلقة خمسون بيتاً موزعة على النحو الآتي:
١- في الأبيات العشرة الأولى تحدث عبيد عن إقفار الديار إما لأن أهلها قد هجروها، وتفرقوا، وإما لأنهم قتلوا، فشيعهم الشاعر بدموع غزيرة.
٢- في البيت الحادي عشر ذكر الشاعر كبر سنه، ثم مضى ينقد أحوال الناس والحياة في سنة أبيات (١٢ – ١٧) ويتذكر شبابه الراحل واقتحامه المسالك المخوفة في ثلاثة أبيات (٢٨ – ٣٠).
٣- يصف الناقة ويشبهها بالحمار والثور في أربعة أبيات (٣١ – ٣٥) ويخص فرسه بأربعة أبيات (٣٦ – ٣٩).
٤- جعل عبيد خاتمة القصيدة مشهداً حياً من مشاهد الصيد، صور فيه كيف تقنص العقاب الثعلب (٤٠ – ٥٠).
وقد نقد المستشرق ليال تسلسل الأبيات في المعلقة، ورأى أن فيها تقطعاً يدل على سقوط أقسام منها.
أغراض الشعر عند عبيد بن الأبرص
في ديوان عبيد ما في دواوين غيره من أغراض كالفخر والهجاء والغزل والوصف والرثاء والحكمة وشيء يسير من مدح. وقد تنوعت هذه الأغراض الشعرية بين القبلي والذاتي، وبين الوصف الطبيعي والتأملات الفلسفية التي تعكس تجربة شاعر عاش حياة طويلة حافلة بالأحداث.
الفخر في شعر عبيد بن الأبرص الأسدي
جعل عبيد فخره قسمة بينه وبين قومه. وأولى مفاخره البراعة في صوغ الكلام وتشقيقه وتنميقه نثراً وشعراً. فهو سباح ماهر، يعوم في لحج المعاني والألفاظ، ويتقلب بين أمواج الخواطر والمشاعر، ويلاحق الصور الشاردة حتى يظفر بها، ويغوص على الدرر في مظانها البعيدة الغور، كأنه سمكة من أسماك القرش، أو حوتُ أَلِفِ التوثب والتعقب، والشعراء الآخرون ضفادع حقيرة، إن سبحت رمحت الماء ولم تغص، وإن نقّت صكت السمع ولم تطرب:
سلِ الشُّعراءَ هَلْ سَبَحُوا كسبحي حُورَ الشَّعْرِ أَوْ عَاصُوا مَغَاصي
لساني بالنثير وبالقوافي وبالأسجاع أمهرُ في الغياصِ
من الحوت الذي في لُجِّ بَحْرٍ يجيدُ السَّبْحَ في لحجِ المغاصِ
ولمّا كان اللسان ترجمان العقل فالشاعر المبدع يحرك عقله لسانه بجيد الشعر، ومن كان له مثل ذكاء عبيد المتوقد وعلمه الواسع استطاع أن يضيء للناس سبل الحياة، ويذلل شعابها الوعرة الملتوية:
وَإِنِّي لَذُو رَأَي يُعَاشُ بِفَضْلِهِ ومَا أَنَا مِنْ عِلْمِ الأُمورِ بِمُبْتدِي
وأما الخلق فما شئت من طهارة لسان، وحسن عشرة، وتواضع وتعاطف وتواصل، فهو لا يجفو صديقاً، ولا يتنكر لعهد:
لعمرِك ما يخشى الجليس تفحشي عليه، ولا أنأى على المتودد
ولا أبتغي وُدَّ امرىءٍ قلَّ خيرُهُ وما أنا عنْ وصْلِ الصّديق بأصْيدِ
ومن مفاخره مكارم الأخلاق كالترفع عن السؤال وستر الفقر بالاستغناء عن الأشياء، وإكبار الكبار، وبر الوالدين، وحماية الشرف من المهانة، ومجانبة البخل والتعهّر:
لعمرُكَ إِنَّنِي لَأُعِفُّ نَفْسي وأسترُ بالتَّكَرُّمِ مِنْ خَصَاصِ
وَأَكْرِمْ وَالدِي وَأَصُونُ عِرْضِي وَأَكْرَهُ أَنْ أَعَدَّ مِن الجراص
ومكارم الأخلاق التي رققت شمائله بغضت إليه الحرب والعدوان على الناس، ضعف وخوف، فإن لقي الأرعن المتحرق إلى الشر أحرقه بناره: ودعته إلى إطفاء نار الحرب، وقمع جذور الحقد والفتنة، لكن حلمه لا يحمل ذرة من ضعفٍ وخوغ، فإن لقي الأرعن المتحرّق إلى الشّر أحرقه بناره:
وإني لأطفي الحرب بعدَ شُبُوبِها وقَدْ أُوقِدتْ للغَيِّ في كُلِّ مِوقِد
فأوقدتُها للظّالم المُصْطلي بها إذا لمْ يَزَعهُ رأيهُ عن تردُّد
ومن هذه المفاخر تبدو شخصية عبيد رقيقة مهذبة، برئت من جفوة الأعراب كأن احتكاكه بالحضارة، وتردده على أمراء الحيرة، وتجاربه العديدة قد ثقفته ولطفه وبغضت إليه ضراوة الفخر وشراسته. أما في الفخر القبلي فالعنفوان أغلب، لأن روح القبيلة تغلب نزعات الأفراد. وروح القبيلة القوة لا الرقة والعنف لا اللطف، فإذا فخر عبيد ببني أسد ذكر الخيام العالية الدالة على السيادة، والخيل العتاق الموحية بالكر والفر، والأندية الحافلة بالخطباء والشعراء:
اذْهَبْ إِلَيْكَ، فَإِنِّي مِنْ بَنِي أَسَدٍ أَهْلِ القِبَابِ وَأَهْلِ الْجُرْدِ وَالنَّادِي
ومن حق الشاعر أن يفخر بأصول أسد العريقة، وشرفها الباذخ، فهي ذؤابة النسب الصراح بين العرب، وحفاظها على نسبها يدفعها إلى التضحية بالأموال لتحمي الأعراض، وإلى المطاعنة بالحراب والرماح والضرب بالسيوف لتدفع عن حرماتها الكبد والأذى:
إِنَّنَا إِنَّمَا خُلِقْنا رؤوساً مَنْ يُسَوّي الرؤوس بالأذناب
لا نقي بالأحساب مالا وَلَكِن نَجْعَلُ المال جُنَّةَ الأَحسابِ
وَنَصُدُّ الأَعْدَاء عَنا بِضَرْبٍ ذي خدام وطعْنِنا بالحِراب
والأحساب الجديرة بالإعجاب هي المبنية على مجد عريق، وأعمال جليلة يتناقل الناس أخبارها جيلاً بعد جيل، والمشفوعة بعقول راجحة، تحافظ على رصانتها في الملمات. وربما كانت أعظم المفاخر في تاريخ قومه قتل الملوك. فقد رفضوا الخضوع الحجر والد امرىء القيس، ومنعوه الإتاوة، ثم صرعوه، ومزقوا راياته، وخلفوا جسده الممزق بالرماح تمزقه نيوب الضواري، ومخالب الكواسر:
كُمْ مِنْ رئيسٍ قدْ قتلـ ـناه وضيْمٍ قدْ أبيْنا
ولرُبَّ سيدٍ معشَرٍ ضخمِ الدَّسيعَةِ قدْ رَمَيْنا
عِقْبانهُ ترَكْنا شِلْوِهُ جزرَ السِّباع وقدْ مَضَيْنا
ولك أن تقيس بني أسد ببني تغلب، فكلتا القبيلتين بغى عليها ملك ظالم، وكلتاهما ثارث وثارت، واشتفت وفخرت بقتل الملوك.
الهجاء عند عبيد بن الأبرص
إن العنفوان الذي يفجر إعجاب الشاعر بنفسه وبقبيلته قد يتزيّا بزي آخر، إذ يخلع ثوب الفخر، ويرتدي ثوب الهجاء. وعلى هذا النحو من تبدل المظهر وثبات الجوهر انتقل عبيد من الاعتزاز بقومه إلى هجو كندة وامرىء القيس وريث العرش الضائع. وربما كان عبيد على حق في هذا الهجاء، لأن امرأ القيس كان أضعف من أن يطلب حقاً، أو يأخذ بثأر، ومن كان مثله فغنيمته من الحرب السلامة والإياب.
ولو لم يعكف على الدنان والقيان في شبابه لما خلف أباه للمغيرين. إن أمثاله من المخمورين المخنثين لا يحسنون من القتال إلا البكاء على القتلى، ولا من الثأر إلا الثرثرة من بعيد:
وَرَكْضُكَ لَوْلاهُ لَقِيتَ الذي لقوا فذاك الذي نَجَاكَ مَا هُنالِكَا
وَأَنْتَ امْرُؤٌ أَهَاكَ رَقَّ وَقَيْنَةٌ فَتُصْبِحُ مخمُوراً وتي مُشَارِكَا
عن الوترِ حَتَّى أَحْرَزَ الوِتْرَ أَهْلُهُ فأنتَ تُبَكّي إِثْرَهُ مُتْهَالِكَا
وإذا كان بكاء امرىء القيس فيه قليل من حزن، ففيه كثير من رعونة، لأن دموعه، وإن غزرت، لن ترد الملك الضائع، وتهديده، وإن عظم، لن يحقق الرغاب المتوهمة. والدليل على رعونته استعانته أعدى أعداء العرب على العرب وهو قيصر الروم:
ياذا الْمخَوْفُنَا بِمُقْتَلِ شَيْخِيهِ حجر، تمني صاحب الأحلام
لا تبكيا سفَها، وَلا سَادَاتِنَا وَاجْعَلْ بُكَاءَكَ لابنِ أمِّ قطامِ
أزعَمْتَ أَنَّكَ سَوْفَ تَأْنِي قَبْصَراً فَلَتَهْلِكَنَّ إذن وَأَنْتَ شآمي
وفي هذا الهجو، على قسوته وشماتته، تهذيب وصدق، فعبيد لا يأتي بفاحش القول، ولا يفتري على امرىء القيس ما ليس فيه، ولا يلصق به منقصة لم تؤثر عنه بل يصور ضعفه وخيانته، ويضعه أمام حقيقة تاريخية، كان عليه أن يدرك قسوتها قبل أن يسلك إلى قيصر مسالك التلف والهلكة. وأي خزي أخرى من أن يستعدي المرء الروم على العرب ثم يرد مدحورا؟
الغزل في شعر عبيد بن الأبرص
في شعر عبيد من الغزل ضربان: حاضر يصور حب الشباب في الشباب، وغابر كان له في الشباب الغابر نضرة ثم أذبلته الكهولة، وأبقت منه الذكرى. أما الحاضر فيضم ما قاله عبيد وهو موفور النشاط، مقبل على الحياة، يسعى إلى اللذة ويتعلق بالمحبوبة، ويخشى هجرها، ويحس لنأيها أثراً دامياً في كبده، ولوصالها حلاوة في فمه. إن لثمها توهم أنه ينغب من صهباء صافية، وإن أثملته مشي مشية الخيلاء:
نأتْكَ سُلَيْمَى فَالفُؤاد قَرِيحُ وليس لحاجاتِ الفؤادِ مُريحُ
إذا ذُقْتُ فَاهَا قُلْتُ: طَعْمُ مُدَامَةٍ مشعشعة تُرخِي الإزارَ قَديحُ
وعبيد كغيره من شعراء زمانه كان كلفاً بوصف الظعائن، ثم باختيار ظعينة منهن، يوليها حبه وفنه. لقد ظعنت نسوة الحي وبينهن امرأة تعلقها قلب الشاعر لجمالها المتميز، فتحتجب، وتتجنب الزينة الفاضحة، فتلقي خمارها على وجهها بيد برئت من الوشم:
فيهن هِنْدُ وَقَدْ هَامَ الفُؤَادُ بها بيْضَاءُ آنِسَةٌ بالحُسنِ موسومَهْ
فإنّها كمهاةِ الجوِّ ناعمةٌ تدني النَّصِيفَ بِكفٍّ غَير موشُومهْ
وتعفف صاحبته لا يعنى أن الشاعر كان زاهدا في الوصال، فإن ابتسامة صاحبته سعدى عن ضواحك بيض كالأقحوان كافية لاجتذاب الشاعر، وتضرم عطشه، فهو إليها ظامئ، لاغب، وأصعب العطش ما لفحك والماء منك قريب:
وتبْسِمُ عَنْ عَذْبِ اللَّثاتِ كَأَنَّه أَقَاحِي الربا أَضْحَى وَظَاهِره ندي
فاني إلى سُعْدَى وَإن طال نأيُها إلى نيلها ما عشت كالحائِم الصَّدي
على أن هذا الضرب من غزله قليل لا يقاس بالضرب الآخر من غزله الغابر قدراً ومقداراً. إذ تحس وأنت تطوف بديوانه أن الغلبة في غزله لشعر الكهولة والشيخوخة فإذا رفلت بعض المقطعات من هذا الغزل الغابر بأثواب الشباب رأيت في رفلانها تعثراً يستوجب العطف، لا تخطرا يرمي إلى الإغواء، لأن الشاعر يتذكر في كهولته مرح الشباب، فيصف ما اعتقلت ذاكرته منه وصف المتحسر على حبيب فارقه، وكنز ضيعه. وأشق ما يشق عليه في هذه الحال إعراض النسوة عنه لهرمه:
وَقَدْ عَلا لَمّتِي شَيْبٌ فَوَدَعَني مِنْهُ الغَوَانِي وَدَاعَ الصَّارِمِ القَالي
وفي هذا الضرب الموجع من الغزل يكثر عبيد من محاورة امرأة معرضة تسخر من فقره ومن ابتعاد أصحابه عنه، وزهد الغواني فيه لشحوب وجهه، وبياض رأسه، وانتباذه اللهو:
زعَمَتْ أَنَّنِي كَرْتُ، وَأَنِّي قلَّ مالي، وَضَنْ عَنِّي الموالي
وصحًا بَاطِلِي وَأَصْبَحْتِ شَيْخاً لا يُواتِي أَمْثَالَهَا أَمثالي
أن رَأَتْنِي تَغَيَّرُ اللَّوْنُ مِنِّي وعلا الشيب مفرقي وقذالي
فإذا فرغت هذه الساخرة منه ردّ عليها الردّ الذي يفرغ غضبه، ويرضي غروره ولكنه لا يبدله من ضعفه قوة، فيزعم أنه كان معشوق النساء، وأنه كان يخلو بالفتاة الضامرة الخصر، البضة الجسم، فتتوثب لديه كالظبية، وتتلوى بين يديه وهو يلثم عنقها وخدها، فلا تضيق به، ولا تدفعه عنها:
وَلَقَدْ أَدْخُلُ الحياة على مهـ ـضُومُةِ الكَشْحَ طفلة كالغزالِ
فتعاطَيْتُ جيِدَها ثُمَّ مَالَتْ ميلان الكثيبِ بينِ الرّمالِ
والتناقض بين شيخوخة الجسد وفناء النفس يلح على عبيد الحاحا عنيفا، ويعلم حسرة عميقة لا شفاء لها إلا تذكر الماضي الغابر، وتحويل الكهولة المقيمة إلى تصار متخيّل، يطير الشاعر إليه على جناح الوهم. ولذلك تزدحم في هذا الغزل عباد الله الباكية على الشباب الراحل نحو: حل المشيب دار الشباب و تصبو وقد راعك المشيب ونحو قد علاه الوضح الشامل و درَّ درُّ الشباب والشعر الأسود والله ابيضت قروني و فاتني أسفاً شبابي و الشيبُ شَينٌ لمن يشيب.
الوصف في شعر عبيد بن الأبرص الأسدي
لم يخصص عبيد قصائد مستقلة للوصف، بل جاء الوصف في شعره كعنصر تزييني يتداخل مع الأغراض الشعرية الأخرى، شأنه في ذلك شأن سائر الشعراء الجاهليين. وتتنوع الموصوفات في ديوانه لتشمل حيوانات الصحراء ونباتاتها، إضافة إلى رمالها وأمطارها، ومشاهد الرحيل والإقامة، فضلاً عن الأسلحة والدروع.
راقب عبيد حركة القوافل فشبهها بسفن تمخر عباب البحر، ولمعت خوذات المحاربين في عينيه كأنها نيران مشتعلة فوق قمم الجبال، وانطلقت به ناقته السريعة كأنها ذئبة جائعة، وبرز صدرها الصلب كأنه حجر تُطحن عليه العطور. هذه الصور من الشائع المألوف في الشعر الجاهلي، لا تميز شاعراً عن آخر. لذلك سنشير إليها عابرين، ونتوقف عند صورتين مميزتين: الأولى تتضمن إبداعاً وطرافة، والثانية تظهر مهارة فنية ترتقي بالمشهد المألوف إلى آفاق أرحب.
اعتاد شعراؤنا القدامى عند المفاخرة بشعرهم أن يشبهوا قصائدهم بالوعول الممتنعة، واللآلئ النفيسة، والرماح المستقيمة، وأن يصفوا ألسنتهم بالسيوف القاطعة والنصال الحادة. أما عبيد فقد ابتكر عند الافتخار بفصاحته ومهارته في التعبير صورة نادرة في الشعر العربي الصحراوي، إذ تخيل حركة الأسماك في الماء.
زعم عبيد أن لسانه يصطاد المعاني من بحر اللغة، ويتلاعب بالألفاظ كما تلعب السمكة بالماء، فهي تشق طبقاته وتتحرك فيه يميناً ويساراً، وتنطلق بسرعة الضوء الخاطف. ومَن ينظر إلى حوض السمك الصغير ينظر إلى بحر واسع. وكما أن حياة السمك مرتبطة بالماء، فحياة اللسان مرتبطة بالكلام الفصيح شعراً ونثراً وسجعاً:
لساني بالنثر وبالقوافي وبالأسجاع أمهر في الغياص
من الحوت الذي في لج بحر يجيد السبح في لحج المغاص
إذا ما باص لاح بصفحتيه وبيص في المكر وفي المحاص
تلاوص في المداص ملاوصات له ملصى دواجن بالملاص
بنات الماء ليس لها حياة إذا أخرجنهن من المداص
في الصورة الأخيرة “بنات الماء” ما يستدعي التوقف عند معنى نطرحه على سبيل التخمين لا الجزم:
إذا كان خروج السمك من الماء يهدده بالهلاك، فما صلة ذلك بالمعاني التي يخرجها اللسان من العقل؟ يبدو أن الشاعر أراد رصد اللحظة التي يتولد فيها المعنى ويكتسي الصورة الفنية. هذه اللحظة شديدة التوهج في الذهن، حيث تتقاذف خلايا الدماغ الفكرة أو جزءاً منها وهي في طور التكوين، وتظل تصقلها وتشكلها حتى تكتمل. فخلية تضبط المعنى، وأخرى ترسم الشكل، وثالثة تلون الخطوط، ورابعة تبث الحركة، فيصبح الذهن كله كخلية نحل دائبة النشاط. فحين ينتقل البيت من الذهن إلى اللسان، ويُلقى على مسامع الآخرين، يولد ويموت في آن واحد، كما تموت السمكة خارج الماء: يولد لأنه خرج من ذهن الشاعر، ويموت لأنه انقطعت صلته بالذهن القادر على تطويره وتعديله.
كثيراً ما يحاول الناقد الإمساك بالجوانب الفنية في النص، فيشرح المعنى ويحلل الصورة ويستشعر العاطفة ويتذوق الإيقاع ليكشف أسرار الجمال وينقلها إلى الآخرين، وهو في ذلك يقضي على العمل الفني كما يقضي الصياد على السمكة حين يحاول الإمساك بها ونقلها، فتتملص منه وتقفز لتنجو، وهيهات:
إذا قبضت عليه الكف حيناً تناعص تحتها أي انتعاص
وباص ولاص من ملصى ملاص وحوت البحر أسود ذو ملاص
أما الصورة الثانية فهي صورة السحاب وهو يتحول من قطن منفوش إلى سحب كثيفة. وما يهمنا أن نلج ذهن الشاعر الجاهلي ونراقب حركات ذهنه وهو يصنع الجمال، ولا يهمنا أن يكون بعض النص منسوباً إلى أوس بن حجر، بل يعنينا الاستمتاع بتحليل هذا العمل الفني كما يستمتع الغواص باستخراج الكنوز والنفائس.
تخيل الشاعر جالساً في ركن خيمته، والسحابة الكثيفة في بداية تشكلها، والبرق يضيئها بين حين وآخر بخيوط تشق جوفها المظلم، وأطراف السحابة المتدلية في السماء تكاد تلامس الأرض، حتى إن الإنسان ليستطيع أن يمسك بأذيالها الشبيهة بالشعر الأشيب:
يا من لبرق أبيت الليل أرقبه من عارض كبياض الصبح لماح
دان مسف فويق الأرض هيدبه يكاد يدفعه من قام بالراح
ثم انهمر المطر بعد رعد قاصف وبرق خاطف، فكان لانهماره صوت خشن وجريان يكتسح الأرض وينثر الحجارة، وكان للبرق الذي يشق بطن السحاب خطف وكشف: خطف يخطف الأبصار، وكشف يكشف بياض الغيم كأنما يكشف الجواد الأبلق عن بياض جنبه وإبطه عند العدو:
ينزع جلد الحصى أجش مبترك كأنه فاحص أو لاعب داح
كأن ريقه لما علا شطباً أقراب أبلق ينفي الخيل رماح
لم يخفت قصف الرعد، بل زمجر في أعلى السحابة، فاهتز ذيلها وعجز عن حمل الماء الثقيل فانسكب. ولم يتوقف البرق عن الاشتعال، وكلما اشتعل خُيل للشاعر أن السحابة كأستار بيضاء منسدلة على الأفق، وكأنه يرى نوقاً ضخمة تركض مذعورة بين السماء والأرض. وعندما يدوي الرعد تهتز جنبات السحب بصوت مهيب، كأنها أشداق النوق وهي ترغو وتشقشق وترعى فصالها وتدعوها للتجمع في أرض آمنة:
فالتج أعلاه ثم ارتج أسفله وضاق ذرعاً بحمل الماء منصاح
كأنهما بين أعلاه وأسفله ريط منشرة أو ضوء مصباح
كأن فيه عشاراً جلة شرفاً شعثاً لهاميم قد همت بإرشاح
بحاً حناجرها هدلاً مشافرها تسيم أولادها في قرقر ضاحي
فن الرثاء:
رثاء عبيد نوع من الفخر، نظم معظمه في رثاء أشراف بني أسد، وحق له أن يرثي ولهم أن يُرثوا. فقد عمر الرجل طويلاً، تجعله الروايات المبالغ فيها ثلاثة قرون، بينما التقدير المعقول تسعون سنة. في هذا العمر المديد شهد الشاعر أبطالاً يقاتلون فيُقتلون، وأمجاداً تُشاد فوق أمجاد، وعزائم ومكاسب، ومنتصرين ومنهزمين، ثم رحل هؤلاء وبقي الشاعر شيخاً، فبكاهم وحزن على أشرافهم الذين سامروه في الخيام العالية، وسقوه الخمر بالأقداح الممتلئة، وتذكر أغنامهم وإبلهم وخيولهم العربية الأصيلة وأسلحتهم المعدة للقتال، فقال:
يا عين فابكي ما بني أسد فهم أهل الندامه
أهل القباب الحمر والنعم المؤيل والمدامه
وذوي الجياد الجرد والأمل المثقفة المقامه
وربما اجتاحته الذكرى فغلبته وذهبت بصبره، فاستسلم قلبه للحزن المؤلم وعينه للدمع المنهمر، فكأن عبراته نهر يسقي الحقول:
تذكرت أهلي الصالحين بملحوب فقلبي عليهم مالك جد مقلوب
تذكرتهم ما إن تحف مدامعي كأن جدول يسقي مزارع مخروب
الحكمة:
الحكمة كالرثاء، يزيدها طول العمر عمقاً وصدقاً، ويمنحها التمرس بالتجارب واقعية وإنسانية. وعبيد كغيره من معمري الجاهلية، شغلته قضية الحياة والموت، فربط بها كثيراً من تأملاته، واستنبط منها فروعاً ذهب بأكثرها مذهب التشاؤم. فخاف من زوال النعم، وتوقع الفشل وضياع المكاسب، وحيرته رحلة الناس في قافلة الموت التي تمضي ولا تعود:
فكل ذي نعمة مخلوسها وكل ذي أمل مكذوب
وكل ذي إبل موروثها وكل ذي سلب مسلوب
وكل ذي غيبة يؤوب وغائب الموت لا يؤوب
وقادته حكمته إلى أن كل خطوة يخطوها الإنسان في الحياة تقربه من قبره ذراعاً، فعلى الإنسان أن يدخر العمل الصالح ويتجنب الإساءة، لأن الجسد فانٍ والذكر باقٍ:
يا عمرو ما طلعت شمس ولا غربت إلا تقرب آجال لميعاد
الخبر يبقى وإن طال الزمان به والشر أخبث ما أوعيت من زاد
وعلمته التجارب الاعتماد على الاختبار وتجنب الحكم المتسرع، فهو لا يمدح أحداً ولا يذمه إلا بعد اختباره واستكشاف معدنه:
ولا تظهرن ود امرئ قبل خبره وبعد بلاء المرء فاذمم أو احمد
وثبت له أن خطأ الحاكم أخطر من خطأ المحكوم، فليكن الأمير حذراً بصيراً، وليحتكم إلى عقله في إدارة شؤون الرعية:
والناس يلحون الأمير إذا غوى خطب الصواب ولا يلام المرشد
على هذا النحو صاغ عبيد خلاصة تجاربه في أبيات واضحة المعاني سهلة اللغة مألوفة الصور، فحُفظت عنه وتناقلتها الأجيال.
مكانته وسماته الفنية:
ذكرنا سابقاً أن صاحب الطبقات صنف عبيد بن الأبرص في الطبقة الرابعة من الشعراء ثاني أربعتها، وأشار إلى ما في شعره من اضطراب وشهرة، لكنه لم يوضح هذه الإشارات السريعة توضيحاً كافياً. ونحن رغم تقديرنا لهذا الرأي، لا نأخذ بالتصنيف الذي اعتمده ابن سلام نفسه عند دراسة الشعراء ونقدهم، لأنه لم يدعم كثيراً من آرائه بحجج كافية، ولأن معايير التصنيف التي استند إليها لم تكن قواعد نقدية ثابتة يسهل تطبيقها على الشعراء.
وقد حاول أستاذنا الدكتور حسين نصار النظر إلى شعر عبيد بعين الناقد المؤرخ الذي يربط الظواهر الأدبية بأزمنتها، وأن يمنح الشاعر المكانة التي يستحقها على هذا الأساس، فقال: لعبيد مكانة خاصة لها أهميتها من عدة وجوه: من الوجه الفني لموقعه بين شعراء الجاهلية، ولكونه مرحلة انتقالية بين الشعر البدائي الذي لم تتحكم فيه القيم الفنية ولم تطبق عليه القواعد الشعرية، وبين الشعر الناضج الذي نعرفه. ومن الوجه التاريخي إذ يلقي شعره عدة أضواء على أحداث شبه الجزيرة العربية في عصره. والعجيب أن نجد القدماء من الأدباء واللغويين قليلاً ما يرجعون إلى شعر عبيد ويستشهدون به في أبحاثهم، حتى لا نجد له ما نجد لمعاصريه من الجاهليين فيما بين أيدينا من كتبهم. ولعل سبب ذلك الاضطراب الذي ساد كثيراً من شعره، لعدم سيره وفقاً للقواعد الشعرية.
هذا الكلام يفتح لنا نافذة نطل منها على السمات الفنية في شعر عبيد، وهي:
١- الاضطراب:
وصف النقاد القدماء والمحدثون شعر عبيد بالاضطراب، وهم لا يقصدون الخروج على قواعد اللغة والنحو، بل يقصدون اختلال الوزن. ومن يطالع ديوانه كاملاً لا تتضح له هذه الظاهرة إلا في المعلقة وبعض المقطوعات. أما القسم الأكبر من أبحره فبعضها تام وبعضها مجزوء أو مرفل. ونحن لا نستبعد أن تكون المعلقة سليمة البناء، وأن الخلل الطارئ عليها شكل من أشكال التصحيف وعبث الرواة والنقلة. وقد يستهجن القارئ عيوباً فنية في عروض عبيد كاستخدام حروف روي صعبة من طاء وصاد وزاي، وكتكرار كلمة القافية في أبيات متتالية وهو ما يسميه العروضيون الإيطاء، من ذلك على سبيل المثال إعادة كلمة (مغاص) في وصف الحوت الذي مر ذكره. وعذره أن هذا العيب كان شائعاً في شعر غيره كشيوعه في شعره.
٢- الموسيقى الداخلية:
في شعر عبيد إيقاعات صوتية لا تُقاس بتفعيلات العروض، وتتمثل في توازن الجمل. وهذه الخاصية تنقض سابقتها وتدحض حكم النقاد على عبيد. وهي دليل على التأني والإتقان وجودة الصنعة، كقوله في وصف السحابة: بحاً حناجرها، هدلاً مشافرها. وقد تتحول هذه الصنعة إلى مبالغة تثير الضحك لا الإعجاب كقوله في وصف الحوت: وباص ولاص من ملص ملاص.
لكن مثل هذه التراكيب قليلة في شعر عبيد بل نادرة، وهي تتصل بغرابة القافية وتكشف عن لعب فني لا عن الموهبة الحقيقية.
أما الموهبة الحقيقية فتظهر في التناسق بين الألفاظ والمعاني، وفي تطويع الإيقاع لمشاعر النفس، وتسخير الموسيقى لخدمة الأفكار. ويكفيك أن تقرأ ما قاله عبيد في ختام المعلقة وهو يصف عقاباً تنقض على ثعلب تحاول اصطياده. اقرأ الأبيات وانظر كيف تحولت حركات الثعلب والعقاب إلى موسيقى تربط الأفكار بالمشاعر والحس بالإيقاع، فتحس ما في قلوبهم وأنت تصغي إلى معركتهم. قال عبيد:
فدب من رأيها دبيباً والعين حملاقها مقلوب
فأدركته فطرحته والصيد من تحتها مكروب
فرنحته ووضعته فكدحت وجهه الجيوب
٣- خصوبة الخيال:
في خيال عبيد خصوبة واضحة، وصور تتفجر حيوية وحركة، وحركاته تتوالى بشكل متواصل ومتوتر. ولعل أجمل ما يعجبك في تصويره التتبع الدقيق لتفاصيل الموصوف، وتسجيل الأجزاء الدقيقة منه بأسلوب شديد الوضوح والواقعية، وفي وصف السحاب الذي ذكرناه سابقاً تأكيد لما نزعم.
٤- رقة الأحاسيس:
تنبعث من شعر عبيد مشاعر رقيقة شفافة، تدل على نفس مرهفة حساسة، وتكشف عن تعاطف الشاعر مع كل كائن حي. فقد قيل: إنه كان يُشرك الحيوان فيما يملك ويرفق به عند ملاقاته، فيسقي الحية العطشى ويتبعها بنظرات حانية رحيمة. ونستطيع أن نستشعر هذه الروح منبعثة من صوره، كقوله في وصف الظباء وهي تحنو على صغارها، والشاعر مأخوذ بما يشاهد يراقب الكبار بمثل ما يراقب الصغار من شفقة حانية:
وظباء كأنهن أباريق لجين تحنو على الأطفال
وتستطيع أن تستشعر هذه الشفقة الحانية في حبه للإبل، إذ يقرن الإبل بالشباب ويدعو لها وللشباب دعاء المحب للمحبوب:
در در الشباب والشعر الأسود والراتكات تحت الرحال
وتفوح هذه الروح من هديل حمامة أصغى إليها الشاعر فأبكته، إذ ظن أنها حزينة مثله لفراق الحبيب:
وقفت بها أبكي بكاء حمامة أراكية تدعو الحمام الأواركا
إذا ذكرت يوماً من الدهر شجوها على فرع ساق أذرت الدمع سافكا