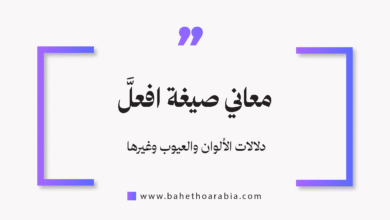النسب (النسبة) في العربية: قواعد القياس والسماع وتطبيقاتها على الأبنية المختلفة

تتبوّأ دراسة النسب (النسبة) مكانة مركزية في الدرس الصرفي العربي، لأنها تكشف آليات توليد الصفات والانتسابات من الأسماء، وتضبط الصيغ القياسية التي تُبنى عليها النعوت في سياقات النسبة والانتساب. فالنسب (النسبة) ليس مجرّد إضافة ياء مشدّدة وكسر ما قبلها، بل هو منظومة قواعد دقيقة تتداخل فيها مباحث القلب والإبدال والحذف والإعلال، وتظهر من خلالها صلة الصرف بالدلالة والنحو والاستعمال.
يُبنى النسب (النسبة) على أسسٍ مضبوطة تُراعي بنية الاسم المنسوب من حيث كونه ممدوداً أو مقصوراً أو منقوصاً أو مركّباً أو مُعتلاً أو صحيحاً، ويُرتّب لكل حالةٍ حكمُها التفصيلي في صيغ اللاحقة وحركات ما قبلها وما يطرأ من تغييرات صوتية. وبهذا يتبدّى إطار النسب (النسبة) بوصفه نسقاً معيارياً فيه مواضع قياس مطّردة ومواضع سماعٍ محفوظة، بما يضمن اتساق القاعدة مع الاستعمال العربي الفصيح.
وتمييز النسب (النسبة) عن غيره من الظواهر المشابهة يعدّ ضرورة منهجية؛ فوجود الياء المشدّدة في آخر الكلمة لا يعني دائماً أننا بإزاء صيغة نسب، إذ قد تدل على مبالغةٍ اشتقاقية أو على مفردٍ من اسم جنسٍ جمعيّ أو على مصدرٍ صناعيّ. لذلك تُسعفنا ضوابط النسب (النسبة) في الفصل بين هذه الأبواب، وتحديد ما يدخل في قياس النسبة وما يخرج عنها، اتقاءً للبسٍ يُفضي إلى اضطرابٍ في الضبط أو الدلالة.
ويقدّم هذا العرض لباب النسب (النسبة) مسحاً منهجياً لأبوابه الجزئية: النسبة إلى ما فيه تاء مربوطة، وإلى الممدود، وإلى ما انتهى بألف أو بياء، وإلى ما كانت ياؤه مشدّدة قبل الآخر، وإلى ما حُذفت لامه أو فاؤه، وإلى الثنائي، وإلى الجمع، وإلى المركّب، وإلى صيغ فَعِيل وفُعَيْل ونظائرهما، وإلى فَعُولة، وإلى الثلاثي المكسور العين، إضافةً إلى صيغٍ تُؤدّي معنى النسب من غير ياءٍ صريحة، وإلى شواذّ السماع. وتتكامل هذه المحاور لتشكّل خريطةَ أنماط النسب (النسبة) التي يُحتاج إليها في القراءة والكتابة والتحقيق والتدريس.
ويعتمد تناول النسب (النسبة) على منهجٍ يجمع بين الضبط القياسي والتحفّظ السّماعي؛ إذ تُقدَّم القاعدة المطّردة مع بيان علّتها الصوتية والصرفية، ويُنوَّه بما خالف القياس حفظاً للسماع العربي الموثوق. ويقتضي ذلك دقّةً في التمثيل، وانضباطاً في المصطلح، وموازنةً بين مرونة الاستعمال والحفاظ على أصول الصياغة.
وتتجلّى أهمية النسب (النسبة) تطبيقياً في صناعة المعجم، وضبط النصوص التراثية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، وفي أعمال الترجمة والتحرير، وفي أدوات المعالجة الحاسوبية للغة التي تتطلّب توصيفاً صرفياً دقيقاً للأبنية واللواحق. ومن هنا فإن إحكام أدوات النسب (النسبة) يُعدّ عنصراً تأسيسياً في كفاءة التعبير العربي ودقّة توصيف المفاهيم والأعلام والجهات والانتماءات.
النسب
تعريفه: يُراد بـ النسب (النسبة) في العربية إلحاقُ ياءٍ مُشدَّدةٍ بآخر الاسم مع كسر ما قبلها، نحو: حلبي، دمشقي، حمصي، مصري، عراقي، وطنيّ. والاسمُ المنسوب يُستعمل وصفاً على نحوٍ يُشبه اسم المفعول؛ لاشتماله على معناه في باب النسب (النسبة)، فقولنا: هذا رجلٌ حلبي، معناه: هذا رجلٌ منسوب إلى حلب. وقد سبق أن الاسم المنسوب يعمل عمل اسم المفعول، فتقول: أخوك فلسفيٌّ رأيُه؛ فـ (رأيه) ٩ نائب فاعل للاسم المنسوب ضمن نظام النسب (النسبة).
والياء المشددة في آخر الاسم لا تدلّ دائماً على كون الاسم منسوباً؛ فقد تكونان زائدتين لغير باب النسب، نحو: كرسي. وإذا دخلتا على المشتق كانتا للمبالغة، نحو: رئيسيّ، دوّاريّ، أحمريّ. وإذا دخلتا على اسم الجنس الجمعي كانتا للدلالة على المفرد، نحو: عربي، رومي، تركي. وتكونان مع التاء للدلالة على المصدر الصناعي، نحو: ألوهيّة، محسوبية، حرية. ويُشار هنا إلى أن هذه الظواهر تُميّز بين باب النسب وباب الاشتقاق الصناعي في ضوء فروق دقيقة بين النسب (النسبة) والمبالغة والمصدر الصناعي في العربية.
طرائق النسبة
يتناول هذا القسم قواعد النسب وأحكام النسبة، ومظانّ النسب وأنماط النسبة، وصيغ النسب ومقاييس النسبة، وتفريعات النسب ومسائل النسبة، وشواذّ النسب واستثناءات النسبة؛ بما يقدّم خارطةً منهجية دقيقة لباب النسب (النسبة) في العربية.
١ـ النسبة إلى ما فيه تاء مربوطة
تحذف التاء المربوطة، ثم تُضاف ياء النسب المشددة، نحو: مكّي، شجريّ، فاطميّ، عاطفيّ، ثوريّ، بلاغيّ. وهذا الإجراء قاعدة مطّردة في باب النسب.
٢ـ النسبة على الممدود
- إذا كانت الهمزة للتأنيث أُبدلت واواً، نحو: حمْراء ـ حمراويّ، سوداء ـ سوداويّ، صحراء ـ صحراوي، كيمياء ـ كيميائيّ.
- وإذا وقعت قبل الألف واوٌ فإن الهمزة تثبت، نحو: حواء ـ حوائي، شعواء ـ شعوائيّ، وعشواءّ ـ عشوائيّ.
- وإذا كانت الهمزة أصلية ثبتت، نحو: ابتدائي، إنشائي، إنباتي، وبائيّ.
- وإذا كانت مبدلةً أو للإلحاق ثبتت، أو قُلبت واواً، إلا إذا كان قبل الألف واوٌ فإنها لا تُقلب واواً، نحو: كسائي وكساوي، اصطفائي واصطفاوي، انتقائي وانتقاوي، حربائي وحرباوي، هوائي، ولوائي، واستوائي، وانطوائي.
وهذه الأحكام من ضوابط النسب في العربية.
٣ـ النسبة إلى ما انتهى بألف
- إن كانت الألف ثالثةً قُلبت واواً، نحو: عصا ـ عصوي، فتى ـ فتوي، رِبا ت ربوي، رضى ت رضوي. والحكم نفسه إذا جاءت بعد الألف تاء التأنيث، نحو: حماه ـ حَمَوي، حياة ـ حيويّ، نواة ـ نوويّ.
- إذا كانت الألف رابعة، والحرف الثاني ساكناً، جاز ثلاثة أوجه، هي:
١ـ قلب الألف واواً، نحو: حُبْلى ـ حُبْلَويّ، ملهى ـ ملهوي، عِيْسى ـ عِيْسَويّ، موسى ـ مُوسَويّ.
٢ـ حذفها: نحو: حُبْليّ، ملهيّ، عِيْسيّ، مُوسِيّ.
٣ـ قلب الألف واواً، وزيادة ألف قبل الواو، نحو: حُبْلاويّ، ملْهاويّ، عِيْساوي، مُوساويّ. - فإن كان بعد الألف تاء التأنيث وجب قلبها واواً، نحو: مأساة ـ مأساوي، مَلْهاة ـ ملهاوي، مِصفاة ـ مِصفاويّ.
- إذا كانت الألف رابعة، والحرف الثاني ساكناً، أو كانت خامسة أو سادسة حُذفت، نحو: بَرَدى ـ بَرَدِيّ، سُمَانى ـ سُماني، شنفرى ـ شنفري، مصطفى ـ مصطفيّ، مستشفى ـ مشتشْفِي.
وهذا من أصول النسب (النسبة) في الأبنية المعتلّة.
٤ـ النسبة إلى ما انتهى بياء
- إذا كان الاسم المنقوص ثلاثياً مثل: الشجيّ، والحميّ، قُلبت الياء واواً، وفُتح ما قبلها، نحو: الشَجَويّ، الحَمَوي.
- وإذا كانت الياء رابعة حُذفت الياء، وجاز قلبها واواً، نحو: الثاني ـ الثانيّ أو الثانوي، الماضي ـ الماضيّ أو الماضوي، السامي ـ الساميّ أو الساموي. فإذا كان بعدها تاء التأنيث وجب قلبها واواً، نحو: تربية ـ تربوي، تصفية ـ تصفوي.
- وإذا كانت الياء فوق الرابعة حُذفت، نحو: المعتدي ـ المعتديّ، المهتدي ـ المهتديّ، المستعلي ـ المستعليّ. وكذلك إذا كانت بعدها تاء التأنيث، نحو: إسبانيا ـ إسبانيّ، انطاكيا ـ إنطاكيّ.
- إذا كان آخر الاسم ياء قبلها ساكن، فإن هذه الياء تثبت، ثم تُضاف ياء النسب المشددة، نحو: ظبْي ـ ظبْيِيّ، رَمْي ـ رَمْيِيّ. وكذلك الأمر إذا كان بعدها تاء التأنيث، نحو: ظبية ـ ظبييّ. وأجاز بعضهم قلبها واواً، نحو: قَرْيَة ـ قَرَويّ. فإن كان ما قبل الياء ألفاً قُلبت الياء همزة، نحو: زاري ـ زارئيّ. وكذلك الأمر إن جاء بعد الياء تاء مربوطة، نحو: غاية ـ غائيّ، وقاية ـ وقائيّ، نهاية ـ نهائيّ.
- إذا كانت الياء مُشدّدة، وكان قبلها حرفٌ واحد قُلبت الياء الثانية واواً، وعادت الأولى إلى أصلها اليائي أو الواوي، نحو: طيّ ـ طوَوِيّ؛ لأن الأصل طوى، وأصل طوى هو طوَوَ. وتقول في النسب إلى حيّ: حيوي؛ لأن الأصل حيِيَ. وكذلك الأمر إن كان بعدها تاء التأنيث.
- وإذا كانت الياء المشددة بعد حرفين وجب حذف الأولى، وقلب الثانية واواً، نحو: عليّ ـ علويّ، عديّ ـ عدويّ، نبيّ ـ نبوي، قُصَي ـ قصويّ. وكذلك الحكم إن كان بعدها تاء التأنيث، نحو: أميّة ـ أمويّ.
- وإذا كانت الياء المشددة بعد ثلاثة أحرف أو أكثر حُذِفتْ، نحو: كرسيّ، مهديّ، مرضيّ، شافعيّ؛ فالنسبة إليه بلفظه من غير تبديل، وذلك على تقدير حذف الياء المشددة، وإلحاق علامة النسب.
وهذه تفاصيل من مسائل النسب في الأسماء المعتلة.
٥ـ النسبة إلى ما كانت فيه الياء المشددة قبل الآخر
نحو: طيِّب، ميِّت، هيِّن، مبيّن، معين.
- إن كانت الياء المشددة مكسورة حُذفت الياء الثانية المتحركة، وبقيت الأولى ساكنة، نحو: طَيْبِي، هَيْنِي، مَيْتِي.
- وإن كانت الياء المشددة مفتوحة فلا حذف، نحو: مبيّني، مُعَيّنيّ.
وهذا تفصيل يدخل في أبواب النسب (النسبة).
٦ـ النسبة على ما حُذفت لامه
في العربية كلمات حُذفت لامُها، نحو: يد، وأب، وأخ، وفم، ودم، ولغة، وابن، واسم، … وقسم من هذه الكلمات تعود إليه اللام في التثنية والجمع السالم، نحو: أبوان، أخوان، أخوات، سنوات. وقسمٌ لا تعود إليه اللام، نحو: يدان، دمان، فمان.
وتُردّ اللام في النسب وجوباً إذا رُدّت في التثنية أو الجمع، ويجوز ردّها أو عدمه إذا كانت لا تُردّ في التثنية أو الجمع، نحو: أب ـ أَبَويّ، أخ ـ أخويّ، دم ـ دَمِيّ أو دَمَوي، فم ـ فِمِي أو فَمَويّ، لُغَة ـ لُغِي أو لغويّ.
ولا يجوز الجمع بين العِوَض والمحذوف المُعوّض عنه؛ فتقول: اسم ـ سِمَوِيّ أو اسميّ، وابن ـ بنوي أو ابني، وفي أخت ـ أختيّ أو أخوي.
وهذه القاعدة من معايير النسب الدلالية والصرفية.
٧ـ النسبة إلى ما حُذفت فاؤه
لا تُردّ فاء الكلمة إذا كانت لامُها حرفاً صحيحاً، نحو: عِدة ـ عِدِي، صفة ـ صفيّ، زنة ـ زنيّ. وتُردّ إن كانت اللام حرف علة، نحو: شية ـ شَويّ.
وهذا من ضوابط النسب في الأجوف والمثال.
٨ـ النسبة على الثنائي
إذا سُمّيتَ بالثنائي ونسبتَ إليه ضُعّفت ثانيته، نحو: لو ـ لوّيّ، عن ـ عنّي. فإذا كان آخره لا يُضعّف زِدتَ همزةً أو واواً، نحو: لا ـ لائيّ أو لاويّ.
وهذه من طرائق النسب في الأسماء الثنائية.
٩ـ النسبة إلى الجمع
إذا أُريد النسب إلى جمع التكسير رُدّ إلى المفرد ونُسب إليه، نحو: بساتين ـ بُستاني، حُقول ـ حَقْليّ. فإذا نُقل الاسم المجموع إلى العلمية فإنه يُنسب إليه على صيغته، نحو: المدائن ـ المدائنيّ، الأنصار ـ الأنصاريّ، الجزائر ـ الجزائريّ. وكذلك ما يُشبه الاسم العلم، نحو: فرائض ـ فرائضي، شعوب ـ شعوبي. وما هو جمعٌ لا مفرد له من لفظه، نحو: نساء ـ نسائيّ، أبابيل ـ أبابيليّ. وما يتغيّر معناه إذا نُسب إلى مفرده، نحو: أعراب ـ أعرابي.
وأجاز مجمع اللغة بالقاهرة، والكوفيون قبله، النسب إلى جمع التكسير، نحو: الملوك ـ الملوكيّ، الثعالب ـ الثعالبيّ، الكتب ت الكتبيّ، فضول ـ فضوليّ.
وهذه مسائل تدخل ضمن أحكام النسب (النسبة) في الجموع.
١٠ـ النسبة إلى المركب
يُنسب إلى صدر المركب ويُحذف الباقي، نحو: نأبط شراً ـ تأبطيّ، رام الله ـ راميّ، بعلبك ـ بعليّ، عبد الله ـ عبدي، امرؤ القيس ـ امرئي أو مَرَئي. فإن كان الاسم مصدّراً بـ (ابن)، أو (أبو) أو (أم)، أو خِيف اللبس في النسب إلى صدره، نُسب إلى عجزه، نحو: أبو بكر ـ بكري، ابن عباس ـ عباسيّ، أم كلثوم ـ كلثومي، عبد مناف ـ منافيّ، شمس ـ شمسيّ.
وهذا الضرب من النسب يعتني بدفع اللبس وتحقيق الدلالة.
١١ـ النسبة إلى الاسم الذي فيه ياء زائدة بعد عينه: (فَعِيل وفَعِيلة، وفُعَيْل وفُعْيَلَة)
آـ تُحذف التاء مما آخره تاء.
بـ تُحذف الياء من فَعيْل وفُعيْل إذا كانت اللام حرف علة، وتُقلب حركة العين فتحة، وتُقلب الياء الباقية واواً، نحو: عَديّ ـ عَدَويّ، قُصَيّ ـ قُصويّ، غني ـ غَنَويّ، عَليّ ـ عَلَويّ، لُؤَيّ ـ لُؤَويّ. أمّا إذا كانت اللام صحيحة فلا تُحذف، نحو: عقيل ـ عقيليّ، نُمّيْر ـ نُميريّ، سليم ـ سَليميّ، كريم ـ كريميّ. وشذّ قولهم: ثقيف ـ ثقفي، قُريش ـ قريشيّ، هُذَيل ـ هذلي.
جـ تُحذف الياء من (فعِلة) و(فُعَيْلة)، وتُقلب كسرة العين فتحة إذا لم يكن الاسم مُضاعفاً (عينه ولامه متماثلان)، أو إذا لم تكن عينه حرف عِلّة، نحو: ربيعة ـ رَبَعيّ، حنيفة ـ حَنَفي، قبيلة ـ قبليّ، كنيسة ـ كنسيّ، جهينة ـ جهنيّ، أميّة ـ أُمويّ، قُرَيظة ـ قُرَظي. أمّا إذا كان الاسم مُضاعفاً فلا حذف، نحو: شديدة ـ شديدي، مديدة ـ مديديّ. وكذلك إذا كانت عينه حرف عِلّة، نحو: طويلة ـ طويلي، نُوَيرة ـ نويريّ، عيينة ـ عُيَيُنيّ. وشذّ قولهم: طبيعة ـ طبيعيّ، بَديهة ـ بديهيّ، سَلِيْقة ـ سَليقيّ، رُديْنة ـ رُدينيّ، حنيفة ـ حنيفيّ.
وهذه أبواب تفصيلية من صميم النسب (النسبة).
١٢ـ النسب إلى (فَعُوْلة)
تُحذف الواو، وتُقلب ضمّة العين فتحة إذا كان الاسم صحيح العين ولم تكن عينه ولامه متماثلتين، نحو: شَنُوءة ـ شَنَئِي، ركوبَة ـ رَكَبيّ، حَلُوبة ـ حَلَبيّ. أمّا النسب إلى بيوضة فهو بيوضيّ؛ لأن العين حرف عِلّة، والنسب إلى ملولة هو ملوليّ؛ لأن العين واللام حرفان متماثلان.
ويُعدّ ذلك من تطبيقات النسب على الأبنية المزيدة.
١٣ـ النسبة إلى الثلاثي المكسور الثاني
تُقلب الكسرة في الاسم المنسوب فتحة، نحو: نَمِر ـ نَمَريّ، مَلِك ـ مَلَكيّ، إبِل ـ إبَليّ، مَعِدَة ـ مَعَديّ.
وهذا من سنن التخفيف في باب النسب (النسبة).
١٤ـ النسبة بلا ياء
تدلّ صيغ فاعل، وفَعّال، وفَعِل، على معنى الاسم المنسوب، نحو: تامر (أي ذو لبن وتمر)، وحائك (منسوب إلى الحياكة)، ونجّار، وحلّاق، وحدّاد، وصبّاغ؛ أي منسوب إلى النجارة أو الحلاقة أو الحدادة أو الصباغة. وتقول: أخوك طَعِمٌ لَبِسٌ؛ أي هو ذو طعامٍ حسن ولباسٍ حسن. وهذه الصيغ تقوم بوظيفة النسب من غير علامةٍ صريحة للنسبة.
١٥ـ شواذ النسب
سُمع عن العرب ما يخالف القواعد السابقة، فيُحفَظ ولا يُقاس عليه؛ لأنه يُعدّ من شواذِّ النسب، نحو: دَهْر ـ دُهري، بَصْرَة ـ بِصريّ، الريّ ـ الرّازي، مرو ـ مروزيّ، بحرين ـ بحراني، شام ـ شآمٍ، تهامة ـ تَهَامٍ، يَمَن ـ يمانٍ، البادية ـ بَدَويّ، حروراء ـ حَرُوريّ، فوق ـ فوقانيّ، تحت ـ تحتاني ـ يمن ـ يَمَان.
وبذلك يتّضح النسق العام لباب النسب وأطراف النسبة في العربية، مع ضبط مواضع القياس ومواضع السماع، وكلّها داخلةٌ في نظام النسب (النسبة) المعياري.
السؤالات الشائعة
١) ما المقصود بـ النسب (النسبة) في العربية، وما حدوده الدلالية والصرفية؟
النسب (النسبة) في العربية عملية صرفية تُشتقّ بها صفةٌ نسبية من اسمٍ جامد أو مشتق، بإلحاق ياء مشددة في آخره مع كسر ما قبلها غالباً، للدلالة على معنى الانتماء والاتصال والملابسة، كقولنا: مصريّ، عربيّ، فلسفيّ. وتعمل هذه الصفة عمل الصفات في الإعراب فتقبل المطابقة والجر بالحرف، وقد تعمل عملاً خاصاً يشبه عمل اسم المفعول كما في نحو: أخوك فلسفيٌّ رأيه، أي: رأيه متّصف بالفلسفة. ويتميّز النسب (النسبة) دلالياً عن الصفات النوعية أو الكيفية؛ إذ تفيد صفة النسب علاقةً موضوعية بموصوفها: بلد، قبيلة، علم، حرفة، مذهب، فن، زمان، مكان، أو مادة. أمّا صرفياً، فالنسب (النسبة) يخضع لقواعدٍ دقيقة تتعلّق ببنية الاسم المنسوب: الممدود، المقصور، المنقوص، ذوات الياء أو الألف أو الهمزة، الأسماء المحذوفة اللام أو الفاء، المركّبات والجموع، ونحو ذلك. ويُفصل في كل بابٍ أحكام القلب والإبدال والحذف وردّ المحذوف وفق عللٍ صوتية وصرفية. وتبقى لبعض الصيغ أحكام سماعية تُحفظ ولا يُقاس عليها. بهذا يتحدد نطاق النسب (النسبة) بكونه نسقاً قياسياً أساساً، مع مراعاة مستثنيات السماع، ومراعاة التمييز بين صيغ النسب، وصيغ المبالغة، والمصدر الصناعي، وصيغ المفرد من اسم الجنس الجمعي.
٢) كيف نميّز بين ياء النسب وياء المبالغة أو المصدر الصناعي أو المفرد من اسم الجنس الجمعي؟
الفصل بين هذه الأبواب ضرورة منهجية في باب النسب (النسبة). يمكن اعتماد اختبارات عملية:
- اختبار الإبدال الدلالي: إذا أمكن إحلال تركيب “منسوب إلى …” محل الصفة مع استقامة المعنى، فالأصل أنها نسب (النسبة): رجل حلبيّ = رجل منسوب إلى حلب. أمّا “ألوهيّة، حرّية، محسوبية” فهي مصادر صناعية لا يصح فيها هذا الإبدال.
- اختبار الصيغة: المصدر الصناعي يُلحَق عادةً بياء وتاء مربوطة (ـيّة) للدلالة على مفهومٍ مجرّد (مدنية، قومية)، بينما النسب (النسبة) صفة منتهية بياء مشددة من غير تاء (مصريّ، عربيّ).
- اختبار الوظيفة النحوية: صفة النسب تجري مجرى النعوت في الإعراب وقد تعمل عمل اسم المفعول على قلة، نحو: أخوك فلسفيٌّ رأيه. أمّا صيغ المبالغة فغالباً تصف كثرة الفعل (رحيميّ، عطوفيّ) ولا تؤدّي معنى الانتماء.
- اختبار الدلالة المعجمية: يرد “عربي، تركي، رومي” للدلالة على المفرد من اسم الجنس الجمعي، وليس المقصود به النسب (النسبة) الصناعي، وإن وافق هيئة النسب صوتياً.
- اختبار الاستعمال القياسي والسماعي: بعض الألفاظ رُوعي فيها السماع على القياس، فينبغي الرجوع إلى المعاجم والمجامع. بهذه الضوابط يُحافَظ على نقاء دلالة النسب (النسبة) من الالتباس مع الأبواب القريبة.
٣) ما القواعد العامة لمعالجة الهمزة والألف والياء في صيغ النسب (النسبة)؟
يعتمد باب النسب (النسبة) على علل صوتية وصرفية تضبط تحوّلات الهمزة والألف والياء:
- الهمزة في الممدود:
١) إذا كانت للتأنيث قُلبت واواً: حمْراء → حمراويّ، صحراء → صحراويّ.
٢) إذا كانت أصلية ثبتت: ابتدائي، إنشائي.
٣) إذا سُبقت واواً قبل الألف ثبتت: حواء → حوائيّ.
٤) الهمزة المبدلة أو للإلحاق تُثبت أو تُقلب واواً بحسب ما قبلها، ويُستثنى ما قبل الألف من واو فلا تُقلب غالباً: كسائي/كساوي، اصطفائي/اصطفاوي. - الألف في المقصور:
١) إذا كانت ثالثة قُلبت واواً: عصا → عصوي، فتى → فتوي، حياة → حيويّ، نواة → نوويّ.
٢) إذا كانت رابعة مع سكون الثاني: ثلاثة أوجه (قلبها واواً، حذفها، أو قلبها مع زيادة ألف قبل الواو): حُبلى → حُبلاويّ/حُبْلَويّ/حُبْليّ. وإذا أعقبتها تاء التأنيث وجب قلبها واواً: مأساة → مأساويّ.
٣) إذا طالت البنية (رابعة مع بنية مخصوصة أو خامسة وسادسة) غلب الحذف مع صورٍ مشهورة: بَرَدى → بَرَديّ، مصطفى → مصطفيّ. - الياء في المنقوص والمشددة:
١) الثلاثي المنقوص يقلب ياءه واواً مع فتح ما قبلها: الشجيّ → الشجويّ.
٢) إذا كانت الياء رابعة يجوز حذفُها أو قلبُها واواً: الثاني → الثانيّ/الثانويّ، وتلزم الواو مع تاء التأنيث: تربية → تربويّ.
٣) إذا تكرّرت الياء وشُدّدت، نُظِر في موقعها: بعد حرفٍ واحد تُقلب الثانية واواً (طيّ → طوويّ)، وبعد حرفين تُحذف الأولى وتُقلب الثانية واواً (عليّ → علويّ).
هذه المبادئ إطارٌ عملي يُسترشد به عند إجراء النسب (النسبة).
٤) ما منهجية النسب (النسبة) إلى الجموع والمركّبات والأعلام، ومتى يُنسب إلى الصدر أو العجز؟
- الجموع: الأصل ردّ جمع التكسير إلى مفرده ثم إجراء النسب (النسبة): بساتين → بستانيّ، حقول → حقليّ. فإن نقل الجمع إلى العلمية نُسِب على هيئته: المدائن → المدائنيّ، الجزائر → الجزائريّ. ويُنسب إلى الجمع إذا لم يكن له مفرد من لفظه (نساء → نسائيّ)، أو إذا تغير المعنى بالنسب إلى مفرده (أعراب → أعرابيّ). وقد أجاز مجمع القاهرة والكوفيون قبلَه النسب إلى الجمع قياساً في صورٍ: الملوك → الملوكيّ، الثعالب → الثعالبيّ.
- المركّبات: القياس النسب (النسبة) إلى الصدر وحذف العجز: بعلبك → بعليّ، رام الله → راميّ. وإذا صُدّر بـ ابن/أبو/أمّ أو خيف اللبس نُسِب إلى العجز: أبو بكر → بكريّ، ابن عباس → عباسيّ، أم كلثوم → كلثوميّ، عبد مناف → منافيّ.
- الأعلام: تُراعى شهرة الاستعمال والسماع، وقد تُقدّم الدلالة على القياس دفعاً للبس. هذه المنهجية تضمن وضوح الإسناد الدلالي مع سلامة البنية في النسب (النسبة).
٥) ما أبرز الشواذ السمعية في باب النسب (النسبة)، وكيف نتعامل معها؟
الشاذّ السماعي هو ما خالف القياس في النسب (النسبة) واعتمدته العرب في الاستعمال، فيُحفَظ ولا يُقاس عليه. من ذلك: دهر → دهريّ، بصرة → بصريّ، الريّ → الرازي، مرو → مروزيّ، بحرين → بحرانيّ، شام → شآمٍ، تهامة → تهامٍ، يمن → يمانٍ/يمان، البادية → بدويّ، حروراء → حروريّ، فوق → فوقانيّ، تحت → تحتانيّ. التعامل المنهجي مع هذه الصور يكون عبر:
- التوثيق المعجمي: اعتماد الشواهد الموثوقة وشهرة الدوران.
- حفظ الصيغة كما وردت: عدم تسويتها بالقياس إن عارضت السماع.
- التنبيه التعليمي والتحريري: تمييز القياسي من السماعي منعاً للتعميم الخاطئ.
يُبرز هذا الباب أن النسب (النسبة) نسق قياسي في جوهره، لكنه يحتفظ بذاكرة سماعية يجب احترامها في التحقيق والضبط.
٦) ما الخطوات العملية المنهجية لاشتقاق صيغة النسب (النسبة) في التحرير اللغوي؟
يمكن اتباع مسارٍ إجرائي واضح:
١) تحديد نوع الاسم: هل هو ممدود، مقصور، منقوص، ذو همزة للتأنيث أم أصلية، مركّب، جمع، أو من ذوات المحذوف (ف/ل)؟
٢) تحليل البنية الصوتية: تعيين مواقع الألف/الياء/الهمزة وسكون الثاني، وتشديد الياء، وجود تاء مربوطة.
٣) اختيار قاعدة التحويل: تطبيق حكم الباب المناسب (قلب، حذف، ردّ، زيادة ألف قبل الواو عند لزومها).
٤) فحص اللبس: إن أدّى النسب (النسبة) إلى لبسٍ دلاليّ في المركّبات أو الأعلام، فلتُقدّم النسبة إلى العجز.
٥) الموازنة بين الأوجه: عند تعدّد الصيغ (الثانيّ/الثانويّ) يُختار الأفصح أو الأشيع أو ما يوافق السياق الاصطلاحي.
٦) التحقق الكتابي والصوتي: ضبط الشدّة والكسرة قبل ياء النسب، والهمزة رسماً (إثباتاً/قلباً)، ومراجعة القاعدة القياسية مقابل السماع.
هذا البروتوكول يجعل إجراء النسب (النسبة) قابلاً للتعميم في التحرير، ويقلّل من الأخطاء الناشئة عن الخلط بين الأبواب المتقاربة.
٧) ما الأخطاء الشائعة في النسب (النسبة) وكيف تُعالَج؟
- إبقاء التاء المربوطة: الصواب حذفها قبل ياء النسب: بلاغة → بلاغيّ لا “بلاغتيّ”.
- الخلط بين النسب والمصدر الصناعي: “مدنيّة” مصدر صناعي، أمّا الصفة النسبية فهي “مدنيّ”.
- سوء معالجة الهمزة في الممدود: صحراء → صحراويّ لا “صحراييّ”.
- اضطراب المقصور: حياة → حيويّ، نواة → نوويّ، لا “حياتيّ” في الدلالة العامة.
- المنقوص والمشدّد: عليّ → علويّ لا “عليّي”، الشجيّ → الشجويّ لا “الشجيّي”.
- الجمع والمركّب: ردّ جمع التكسير إلى مفرده عند القياس: بساتين → بستانيّ، وتقديم العجز دفعاً للبس في: أبو بكر → بكريّ.
- إهمال السماع: الريّ → الرازي، فوق → فوقانيّ.
المعالجة تكون بالرجوع إلى قواعد الباب، واستحضار علل القلب والحذف، وتحرّي الشيوع في الأوجه الجائزة، والاحتكام إلى المصادر الموثوقة في الشواذ. هذا يضمن نقاء الدلالة وانسجام البنية الصوتية في النسب (النسبة).
٨) كيف يعمل الاسم المنسوب في الجملة، وما حدود شبهه باسم المفعول؟
الاسم المنسوب صفة نسبية تجري مجرى النعوت في المطابقة والوظيفة الإعرابية، وقد يُلحظ فيه شبهٌ باسم المفعول من جهة المعنى والقدرة على العمل في بعض التراكيب، كما في: أخوك فلسفيٌّ رأيه؛ فـ “فلسفيّ” صفة نسب، و“رأيه” نائب فاعل سدّ مسدّ معمولٍ لاسم منسوب مؤوّل بمعنى “مفعولٌ به للفلسفة” أي متّصف بها. هذا العمل ليس مطّرداً على إطلاقه كعمل اسم الفاعل أو المفعول، بل يُلحظ في التركيبات المستقرّة دلالياً التي يكون فيها المنسوب أصلاً لمعنى يَقبل الإسناد؛ كقولك: الثوب قُطنيٌّ نسجه، القرار وزاريٌّ صدوره، البحث العلميّ منهجه. الضوابط العملية:
- لا يعمل الاسم المنسوب إلا إذا دلّ على نسبةٍ تقوم مقام معنى الوصف القابل للإسناد.
- يغلب أن يكون معموله معرفةً مضافةً إلى الضمير أو معرّفةً بسياقٍ سابق.
- يبقى الأصل في النسب (النسبة) أن يكون نعتاً، والعمل بابٌ تابع يقدَّر بقدره.
هذا التصور يُحافظ على الفارق بين صفة النسب (النسبة) والاشتقاقات العاملة، ويمنع التوسّع غير المنضبط.
٩) ما تطبيقات النسب (النسبة) في المعاجم وتعليم العربية واللسانيات الحاسوبية؟
- المعاجم: ضبط مداخل النسب (النسبة) يقتضي بيان القياسي والسماعي، وتوثيق الأوجه مع الإحالات بين الأصل والمنسوب، وإبراز الفروق بين النسب، والمصدر الصناعي، والمبالغة.
- التعليم: يُوفَّق بين القاعدة والتمرين التطبيقي على أبواب الممدود والمقصور والمنقوص والمركّب والجموع، مع تمارين قرارٍ (Decision Tasks) تفرّق بين الأبواب المتشابهة.
- التحرير والترجمة: يضمن النسب (النسبة) توحيد المصطلحات: اقتصاديّ، سياسيّ، لغويّ، بنكيّ، مع مراعاة الأسماء الأعجمية عبر التعريب ثم إجراء النسب.
- اللسانيات الحاسوبية:
١) بناء قواعد توليد آلي (Finite-State Morphology) تُراعي قواعد القلب والحذف.
٢) تعليم نماذج التعرّف الصرفي على وسم nisba=Yes مع سمات الأصل (ممدود/مقصور/منقوص).
٣) استخراج الكيانات والصفات العَلَمية (NER) باستثمار صيغ النسب (النسبة) للإسناد الجغرافي والمؤسسي.
٤) التطبيع الإملائي لياء النسب والهمزات.
هذه التطبيقات تُظهر أن باب النسب (النسبة) ليس معرفةً نظرية فحسب، بل أداة معيارية عملية في الصناعة اللغوية الحديثة.
١٠) عند تعدّد أوجه النسب (النسبة)، كيف نرجّح بين الصيغ المختلفة؟
الترجيح محكومٌ بضرورات القياس والاستعمال:
- القياس الصرفي: تقديم ما وافق علل الباب (قلب/حذف/ردّ) على ما شذّ.
- الشيوع والفصاحة: اختيار الأشيع في الاستعمال الموثّق ما لم يخالف أصلاً صريحاً.
- السلامة الصوتية: الأخفّ نطقاً أولى إذا استوت الأوجه في القياس.
- دفع اللبس: في المركّبات والأعلام يُقدّم ما يزيل الالتباس: عبد الله → عبديّ، وأبو بكر → بكريّ.
- قرارات المجامع: يُعتدّ بإجازات المجامع اللغوية عند السعة، كالإذن بالنسب إلى جمع التكسير في مواضع.
- السياق الاصطلاحي: في العلوم والفنون تُختار الصيغة المستقرّة اصطلاحاً: إشعاعيّ، وراثيّ، بنيويّ.
منهجياً، يُستحسن عرض الأوجه في المعجم أو الهامش عند الحاجة، مع اعتماد صيغةٍ معيارية واحدة في المتن لضبط الأسلوب. هذا يحقّق توازناً بين مرونة النسب (النسبة) وحاجات التقييس والتحرير.