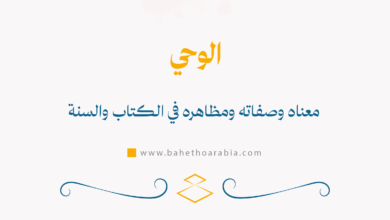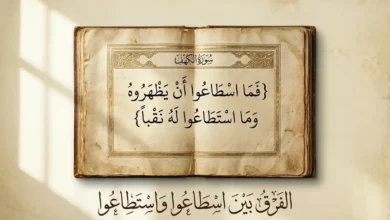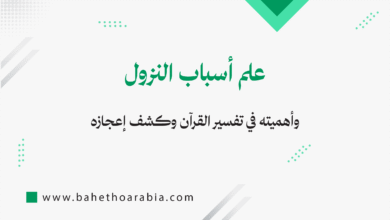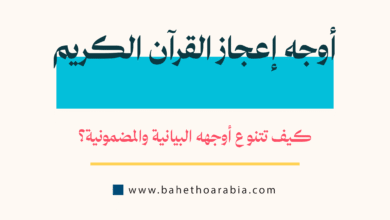المكي والمدني: تعريفها وضوابطها، وموضوعات القرآن وأساليبه
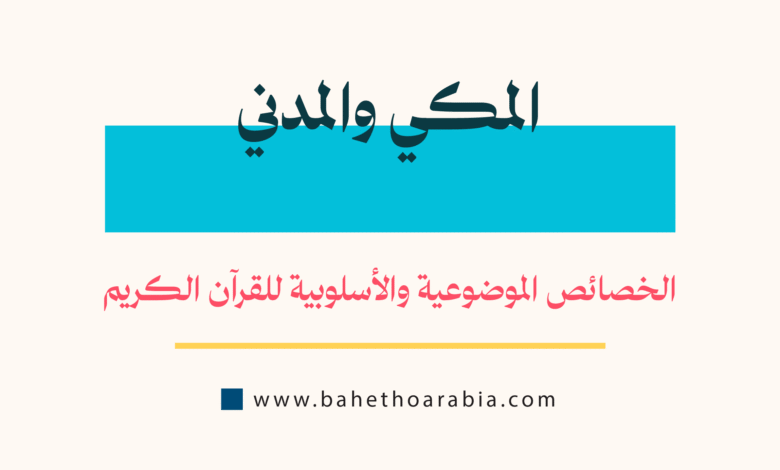
يُعد علم المكي والمدني من أهم علوم القرآن الكريم، إذ يكشف عن الخصائص الموضوعية والأسلوبية للقرآن في مرحلتي نزوله قبل الهجرة وبعدها. وتتجلى من خلال هذا العلم حكمة التنزيل المنجم، ومراعاة البيان القرآني لمقتضى الحال في كل ظرف وموقف، مما يؤكد إعجاز القرآن الخالد الذي تحدى به العرب والعجم على مر العصور.
مقدمة
هل تساءلت يوماً لماذا تختلف آيات القرآن بين قصيرة مؤثرة وطويلة تشريعية؟ ولماذا تركز بعض السور على العقيدة بينما تفصل أخرى الأحكام؟ السر يكمن في التمييز بين المكي والمدني، ذلك العلم الفريد الذي يفتح أمامك أبواب فهم القرآن الكريم في سياقه التاريخي والموضوعي. فالقرآن المكي نزل في مكة قبل الهجرة ليرسخ العقيدة ويواجه الشرك، بينما نزل المدني بعد الهجرة ليبني المجتمع المسلم ويشرع الأحكام. وبين هاتين المرحلتين، تتجلى معجزة البيان القرآني الذي يخاطب كل عصر وجيل، ويتحدى الإنس والجن أن يأتوا بمثل سورة من مثله. رحلة علمية شيقة تأخذك إلى عمق الإعجاز القرآني، وتكشف لك أسرار التنزيل الحكيم.
موضوعاً وأسلوباً
يتميز علم المكي والمدني بمزية خاصة لعلها فريدة في الدراسات القرآنية التي تتكون منها أبحاث علوم القرآن. ولعلها كانت تحت ناظرة الملاحظة للإمام السيوطي في كتابه (الاتقان في علوم القرآن) حيث صدر كتابه هذا بمعرفة المكي والمدني. ذلك أننا نستطيع بواسطة هذا العلم أن نحصل على صورة عامة، وفكره اجمالية عن الظروف العامة التي حفت بنزول القرآن، والموضوعات التي عالجها في تلك الظروف، والاساليب التي اتبعها في معالجة تلك الموضوعات، مما ينير السبيل أمام دارس القرآن العظيم، ويجعل للموضوع أهمية خاصة في حقل الدراسات الأدبية.
ومن هنا فاتنا نرى لزاما الأخذ بأشهر المذاهب كما ذكر السيوطي فنقول: القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة. ويزيد يحيى بن سلام هذا التعريف تفصيلا فيقول: ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فهو من المكي. وهذا كما قال السيوطي أثر لطيف يؤخذ منه أن ما نزل في سفر الهجرة مكي اصطلاحاً. بل نزيد المسألة ايضاحا فنقول: ان عموم قولهم المدني ما نزل بعد الهجرة، يشمل ما نزل بعد الهجرة بمكة نفسها، في عام الفتح، أو في عام حجة الوداع.
تعريف المكي والمدني وأمثلته القرآنية
مثل هذه الآية وهي قوله تعالى في سورة النساء: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ان الله نيما يعظكم به إن الله كان سميعاً بصيرا). نزلت هذه الآية في مكة لما أن فتحها الله على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الخبر المشهور الذي أخرجه ابن جرير الطبري وغيره واللفظ لابن جرير عن ابن جريج في الآية قال: نزلت في عثمان بن طلحة، قبض منه النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة، فدخل به البيت يوم الفتح، فخرج وهو يتلو هذه، فدعا عثمان اليه فدفع اليه المفتاح، قال: وقال عمر بن الخطاب: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكعبة وهو يتلو هذه الآية، فداه أبي وأمي، ما سمعته بتلوها قبل ذلك.
ومثل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عبداً. قال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ديناً. قال عمر: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة. وهكذا تميز جعل الهجرة حدا فاصلا بين المكي والمدني بشمول التقسيم والتعريف جميع القرآن لا يخرج عنه شيء، وهذه مزية علمية لها أهميتها في تفسير القرآن وكذلك في دراسته الأدبية، لأنها أجمع وأشمل في إلقاء النظرة الاجمالية على موضوعات القرآن الكريم وأساليبه.
التعريفات الأخرى وقصورها
خلافاً لتعريفين آخرين لم يحوزا القبول والاعتماد من العلماء. وهما: تعريف المكي بأنه ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة، والمدني ما نزل بالمدينة. وكذا تعريف: المكي بأنه ما وقع خطابا لأهل مكة، والمدني ما وقع خطابا لأهل المدينة. فالتعريف الأول من هذين التعريفين مكاني، أخذ بظاهر النسب الى مكة والمدينة، فكانت فيه ثلمة، هي وجود قسم ثالث لا يدخل في القسمين، وهو ما نزل من القرآن في الأسفار والغزوات، فانه لا يعد مكياً ولا مدنياً، وهو قسم كبير من القرآن فيه أمور وأحكام هامة.
وثاني هذين التعريفين أضيق من سابقه، لأنه شخصي، تقيد بتوجيه الخطاب لأشخاص معينين هم أهل مكة، وأهل المدينة، فبقي القسم الأكبر من القرآن غير داخل في المكي والمدني. وهكذا قصر هذا التعريفان عن المقصود الهام الذي نحصل عليه من التعريف الأول المشهور والمعتمد، لأنهما أخرجا عن نطاق البحث قسما كبيرا من القرآن، من غير أن يكون ثمة مبرر لإخراجه عن هذا التقسيم، سواء في ذلك من الناحية العلمية الشرعية، أو من حيث الدراسة الأدبية لا في حقل الموضوعات أو الأساليب. وبناء على هذا الضابط المختار كانت السور المدنية تسعا وعشرين سورة. وسائر سور القرآن بعد ذلك مكية، وهي خمس وثمانون سورة.
التداخل بين المكي والمدني في السور
على أنه قد يكون في بعض السور المكية ما هو مدني، كما أنه ربما يكون في بعض السور المدنية ما هو مكي، والنظر في اعتبار السورة من هذا أو ذاك إلى مطلعها، إن نزل مطلع السورة قبل الهجرة عدت مكية، وإن نزل مطلعها بعد الهجرة كانت مدنية. وبالنظر لهذا العموم الشامل الذي عرفناه يندرج في ضمن المكي والمدني أنواع كثيرة من الدراسات القرآنية المتصلة بالظروف المحيطة بنزول القرآن، كالسفري والحضري، والليلي والنهاري، وما حمل من مكة إلى المدينة، وما حمل من المدينة الى مكة، وما نزل بالمدينة وحكمه مكي، وما نزل بمكة وحكمه مدني، وغير ذلك من بحوث تدل على الاعتناء العجيب الذي أحيط به هذا القرآن، وتوفير وسائل بحثه ودراسته من جميع الجهات.
ضوابط المعرفة للمكي والمدني
لا ريب أن النقل والرواية عن الصحابة الذين عاينوا التنزيل هو المصدر الأصلي في هذا العلم، وقد كانت عناية الصحابة والتابعين بهذه الأمور عناية بالغة، حتى نجد العالم يعتز بعلمه بهذا الموضوع. أخرج البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: والذي لا إله غيره ما من كتاب الله سورة الا أنا أعلم حيث نزلت وما من آية إلا أنا أعلم فيما أنزلت. وقال أيوب السختياني سأل رجل عكرمة عن آية من القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل، وأشار الى سلنع. أخرجه أبو نعيم.
ثم لم يكتف علماؤنا باستقصاء المكي والمدني من القرآن بتعيين كل قسم تعييناً تفصيلياً سورة سورة، وآية آية، بل قدموا للمدارس ضوابط عامة تسهل عليه سبيل هذه المعرفة. وهذه الضوابط على غاية الأهمية، لأنها مع تسهيلها معرفة المكي والمدني تسعف الدارس بمؤثرات هامة على طريق دراسة سمات المكي والمدني الموضوعية والأسلوبية. وهي كالتالي:
١- وأول هذه الضوابط: ما ثبت عن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود قال: كل شيء نزل فيه: يا أيها الناس، فهو بمكة، وكل شيء نزل فيه يا أيها الذين آمنوا فهو بالمدينة. لكن ثبت استثناء مواضع قليلة جدا جاء فيها الخطاب يا أيها الناس وليست مكية.
٢- كل سورة فيها الاستفتاح بالحروف المقطعة فهي مكية سوى الزهراوين: البقرة وآل عمران.
٣- كل سورة فيها كلا فهي مكية.
٤- كل سورة فيها ذكر آدم وابليس فهي مكية سوى السورة الطولى أي البقرة.
٥- كل سورة فيها فريضة أو حد فهي مدنية.
٦- كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية سوى العنكبوت.
والحكمة في ذلك ترجع الى المقاصد الموضوعية التي نزل بها القرآن، فالخطاب في مكة كان الأمور اعتقادية تشمل كل الناس، وهي مناط انسانيتهم فناسب خطابهم بـ يا أيها الناس، كما أن محاورة أهل العناد تناسب الردع كلا، وكذلك التنويه بإعجاز القرآن لإقحام المنكرين، والاستفتاح بحروف الهجاء في أوائل السور، وقد وجد من ذلك قليل في القرآن المدني تبعا لاقتضاء الموضوعات المدنية التي كانت فترة بناء وكانت فترة مكة فترة تأسيس.
الفترة المكية والفترة المدنية
يتميز كل من القرآن المكي والمدني بموضوعات في المضمون ومناهج في الأسلوب، تجاوب بها البيان القرآني مع مقتضيات البلاغة ومراعاة مقتضى الحال. لقد مرت الدعوة القرآنية بمرحلتين متتابعتين، كما أنهما متمايزتان بوضوح عن بعضهما. كانت أولاً المرحلة المكية حيث نهض النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا يدعو الى توحيد الله تعالى بين قوم شديدي المراس والعنجهية، لا يتبعه بين فينة وأخرى سوى الواحد بعد الواحد، ثم يتحمل هو وهذه الفئة القليلة من أصحابه الشدائد، والمكائد، والأذى بأنواعه المادية والنفسية.
فكان القرآن الكريم ينزل ينافح عن الدعوة وعقيدتها، وعن تلك الجماعة الصغيرة التي رسخ الايمان في قلوبها رسوخا جعلها تتحدى من الأهوال ما تعجز عن تحمله الأمم، ويعمل في الوقت نفسه على امداد المسلمين في مكة بأسباب الايمان والاعتصام بحبل الله المتين ويرد شبهات المشركين وأفك الآفكين. عنوان المرحلة المكية كان العقيدة.
المرحلة المدنية وبناء المجتمع الإسلامي
ثم كانت المرحلة المدنية: حيث وجد المسلمون الأمن والاستقرار وأن لهم أن يقيموا مجتمعا اسلاميا خالصا، فكانت آيات التشريع، وكانت المصادمات الحربية، والمؤامرات التي شارك فيها المنافقون، وكانت من المسلمين مواقف في النصر ومواقف في بعض النكسات، فكان القرآن ينزل في المدينة ليشيد بناء المجتمع المسلم والأمة المسلمة، ويحول العقيدة الى سلوك ونظام في الحياة، فكانت موضوعاته تعنى بالأحكام، والفرائض والعقوبات، وببناء المسلمين من الناحية النفسية ذلك البناء الذي تخرج به جبل الصحابة أفضل جيل، وكانت الأمة المسلمة باعتصامها به خير أمة أخرجت للناس.
وهكذا كانت قضية البلاغة والبيان توجب تنوعا ملائما لكل مرحلة تظهر آثاره في مضامين وأغراض القرآن المكي والمدني، وفي أسلوبهما البياني. تفصيل ذلك أنه من المعلوم أن دعوة القرآن تتألف من أمرين أساسيين يمكن أن نلخصهما بأنهما: العقيدة، والشريعة، أو الفكرة اليقينية القطعية والأحكام العملية، وواضح أن لا يخاطب الانسان بالشريعة والأحكام الا بعد الإيمان بعقيدة القرآن، والتيقن بدعوته، لذلك كان من الطبعي أن تعنى الآيات المكية بالعقيدة، وتعنى الآيات المدنية بالشريعة، وهكذا كانت لهما السمات الموضوعية الخاصة بكل منهما.
القرآن المكي من حيث الموضوع
فمن سمات القرآن المكي الاعتناء بالموضوعات التالية الأساسية:
١- تقرير أصول العقائد الايمانية، بدعوة الخلق الى توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة، والايمان باليوم الآخر وما يتبع ذلك من الجزاء والجنة والنار، وتقرير رسالة النبي صلى الله عليه وسلم والرسل من قبله، والايمان بالملائكة عليهم السلام. تأمل مثلا سورة الحجر المكية ودعوتها لهذه الأصول في مثل هذه الآيات التي تدعو الى الايمان بالله تعالى وتوحيده: لقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل شيطان رجيم، إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين، والأرض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وما ننزله الا بقدر معلوم، وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فاسقيناكموه وما أنتم له بخازنين، وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.
وانظر في مطلع سورة الحج هذا المشهد من مشاهد القيامة مشفوعا بالدلائل القاطعة على حقية القيامة: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فانه يضله ويهديه الى عذاب السعير، يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم، ونقر في الأرحام ما نشاء الى أجل مسمى، ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا، وترى الأرض هامدة فاذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
٢- الحملة على الشرك والوثنية، والالحاد والدهرية، واقامة الحجج والبراهين الدامغة على بطلان عقائدهم الزائفة، مستعينا بضرب الأمثال وأنواع البيانات، حتى كشف لهم سوءة عقائدهم وفضحها حتى جعل أصنامهم دون الذباب، تأمل هذه الآيات من سورة الحج أيضا: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وتأمل قوله في سورة العنكبوت: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون.
ولما كان التقليد منبعا خطيرا من منابع الضلال، واحتج المشركون بما وجدوا عليه آباءهم، عني القرآن بتوسيع آفاق العقل والفكر وأمر بالتفكر وحض على النظر والتعقل، وسفه أحلامهم وأحلام آبائهم، حتى جعل التقليد الأعمى للآباء عارا وشنارا، يعتبر به المعتبر، فضلا عن تقليد الأعداء فيما يبتكرونه في الفكر من الأزياء. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقال تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم، قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون، فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.
٣- الاستدلال بدلائل الأنفس والأكوان على عظمة الله تعالى وسلطانه، ووجوب طاعته والانقياد له، وتوحيده في ألوهيته وربوبيته، والايمان بالقيامة والبعث بعد الموت. حتى كانت في تلك الآيات دلائل إعجاز علمي، لما اشتملت عليه من حقائق الكون والإنسان والحياة، ونواميس خلقه تعالى وسنن تصريفه لأمور الأكوان. انظر هذه الآيات من سورة لقمان وما فيها من سبق علمي: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، الى أن قال: ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون، لله ما في السموات والأرض إن الله هو الغني الحميد، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ان الله سميع بصير، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري الى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير، ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.
٤- اعتناء القرآن المكي بقصص الأنبياء مع أقوامهم، حتى كاد ذلك أن يكون علامة تميزه، إذ لم يوجد قصص الأنبياء في القرآن المدني الا في سور قليلة، كقصة موسى وقومه في سورة البقرة والمائدة وهما مدنيتان، وقصة عيسى وموسى عليهما السلام في سورة آل عمران والصف وهما مدنيتان أيضاً. والحكمة في اعتناء القرآن المكي بقصص الأنبياء والأمم الغابرة ظاهرة جدا مما ذكرناه في حكم نزول القرآن منجماً، وما كان لها من أثر عظيم في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ومواساتهم فيما كان يصيبهم، وإنذار أعدائهم، وإثارة العبرة والعظة بقصص من سبقهم.
انظر على سبيل المثال القصص في سور الأعراف، يونس، هود وغيرها تجد فيها أبلغ المواعظ وأنفع العبر لتقرير سننه تعالى في إهلاك أهل الكفر والطغيان وانتصار أهل الايمان والإحسان. تأمل قوله تعالى في آخر قصة موسى مع فرعون في سورة غافر: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار، قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوماً من العذاب، قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار.
٥- ان القرآن المكي شرح أصول الأخلاق، وقواعد عامة في الاجتماع مما لا يختلف فيه حال ولا عقل، لكونها من البدهيات الظاهرة والمقومات الأساسية لسعادة الإنسان، واطمئنانه بالإيمان، كالصدق، والبر، والصلة، وبر الوالدين، وإكرام الجار، وطهارة القلب واللسان، وغير ذلك. وقد شرح القرآن تلك القيم ببيانه المعجز شرحا غرسها في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق، والظلم، ووأد البنات، والقتل والزنا.
انظر هذه الآيات بالوصايا العشر الأخلاقية والاجتماعية في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفوراً، وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسوراً، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا.
القرآن المدني من حيث الموضوع
من سمات القرآن المدني الاعتناء بالموضوعات التالية:
١- بيان جزئيات التشريع وتفاصيل الأحكام العملية، في العبادات كأحكام الصلاة، والزكاة والصوم، والحج، والمعاملات كالبيوع والأموال، والاجتماعيات كالنكاح والطلاق والرضاع، والعقوبات كالحدود والقصاص كما هو ملاحظ في سورة البقرة والنساء والمائدة والنور.
٢- دعوة أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى الى الاسلام، وإقامة الحجج عليهم، كما هو ملاحظ في سورة البقرة، وآل عمران، والمائدة وغيرها. انظر مثلا قوله تعالى لليهود: ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، وذلك بعد قوله: يا أهل الكتاب لم تحاجون في ابراهيم وما أنزلت التوراة والانجيل الا من بعده أفلا تعقلون.
٣- وصف المنافقين، وكشف فضائحهم والتحذير من أساليبهم، لأن النفاق أخطر ما تبتلى به دعوة، حتى انزلت سورة خاصة تحمل اسم المنافقين، وغير ذلك من مواضع في القرآن تتعلق بهم.
٤- بيان الأحكام الخاصة بالعلاقات بين الأمة الاسلامية وغيرها. وكان ذلك أول تنظيم وتقنين يحكم العلاقات بين الدول، كالأحكام المتعلقة بالحرب، والسلم والصلح، والمعاهدات، والغنائم والأسرى، كما في سورة البقرة والأنفال وبراءة والقتال والفتح والحشر، ما جعل القانون الدولي مدينا للقرآن في هذه الأحكام، ولا تزال الأصول القرآنية في هذا الباب نبراسا يعمل بها القانون الدولي في هذا العصر.
القرآن المكي من حيث الأسلوب
واذا كان لكل من القرآن المكي والمدني موضوعات يعنيان بها، فلا غرو أن تكون لهما أساليبهما التي تميز أحدهما عن الآخر في كثير من الأحيان بحسب تنوع الموضوعات التي يعالجها القرآن مكيا كان أو مدنيا. ذلك أن المبنى والمعنى، والشكل والمضمون ركنان متآزران في الأداء القرآني، كل فكرة لها قالب، ولها أسلوب وتناغم خاص، واثارة معينة للخيال والعاطفة.
فمن سمات أسلوب القرآن المكي: أنه يغلب عليه قصر الآيات والسور، وقوة التعبير والتناغم الموسيقي، وكثرة الفواصل القرآنية وقصرها، وتنوعها بما يتناسب مع المعاني والمواقف والصور، وكثرة أسلوب التأكيد، والاعتناء بوسائل التقرير أي ترسيخ المعاني وتثبيتها، فكثر في المكي القسم، وضرب الأمثال، والتشبيه وتكرار بعض الجمل أو الكلمات، وأن الآيات المكية يكثر فيها التجسيم الحسي، واضفاء الحركة وخواص الحياة على الأشياء، ولا سيما في مشاهد القيامة، وأهوال النار، وبيان أحوال أهل الجنة والنار، وكذلك القصص.
والحكمة في اختيار هذه الأساليب للقرآن المكي واضحة ظاهرة لنزول القرآن بمكة، وكان أهلها ينكرون دعوة القرآن وهم أصحاب عنجهية، وحمية جاهلية، فكان المناسب لهم النذر القارعة، والعبارات الشديدة الرادعة ليزدجروا عن غيهم، ويسلسلوا قيادهم أمام التأكيدات والتخيلات الحسية، كما أن مضمون خطابات القرآن في مكة لا يختص بالمؤمنين، بل يتوجه للناس أجمعين، يحمل الدعوة الى أصول الايمان، فكان من المناسب أن يبرز في اعجازها عنصر الجانب الصوتي، والجرس الموسيقي، فتصخ آياته الآذان، وتستولي على المشاعر وتدعهم في حيرة ودهشة مما يسمعون، فلا يلبث البليغ منهم أن يلقي عصا العجز، بل يرسلها قولة صريحة تعلن اعجاز القرآن.
أمثلة على إعجاز الأسلوب المكي
ومن أمثلة ذلك المعروفة: الوليد بن المغيرة القرشي، الذي لم يلبث بعد أن سمع القرآن سماع تأمل وتروٍ أن تغير موقفه حتى شهد للقرآن بالإعجاز فقال: والله لقد سمعت كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، وان له الحلاوة وان عليه لطلاوة، وان أعلاه لمثمر وأن أسفله لمغدق، وما هو بقول بشر، وانه ليعلو ولا يعلى. ولما أكرهه أصحابه المشركون على أن يقول قولا ينصر آلهتهم ويرضيهم لم يتمكن من اخفاء الصراع الذي في نفسه، فاستمهلهم وقتا ليفكر، ثم خرج ليقول: إن القرآن سحر يؤثر يأخذه محمد من بعض العالمين بالسحر.
فأنزل الله تعالى فيه: انه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. فتأمل هذه الآيات كيف صورت صراعه النفسي، وتكلفه الشديد ذلك التصوير المعبر الموحي، الذي صار مثلا يضرب في الجهد العظيم، الذي يخرج بعده صاحبه بالقول الباطل العقيم.
القرآن المدني من حيث الأسلوب
ومن سمات أسلوب القرآن المدني: طول أكثر السور والآيات، كما هو واضح ظاهر من سورة البقرة وآل عمران مثلا، وأنها غالبا ما تسلك سبيل الهدوء، واللين في أسلوبها، واسترسال فواصلها. والحكمة في اختيار هذا الأسلوب اشتمال القرآن المدني على الموضوعات السابقة، وهي تقتضي البسط والاسهاب، كما أن الخطاب في المدينة توجه في أكثره للمؤمنين وذلك يناسب الهدوء واللين.
تعقيب على أسلوب المكي والمدني
وجدير بالتذكير ههنا أن هذه السمات للمكي والمدني لا تشكل حدودا فاصلة وقيودا حادة، بل هي سمات كثرة، قد تتخلف في كثير من الأحيان، حسبما يقتضي الموضوع ذلك، فالقضية ليست قضية فترة ومرحلة تحكم الأسلوب، بل قضية مضمون يتطلب الأسلوب الملائم. لذلك آثرنا التعبير بـ الاعتناء و كثرة و أكثر في التعبير عن هذه السمات، ولم نقل علامات أو خصائص كما وقع لبعض الكاتبين المعاصرين، فأوهموا بعبارتهم تلك غير الحق وغير الواقع.
ومن ذلك تتبين فساد ما توهمه بعض المستشرقين، ومن تبعهم من ببغاوات تتلمذت عليهم من أبنائنا من توهم أو تصور ما زعم من تأثر القرآن بالبيئة، وأن القرآن لما كان في مكة بين الأميين جاءت سور المكي وآياته قصيرة، ولما وجد في المدينة بين مثقفين مستنيرين جاءت سور المدني وآياته طويلة، وجاء القرآن المكي لذلك خلوا من التشريع والأحكام، بينما القسم المدني مشحون بتفاصيل التشريع والأحكام، بل بلغ الأمر بهذا الزاعم أن قال: ان القسم المكي يمتاز بالهروب من المناقشة، وبالخلو من المنطق والبراهين، فيقول: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين، بخلاف القسم المدني فهو يناقش الخصوم بالحجة الهادئة والبرهان الساكن الرزين فيقول: لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا. هكذا يستدل هذا الزاعم بهذه الاستدلالات على زعمه عن تأثر القرآن بالبيئة.
الرد على شبهات المستشرقين
وهذا في الواقع تجن واختلاق، صادر عن سفيه جهول، أو آفك معرض متحامل حقود، ولعل الطريقة التي اتبعناها في تفصيل مزايا القرآن المكي والمدني مضمونا وأسلوبا تجعل قارئ الموضوع يدرك بسهولة ويسر بطلان هذه التقولات ومنافاتها للحقيقة، وبعدها عن الواقع بعد السماء عن الأرض، وبون الشرق عن الغرب، فلنذكر ملاحظات وجيزة لرد هذا الزعم فيما يلي: إن سمات المكي والمدني الأسلوبية والموضوعية أيضا خاضعة لقضية البلاغة الجوهرية والمسلمة لدى كل ذي إلمام بالبلاغة والبيان عربيا أو غير عربي وهي مراعاة مقتضى الحال، كما ذكرنا منذ قليل، لذلك نجد في المكي سورا طوالاً بل من أطول الطوال ونجد في المدني سورا قصارا وفيها الآيات والفقرات القصيرة، بل من أقصر القصار، كما في سورة النصر، وسورة الكوثر وهي أقصر سورة في القرآن وهي مدنية كما ثبت بذلك الحديث الصحيح الذي لا يقاوم.
كذلك نجد في المدني شدة أحياناً، كما في هذه الآيات من مطلع سورة الصف المدنية بالاتفاق: سبح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. بل نجد في المدني ما بلغ الغاية في الشدة والتخويف، كما في قوله تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. كان الإمام أبو حنيفة يقول في هذه الآية: واتقوا النار التي أعدت للكافرين هي أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين ان لم يتقوه في اجتناب محارمه. كما قد نجد كذلك في المكي اللين والعفو البالغ أقصاه، كقوله تعالى في سورة فصلت: ومن أحسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها الا الذين صبروا، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم.
دحض المزاعم بالدلائل العلمية
إن ادعاء خلو القرآن المكي من الحجج والأدلة قلب للقضايا وعكس للأوضاع ومناقضة للحقائق، فالقرآن المكي من سماته الموضوعية كما ذكرنا اعتناؤه بالدلائل العلمية الكونية على عظمة الله تعالى ووحدانيته، وعلى ابداع حكمته وجليل علمه وقدرته، حتى كانت فيها دلائل الاعجاز العلمي الذي ألفت ولا تزال الكتب تؤلف في كشف عجائب هذا الإعجاز، وأسرار دلالته على موافقة ما يكشفه العلم بعد هذه القرون والحقب الطوال. وكذلك نجد في القرآن المكي الدلائل العقلية القاطعة على حقية التوحيد، والقيامة، وبعث الرسل وغير ذلك، وقد سبقت لنا آيات من سورة يس في دلائل القيامة، وانظر قوله تعالى في اثبات التوحيد في سورة المؤمنون المكية: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.
بل ان هذا الزاعم قد حكم على نفسه بالجهل المطبق أو التجاهل والتجني المهلك، فان الآية التي أوردها على أنها من المدني: لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا، إنما هي من القرآن المكي، وهي الآية ٢٢ من سورة الأنبياء، وهي مكية كلها، وهذه الآية مكية بالإجماع. وهكذا كان دأب الباطل أن يتخذ الإفك وتحريف الحقائق ذريعة يسند اليها باطله وجحوده سواء كان صاحبه جاهليا قديما، أو عصريا حديثا.
الإعجاز القرآني يتجاوز حدود البيئة
إن كل التقولات سواء كانت في هذا الموضوع أو غيره تبتعد عن حقيقة الموضوع، وتحاول تناسيها، أو إنساء القارئ إياها، وتلك هي حقيقة الإعجاز، فقد كان ينبغي على أي باحث يريد أن ينقد بموضوعية نزيهة أن يواجه هذا السؤال عن اعجاز القرآن، هل انقطع حبله باختلاف البيئة كما ينقطع في الانتقال من القرآن الى الحديث، أم أن خصوصية الإعجاز لا تزال هي هي، وأن التحدي بالقرآن هو هو، سواء قلنا إن أهل المدينة كان فيهم أهل كتاب مثقفون مستنيرون، أو قلنا أهل مكة أعلى كعبا في البلاغة وأرسخ قدما في البيان.
بل ان القرآن المدني يعلن التحدي بالقرآن على العالم بأدنى ما تحدى به القرآن المكي، وهو أن يأتوا بمثل سورة واحدة فقط من سوره، سواء كانت مكية أو مدنية وسواء كان السامع مكيا أو مدنياً، أو غير مكي ولا مدني، وسواء كان في عصر نزول القرآن أو بعده الى الأبد. بل ان القرآن المدني قد جاء في تحديه بمزيد من ارخاء العنان، والتسهيل في التحدي، كما تشير اليه الآية التي وردت في سورة البقرة المدنية إذا قورنت بالآية التي في سورة يونس المكية.
التحدي القرآني في المكي والمدني
ففي سورة يونس وردت الآية هكذا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين. وفي البقرة: وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. فقد عبر في يونس بـ سورة مثله وفي البقرة بسورة من مثله، فأشار بذلك الى الاكتفاء بما هو من جنس القرآن وطبقته وإن لم يكن مماثلا له تمام المماثلة، ومطابقا على كمال المطابقة، ثم لم تكتف الآية بذلك بل أضافت تأكيد التحدي والإعجاز هذا الإعلان البات الذي يقطع الآمال أن تتعلق بالإتيان بسورة من مثله: «فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين».
وها قد مرت الأعوام والسنون، وانقضت الأجيال والقرون، وتقدمت العلوم والفنون لتزيد هذا الإعلان تصديقاً، وذلك التنبؤ الغيبي تحقيقاً، بأنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بمثل سورة منه «لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً».
خاتمة: وحدة الإعجاز القرآني
وهكذا يتبين لنا من خلال دراسة المكي والمدني أن القرآن الكريم – على تنوع موضوعاته وتعدد أساليبه بحسب مقتضى الحال والظروف – يبقى معجزة واحدة متكاملة، لا ينفصل إعجاز مكيه عن مدنيه، ولا يختلف تحديه في مرحلة عن أخرى. فالإعجاز القرآني حقيقة ثابتة متجاوزة لحدود الزمان والمكان، والبيئة والأشخاص، شاهدة على أن هذا الكلام ليس من صنع البشر، بل هو كلام رب العالمين، الذي أنزله على قلب سيد المرسلين، ليكون للعالمين نذيراً وبشيراً، وهدى ورحمة للمؤمنين.
وإن معرفة المكي والمدني لتفتح أمام الدارس آفاقاً رحبة لفهم القرآن الكريم في سياقه التاريخي والموضوعي، دون أن تنتقص من عالميته وخلوده، بل تزيده وضوحاً وبياناً، وتجعل المتدبر فيه أكثر إدراكاً لحكمة التنزيل، وبلاغة الأسلوب، وشمول الرسالة.
سؤال وجواب
١. ما هو التعريف الأدق للقرآن المكي والمدني؟
القرآن المكي هو ما نزل قبل الهجرة النبوية ولو كان في غير مكة، والقرآن المدني هو ما نزل بعد الهجرة ولو كان في مكة نفسها كما حدث في عام الفتح أو حجة الوداع. وهذا التعريف الزماني هو الأشهر والأدق لأنه يشمل جميع القرآن دون استثناء، بخلاف التعريف المكاني الذي يقصر المكي على ما نزل بمكة فقط والمدني على ما نزل بالمدينة، فيخرج منه ما نزل في الأسفار والغزوات.
٢. كم عدد السور المكية والمدنية في القرآن الكريم؟
عدد السور المدنية تسع وعشرون سورة، وسائر سور القرآن مكية وهي خمس وثمانون سورة. ومع ذلك قد يكون في بعض السور المكية آيات مدنية، وفي بعض السور المدنية آيات مكية، والعبرة في تصنيف السورة بمطلعها، فإن نزل مطلعها قبل الهجرة عدت مكية وإن نزل بعدها كانت مدنية.
٣. ما هي أهم الموضوعات التي اعتنى بها القرآن المكي؟
يعتني القرآن المكي بخمسة موضوعات أساسية: تقرير أصول العقائد من توحيد وإيمان بالبعث والرسل، والحملة على الشرك والوثنية بالحجج الدامغة، والاستدلال بآيات الأنفس والآفاق على عظمة الله، وقصص الأنبياء مع أقوامهم للعبرة والتثبيت، وشرح أصول الأخلاق والقيم الإنسانية العامة كالصدق والبر وبر الوالدين.
٤. ما هي السمات الموضوعية للقرآن المدني؟
يتميز القرآن المدني بأربعة موضوعات رئيسية: بيان تفاصيل التشريع والأحكام العملية في العبادات والمعاملات والعقوبات، ودعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى إلى الإسلام وإقامة الحجج عليهم، وكشف المنافقين وفضائحهم والتحذير منهم، وبيان الأحكام المنظمة للعلاقات بين الأمة الإسلامية وغيرها من الحرب والسلم والمعاهدات.
٥. ما الفرق بين أسلوب القرآن المكي والمدني؟
يغلب على القرآن المكي قصر الآيات والسور، وقوة التعبير والتناغم الموسيقي، وكثرة الفواصل القصيرة المتنوعة، وأساليب التأكيد كالقسم وضرب الأمثال والتكرار، والتجسيم الحسي لمشاهد القيامة والجنة والنار. بينما يتميز القرآن المدني بطول الآيات والسور غالباً، والميل إلى الهدوء واللين في الأسلوب، واسترسال الفواصل، لأنه يتوجه للمؤمنين ويشتمل على تفاصيل تحتاج للبسط والإسهاب.
٦. ما هي الضوابط العامة لمعرفة المكي والمدني؟
توجد ستة ضوابط رئيسية: كل آية فيها “يا أيها الناس” فهي مكية وما فيه “يا أيها الذين آمنوا” فمدني، وكل سورة بها حروف مقطعة فمكية سوى البقرة وآل عمران، وكل سورة فيها “كلا” فمكية، وكل سورة فيها ذكر آدم وإبليس فمكية إلا البقرة، وكل سورة فيها فريضة أو حد فمدنية، وكل سورة فيها ذكر المنافقين فمدنية سوى العنكبوت.
٧. لماذا اختار القرآن المكي أسلوب القصر والشدة؟
اختار القرآن المكي هذا الأسلوب لمناسبة المخاطبين وهم المشركون أصحاب العنجهية والحمية الجاهلية، فكان المناسب لهم النذر القارعة والعبارات الشديدة الرادعة، كما أن مضمون الخطاب يتوجه للناس كافة بدعوة أصول الإيمان، فكان من المناسب إبراز عنصر الجانب الصوتي والجرس الموسيقي ليستولي على المشاعر ويصخ الآذان ويظهر الإعجاز.
٨. هل يمكن أن تكون في السورة المكية آيات مدنية؟
نعم، قد يكون في بعض السور المكية آيات مدنية، وقد يكون في بعض السور المدنية آيات مكية، والنظر في اعتبار السورة مكية أو مدنية يكون إلى مطلعها. فمثلاً سورة النساء مدنية لكن فيها آية نزلت بمكة عام الفتح وهي “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها”، وكذلك آية “اليوم أكملت لكم دينكم” من سورة المائدة المدنية نزلت بعرفة.
٩. كيف نرد على من يزعم تأثر القرآن بالبيئة؟
الرد يكون بعدة وجوه: أولاً أن سمات المكي والمدني خاضعة لقاعدة مراعاة مقتضى الحال البلاغية لا للبيئة، فنجد في المكي سوراً طوالاً وفي المدني قصاراً كالنصر والكوثر. ثانياً أن القرآن المكي مليء بالأدلة العقلية والبراهين الكونية فكيف يوصف بالخلو من المنطق. ثالثاً أن حقيقة الإعجاز واحدة لم تتغير بتغير المكان، والتحدي بالإتيان بمثله قائم في المكي والمدني على السواء.
١٠. ما الحكمة من اختلاف موضوعات المكي والمدني؟
الحكمة تكمن في التدرج الطبيعي للدعوة، فالمرحلة المكية كانت مرحلة تأسيس العقيدة وبناء الإيمان في قلوب المسلمين وسط الشدائد والمحن، فناسبها التركيز على أصول الإيمان والعقيدة. أما المرحلة المدنية فكانت مرحلة بناء المجتمع المسلم والدولة الإسلامية، فناسبها تفصيل الأحكام والتشريعات. وهذا من مراعاة البلاغة لمقتضى الحال، إذ لا يخاطب الإنسان بالشريعة إلا بعد الإيمان بالعقيدة.