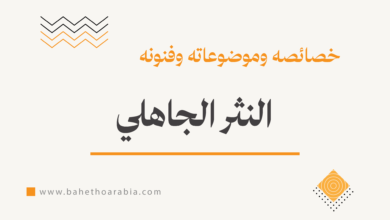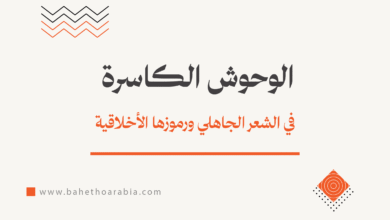الهجاء عند زهير بن أبي سلمى: بين النفور الأخلاقي والضرورة الظرفية

هل يمكن لشاعر الحكمة والسلام، الذي صاغ أروع قصائد الدعوة إلى السلم ونبذ الضغينة، أن يُشهر سيف الهجاء البتّار؟ وكيف لشخصية اتسمت بالوقار والأناة مثل زهير بن أبي سلمى أن تنزل إلى ساحة القدح والذم؟ تطرح هذه التساؤلات مفارقة عميقة تكمن في قلب مسيرة واحد من أعظم شعراء العربية. إن الهجاء عند زهير بن أبي سلمى لا يمثل مجرد غرض شعري عابر، بل هو نافذة نادرة تطل على الصراع الداخلي بين الطبع الأخلاقي الرفيع وضرورة الرد على الظلم الفادح. في هذا المقال، سنغوص في تلك اللحظات الاستثنائية التي اضطر فيها شاعر الحوليات إلى استخدام أقذع الألفاظ، ليس كخيار، بل كرد فعل أخير، لنكتشف كيف أن هذا الجانب المظلم من شعره يؤكد، paradoxically، على عظمة حكمته ورسوخ مبادئه.
الهجاء عند زهير بن أبي سلمى
يُعد الهجاء عند زهير بن أبي سلمى ظاهرة نادرة، إذ إن شخصية تتسم بمثل أخلاقه الكريمة تنفر بطبيعتها من الهجاء أو تزهد فيه، فلم تسرف في ممارسته إسراف الحطيئة، ولم تبلغ فيه درجة الإقذاع التي وصل إليها. يقوم هذا الفن الشعري على استقصاء العيوب والتنقيب عن المثالب، وهو ما يتناقض مع نصيحة زهير للناس بالإضراب عن الضغينة والعتاب، حيث قال: «ولا تكثر على ذي الضغن عتباً». وقد زجر نفسه عن الهجاء قائلاً: «أبيت فلا أهجو الصديق»، فكيف يمكن لمن يتبنى هذا المبدأ أن يجيد الهجاء، الذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالحقد ولؤم الطباع وسلاطة اللسان. إن دراسة الهجاء عند زهير بن أبي سلمى تكشف أنه لم يكن يوماً شخصية صدامية كـ«كبش نطاح» أو «كلب هراش»، ولم تفارقه حكمته وأناته، كما لم يختر إلا الصدق والحق ليجري بهما لسانه في جميع أغراض الشعر.
على الرغم من ذلك، فإن الظلم قد يطغى على الحلم، كما أن اعتداء اللئام على الكرام لا يمكن دفعه بالحكمة وحدها، مما يضطر المرء الكريم إلى امتطاء مطية الهجاء وهو كاره لها، ليقتص ممن اعتدى عليه. وهذا الظرف هو الذي يفسر دوافع الهجاء عند زهير بن أبي سلمى. فقد أغار بنو الصيداء، وهم قوم من بني أسد، على إبل لزهير فاستولوا عليها، وأسروا غلاماً له اسمه (يسار). في البداية، لجأ الشاعر إلى الحكمة وترفّق في طلبه، وسأل الغزاة أن يردوا عليه ما اغتصبوه، لكنهم رفضوا. وفي محاولة لتجنب ممارسة الهجاء عند زهير بن أبي سلمى، روّى الشاعر في أمره ورعى الحلف الذي يربط قومه بقوم المغيرين، وصان حرمة الجوار. واستحث سيدهم الحارث بن ورقاء على انتزاع إبله من سارقيها وإعادتها إليه مع غلامه يسار. وطفق زهير يشكو ما ناله من ظلم لا يصبر عليه ملك ولا شخص من عامة الناس، وحذر الحارث من المماطلة والمراوغة، ونصح له بحماية عرضه من لسان زلق طلق قادر على هتك ستره وفضح مخازيه، وهجوه بفاحش القول، وتلطيخ شرفه بعار يلازمه ملازمة الدهن للثوب الأبيض، فقال:
يَا حَارِ لَا أَرْمِيَنْ مِنْكُمْ بِدَاهِيَةٍ *** لَمْ يَلْقَهَا سُوقَةٌ قَبْلِي وَلَا مَلِكُ
فَارْدُدْ يَسَاراً، وَلَا تَعْنُفْ عَلَيَّ، وَلَا *** تَمْعَكْ بِمَرْضِكَ إِنَّ الغَادِرَ المَعِكُ
لَيَأْتِيَنَّكَ مِنِّي مَنْطِقٌ قَذَعٌ *** بَاقٍ كَمَا دَنَّسَ القُبْطِيَّةَ الوَدَكُ
وفي تفسير هذه الأبيات، يُشار إلى أن كلمة “تمعك” تعني المماطلة، و”المَعِك” هو الغادر. أما “القَذَع” فيشير إلى أقبح أنواع الشتم والهجاء، و”القبطية” هي ثياب بيضاء رقيقة، و”الودك” هو الدسم، في تشبيه بليغ للعلاقة بين العار والشرف. إن هذه الأبيات تمثل مرحلة التهديد التي تسبق التطبيق الفعلي لفن الهجاء عند زهير بن أبي سلمى.
يُستدل من الروايات أن الحارث طمع في حلم زهير، فلم يستجب لتحذيره، وأمسك بالغلام والإبل، ظناً منه أن حكمة زهير تمنعه من الخوض في أعراض الناس. ويذكر الرواة أن «الحارث لما بلغته القصيدة لم يلتفت إليها، فأحفظ ذلك زهيراً»، فانفجرت نفسه عن ثورة عنيفة، وانطلق لسانه بالهجاء المقذع، وهو ما يمثل ذروة الهجاء عند زهير بن أبي سلمى. وقال فيه وفي بني أسد أبياتاً فاحشة كان مطلعها:
تَعَلَّمْ أَنَّ شَرَّ النَّاسِ حَيٌّ *** يُنَادِي فِي شِعَارِهِمْ يَسَارُ
تُظهر هذه الأبيات الجانب الأكثر حدة في الهجاء عند زهير بن أبي سلمى، حيث يرمي خصومه بتهمة العنة، ويدعي أنهم احتفظوا بغلامه “يسار” بسبب فحولته التي أرضت نساءهم، فتعلقن به ورغبن عن أزواجهن. ولعل هذا النموذج من الهجاء عند زهير بن أبي سلمى كان من أسوأ ما قاله الشاعر، وربما كان العار الذي لحق به جراء هذه الأبيات أشد من العار الذي لحق بالحارث؛ إذ إنها شقت عنه ثوب الوقار الناصع البياض ووصمته بوصمة سوداء. وفي هذا السياق، قال شيخ من مزينة، وهم قوم زهير: «لولا الذي كان من زهير من الفحش في هجاء بني أسد لما كان في الأرض أتم من مروءة شعره، ولا أقصد، ولا أقل تزيداً منه». إن هذا الرأي يعكس الأثر السلبي الذي تركه هذا النوع من الهجاء عند زهير بن أبي سلمى على صورته العامة.
ومع ذلك، لا يمكن الشك في أن زهيراً قد دُفع إلى الهجاء دفعاً، وأن هذا النمط لم يكن من سمات شعره الأصيلة، مما يؤكد أن الهجاء عند زهير بن أبي سلمى كان استثناءً وليس قاعدة. والدليل الأبرز على ذلك هو ندمه، وهو ما يميز تجربة الهجاء عند زهير بن أبي سلمى عن غيره من الشعراء الذين امتهنوه. فعندما ارعوى الحارث ورد إليه غلامه، مدحه زهير قائلاً:
إِنَّ ابْنَ وَرْقَاءَ لَا تُخْشَى بَوَائِقُهُ *** لَكِنَّ وَقَائِعَهُ فِي الحَرْبِ تُنْتَظَرُ
إن هذا التحول السريع يؤكد أن الهجاء عند زهير بن أبي سلمى كان مرتبطاً برد الظلم لا بطبع لئيم. ومن أوتي من الحكمة ما أوتي زهير، فإن ندمه على الذنب يكون أشد من سروره بالثأر. ويتجلى ذلك في حادثة أخرى تؤكد طبيعة الهجاء عند زهير بن أبي سلمى العارضة، حيث هجا قوماً من بني جناب الكلبيين فأوجعهم، ونال من رجولتهم، ودعاهم إلى ترك نسائهم، وجعلهم كالنساء اللواتي يُبتغى لهن الأزواج:
وَمَا أَدْرِي – وَسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي – *** أَقَوْمٌ آلُ حِصْنٍ أَمْ نِسَاءُ
فَإِنْ تَكُنِ النِّسَاءُ مُخَبَّآتٍ *** فَحَقٌّ لِكُلِّ مُحْصَنَةٍ هِدَاءُ
ثم ندم على ذلك ندماً شديداً، وحلف ألا يهجو أهل بيت من العرب أبداً. إن هذا الندم يُعد السمة الفارقة في دراسة الهجاء عند زهير بن أبي سلمى. إن مسلكه في كلا الموقفين يقدم دليلاً قاطعاً على أن الهجاء عند زهير بن أبي سلمى لم يكن جزءاً من طبعه الشعري، وإنما كان هيجة عارضة، وريحاً عابرة، وشقشقة هدرت ثم قرت. لذا، فإن فهم الهجاء عند زهير بن أبي سلمى يتطلب النظر إليه كضرورة فرضتها الظروف القاسية لا كرغبة أصيلة في التجريح.
خاتمة
وهكذا، يتضح أن دراسة الهجاء عند زهير بن أبي سلمى تقودنا إلى استنتاج أعمق من مجرد تصنيفه ضمن أغراضه الشعرية. فهجاؤه لم يكن طبعاً متأصلاً أو سلاحاً يستمتع بإشهاره، بل كان بمثابة جرح اضطر أن يفتحه في كبريائه ليدافع عن حقه. إن قصائده الهجائية القليلة، وما تلاها من ندم صادق وقسم غليظ، لا تمثل نقطة سوداء في مسيرته، بل هي الدليل القاطع على سمو نفسه. لقد كانت “شقشقة هدرت ثم قرت”، سحابة عابرة لم تلبث أن انقشعت لتجعل سماء حكمته أكثر صفاءً وجلاءً. وفي نهاية المطاف، يظل الهجاء عند زهير بن أبي سلمى شاهداً على أن الحكيم لا يهجو لأنه شرير، بل لأنه إنسان يرفض أن يُسحق كرامته، حتى لو كلفه ذلك جزءاً من وقاره مؤقتاً.
السؤالات الشائعة
١ – ما الذي يميز الهجاء عند زهير بن أبي سلمى عن غيره من شعراء عصره؟
يتميز الهجاء عند زهير بن أبي سلمى بكونه هجاءً ظرفياً وغير متأصل في شخصيته الشعرية. على عكس شعراء كالحطيئة الذين اتخذوا من الهجاء حرفة ووسيلة للتكسب، كان هجاء زهير رد فعل اضطرارياً على ظلم فادح لم تجدِ معه الحكمة نفعاً. السمة الأبرز لهجائه هي الندم الذي يعقبه، فهو لم يكن يستمتع به بل كان يراه شراً لا بد منه، وسرعان ما يعود إلى طبعه الأصيل من الوقار والمدح عند زوال السبب، وهو ما يجعله ظاهرة أخلاقية تستحق الدراسة أكثر من كونه مجرد غرض شعري.
٢ – ما هي الدوافع الرئيسية التي أجبرت زهيراً على اللجوء إلى الهجاء رغم نفوره منه؟
الدافع الرئيسي هو الشعور بالظلم الشديد والعدوان على حقوقه وممتلكاته. يتجلى ذلك بوضوح في حادثتين محوريتين: الأولى عندما أغار بنو أسد على إبله وأسروا غلامه “يسار”، ورفض سيدهم الحارث بن ورقاء إعادتها رغم محاولاته السلمية المتكررة. والثانية حين هجا بني جناب الكلبيين. في كلتا الحالتين، لم يكن الهجاء عند زهير بن أبي سلمى خياراً أولياً، بل كان السلاح الأخير الذي لجأ إليه بعد استنفاد كل وسائل الحكمة والدبلوماسية، ليقتص لكرامته ويسترد حقه المسلوب.
٣ – كيف تطورت حادثة بني أسد من محاولة سلمية إلى هجاء مقذع؟
تطورت الحادثة عبر مراحل متدرجة تكشف عن صبر زهير وأناته. بدأت بطلب مباشر ومهذب لرد الإبل والغلام، ثم انتقلت إلى استحثاث سيد القوم، الحارث بن ورقاء، والاعتماد على العهود والجوار. فلما لم يجد استجابة، لجأ إلى التهديد المبطن في قصيدة حذره فيها من “منطق قذع” سيلحق به العار الأبدي. وعندما تجاهل الحارث كل هذه التحذيرات، انفجرت قريحة زهير بالهجاء الفاحش والمباشر، مما يوضح أن الهجاء عند زهير بن أبي سلمى لم يكن عملاً متسرعاً، بل كان نتيجة حتمية لتجاهل خصمه لكل محاولات الحل السلمي.
٤ – هل يمكن تقديم مثال على الهجاء الفاحش في شعر زهير، وما هو مضمونه؟
نعم، أبرز مثال هو قوله في هجاء بني أسد بعد استيلائهم على غلامه: “تَعَلَّمْ أَنَّ شَرَّ النَّاسِ حَيٌّ *** يُنَادِي فِي شِعَارِهِمْ يَسَارُ”. مضمون هذا البيت يتجاوز الذم العام إلى الطعن المباشر في الشرف والرجولة، وهو من أشد أنواع الهجاء في العصر الجاهلي. فهو يرميهم بـ “العُنّة” (الضعف الجنسي)، ويدّعي أنهم احتفظوا بغلامه “يسار” ليس كعبد، بل لأن نساءهم فُتِنَّ به ورغبن فيه لتعويض ما يفتقدنه في أزواجهن، وهو اتهام مهين يهدف إلى إلحاق عار لا يُمحى.
٥ – ما هي الأدلة التي تثبت ندم زهير على ممارسته للهجاء؟
هناك دليلان قاطعان على ندمه. الدليل الأول هو سلوكه بعد أن رد الحارث بن ورقاء إليه حقه، حيث تحول زهير فوراً من الهجاء إلى المدح فقال: “إِنَّ ابْنَ وَرْقَاءَ لَا تُخْشَى بَوَائِقُهُ *** لَكِنَّ وَقَائِعَهُ فِي الحَرْبِ تُنْتَظَرُ”، مما يثبت أن هجاءه كان مرتبطاً بالظلم فقط. أما الدليل الثاني والأقوى، فهو أنه بعد هجائه لبني جناب، شعر بالأسف الشديد و”حلف ألا يهجو أهل بيت من العرب أبداً”، وهذا القسم يعد دليلاً نهائياً على أن تجربة الهجاء عند زهير بن أبي سلمى كانت مؤلمة لنفسه وأنه رفضها كمبدأ دائم في شعره وحياته.
٦ – كيف يختلف أسلوب الهجاء عند زهير بن أبي سلمى عن شعراء الهجاء المتخصصين كالحطيئة؟
الاختلاف جوهري ويكمن في الغاية والمنهج. الحطيئة كان الهجاء لديه صناعة وهدفاً بحد ذاته، يستخدمه لابتزاز الناس وكسب المال، فكان هجاؤه شاملاً لا يفرق بين مستحق وغير مستحق. أما الهجاء عند زهير بن أبي سلمى، فكان وسيلة استثنائية لتحقيق غاية محددة وهي رد العدوان. لذلك، كان هجاؤه موجهاً وشخصياً، مرتبطاً بالحادثة، وينتهي بانتهائها. بينما هجاء الحطيئة كان طبعاً وسلوكاً عاماً ومستمراً.
٧ – ما هو الأثر الذي تركه هجاء زهير على سمعته وعلى خصومه؟
كان له أثر مزدوج. على خصومه، كان أثره مدمراً وفعالاً، فقد كان كلامه يصيب كالسهم في مقتل، ويدفعهم في النهاية إلى إعادة الحقوق لأصحابها تجنباً للمزيد من الفضيحة والعار. أما على سمعته هو، فقد ترك ندبة، حيث رأى بعض قومه، كما قال الشيخ المزيني، أن هذا الفحش في الهجاء قد “شق عنه ثوب الوقار” وقلل من تمام مروءته الشعرية. وهذا يوضح أن الهجاء عند زهير بن أبي سلمى كان سلاحاً ذا حدين.
٨ – هل يُعتبر الهجاء مكوناً أصيلاً في شعر زهير أم ظاهرة استثنائية؟
يُعتبر الهجاء ظاهرة استثنائية وعارضة بكل المقاييس. ديوانه الشعري زاخر بالحكمة والمدح الصادق ووصف الحرب والسلم، بينما لا تحتل قصائد الهجاء إلا حيزاً ضئيلاً جداً. إن ندرة هذه القصائد، وارتباطها بأحداث محددة، والندم الذي تلاها، كلها تؤكد أن الهجاء عند زهير بن أبي سلمى لم يكن أبداً جزءاً من مشروعه الشعري الأساسي، بل كان “شقشقة هدرت ثم قرت”.
٩ – كيف يوفق النقاد بين صورة زهير كشاعر حكيم وبين استخدامه للهجاء المقذع؟
يوفق النقاد بين الصورتين بالنظر إلى الهجاء ليس كنقيض للحكمة، بل كأداة اضطر الحكيم لاستخدامها حين فشلت كل أدوات الحكمة الأخرى. فالحكمة لا تعني السكوت عن الظلم، بل تعني التعامل معه بالطريقة المناسبة. حين كانت الكلمة الطيبة ممكنة، استخدمها زهير، وحين أصبح الهجاء هو اللغة الوحيدة التي يفهمها خصمه، استخدمها بمرارة. فاستخدامه للهجاء يؤكد إنسانيته ورفضه للضيم، وهي قيم لا تتعارض مع جوهر الحكمة.
١٠ – ما هي الخلاصة النهائية حول طبيعة الهجاء عند زهير بن أبي سلمى؟
الخلاصة هي أن الهجاء عند زهير بن أبي سلمى يمثل حالة فريدة من “الهجاء الأخلاقي” إذا جاز التعبير. فهو لم يكن نابعاً من حقد أو لؤم طبع، بل من إحساس عالٍ بالعدالة والكرامة. إنه هجاء الضرورة الذي يمارسه الشريف وهو كاره، ويتوقف عنه فوراً عند تحقق العدل، ويندم عليه لاحقاً. لذا، فإن هذا الجانب من شعره، رغم قذعه، يعزز صورته كشاعر ذي مبادئ راسخة، تضطره الظروف أحياناً إلى استخدام أسلحة لا تشبهه.