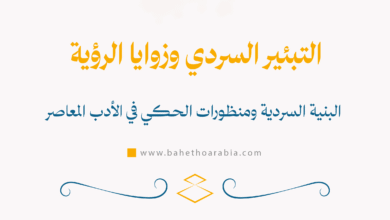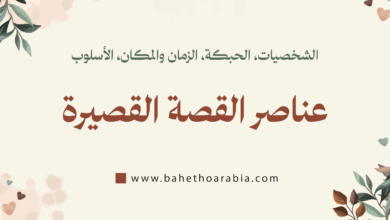الغرائبية: من تجسيد العوالم الأخرى إلى إعادة تقييم الانفتاح الثقافي
تحليل معمق لمفهوم الإعجاب بالآخر وتحدياته عبر التاريخ والفنون والثقافة

تُعد الغرائبية ظاهرة ثقافية معقدة تنشأ من التفاعل بين الذات والآخر، حيث يتم تمثيل ثقافة بعيدة أو غير مألوفة بطريقة تبسيطية ومثالية في كثير من الأحيان. هذه الظاهرة ليست مجرد إعجاب بريء، بل هي عملية بناء ثقافي تعكس علاقات القوة والفضول والتخيلات السائدة في مجتمع ما.
المقدمة: تعريف الغرائبية وتجلياتها الأولية
تُعرّف الغرائبية (Exoticism) في جوهرها بأنها الافتتان بالثقافات الأجنبية والبعيدة، وتمثيلها بطرق تؤكد على اختلافها وتميزها عن ثقافة المُشاهد أو المُبدع. تنشأ الغرائبية من مسافة جغرافية ونفسية تفصل بين “نحن” (الثقافة المألوفة والمعيارية) و”هم” (الثقافة الأخرى، الغامضة، والمثيرة). إن جوهر الغرائبية يكمن في عملية الانتقاء والتضخيم؛ حيث يتم اختيار عناصر معينة من الثقافة الأخرى – كالأزياء، العادات، الموسيقى، أو الطقوس – وتجريدها من سياقها الأصلي، ثم إعادة تقديمها بصورة تتوافق مع توقعات ورغبات الجمهور المحلي. هذه العملية غالبًا ما تؤدي إلى خلق صورة نمطية ومبسطة، تركز على الجوانب الحسية، الروحانية، أو البدائية المتخيلة في تلك الثقافة، متجاهلةً تعقيداتها وتناقضاتها الداخلية. ومع ذلك، فإن للغرائبية وجهاً آخر لا يمكن إغفاله، فهي قد تكون محركاً للفضول الفكري والإبداع الفني، ودافعاً للتواصل المبدئي مع ثقافات لم تكن لتلفت الانتباه لولا هذا الإطار الجذاب. لقد شكلت الغرائبية عبر التاريخ نافذة، وإن كانت مشوهة أحيانًا، أطلّت من خلالها الثقافات على بعضها البعض، مما أثرى الفنون والآداب والفكر. هذه المقالة تستكشف مفهوم الغرائبية في أبعاده المتعددة، متتبعةً جذوره التاريخية، وتجلياته في مختلف الحقول الإبداعية، وصولاً إلى نقده المعاصر في ضوء دراسات ما بعد الكولونيالية والعولمة، بهدف فهم كيف تتأرجح هذه الظاهرة بين كونها جسراً للتواصل الثقافي وأداة لترسيخ الهيمنة والقولبة. إن فهم آليات عمل الغرائبية يساعدنا على التمييز بين التقدير الثقافي الحقيقي والاستيلاء السطحي.
الجذور التاريخية للغرائبية: من العصور القديمة إلى عصر الاستكشاف
لا يمكن حصر ظاهرة الغرائبية في حقبة زمنية محددة، إذ إن بذورها تمتد عميقاً في التاريخ الإنساني، كلما وُجد احتكاك بين مجتمعات مختلفة. في العالم القديم، يمكن رؤية شكل مبكر من الغرائبية في كتابات المؤرخ اليوناني هيرودوت، الذي وصف عادات المصريين والفرس والسكثيين بطريقة تبرز غرابتهم واختلافهم عن الأعراف اليونانية، ممزوجة بالدهشة والإعجاب أحياناً، وبالتحفظ أحياناً أخرى. كما أن الإمبراطورية الرومانية، في أوج قوتها، أظهرت افتتاناً كبيراً بالثقافة المصرية، خاصة طقوسها الدينية وفنونها، وهو ما تجلى في استيراد المسلات وبناء الهياكل ذات الطابع المصري في روما، مما كان يهدف إلى استعراض قوة الإمبراطورية وقدرتها على احتواء العالم المعروف وامتلاك رموزه. انتقل هذا الاهتمام بتغذية نزعة الغرائبية إلى فترات لاحقة. ومع بزوغ فجر العصور الوسطى، أخذت كتابات الرحالة، مثل ماركو بولو في رحلته إلى الصين وابن بطوطة في أسفاره الواسعة، دوراً محورياً في تشكيل التصورات عن الأراضي البعيدة. قدم هؤلاء الرحالة أوصافاً مليئة بالعجائب والكنوز والثقافات الفريدة، والتي على الرغم من قيمتها التوثيقية، ساهمت في خلق صورة أسطورية عن “الشرق” وغيره من المناطق، صورة غذّت الخيال الأوروبي وألهبت فضوله. لكن التحول الجذري في تاريخ الغرائبية جاء مع عصر الاستكشاف الأوروبي بدءاً من القرن الخامس عشر. لقد أدت الرحلات البحرية الكبرى إلى “اكتشاف” عوالم جديدة بالكامل بالنسبة للأوروبيين، ونتج عن ذلك تدفق هائل للمعلومات، والسلع، والأشخاص، والقصص التي لم تكن معروفة من قبل. أصبحت المنتجات مثل التوابل والحرير والبورسلين رموزاً للفخامة والغموض، وتطورت رؤية استعلائية للآخر، حيث تم تصوير الشعوب الأصلية في الأمريكيتين وأفريقيا وآسيا إما كـ “متوحشين نبلاء” يعيشون في براءة فطرية، أو ككائنات همجية تحتاج إلى التمدين. هذا الاحتكاك غير المتكافئ، القائم على علاقة قوة استعمارية، هو الذي صاغ مفهوم الغرائبية الأوروبي الحديث، حيث لم تعد الغرائبية مجرد فضول، بل أصبحت جزءاً من الأيديولوجيا التي تبرر الهيمنة والتوسع، من خلال تأطير الثقافات الأخرى كأشياء جميلة، غامضة، وبدائية، وبالتالي قابلة للسيطرة والدراسة والامتلاك.
الغرائبية في الأدب: بناء العوالم الأخرى
وجد مفهوم الغرائبية في الأدب تربة خصبة للنمو والازدهار، حيث مكّن الكتّاب من خلق عوالم بديلة واستكشاف موضوعات إنسانية من خلال عدسة “الآخر” المختلف. في عصر التنوير، استخدم فلاسفة مثل مونتسكيو في “رسائله الفارسية” شخصيات أجنبية كأداة لنقد مجتمعاتهم الأوروبية، وهي حيلة أدبية تستخدم الغرائبية كقناع لطرح أفكار جريئة. ومع ذلك، تجلت الغرائبية الأدبية بأوضح صورها مع بزوغ الحركة الرومانسية في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. كانت الرومانسية، كثورة على العقلانية الصارمة للتنوير، تبحث عن العاطفة، والخيال، والجمال في كل ما هو بعيد وغير مألوف. وجد الشعراء والروائيون الرومانسيون في “الشرق” و”العوالم الجديدة” مصدراً لا ينضب للإلهام. أعمال مثل “أتالا” لشاتوبريان، التي تصور قصة حب مأساوية في براري أمريكا الشمالية، وقصائد اللورد بايرون المستوحاة من رحلاته في اليونان والشرق الأدنى، كلها أمثلة ساطعة على كيفية توظيف الغرائبية لخلق أجواء من الشغف والغموض والجمال الحزين. لقد كانت هذه الأعمال تبني صورة مثالية عن الآخر، صورة تتجاهل الواقع الاجتماعي والسياسي المعقد لتلك المناطق، وتركز بدلاً من ذلك على المناظر الطبيعية الخلابة والعواطف الجياشة. يُعد الاستشراق (Orientalism)، كما حلله المفكر إدوارد سعيد، أبرز صور الغرائبية الأدبية وأكثرها إشكالية. فالأدب الاستشراقي لم يكن مجرد تصوير بريء للشرق، بل كان نظاماً معرفياً متكاملاً أنتجه الغرب لـ “فهم” الشرق و”السيطرة” عليه. لقد بنى الكتاب والفنانون الغربيون صورة نمطية عن الشرق باعتباره مكاناً للحسية المفرطة، والاستبداد السياسي، واللاعقلانية، والخلود السكوني، في مقابل الغرب العقلاني، الديمقراطي، والديناميكي. هذه الثنائية خدمت الأجندة الإمبريالية وعززت الشعور بالتفوق الغربي. إن فهم الغرائبية في الأدب يتطلب النظر إلى ما هو أبعد من مجرد الإعدادات والموضوعات.
تتجلى خصائص الغرائبية الأدبية في عدة جوانب، يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- مثالية المكان: يتم تصوير البيئات الطبيعية (الصحاري، الأدغال، الجزر الاستوائية) كفضاءات نقية، عنيفة، أو ساحرة، منفصلة عن الواقع اليومي المعاش لسكانها. هذه الأماكن تصبح مسرحاً للأحداث الدرامية بدلاً من كونها أوطاناً حقيقية. إن هذه المثالية هي سمة أساسية في أعمال الغرائبية.
- نمطية الشخصيات: غالباً ما يتم اختزال الشخصيات “الغريبة” في نماذج مكررة: الشيخ الحكيم الغامض، الأميرة الأسيرة الحسناء، المحارب الشجاع والبدائي، أو التاجر الماكر. هذه الشخصيات تفتقر إلى العمق النفسي وتعمل كرموز أو أدوات لخدمة الحبكة التي تتمحور حول البطل الغربي. هذه القولبة هي إحدى إشكاليات الغرائبية.
- التركيز على الحسي والغامض: يميل الأدب الذي يوظف الغرائبية إلى التضخيم من العناصر الحسية مثل الألوان الزاهية، الروائح النفاذة، الأصوات الغريبة، والطقوس المبهمة. الهدف هو خلق جو من الغموض والإثارة يداعب خيال القارئ الغربي.
- استخدام المفردات الأجنبية: يتم إقحام كلمات من لغات أخرى في النص (مثل باشا، بازار، جن) لإضفاء “نكهة” محلية وإيهام القارئ بالأصالة، حتى لو كان استخدامها سطحياً أو غير دقيق. هذه التقنية تعزز الإحساس بالغرائبية.
الفنون البصرية والموسيقية: تجسيد الغرائبية سمعياً وبصرياً
لم يقتصر تأثير الغرائبية على الأدب، بل امتد بقوة ليشمل الفنون البصرية والموسيقية، حيث وجد الفنانون والموسيقيون في الثقافات البعيدة مادة غنية للتعبير عن رؤاهم وتجاوز التقاليد الفنية السائدة في مجتمعاتهم. في الفن التشكيلي، كانت الغرائبية محركاً أساسياً للعديد من الحركات الفنية، خاصة في القرن التاسع عشر. يُعد الرسام الفرنسي أوجين ديلاكروا مثالاً بارزاً، فلوحاته المستوحاة من رحلته إلى المغرب، مثل “نساء الجزائر في مخدعهن”، مليئة بالألوان الدافئة والضوء المسرحي والأقمشة الفاخرة، مقدمةً رؤية حسية ورومانسية عن الحياة في “الحريم”. كذلك، اهتم فنانون مثل جان ليون جيروم وجان أوغست دومينيك آنغر برسم مشاهد من الشرق، تركز على الحمامات، وأسواق الرقيق، والمشاهد الصحراوية، وهي صور عززت الأفكار النمطية عن الكسل والشهوانية التي ربطها الخيال الأوروبي بالشرق. لقد كانت هذه اللوحات تخلط بين الدقة في تصوير بعض التفاصيل الزخرفية والخيال المحض في بناء المشهد العام، مما أنتج نوعاً من الواقعية الزائفة التي تخدم رغبات الجمهور الأوروبي في استهلاك الغرائبية البصرية. لم تقتصر الغرائبية على اللوحات الزيتية، بل ظهرت بوضوح في الفنون الزخرفية، مثل طراز “الشنوازري” (Chinoiserie) في القرن الثامن عشر، الذي قلد الزخارف والأساليب الفنية الصينية في الأثاث والخزف وتصميم الحدائق الأوروبية، وطراز “التوركري” (Turquerie) الذي استلهم من الفن العثماني. لقد كانت هذه الأساليب تعبيراً عن الترف والمكانة الاجتماعية، حيث كان امتلاك “قطعة من الشرق” دليلاً على الثقافة الواسعة والثراء. وفي عالم الموسيقى، وجدت الغرائبية طريقها إلى أعمال كبار المؤلفين الموسيقيين. يمكن تتبع هذه النزعة إلى أعمال مثل “المسيرة التركية” لموتسارت، التي استخدمت إيقاعات وآلات إيقاعية لمحاكاة موسيقى الفرق العسكرية العثمانية التي كانت تثير الرهبة والفضول في أوروبا. وفي القرن التاسع عشر، أصبحت الغرائبية الموسيقية أكثر تعقيداً، حيث سعى المؤلفون إلى استحضار أجواء أماكن بعيدة من خلال استخدام سلالم موسيقية غير مألوفة (مثل السلم الخماسي لاستحضار أجواء شرق آسيا)، وتوزيع أوركسترالي مبتكر، وإيقاعات راقصة “غريبة”. أوبرا “كارمن” لجورج بيزيه هي مثال كلاسيكي على الغرائبية، حيث تم تصوير إسبانيا كعالم مليء بالغجر المتمردين ومصارعي الثيران الشجعان والعواطف الجامحة، مع استخدام موسيقى مستوحاة من الفلكلور الإسباني. كما أن مؤلفين مثل ديبوسي في مقطوعته “Pagodes” استلهموا من موسيقى الجاملان الإندونيسية، وروسكي-كورساكوف في “شهرزاد” استند إلى حكايات ألف ليلة وليلة لخلق عالم صوتي ساحر ومليء بالألوان الشرقية. إن الغرائبية في الموسيقى، كما في الفن التشكيلي، كانت غالباً ما تعتمد على الانطباعات والتخيلات أكثر من اعتمادها على دراسة عميقة للتقاليد الموسيقية الأصلية، فكان الهدف هو إثارة شعور بالاختلاف والدهشة لدى المستمع الغربي، وليس تقديم تمثيل دقيق لتلك التقاليد.
الغرائبية من منظور الأنثروبولوجيا وما بعد الكولونيالية
تقدم الأنثروبولوجيا النقدية ودراسات ما بعد الكولونيالية تحليلاً جذرياً ومغايراً لمفهوم الغرائبية، حيث تنتقل من النظر إليه كظاهرة فنية أو فضول ثقافي بريء إلى اعتباره أداة معرفية وسياسية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتاريخ الإمبريالية وعلاقات القوة العالمية. من هذا المنظور، لا تنفصل الغرائبية عن عملية بناء “الآخر” (The Other)، وهي العملية التي تقوم من خلالها الثقافة المهيمنة بتعريف نفسها عبر تحديد ما هي ليست عليه. يتم بناء الذات (الغربية، العقلانية، المتقدمة) في مقابل الآخر (الشرقي/الأفريقي/الأصلي، اللاعقلاني، البدائي). تعمل الغرائبية كآلية جمالية لهذه العملية، إذ تجعل “الآخر” موضوعاً للفرجة والمتعة، ولكنها في الوقت نفسه تثبّته في مكانة أدنى ضمن تسلسل هرمي ثقافي. لقد كانت الأنثروبولوجيا في بداياتها متورطة في هذه العملية، حيث كان علماء الأنثروبولوجيا الأوائل يذهبون لدراسة “الشعوب البدائية” بهدف توثيق عاداتهم الغريبة قبل أن “تندثر”، وهي نظرة أبوية تفترض أن هذه الثقافات جامدة وغير قادرة على التطور بنفسها. هذه النظرة للغرائبية تفضح كيف يمكن للمعرفة أن تكون في خدمة السلطة. تكمن إشكالية الغرائبية الأساسية، وفقاً لهذا النقد، في أنها عملية تجريد واختزال. فهي تنتزع الممارسات الثقافية والرموز الفنية من سياقاتها الاجتماعية والدينية والتاريخية الحية، وتحولها إلى مجرد “مظاهر” أو “علامات” للاختلاف. على سبيل المثال، قد يتم الإعجاب بقناع أفريقي لجماله التجريدي في متحف غربي، مع تجاهل كامل لوظيفته الطقسية ودوره الروحي في مجتمعه الأصلي. هذا التجريد يحول الثقافة إلى سلعة قابلة للاستهلاك، ويفقدها معناها وعمقها. نظرية ما بعد الكولونيالية، وخاصة أعمال مفكرين مثل إدوارد سعيد وفرانز فانون وغاياتري سبيفاك، تعمّق هذا النقد. يرى سعيد أن الغرائبية، في شكلها الاستشراقي، ليست مجرد مجموعة من الصور النمطية، بل هي خطاب (Discourse) متكامل أنتج معرفة عن الشرق خدمت الأهداف الاستعمارية. إن نقد الغرائبية ما بعد الكولونيالي لا يهدف إلى رفض أي شكل من أشكال التفاعل الثقافي، بل يدعو إلى الوعي بعلاقات القوة المتضمنة فيه.
يقوم النقد ما بعد الكولونيالي للغرائبية على عدة محاور أساسية:
- تكريس اللامساواة: الغرائبية هي علاقة ذات اتجاه واحد، حيث تملك الثقافة المهيمنة القوة لتمثيل الثقافات الأخرى وتعميم هذه التمثيلات، بينما نادراً ما تتاح للثقافات الأخرى الفرصة لتمثيل الثقافة المهيمنة بنفس الطريقة. هذا يعزز الهيمنة الثقافية للغرب.
- التشييء والتجريد من الإنسانية: من خلال التركيز على الجوانب الحسية والغامضة، تحول الغرائبية البشر إلى مواضيع فنية أو عناصر ديكورية. يتم الإعجاب بـ “جمالهم البدائي” أو “روحانيتهم الفطرية”، ولكن نادراً ما يتم الاعتراف بهم كذوات فاعلة لها تاريخها وتطلعاتها السياسية وصوتها الخاص.
- حجب الواقع: الصورة الرومانسية والمثالية التي تقدمها الغرائبية غالباً ما تخفي وراءها واقعاً قاسياً من الاستغلال الاقتصادي، والقمع السياسي، والتدمير البيئي الذي تسببت به القوى الاستعمارية. فالتركيز على “سحر الشرق” يتجاهل تاريخ الهيمنة الغربية عليه.
- الاستغلال التجاري: في عالم اليوم، أصبحت الغرائبية أداة تسويقية قوية. يتم استخدام صور مبسطة للثقافات “الغريبة” لبيع كل شيء، من رحلات سياحية ومنتجات تجميل إلى ديكورات منازل، في عملية تُعرف بالاستيلاء الثقافي (Cultural Appropriation)، حيث يتم جني الأرباح من ثقافة ما دون الاعتراف بمصدرها أو مشاركة أهلها في الفائدة. إن فهم هذه الأبعاد النقدية للغرائبية ضروري لتجاوزها نحو تفاعل ثقافي أكثر عدلاً واحتراماً.
الغرائبية في العصر الحديث: من السياحة إلى الثقافة الرقمية
لم تختفِ الغرائبية مع نهاية الحقبة الاستعمارية الرسمية، بل تكيفت واتخذت أشكالاً جديدة في عالمنا المعولم. أصبحت السياحة العالمية واحدة من أبرز ساحات تجلي الغرائبية المعاصرة. يسافر الملايين سنوياً بحثاً عن تجارب “أصيلة” و”غريبة” في وجهات بعيدة. غالباً ما يتم تسويق هذه الوجهات من خلال صور نمطية تعزز الغرائبية: الشواطئ الاستوائية البكر، الأسواق الشرقية الصاخبة، المعابد الآسيوية الهادئة، أو القرى الأفريقية “التقليدية”. يسعى السائح الحديث إلى استهلاك “الاختلاف”، ولكن ضمن إطار آمن ومُنظم يلبي راحته وتوقعاته. هذا يؤدي إلى ما يسمى بـ “الغرائبية المُدجّنة”، حيث يتم تنظيم عروض فلكلورية ورقصات تقليدية خصيصاً للسياح، وتُصمم تجارب “لقاء السكان المحليين” بطريقة مسرحية، مما يحول الثقافة الحية إلى منتج سياحي. إن هذه الصناعة تعيد إنتاج ديناميكيات الغرائبية القديمة، حيث يصبح السكان المحليون جزءاً من “المشهد” الذي يستهلكه السائح الغربي. كما أن عالم الموضة والإعلان يستخدم الغرائبية بشكل مكثف. تستلهم دور الأزياء العالمية مجموعاتها من “الزخارف القبلية” الأفريقية، أو “التطريزات” الهندية، أو “الكيمونو” الياباني، وغالباً ما يتم ذلك دون فهم عميق للمعاني الثقافية لهذه العناصر أو إعطاء الفضل لمصمميها الأصليين. الإعلانات التجارية تبيع المنتجات عبر ربطها بصور مثالية عن أماكن “غريبة”، مثل بيع سيارة من خلال عرضها وهي تسير في صحراء شاسعة مع موسيقى تصويرية “شرقية”، أو بيع مشروب عبر تصوير أشخاص يستمتعون به على شاطئ استوائي. هذه الاستراتيجيات التسويقية تعتمد على قوة الغرائبية في إثارة مشاعر الهروب والمغامرة والتميز لدى المستهلك. ومع ظهور الثقافة الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، اكتسبت الغرائبية بعداً جديداً. منصات مثل انستغرام أصبحت مسرحاً لاستعراض “نمط الحياة الغريب”. يقوم “مؤثرو السفر” بالتقاط صور احترافية في مواقع “غريبة” حول العالم، مقدمين نسخة منمقة ومفلترة من الواقع. هذه الصور غالباً ما تركز على الجماليات السطحية وتتجاهل السياقات الاجتماعية والسياسية المعقدة، معززةً فكرة أن العالم هو مجرد خلفية جميلة لالتقاط الصور الشخصية. إن هذه النسخة الرقمية من الغرائبية سريعة الانتشار وسهلة الاستهلاك، وهي تساهم في تسطيح فهمنا للثقافات الأخرى وتحويلها إلى مجرد “محتوى” بصري جذاب. على الرغم من هذه الجوانب الإشكالية، يمكن أن تحمل الغرائبية المعاصرة أيضاً بذوراً لتفاعلات إيجابية، فالعولمة تتيح وصولاً غير مسبوق للمعلومات، مما قد يساعد على تفكيك الصور النمطية.
الخاتمة: إعادة تقييم الغرائبية بين الانفتاح الثقافي والهيمنة
في الختام، تظل الغرائبية مفهوماً جدلياً ومعقداً يكشف الكثير عن طبيعة التفاعل الثقافي عبر التاريخ. لقد بدأت كفضول إنساني طبيعي تجاه المجهول، ثم تحولت عبر العصور لتصبح أداة جمالية في الفنون والآداب، قبل أن تتشابك بشكل وثيق مع المشاريع الاستعمارية وتصبح جزءاً من خطاب الهيمنة الثقافية. وفي عصرنا الحالي، تستمر الغرائبية في الحضور بأشكال متجددة في السياحة والإعلام والثقافة الاستهلاكية. إن الرحلة عبر تاريخ وتجليات الغرائبية تعلمنا أن الإعجاب بالثقافات الأخرى ليس ظاهرة بسيطة أو محايدة أبداً، بل هو محكوم بسياقات القوة والمعرفة والرغبة. لقد كانت الغرائبية في كثير من الأحيان مرآة عكست خيالات ومخاوف وتحيزات الثقافة المهيمنة أكثر مما قدمت صورة حقيقية عن الثقافات التي صورتها. ومع ذلك، فإن إدانة الغرائبية بشكل مطلق قد يقودنا إلى نوع من الانغلاق الثقافي. التحدي الحقيقي يكمن في تجاوزها نحو شكل من أشكال الانفتاح الثقافي القائم على الاحترام المتبادل والفضول النقدي. إن تجاوز إشكاليات الغرائبية يتطلب الانتقال من الرغبة في “استهلاك” الآخر المختلف إلى السعي لـ “فهمه” في سياقه الخاص، والاعتراف بتعقيداته وصوته. وهذا يتطلب جهداً واعياً للاستماع إلى الروايات التي تقدمها الثقافات عن نفسها، بدلاً من الاكتفاء بالصور التي صنعناها عنها. فالفرق بين الغرائبية السطحية والفهم الثقافي العميق هو الفرق بين النظر إلى الآخر كموضوع غامض للفرجة، والتعامل معه كشريك متساوٍ في الحوار الإنساني. إن الوعي بتاريخ وآليات عمل الغرائبية هو الخطوة الأولى نحو بناء علاقات ثقافية أكثر عدلاً وإنصافاً في عالم يزداد ترابطاً يوماً بعد يوم.
سؤال وجواب
- وفقاً للمقالة، ما هو جوهر عملية الغرائبية؟
أ) التوثيق الدقيق للثقافات الأخرى.
ب) الانتقاء والتضخيم لعناصر معينة من ثقافة ما.
ج) التبادل الثقافي المتكافئ بين الشعوب. - أي من الحركات الأدبية التالية ارتبطت بقوة بظاهرة الغرائبية في القرن التاسع عشر؟
أ) الحركة الكلاسيكية.
ب) الحركة الواقعية.
ج) الحركة الرومانسية. - من هو المفكر الذي حلل “الاستشراق” كأبرز صور الغرائبية الأدبية وأكثرها إشكالية؟
أ) فرانز فانون.
ب) إدوارد سعيد.
ج) هومي بابا. - في الفنون البصرية، أي من الأساليب التالية يعد مثالاً على الغرائبية؟
أ) التكعيبية.
ب) الشنوازري (Chinoiserie).
ج) الانطباعية. - ما هي السمة الأساسية للشخصيات “الغريبة” في الأدب الذي يوظف الغرائبية؟
أ) العمق النفسي والتعقيد.
ب) النمطية والاختزال في نماذج مكررة.
ج) التطور المستمر طوال الرواية. - وفقاً للنقد ما بعد الكولونيالي، كيف تخدم الغرائبية الهيمنة الثقافية؟
أ) من خلال تشجيع الحوار المتساوي.
ب) من خلال تقديم تمثيل دقيق للواقع.
ج) من خلال جعل الثقافة الأخرى موضوعاً للفرجة والاستهلاك. - في أي مجال معاصر تظهر “الغرائبية المُدجّنة” بشكل واضح؟
أ) البحث العلمي الأكاديمي.
ب) صناعة السياحة العالمية.
ج) الترجمة الأدبية الاحترافية. - مقطوعة “المسيرة التركية” لموتسارت هي مثال على الغرائبية في أي مجال؟
أ) الأدب.
ب) الفن التشكيلي.
ج) الموسيقى. - ما هو المصطلح الذي يصف استغلال عناصر ثقافة ما تجارياً دون الاعتراف بمصدرها؟
أ) التثاقف (Acculturation).
ب) العولمة (Globalization).
ج) الاستيلاء الثقافي (Cultural Appropriation). - ما هو التحدي الأساسي لتجاوز إشكاليات الغرائبية كما ورد في الخاتمة؟
أ) الانغلاق على الثقافة الذاتية وتجنب الآخر.
ب) الانتقال من استهلاك الآخر إلى فهمه في سياقه.
ج) التركيز فقط على الجوانب الجمالية للثقافات.
الإجابات الصحيحة:
- ب
- ج
- ب
- ب
- ب
- ج
- ب
- ج
- ج
- ب