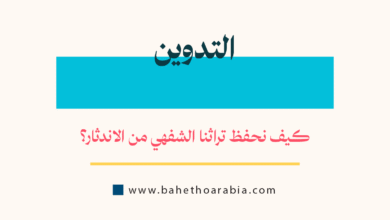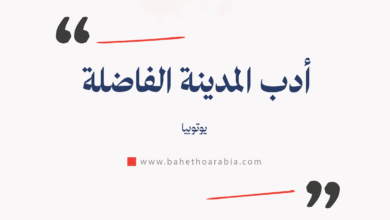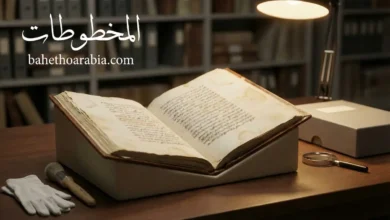الاستطراد في الأدب والخطاب العربي: فن التوغل وعمق الإبداع
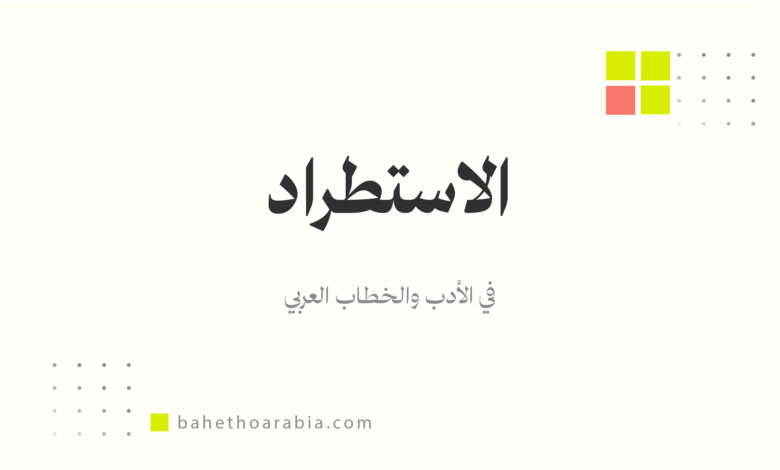
يُعد الاستطراد ظاهرة لغوية وبلاغية تتجاوز مجرد الانحراف عن الموضوع الأصلي، فهو فن متجذر في الوعي الإنساني والخطاب البشري على مر العصور. إنه ليس مجرد إضافة عرضية، بل هو أسلوب يثري النصوص ويمنحها عمقًا متعدد الأبعاد. تتجلى قيمته في قدرته على ربط الأفكار، حتى تلك التي تبدو متباعدة في ظاهرها، مما يجعله تعبيرًا عن حالات نفسية وفكرية عميقة لدى المتكلم. يرتبط الاستطراد ارتباطًا وثيقًا بالدواعي النفسية للمتكلم، حيث يمكن أن يكون انعكاسًا لتدفق الأفكار أو رغبة في استكشاف جوانب خفية أو إثراء المعنى بما يتجاوز السرد المباشر. هذه الخاصية تجعله أداة ديناميكية تمنح النص حيوية وتجددًا، وتضيف إليه طبقات من الدلالة لا يمكن تحقيقها بالخطاب الخطي المباشر وحده.
تعريف لغوي واصطلاحي للاستطراد
لفهم الاستطراد بعمق، لا بد من تأصيل مفهومه لغويًا واصطلاحيًا. لغويًا، يتضمن الاستطراد في أصله من الفعل “طَرَدَ” معاني متعددة. فهو يحمل معنى “الإبعاد”، كما في قول “أطرده السلطان” إذا أمر بإخراجه عن بلده. كما يأتي بمعنى “الضم”، مثل “طردتُ الإبلَ” أي ضممتها من نواحيها. الأهم في سياقنا هذا هو معنى “التتابع”؛ فـ”اطَّرد الشيء” يعني أن يتبع بعضه بعضًا ويجري، و”اطَّرد الأمر” يعني استقامته وانتظامه. إن التأصيل اللغوي لمصطلح “الاستطراد” يكشف عن طبيعته الديناميكية المتدفقة، فهو ليس مجرد انحراف عشوائي، بل حركة متتابعة ومنسجمة. هذا الفهم اللغوي يمهد لإدراك أعمق للاستطراد كظاهرة بيانية تحمل في طياتها إبداعًا في الربط بين الأفكار، حتى وإن بدت متباعدة في ظاهرها. إنه يشير إلى أن الاستطراد الحقيقي ينطوي على نوع من التدفق المنظم، وليس مجرد قفز غير مبرر بين الموضوعات.
اصطلاحياً، يُعرّف الاستطراد بأنه خروج المتكلم من الغرض الذي هو فيه إلى غرض آخر لمناسبة أو علاقة بينهما، ثم يعود لينتقل إلى إتمام الكلام الأول. هذه العودة إلى الموضوع الأصلي هي ما يميز الاستطراد عن مجرد التشتت أو الخروج العشوائي عن السياق. فالمناسبة الرابطة بين الموضوعين، والعودة إلى الأصل، هما الركنان الأساسيان اللذان يحددان طبيعة الاستطراد كفن بلاغي مقصود.
أهمية الاستطراد في إثراء النصوص وتعميق المعاني
يُعد الاستطراد فنًا بلاغيًا دقيق المجرى، غزير الفوائد، يعتمد عليه الفصحاء والبلغاء على حد سواء لتعزيز بلاغة خطابهم. تكمن أهميته في قدرته على إثراء النصوص وتعميق معانيها بطرق متعددة. فهو لا يضيف معلومات فحسب، بل ينسج شبكة من العلاقات الدلالية التي تثري التجربة القرائية أو الاستماعية. يساهم الاستطراد بفعالية في تقوية الرغبة وشحذ الهمة لدى المتلقي، حيث يكسر رتابة السرد المباشر ويقدم أبعادًا جديدة للموضوع. وله القدرة على إلهاب الحماس وتحريك العواطف، مما يعزز من تأثير الخطاب ويجعله أكثر رسوخًا في الذهن. هذه القدرة على التفاعل مع المتلقي على مستويات متعددة، فكرية وعاطفية، هي ما يجعله أداة بلاغية قوية ومؤثرة.
نظرة عامة على محاور المقال
تستكشف هذه المقالة الاستطراد كفن بلاغي متكامل، بدءًا من نشأته وتطوره في البلاغة العربية، مرورًا بتجلياته المتنوعة في النصوص الدينية والأدبية الكلاسيكية والحديثة. كما تتعمق في أبعاده الفكرية والفلسفية وتطبيقاته في الخطاب اليومي والسياسي، وتناقش أغراضه الفنية وتأثيره على المتلقي.
المبحث الأول: الاستطراد في البلاغة العربية: نشأة وتطور وتأصيل
تعريف الاستطراد في الدراسات البلاغية القديمة والحديثة
تناول البلاغيون العرب القدامى الاستطراد كفن من فنون البديع، وهو أحد الأقسام الثلاثة لعلوم البلاغة العربية (البيان، والمعاني، والبديع). وقد ورد ذكره ركنًا ركينًا في مؤلفات كبار العلماء مثل السكاكي، وابن سنان الخفاجي، وعبدالقاهر الجرجاني، والخطيب القزويني، وابن معصوم المدني، والآمدي.
عرف الجرجاني الاستطراد بأنه “سَوقُ الكلام على وجهٍ يَلزم منه كلامٌ آخرُ، وهو غير مقصود بالذات، بل بالعَرَض”. هذا التعريف يشير إلى أن الموضوع الفرعي الذي يُستطرد إليه ليس هو الهدف الأساسي من الكلام، بل يظهر بشكل عرضي نتيجة لمناسبة أو علاقة مع الموضوع الأصلي. أما السيوطي، فقد أضاف تعريفًا يوضح طبيعة الانتقال، فقال: “الاستطراد: أن يكون في شيءٍ من الفنون، ثم سنَح له فنٌّ آخر يُناسبه، فيُورِده في ذِكره”. هذا يؤكد على ضرورة وجود مناسبة تربط بين الفن الأصلي والفن المستطرد إليه، مما يضمن عدم تشتت المعنى الكلي للنص.
في الدراسات الحديثة، استمر الاهتمام بالاستطراد، حيث تناولته أبحاث معاصرة كـ”دراسة تاريخية فنية تطبيقية”. هذا التناول الحديث يدل على استمرارية البحث في هذا الفن وتطوره، وإعادة قراءته في سياقات جديدة، مما يعكس مرونته وقدرته على التكيف مع أشكال الخطاب المختلفة.
الفرق بين الاستطراد والفنون البلاغية المشابهة (كالاعتراض)
يُعد الاستطراد قريبًا من فن الاعتراض، الذي يُعرف بأنه إيراد كلام بين كلامين متصلين معنىً لغرض معين كالتوضيح أو التفسير أو الدعاء. إلا أن هناك فرقًا جوهريًا يميز الاستطراد ويمنحه خصوصيته. فبينما الاعتراض قد يكون قبيحًا أو حسنًا أو متوسطًا، تبعًا لمدى انسجامه مع السياق وخدمته للمعنى، فإن الاستطراد “حسن كله”. هذا الحكم القيمي يشير إلى أن الاستطراد الفعال يتطلب دوماً وجود “مناسبة” قوية أو غرض فني يبرر الخروج عن الموضوع الأصلي. هذا الشرط يمنعه من أن يكون مجرد مقاطعة أو تشتيت، مما يرفع من شأن هذا الفن كتقنية تتطلب مهارة ودقة في التوظيف. فالاستطراد الناجح هو الذي يضيف قيمة حقيقية للنص دون أن يخل بتماسكه أو وضوحه، بينما الاعتراض قد يؤدي أحيانًا إلى الإخلال بالمعنى إذا لم يُوظف ببراعة.
شيوع الاستطراد وقيمته الجمالية والبلاغية في الأدب العربي القديم
كان الاستطراد شائعًا وكثيرًا في الأدب العربي، سواء في الشعر أو النثر، خاصة في الشعر الجاهلي وما تلاه من عصور الاحتجاج. هذا الشيوع يدل على كونه جزءًا أصيلًا من البلاغة العربية ووسيلة تعبيرية مفضلة لدى كبار الأدباء. ترتبط قيمته الجمالية والبلاغية ارتباطًا وثيقًا بالدواعي النفسية للمتكلم، مما يجعله تعبيرًا عن حالات فكرية وعاطفية عميقة. فالشاعر أو الخطيب قد يستطرد ليعبر عن فكرة طرأت على ذهنه، أو ليثير عاطفة معينة، أو ليعمق معنىً بطريقة غير مباشرة.
في العصر الجاهلي، كان يُنظر إلى الاستطراد والإطالة كسمة تُحمد للشاعر، حيث تدل على طول نفسه وقدرته على التطرق لموضوعات أخرى، سواء كانت قريبة المعنى أو بعيدة عن المعنى الأساسي للقصيدة. إن التقدير التاريخي للاستطراد في الشعر الجاهلي، حيث كان يُنظر إليه كدليل على “طول النفس” والبراعة الشعرية، يوضح أن قيمة هذه الظاهرة البلاغية ليست ثابتة، بل تتأثر بالسياق الثقافي والزمني. فما قد يُعد عيبًا أو تشتيتًا في عصر ما، كان يُنظر إليه كفضيلة تعكس اتساع أفق الشاعر وقدرته على الربط بين المعاني في عصر آخر، مما يكشف عن مرونة المعايير النقدية وتطورها عبر الزمن. هذه المرونة في التقييم تعكس الطبيعة المتغيرة للذوق الأدبي والمعايير البلاغية.
جدول 1: مقارنة بين الاستطراد وبعض الفنون البلاغية المشابهة
لفهم الفروق الدقيقة بين الاستطراد والفنون البلاغية الأخرى، يقدم الجدول التالي مقارنة توضيحية:
| الميزة / الفن البلاغي | الاستطراد | الاعتراض | التذييل |
| التعريف المختصر | الخروج من غرض إلى آخر لمناسبة ثم العودة للأول. | إيراد كلام بين كلامين متصلين معنىً. | إيراد كلام بعد تمام المعنى لتأكيده. |
| العودة للموضوع الأصلي | نعم (أساسي للتعريف) | لا يشترط العودة (يمكن أن يكون جملة اعتراضية) | لا يوجد خروج أصلاً، بل تأكيد. |
| القيمة البلاغية/الحكم | حسن كله (إذا توافرت المناسبة) | يقبح ويحسن ويتوسط | حسن (لأغراض التأكيد) |
| الغرض الأساسي | إثراء المعنى، تعميق الفكرة، هجاء/مدح غير مباشر، إثارة التأمل | توضيح، تفسير، تنبيه، دعاء | تأكيد، تقوية المعنى، إيضاح. |
هذا الجدول يسهم في وضوح المفاهيم للقارئ، حيث يساعد على التمييز الدقيق بين الاستطراد والفنون البلاغية الأخرى التي قد تبدو متشابهة، مما يمنع اللبس الاصطلاحي ويعزز الفهم الدقيق للمصطلح. كما يُظهر فهمًا متعمقًا للفروقات الدقيقة في علم البلاغة، وهو ما يتناسب مع المستوى الأكاديمي للمقالة ويضيف قيمة تحليلية لها. ويعزز الجانب النظري للمقال بتقديم مقارنة منهجية مبنية على تعريفات البلاغيين، مما يرسخ الأساس العلمي للمقالة.
المبحث الثاني: تجليات الاستطراد في النصوص الدينية والأدبية الكلاسيكية
الاستطراد في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف: أمثلة ودلالات
يُعد الاستطراد أسلوبًا بلاغيًا حاضرًا في أسمى النصوص العربية، وهو القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، مما يبرز قيمته الفنية والدلالية.
في القرآن الكريم: من أمثلة الاستطراد في القرآن الكريم قوله تعالى: “أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون”. يُفسَّر هذا الاستطراد بأن المراد كان الإخبار عن سجود كل شيء لله تعالى، وإن كان ابتداء الكلام في أمر خاص يتعلق بظلال الأشياء. هذا الانتقال من الخاص إلى العام، ومن الظاهرة الطبيعية إلى الحقيقة الكونية، يدل على اتساع الدلالة وعمق المعنى، حيث يوجه القرآن المتلقي للتأمل في عظمة الخالق من خلال مظاهر الكون المختلفة. إن وجود الاستطراد في نصوص مقدسة كالقرآن الكريم يمنحه بعدًا إلهيًا، مما يوحي بأن الخروج عن السياق المباشر لغرض أسمى، كتعميم الدلالة أو إثراء المعنى، هو أسلوب بلاغي فطري وفعّال.
في كتب التفسير: شهدت كتب التفسير شيوعًا وكثرة في الاستطرادات، التي كانت تحمل قيمة علمية كبيرة، حيث كان المفسرون يستطردون لبيان مسائل فقهية، لغوية، تاريخية، أو علمية تتعلق بالآيات. ومع ذلك، في كثير من المواضع، طغت هذه الاستطرادات على بيان معاني ومقاصد وهدايات الآيات، التي هي المقصود الأول والأهم من التفسير. هذا يبرز التحدي البشري في تحقيق التوازن بين الإثراء والوضوح في الخطاب، فبينما الاستطراد الإلهي يأتي دائمًا لغرض محكم، قد يقع البشر في الإفراط الذي يطغى على الهدف الأساسي للنص.
الاستطراد في الشعر العربي القديم: دراسة تطبيقية لأبرز النماذج
تُظهر الأمثلة الكلاسيكية للاستطراد بوضوح أنه ليس مجرد انحراف عشوائي، بل هو حركة بلاغية محسوبة تتميز بوجود “مناسبة” دقيقة تربط بين الموضوع الأصلي والموضوع الفرعي. هذه المناسبة تتيح للشاعر تحقيق أغراض فنية متعددة، مثل الهجاء المبطن أو تعزيز المدح، مما يضفي على النص طبقات من المعنى ويبرز القدرة الإبداعية للمتكلم في نسج الأفكار.
- السموأل: يُعتبر السموأل من أوائل الشعراء الذين أجادوا الاستطراد في الشعر، وذلك في قوله الشهير: “وإنا لقوم لا نرى القتل سبة… إذا ما رأته عامر وسلولُ يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه آجالهم فتطول”. هنا، ينتقل الشاعر ببراعة من الفخر بقومه وشجاعتهم وعدم خوفهم من الموت، إلى هجاء قبيلتي عامر وسلول اللتين تخافان الموت وتعتبرانه عارًا، ثم يعود لتعزيز فخره بقومه. هذا المثال يبرز الاستطراد كأداة للفخر والهجاء في آن واحد، ويظهر قدرة الشاعر على التلاعب بالمعاني لتحقيق أغراض متعددة.
- أبو تمام: يُنسب إلى أبي تمام مصطلح “المستطرد” أو “الاستطراد” في سياق يصف فيه فرسًا، لكن الغرض الحقيقي من هذا الوصف كان هجاء عثمان بن إدريس الشامي. يقول في وصف الفرس: “وسابح هطل التعداء هتان على الجراء أمين غير خوان أظمى الفصوص ولم تظمأ قوائمه فخل عينيك في ريان ظمآن ولو تراه مشيحا والحصى فلق بين السنابك من مثنى ووحدان أيقنت – إن لم تثبت – أن حافره من صخر تدمر أو من وجه عثمان”. هذا المثال يوضح استخدام الاستطراد كأداة للهجاء غير المباشر والذكي، حيث يتم إخفاء القصد الحقيقي وراء وصف ظاهري للفرس، ثم يُفاجأ المتلقي بالانتقال إلى الهجاء.
- حسان بن ثابت: في قوله مخاطبًا محبوبته: “إن كنت كاذبة الذي حدثتني فنجوت منجى الحارث بن هشام ترك الأحبة أن يقاتل دونهم ونجا برأس طمرة ولجام”. هنا، يشبه حسان نجاة محبوبته بنجاة الحارث بن هشام الذي فر من المعركة، وهو تشبيه يحمل ذمًا مبطنًا في سياق الغزل. هذا يظهر براعة الاستطراد في الجمع بين المتناقضات (الغزل والذم)، ويجعل المعنى أكثر عمقًا وتعقيدًا.
- زهير بن أبي سلمى: من أمثلة الاستطراد التي تُظهر الانتقال من الذم إلى المدح قول زهير: “إن البخيل ملوم حيث كان ولكن الجواد على علاته هرم”. يبدأ الشاعر بذم البخيل، ثم يستطرد ليمدح الجواد، مما يبرز التباين ويقوي المعنى المراد إيصاله حول فضل الجود.
المبحث الثالث: الاستطراد في السرد العربي الحديث والمعاصر
الاستطراد في الرواية العربية الحديثة: تقنيات السرد غير الخطي والميتا سرد
في السرد الحديث، يتجاوز الاستطراد كونه مجرد زينة بلاغية ليصبح تقنية بنيوية وثيمية أساسية. فالميتا سرد والتقنيات غير الخطية ليست مجرد انحرافات، بل هي أدوات لتفكيك الواقع، والتشكيك في سلطة السارد، وإشراك القارئ على مستوى أعمق وأكثر فكرية. وتوضح الأمثلة الروائية كيف يُستخدم الاستطراد لاستكشاف قضايا مجتمعية ووجودية معقدة، مما يبرز تطور دوره الإبداعي من مجرد أداة بلاغية إلى عنصر محوري في بناء المعنى.
- الميتا سرد (Meta-narrative): تُعد ظاهرة الميتا سرد من أبرز تمثيلات الاستطراد في الفن الروائي العربي الحديث. تُعرف بأنها “رواية عن الرواية”، تتضمن تعليقاً على سردها وهويتها اللغوية، وتثير أسئلة حول طبيعة الرواية والحقيقة. يُمثل هذا النوع من الاستطراد تمرداً على الرواية الواقعية، حيث يرتد النص على ذاته وآلياته بدلاً من الارتداد على الواقع، مما يعكس وعيًا ذاتيًا بالعملية السردية.
- تقنيات السرد غير الخطي: تتميز روايات ما بعد الحداثة بالتشظي في البنية السردية والشخصيات والزمن، حيث قد تكون عملية السرد غير خطية أو تتكون من أجزاء منفصلة لا ترتبط ببعضها بوضوح. تتضمن هذه التقنيات التلاعب بالزمن (تداخل الماضي والحاضر والمستقبل) وتداخل الأنواع الأدبية المختلفة (مثل الخيال العلمي مع الأدب الواقعي أو الرواية البوليسية والفلسفة)، مما يخلق إحساسًا بالفوضى أو عدم الاستقرار الزمني.
- أمثلة من الرواية العربية:
- نجيب محفوظ – “أولاد حارتنا“: الرواية مقسمة لافتتاحية وخمس قصص فرعية، كل منها تتناول شخصية ودورها في تحقيق العدل في الحارة. الجبلاوي في الرواية يرمز للذات الإلهية أو الدين الذي سيطر على الناس. الاستطراد هنا يظهر في الانتقال بين هذه القصص الفرعية التي تخدم الثيمة الكبرى للرواية (البحث عن العدل ومواجهة الظلم)، مع وجود رموز ودلالات عميقة تتجاوز السرد المباشر، مما يدفع القارئ للتأمل الفلسفي في طبيعة السلطة والدين والمجتمع.
- غسان كنفاني – “رجال في الشمس“: تصور الرواية معاناة الشعب الفلسطيني وفقدان الهوية بعد النكبة. تستخدم مفارقات زمنية وتقنية الاسترجاع (الفلاش باك) لتسليط الضوء على خلفيات الشخصيات. الاستطراد فيها يظهر في سرد الأحداث برشاقة دون ملل رغم تنوعها وتداخلها. النهاية المأساوية (اختناق الرجال في الخزان) وما يتبعها من سؤال “لماذا لم يدقوا جدران الخزان؟” يمكن اعتباره استطراداً فكرياً يدفع المتلقي للتأمل في أسباب الصمت والخذلان، متجاوزاً حدود السرد التقليدي إلى مستوى رمزي عميق.
- رضوى عاشور – “ثلاثية غرناطة“: تعالج قضايا الحاضر من خلال رموز الماضي، مستلهمة سقوط غرناطة. الاستطراد فيها يظهر في بنية السؤال التي تستدعي تدخل المتلقي وفتح آفاق التأويل، حيث لا تقدم إجابات جاهزة بل تدعو القارئ للمشاركة في بناء المعنى. كما تعتمد على الاختزال والتكثيف الذي يلخص مساحات زمنية ووحدات سردية عديدة بكلمة واحدة. وتعتمد على المشهدية السردية المتجاورة التي تحكي عن شخصية أو حدث وتتضافر لخدمة السيرة العامة لغرناطة عبر تحولاتها التاريخية.
- جبرا إبراهيم جبرا – “البحث عن وليد مسعود“: يقدم شخصية مثقفة مثقلة بالأسئلة الفلسفية وسؤال الوطن. توصف الرواية بأنها “ثرثرة متراصة” وأنها “ملحمة أنطولوجية”. الاستطراد هنا يتجلى في كثرة الأسئلة الفلسفية والتأملات الوجودية التي تخرج عن السرد المباشر للحدث، مما يعمق الجانب الفكري للرواية ويجعلها تتجاوز مجرد الحكاية إلى استكشاف أعمق لذات الإنسان الفلسطيني وقضيته.
الاستطراد في المسرح العربي: توظيف التراث وتقنيات الانحراف السردي
يشير توظيف الاستطراد والتقنيات غير الخطية في المسرح العربي الحديث إلى تحول كبير يتجاوز البنى الدرامية التقليدية. هذا التوجه يعكس تيارًا فنيًا أوسع يسعى إلى تحدي الأنماط السردية المألوفة، وإشراك الجمهور بشكل أكثر فاعلية في بناء المعنى، وتصوير تعقيدات الواقع المعاصر وتجزئته. إن إعادة تعريف الشكل الدرامي هذا، المتأثر بتقنيات السرد، يفتح آفاقًا جديدة للتعبير الفني والمشاركة النقدية.
- توظيف التراث: اتكأ المسرحيون العرب على الموروث الشعبي كوسيلة للخروج عن أصول الدراما التقليدية، مما فتح الباب أمام أشكال جديدة من الاستطراد. هذا التوظيف للتراث يسمح للمسرح بالتحرر من القيود البنيوية الصارمة للدراما الكلاسيكية، ويمنح الكاتب حرية أكبر في التنقل بين الأزمنة والموضوعات.
- تقنيات الانحراف السردي:
- التشظي (Fragmentation): تتميز روايات ما بعد الحداثة، والتي تؤثر على المسرح، بالتشظي في البنية السردية والشخصيات والزمن. فقد تكون عملية السرد غير خطية أو تتكون من أجزاء منفصلة لا ترتبط ببعضها بوضوح، مما يعكس عدم الثبات واللامركزية في الحياة والتجربة الإنسانية.
- تداخل الأنواع (Genre Blending): تميل روايات ما بعد الحداثة إلى كسر الحدود التقليدية بين الأنواع الأدبية. فقد نجد في الرواية مزيجًا من الخيال العلمي مع الأدب الواقعي، أو الجمع بين الرواية البوليسية والفلسفة، مما يعكس تنوعًا وتعددًا في الأساليب الأدبية. هذا التداخل يظهر أيضًا في المسرح، حيث يمكن أن يتأثر المسرح بالرواية، ويُعرف بـ”مسرح الرواية” أو “المسرح الرابسودي”.
- السرد المتعدد (Multiple Narratives): تعتمد روايات ما بعد الحداثة غالبًا على أصوات متعددة للسرد، مما يوفر للقارئ وجهات نظر مختلفة حول الأحداث أو الشخصيات. هذا التعدد في السرد يعزز من اللا يقين ويخلق تجربة قراءة أكثر تعقيدًا، وينتقل هذا التأثير إلى المسرح أيضًا.
- التلاعب باللغة (Linguistic Manipulation): يتميز أدب ما بعد الحداثة بتجريب اللغة والتلاعب بها، فقد يتم كسر القواعد التقليدية للنحو أو استخدام اللغة بطرق غير مألوفة أو الدمج بين اللغة الفصحى والعامية. هذا التلاعب يعكس الشك في القدرة على إيصال المعنى بشكل دقيق، ويُستخدم لإضافة طبقات من المعنى أو لتحدي التوقعات اللغوية.
- أمثلة من المسرح العربي:
- يُلاحظ استخدام “الاستطراد التداخلي” في المسرح العربي المعاصر، وهو ما يشير إلى تداخل الأحاديث والخطابات داخل العمل المسرحي.
- المسرح العربي المعاصر يتبنى ما يُعرف بـ”الدراماتورجيا والأفق ما بعد الدرامي”، حيث يخضع الإخراج لمبادئ متناقضة ويدمج أساليب تمثيل غير متناسقة، مما يؤدي إلى تشظي يجعل من المستحيل تركيز الإخراج حول مبدأ موحد. هذا يتوافق مع فكرة الانحراف السردي.
- مسرحيات كاتب مثل سعد الله ونوس، اتسمت بالبناء السردي المسرحي الذي يتداخل مع البنية الحكائية للرواية. وقد استخدم ونوس تقنيات سردية متعددة أسهمت في إنتاج الدلالات والرموز وحققت تكاملًا دراميًا في بناء النص. وكان هدفه قص حكايات تكشف جوانب مهمة ومعتمة في المجتمع العربي وتكوين الشخصية العربية.
المبحث الرابع: الاستطراد في الخطاب الفكري والفلسفي واليومي
الاستطراد في الخطاب الفكري والفلسفي
في الخطاب الفكري والفلسفي، يتجاوز الاستطراد كونه مجرد أداة بلاغية ليصبح أداة معرفية وإبستمولوجية. فهو يتيح استكشاف الأفكار المعقدة والمترابطة، وبناء الهوية من خلال الخطاب، ورسم خرائط التكوينات المعرفية. هذا يبين أن الاستطراد لا يقتصر على الزخرفة الأسلوبية، بل يتعلق بعملية التفكير نفسها، وتوليد المعرفة، وصناعة المعنى، وغالبًا ما يعكس التعقيد المتأصل في الموضوع المطروح.
- التخيل الفلسفي: يبحث فلاسفة العقل في دور التخيل في مجالات مثل قراءة الأفكار والتظاهر. كما يبحث فلاسفة الجمال في دور التخيل في إنشاء الأعمال الفنية والتعامل معها، وعلماء المعرفة في دوره بتجارب الفكر النظري وصنع القرار. هذا يتصل بالاستطراد كأداة لاستكشاف الإمكانات غير الواقعية، والأزمنة الأخرى غير الحاضر، ووجهات النظر المختلفة عن الذات. فالاستطراد في الخطاب الفلسفي يمكن أن يكون وسيلة لتمثيل هذه الاحتمالات وتوسيع نطاق التفكير.
- علم النفس الاستطرادي (الخطابي): يقوم هذا الفرع من علم النفس على أساس البنائية الاجتماعية، حيث لا تُعتبر الذات الفردية كيانًا مستقلاً ومعزولًا، بل هي في تفاعل ديناميكي مستمر مع العالم الاجتماعي. تتشكل العقول والذوات والهويات، وتتفاوض، ويُعاد تشكيلها في هذا التفاعل الاجتماعي. هذا المنظور يشير إلى أن الهويات تُبنى استطراديًا، أي من خلال تداخل الأحاديث والسرديات الثقافية التي تُموضع الأفراد في فئات اجتماعية معينة.
- ميشيل فوكو وتداخل الأحاديث: يرى ميشيل فوكو أن تداخل الأحاديث (وهو شكل من أشكال الاستطراد في سياق تحليل الخطاب) يشير إلى العلاقات القائمة بين التكوينات الاستطرادية الكبيرة غير المتجانسة، مثل التاريخ الطبيعي والاقتصاد السياسي في عصر التنوير. هذا يعني أن الاستطراد ليس مجرد اختيار أسلوبي، بل هو جانب أساسي من كيفية بناء المعرفة والسلطة داخل الخطاب. فالتداخل بين الأحاديث يرسم مخططًا لتهيئة الاستطراد بين الموضوعات، ويشكل ما يُعد حديثًا مقبولًا داخل كل كيان استطرادي.
- ابن خلدون ومقدمته: تُعد مقدمة ابن خلدون مثالًا بارزًا على الاستطراد في الخطاب الفكري. فقد كان ابن خلدون يستخدم التشبيهات المادية والأمثلة لتوضيح المفاهيم المعقدة، مثل تشبيه قوة العصبية بانتشار الأشعة، أو هرم الدول باضمحلال الشعلة، أو القريحة بالضرع الذي يدر بالامتراء. مقدمته تتميز بالاستطرادات المتكررة التي تخدم غرض التوسع في الأفكار، ورسم الموازنات، وتقديم تفسيرات شاملة، مما يعكس منهجه الموسوعي وترابط المعرفة في فكره. هذه الاستطرادات ليست عشوائية، بل هي جزء لا يتجزأ من بناء حججه وتعميق فهمه للظواهر الاجتماعية والتاريخية.
- طه حسين ومقالاته الأدبية: عُرف طه حسين بأسلوبه الموسوعي وكثرة استطراداته، وهي سمة اعترف بها هو نفسه. غالبًا ما كانت استطراداته تنبع من “تشابك الأفكار وتعقدها” في عقله، مما جعل كتاباته تتدفق “كالسيل المنهمر” الذي لم يستطع ضبطه تمامًا. هذا يسلط الضوء على أن الاستطراد يمكن أن يكون نتيجة طبيعية لعملية فكرية غنية ومعقدة، حيث تتداعى الأفكار وتتوالد، مما يثري النص بعمق غير متوقع.
الاستطراد في الخطاب السياسي
في الخطاب السياسي، يُعد الاستطراد أداة قوية ذات حدين. فعندما يكون هادفًا، يمكنه إثراء المعنى والإقناع. ومع ذلك، فإن ظاهرة “الاستطراد الناقص” تكشف كيف يمكن إساءة استخدامه لتجنب المعالجة الحقيقية للقضايا، وتكريس الأفكار القديمة، بل والتلاعب بالرأي العام من خلال التأطير الأيديولوجي. هذا يبرز البعد الأخلاقي للاستطراد، حيث يمكن استغلال إمكاناته الإبداعية لتحقيق الوضوح أو التعتيم، اعتمادًا على نية المتحدث ومدى وعي المتلقي النقدي.
- الاستطراد الهادف والعبثي: يؤكد البلاغيون أن الانتقال إلى معنى آخر في الخطاب السياسي يجب أن يكون لسبب ومقصد، وإلا كان استطرادًا عبثيًا لا فائدة منه. الاستطراد الفعال في هذا السياق يخدم غرضًا إقناعيًا أو توضيحيًا.
- “الاستطراد الناقص” ومشكلة المفاهيم المبتورة: يرى بعض النقاد أن أغلب الإجابات والاقتراحات في الخطاب السياسي تقع ضمن سياق “الاستطراد الناقص”، الذي ينتج سلسلة من المعاني الناقصة والمفاهيم المبتورة. هذا النوع من الاستطراد غالبًا ما يغلب عليه حرص شديد على إعادة تدوير المفاهيم القديمة ووضعها في “أوانٍ حديثة” دون خطو نحو “القطيعة” أو “التجاوز” الحقيقي. هذا يعكس نقصًا في الإبداع واعتمادًا على الصنعة.
- النفوذ والأيديولوجيا: يرتبط تداخل الأحاديث (شكل من أشكال الاستطراد) ارتباطًا وثيقًا بمفاهيم الأيديولوجيا والسيطرة والنفوذ، حيث يميز بعض التفسيرات ويفضلها اجتماعيًا. فبناء على رأي باختين/فولوشينوف، تعتبر العلامات أمرًا أيديولوجيًا، وبالتالي فإن تضمين حديث تداخل بين الأحاديث يعتبر تفسيرًا أيديولوجيًا للحديث. وفي رأي ميشيل فوكو، فإن الاستطرادية بين الموضوعات والأنماط ترسم مخططًا لتهيئة الاستطراد، وتشكل جزءًا من تحليل الخطاب لديه.
- اللغة الاستعارية في الخطاب السياسي: تُستخدم الاستعارات في الخطاب السياسي كأداة للتحريض والتحفيز والإقصاء والإغراء والتمييز والهيمنة وإسباغ الشرعية وإجهاض النقد. هذه الاستعارات لا تقول أو تعبر فحسب، بل تخفي بعض مظاهر الواقع. هذا يعكس كيف يمكن للاستطراد، عبر اللغة الاستعارية، أن يُدغدغ مشاعر المواطنين ويستمال عقولهم نحو مستقبليات بعيدة المدى، وغالبًا ما تكون لغته ملتبسة وغامضة وحافلة بالمعاني المتعددة والتفسيرات التي تهدف إلى استثارة النفوس لخدمة السياسة.
الاستطراد في الحديث اليومي
إن التمييز بين الاستطراد المحمود والمذموم في التواصل اليومي يؤكد أهمية “الهدف” و”الصلة” بالموضوع. فعندما يُوظف بفعالية، يُثري التواصل من خلال توفير السياق، وتوضيح المعنى، أو بناء الألفة. أما الاستطراد العشوائي فيؤدي إلى التشتت وفقدان الرسالة الأصلية. هذا يبرز أن القيمة الإبداعية للاستطراد، حتى في السياقات غير الرسمية، تكمن في قصده وقدرته على تحقيق هدف تواصلي دون إحداث تشتيت غير مرغوب فيه.
- أنواع الاستطراد في الحديث: يمكن التمييز بين نوعين من الاستطراد في الحديث اليومي:
- الاستطراد المحمود: وهو الاستطراد الذي يتم ببراعة وعلم وتأصيل وتفنن، حيث يُذكر فائدة أو معلومة في مكان يرى المتكلم أنه لائق بها، ثم يعود إلى الموضوع الأصلي. هذا النوع مقبول ومحمود.
- الاستطراد المذموم: وهو الخروج عن المراد لأدنى سبب، ويصنعه أصحاب التكاثر من الكلام، مما يؤدي إلى تشتيت السامع وإفساد الحديث. هذا النوع مذموم ويُعاب عليه.
- تداخل الأحاديث في الحديث اليومي: يشير تداخل الأحاديث إلى العلاقات غير المباشرة أو المباشرة التي تربط حديثًا ما بأحاديث أخرى، والاستطراد بين الموضوعات والأنماط هو سمة الحديث الذي يرتبط بأحاديث أخرى. هذا التداخل غالبًا ما يشير إلى أن عناصر تم استحضارها من حديث آخر، مما يثري المحادثة ويوفر سياقات أوسع.
- أمثلة عملية:
- في الخطاب الديني: قد يستطرد الخطيب لذكر فائدة فقهية أو قصة تاريخية تتعلق بآية أو حديث، ثم يعود إلى صلب الموضوع الذي يتحدث عنه، مثل استطراد البوصيري في مدح النبي صلى الله عليه وسلم ضمن قصيدته الهمزية.
- في بيئات العمل والمحادثات العفوية: يُعد التواصل الشفهي أداة أساسية للتفاعل، حيث تُعزز الاجتماعات والمناقشات اليومية والمحادثات العفوية من نقل الأفكار وتحديد الأهداف المشتركة. يمكن أن يظهر الاستطراد هنا عندما ينتقل المتحدث إلى مثال أو قصة شخصية لتوضيح نقطة، أو ليعبر عن صدق مشاعره ونواياه من خلال نبرة صوته وتعابير وجهه. كما يمكن أن يساعد في حل المشكلات عبر طرح الأسئلة وتبادل وجهات النظر.
المبحث الخامس: أغراض الاستطراد الفنية وتأثيره على المتلقي
الأغراض الفنية للاستطراد
يُعد الاستطراد أداة بلاغية متعددة الأغراض، تُستخدم لتحقيق تأثيرات فنية ودلالية عميقة في النص:
- الإثراء والتعميق: يساهم الاستطراد في إثراء النص وتعميق المعاني، حيث يضيف طبقات من الدلالة ويوسع أفق الموضوع الأصلي. فهو يسمح باستكشاف جوانب مختلفة من الفكرة الرئيسية، مما يجعل النص أكثر غنى وتنوعًا.
- التشويق والإثارة: يخلق الاستطراد عنصر المفاجأة والتشويق، ويشد انتباه المتلقي من خلال الانتقال بين الأفكار والموضوعات. هذا التنوع يكسر الرتابة ويحافظ على اهتمام القارئ أو المستمع.
- الهجاء والمدح غير المباشر: يُستخدم الاستطراد ببراعة لإخفاء القصد الحقيقي وراء وصف ظاهري، كما في أمثلة أبي تمام والسموأل. هذه التقنية تسمح للشاعر بالتعبير عن مشاعره (مدحًا أو ذمًا) بطريقة ذكية وغير مباشرة، مما يزيد من قوة التأثير الفني.
- إبراز البراعة اللغوية والاتساع المعرفي: يدل الاستطراد المتقن على “طول نفس” الشاعر أو الكاتب وقدرته على الربط بين الموضوعات المختلفة بسلاسة، مما كان يُحمد عليه في العصور القديمة كعلامة على التمكن اللغوي والمعرفي.
- التأمل الفلسفي والاجتماعي: في السرد الحديث، يُستخدم الاستطراد لدفع المتلقي للتفكير في قضايا أعمق تتجاوز السرد المباشر، مثل قضايا الهوية، الوجود، والعدالة، كما يتضح في روايات نجيب محفوظ وغسان كنفاني.
تأثير الاستطراد على المتلقي
إن الطبيعة المزدوجة للاستطراد – قدرته على الإثراء وإمكانية إضعافه للنص – تبرز الأهمية الحاسمة لـ”التوازن” و”الهدف”. فالقيمة الإبداعية للاستطراد تتحقق عندما يخدم غرضًا فنيًا أو تواصليًا واضحًا، مضيفًا طبقات من المعنى دون التضحية بالوضوح. وعندما يصبح الاستطراد غاية في حد ذاته، أو يفتقر إلى “مناسبة” قوية، فإنه يخاطر بالتحول إلى عيب، مما يؤكد أن البراعة الحقيقية تكمن في الانحراف المدروس والهادف.
- التأثير الإيجابي:
- تقوية الرغبة وشحذ الهمة: يلهب الاستطراد الحماس ويحرك العواطف لدى المتلقي، مما يعزز من تأثير الخطاب ويجعله أكثر إقناعًا.
- إثارة التأمل: يدفع المتلقي للتفكير العميق في المعاني المتشابكة، ويحفزه على الربط بين الأفكار المختلفة، مما يزيد من تفاعله الفكري مع النص.
- كسر الملل: يجدد اهتمام المتلقي من خلال التنوع في الموضوعات وعدم الالتزام بخط سردي واحد، مما يجعل التجربة أكثر جاذبية.
- التأثير السلبي (عيوب الاستطراد):
- الإطالة المذمومة: طول الاستطراد المفرط يفسد النص ويخرج السامع عن المقصود الأصلي لموضوع الخطبة أو المقال. هذا يؤدي إلى فقدان التركيز وتشتت الانتباه.
- التشتيت والغموض: قد يؤدي الاستطراد غير المبرر أو المبالغ فيه إلى تشتيت انتباه المتلقي وفقدان التركيز على الفكرة الرئيسية، مما يجعل النص غامضًا أو غير واضح.
- فقدان الإبداع والاعتماد على الصنعة: في بعض الحالات، قد يصبح الاستطراد مجرد صنعة بلا روح إبداعية، يعتمد فيها الكاتب على كثرة الكلام دون إضافة قيمة حقيقية، مما يفقده قيمته الفنية.
- طغيان الاستطراد على المقصد الأصلي: كما حدث في بعض كتب التفسير، حيث طغت الاستطرادات على بيان معاني الآيات ومقاصدها الأصلية، مما أضعف الهدف الأساسي للنص.
المبحث السادس: الاستطراد ومرتكزات تحسين محركات البحث (SEO)
يتطلب تحسين محركات البحث (SEO) للمحتوى الاستطرادي نهجًا استراتيجيًا. فالعمق الإبداعي للاستطراد، الذي يتيح تقديم محتوى غني ومتعدد الأوجه، يتوافق بشكل طبيعي مع مبادئ تحسين محركات البحث التي تفضل المواد الشاملة والجذابة للمستخدم. ومع ذلك، يتطلب ذلك هيكلة دقيقة ودمجًا للكلمات المفتاحية لضمان قدرة محركات البحث على فهرسة المعلومات المتنوعة وتصنيفها بفعالية. يكمن التحدي في الحفاظ على التدفق الطبيعي للاستطراد مع الالتزام بالمتطلبات التقنية لسهولة الاكتشاف، مما يحول “التشتيت” المحتمل إلى “صلة عميقة” بالموضوع.
أهمية الاستطراد المتقن في المحتوى الرقمي
- إثراء المحتوى: الاستطراد المتقن يضيف عمقًا وتنوعًا للمقالة، مما يجعلها أكثر جاذبية للقراء. فالمقالة التي تتناول موضوعًا من زوايا متعددة وتستطرد لتقديم معلومات إضافية ذات صلة تكون أكثر قيمة للقارئ.
- زيادة وقت بقاء الزائر (Dwell Time): المحتوى الغني والمترابط، حتى مع الاستطرادات الهادفة، يشجع القارئ على البقاء في الصفحة لفترة أطول لاستيعاب كل المعلومات المقدمة، وهو عامل إيجابي مهم لتحسين محركات البحث.
- الاستجابة لنية البحث الشاملة: يمكن للاستطراد أن يغطي جوانب متعددة من موضوع واسع، مما يلبي نية البحث المتنوعة للمستخدمين ويجيب على أسئلتهم المحتملة التي قد لا تكون ظاهرة في الكلمة المفتاحية الرئيسية وحدها. هذا يزيد من فرص ظهور المقالة في نتائج البحث لمجموعة واسعة من الاستفسارات.
خاتمة: الاستطراد – فن يتجدد في رحاب اللغة والمعرفة
لقد كشفت هذه الدراسة عن الاستطراد كفن بلاغي عميق ومتعدد الأوجه، يتجاوز مجرد الانحراف اللفظي ليصبح أداة إبداعية محورية في تشكيل المعنى عبر مختلف أشكال الخطاب. من جذوره المتأصلة في البلاغة العربية القديمة، حيث كان يُنظر إليه كعلامة على براعة الشاعر وطول نفسه، إلى تجلياته المعقدة في السرد الروائي والمسرحي الحديث، حيث يُستخدم لتفكيك الواقع وبناء طبقات دلالية جديدة، يظل الاستطراد يمثل فنًا حيويًا ومتجددًا.
لقد تبين أن الاستطراد، عندما يُوظف بمهارة وهدف، يثري النصوص ويعمق معانيها، ويحفز المتلقي على التأمل والتفاعل الفكري والعاطفي. سواء في النصوص الدينية التي تستطرد لتعميم الدلالة، أو في الشعر الذي يخفي الهجاء في ثنايا المدح، أو في الرواية التي تستخدم الميتا سرد لتعكس تعقيدات الهوية والواقع، فإن الاستطراد يبرز كتقنية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.
ومع ذلك، فإن هذه القوة الإبداعية تحمل في طياتها تحديًا، فكما يمكن للاستطراد أن يضيف قيمة، يمكن للإفراط فيه أو غياب المناسبة أن يؤدي إلى التشتيت والغموض، كما رأينا في بعض تطبيقاته في كتب التفسير أو في ظاهرة “الاستطراد الناقص” في الخطاب السياسي. هذا يؤكد أن جوهر الاستطراد الفعال يكمن في التوازن والهدف الواضح، حيث يصبح الانحراف المدروس وسيلة لتعميق الصلة بالموضوع الأصلي، لا الابتعاد عنه.
في العصر الرقمي، حيث تسعى المقالات إلى تحقيق أقصى قدر من الوصول والتأثير، يظل الاستطراد المتقن أداة قيمة. فهو يتيح إنشاء محتوى شامل وجذاب يلبي نية البحث المتنوعة، ويزيد من وقت بقاء الزائر، ويعزز من جودة المحتوى. ومع الالتزام بمعايير تحسين محركات البحث (SEO) من حيث الكلمات المفتاحية، وهيكلة المقال، واستخدام الروابط، يمكن للاستطراد أن يتحول من مجرد إضافة شكلية إلى عنصر استراتيجي يعزز من اكتشاف المحتوى وقيمته المعرفية.
في الختام، يظل الاستطراد فنًا يعكس مرونة اللغة العربية وقدرتها على التعبير عن أدق المعاني وأكثرها تعقيدًا. إنه ليس مجرد تقنية بلاغية، بل هو نافذة على عوالم الفكر والإبداع، يتجدد بتجدد أشكال الخطاب، ويظل محركًا أساسيًا لعمق المعنى وإثراء التجربة الإنسانية.