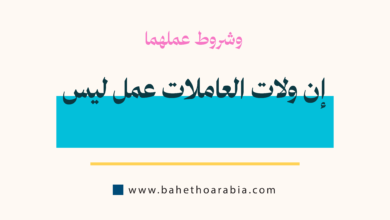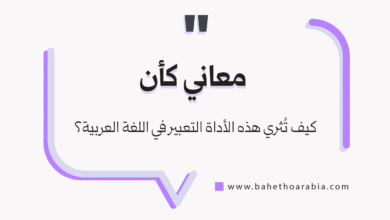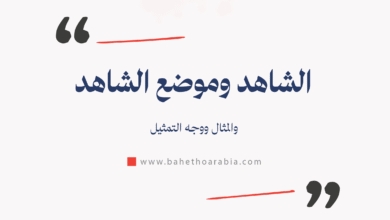الاسم المتمكن والاسم غير المتمكن وتنوين التمكين وتنوين التنكير

يُمثّل التمييز بين الإعراب والبناء أحد المرتكزات الأساسية في علم النحو العربي، حيث تنبني عليه أحكام تركيبية ودلالية بالغة الأهمية. وفي هذا الإطار، يحتل الاسم مكانة محورية، إذ يُعد الأصل فيه أن يكون معربًا متغير الآخر، إلا أنه قد يطرأ عليه ما يغير هذه الحالة، فيقترب من الفعل فيُمنع من الصرف، أو يشابه الحرف فيُبنى. تهدف هذه المقالة إلى تقديم تحليل منهجي وتفصيلي لأقسام الاسم من حيث درجة تمكنه في باب الاسمية، وهو المبحث الذي أرسى قواعده النحاة القدامى لضبط الفروق الدقيقة بين الأسماء. وسينطلق التحليل من تعريف المصطلحات المحورية كتنوين التمكين وتنوين التنكير، اللذين يُعدان مؤشرين على حالة الاسم، قبل أن يتعمق في شرح أقسام الاسم الثلاثة: المتمكن الأمكن، والمتمكن غير الأمكن (الممنوع من الصرف)، وغير المتمكن (المبني)، مع عرض تفصيلي لحالات بناء الاسم المختلفة وأمثلتها من القرآن الكريم والشعر العربي الفصيح.
مقدمة
يُقرِّر النحويون أن الأصل في الاسم أن يكون مُعربًا، بحيث تتغير حركة آخره تبعًا للعوامل الداخلة عليه، وأن يقبل تنوين التمكين. ويُضاف إلى ذلك أن الاسم قد يُمنَع من الصرف إذا أشبه الفعل، وقد يُبنى إذا أشبه الحرف. بناءً على هذا التصور، قسّم النحويون الاسم إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الاسم المتمكن الأمكن، والاسم المتمكن غير الأمكن، والاسم غير المتمكن. وتوضح الأقسام التالية هذه المصطلحات تفصيلًا لضمان استيعاب مضمونها لدى دارسي العلم.
تعريف تنوين التمكين
يُعرَّف تنوين التمكين بأنه التنوين الذي يلحق الاسم المتمكن في باب الاسمية، وهو الاسم الذي لا يشبه الفعل ليُمنَع من الصرف، ولا يشبه الحرف ليُبنى، كما يتضح في تنوين الكلمات الآتية: (رجلٌ، فرسٌ، دارٌ، حديقة …).
تعريف تنوين التنكير
يُطلق مصطلح تنوين التنكير على التنوين الذي يلحق أواخر الكلمات بهدف التفريق بين حالتي المعرفة والنكرة. يلحق هذا التنوين الاسم المعرب، مثل الأسماء المذكورة في قسم تنوين التمكين، كما يلحق الاسم المبني، نحو: (صه، مه، إيه). فعلى سبيل المثال، يُستخدم اسم الفعل (صَهْ) للطلب بالسكوت عن حديث محدد، بينما يؤدي تنوينه تنوين تنكير (صَهٍ) إلى دلالة الطلب بالسكوت المطلق عن أي حديث كان دون تعيين.
تعريف الاسم المتمكن الأمكن
يُقصد بالاسم المتمكن الأمكن ذلك الاسم الأصيل في باب الاسمية والمتمكن منه تمكنًا تامًا، بحيث لم يطرأ عليه ما يضعف هذا التمكن. وبناءً على ذلك، فإنه يُعرب بالحركات ويقبل تنوين التمكين، وتندرج تحته غالبية الأسماء العربية.
تعريف الاسم المتمكن غير الأمكن
يُعرَّف الاسم المتمكن غير الأمكن بأنه الاسم الذي يُعرب بالحركات، إلا أنه لا يقبل التنوين، ويُجر بالفتحة نيابةً عن الكسرة. وقد اصطلح النحويون على تسمية هذا النوع من الأسماء بـ “الممنوع من الصرف”.
تعريف الاسم غير المتمكن
هو الاسم الذي أشبه الحرف في وجه من الوجوه، ففقد بذلك تمكنه من باب الاسمية وأصبح مبنيًا كالحروف. ويأتي بناء الاسم على الحالات التالية:
أ – البناء على السكون: ويشمل أسماءً مثل: مَنْ، مَا، الذي، التي، هذا، وغيرها.
ب – البناء على الفتح: ويندرج تحته اسم (لا) النافية للجنس إذا لم يكن مضافًا أو شبيهًا بالمضاف، نحو: (لا خيرَ في الإهمال)، والمركبات من الأعداد (أحدَ عشرَ …. وغيرها)، والظروف المركبة (صباحَ مساءَ، بينَ بينَ)، والأحوال المركبة (بيتَ بيتَ)، وبعض الظروف المبهمة المضافة إلى جملة، ومثاله قول الشاعر النابغة الذبياني:
على حينَ عاتبتُ المشيبَ على الصِّبا * وقلت ألمَّا أَصْحُ والشيبُ وازعُ
فلفظ “حينَ” في هذا السياق يُبنى على الفتح في محل جر.
وقد يُبنى الاسم على الفتح أيضًا إذا كان مبهمًا وموغلاً في الإبهام وأُضيف إلى مبني، فاكتسب منه البناء، إذ يُبنى على الفتح لخفته. ومثال ذلك قوله تعالى في سورة الذاريات: {إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ}. فقد وردت قراءة برفع (مثلُ) على أنها صفة لـ (حق)، وقراءة أخرى ببنائها على الفتح (مثلَ) في محل رفع.
وينوب عن الفتحة حرف الياء في حالة الاسم المستحق للبناء إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالمًا، كما في قول الشاعر:
تَعَزَّ فَلَا إِلْفَينِ بِالْعَيشِ مُتِّعَا * وَلَكِنْ لِوَرَّادِ الْمَنُونِ تَتَابُعُ
حيث إن “إلفينِ” هو اسم لا النافية للجنس مبني على الياء في محل نصب.
ج – البناء على الكسر: ويشمل ذلك الاسم المختوم بـ (ويه) في رأي من ألزمه البناء على الكسر، نحو: سيبويهِ وعمرويهِ، وما صِيغ من أسماء الأفعال على وزن (فَعَالِ)، نحو: نَزَالِ وحَذَارِ ودَرَاكِ، وما جاء على وزن (فَعَالِ) من الأعلام، كـ حَذَامِ وقَطَامِ ورَقَاشِ، أو في النداء حين يكون سبًّا للأنثى، نحو: يا لَكَاعِ، يا خَبَاثِ، يا غَدَارِ، وكذلك كلمة (أمسِ) إذا أُريد بها اليوم الذي يسبق يومك.
كذلك، قد يُبنى اسم (لا) النافية للجنس على الكسر أو الفتح إذا جاء جمعًا بألف وتاء مزيدتين، ويتضح ذلك في قول سلامة بن جندل السعدي:
إِنَّ الشَّبَابَ الَّذِي مَجْدٌ عَوَاقِبُهُ * فِيهِ نُلَذُّ وَلَا لَذَّاتِ لِلشَّيبِ
فقد رُوي بناء كلمة (لذاتِ) على الكسر في محل نصب، كما رُوي بناؤها على الفتح في محل نصب أيضًا.
د – البناء على الضم: ويشمل ظروف الزمان المبهمة التي قُطعت عن الإضافة لفظًا لا معنى، كـ (قبلُ وبعدُ وأولُ)، وما حُمل عليها من أسماء الجهات، نحو: (قُدَّامُ، خلفُ، وراءُ، عَلُ…). ويستشهد على ذلك بقوله تعالى في سورة الروم: {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ}، أي: من قبل الغَلَبِ ومن بعده.
وقد أشار النحاة إلى أن (أيًّا) الموصولة تُبنى على الضم إذا أضيفت وحُذف صدر صلتها، ومثاله قوله تعالى في سورة مريم: {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيّاً}. فكلمة (أيُّ) في الآية هي اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به للفعل “ننزعن”. وكلمة (أشدُّ) هي خبر لمبتدأ محذوف تقديره “هو”، والجملة الاسمية “هو أشد” تمثل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب.
وذكروا أن (أيًّا) تكون معربة في سائر استعمالاتها الأخرى، سواء كانت استفهامية، أم شرطية، أم موصولة في غير هذه الحالة. بل إن بعض النحاة يرى أنها معربة حتى في الحالة المذكورة آنفًا.
وينوب عن الضمة الألف في المثنى والواو في جمع المذكر السالم، وذلك إذا وردا في النداء كاسمين مفردين معرفتين مستحقين للبناء، نحو: (يا زيدانُ، يا زيدونَ). فكلمة “زيدانُ” هي منادى مفرد علم مبني على الألف في محل نصب على النداء.
خاتمة
ختامًا، يتضح أن التقسيم النحوي للاسم إلى متمكن أمكن، ومتمكن غير أمكن، وغير متمكن، ليس مجرد تصنيف شكلي، بل هو نظام دقيق يعكس درجة أصالة الاسم في باب الاسمية ومدى قربه أو بعده عن طبيعة الفعل أو الحرف. وقد بُيّن أن تنوين التمكين هو السمة الفارقة للاسم الأصيل (المتمكن الأمكن)، بينما يُعد غيابه في الممنوع من الصرف علامة على مشابهته للفعل، ويشير البناء في الاسم غير المتمكن إلى مشابهته للحرف في أحد أوجه الشبه التي فصلها النحاة. كما استُعرضت حالات البناء المختلفة على السكون والفتح والكسر والضم، مع ما ينوب عنها، مدعومةً بشواهد ترسخ الفهم. إن الإلمام بهذه التقسيمات الدقيقة لا يقتصر على كونه ضرورة إعرابية فحسب، بل هو مفتاح لفهم الفلسفة اللغوية التي حكمت رؤية النحاة العرب لبنية الكلمة ووظيفتها داخل السياق، مما يعزز من قدرة الدارس على التحليل اللغوي السليم.
الأسئلة الشائعة
١ – ما هو المعيار الأساسي الذي اعتمده النحاة للتمييز بين الاسم المتمكن الأمكن، والمتمكن غير الأمكن، وغير المتمكن؟
الإجابة: المعيار الأساسي الذي اعتمده النحاة لهذا التصنيف الدقيق هو “درجة التمكن في باب الاسمية”. يُقصد بهذا المفهوم مدى أصالة الاسم في حمله لخصائص الاسمية الخالصة، وعلى رأسها الإعراب وقبول تنوين التمكين. وبناءً على هذا المعيار، تم التمييز كالتالي:
- الاسم المتمكن الأمكن: يمثل الدرجة الأعلى والأكمل من التمكن. هو الاسم الذي لم يشبه الفعل أو الحرف، ولذلك احتفظ بكامل خصائص الاسمية، فهو معرب بالحركات الثلاث (الضمة والفتحة والكسرة) ويقبل تنوين التمكين، مثل: (محمدٌ، كتابٌ، مدرسةٌ).
- الاسم المتمكن غير الأمكن: يمثل درجة أقل من التمكن. هو اسم أصيل في الاسمية (فهو معرب)، لكنه أشبه الفعل في وجود علتين فرعيتين، ففقد جزءاً من خصائص الاسمية، وهو تنوين التمكين والجر بالكسرة. لذلك سُمي “متمكناً” لأنه معرب، و”غير أمكن” لأنه ممنوع من الصرف، مثل: (أحمدُ، مساجدُ، فاطمةُ).
- الاسم غير المتمكن: يمثل الدرجة الأدنى، حيث فقد الاسم تمكنه بالكامل وأصبح مبنياً. العلة في ذلك هي مشابهته القوية للحرف في وجه من الوجوه (إما في المعنى كأدوات الاستفهام، أو في البنية كالحروف القليلة، أو في الافتقار إلى جملة بعده كالأسماء الموصولة). هذه المشابهة أخرجته من حيّز الإعراب وأدخلته في حيّز البناء، مثل: (هذا، الذي، مَنْ).
٢ – ما الفرق الجوهري بين “تنوين التمكين” و”تنوين التنكير” من حيث الوظيفة والدلالة؟
الإجابة: الفرق بين هذين النوعين من التنوين جوهري ويتعلق بالوظيفة النحوية والدلالية لكل منهما:
- تنوين التمكين: وظيفته صرفية نحوية بحتة. هو علامة تأتي في آخر الاسم “المتمكن الأمكن” لتدل على أن هذا الاسم قد بلغ أقصى درجات التمكن في باب الاسمية، وأنه لم يشبه الحرف فيُبنى، ولم يشبه الفعل فيُمنع من الصرف. هو ليس له دلالة على معنى إضافي كالتعريف أو التنكير، بل هو مؤشر على الحالة الصرفية للاسم. لذا نجده في (رجلٌ) للدلالة على أنه اسم أصيل في الاسمية.
- تنوين التنكير: وظيفته دلالية تفريقية في المقام الأول. يُستخدم هذا التنوين للتفريق بين حالة المعرفة وحالة النكرة في بعض الأسماء المبنية. فعندما يلحق باسم مبني، فإنه ينقله من دلالة محددة معينة إلى دلالة عامة غير معينة. المثال الأوضح هو اسم الفعل (صَهْ) الذي يعني “اسكت عن هذا الحديث المعين”، وعندما يلحقه تنوين التنكير فيصبح (صَهٍ)، يتغير معناه إلى “اسكت عن أي حديث كان”، أي سكوتًا مطلقًا. فهو أداة لإكساب النكرة معنى الشمول وعدم التعيين.
٣ – ما المقصود بـ “مشابهة الاسم للحرف” كعلة أساسية للبناء، وكيف تتجلى هذه المشابهة؟
الإجابة: تُعد “مشابهة الاسم للحرف” العلة الجامعة التي يرجع إليها النحاة سبب بناء الأسماء. فالحروف كلها مبنية لأنها لا تقع فاعلاً أو مفعولاً، فهي جامدة لا تتغير. فإذا اقترب اسم ما من الحرف في إحدى خصائصه، فإنه يفقد مرونته الإعرابية ويُبنى مثله. تتجلى هذه المشابهة في عدة أوجه:
- الشبه الوضعي: أن يكون الاسم موضوعاً على حرف واحد (كتاء الفاعل) أو حرفين (كمَا الاستفهامية و”نا” الفاعلين)، فيشبه في بنيته الحروف مثل “مِنْ” و”عَنْ” و”بَلْ”.
- الشبه المعنوي: أن يتضمن الاسم معنى من معاني الحروف، كأسماء الاستفهام (متى، أين) التي تتضمن معنى همزة الاستفهام، وأسماء الإشارة (هذا) التي تتضمن معنى الإشارة الذي كان يمكن أداؤه بحرف.
- الشبه النيابي (الاستعمالي): أن يعمل الاسم في غيره دون أن يُعمل فيه، فيشبه الحرف الذي يؤثر فيما بعده ولا يتأثر بما قبله، وهذا ينطبق على أسماء الأفعال مثل (حَذَارِ) بمعنى “احذر”.
- الشبه الافتقاري: أن يفتقر الاسم افتقاراً دائماً إلى جملة بعده توضح معناه، كالأسماء الموصولة (الذي، التي)، فهي تفتقر إلى صلة الموصول كما تفتقر حروف الجر إلى مجرورها.
٤ – لماذا يُطلق على الممنوع من الصرف مصطلح “متمكن غير أمكن”؟ وما الذي يفقده من “تمام التمكن”؟
الإجابة: هذه التسمية الدقيقة تعكس الحالة الوسطى التي يحتلها الممنوع من الصرف بين الاسم المعرب بالكامل والاسم المبني.
- هو “متمكن” لأن أصله اسم معرب، وتتغير حركة آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، فهو يرفع بالضمة وينصب بالفتحة، وهذا يجعله جزءاً من عالم الأسماء المعربة المتمكنة.
- وهو “غير أمكن” لأنه لم يصل إلى درجة التمكن الكاملة. فقدَ خاصيتين جوهريتين من خصائص الاسم المتمكن الأمكن بسبب مشابهته للفعل، وهما:
١. التنوين: فالممنوع من الصرف لا يقبل تنوين التمكين أبداً.
٢. الجر بالكسرة: فهو يُجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ما لم يكن مضافاً أو معرفاً بـ “ال”.
هذا الفقدان الجزئي لخصائص الاسمية هو ما جعله “غير أمكن”، أي غير مكتمل التمكن، فهو يقف في منطقة وسطى بين الاسم الأصيل (المتمكن الأمكن) والاسم الذي فقد إعرابه بالكامل (غير المتمكن).
٥ – يُبنى الاسم على الفتح لكونها أخف الحركات. كيف ينطبق هذا المبدأ على الحالات المذكورة في النص مثل اسم “لا” النافية للجنس والأعداد المركبة؟
الإجابة: مبدأ البناء على الفتح لخفته هو تعليل صوتي ومنطقي يقدمه النحاة. فالفتحة هي أخف الحركات نطقاً وأقلها جهداً على جهاز النطق، ولذلك تُختار للبناء في الحالات التي يكثر فيها الاستعمال أو يتطلب فيها التركيب خفة وسرعة.
- في الأعداد المركبة (أحدَ عشرَ إلى تسعةَ عشرَ): هذه الأعداد تُعامل ككلمة واحدة مركبة تركيب مزج. ولأنها طويلة في بنيتها (مكونة من جزأين)، ولكثرة دورانها في الكلام، اختير لبنائها أخف الحركات وهو الفتح لتسهيل النطق وتجنب الثقل الصوتي الذي قد ينشأ عن استخدام الضم أو الكسر.
- في اسم “لا” النافية للجنس (المفرد): مثل “لا رجلَ في الدار”. اسم “لا” هنا مركب معها تركيباً شديداً حتى أصبحا معاً كالكلمة الواحدة. هذا التركيب تطلب علامة بناء خفيفة لا تتغير، فاختير الفتح لأنه الأنسب لهذا الموضع الذي يقتضي الإيجاز والسرعة في النطق.
٦ – كيف يمكن لاسم مثل “أيّ” أن يكون مبنياً في سياق ومعرباً في سياقات أخرى؟ وما هو التفسير النحوي لحالة بنائه على الضم في الآية الكريمة؟
الإجابة: اسم “أيّ” من الأسماء التي لها طبيعة مزدوجة، فالأصل فيها الإعراب، لكنها تُبنى في حالة خاصة جداً.
- حالات الإعراب: تكون “أيّ” معربة في معظم استعمالاتها: إذا كانت استفهامية (أيُّ رجلٍ قادم؟)، أو شرطية (أيَّهم تضربْ أضربْ)، أو موصولة ولم يتوفر فيها شرط البناء (يعجبني أيُّهم هو قائمٌ).
- حالة البناء: تُبنى “أيّ” على الضم في حالة واحدة فقط، وهي المذكورة في الآية {ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ}. شروط بنائها هنا هي:
١. أن تكون موصولة.
٢. أن تكون مضافة.
٣. أن يُحذف صدر صلتها (المبتدأ في جملة الصلة).
فأصل الكلام: “أيُّهم هو أشدُّ”. عندما حُذف المبتدأ (هو)، ضعفت الصلة، فأشبهت “أيّ” الموصولة الحرف في افتقارها الشديد لما بعدها، فبُنيت تعويضاً عن هذا الضعف. أما سبب البناء على الضم تحديداً، فيُعلله النحاة بأن الحركة المحذوفة من صدر الصلة كانت الضمة (لأنه مبتدأ مرفوع)، فنُقلت هذه الضمة إلى “أيّ” لتكون علامة بنائها، دلالة على المحذوف.
٧ – ما هي شروط بناء اسم “لا” النافية للجنس، وكيف تتغير علامة بنائه بين الفتح والياء والكسر كما ورد في الأمثلة؟
الإجابة: يُبنى اسم “لا” النافية للجنس إذا كان مفرداً (أي ليس مضافاً ولا شبيهاً بالمضاف). علامة البناء تختلف حسب طبيعة الاسم نفسه، فهو يُبنى على ما كان يُنصب به لو كان معرباً:
- البناء على الفتح: وهذا هو الأصل في الاسم المفرد الصحيح الآخر، مثل “لا خيرَ في الإهمال”. يُبنى على الفتح لأنه لو كان منصوباً لنُصب بالفتحة.
- البناء على الياء: وذلك إذا كان الاسم مثنى أو جمع مذكر سالماً، لأنهما يُنصبان بالياء. ومثاله في المثنى قول الشاعر: “فَلَا إِلْفَينِ”، فكلمة “إلفين” اسم “لا” مبني على الياء في محل نصب. ومثاله في جمع المذكر السالم: “لا مسلمِينَ في المدينة”.
- البناء على الكسر: وذلك إذا كان الاسم جمع مؤنث سالماً. يُبنى على الكسر نيابة عن الفتحة، لأن جمع المؤنث السالم يُنصب بالكسرة. ومثاله قول الشاعر: “وَلَا لَذَّاتِ للشيبِ”. ويجوز فيه أيضاً البناء على الفتح عند بعض القبائل العربية.
٨ – ما العلة في بناء أسماء الأفعال والأعلام المؤنثة المختومة بـ (ـالِ) مثل “حذارِ” و”حذامِ” على الكسر تحديداً؟
الإجابة: بناء هذه الأسماء على الكسر له تعليلات صرفية وصوتية.
- أسماء الأفعال على وزن (فَعَالِ): مثل “نَزَالِ” و”حَذَارِ”. العلة في بنائها أنها نابت عن الفعل وعملت عمله (الشبه النيابي)، لكنها لم تتأثر بالعوامل، فأشبهت الحرف وبُنيت. أما سبب اختيار الكسرة كعلامة بناء، فيُرجعه بعض النحاة إلى أن هذه الصيغة أصلها للأمر، والأمر يتطلب حركة قوية وحاسمة، والكسرة حركة قوية. كما أنها تُستخدم للتفريق بينها وبين صيغة المصدر (حَذَاراً) المنصوبة.
- الأعلام المؤنثة على وزن (فَعَالِ): مثل “حَذَامِ” و”قَطَامِ”. هذه الأعلام معدولة عن صيغة أخرى (حاذمة، قاطمة)، وهذا العدل هو أحد أسباب منعها من الصرف. ولكن عندما جاءت على هذا الوزن الذي يشبه وزن اسم الفعل، اكتسبت منه صفة البناء. واختير لها البناء على الكسر لمشابهتها اللفظية لأسماء الأفعال المبنية على الكسر، ولأن الكسرة هي العلامة الأصلية للتأنيث في بعض الحالات، فكانت مناسبة لهذه الأعلام المؤنثة.
٩ – كيف يؤثر فهم تنوين التنكير على الإعراب والمعنى في أسماء الأفعال مثل “صَهْ” و”صَهٍ”؟
الإجابة: فهم دور تنوين التنكير حاسم لتحديد المعنى الدقيق وبالتالي التحليل النحوي السليم.
- من حيث المعنى: كما ذُكر، التنوين ينقل الكلمة من التعيين إلى الإطلاق. (صَهْ) بالسكون هي اسم فعل أمر مبني على السكون، معناه “اسكت عن هذا الموضوع المحدد الذي نتحدث فيه”، فالسكوت هنا مقيد. أما (صَهٍ) بالتنوين، فهي اسم فعل أمر مبني على الكسر، ومعناها “اسكت عن أي كلام كان”، فالسكوت هنا مطلق وشامل. هذا الفرق الدلالي جوهري في فهم مراد المتكلم.
- من حيث الإعراب: على الرغم من أن كليهما اسم فعل أمر مبني، إلا أن علامة البناء الظاهرة تتغير.
- (صَهْ): اسم فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره “أنت”.
- (صَهٍ): اسم فعل أمر مبني على الكسر الظاهر (بسبب التنوين) لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر وجوباً تقديره “أنت”.
فالتنوين هنا ليس علامة إعراب، بل هو لاحقة صوتية دلالية غيرت حركة البناء الظاهرة من السكون إلى الكسر.
١٠ – قارن بين حالة بناء الظرف “قبلُ” على الضم وحالة بنائه على الفتح في قول الشاعر “على حينَ”. ما الذي يحدد حركة البناء في كلتا الحالتين؟
الإجابة: المقارنة بين هاتين الحالتين تكشف عن سببين مختلفين للبناء وحركتين مختلفتين بناءً على السياق:
- بناء “قبلُ” على الضم:
- السبب: يُبنى هذا الظرف (ومعه: بعدُ، فوقُ، تحتُ…) على الضم عندما يُقطع عن الإضافة لفظاً، مع نية المضاف إليه معنىً. في قوله تعالى {لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ}، التقدير هو “من قبلِ الغلبِ ومن بعدِه”. فحُذف المضاف إليه (الغلب)، وبُني الظرف على الضم للدلالة على هذا الحذف وأن معناه لا يزال مقصوداً. الضمة هنا كأنها تعويض عن الكلمة المحذوفة.
- المحدد للحركة: القطع عن الإضافة لفظاً لا معنى.
- بناء “حينَ” على الفتح:
- السبب: الظرف “حين” في الأصل معرب منصوب (أو مجرور بحرف جر). لكن في قول الشاعر “على حينَ عاتبتُ…”، أُضيف الظرف المبهم (حين) إلى جملة فعلية (عاتبتُ)، والجمل مبنية. هذا القرب من المبني (الجملة) أكسبه البناء، فاكتسب العدوى منه.
- المحدد للحركة: إضافته إلى جملة فعلية فعلها مبني (الفعل الماضي)، أو إضافته إلى اسم مبني. واختير الفتح لأنه أخف الحركات، وهو مناسب للظروف التي يكثر استعمالها.
فالخلاصة أن المحدد في حالة “قبلُ” هو الحذف والنية، والمحدد في حالة “حينَ” هو الإضافة إلى مبني.