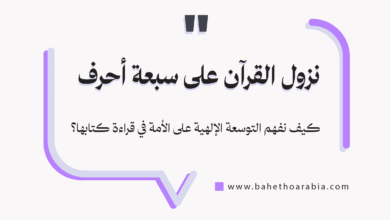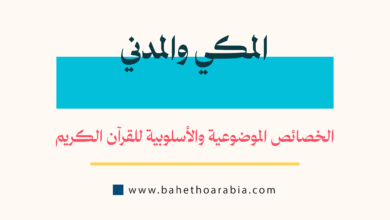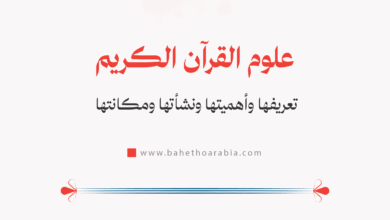أوجه إعجاز القرآن الكريم: كيف تتنوع أوجهه البيانية والمضمونية؟
ما الذي يجعل القرآن معجزاً للعالمين في بيانه ومضمونه؟
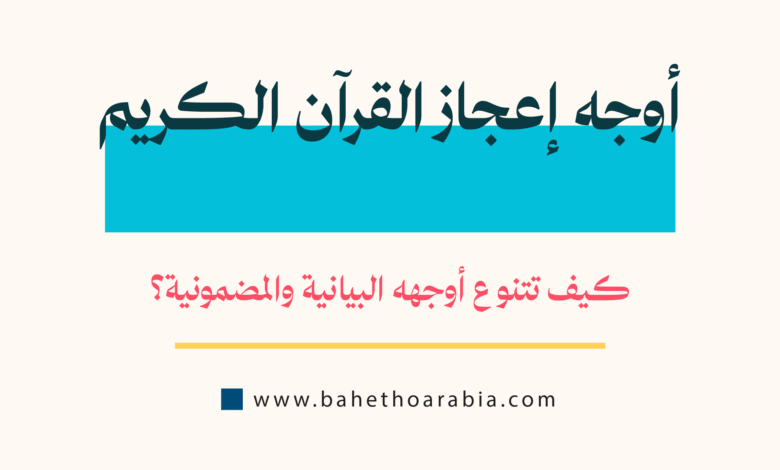
يمثل إعجاز القرآن الكريم ظاهرة فريدة حيرت العقول وأذهلت الألباب عبر العصور، فقد جمع بين روعة البيان وعمق المضمون بطريقة لم تتحقق في أي كلام بشري. وقد كرس العلماء والأدباء جهودهم لاستكشاف أوجه هذا الإعجاز الذي يتجدد مع كل قراءة وتدبر.
المقدمة
إن إعجاز القرآن الكريم يمثل معجزة خالدة تتجاوز حدود الزمان والمكان، فهو يخاطب العقول والقلوب في كل عصر بلغة تناسب مستوى فهمهم وإدراكهم. وقد اجتهد العلماء والباحثون قديماً وحديثاً في دراسة هذا الإعجاز من جوانبه المتعددة، سواء من حيث البيان اللغوي والأسلوبي، أو من حيث المضمون العلمي والتشريعي. ويتميز إعجاز القرآن الكريم بأنه شامل لجميع البشر، عرباً وعجماً، فصحاء وغير فصحاء، وهذا ما يجعله حجة قائمة إلى يوم القيامة. إن التعمق في دراسة أوجه الإعجاز القرآني يكشف عن بحر زاخر من المعارف والحكم التي لا تنضب، مما يدفع كل باحث للإحساس بالتقصير مهما بلغ من الجهد في استقصاء هذا الموضوع العظيم.
تفصيل أوجه إعجاز القرآن
كانت عناية العلماء والأدباء بشرح أوجه إعجاز القرآن تفصيلا عناية بالغة، حتى كان ذلك شغلهم الشاغل، وذلك لأن أوجه الاعجاز في القرآن تتنوع تنوعا واسعا شاملا للأسلوب والمضمون، للمبنى والمعنى، مما يجعل الباحث يحس بالتقصير مهما بحث وبالغ في استقصاء الموضوع.
لقد شكل إعجاز القرآن الكريم محور اهتمام الدارسين على مر العصور، فالقرآن معجز في كل جوانبه، من ألفاظه إلى معانيه، ومن تراكيبه إلى مقاصده. وهذا التنوع العجيب في أوجه الإعجاز يجعل كل عالم أو باحث يجد فيه مجالاً رحباً للدراسة والتأمل، دون أن يستطيع الإحاطة الكاملة بكل جوانبه. فالقرآن الكريم كتاب الله المعجز الذي لا تنقضي عجائبه ولا تنتهي أسراره، وكلما تعمق الباحث فيه ازداد علماً ويقيناً بأنه كلام رب العالمين.
شمول أوجه اعجاز القرآن
غير أن هذا الاتساع العجيب والتنوع المتجدد في اعجاز القرآن حتى حارت فيه العقول، جعل للقرآن مزية جلالة هي شمول إعجازه كل أنواع البشر عرباً وعجماً، من كان مميزا للكلام البليغ والأبلغ، ومن لم يُرزق تلك الموهبة، وإن كانت الحجة تلزم هذا النوع من الناس بشهادة أهل الموهبة الفنية والذوق الأدبي من الفصحاء العقلاء والبلغاء المراجيح الأثباء، ويتكوم المعاندين من غير المنصفين أمام التحدي على أعقابهم خاسرين، فالهم إذا عجزوا وهم أرباب الفصاحة وفرسان البيان كان غيرهم أولى بالعجز والتي أمام هذا التحدي.
على أن اعجاز القرآن في حق هذه الفئة ليس قاصراً على هذه الطريقة، مع غاية ظهورها وقوتها، بل إن القرآن معجز للعالمين بمضمونه أيضاً، وما اشتمل عليه من العلوم والمعارف، حتى لم يبق في الإعجاز أبلغ ولا أعظم من ذلك الإعجاز. وسنقدم فيما يلي خلاصات لأوجه هامة من أوجه إعجاز القرآن مستفيدين من دراسات القدماء، ومن نتائج بحوث الحدث، ونقسمها إلى قسمين رئيسين: القسم الأول: أوجه الإعجاز من حيث البيان. القسم الثاني: أوجه الإعجاز من حيث المضمون.
القسم الأول: أوجه إعجاز القرآن من حيث البيان
هذا القسم من أوجه إعجاز القرآن أعظم جوانب الإعجاز في القرآن، وإن كان قد يخفى معنى عظمته على كثير من الناس، والسبب في عظمة هذا القسم أنه هو الذي به كان القرآن قرآناً، وأن المنهج البياني المعجز القرآن هو سمة عامة لجميع القرآن الكريم، أما الأوجه الأخرى فيوجد الوجه منها في بعض الآيات دون الآخر، مثل إخبار الغيب، والإعجاز العلمي، والإعجاز التشريعي وهكذا.
وهذا الوجه يدركه العرب، وهم أول من يخاطب به وإذا عجزوا هم عنه، فغيرهم أعجز وأعجز. وقد أطال الدارسون القدماء والمحدثون في بيان خصائص أسلوب القرآن الكريم، وتلخص منها هذه الجوانب فيما يلي.
الوجه الأول: المنهج البديع المخالف لكل منهج معهود في لسان العرب وفي غيرها
بيان ذلك وتفصيله أن نظم القرآن ليس نثراً كالنثر، كما أنه ليس من نظم الشعر في شيء، وكذلك قال رب العزة الذي تولى نظمه: وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وفي صحيح مسلم أن أُنيساً أخا أبي ذر قال لأبي ذر: لقيت رجلاً في مكة على دينك يزعم أن الله أرسله، قلت: فما يقول الناس؟ قال يقولون: شاعر، كاهن، ساحر، وكان أنيس أحد الشعراء قال أنيس: لقد سمعت قول الكهنة، فما هو بقولهم، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر فلم يلتئم على لسان أحد بعدي أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم الكاذبون.
وكذلك أقر عتبة بن ربيعة أنه ليس بسحر ولا شعر لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حم) فصلت، على ما سبق بيانه هنالك، فإذا اعترف عتبة بن ربيعة على موضعه من اللسان وموضعه من الفصاحة والبلاغة، بأنه ما سمع مثل القرآن قط كان في هذا القول مقراً بإعجاز القرآن له ولضربائه من المتحققين بالفصاحة والقدرة على التكلم بجميع أجناس القول وأنواعه.
الوجه الثاني: الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال
الجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال، وتأمل ذلك في سورة «ق، والقرآن المجيد» إلى آخرها وقوله سبحانه: (والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة). إلى آخر السورة، وكذلك قوله سبحانه (ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون) إلى آخر السورة قال ابن الحصار: فمن علم أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، علم أن مثل هذه الجزالة لا تصح في خطاب غيره.
ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا، أن يقول: «لمن الملك اليوم»، ولا أن يقول: «ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء». إن هذه الجزالة والقوة في الأسلوب من خصائص إعجاز القرآن الكريم التي تدل على مصدره الإلهي، فلا يستطيع مخلوق مهما بلغ من الفصاحة والبلاغة أن يأتي بمثل هذه الجزالة في الخطاب، لأنها تليق بعظمة الخالق سبحانه وتعالى فقط.
الوجه الثالث: التفنن في التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي
وقد قام العلماء بدراسة بعض أنواع من ذلك، وقدموا فيها دراسات باهرة، كثير منها في جوانب لا تخطر على البال فمن ذلك:
١- تعبيره عن طلب الفعل
فقد تنوعت طرق هذا التعبير في القرآن تنوعاً لا تجد له مثيلاً في أدب الأدباء ودواوين الشعراء، ذكروا منها أربعة عشر نوعاً ولوناً من ألوان التعبير نذكر منها:
أ- الإخبار بكون الفعل على الناس «ولله على الناس حج البيت».
ب- الإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب منه (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء).
ج- الإخبار عن المبتدأ بمعنى يجب تحقيقه من غيره: (ومن دخله كان آمناً). أي مطلوب من الناس تأمين من دخل الحرم.
د- ترتيب الفعل على شرط قبله «فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي».
هـ- استعمال الفعل منفياً معطوفاً عقب استفهام نحو «أفلا تذكرون» أي تذكروا.
٢- تعبيره عن النهي
وهو متنوع كذلك تنوعاً كبيراً ذكروا منها خمس عشرة نوعاً، نذكر منها:
أ- وصفه بأنه ليس براً، (وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها).
ب- وصفه بأنه شر (ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شرٌّ لهم).
ج- وصف موضع الفعل بالأذى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى).
د- هـ- وصف الفعل بأنه من عمل الشيطان، وكذلك تعليق الفلاح على تركه، كقوله في آية تحريم الخمر والميسر… ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون).
شهادة الوليد بن المغيرة على التفنن القرآني
وقد كان هذا التفنن العجيب في تصريف الكلام مما لفت نظر العرب وانتباههم. وقد سمع الوليد بن المغيرة قارئاً يقرأ (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد).
فحرك الوليد رأسه تعجباً وقال كلمة هامة في إعجاز الآية: «جمع الأمر والنهي، والاستخبار والحظر والإباحة والترغيب والترهيب، والنداء والجواب. أشهد أن هذا ما خرج من فك بشر». ثم استرجع وقال: إنْ هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر. وهذه الشهادة من أحد أكابر قريش وفصحائها تُعَدُّ اعترافاً واضحاً بعجز البشر عن الإتيان بمثل هذا النظم المعجز، رغم محاولته إنكار ذلك بنسبته إلى السحر.
الوجه الرابع: الإبداع
الإبداع: وهو أن تكون كل لفظة من الكلام على انفرادها متضمنة لوناً أو لونين من البلاغة حسب قوة الكلام وما يعطيه معناه، بحيث يأتي في الجملة الواحدة عدة ضروب من البلاغة ولا تخلو لفظة واحدة من لون بلاغي فأكثر. قال ابن أبي الإصبع المصري: (وما رأيت ولا رويت في الكلام المنثور والشعر الموزون كآية من كتاب الله تعالى استخرجت منها أحداً وعشرين ضرباً من البديع، وعددها سبع عشرة لفظة، وهي قوله تعالى: (وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغِيضَ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين).
وتفصيل ما جاء فيها من البديع: المناسبة التامة في: ابلعي وأقلعي، والمطابقة اللفظية في ذكر السماء والأرض، والاستعارة في قوله: ابلعي وأقلعي للأرض والسماء، والمجاز في قوله: (يا سماء) فإن الحقيقة: ويا مطر السماء أقلعي، والإشارة في قوله: (وغيض الماء) فإنه سبحانه وتعالى عبَّر بهاتين اللفظتين عن معانٍ كثيرةٍ؛ لأن الماء لا يغيض حتى يقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما يخرج من عيون الماء فينقص الحاصل على وجه الأرض من الماء، والإرداف في قوله: (واستوت على الجودي) فإنه عبر عن استقرار السفينة على هذا المكان وجلوسها جلوساً متمكناً لا زيغ فيه ولا ميل، لطمأنينة أهل السفينة بلفظ قريب من لفظ الحقيقة، والتمثيل في قوله: (وقضي الأمر) فإنه عبر بذلك عن هلاك الهالكين ونجاة الناجين بلفظ فيه بعد ما من لفظ الحقيقة بالنسبة إلى لفظ الإرداف، والتعليل لأن غيض الماء علة الاستواء، وصحة التقسيم حين استوعب سبحانه أقسام أحوال الماء حالة نقصه، إذ ليس إلا احتباس ماء السماء واحتقان الماء الذي ينبع من الأرض، وغيض الماء الحاصل على ظهر الأرض، والاحتراس في قوله: (وقيل بعداً للقوم الظالمين) محترساً من توهم من يتوهم أن الهلاك ربما عم من لا يستحق الهلاك فجاء سبحانه بالدعاء على الهالكين ليتعلم أنهم مستحقو الهلاك، فإن عدله منع أن يدعو على غير مستحق للدعاء عليه، والانفصال فإن لقائل أن يقول: إن لفظة القوم مستغنى عنها، فإنه لو قيل: «وقيل بعداً للظالمين» لتم الكلام، والانفصال عن ذلك أن يقال: لما سبق في صدر الكلام قبل الآية قوله تعالى: (وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه) وقال سبحانه قبل ذلك مخاطباً لنوح عليه السلام: (ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون) فاقتضت البلاغة أن يؤتى بلفظة القوم التي آلة التعريف فيها للعهد ليتبين أنهم القوم الذين تقدم ذكرهم في قوله تعالى: (وكلما مر عليه ملأ من قومه) ووصفهم بالظلم، وأخبر بسابق علمه أنهم هالكون بقوله: (ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون) فحصل الانفصال عن الإشكال، وعلم أن لفظة القوم ليست فضلة في الكلام، والمساواة لأن لفظ الآية لا يزيد على معناه ولا ينقص عنه، وحسن النسق في عطف القضايا بعضها على بعض بأحسن ترتيب حسبما وقعت أولاً فأولاً، فإنه سبحانه أمر الأرض بالابتلاع، ثم عطف على ذلك أمر السماء بالإقلاع ثم عطف غيض الماء على ذلك، ثم عطف على ذلك قضاء الأمر بهلاك الهالكين ونجاة الناجين، ثم عطف على ذلك استواء السفينة على الجودي، ثم عطف على ذلك الدعاء على الهالكين، فجاء عطف هذه الجمل على ترتيب وقوعها في الوجود، وائتلاف اللفظ مع المعنى لكون كل لفظة لا يصلح في موضعها غيرها، والإيجاز لأنه سبحانه اقتص القصة بلفظها مستوعبة، بحيث لم يُخلَّ منها بشيء في أخصر عبارة، بألفاظ غير مطولة، والتسهيم: لأن من أول الآية إلى قوله تعالى: (أقلعي) يقتضي آخرها، والتهذيب لأن مفردات الألفاظ موصوفة بصفات الحسن، كل لفظة سهلة مخارج الحروف، عليها رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة، والتركيب سليم من التعقيد وأسبابه، وحسن البيان من جهة أن السامع لا يتوقف في فهم معنى الكلام، ولا يشكل عليه شيء منه، والتمكين لأن الفاصلة مستقرة في قرارها، مطمئنة في مكانها غير قلقة ولا مستدعاة والانسجام: وهو تحدر الكلام بسهولة وعذوبة سبك مع جزالة لفظ، كما ينسجم الماء القليل من الهواء، وما في مجموع ألفاظ الآية من الإبداع، وهو الذي سمي به هذا الباب، إذ في كل لفظة بديع وبديعان، لأنها كما تقدم سبع عشرة لفظة تضمنت أحداً وعشرين ضرباً من البلاغة سوى ما يتعدد من ضروبها، فإن الاستعارة وقعت في موضعين: وهما الابتلاع والإقلاع، فانظر: رحمك الله إلى عظمة هذا الكلام، وما انطوى عليه نظمه، وما تضمنه لفظه لتقدره قدره. وهذا ما ظهر لي منه على ضعف نظري وقلة مادتي من العلوم وكلال ذهني. والله أعلم).
الخاتمة
إن إعجاز القرآن الكريم يمثل آية باقية خالدة تشهد على صدق الرسالة المحمدية، فقد جمع بين الإعجاز البياني والإعجاز المضموني بطريقة فريدة لا نظير لها. وقد تبين من خلال استعراض أوجه الإعجاز البياني أن القرآن الكريم قد جاء بمنهج بديع في التعبير لم يعهده العرب في نثرهم ولا شعرهم، وتميز بجزالة لا تصح إلا من الخالق سبحانه وتعالى، كما أظهر تفنناً عجيباً في التصرف في اللغة العربية بما يعجز عنه أفصح الفصحاء، وحوى من ضروب البلاغة والبديع ما يجعل كل لفظة فيه معجزة قائمة بذاتها. وهذا التنوع والشمول في الإعجاز يجعل القرآن الكريم حجة بالغة على جميع الناس في كل زمان ومكان، ويدعو كل مسلم إلى التدبر في آياته والوقوف على أسرار بلاغته وعظمة معانيه، ليزداد إيماناً ويقيناً بأن هذا الكتاب العظيم هو كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
سؤال وجواب
١- ما المقصود بإعجاز القرآن الكريم؟
إعجاز القرآن الكريم هو عجز الإنس والجن عن الإتيان بمثله أو بسورة من مثله، رغم التحدي المستمر لهم، ويشمل هذا الإعجاز جوانب متعددة منها البيانية واللغوية والتشريعية والعلمية والغيبية، مما يجعله معجزة خالدة تناسب كل العصور والأزمنة.
٢- لماذا يُعد الإعجاز البياني أعظم أوجه إعجاز القرآن؟
يُعَدُّ الإعجاز البياني أعظم أوجه إعجاز القرآن الكريم لأنه السمة العامة الشاملة لجميع آيات القرآن دون استثناء، بينما الأوجه الأخرى كالإعجاز العلمي وإخبار الغيب توجد في بعض الآيات دون غيرها، كما أنه الوجه الذي يدركه العرب مباشرة وهم أهل اللسان والبيان.
٣- كيف يكون القرآن معجزاً لغير العرب؟
القرآن الكريم معجز لغير العرب من خلال مضمونه وما اشتمل عليه من العلوم والمعارف والتشريعات والأخبار الغيبية، كما أن غير العرب ملزمون بشهادة أهل الاختصاص من الفصحاء والبلغاء العرب الذين أقروا بعجزهم عن الإتيان بمثله، فإذا عجز أرباب الفصاحة كان غيرهم أولى بالعجز.
٤- ما الفرق بين نظم القرآن والشعر والنثر؟
نظم القرآن الكريم يمثل منهجاً بديعاً مخالفاً لكل منهج معهود في لسان العرب، فهو ليس نثراً كالنثر المعروف، وليس من نظم الشعر في شيء، وقد شهد بذلك الفصحاء من العرب كأُنيس أخي أبي ذر الذي وضع القرآن على أوزان الشعر فلم يلتئم، مما يؤكد تفرد القرآن بأسلوب لا يشبه أي كلام بشري.
٥- ما المقصود بالجزالة في القرآن الكريم؟
الجزالة في القرآن الكريم هي قوة الألفاظ وفخامتها ومتانتها بحيث لا تصح من مخلوق بحال، كما في قوله تعالى في سورة ق والآيات التي تتحدث عن يوم القيامة، فهي تحمل من العظمة والهيبة ما يليق بجلال الله سبحانه وتعالى فقط، ولا يصح أن يتكلم بمثلها أي مخلوق مهما بلغت منزلته.
٦- كيف يتفنن القرآن في التعبير عن طلب الفعل والنهي؟
يتفنن القرآن الكريم في التعبير عن طلب الفعل بأربعة عشر أسلوباً متنوعاً، منها الإخبار بكون الفعل على الناس، والإخبار عن المكلف بالفعل المطلوب، وترتيب الفعل على شرط، كما يتنوع في التعبير عن النهي بخمسة عشر أسلوباً منها وصف الفعل بأنه ليس براً أو أنه شر أو أذى أو من عمل الشيطان، وهذا التنوع لا نظير له في أدب الأدباء ودواوين الشعراء.
٧- ما هو الإبداع البلاغي في القرآن الكريم؟
الإبداع البلاغي في القرآن هو أن تكون كل لفظة من الكلام متضمنة لوناً أو أكثر من ألوان البلاغة، بحيث تجتمع في الجملة الواحدة عدة ضروب من البديع، كما في آية الطوفان التي استخرج منها العلماء أحداً وعشرين ضرباً من البلاغة في سبع عشرة لفظة فقط، مما يدل على إعجاز كل كلمة في القرآن.
٨- لماذا اعترف الوليد بن المغيرة بإعجاز القرآن؟
اعترف الوليد بن المغيرة بإعجاز القرآن عندما سمع آية سورة المائدة التي جمعت الأمر والنهي والاستخبار والحظر والإباحة والترغيب والترهيب والنداء والجواب في آية واحدة، فقال إن هذا ما خرج من فك بشر، وهذه شهادة من أحد أكابر قريش وفصحائها تؤكد العجز التام عن الإتيان بمثل هذا النظم.
٩- كيف يجتمع في الآية الواحدة عشرات الضروب البلاغية؟
يجتمع في الآية الواحدة عشرات الضروب البلاغية من خلال التركيب المعجز الذي يجعل كل لفظة تحمل معاني متعددة ووظائف بلاغية مختلفة، كالمناسبة والمطابقة والاستعارة والمجاز والإشارة والإرداف والتمثيل والتعليل والاحتراس والمساواة وحسن النسق والإيجاز والتسهيم والتهذيب والتمكين والانسجام، وكل هذا في انسجام تام دون تكلف أو تعقيد.
١٠- ما الفرق بين دراسات القدماء والمحدثين لإعجاز القرآن؟
دراسات القدماء لإعجاز القرآن الكريم ركزت على الجوانب البيانية والبلاغية واللغوية بشكل أساسي، مستفيدين من معرفتهم العميقة باللغة العربية وأساليبها، بينما أضاف المحدثون جوانب جديدة كالإعجاز العلمي والتشريعي والنفسي، مع الاستمرار في تطوير فهم الجوانب البيانية بأدوات بحثية حديثة، وكلا الفريقين أسهم في إثراء فهمنا لعظمة القرآن الكريم.