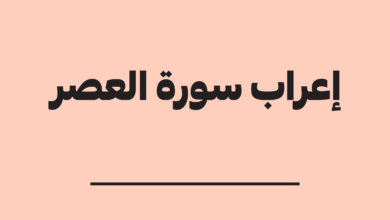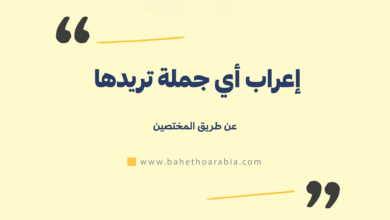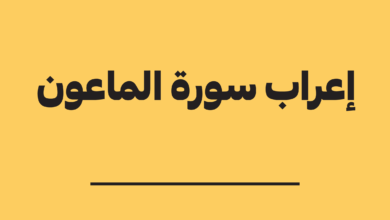إعراب الفعل المعتل الآخر: حالات الرفع والنصب والجزم بالأمثلة
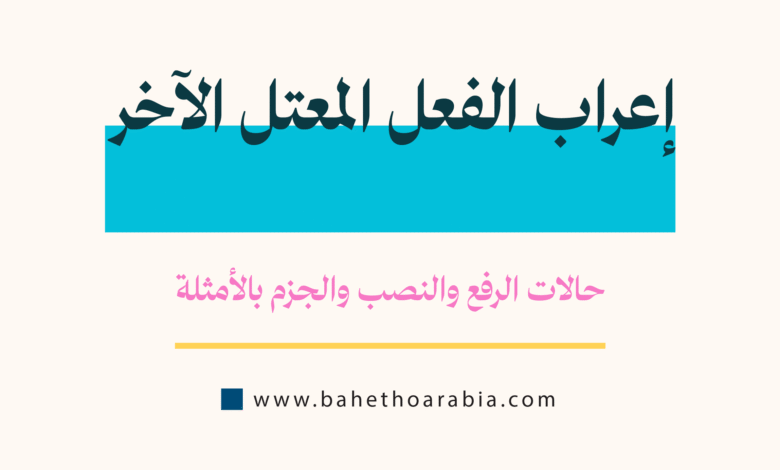
يُمثّل فهم قواعد الإعراب في اللغة العربية عموداً فقرياً لإتقان بنيتها المنطقية والدلالية، ويأتي إعراب الفعل المعتل في صدارة المباحث التي تتطلب دقة وعناية خاصة. فبينما تسير الأفعال صحيحة الآخر على وتيرة إعرابية واضحة، تتخذ الأفعال المعتلة مساراً فريداً تتغير فيه العلامات الإعرابية بين الظهور والتقدير والحذف، مما يمنحها خصوصية تجعل من دراستها ضرورة حتمية لكل باحث ومتعلم. يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل أكاديمي شامل ومفصل لقواعد إعراب الفعل المعتل، مستعرضاً حالاته الثلاث – الرفع والنصب والجزم – معززاً بالأمثلة القرآنية والشواهد النحوية التي تزيل كل غموض وتُرسي أساساً متيناً لفهم هذا الباب النحوي الهام.
تعريف الفعل المعتل
يُعرَّف الفعل المعتل بأنه كل فعل كان أحد حروفه الأصلية حرف علة، وهي الألف أو الياء أو الواو. وهذا التعريف هو حجر الزاوية لفهم إعراب الفعل المعتل. وفي سياق هذا البحث الذي يركز على إعراب الأفعال، ينصب اهتمامنا على دراسة إعراب الفعل المعتل الآخر على وجه الخصوص، وهو الفعل الذي ينتهي بأحد حروف العلة، ومن أمثلته:
يخشى: معتل الآخر بالألف.
يقضي: معتل الآخر بالياء.
يدعو: معتل الآخر بالواو.
وتتشابه الحالات الإعرابية لهذه الأفعال مع الفعل الصحيح الآخر، حيث تكون مرفوعة عند التجرد من النواصب والجوازم، ومنصوبة عند دخول أداة نصب، ومجزومة عند دخول أداة جزم. ويتطلب إعراب الفعل المعتل تفصيلاً دقيقاً لكل حالة على حدة، وهو ما سنوضحه فيما يلي، لترسيخ فهم إعراب الفعل المعتل بشكل كامل.
إعراب الفعل المعتل الآخر بالألف
١ – حالة الرفع:
في حالة الرفع، تُقدَّر الضمة على آخره، ويكون المانع من ظهورها هو التعذر، الذي يعني استحالة النطق بالحركة. تُعَدُّ هذه القاعدة أساسية في إعراب الفعل المعتل المنتهي بألف.
قال تعالى: {وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء}.
يُظهر تحليل الفعل (يخفى) في الآية الكريمة أنه مرفوع، ولكن الضمة لم تظهر على الألف، والسبب في ذلك هو تعذُّر النطق بها مع الألف الساكنة، وهذا تطبيق مباشر لقاعدة إعراب الفعل المعتل.
ويكون إعراب الفعل المعتل (يخفى) على النحو التالي: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر.
٢ – حالة النصب:
تُقدَّر الفتحة أيضًا على الألف في حالة النصب، كما هو الحال مع الضمة في حالة الرفع، وذلك لتعذر ظهور الحركة نطقًا. ويمثل هذا المبدأ جزءًا لا يتجزأ من إعراب الفعل المعتل الآخر بالألف. يتجلى ذلك في قوله تعالى: {ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم}.
فالفعل (ترضى) هنا فعل مضارع منصوب بـ (لن)، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، وقد منع من ظهورها التعذر، مما يؤكد على خصوصية إعراب الفعل المعتل في حالة النصب.
٣ – حالة الجزم:
أما في حالة الجزم، فإن إعراب الفعل المعتل يتخذ منحى مختلفًا، حيث يُحذَف حرف العلة من آخره، وتكون علامة الجزم هي حذف هذا الحرف. يتضح هذا الحكم في قوله تعالى: {ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله}، وقوله عز وجل: {ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض}.
إن الفعلين (يأبَ) و(ترَ) مجزومان؛ الأول بـ (لا) الناهية، والثاني بـ (لم) الجازمة، وعلامة جزمهما هي حذف حرف العلة من آخرهما، وهو الحكم القياسي في إعراب الفعل المعتل عند الجزم.
إعراب الفعل المعتل (يأبَ): فعل مضارع مجزوم بـ (لا) الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره.
إعراب الفعل المعتل (ترَ): فعل مضارع مجزوم بـ (لم)، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره.
إعراب الفعل المعتل الآخر بالياء أو الواو
١ – في حالة الرفع:
عند دراسة إعراب الفعل المعتل المنتهي بالياء أو الواو، نجد أن الحركة في حالة الرفع، وهي الضمة، تُقدَّر على آخره، ويكون المانع من ظهورها هو الثقل. ومن أمثلة ذلك: (يقضي) و(يدعو).
إذ لا يوجد استحالة نطقية (تعذر) في قول: (يقضيُ) أو (يدعوُ) بإظهار الحركة، ولكن النطق بها يسبب ثقلًا على اللسان عند الانتقال من الكسرة إلى الضمة في الأول، أو نطق الضمة على الواو في الثاني. وعليه، فإن تقدير الحركة هنا يهدف إلى التخفيف، وهو جانب مهم في فهم إعراب الفعل المعتل.
قال تعالى: {يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها}.
وقال تعالى: {يوم ندعو كل أناس بإمامهم}.
ويكون إعراب الفعل المعتل (تأتي): فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء للثقل.
ويكون إعراب الفعل المعتل (ندعو): فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو للثقل.
٢ – حالة النصب:
خلافًا لحالة الرفع، يتميز إعراب الفعل المعتل بالياء أو الواو في حالة النصب بظهور الفتحة على حرف العلة، وذلك لخفة نطقها على هذين الحرفين.
قال تعالى: {لن ندعوَ من دونه إلهاً}.
وقال عز وجل: {ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيَهم الله خيراً}.
إن إعراب الفعل المعتل (ندعوَ) هو: فعل مضارع منصوب بـ (لن)، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.
أما إعراب الفعل المعتل (يؤتيَهم) فهو: فعل مضارع منصوب بـ (لن)، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الياء، والضمير (هم) في محل نصب مفعول به. ويُظهر هذا المثال وضوح الفتحة عند التعامل مع إعراب الفعل المعتل بالياء.
٣ – حالة الجزم:
عند دخول أداة جازمة، يتحد حكم إعراب الفعل المعتل المنتهي بالياء أو الواو مع حكم المعتل الآخر بالألف، حيث تكون علامة الجزم هي حذف حرف العلة.
قال تعالى: {كلا لما يقضِ ما أمره}.
وقال عز وجل: {فلا تدعُ مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين}.
وقال: {ومن يتقِ الله يجعل له مخرجاً}.
إعراب الفعل المعتل (يقضِ): فعل مضارع مجزوم بـ (لما)، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره.
إعراب الفعل المعتل (تدعُ): فعل مضارع مجزوم بـ (لا) الناهية، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره.
إعراب الفعل المعتل (يتقِ): فعل مضارع مجزوم لوقوعه فعلًا للشرط، وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره. ويُعد هذا تطبيقًا دقيقًا لقواعد إعراب الفعل المعتل في أسلوب الشرط.
أبيات الألفية في إعراب الفعل المعتل
وأي فعل آخر منه ألف *** أو واو أو ياء فمعتلاً عُرِفْ
فالألفَ انوِ فيه غيرَ الجزمِ *** وأبدِ نصبَ ما كـ يدعو يرمي
والرفع فيهما انوِ واحذفْ جازماً *** ثلاثَهُنَّ تقضِ حكماً لازما
خاتمة
وفي ختام هذا التحليل المفصّل، يتضح أن إعراب الفعل المعتل ليس مجرد مجموعة من القواعد الاستثنائية، بل هو نظام دقيق يعكس مرونة اللغة العربية وقدرتها على تحقيق التوازن بين البنية النحوية ومتطلبات السلاسة النطقية. لقد استعرضنا كيفية تقدير الحركات للتعذر أو للثقل، وكيفية ظهورها عند الخفة، ومتى يكون حذف حرف العلة هو العلامة الإعرابية الحاسمة. إن التمكن من إعراب الفعل المعتل هو بمثابة امتلاك مفتاح أساسي لفهم أعمق للنصوص العربية الرفيعة، وعلى رأسها القرآن الكريم، ويفتح الآفاق نحو تحليل لغوي أكثر نضجاً ودقة.
الأسئلة الشائعة
١ – ما هو الفرق الجوهري بين “التعذر” و”الثقل” في إعراب الفعل المعتل؟
الفرق جوهري وأساسي في فهم إعراب الفعل المعتل. التعذر يعني الاستحالة المطلقة لنطق الحركة على الحرف، وهو خاص بالألف المقصورة أو الممدودة (مثل: يخشى، يسعى)، فلا يمكن فيزيائياً نطق ضمة أو فتحة على الألف. أما الثقل، فهو يعني إمكانية نطق الحركة، لكن مع وجود صعوبة ومشقة في اللفظ، وهو خاص بالواو والياء (مثل: يدعو، يقضي). يمكن نظرياً أن نقول “يَدعُوُ” أو “يَقضِيُ”، لكن هذا النطق ثقيل على اللسان العربي الفصيح، لذا تُقدّر الضمة للتخفيف.
٢ – لماذا تظهر الفتحة على الفعل المعتل بالياء والواو في حالة النصب، بينما تُقدَّر على المعتل بالألف؟
السبب يكمن في الخصائص الصوتية للحركات وحروف العلة. الفتحة هي أخف الحركات، ونطقها بعد الياء أو الواو (مثل: لن يرميَ، لن يدعوَ) لا يسبب أي ثقل، بل ينسجم مع مخرج الحرفين، لذا تظهر. في المقابل، يستحيل نطق الفتحة على الألف (كما في: لن يرضى) لأن الألف حرف ساكن بطبيعته ومفتوح ما قبله دائماً، وأي محاولة لوضع حركة عليه تُفسد طبيعته الصوتية، لذا تُقدَّر الفتحة للتعذر، وهذه من أدق نقاط إعراب الفعل المعتل.
٣ – عند جزم الفعل المعتل بحذف حرف العلة، ما هي الحركة التي توضع على الحرف الأخير؟
عندما يُحذف حرف العلة كعلامة جزم، تُوضع حركة على الحرف الذي يسبقه تكون مُجانسة للحرف المحذوف للدلالة عليه.
- إذا كان المحذوف ألفاً (مثل: لم يخشَ)، توضع فتحة على الحرف السابق (الشين).
- إذا كان المحذوف واواً (مثل: لم يدعُ)، توضع ضمة على الحرف السابق (العين).
- إذا كان المحذوف ياءً (مثل: لم يرمِ)، توضع كسرة على الحرف السابق (الميم).
هذه الحركة ليست علامة إعراب، بل هي علامة إرشادية تشير إلى طبيعة الحرف المحذوف.
٤ – هل تنطبق قواعد إعراب الفعل المعتل على الفعل الماضي والأمر؟
قواعد إعراب الفعل المعتل التي نوقشت (الرفع والنصب والجزم) خاصة بالفعل المضارع لأنه هو الفعل المُعرب. أما الفعل الماضي والأمر فهما مبنيان دائماً، ولكن حرف العلة يؤثر في علامة البناء:
- الفعل الماضي المعتل الآخر: يُبنى على الفتح المقدر على الألف للتعذر (مثل: دعا، سعى)، ويبنى على الضم المقدر على حرف العلة المحذوف عند اتصاله بواو الجماعة (مثل: دَعَوْا، سَعَوْا).
- فعل الأمر المعتل الآخر: يُبنى على حذف حرف العلة من آخره (مثل: اِدعُ، اِقضِ، اِسعَ)، وهي نفس علامة جزم مضارعه.
٥ – كيف يؤثر اتصال الضمائر بالفعل المعتل على إعرابه؟
اتصال الضمائر يؤثر بشكل كبير على إعراب الفعل المعتل. على سبيل المثال، إذا اتصلت به واو الجماعة أو ياء المخاطبة، فإنه قد يُحذف منه حرف العلة الأصلي لمنع التقاء الساكنين، ويصبح من الأفعال الخمسة، فيُرفع بثبوت النون ويُنصب ويُجزم بحذفها (مثل: يخشَوْن، لن تسعَيْ). فهم هذه التغيرات الصرفية ضروري لإتقان إعرابه.
٦ – هل يمكن أن يأتي الفعل معتلاً في أوله أو وسطه وآخره في نفس الوقت؟
نعم، ويُسمى في علم الصرف “اللفيف”. إذا اجتمع حرفا علة في الفعل، يكون إما “لفيفاً مقروناً” (الحرفان متجاوران مثل: كَوَى، شَوَى) أو “لفيفاً مفروقاً” (يفرق بينهما حرف صحيح مثل: وَعَى، وَقَى). عند إعراب الفعل المعتل من هذا النوع في صيغة المضارع (يكوي، يعي)، فإننا نركز على حرف العلة الأخير لتحديد علامة الإعراب، كما في القواعد التي تم شرحها.
٧ – ما هي أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الطلاب عند إعراب الفعل المعتل؟
من أبرز الأخطاء:
- الخلط بين التعذر والثقل: استخدام أحدهما مكان الآخر.
- إظهار الضمة على الواو والياء: قول “يدعوُ” في حالة الرفع بدلاً من تقديرها.
- نسيان حذف حرف العلة في الجزم: كتابة “لم يدعو” بدلاً من “لم يدعُ”.
- اعتبار الحركة الدالة على الحرف المحذوف علامة إعراب: الظن بأن الكسرة في “لم يرمِ” هي علامة الجزم.
٨ – هل الإعراب التقديري يقلل من قوة الفعل أو دلالته في الجملة؟
إطلاقاً. الإعراب التقديري هو مجرد تكيّف صوتي تفرضه طبيعة الحروف، ولا يؤثر على القيمة الدلالية أو الوظيفية للفعل في الجملة. فالفعل “يخشى” في حالة الرفع له نفس القوة الدلالية للفعل “يكتبُ”، كلاهما مرفوع ويدل على حدث يقع في الحاضر، والفرق يكمن فقط في كيفية ظهور العلامة الإعرابية أو تقديرها.
٩ – كيف أفرق بين ياء الفعل المعتل وياء المتكلم؟
يمكن التفريق بينهما من خلال السياق وعلامة الإعراب. ياء الفعل الأصلية (مثل: يقضي) لا تظهر عليها الضمة للثقل. أما ياء المتكلم فهي ضمير متصل يُضاف إلى الفعل (مثل: يكرمني)، وتسبقها غالباً “نون الوقاية” لحماية الفعل من الكسر، وتكون الفتحة ظاهرة على الفعل قبلها (يكرمَ)، والياء نفسها تكون في محل نصب مفعول به. هذا التمييز ضروري لتجنب الخطأ في إعراب الفعل المعتل.
١٠ – هل هناك استثناءات لهذه القواعد في اللغة العربية؟
القواعد المذكورة هي القواعد القياسية والمطردة في النحو العربي. قد توجد بعض القراءات القرآنية أو الشواهد الشعرية النادرة التي تبدو وكأنها تخالف هذه القواعد (كإظهار الحركة للضرورة الشعرية)، ولكنها تُعامل كحالات خاصة أو ضرورات لا يُقاس عليها في الاستخدام العام. لذا، فإن الاعتماد على هذه القواعد هو الأساس السليم والصحيح لفهم إعراب الفعل المعتل.