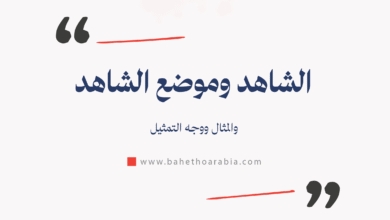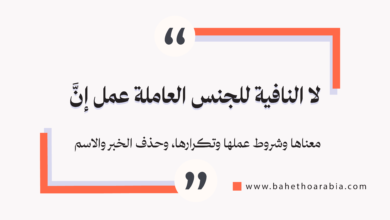الإغراء والتحذير في النحو العربي: تعريف، صور، وأحكام إعرابية تطبيقية
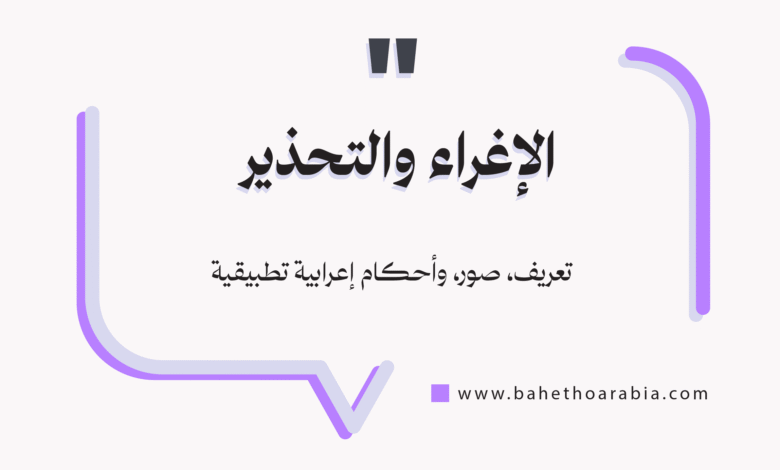
يُعَدّ أسلوبا (الإغراء) و(التحذير) من التراكيب النحوية ذات الوظيفة التداولية الدقيقة في العربية، لما ينطويان عليه من توجيه مباشر لسلوك المخاطَب؛ إذ يُبنى كلاهما على حذف العامل لفظاً وإبقائه تقديراً مع دلالةٍ واضحة على قصد المتكلِّم. وتستند قوة أسلوبي (الإغراء) و(التحذير) إلى تحقيق غرضين مقابلين: حثّ المخاطَب على المبادرة إلى أمر محمود، وصرفه عن الوقوع في أمر مذموم. وتكشف دراسة (الإغراء) و(التحذير) عن تلاحمٍ بين البنية النحوية والغاية البلاغية، حيث تتضافر الصياغة المختزلة والوزن الإيقاعي والنبرة الأمرية في بناء تأثيرٍ تواصليّ مباشر. ومن ثَمّ تتّضح أهمية استحضار الأصول الإعرابية والصور التطبيقية ومواطن الوجوب والجواز في حذف العامل، سعياً إلى ضبط الاستعمال الدقيق لأسلوبي (الإغراء) و(التحذير) في القول والكتابة. وسيقع في هذا العرض تحليل أمثلتهما الأصيلة، وتفصيل صورهما، واستجلاء مواضع الشاهد الشعري، مع إبراز العلاقة المنهجية بين النظرية والتطبيق في إطار (الإغراء) و(التحذير).
تهيئة نظرية: التراكيب الخاصة بالمفعول به ضمن (الإغراء) و(التحذير)
تتعدَّدُ التَّراكيبُ الخاصَّةُ بالمفعولِ بِهِ في اللُّغةِ العربيَّةِ، ومنها الاشتغالُ والتَّنازعُ و(الإغراء) و(التحذير) والاختصاصُ. وقد تناولْنَا في دروسٍ سابقةٍ أسلوبي الاشتغالِ والتَّنازعِ، كما تحدَّثْنَا عنِ المفعولِ بِهِ؛ وفي هذا الدرس نواصل البناء على تلك المعالجة بتخصيص البحث لأسلوبي (الإغراء) و(التحذير)، مع التزام التحليل الأكاديمي المباشر للنصوص والشواهد. ويُسهم التقديم المقارن بين (الإغراء) و(التحذير) في إبراز ما يشتركان فيه من بنية حذف العامل، وما يفترقان فيه من غايةٍ دلالية ووظيفةٍ تداولية.
التعريف الدقيق للأسلوب الأوّل: (الإغراء) في سياق (الإغراء) و(التحذير)
الإغراءُ هوَ نصبُ الاسمِ بفعلٍ محذوفٍ تقديرُهُ (الْزَمْ) أو ما في معناهُ، نحوُ قولِنَا: (النَّجدةَ).
النَّجدةَ: مفعولٌ بِهِ منصوبٌ على الإغراءِ بفعلٍ محذوفٍ جوازاً تقديرُهُ: الزمْ، وعلامةُ نصبِهِ الفتحةُ الظَّاهرةُ على آخرِهِ.
والغرضُ مِنَ الإغراءِ تنبيهُ المخاطبِ إلى أمرٍ محمودٍ ليفعلَهُ.
وفي سياق المقارنة المنهجية بين أسلوبي (الإغراء) و(التحذير)، يتبيّن أن الأساس التركيبي واحد (نصب اسمٍ بعاملٍ محذوف)، بينما يختلف المقصد التداولي باختلاف جهة التوجيه.
صور (الإغراء) وصلته بـ(الإغراء) و(التحذير)
لأسلوبِ الإغراءِ صورٌ ثلاثٌ، تتمايز بحسب البنية التركيبيّة ونوع الربط بين الألفاظ، على النحو الآتي:
١ – أنْ يأتي المُغْرَى بِهِ مفرداً (أي غيرَ مكرَّرٍ ولا معطوفاً عليهِ)؛ فيُنْصَبَ بفعلٍ محذوفٍ جوازاً، نحوُ قولِنَا: (الصِّدقَ في كلِّ عملٍ؛ فإنَّهُ طريقُ النَّجاحِ). ويُفهَم أن الجواز هنا مبنيٌّ على تقدير العامل مع عدم وجود قرينة تعوِّض عنه في السطح النّصي.
٢ – أنْ يأتي المُغرى بِهِ مكرَّراً، نحوُ قولِنَا: (المروءةَ المروءةَ؛ فإنَّهَا للرَّجلِ الكريمِ أجملُ حِليةٍ). ويكونُ الأوَّلُ منصوباً على الإغراءِ بفعلٍ محذوفٍ وجوباً، والثَّاني توكيداً لفظيّاً للأوَّلِ، وذلك لأنّ التكرار نفسه يقوم مقام العامل في السطح، فكان حذفُهُ وجوباً.
ومِنْهُ قولُ الشَّاعرِ:
أَخَاكَ أَخَاكَ إِنَّ مَنْ لَا أَخَا لَهُ … كَسَاعٍ إِلَى الْهَيجَا بِغَيرِ سِلَاحِ
أي: الزمْ أخاكَ.
والشَّاهدُ: وجوبُ إضمارِ الفعلِ (الزمْ)؛ لأنَّ المغرى بِهِ مكرَّرٌ، فـ”أخاكَ” منصوبٌ بتقديرِ: الزمْ أخاكَ، و”أخاكَ” الثَّانيةُ: توكيدٌ لفظيٌّ.
٣ – أنْ يأتي معطوفاً عليهِ، نحوُ قولِنَا: (العِلمَ الصَّحيحَ والخُلُقَ القويمَ؛ فإنَّهُمَا أساسُ بناءِ الأممِ). والعاملُ في هذهِ الصُّورةِ محذوفٌ وجوباً أيضاً؛ إذ عُدَّ التَّكرارُ والعطفُ تعويضاً عنِ العاملِ، فكانَ حذفُهُ واجباً؛ لئلَّا يُجْمَعَ بينَ العِوَضِ والمُعَوَّضِ عنْهُ.
رفع المُغرى به المكرَّر وشاهدُ الرفع عند العرب في إطار (الإغراء) و(التحذير)
وقدْ يأتي المكرَّرُ مرفوعاً على أنَّهُ خبرٌ لمبتدأٍ محذوفٍ، كقولِ الشَّاعرِ:
إِنَّ قَوماً مِنْهُمْ عُمَيرٌ وَأَشْبَا * هُ عُمَيرٍ وَمِنْهُمُ السَّفَّاحُ
لَجَدِيرُونَ بِالْوَفَاءِ إِذَا قَا * لَ أَخُو النَّجْدَةِ السِّلَاحُ السِّلَاحُ
موضعُ الشَّاهدِ: السِّلاحُ السِّلاحُ.
وجهُ الاستشهادِ: رُفِعَ المُغْرَى بِهِ المكرَّرُ، وأصلُهُ أنْ يُنْصَبَ بتقديرِ: خُذِ السِّلاحَ، والثَّاني يُعربُ توكيداً لفظيّاً.
قالَ الزَّجَّاجُ في معاني القرآنِ: والعربُ تُحَذِّرُ وتُغري بالرَّفعِ كالنَّصبِ. وتفيد هذه الملاحظة أنَّ البناءين متجاوران في الاستعمال العربي، وأن الرفع قد يحمل دلالة تقريرية تضاهي الدلالة الإنشائية للنصب، في سياق توجيه المخاطَب كما في (الإغراء) و(التحذير).
التعريف الدقيق للأسلوب الثاني: (التحذير) في نظام (الإغراء) و(التحذير)
التَّحذيرُ هوَ نصبُ الاسمِ بفعلٍ محذوفٍ تقديرُهُ (احذرْ) أو ما في معناهُ، نحوُ: (الكذبَ) أو (إيَّاكَ النَّميمةَ).
والغرضُ مِنَ التَّحذيرِ تنبيهُ المخاطَبِ إلى أمرٍ مكروهٍ ليتجنَّبَهُ.
ويقوم (التحذير) على ذات البنية النحوية المميِّزة للأساليب الإنشائية في العربية، كما يتجاوب وظيفياً مع (الإغراء) بوصفهما قطبيْ توجيهٍ في الخطاب: الأول حثٌّ والثاني كفٌّ. وتُبرز المقارنة بين (الإغراء) و(التحذير) وحدةَ الأداة النحوية واختلافَ المقصد التداولي.
صور التحذير المماثلة لصور الإغراء ضمن (الإغراء) و(التحذير)
للتَّحذيرِ صورٌ تُمَاثِلُ صورَ الإغراءِ، وقدْ يأتي:
• مفرداً، نحوُ قولِنَا: (الإهمالَ؛ فإنَّهُ مُضَيِّعُ للآمالِ). وفيه يكون العامل المحذوف جائز الحذف نظراً لعدم وجود ما يقوم مقامه.
• مكرَّراً، نحوُ: (الضَّغينةَ الضَّغينةَ؛ فإنَّهَا تَشْحَنُ النَّفسَ بالبغضاءِ). ويكون حذف العامل وجوباً لقيام التكرار مقامه.
• معطوفاً عليهِ، نحوُ: (اللَّهوَ والهزلَ والعدوُّ يتربَّصُ بنَا الدَّوائرَ). وهنا يُحذف العامل وجوباً؛ لأنّ العطف عِوضٌ عنه، اتساقاً مع قاعدة عدم الجمع بين العوض والمعوَّض.
صورٌ ينفرد بها الأسلوب الثاني في (الإغراء) و(التحذير)
ينفردُ التَّحذيرُ بصورٍ ليستْ للإغراءِ، وهي على التفصيل الآتي:
١ – أنْ يكونَ التَّحذيرُ بالضَّميرِ المنفصلِ (إيَّاكَ) وفروعِهِ، ويأتي المُحَذَّرُ مِنْهُ:
• معطوفاً، نحوُ: (إيَّاكَ وإضاعةَ الوقتِ). فهُنَا إيَّاكَ: ضميرُ نصبٍ منفصلٌ، في محلِّ نصبٍ بفعلٍ محذوفٍ وجوباً، والتَّقديرُ: أُحَذِّرُكَ، ثُمَّ حُذِفَ الفعلُ فانفصلَ الضَّميرُ.
• أو غيرَ معطوفٍ، نحوُ: (إيَّاكَ الإهمالَ). فهنَا يُمكنُ أنْ تجعلَ الواوَ عاطفةً لجملةٍ على جملةٍ، والتَّقديرُ: (باعدْ نفسَكَ واجتنبْ إضاعةَ الوقتِ)، أو تجعلَ الواوَ مفيدةً للمعيَّةِ، والثَّاني مفعولٌ معَهُ.
وقدْ يُكرَّرُ الضَّميرُ فيكونُ الثَّاني توكيداً لفظيّاً للأوَّلِ، كقولِ الشَّاعرِ:
فَإِيَّاكَ إِيَّاكَ الْمِرَاءَ فَإِنَّهُ * إِلَى الشَّرِّ دَعَّاءٌ وَلِلشَّرِّ جَالِبُ
وقدْ يُجَرُّ المُحَذَّرُ مِنْهُ بجارٍّ ويتعلَّقانِ بالفعلِ المحذوفِ، كقولِنَا: (إيَّاكَ مِنَ الاستهتارِ؛ فإنَّهُ مَزَلَّةُ قَدَمٍ).
٢ – أنْ يُذْكَرَ المحذَّرُ مِنْهُ والمحذَّرُ لأجلِهِ متعاطفينِ، نحوُ: (ثوبَكَ والوحلَ، أو رأسَكَ والغصنَ)، والأفضلُ في هذهِ الصُّورةِ تقديرُ عاملينِ محذوفينِ، وتكونُ الواوُ عاطفةً لجملةٍ على جملةٍ، والتَّقديرُ: صُنْ ثَوبَكَ واحذرِ الوحلَ، احفظْ رأسَكَ واجتنبِ الغصنَ.
٣ – أنْ يذكرَ المحذَّرُ مِنْ أجلِهِ والمحذَّرُ مِنْهُ دونَ عاطفٍ، نحوُ: (نفسَكَ الأهواءَ؛ فإنَّهَا تُعمي عنِ الحقِّ) فيُنصبانِ بالعاملِ المحذوفِ، والتَّقديرُ: جَنِّبْ نفسَكَ الأهواءَ.
وحَذْفُ العاملِ واجبٌ في الصُّورِ الثَّلاثةِ السَّابقةِ؛ لأنّ الروابط السياقية (التكرار، العطف، إضافة الضمير) تؤدي وظيفة الإشارة إلى الأمر المنهي عنه بما يُغني عن ذكر الفعل لفظاً.
وقدْ يأتي المحذَّرُ منهُ مكرَّراً مرفوعاً، نحوُ: (الخيانةُ الخيانةُ) فيكونُ الأوَّلُ خبراً لمبتدأٍ محذوفٍ، والثَّاني توكيداً لفظيّاً لَهُ.
خاتمة موسّعة تربط بين (الإغراء) و(التحذير) في البنية والدلالة
تُمثّل أساليب الأمر غير الصريح في العربية، وعلى رأسها (الإغراء) و(التحذير)، نموذجاً بليغاً للتكثيف النحوي والدقة الدلالية؛ إذ يلتقي فيه حذف العامل مع صراحة القصد، فيتنزّل التركيب منزلة الأمر والنهي دون التصريح بهما. وقد بيّن العرض أن صور (الإغراء) و(التحذير) تتوزّع بين المفرد والمكرَّر والمعطوف، مع تفاوتٍ في وجوب حذف العامل وجوازه بحسب وجود ما يعوِّض عنه في السطح النصّي. كما دلّت الشواهد الشعرية على سعة الاستعمال، وعلى جواز الرفع في المواضع التي يتقوّى فيها الحكم أو يُراد تقرير المعنى، وفق ما قرّره الزجّاج من أن العرب تُحذِّر وتُغري بالرفع كالنصب. ويستخلص الدارس من ذلك أن اختيار الصيغة الأنسب بين صور (الإغراء) و(التحذير) متعلّقٌ بغرض الخطاب وسياقه، وأنّ الوعي بالبنية الإعرابية يضمن سلامة الدلالة ووضوح المقصد. ومن آفاق البحث التطبيقية تتبّع أثر الإيقاع والتكرار والعطف في تعزيز وظيفة التوجيه، وتوسيع قاعدة الشواهد النثرية والشعرية لتدريب الملكة على إنشاء تراكيب (الإغراء) و(التحذير) واستعمالها على وجهها الصحيح.
الأسئلة الشائعة
١- ما الضابط النحوي الجامع لتعريف الإغراء؟
- الإغراء تركيب إنشائي يُنصب فيه الاسم بفعلٍ محذوف تقديره “الزم” أو ما في معناه، والغرض حثّ المخاطَب على فعلٍ محمود. يقوم الضابط على ثلاثة أركان: اسمٌ منصوب (مغرى به)، وعامل محذوف تقديره فعل أمر، وقرينة سياقية تُبرز القصد. ويُفهم من نصب الاسم أنه مفعولٌ به لذلك العامل المقدّر، وتنبني أحكامه على الصور الثلاث: المفرد، والمكرَّر، والمعطوف، مع تمييز مواضع وجوب الحذف وجوازه.
٢- ما العلة في وجوب حذف العامل أحياناً وجوازه أحياناً أخرى في الإغراء والتحذير؟
- العلة راجعة إلى قيام عِوَضٍ سياقي عن العامل. فإذا وُجد التكرار أو العطف في موضع ينهض مقام الفعل المحذوف، وجب الحذف لئلا يُجمع بين العوض والمعوَّض. أمّا إذا خلا التركيب من التكرار والعطف، كان الحذف جائزاً لأن دلالة الأمر قائمة بالسياق وإن لم توجد قرينة لفظية تقوم مقام الفعل.
٣- كيف يُفرَّق دلالياً بين الإغراء والتحذير وهما يشتركان في البنية النحوية؟
- التفرقة دلالية وظيفية: الإغراء توجيه إيجابي نحو مطلوبٍ محمود، والتحذير توجيه سلبي عن مطلوبٍ مذموم. كلاهما يعتمد نصب الاسم بعاملٍ محذوف، غير أنّ الإغراء يحمل معنى الحثّ، بينما يحمل التحذير معنى الكفّ والمنع. وتنعكس هذه الثنائية على اختيار ألفاظ المغرى به أو المحذَّر منه، فتجيء في الإغراء من قبيل الفضائل، وفي التحذير من قبيل الرذائل والمخاطر.
٤- ما الإعراب التفصيلي لأمثلة الإغراء من قبيل: “النَّجدةَ” و”الصِّدقَ في كلِّ عملٍ”؟
- في “النَّجدةَ”: مفعولٌ به منصوب على الإغراء بفعل محذوف جوازاً تقديره “الزمْ”، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. وفي “الصِّدقَ في كلِّ عملٍ”: الصِّدقَ مفعولٌ به منصوب على الإغراء بالعامل المحذوف جوازاً، وشبه الجملة “في كلِّ عملٍ” متعلّق بمحذوف صفة للصِّدق، والجملة تُفيد التقرير بأن الصدق طريق النجاح.
٥- هل يَرِدُ المغرى به أو المُحذَّر منه مرفوعاً مع أن الأصل نصبه؟
- نعم، قد يرد مرفوعاً على أنه خبرٌ لمبتدأٍ محذوف مع بقاء معنى التوجيه، كما في “السِّلاحُ السِّلاحُ” و”الخيانةُ الخيانةُ”. الأول خبر لمبتدأ محذوف تقديره “هذا”، والثاني توكيد لفظي. وقد قرر الزجاج أن العرب تُحذِّر وتُغري بالرفع كالنصب؛ إذ يؤدّي الرفع وظيفة التقرير وإظهار الثبات، بينما يؤدّي النصب وظيفة الإنشاء والأمر.
٦- ما ضوابط استعمال الضمير المنفصل “إيّاك” في باب التحذير؟
- يُنصب “إيّاك” بفعلٍ محذوف وجوباً تقديره “أحذّرك” أو “باعدْ نفسك”، ويأتي معه المحذَّر منه إمّا معطوفاً بالواو “إيّاك وإضاعةَ الوقتِ” أو غير معطوف “إيّاك الإهمالَ”. ويجوز تكرار “إيّاك” للتوكيد اللفظي، كما في الشاهد الشعري. وقد يجرّ المحذَّر منه بحرف جرّ “إيّاك من الاستهتار”، ويتعلّقان بالفعل المحذوف. وتُحدَّد وظيفة الواو بين العطف أو المعيّة بحسب المقام.
٧- ما علاقة هذين الأسلوبين بالإنشاء الطلبي وبنيته في العربية؟
- هما من الأساليب الإنشائية الطلبية غير الصريحة، لأنهما يُشيران إلى أمرٍ أو نهيٍ دون أدواتهما الظاهرة، حيث يُستعاض عن الفعل الأمر بقرائن لفظية كالتكرار والعطف أو بقرائن حالية. وبذلك يتكامل المستوى النحوي (نصب الاسم بالعامل المحذوف) مع المستوى البلاغي (التأثير في المتلقّي عبر إيقاعٍ مكثّف ونبرة تعبيرية حازمة).
٨- ما الأثر التداولي للتكرار والعطف في تقوية المعنى؟
- يُنتج التكرار إيقاعاً يُرسّخ المعنى في ذهن المخاطَب ويضاعف قوّة التوجيه، ولذا يقوم مقام العامل ويُوجب حذفه. وأمّا العطف فيربط بين عناصر متقاربة في الحكم، فيؤدي وظيفة جمعية تعزّز التوجيه وتوسّع نطاقه، ولذلك يُعدّ أيضاً عِوضاً عن العامل المحذوف. وكلا الوسيلتين تُسهِمان في وضوح القصْد وفي تقوية الاستجابة المتوقعة.
٩- ما أبرز الأخطاء الشائعة في استعمال الإغراء والتحذير وكيف تُصحَّح؟
- من الأخطاء: نصب الاسم مع عدم وجود قرينة تدل على التوجيه، أو إظهار العامل حيث يجب حذفه مع التكرار أو العطف، أو الخلط بين المفرد والمكرَّر في التوكيد اللفظي، أو إسقاط علامة النصب في الأمثلة القياسية. والتصحيح يكون بمراجعة الضابط: تقدير العامل الأمر في الذهن، والتحقّق من قيام التكرار أو العطف مقامه في مواضع الوجوب، والمحافظة على علامات الإعراب، وتمييز وظيفة كل عنصر في التركيب.
١٠- ما سبل تعليمية فعّالة لترسيخ هذا الباب لدى المتعلّمين؟
- يُستحسن الجمع بين التحليل النحوي الممنهج والتطبيق العملي: عرض التعريف والصور مع شواهدٍ معرّبة، ثم تدريب المتعلمين على بناء تراكيب مماثلة في سياقات حياتية، ومقارنة أثر النصب والرفع، وتوظيف “إيّاك” في تراكيب مختلفة. كما تنفع التمارين التفريقية بين المفرد والمكرَّر والمعطوف، وتمارين تقدير العامل وإعراب المكوّنات، مع توظيف الشواهد الشعرية والمثال القرآني والحديثي حيث تيسّر.