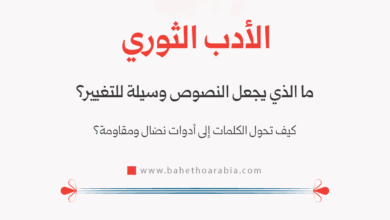الإغراب في الأدب: فن نزع الألفة وإيقاظ الإدراك الجمالي

تتميز الأعمال الأدبية بقدرتها الفائقة على تحويل المألوف إلى استثنائي، وعلى بث الروعة في تفاصيل الحياة اليومية، دافعةً المتلقي إلى رؤية العالم بعين جديدة غير مثقلة بالعادات. إن هذه القدرة التحويلية هي جوهر مفهوم “الإغراب” في الأدب، وهو تقنية محورية تهدف إلى تقديم الأشياء والأحداث والمواقف الشائعة بطريقة غير مألوفة، غريبة، أو حتى صادمة. يكمن الغرض الأساسي من هذه الاستراتيجية الفنية في كسر روتين الإدراك التلقائي، مما يعزز وعي القارئ، ويقدم له منظورات مبتكرة، ويجدد تفاعله مع النص والعالم الذي يمثله.
يُعد “الإغراب” ظاهرة فنية ذات صدى مزدوج؛ ففي حين نالت صياغتها النظرية الأكثر بروزًا في العصر الحديث، لا سيما عبر الشكلانية الروسية، فإن الدافع الجمالي الكامن وراءها وتطبيقاتها العملية تتجذر بعمق في التراث الأدبي العربي القديم. هذا التناغم بين القديم والحديث يؤكد أن “الإغراب” ظاهرة فنية خالدة وعابرة للثقافات. تؤكد هذه المقالة أن الإغراب يتجاوز مجرد كونه زينة أسلوبية؛ إنه أداة فنية عميقة وضرورية. وظيفته الأساسية هي مكافحة “الأتمتة” أو التبلد الإدراكي الناتج عن التعود، مما ينشط الانخراط الحسي والفكري. وفي نهاية المطاف، يعمق الإغراب التجربة الجمالية والنقدية للأدب، ويدفعنا إلى “الرؤية” و”الشعور” و”التفكير” من جديد حقًا، بدلاً من استهلاك المعلومات بشكل سلبي.
الإغراب: مفهوم يتجاوز الزمان والمكان
يُعد هذا القسم التأسيسي بمثابة استكشاف دقيق للأسس التاريخية والنظرية للإغراب، متتبعًا حضوره الضمني في الفكر العربي الكلاسيكي وصياغته الصريحة والمنهجية من قبل الشكلانيين الروس.
الجذور اللغوية والجمالية في التراث العربي القديم
يُعرف الإغراب في التراث الأدبي القديم بأنه إتيان الأديب بالغريب وغير المألوف من الألفاظ والصور، وهو تعريف يربط بشكل مباشر بين الفهم القديم والحديث لهذا المفهوم. على الرغم من أن النقاد العرب القدماء لم يستخدموا مصطلح “الإغراب” ضمن إطار نظري منهجي، إلا أنهم أدركوا ضمنيًا وقدروا وحللوا الآثار الجمالية لتقديم اللغة والصور بطريقة غير مألوفة. كانت نقاشاتهم النقدية، التي غالبًا ما تركزت حول مفاهيم البلاغة والفصاحة، تحتوي على إرهاصات واضحة لهذا المفهوم الحديث.
يُقدم القرآن الكريم مثالًا ساميًا على ذلك، حيث تحدت أنماطه اللغوية والتركيبية الفريدة، والتي غالبًا ما كانت تمثل تحديًا للمألوف، التعبيرات والتوقعات المعتادة للعرب، محققة بذلك تأثيرًا جماليًا وروحيًا لا مثيل له. يتجلى ذلك بوضوح في رد فعل الوليد بن المغيرة على الأسلوب القرآني، حيث وصفه بعبارات مثل “مثمر أعلاه ومغدق أسفله” و”يعلو ولا يعلى”، مما يوضح إدراكه البديهي لقوة جمالية تتجاوز الفصاحة التقليدية، وهي قوة مستمدة تحديدًا من تعبيره غير المعتاد، لكنه آسر. كان هذا شكلًا من أشكال الإغراب الذي أثار الإعجاب والرهبة.
كما يُعد موقف سيدنا عمر بن الخطاب من كلمة “الأبّ” في القرآن الكريم مثالًا آخر على هذا الإدراك الجمالي المبكر. فعندما تساءل عن معناها، ثم قرر عدم الخوض في دلالتها المعجمية الدقيقة رغم غرابتها، فإن ذلك يشير إلى تقدير واعٍ لقوتها الإيحائية، وتناغمها الإيقاعي، ومساهمتها الفنية الشاملة ضمن النص المقدس، بدلاً من مجرد السعي وراء الوضوح الدلالي. وهذا يدل على فهم بأن التأثير الجمالي يمكن أن ينبع من غرابة الكلمة ذاتها. بالإضافة إلى ذلك، أُعجب النقاد العرب الكلاسيكيون غالبًا بالتراكيب النحوية الفريدة في القرآن (مثل تأخير الاسم الظاهر عن الضمير العائد عليه في قوله تعالى: “فأوجس في نفسه خيفة موسى”) وصوره الغريبة، لكنها بالغة القوة (مثل وصف ثمر شجرة الزقوم بـ”رؤوس الشياطين”). وقد أشار الجاحظ إلى أن هذه الصورة رسخت بقوة في أذهان الناس استقباح صور الشياطين، مما يبرهن على القوة الإيحائية الهائلة للمقارنات غير المألوفة أو المدهشة.
على الرغم من أن الفصاحة، المرتبطة غالبًا بالوضوح والاستخدام الشائع، كانت المعيار الجمالي المهيمن، إلا أنه كان هناك نقاش نقدي دقيق ومستمر حول استخدام “الغريب” و”الحوشي” (الكلمات القديمة أو الصعبة). فقد أظهر الجاحظ نظرة براغماتية، مشيرًا إلى أن “سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني وقد يحتاج إلى السخيف في بعض المواضع”، وسماحه للبدو باستخدام “الحوشي” بشكل طبيعي دون تكلف. وهذا يدل على إدراك أن “الغرابة” يمكن أن تكون مناسبة وفعالة جماليًا بناءً على السياق، والمتحدث، والجمهور المستهدف. كما أشار ابن رشيق إلى أن الخلل غالبًا ما يكمن ليس في الكلمة “الغريبة” نفسها، بل في استخدامها غير المناسب أو عدم قدرة الجمهور على فهمها. وهذا يعني أن فعالية “الغرابة” نسبية، وتعتمد على مهارة الفنان في توظيفها وقدرة المتلقي على التفسير.
يُعد إسهام حازم القرطاجني ذا أهمية خاصة، حيث ربط جماليات العناصر اللغوية “الغريبة” بنظريته في “التخييل”. فقد أكد على دورها في إثارة الوجدان ونقل المتلقي من عالم الواقع العادي إلى عالم الشعر الإيحائي من خلال الإيحاء والتضمين. هذا المفهوم يتوازى بشكل مباشر مع الفهم الحديث لوظيفة الإغراب الجمالية والتجريبية. إن الإدراك الصريح لمفهوم الإغراب ضمن التراث الأدبي العربي القديم، والذي سبق صياغته النظرية الرسمية من قبل الشكلانيين الروس، يقدم دليلًا مقنعًا على أن الدافع الفني الأساسي لجعل المألوف غريبًا هو ظاهرة جمالية إنسانية عالمية. وهذا يؤكد أن هذا ليس بناءً نظريًا غربيًا فريدًا، بل استراتيجية متكررة، وربما فطرية، لتحقيق تأثير فني عميق عبر الثقافات المتنوعة. فبينما اختلف
التسمية والمنهجة للمفهوم، كان التطبيق الفني الكامن موجودًا.
الشكلانيون الروس و”الأسترانينيه”
يُعد فيكتور شكلوفسكي شخصية محورية في الحركة الشكلانية الروسية والمهندس الفكري لمفهوم “الأسترانينيه” (الإغراب)، الذي صاغه في مقالته الرائدة عام 1917 بعنوان “الفن كتقنية”. مثلت هذه المقالة نقطة تحول في النظرية الأدبية الحديثة، حيث حولت التركيز من العوامل الخارجية إلى الخصائص الجوهرية للنص الأدبي.
يتمثل الجوهر الأساسي للحجة الشكلانية في أن اللغة الأدبية تختلف جوهريًا عن اللغة اليومية العملية. فبينما تعطي اللغة العملية الأولوية للكفاءة والوضوح والتعرف التلقائي (مما يسمح لنا بالتنقل في العالم دون جهد واعٍ)، فإن اللغة الشعرية مصممة عمدًا لتكون “صعبة الفهم”، و”لتعيق الإدراك”، و”لإطالة التجربة الجمالية”. هذه “الصعوبة” المتعمدة ليست عيبًا أو حاجزًا، بل هي خيار فني حاسم يجبر على الانخراط الواعي.
يُعد مفهوم شكلوفسكي المركزي لـ”الأتمتة” جوهريًا هنا. يشير هذا المفهوم إلى العملية التي يفقد بها إدراكنا التلقائي والعادي للأشياء والتجارب، وحتى اللغة، تأثيرها الحسي، فتصبح “متبلدة” أو غير مدركة. يمكن ملاحظة أمثلة حية لذلك في الفعل اللاواعي لحمل القلم بعد تكرارات لا حصر لها، أو قيادة مسار مألوف دون ملاحظة المحيط حقًا. بالنسبة لشكلوفسكي، تؤدي هذه الأتمتة إلى حياة من التجارب غير المتفحصة والمتبلدة.
يُوضع الإغراب كجهاز فني أساسي لمكافحة هذه الأتمتة المنتشرة. فمن خلال جعل الأشياء “غريبة” أو “غير مألوفة” أو “صعبة”، ينشط الفن التجارب العادية، مما يجبر القراء على الانخراط بشكل أعمق، وإبطاء إدراكهم، ورؤية العالم بعيون جديدة غير متعبة. الغرض الصريح هو “إزالة أتمتة الإدراك”. بالنسبة للشكلانيين الروس، كان مفهوم “الأدبية” ذا أهمية قصوى، ويشير إلى ما يميز الأدب عن الأشكال الأخرى من الخطاب، مما يجعل النص
فنًا. الإغراب مركزي لتحقيق هذه “الأدبية”، لأنه الآلية التي تحول اللغة العادية إلى لغة أدبية. ركزت منهجيتهم بشكل مكثف على البنية الداخلية للجهاز الفني للعمل الأدبي نفسه، بدلاً من العوامل الخارجية مثل سيرة المؤلف، أو السياق الاجتماعي، أو الرسالة الفلسفية.
كما قدم شكلوفسكي تمييزًا مؤثرًا بين الحبكة (fabula)، وهي التسلسل الزمني للأحداث أو المادة القصصية الأساسية، والرواية (syuzhet)، وهي الترتيب الفني غير الزمني أو عرض تلك الأحداث، أي الحبكة. بالنسبة لشكلوفسكي، فإن الرواية هي في الأساس الحبكة التي جرى إغرابها. ويُعد كتاب لورنس ستيرن “تريسترام شاندي” مثالًا على ذلك، حيث يستخدم الكتاب إزاحات زمنية متعمدة، واستطرادات، واضطرابات سببية لإعاقة إعادة تجميع القارئ للقصة المألوفة تلقائيًا، وبالتالي إطالة وإثراء عملية الإدراك.
إن نظرية الإغراب لدى شكلوفسكي تتجاوز مجرد ملاحظة الخيار الأسلوبي؛ إنها بيان فلسفي عميق حول الغرض الأساسي للفن ودوره في التجربة الإنسانية. فهي تفترض أن الوظيفة الأساسية للفن هي إعادة تحسيس البشرية بثراء الوجود وتعقيده وروعته المطلقة، مما يمنع الحياة من الانحدار إلى سلسلة من الأفعال التلقائية غير المتفحصة. “الصعوبة” المتعمدة التي يقدمها ليست عيبًا، بل وسيلة متعمدة وضرورية لإيقاظ الوعي، وإطالة الإدراك، وفي نهاية المطاف جعلنا “نعيش” و”نشعر” بكل لحظة بشكل أكثر كثافة.
| المعيار | التراث العربي القديم | الشكلانية الروسية |
| المصطلح المستخدم | الإغراب / الغريب / نزع الألفة (مفهوم ضمني) | Ostranenie / Defamiliarization |
| الفترة الزمنية الرئيسية | العصور الجاهلية، الإسلامية، والعباسية | أوائل القرن العشرين (خاصة 1910s-1920s) |
| التركيز الأساسي | الألفاظ والصور والتراكيب غير المألوفة (ضمن البلاغة والنقد) | “الأدبية” (Literariness) وتمييز اللغة الأدبية عن اللغة العادية |
| الهدف/الوظيفة المعلنة | تحقيق التأثير الجمالي والإيحائي، إبراز الإعجاز (في القرآن)، إثارة الوجدان (التخييل) | نزع الألفة عن الإدراك الآلي، إطالة الإدراك، تجديد الرؤية |
| أمثلة بارزة | القرآن الكريم (أسلوب الوليد بن المغيرة، لفظ “الأبّ”)، شعر الفحول (مناقشات حول الحوشي) | أعمال فيكتور شكلوفسكي (مثل “الفن كتقنية”)، أمثلة من تولستوي (الفرس في “خولستومير”)، لورنس ستيرن (“تريسترام شاندي”) |
| المنظور النقدي/المنهجي | نقد جزئي، ذوقي، يعتمد على الاستقراء، ضمن علوم البلاغة والنحو | منهج علمي، نظري، يركز على بنية النص الداخلية، يسعى لوضع قواعد عامة للأدب |
التصدير إلى “جداول بيانات Google”
وظائف الإغراب وأثره الجمالي
يستكشف هذا القسم الفوائد العملية المتعددة والنتائج الجمالية العميقة المستمدة من الاستخدام الحكيم للإغراب، مع الاعتراف بالتحديات والقيود الكامنة فيه.
إيقاظ الإدراك وتجديد الرؤية
يعمل الإغراب على تعميق التجربة الحسية للقارئ للنصوص الأدبية بشكل مكثف. فمن خلال إزالة غشاء العادة، يجعل حتى التفاصيل الأكثر شيوعًا حيوية وذات مغزى ويتم إدراكها بشكل جديد. هذا الإدراك المتجدد يحول فعل القراءة إلى انخراط أكثر غمرًا وحيوية. إحدى الطرق القوية لتحقيق هذه التجربة الحسية المعززة هي من خلال الأوصاف الحسية المتقاطعة. يمكن للكتاب وصف الأشياء أو الأحاسيس العادية باستخدام مصطلحات مرتبطة عادةً بفئات حسية أخرى، مثل “نظرة الجدار المالحة” أو “اللون الصاخب للقميص”. هذا الاندماج غير المتوقع للحواس يولد صورًا جديدة وأوصافًا أكثر ثراءً وتعقيدًا تهز إدراك القارئ.
بطبيعته، يجبر الإغراب القراء على تجاوز وجهات نظرهم المتأصلة ورؤية العالم من منظور متغير، غالبًا ما يكون مفاجئًا، مما يكسر المفاهيم المسبقة والأحكام التلقائية. تظهر أمثلة تحول المنظور في رواية ليو تولستوي “خولستومير” (قصة حصان)، حيث يُروى العالم، وخاصة المجتمع البشري واتفاقياته، من منظور فريد لحصان. هذا التحول الجذري في وجهة النظر يجعل الأفعال البشرية المألوفة والممتلكات والقيم الأخلاقية تبدو غريبة تمامًا وغير منطقية وغالبًا سخيفة، مما يجبر القارئ على إعادة تقييم افتراضاته الخاصة حول الوضع الطبيعي والقيمة. وبالمثل، يقدم كتاب جوناثان سويفت “رحلات جاليفر” مثالًا قويًا عندما يزور جاليفر أرض عمالقة بروبدينجناج، ويلاحظ صدر مرضعة عملاق وثديها العاري الضخم ببثور ونمش مكبرة على بشرتها، مما يثير الاشمئزاز لديه. هذا التحول الجذري في المقياس، حيث تُرى الملامح البشرية المألوفة تحت “عدسة مكبرة”، يحول الجمال إلى قبح، مما يجبر على إعادة تقييم حشوية للإدراك والطبيعة النسبية للجمال.
إن الإغراب يعطل بشكل أساسي “أتمتة” الإدراك، مما يجبر القراء على معالجة المعلومات بنشاط بدلاً من تلقيها بشكل سلبي. هذا الاحتكاك المعرفي يجبر على الانخراط الواعي مع النص، مما يحول القراءة إلى تمرين فكري نشط. عندما يتم تحقيق الإغراب من خلال تحولات جذرية في وجهة النظر السردية أو الإدراكية، فإنه يتجاوز مجرد جعل اللغة غريبة. إنه يغير بشكل أساسي علاقة القارئ بالواقع، وبالتالي علاقته بنفسه. فمن خلال إجبار القراء على تجربة العالم من خلال عيون حصان، أو عملاق، أو حشرة متحولة، تدفع هذه التقنية القراء إلى تفكيك افتراضاتهم المتأصلة حول الوضع الطبيعي، والجمال، وحتى الهوية. هذه العملية ليست مجرد تمرين فكري، بل يمكن أن تعزز شكلًا أعمق من التعاطف والتأمل النقدي.
تعميق الانخراط النقدي والإبداعي
يجبر الإغراب القراء على الانخراط نقديًا مع النص. فمن خلال تقديم العناصر بطريقة غير مألوفة، فإنه يتطلب من القراء العمل بنشاط لفك شفرة أهمية هذه المكونات الغريبة، مما يعزز انخراطًا أعمق وأكثر تحليلًا للمادة. هذا ينقل القارئ من الاستهلاك السلبي إلى التفسير النشط.
بالنسبة للكتاب، يعمل الإغراب كأداة لا تقدر بثمن تدفعهم بنشاط إلى ما وراء الحدود التقليدية. إنه يشجع على استكشاف إمكانيات سردية جديدة ويحفز التجريب باللغة والشكل والبنية، مما يؤدي إلى فن أدبي مبتكر ومعبر بعمق. إنه يصقل الكتابة الحسية، ويعزز الحرية الإبداعية، وينشط المسارات السردية المألوفة. كما أن العرض المتعمد والغريب للمعلومات يدفع القراء إلى تفسير العمل على مستويات متعددة، غالبًا ما تكون متداخلة – حرفية، مجازية، رمزية، وموضوعية – مما يعزز بشكل كبير ثراء النص وتعقيده وصدىه الدائم. وهذا يتناقض بشكل صارخ مع اللغة التعليمية أو المعلوماتية، التي تهدف عادة إلى معنى واضح، فريد، وغير غامض.
على عكس التواصل التقليدي الذي يهدف غالبًا إلى الفهم المباشر والفوري، يُدخل الإغراب عمدًا درجة من الاحتكاك المعرفي. هذا الاحتكاك يجبر القارئ على أن يصبح مشاركًا نشطًا، بدلاً من سلبيًا، في بناء المعنى. هذا التحول من الاستقبال السلبي إلى التفسير النشط هو محور قيمته الجمالية والفكرية العميقة، مما يعزز تفاعلًا ديناميكيًا بين النص والقارئ.
التحديات والحدود
يُعد أحد التحديات الكبيرة في استخدام الإغراب هو احتمال الغموض المفرط. فإذا أصبح النص مهتمًا بشكل مبالغ فيه بالغرابة أو الابتكار، فقد يهمل عن غير قصد توصيل رسائل واضحة أو مؤثرة، مما يقلل من صداه العاطفي أو الموضوعي. وهذا يتوافق مباشرة مع النص الأصلي الذي قدمه المستخدم، والذي يشير إلى أن الأدب الحديث يمكن أن “يسرف في الاستغلاق، وتستعلي على القارئ”.
واجه الشكلانيون الروس أنفسهم انتقادات بسبب نهجهم، الذي جادل البعض بأنه أدى إلى “الإفراط في تسلّط النص، والتنظيرات المجردة وتغييب دور الكاتب والقارئ”. هذا التركيز المفرط على الآليات الداخلية للنص يمكن أن يؤدي، في الحالات القصوى، إلى “الغموض واللاجدوى”، مما يجعل الفن غير متاح أو غير ذي صلة.
يجب التأكيد على أن الإتقان الحقيقي للإغراب يكمن في تحقيق توازن دقيق وحكيم بين الحداثة والاتساق السردي. يجب أن تخدم هذه التقنية دائمًا التأثير العاطفي للقصة وعمقها الموضوعي، بدلاً من أن تكون مجرد زخرفة أسلوبية تهدف إلى إرضاء الذات وتؤدي إلى نفور الجمهور. بينما يهدف الإغراب إلى تعميق الانخراط والإدراك، فإن تطبيقه المفرط أو غير الماهر يمكن أن يؤدي بشكل متناقض إلى نفور القارئ وتعتيم المعنى، مما يؤدي في النهاية إلى انهيار التواصل الفعال. وهذا يسلط الضوء على توتر حاسم ومتأصل في الابتكار الفني: إلى أي مدى يمكن للفنان أن يدفع حدود التقاليد والوضوح قبل أن يفقد جمهوره أو يضر بالرسالة التي يسعى لإيصالها؟
أمثلة من الأدب العالمي: رحلة عبر الإغراب
يُقدم هذا القسم أمثلة مقنعة وملموسة للإغراب عبر مجموعة متنوعة من الأنواع الأدبية، مما يوضح بدقة تطبيقاته وآلياته المتنوعة وتأثيراته العميقة.
| الآلية/التقنية | التجليات/أمثلة | الأثر/التأثير |
| تغيير المنظور السردي أو الإدراكي | تولستوي (الفرس في “خولستومير”)، سويفت (جاليفر وجلد العمالقة)، كافكا (تحول جريجور إلى حشرة) | إيقاظ الإدراك، تعميق الانخراط، تحدي التوقعات، إثارة التساؤلات الوجودية/الاجتماعية |
| التراكيب اللغوية غير المألوفة | الشعر الحديث (بشكل عام)، البلاغة القرآنية (تأخير الاسم الظاهر) | تعزيز التجربة الحسية، إطالة الإدراك، إثارة المشاعر |
| السرد غير الخطي أو المتقطع | لورنس ستيرن (“تريسترام شاندي”)، مسرح العبث (هارولد بينتر) | تحدي التوقعات، تعميق الانخراط النقدي، توسيع التفسير |
| المزج بين الواقعية والخيال (الواقعية السحرية) | ماركيز (“مائة عام من العزلة”)، موركامي (“كافكا على الشاطئ”) | إثارة التساؤلات الوجودية، تعزيز التجربة الحسية، توسيع التفسير |
| استخدام المجازات والصور المدهشة/الصادمة | إليوت (المساء كمريض مخدر، الضباب كقطة)، البلاغة العربية (وصف شجرة الزقوم) | إيقاظ الإدراك، تعزيز التجربة الحسية، إثارة المشاعر |
| تغيير المقياس أو الحجم | سويفت (“جاليفر” وجلد العمالقة) | تحدي التوقعات، إثارة التساؤلات الجمالية/الفلسفية |
| إعادة تعريف المألوف | أورويل (“مزرعة الحيوان” – السياسة)، العقاد/القصيبي (الغربة الروحية) | إثارة التساؤلات الاجتماعية/الوجودية، تعميق الانخراط النقدي |
التصدير إلى “جداول بيانات Google”
في الرواية والنثر
يُعد كتاب ليو تولستوي “خولستومير” مثالًا جوهريًا على الإغراب، حيث يوصف العالم، وخاصة المجتمع البشري واتفاقياته، من منظور فريد لحصان. هذا التحول الجذري في وجهة النظر يجعل الأفعال البشرية المألوفة والممتلكات والمفاهيم الأخلاقية تبدو غريبة تمامًا وغير منطقية وغالبًا سخيفة، مما يجبر القارئ على إعادة تقييم افتراضاته الخاصة حول الوضع الطبيعي والقيمة.
كما يُقدم كتاب جوناثان سويفت “رحلات جاليفر” مثالًا قويًا على الإغراب من خلال تغيير المقياس. فعندما يزور جاليفر أرض عمالقة بروبدينجناج، يواجه مرضعة يظهر “ثديها العاري الضخم” وبشرتها المكبرة، مع “بقعها وبثورها ونمشها”، مثيرة للاشمئزاز بالنسبة له. هذا التحول في المنظور، حيث تُرى الملامح البشرية المألوفة تحت “عدسة مكبرة”، يحول الجمال إلى قبح، مما يجبر على إعادة تقييم حشوية للإدراك والطبيعة الذاتية للحكم الجمالي.
يُظهر غابرييل غارثيا ماركيز في روايته “مائة عام من العزلة” إتقانًا في استخدام “الواقعية المفرطة” وتقاليد الواقعية السحرية لزعزعة الاستقرار المنهجي للإدراكات التقليدية للواقع والزمن والتجربة الإنسانية. من الأمثلة البارزة على ذلك وباء الأرق الذي يجتاح بلدة ماكوندو. تُرسل الحكومة دواءً، لكنها تقرر صبغه ليغير لونه يوميًا، على الرغم من أن البلدة بأكملها مصابة بعمى الألوان. هذه التفصيلة السخيفة تُغرب عن مرض شائع وحل يبدو منطقيًا، مما يسلط الضوء على واقع مفكك وسريالي وعدم قدرة الشخصيات على الانخراط الكامل في عالمهم. إن “سحر” عالم عائلة بوينديا يجبر القارئ على تعليق الشك، وقبول واقع مغرب كحقيقة داخل السرد.
في رواية فرانز كافكا “المسخ”، يُعد الافتتاح الصادم، حيث يستيقظ البطل غريغور سامسا ذات صباح متحولًا إلى حشرة عملاقة ، مثالًا رئيسيًا على الإغراب. هذا الحدث العبثي وغير المتوقع يُغرب فورًا عن فعل الاستيقاظ اليومي، إلى جانب المفاهيم الأساسية للهوية البشرية، والعلاقات الأسرية، والتوقعات المجتمعية، مما يغرق القارئ في عالم من الغرابة الوجودية العميقة.
كما أن هبوط أليس في كتاب لويس كارول “مغامرات أليس في بلاد العجائب” إلى عالم غريب وغير منطقي يسكنه حيوانات ناطقة وشخصيات غريبة ، يعمل على إغراب مفهوم الواقع نفسه، مما يتحدى اعتماد القارئ على المنطق، والحس السليم، والقواعد المعمول بها. يُقلب العالم المألوف رأسًا على عقب، كاشفًا عن غرابته الكامنة.
وفي رواية جورج أورويل الرمزية “مزرعة الحيوان”، تُغرب ديناميكيات السلطة السياسية والقيادة من خلال تصويرها عبر ثورة حيوانات المزرعة ضد مالكها البشري وتأسيسها لحكومتها الخاصة. تكشف شخصيات الحيوانات وصراعاتها السياسية عن العبثيات والنفاق والمخاطر الكامنة في الشمولية بضوء صارخ ومزعج.
يستخدم هاروكي موراكامي في روايته “كافكا على الشاطئ” الإغراب بشكل متكرر من خلال نسج أحداث سريالية – مثل القطط المتحدثة والاختفاءات غير المبررة – في روايات واقعية خلاف ذلك. هذا التداخل بين الواقع والأحلام، والعادي والخيالي، يُغرب عن الإدراكات التقليدية للعالم، مما يدفع القراء إلى التساؤل عن حدود الوعي والوجود. في كل من هذه الأمثلة المتنوعة، لا تكون “الغرابة” أو “عدم الألفة” مجانية أو لمجرد إثارة الصدمة. بل هي مصممة بدقة لخدمة غرض أعمق، غالبًا ما يكون نقديًا. يعمل الواقع المغرّب كمرآة مشوهة، تعكس جوانب من العالم “العادي” التي غالبًا ما يتم تجاهلها أو قمعها أو اعتبارها أمرًا مسلمًا به. وهذا يسمح للمؤلفين بتجاوز دفاعات القراء الفكرية أو رفضهم المعتاد للحقائق غير المريحة من خلال تقديمها بضوء مدهش وجديد ومزعج غالبًا.
في الشعر والدراما
يُظهر تي. إس. إليوت في “أغنية حب جيه. ألفريد بروفروك” إتقانًا في استخدام الإغراب من خلال استعارات لافتة وغير تقليدية تعطل الصور والتوقعات المألوفة. على سبيل المثال، مقارنة المساء بـ”مريض مخدر على طاولة” تحطم الجمالية التقليدية والرومانسية المرتبطة بالغروب، وتضفي عليه إحساسًا بالمرض والسكون. وبالمثل، فإن تصوير الضباب كـ”قطة صفراء كسولة” يحول ظاهرة طبيعية موضوعية إلى صورة حية ومجسمة، مما يجعل المشهد الحضري يبدو غريبًا حيًا ومزعجًا. تخلق هذه الصور إحساسًا بالانتعاش وتترك انطباعًا أعمق.
تستخدم سيلفيا بلاث في شعرها الاعترافي الإغراب للكشف بقوة عن العناصر القمعية والمزعجة غالبًا والمخبأة داخل المواقف والعلاقات الأسرية التي تبدو مألوفة. تقلب قصائدها الدلالات التقليدية للحياة المنزلية، مما يجبر القراء على مواجهة التعقيدات النفسية والقيود التي تفرضها الأعراف الاجتماعية. تهدف إلى إيصال “الحقيقة الداخلية” للتجربة بطريقة “فنية ومصطنعة”، مما يجعل المألوف يبدو جديدًا ويكشف عن جوانبه المظلمة.
في “حفلة عيد الميلاد”، وهي عمل أساسي في مسرح العبث، يستخدم هارولد بينتر الإغراب من خلال تقديم مواقف مألوفة (حفلة عيد ميلاد في منزل داخلي) وشخصيات (بطل الرواية، ضيوف غامضون) بطرق غريبة وغامضة ومجزأة بعمق. تفتقر المسرحية عمدًا إلى حبكة واضحة وخطية، وتؤكد على العبثية الكامنة في الوجود، وتتحدى تصورات الجمهور للواقع والهوية وتعقيدات العلاقات الإنسانية من خلال حوار مزعج وأحداث غير مبررة.
أما الشعراء الرومانسيون العرب (مثل عباس محمود العقاد وغازي القصيبي)، فبينما تشير “الغربة” في شعرهم غالبًا إلى شعور عميق بالانفصال الوجودي، أو التشتت، أو الوحدة الروحية ، يمكن تفسيرها أيضًا على أنها شكل من أشكال الإغراب النفسي. فمن خلال التركيز المكثف على التجربة الداخلية والذاتية للشعور “بالغرابة” أو “الضياع” داخل عالم المرء ومجتمعه، يُغرب هؤلاء الشعراء عن مفاهيم الانتماء والوضع الطبيعي والرضا. يعبر العقاد عن ذلك بوضوح في موطنه المتكرر “حيران حيران”، بينما يعبر القصيبي عن هذا الشعور العميق بالانفصال عن واقع فاسد أو غير مُرضٍ في قصيدته “العودة إلى الواحة”. هذا يحول تركيز الإغراب من الغرابة الخارجية إلى حالة نفسية داخلية تجعل العالم المألوف يبدو غريبًا.
يعتمد الشعر، بطبيعته، بشكل كبير على الإغراب. ويتحقق ذلك من خلال تقنيات مختلفة مثل تغيير التركيب النحوي التقليدي، واستخدام استعارات معقدة ومدهشة غالبًا، واختيار كلمات غير عادية أو قديمة، وكل ذلك يجبر القارئ على التفكير في الكلمات والعبارات بضوء جديد وغير تلقائي. يكمن الخيط المشترك في هذه الأمثلة من الشعر والدراما في التركيز العميق على
التجربة الداخلية – العواطف، والحالات النفسية، والقلق الوجودي، وغالبًا اللاوعي. فالتقنيات المغرّبة (الصور غير العادية، الحوار المتقطع، الاغتراب الذاتي، الحبكات غير الخطية) ليست مجرد ألغاز فكرية؛ بل هي مصممة بدقة لتتردد صداها على مستوى عاطفي ونفسي عميق. تسمح “الغرابة” بالتعبير عن حقائق معقدة، غالبًا ما تكون غير مريحة، أو غير قابلة للتعبير عنها بشكل مباشر، أو حتى مكبوتة إذا قُدمت بشكل صريح. إنها تخلق مساحة للقارئ/الجمهور لـيشعر بالارتباك، أو القلق، أو الشعور العميق بالاغتراب الذي تعاني منه الشخصيات أو المتحدث.
الخلاصة
يُعد الإغراب، أو “نزع الألفة”، مفهومًا أدبيًا قويًا، دائمًا، وعابرًا للثقافات. إنه يربط بسلاسة الممارسات الجمالية القديمة – المعترف بها ضمنيًا في البلاغة العربية الكلاسيكية والأسلوب القرآني – بالنظرية النقدية الحديثة، كما صاغتها الشكلانية الروسية بشكل منهجي. تكمن وظيفته الأساسية والحيوية في مكافحة الإدراك التلقائي بنشاط، مما ينشط تفاعلنا الحسي والفكري مع النص الفني والعالم الذي يعكسه.
يُسلط الضوء على الأهمية المستمرة، وربما المتزايدة، لفن الإغراب في عالمنا المعاصر الذي يزداد تعقيدًا وسرعة، وغالبًا ما يكون “مؤتمتًا”. ففي عصر يمكن أن يؤدي فيه الحمل الزائد للمعلومات إلى تبلد الإدراك، يظل الإغراب أداة لا غنى عنها. إنه يتحدانا باستمرار للنظر إلى ما وراء السطحي، والتساؤل عن الافتراضات المتأصلة، والشعور بعمق، وإدراك الواقع بكل غرابته وجماله وتعقيده الكامن. وبذلك، فإنه لا يثري تجربتنا الأدبية فحسب، بل يعمق فهمنا وتقديرنا للحياة نفسها بشكل كبير.