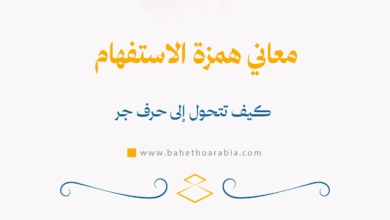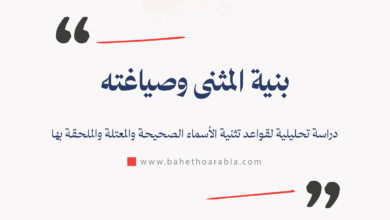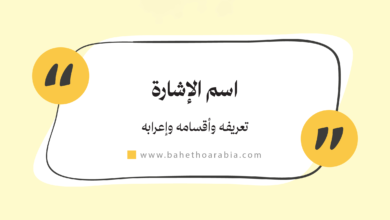ما هي الأسماء التي تجزم فعلين؟ اكتشف أنواعها وقواعدها وأمثلتها بالتفصيل

تتسم اللغة العربية ببنية منطقية مُحكمة، حيث تُبنى الجمل والعلاقات بينها وفق أدوات دقيقة تمنح الكلام دلالته وقوته. ويُعد أسلوب الشرط أحد أبرز التجليات لهذه البنية، فهو يربط بين حدثين ربطاً سببياً، بحيث يكون وقوع الثاني مشروطاً بوقوع الأول. وفي قلب هذا الأسلوب تتربع مجموعة فريدة من الأدوات تُعرف باسم (الأسماء التي تجزم فعلين). هذه الأسماء لا تكتفي بوظيفة الربط الشرطي فحسب، بل تحمل في طياتها معاني مستقلة كالزمان والمكان والعاقل وغير العاقل، مما يمنحها ثقلاً دلالياً وعمقاً نحوياً. في هذا المقال، نقدم تحليلاً أكاديمياً شاملاً لهذه الفئة من الأسماء، مستعرضين أنواعها، ودلالاتها المتعددة، وأوجه إعرابها، مع تسليط الضوء على الآراء النحوية المختلفة التي أحاطت بدراسة الأسماء التي تجزم فعلين، لنكشف عن دورها المحوري في صياغة التراكيب الشرطية في اللغة العربية.
الأسماء التي تجزم فعلين
تشتمل اللغة العربية على فئة من الأسماء التي تتضمن معنى الشرط، وتحديداً معنى حرف الشرط الجازم (إنْ). وبناءً على ذلك، فإن هذه الأسماء التي تجزم فعلين تؤدي الوظيفة النحوية ذاتها، فتقوم بجزم فعلين مضارعين، الأول يُعرف بفعل الشرط والثاني بجواب الشرط، تماماً كما تفعل (إنْ). وتُعد دراسة الأسماء التي تجزم فعلين من المباحث الهامة في النحو. وتشمل قائمة الأسماء التي تجزم فعلين كلاً من: مَنْ، وَمَا، وَمَهْمَا، وَمَتَى، وَأَيَّانَ، وَأَنَّى، وَأَيْنَ، وَحَيْثُمَا، وَكَيْفَ، وَأَيّ.
وعلى الرغم من أن هذه الأسماء التي تجزم فعلين تتفق في وظيفتها الجازمة، إلا أنها تتباين في دلالاتها المعنوية. ولهذا السبب، يستلزم التحليل الدقيق لهذه الأسماء التي تجزم فعلين تصنيفها إلى فئات أو طوائف بناءً على معانيها.
١- الأسماء المبهمة ضمن قائمة الأسماء التي تجزم فعلين: (مَنْ، وَمَا، وَمَهْمَا)
تُستخدم (مَنْ)، وهي من أبرز الأسماء التي تجزم فعلين، للدلالة على الإنسان في معظم السياقات. ويستشهد على ذلك بقوله تعالى: {مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا}. كما ورد استخدام (مَنْ) كأحد الأسماء التي تجزم فعلين في قول الشاعر زهير بن أبي سلمى:
رأيتُ المنايا خبطَ عشواءَ مَنْ تُصِبْ *** تُمِتْهُ ومَنْ تُخْطِئْ يُعَمَّرْ فَيَهْرَمِ
أما (مَا) فهي من الأسماء التي تجزم فعلين التي تدل غالباً على ما لا يعقل. ومثالها من القرآن الكريم قوله تعالى: {وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ}. في هذه الآية، تُعَدُّ (مَا) إحدى الأسماء التي تجزم فعلين، حيث قامت بجزم فعل الشرط وجواب الشرط، وهي هنا تدل على كيان مبهم غير عاقل. ويؤكد هذا الاستخدام لهذه الفئة من الأسماء التي تجزم فعلين قوله تعالى أيضاً: {مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا}.
وتُعد (مَهْمَا) مماثلة لـ(مَا) في دلالتها على ما لا يعقل، ولكنها تتسم بدرجة أعلى من الإبهام، وهي من الأسماء التي تجزم فعلين ذات الدلالة الواسعة. ويظهر استخدامها في قوله تعالى: {وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ}. إن (مهما) في هذه الآية مثال واضح على الأسماء التي تجزم فعلين. وفي الشعر، يقول زهير مستعملاً هذا الاسم من الأسماء التي تجزم فعلين:
ومهما تَكُنْ عند امرئٍ مِنْ خليقةٍ *** وإنْ خالَها تَخْفَى على الناسِ تُعْلَمِ
وقال امرؤ القيس:
أَغَرَّكِ مِنِّي أَنَّ حُبَّكِ قَاتِلِي *** وَأَنَّكِ مَهْمَا تَأْمُرِي القَلْبَ يَفْعَلِ
يختلف الإعراب النحوي لهذه الطائفة من الأسماء التي تجزم فعلين (مَنْ، وَمَا، وَمَهْمَا) بناءً على بنية الجملة التي ترد فيها. فتعرب هذه الأسماء التي تجزم فعلين في محل رفع مبتدأ إذا كان فعل الشرط فعلاً لازماً، أو إذا كان فعلاً متعدياً استوفى مفعوله. وفي المقابل، تُعرب هذه الأسماء التي تجزم فعلين في محل نصب مفعول به إذا كان فعل الشرط متعدياً لم يستوفِ مفعوله. وعليه، فإن (مَنْ) في بيت زهير المذكور آنفاً تُعرب مفعولاً به، بينما تُعرب (مَهْمَا) في بيت امرئ القيس مبتدأ، وهذا يوضح مرونة إعراب الأسماء التي تجزم فعلين.
إضافة إلى ذلك، يمكن إعراب (مَا) و(مَهْمَا) ضمن الأسماء التي تجزم فعلين في محل نصب مفعول مطلق إذا كانتا دالتين على الحدث، كما في المثال: مَا تَنَمْ تَسْتَرِحْ، حيث تُعتبر (مَا) هنا إحدى الأسماء التي تجزم فعلين الدالة على الحدث.
وقد تباينت آراء النحويين حول تحديد خبر المبتدأ عندما تُعرب هذه الأسماء التي تجزم فعلين مبتدأ. فالرأي الأول يذهب إلى أنها لا تحتاج إلى خبر، استناداً إلى أن ما بعدها يغني عن الخبر. أما الرأي الثاني، فيعتبر أن فعل الشرط هو الخبر، لأن جواب الشرط قد يكون له محل من الإعراب في محل جزم. ويرى فريق ثالث أن جواب الشرط هو الخبر، مرتكزين على أن الأصل في هذه الأسماء التي تجزم فعلين هو كونها أسماءً موصولة، وما بعدها يؤدي وظيفة صلتها في المعنى. بينما يقرر فريق رابع أن الخبر هو الجملة الشرطية بأكملها، المكونة من فعل الشرط وجوابه. ولكل رأي من هذه الآراء أدلته وبراهينه التي تدعمه، ولكننا نميل إلى ترجيح الرأي القائل بأن الجملة الشرطية الكاملة هي التي تؤدي وظيفة الخبر لهذه الأسماء التي تجزم فعلين حين تُعرب مبتدأ.
٢- أسماء الزمان ضمن قائمة الأسماء التي تجزم فعلين: مَتَّى وَأَيَّانَ
(مَتَى) هي من الأسماء التي تجزم فعلين وتُستخدم كظرف للزمان. يستشهد على ذلك بقول طرفة بن العبد:
ولستُ بحلَّالِ التِّلاعِ مخافةً *** ولكنْ متى يَسْتَرْفِدِ القومُ أَرْفِدِ
وقد تُلحق بها (مَا) الزائدة، كما في قول رجل من بني قريع، وهذا لا يغير من كونها إحدى الأسماء التي تجزم فعلين:
متَى مَا يَرَ الناسُ الفقيرَ وجارُه *** غنيٌّ يقولوا عاجزٌ وجَليدُ
أما (أَيَّانَ) فهي أيضاً من الأسماء التي تجزم فعلين، ولكن استخدامها في سياق المجازاة الشرطية يُعد قليلاً. ومثالها قول الشاعر مفتخراً:
أيَّانَ نُؤْمِنْكَ تَأْمَنْ غَيْرَنا وإذا *** لم تُدْرِكِ الأَمْنَ مِنَّا لم تَزَلْ حَذِرَا
٣- أسماء المكان ضمن قائمة الأسماء التي تجزم فعلين: أَيْنَ وَحَيْثُمَا وَأَنَّى
(أَيْنَ) هي من الأسماء التي تجزم فعلين وتدل على المكان، كما في قول ابن همّام السلولي:
أينَ تضربْ بِنا العيسَ تجِدنا *** نصرفُ نحوها للتلاقي
وكثيراً ما تُلحق بها (مَا) الزائدة، كما في قوله تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ}، حيث تعمل (أينما) عمل الأسماء التي تجزم فعلين.
أما (حَيْثُمَا) فلا تُستخدم للجزم في أسلوب الشرط إلا إذا اتصلت بها (مَا)، وهي من الأسماء التي تجزم فعلين الدالة على المكان. ومثال ذلك قولك: حَيْثُمَا تَتَوَجَّهْ يُقَدِّرْ لَكَ اللَّهُ خَيْرًا.
وتُعد (أَنَّى) من الأسماء التي تجزم فعلين، وتأتي بمعنى (أين)، كما في قول لبيد:
فأصبحت أنَّى تأْتِها تلتبس بها *** كلا مَركبيها تحتَ رِجلك شَاجِرُ
وقال شاعر آخر:
خليليَّ أنّى تقصداني تقصدا *** أخاً غيرَ ما يُرضيكما لا يُحاوِلُ
ومرة أخرى، برز خلاف بين النحويين حول مسألة تعليق أسماء الزمان والمكان التي تنتمي إلى فئة الأسماء التي تجزم فعلين. فمنهم من يرى أنها تتعلق بفعل الشرط، قياساً على حمل هذه الأسماء على نظائرها من أسماء الاستفهام. وفي المقابل، يرى فريق آخر أنها تتعلق بجواب الشرط، وذلك لكونها مضافة إلى فعل الشرط. إن كلا الرأيين يمتلك من الأدلة ما يسنده، ولكن قد يكون الرأي القائل بتعليق هذه الأسماء التي تجزم فعلين بالجواب، مع جعل جملة فعل الشرط في محل جر بالإضافة، هو الأوجه والأحسن.
٤- (كَيْفَ) كإحدى الأسماء التي تجزم فعلين
أما (كَيْفَ)، فدلالتها المعنوية هي الحال، وإعرابها يكون في محل نصب حال من فاعل فعل الشرط. ولكي تكون (كيف) من الأسماء التي تجزم فعلين، يُشترط أن يتوافق جواب الشرط مع فعل الشرط في المادة الاشتقاقية والمعنى. وقد تُلحق بها (مَا) فتصبح (كَيْفَمَا)، نحو: كَيْفَمَا تَمْشِ أَمْشِ. ويُعد الجزم باستخدام (كيف) قليلاً في الاستعمال اللغوي، حتى إن بعض النحويين ذهبوا إلى القول بأنها لا تجزم أصلاً، مما يضعها في موضع خاص ضمن الأسماء التي تجزم فعلين.
٥- (أَيّ) وهي من الأسماء التي تجزم فعلين المعربة
(أَيّ) هي اسم شرط مبهم، وهي الاسم الوحيد المعرب ضمن قائمة الأسماء التي تجزم فعلين. ويتحدد معناها وإعرابها من خلال الاسم الذي تُضاف إليه. وفي بعض الحالات، قد تُقطع عن الإضافة، ويدل السياق حينئذ على المضاف إليه المحذوف. ويمكن أن تلحقها (مَا) الزائدة. والأمثلة التالية توضح ذلك: أَيُّ كِتَابٍ تَقْرَأْ تَسْتَفِدْ، وَأَيُّ عَالِمٍ تُصَاحِبْهُ يُفِدْكَ، وَأَيَّ حِينٍ تَأْتِنِي تَجِدْنِي، وَأَيَّ جِهَةٍ تَسِرْ أَسِرْ.
إن إعراب (أَيّ) في الجمل السابقة يتحدد بحسب المعنى؛ فهي مفعول به في الجملة الأولى (أي كتاب تقرأ تستفد)، وهي مبتدأ في الجملة الثانية، ومفعول مطلق في الجملة الثالثة، وظرف زمان في الجملة الرابعة، وظرف مكان في الجملة الخامسة. كما أنها قد تُجر بحرف الجر، نحو: فِي أَيِّ طَرِيقٍ تَسِرْ نَسِرْ. وفي هذه الحالة، يكون الجار والمجرور متعلقين بجواب الشرط (نَسِرْ).
ومما يؤكد أن (أَيّ) اسم معرب وليست مبنية كسائر الأسماء التي تجزم فعلين، ورودها منصوبة في قوله تعالى: {أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى}. ففي هذه الآية، قُطعت (أَيّ) عن الإضافة فظهر عليها التنوين، وأُلحقت بها (مَا) الزائدة. وكذلك في قوله تعالى: {أَيَّمَا الْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ}، حيث فصلت (مَا) الزائدة بين (أَيّ) والمضاف إليه (الأَجَلَيْنِ).
خاتمة
وفي ختام هذا التحليل المفصل، يتضح جلياً أن الأسماء التي تجزم فعلين تشكل ركناً أساسياً في بنية أسلوب الشرط في اللغة العربية. فقد استعرضنا كيف أن هذه الأسماء، بدءاً من المبهمة كـ(مَنْ) و(مَا) و(مَهْمَا)، مروراً بأسماء الزمان والمكان، وانتهاءً بالاسم المعرب الفريد (أَيّ)، تؤدي وظيفة مزدوجة بالغة الدقة؛ فهي من جهة تحدد معنى الشرط (للعاقل، أو للزمان، أو للحال)، ومن جهة أخرى تفرض سيطرتها النحوية بجزم فعلين مضارعين. إن الخلافات التي وردت بين النحويين حول إعرابها وتعلُّقها لا تقلل من شأنها، بل تبرهن على ثراء الدرس النحوي وعمقه في استكشاف دقائق اللغة. وبذلك، فإن الإلمام بخصائص الأسماء التي تجزم فعلين واستيعاب وظائفها المتنوعة ليس مجرد تمرين في قواعد الإعراب، بل هو مفتاح لفهم أعمق لآليات الربط المنطقي والدقة التعبيرية التي تميز لغة القرآن الكريم والشعر العربي الأصيل.