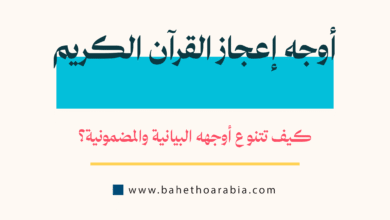أسباب النزول: أهميتها في تفسير القرآن الكريم وكشف إعجازه
دليل شامل لفهم علم أسباب النزول وتطبيقاته في التفسير
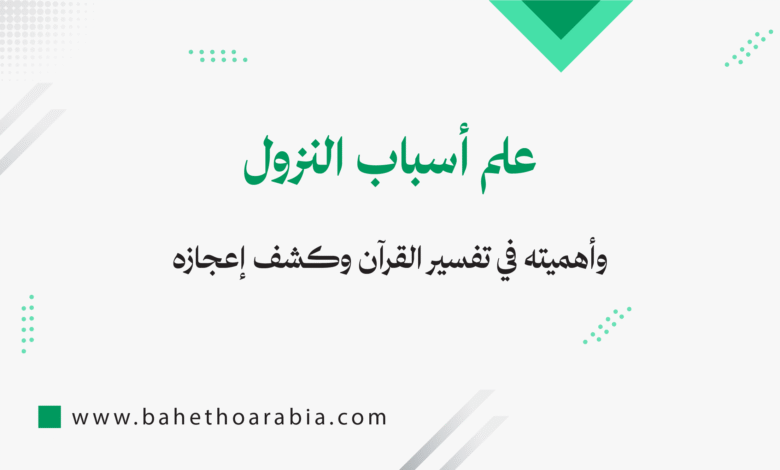
يُعد علم أسباب النزول من أجل العلوم التي تخدم كتاب الله تعالى، إذ يُمثل مفتاحاً لفهم معاني الآيات وإدراك حِكَم التشريع. وقد اعتنى العلماء بهذا العلم عناية فائقة لما له من أثر بالغ في الكشف عن أسرار القرآن الكريم وإعجازه البياني والتشريعي.
مقدمة
إن الناظر في علوم القرآن الكريم يجد أن أسباب النزول تحتل مكانة متميزة بين هذه العلوم، فهي الجسر الذي يربط بين النص القرآني والواقع الذي نزل فيه، والمنارة التي تضيء للمفسر طريق فهم المراد الإلهي. وقد أدرك علماء الأمة منذ القرون الأولى أن معرفة الظروف والأحداث التي نزلت فيها الآيات تُعين على استجلاء المعاني واستنباط الأحكام، وتكشف عن جوانب من الإعجاز القرآني قد تخفى على من لم يطلع على هذا العلم الجليل. ولذلك صدّر الإمام الزركشي بهذا البحث كتابه العظيم “البرهان في علوم القرآن”، مُشيراً إلى المنزلة الرفيعة التي يحتلها في دراسة القرآن الكريم.
أهمية علم أسباب النزول ومنزلته
هذا العلم هام وأساسي في دراسة القرآن الكريم، وأثير لدى الباحثين في علوم القرآن عادة، وفي التفسير خاصة. لما هنالك من الصلة الوثيقة بين السبب والمسبب، حتى قد صدر الإمام الزركشي بهذا البحث كتابه “البرهان في علوم القرآن”. ويقارب هذه المنزلة العالم أسباب النزول ما يعتنى به الأدباء، ويصدرون به شرحهم الأدبي للقصيدة أو نص أدبي من بيان “مناسبة القصيدة” أو “النص” كما جرى عليه اصطلاحهم.
غير أن علماء التفسير وعلوم القرآن كانوا أعظم دقة وأكثر توفيقاً في استعمال كلمة “سبب” موضع كلمة “مناسبة”. ونختار في تعريف سبب النزول هذه العبارة: سبب النزول هو: ما نزلت الآية أو الآيات تتحدث عنه أيام وقوعه. وهذا الشرط “أيام وقوعه” شرط هام جوهري في معرفة سبب النزول، وصيانة الدارس أن يخلط بين سبب النزول وبين موضوعات الآيات التي نزلت تتحدث عن أخبار الوقائع الماضية، مثل أخبار الأنبياء السابقين كإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، وما وقع لهم مع أقوامهم، وغير ذلك من أنباء الأمم السابقة، فكل تلك الوقائع ليست من أسباب النزول، لأنها لم تقع أيام نزول القرآن.
تطبيق عملي على تعريف سبب النزول
وتطبيقاً لذلك ناقشنا الروايات في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾. أخرج ابن جرير عن ابن زيد قال: “هؤلاء المشركون حين حالوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية وبين أن يدخل مكة…”. في رواية أخرى عن ابن عباس ومجاهد أنهم النصارى، قال مجاهد: كانوا يطرحون في بيت المقدس الأذى، ويمنعون الناس أن يصلوا فيه.
فقررنا على الرواية الأولى: بأن الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هم المشركون، أنه يصلح أن يكون صدهم النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عن دخول مكة للعمرة سبباً لنزول الآية، لأن ذلك كان في أيام نزول الآية الكريمة. أما الرواية الثانية أنهم النصارى، فلا يصلح أن يكون منعهم الناس عن الصلاة في بيت المقدس سبباً لنزول الآية الكريمة لأن ذلك إخبار عن واقع في الماضي البعيد لم تنزل الآية أيام وقوعه.
القرآن بين ما نزل بسبب وما نزل ابتداءً
غير أن ثمة أمراً هاماً يجب التنبيه عليه في هذا البحث، وهو أنه ليس كل القرآن قد نزل على أسباب، بل إن القرآن قسمان: قسم نزل ابتداءً غير مبني على سبب بالمعنى الاصطلاحي. ومن ذلك أكثر قصص الأنبياء مع أممهم، وكذا الوقائع الماضية، أو أنباء الغيب القادمة، وأهوال القيامة، والجنة والنار، فقد نزل أكثر ذلك كله ابتداءً من غير سبب.
والقسم الآخر من القرآن: هو الذي نزل على أسباب، ومنه معظم آيات الأحكام، والرد على المخالفين وما نزل بشأن وقائع مع المسلمين، أو المغازي ونحو ذلك. وهذا ظاهر معروف لا يخفى على من له اطلاع على أمور القرآن العظيم. غير أن بعض الكاتبين انطلاقاً من هذا انتقد الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود في قوله: “والله ما نزلت آية إلا وأنا أعلم فيم نزلت…” وكذا ورد نحوه عن علي رضي الله، فادعى أن في هذا مبالغة من قائله لأنه ليس لكل آية سبب نزول، أو أن بعض الرواة تزيد على الصحابي الذي نقل.
وهذا عجيب في فهم كلام الصحابة ثم في نقده، فإن هذا القول لا يعني أبداً أن لكل آية سبباً، بل المراد إن كان لها سبب فهو يعلمه، وذلك بحسب ما رآه باجتهاده في تتبع أسباب النزول. ثم كيف يُظن بالرواة تزيد وهم هنا في هذه الرواية ليسوا من عامة الناس، بل من الثقات الأثبات؟ لقد كان ذلك يوجب على الأستاذ الناقد إعادة النظر في فهم النص ومقصده الحقيقي.
طريق الوصول إلى أسباب النزول ومنهج التثبت منها
ومن البدهي أن يكون طريق الوصول إلى هذا العلم هو النقل والرواية، لا سبيل غيرهما إليه من اجتهاد أو استنباط، إلا في حدود نقد العلماء الروايات وتمييز ما يثبت منها وما لا يثبت. وقد قال الإمام الواحدي في ديباجة كتابه “أسباب النزول”: “ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب، وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاب”.
وهذا حكم مُجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء، وقد تشدد السلف في البحث عن أسباب النزول، حتى قال الإمام محمد بن سيرين: سألت عبيدة عن آية من القرآن؟ فقال: “اتق الله وقل سداداً، ذهب الذين يعلمون فيما أنزل الله القرآن”. لما كان المرجع في معرفة أسباب النزول هو النقل والرواية، لا جرم أن يكون المحدثون فرسان التصنيف في هذا العلم الجليل في مختلف العصور. وجدير بالتنويه هنا أن اهتمام العلماء بهذا الفن جعله أقدم علوم القرآن تأليفاً، فأُلفت كتب كثيرة في أسباب النزول، كما عُني المفسرون بإيرادها في كتب التفسير.
أهم المؤلفات في أسباب النزول
وأهم الكتب المصنفة في أسباب النزول هذان الكتابان المطبوعان:
١ – “أسباب النزول” للإمام المفسر النحوي المحدث أبي الحسين علي بن أحمد النيسابوري الشهير بالواحدي، المتوفى سنة ٤٣٧ هـ، وقد عول فيه على رواية الأسباب بأسانيده، فأحال على الأسانيد وهي طويلة، تكتنف الوعورة دراستها في كثير من الأحيان، كما أنه أورد أشياء معلقة بدون إسناد.
٢ – “لباب النقول في أسباب النزول” للإمام المحدث الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ، جرده من الأسانيد وعزى كل حديث لمن أخرجه، فكفى القارئ بذلك جهداً كبيراً، وزاد على ما ذكره الواحدي.
أهداف علم أسباب النزول وفوائده
لا ريب عند من له تأمل وخبرة بشرح النصوص والوثائق أن معرفة أسباب النزول والوقائع التي بُني عليها وقوع أمر من وقائع التاريخ له أثر بالغ الخطر في دراسة تلك النصوص أو الأحداث، وذلك من أوجه كثيرة، نذكر منها في هذا المقام ما يلي:
الفائدة الأولى: الاستعانة على فهم المعنى المراد، لما هو معلوم من الارتباط بين السبب والمسبب. قال الواحدي: “لا يمكن معرفة تفسير الآية دون الوقوف على قصتها وبيان نزولها”. وقال ابن دقيق العيد: “بيان سبب النزول طريق قوي في فهم معاني القرآن”. وقال ابن تيمية: “معرفة سبب النزول يُعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب”.
الفائدة الثانية: معرفة وجه الحكمة التي ينطوي عليها التشريع، مما يكون أدعى لتفهُّمه وتقبُّله. فمن قرأ أسباب نزول آيات تحريم الخمر متدرجة واحدة تلي الأخرى أدرك ضرورة تحريم الخمر، وبعثه موقف الصحابة وامتثالهم العجيب عند نزول تحريمها الثبات لأن يقتدي بهم، ويأتي بعملهم، فيتزجر عما قد يكون عليه من فعل محرم.
الفائدة الثالثة: كشف أسرار البلاغة في القرآن العظيم، وإدراك مطابقة الكلام لمقتضى الحال الذي هو ركن البلاغة الأساسي.
قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب
لكن هذا التفسير بسبب النزول مضبوط بقاعدة هامة من أهم قواعد التفسير وهي: “العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب”. ومعنى هذه القاعدة أن سبب نزول الآية إذا كان خاصاً، أي حدث من شخص معين أو أشخاص بأعيانهم ونزل نص الآية بصيغة “العموم” فإن العبرة في الحكم لعموم اللفظ، لا لخصوص السبب. ولا يجوز جعل الآية قاصرة على عين الشخص أو الأشخاص الذين وقع لهم سبب النزول، باتفاق العلماء على ذلك.
وهذه القاعدة تضمن استمرارية الأحكام القرآنية وصلاحيتها لكل زمان ومكان، فالآية وإن نزلت في واقعة معينة أو شخص بعينه، فإن حكمها يشمل كل من تحققت فيه العلة والوصف المذكور في الآية. وبذلك يبقى القرآن الكريم مُخاطباً للبشرية جمعاء إلى قيام الساعة، لا يقتصر على حادثة تاريخية عابرة.
كشف أسرار البلاغة القرآنية من خلال أسباب النزول
إن ركن البلاغة الأساسي هو: “مطابقة الكلام لمقتضى الحال”، ومن العسير إذن على الدارس بلاغة القرآن وخصائص أسلوبه أن يصل لإدراك ذلك بعيداً عن دراسة أسباب النزول، التي بها يُدرك خصوصيات مقاصد الأسلوب. بل يصل لما هو أعلى وأجل حيث يجد أن القرآن الكريم راعى مقتضى حال المخاطبين على أعلى مستوى معجز، في الوقت ذاته الذي تلاءم أسلوبه وأداؤه مع مقتضى حال العالمين إلى يوم الدين.
ولذلك نجد دارسي الأدب في أي لغة لا يفتؤون يقدمون بين يدي دراستهم الأدبية لنص ما السبب الذي قيل النص بسببه، والذي يسمونه “مناسبة”. ولقد كان علماؤنا أدق وأكمل عملاً منهم، حيث أطلقوا كلمة “سبب”، وهذا أليق من كلمة “مناسبة” التي استعملها علماؤنا بمعنى وجه الارتباط بين أجزاء النص، وتعلق بعضه ببعض. كما أنه أدل على قوة العلاقة بين النص وسببه، فضلاً عن التوسع المحوط بالتوثق الدقيق للتثبت من أسباب النزول بإثبات الروايات وروايتها بأسانيدها، مما لا نجد له شبيهاً عند غير علماء التفسير والحديث. ولعلنا بهذه المناسبة نلحظ مغزى تعبيرهم أحياناً بقولهم “قصة الآية” يريدون سبب نزول الآية، وما تشير إليه هذه العبارة من المقصد الأدبي والفني الرفيع.
مثال تطبيقي من سورة النور
ومن أمثلة الإفادة من سبب نزول الآية في كشف بلاغة تعبيرها: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ الآية ٣٣ من سورة النور. نزلت هذه الآية كما اتفقت الروايات في عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين في المدينة، كان له إماء، فكان يُكرههن على البغاء طلباً لخَراجِهنَّ – أي الربح من كسبهن الخبيث هذا – ورغبة في أولادهن – ليتاجر بهم – فاشتكين إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعله بهن، فأنزل الله تعالى هذه الآية.
وقد جاء أسلوب الآية بهذا التعبير ﴿إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا﴾ ليتضمن غمز هؤلاء السادة غمزاً موجعاً، كأنه يقول لهم: لقد بلغ الحرص بكم على المال والجشع أنكم مع وجاهتكم ومركزكم الاجتماعي تهبطون إلى مستوى من قلة النخوة والشهامة تأباه الإماء اللواتي ينتمين إلى طبقة دنيا لا تتغير ولا تتحفظ من شيء، فهن يأبين فاحشة الزنا، ثم أنتم تكرهونهن عليها، فمن من الفريقين أرفع وأكرم؟
دراسة تطبيقية شاملة: قصة بني أُبَيرِق من سورة النساء
ونسوق فيما يلي دراسة لنص من القرآن الكريم تستوفي بحث الموضوع فنياً، وتبرز ذوق المفسرين في تسميتهم سبب النزول “قصة الآية”، وهذا النص هو هذه الآيات من سورة النساء: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٠٦﴾ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ﴿١٠٧﴾ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ﴿١٠٨﴾ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿١٠٩﴾ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴿١١٣﴾﴾.
سبب نزول آيات بني أُبَيرِق
أخرج الترمذي والحاكم وغيرهما عن قتادة بن النعمان قال: كان أهل بيت منا يقال لهم بنو أُبَيرِق: بشر وبشير ومبشِّر، وكان بشير رجلاً منافقاً يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ينحله بعض العرب يقول: قال فلان كذا وكذا. وكانوا أهل بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والإسلام، وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة التمر والشعير، فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً من الدّرْمك فجعله في مشربة له فيها سلاح ودرع وسيف، فتُعدي عليه من تحت، فَنُقبت المشربة وأُخذ الطعام والسلاح.
فلما أصبح أتاني عمي رفاعة، فقال: يا ابن أخي إنه قد عُدي علينا في ليلتنا هذه فنُقبت مشربتنا وذهب بطعامنا وسلاحنا، فتجسسنا في الدار وسألنا فقيل لنا: قد رأينا بني أُبَيرِق استوقدوا في هذه الليلة ولا نرى فيما نرى إلا على بعض طعامكم. فقال بنو أُبَيرِق ونحن نسأل في الدار: “والله ما نرى صاحبكم إلا لبيد بن سهل” رجل منا له صلاح وإسلام، فلما سمع لبيد اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟ والله ليخالطنكم هذا السيف أو لتبينن هذه السرقة. قالوا: إليك عنا أيها الرجل، فما أنت بصاحبها. فسألنا في الدار حتى لم نشك أنهم أصحابها.
فقال لي عمي: يا ابن أخي لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك. فأتيته فقلت: أهل بيت منا أهل جفاء عمدوا إلى عمي فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه فليردوا علينا سلاحنا وأما الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “سأنظر في ذلك”. فلما سمع بنو أُبَيرِق أتوا رجلاً منهم يقال له: أُسير بن عروة، فكلموه في ذلك، فاجتمع في ذلك أناس من أهل الدار وقالوا: يا رسول الله إن قتادة بن النعمان وعمه عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة ولا ثبت.
قال قتادة: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: “عمدت إلى أهل بيت ذُكر منهم إسلام وصلاح ترميهم بالسرقة على غير ثبت وبينة…” فرجعت فأخبرت عمي فقال: الله المستعان، فلم يلبث أن نزل القرآن: ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ – بني أُبَيرِق، ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ﴾ أي مما قلت لقتادة، إلى قوله ﴿عَظِيمًا﴾، فلما نزل القرآن أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرده إلى رفاعة ولحق بشير بالمشركين، فنزل على سلافة بنت سعد، فأنزل الله ﴿وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ﴾ إلى قوله ﴿ضَلَالًا بَعِيدًا﴾.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وفي رواية ذكرها كثير من المفسرين، وهي تكمل السابقة أن السارق خبأ الدرع عند زيد بن السمين اليهودي، فتتبعوا أثر الدقيق حتى انتهى إلى منزل اليهودي، فأخذوها… فألصق السارق التهمة باليهودي. ولا نرى مانعاً من قبول هذه الرواية، لما هو معروف من احتيال المذنب لأجل دفع التهمة عنه، فكان أن ألقى التهمة على لبيد بن سهل أولاً، لإبعاد الأنظار عن القضية، ثم اكتُشف الدرع عند اليهودي، فحاول إلصاق التهمة بهذا اليهودي.
شرح المفردات والمعاني اللغوية
بالحق: أي هو حق من الله تعالى أنزل متلبساً بالحق مشتملاً عليه. بما أراك الله: أي عرّفك، أو أدى إليه اجتهادك. للخائنين خصيماً: أي مخاصماً لأجل الخائنين لمصلحتهم ضد البراء، والمراد بالخائنين بنو أُبَيرِق، أو السارق ومن على شاكلته. يختانون: الاختيان اسم من الخيانة، كالاكتساب اسم من الكسب وفيه زيادة وشدة.
وكيلاً: حافظاً ومحامياً. بهتاناً: أصله من البَهْت، الذي يفيد معنى التَّحير، والمراد الكذب على الغير بما يَبْهت منه ويتحير عند سماعه لفظاعته وهو بريء منه، وقيل: هو الكذب الذي يتحير في عظمه.
الشخصيات والمواقف في القصة
قام بالسرقة شخص منافق فاجر فظ، لم تلن طباعه المنحرفة بالإسلام ولا تشرب قلبه الإيمان، ووجد في قومه من يستر عليه، فقام بإلقاء التهمة على رجل بريء، من المسلمين الصالحين لم يلبث أن استبان بطلان اتهامه فأحالها على يهودي وآزره قومه في ذلك، حتى أوشكوا أن يؤثروا على النبي صلى الله عليه وسلم ويقنعوه بأن صاحبهم بريء حتى هم أن يحكم ببراءته، فنزل الوحي بهذه الآيات يفضح القصة وينصف مظلوماً هو يهودي.
قد كنا سنفهم هذه الآيات دون أسباب النزول فهماً مجملاً، لا يقف على التفاصيل ولا يلمس كثيراً من الإعجاز في أسلوب الآيات، بل ولا في مضمونها أيضاً. هذه الآيات تحكي قصة لا نظير لها ولا تعرف البشرية لها شبيهاً وهي تشهد وحدها بإعجاز القرآن، حيث نزل الوحي يكشف أستار الغيب، ويزيح القناع الكاذب عن القضية، على حين خفيت الحقيقة على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه… بل إن هذه الآيات لتشهد بأن هذا القرآن لابد أن يكون من عند الله، بمعالجتها للموضوع، لأن البشر مهما صفت أرواحهم واستقامت نفوسهم لا يستطيعون أن يرتقوا إلى هذا المستوى الذي عالج القرآن به المشكلة إلا بوحي من الله تعالى.
أنه في الوقت الذي كان اليهود في المدينة يطلقون كل سهامهم المسمومة التي تحويها جعبتهم اللئيمة على الإسلام والمسلمين، وكانوا ينشرون فيه الأكاذيب ويؤلبون المشركين، ويشجعون المنافقين، ويخططون لهم، ويطلقون الإشاعات، ويضللون العقول ويطعنون في القيادة النبوية، ويشككون في الوحي والرسالة، وفي ذلك الوقت حيث كانت العصبية القبلية على أشدها كانت هذه الآيات تتنزل من السماء، لتنصف رجلاً يهودياً اتُّهم ظلماً بسرقة، ولتدين الذين تآمروا على اتهامه وهم بيت من الأنصار في المدينة، والأنصار هم عُدة الرسول صلى الله عليه وسلم وجنده، وما أجدرهم بالمراعاة والتألف.
لكن القرآن نزل في هذه الحادثة ليُعلم الأمة أمراً عظيماً، أراد الله أن تتعلمه، وهي الأمة التي كُلفت بأن تنهض بهذا القرآن وتنشره، ذلك هو أمر العدل بين الناس، العدل في هذا المستوى، الذي لا يرتفع إليه الناس، بل لا يعرفه الناس إلا بوحي من الله.
الأطراف الأربعة في قصة بني أُبَيرِق
ولقد عرفنا من روايات أسباب النزول أربعة أطراف تناولتهم الآيات وعالجت موقف كل منهم، هؤلاء الأطراف هم:
أولاً: النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقد رُفعت إليه القضية ملفقة معكوسة، وهو في موقف القاضي الذي ينظر في الدعاوى وأدلتها، وليس هو في موقف المبلغ للوحي ههنا.
ثانياً: السارق الذي احتال حتى سرق الطعام والسلاح، وأفلح في الاختفاء عن أعين الرقباء من الناس.
ثالثاً: المتهم بالباطل، لبيد بن سهل، ثم زيد بن السمين اليهودي.
رابعاً: المدافعون عن السارق بالباطل من قومه المنافقين.
التحليل البلاغي للآيات
وتحس من الآيات بصورة عامة صرامة وشدة في نصرة الحق والغيرة عليه. انظر التعبير بنون العظمة بـ ﴿إِنَّا أَنزَلْنَا…﴾، وتكرر وصف الخيانة، وتوبيخ المنافقين… وقد افتتحت الآيات بتذكير الرسول صلى الله عليه وسلم بتنزيل الكتاب إليه بالحق ليحكم بين الناس بما أراه الله، وأتبعت هذا التذكير بالنهي ﴿وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا﴾ تدافع عنهم وتجادل، ثم توجه الآيات الرسول إلى الاستغفار وترغب فيه ﴿وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾.
والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخطئ، وهو معصوم عن الخطأ، ولا يملك في موقف القضاء غير التصرف بحسب ما يظهر من البينات والشهادات، لكنها الغيرة على العدالة والنصرة للحق، لذلك تكرر النهي وتكرر وصف هؤلاء: ﴿وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾.
وقد تضمن ذلك كشف جوانب جنايتهم وتصعيد هذا الكشف، فهم أولاً “خائنون” لأنهم خانوا الجماعة المسلمة، وخانوا أحكام دينها، ثم هم من جهة أخرى “يختانون أنفسهم”، وهذه العبارة تبرز لنا صورة القوم، في التعبير بالمضارع وبصيغة المفاعلة المبالغة “يختانون”، إنهم يخونون أنفسهم خيانة عظيمة بإيقاعها في الإثم الذي يُجازون عليه شديد الجزاء. ومن ثم تأتي صورة ثالثة: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾، وهي تلويث أنفسهم بالإمعان في الخيانة والإفراط فيها “خوّاناً”، والانهماك في الإثم “أثيماً”، فلا جرم كان ذلك علة لأن يبوءوا بالبغض والسخط من الله تعالى كما يدل عليه ربط الكلام: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا﴾، فإن من كان كذلك لا يجوز أن يحامى عنه أحد.
ومن ثم يتم الانتقال للطرف الثاني وهم المنافقون الذين يتآمرون ويمكرون وكان منهم هذا اللص الجاني بتصوير فيه قوة التشنيع والتنفير من سلوك هؤلاء الخونة: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ﴾.
وهي صورة زرية تجعلهم موضع الاحتقار والسخرية، فهم يستخفون بقبائحهم وكيدهم ومؤامرتهم من الناس، والناس لا يملكون لهم نفعاً ولا ضراً، والذي يملك النفع والضر معهم حين يُبيّتون ما يُبيّتون مطلع عليهم وهم يخفون في جنح الظلام ما به يستخفون، فأي موقف يدعو للزراية والسخرية أكثر من هذا الموقف الذي وقعوا فيه بقلة عقلهم ويقينهم، لذلك ذُيل الكلام بالوعيد: ﴿وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ من الأعمال الظاهرة والخفية ﴿مُحِيطًا﴾، لا يعزب عنه شيء ولا يفوت، فيجازي عليه الجزاء الأوفى.
ومن ثم ينتقل الكلام إلى الذين ناصروا اللص ودافعوا عنه: ﴿هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾. وهذا الختام في الآية قد أفاد نفي الوكيل أي وكيل كان، نفياً باتاً ﴿أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾، وإذن فما جدوى الجدال عنهم في الدنيا، وما أسخفه، وهو لا يدفع عنهم ذلك اليوم الثقيل.
القواعد العامة المستفادة من القصة
ومن ثم تبين الآيات الحكم في هذا الصنيع بعد معالجة المواقف السابقة فتقرر الحكم في هذه الآيات: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١٠﴾ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١١﴾ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿١١٢﴾﴾.
إنها آيات ثلاث تقرر المبادئ الكلية التي يعامل الله عباده بها، والتي يملك العباد أن يعاملوا بعضهم بعضاً بها، ويعاملوا الله على أساسها فلا يصيبهم السوء. الآية الأولى تفتح باب التوبة على مصراعيه، وباب المغفرة على سعته، فتطمع كل مذنب تائب في العفو والقبول: ﴿وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَّحِيمًا﴾.
والآية الثانية تقرر فردية التبعة وهي القاعدة التي يقوم عليها الاعتقاد الإسلامي في الجزاء، والتي تثير في كل قلب شعوراً بالخوف وشعوراً بالطمأنينة: الخوف من عمله وكسبه، والطمأنينة من أن يحمل تبعة غيره: ﴿وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾. فليست هناك خطيئة موروثة في الإسلام، كما أن التهمة الباطلة لا تضر المتهم المظلوم بشيء.
والآية الثالثة تقرر تبعة من يكسب الخطيئة ثم يرمي بها البريء وهي الحالة المنطبقة على حالة العصابة التي يدور عليها الكلام: ﴿وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾. البهتان في رميه البريء، والإثم في ارتكابه الذنب الذي رمى به البريء، وقد احتملهما معاً وكأنما هما حمل يُحمل، على طريقة التجسيم التي تبرز المعنى وتؤكده في التعبير القرآني المصور، بل هو حمل ثقيل كما يصوره التعبير “احتمل”، بزيادة الألف والتاء في الفعل.
وبهذه القواعد بينت الآيات الحكم في جناية هذا الجاني، وهو حكم عام ينطبق على كل من كان على شاكلته، كما تقول القاعدة “العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب”، وبهذا العموم في الصيغة رسم القرآن ميزان العدالة الذي يحاسب كل فرد على ما اجترح، وأعطى المتهم البريء الأمان، وشفى قلبه من الظالم لما أبان عن فظاعة ذنبه وأنه ﴿احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا﴾.
منة الله على رسوله الكريم
وأخيراً يرجع الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم تكريماً وتشريفاً له، ولبيان غاية عناية الله به: ﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا﴾. فالله يمن على رسوله صلى الله عليه وسلم أن عصمه من الانسياق وراء المتآمرين، فأطلعه على مؤامراتهم التي يستخفون بها من الناس ولا يستخفون بها من الله.
ثم يمن عليه المِنّة الكبرى في إنزال الكتاب والحكمة عليه، وتعليمه العلوم الدينية والدنيوية الشرعية النافعة، ولم يكن يعلم شيئاً من ذلك، كما صرح بذلك قوله تعالى: ﴿وَمَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ﴾، وهذه المِنّة مِنّة على البشرية كلها، وُلد معها الإنسان ميلاداً جديداً، وترقى بها في الطريق الصاعد إلى القمة الشاهقة.
شمولية الآيات لجميع جوانب القصة
وهكذا شملت الآيات الشخصيات والمواقف التي أخذنا من سبب النزول معرفتها بوضوح أكبر، ورأينا كيف غطت ببيانها الموجز المعجز كل ما يتصل بتلك الشخصيات والمواقف، مما جعل القضية تنتقل لتربية الأمة كلها. حققت الآيات واجب العدل الأول بإدانة المجرم، وتبرئة البريء، وهذه التبرئة أمر جليل في ميزان الله، وأشادت بصاحب الرسالة وفضل الله العظيم عليه.
ثم حققت هدفاً خطيراً عظيماً لا يقتصر على أشخاص ولا على زمان أو مكان، ذلك هو إقامة الميزان الذي لا يميل مع الهوى، ولا مع العصبية، ولا يتأرجح متأثراً بعوامل المودة أو الشنآن أياً كانت الملابسات والأحوال. وبذلك تطهر المجتمع المسلم من عناصر الضعف البشري فيه، مع علاج رواسب الجاهلية في كل صورها، حتى في صورة التعصب لأهل العقيدة إذا تعلق الأمر بإقامة العدل بين الناس. وبهذا أقام القرآن المجتمع المسلم الفريد على القاعدة الطيبة النظيفة الصلبة التي لا تدنسها المصلحة الأنانية أو العصبية أو الأهواء.
خاتمة
في ختام هذه الدراسة الشاملة لعلم أسباب النزول، يتبين لنا بجلاء أن هذا العلم ليس مجرد معرفة تاريخية للوقائع التي نزلت فيها الآيات، بل هو مفتاح جوهري لفهم القرآن الكريم وكشف إعجازه البياني والتشريعي. فمن خلال معرفة أسباب النزول نستطيع أن نستجلي المعاني الدقيقة للآيات، ونُدرك حِكَم التشريع وأسراره، ونقف على روائع البلاغة القرآنية في مطابقة الكلام لمقتضى الحال.
وقد تبيّن من خلال الأمثلة التطبيقية – وخاصة قصة بني أُبيرِق – كيف أن معرفة السبب تُضيء جوانب من الإعجاز القرآني قد تخفى على من لم يطّلع على هذا العلم، وكيف أن القرآن الكريم يُرسي قواعد العدل المطلق والإنصاف الذي يتجاوز حدود الزمان والمكان.
ومع أهمية معرفة أسباب النزول، فإن قاعدة “العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب” تضمن بقاء القرآن الكريم منهجاً خالداً صالحاً لكل عصر ومصر، يُخاطب البشرية جمعاء بأحكامه وتوجيهاته. وهذا يستدعي من طلاب العلم والباحثين في علوم القرآن أن يولوا هذا العلم الجليل مزيد عناية واهتمام، مع التثبت في الروايات والاعتماد على المصادر الموثوقة، ليكون فهمهم للقرآن الكريم فهماً دقيقاً مبنياً على أسس علمية راسخة.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.
سؤال وجواب
١. ما هو تعريف علم أسباب النزول؟
علم أسباب النزول هو ما نزلت الآية أو الآيات تتحدث عنه أيام وقوعه، ويشترط في سبب النزول أن يكون حدثاً معاصراً لنزول الآية، وليس إخباراً عن وقائع ماضية كقصص الأنبياء السابقين أو أحداث الأمم البائدة.
٢. ما الفرق بين سبب النزول ومناسبة الآية؟
سبب النزول هو الحدث أو الواقعة التي نزلت الآية بشأنها أيام وقوعها، بينما المناسبة في الاصطلاح الأدبي تعني الظرف العام الذي قيل فيه النص. وقد كان علماء التفسير أدق في استعمال كلمة سبب لأنها تدل على قوة العلاقة بين النص والواقعة، فضلاً عن توثيقهم الدقيق للروايات بالأسانيد.
٣. هل كل آيات القرآن الكريم نزلت بأسباب؟
لا، القرآن الكريم قسمان: قسم نزل ابتداءً من غير سبب بالمعنى الاصطلاحي كأكثر قصص الأنبياء والوقائع الماضية وأهوال القيامة والجنة والنار، وقسم نزل على أسباب ومنه معظم آيات الأحكام والرد على المخالفين وما نزل بشأن المغازي والوقائع مع المسلمين.
٤. ما معنى قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
معنى هذه القاعدة أن الآية إذا نزلت في شخص معين أو واقعة خاصة لكن جاءت بصيغة العموم، فإن حكمها يشمل كل من تحققت فيه العلة والوصف المذكور في الآية، ولا يقتصر الحكم على من نزلت فيه الآية. وهذه القاعدة تضمن استمرارية الأحكام القرآنية وصلاحيتها لكل زمان ومكان.
٥. ما هو طريق الوصول إلى معرفة أسباب النزول؟
طريق الوصول إلى علم أسباب النزول هو النقل والرواية الصحيحة عن الصحابة والتابعين الذين شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب، ولا يجوز الاعتماد على الاجتهاد أو الاستنباط الشخصي في تحديد أسباب النزول، إلا في حدود نقد الروايات وتمييز ما يثبت منها وما لا يثبت.
٦. ما أهم الكتب المصنفة في علم أسباب النزول؟
أهم الكتب المطبوعة في أسباب النزول اثنان: الأول كتاب أسباب النزول للإمام الواحدي النيسابوري المتوفى سنة ٤٣٧ هـ وقد أورد الروايات بأسانيدها، والثاني لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي المتوفى سنة ٩١١ هـ وقد جرده من الأسانيد وعزى كل حديث لمن أخرجه.
٧. ما فوائد معرفة أسباب النزول؟
لمعرفة أسباب النزول فوائد جليلة أهمها: الاستعانة على فهم المعنى المراد من الآية لما بين السبب والمسبب من ارتباط، ومعرفة وجه الحكمة الباعثة على التشريع مما يجعله أدعى للتفهم والتقبل، وكشف أسرار البلاغة القرآنية وإدراك مطابقة الكلام لمقتضى الحال الذي هو ركن البلاغة الأساسي.
٨. ما المقصود بقول ابن مسعود ما نزلت آية إلا وأنا أعلم فيم نزلت؟
المراد بهذا القول أن الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود كان يعلم سبب نزول كل آية لها سبب نزول، وليس المعنى أن لكل آية سباً لأن من القرآن ما نزل ابتداءً من غير سبب خاص. وهذا يدل على اجتهاده في تتبع أسباب النزول ومعرفتها، ولا يعني أن كل آيات القرآن نزلت بأسباب كما ظن بعض الكاتبين.
٩. كيف تساعد أسباب النزول في فهم البلاغة القرآنية؟
تساعد أسباب النزول في إدراك بلاغة القرآن لأن ركن البلاغة الأساسي هو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، ومعرفة السبب تكشف خصوصيات مقاصد الأسلوب وتبين كيف راعى القرآن حال المخاطبين على أعلى مستوى معجز، مع ملاءمته لمقتضى حال العالمين إلى يوم الدين، مما يبرز الإعجاز البياني للقرآن الكريم.
١٠. ما الدروس المستفادة من قصة بني أُبَيرِق في سورة النساء؟
قصة بني أُبَيرِق تبين عظمة العدل الإسلامي حيث نزل القرآن ينصف يهودياً اتهم ظلماً في وقت كان اليهود يحاربون الإسلام والمسلمين، وتؤكد أن العدل لا يتأثر بالعصبية القبلية أو الميل للمودة، وتقرر مبدأ فردية التبعة وأن من يرمي بريئاً بذنبه فقد احتمل بهتاناً وإثماً مبيناً، وتكشف عن الإعجاز القرآني في معالجة القضايا الاجتماعية.