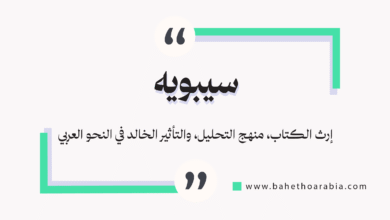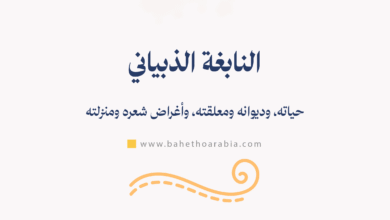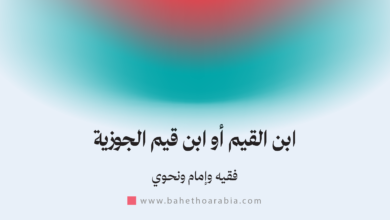عنترة بن شداد: الفارس الشاعر وأسطورة الشجاعة والعشق
دراسة شاملة في حياة وشخصية وشعر فارس بني عبس الأشهر ما بين ٥٢٥ - ٦١٥م
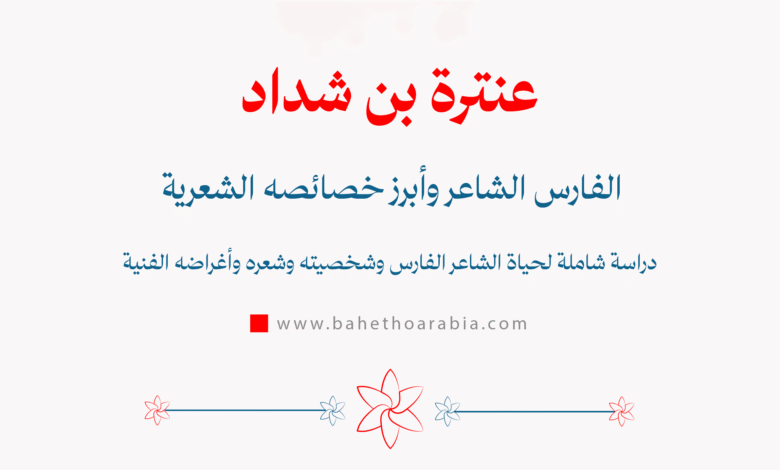
يمثل عنترة بن شداد أيقونة خالدة في التراث العربي، جمعت بين الفروسية والشعر والعشق في سيرة ملهمة. تستعرض هذه المقالة الأكاديمية مسيرته بالتفصيل، كاشفةً عن أبعاد شخصيته وإبداعه.
حياة عنترة بن شداد
يُعد عنترة من أشهر الشخصيات العربية، ومما زاد شهرته اتساعاً في العصور المتأخرة تلك السيرة التي كتبت عنه في العصر العباسي، ثم تناقلها الناس بالقراءة والرواية والإعجاب حتى غدا الجانب القصصي الأسطوري من شخصية الشاعر يطغى على الجانب الحقيقي في أذهان كثير من أبناء الشعب العربي. وحتى نسب إليه من الأخبار والأشعار ما ليس لـه.
ذكر ابن سلام نسبه مفصلا، فقال: هو عنترة بن شداد بن معاوية بن عبس). وفي اسم أبيه خلاف لا فائدة من ذكره، وذكر له الرواة أكثر من كنية، ومن كناه: أبو المغلس، وأبو عبلة، وهو من بني عبس الذين روينا لك طائفة من أخبارهم في حديثنا عن حرب داحس والغبراء التي نشبت بين عبس وذبيان، وصورها زهير بن أبي سلمى. وموطن هذه القبيلة بين شمالي الحجاز وغربي نجد.
قال صاحب الأغاني: (وعنترة أحد أغربة العرب، وهم ثلاثة: عنترة وأمه زبيبة وخفاف بن عمير الشريدي وأمه ندبة والسليك بن عمير السعدي وأمه السلكة، وإليهن ينسبون، وقال أيضاً: وله لقب، يقال له عنترة الفلحاء، وذلك لتشقق شفتيه. وأمه أمَةً حبشية يقال لها زبيبة. وكان لها وَلَدٌ عبيد من غير شدّاد. وكانوا إخوته لأمه.
وقد كان شداد نفاه مرة، ثمّ اعترف به فألحقه بنسبه، وكانت العرب تفعل ذلك، تستعبد بني الإماء، فإن أنجب اعترفت به، وإلا بقي عبداً. واستطاع عنترة بن شداد أن ينتزع إقرار أبيه بنسبه انتزاعاً في موقف بز فيه الأحرار وخلاصة هذا الموقف أنّ بعض أحياء العرب أغاروا على بني عبس، فأصابوا منهم واستاقوا إبلا فتبعهم العبسيون فلحقوهم، فقاتلوهم عما معهم، وعنترة يومئذ فيهم. فقال له أبوه: كرّ يا عنترة. فقال عنترة: العبد لا يحسن الكر، إنما يحسن الحلاب والصر. فقال: كر وأنت حر فكر، وهو يقول: أنا الهجين عنترة كلُّ امرئ يحمي حِرَه أسودُه وأحمرهُ والشعراتُ المشعرة الواردات مِشْفَرة.
وقاتل يومئذ قتالاً حسناً، فادعاه أبوه بعد ذلك، وألحق به نسبه. وكان لهذه الغزاة أثرها الخطير في حياة عنترة، إذ نقلته من عبد يرعى الغنم، ويزري به لداته من أشراف عبس إلى سيد حرّ، يقود الكتائب في وقائع داحس والغبراء. ومن خادم يعيش بين الإماء إلى فارس يهابه فرسان الحي، ويحسدونه لكن هذا الفارس الجلد كان ينطوي على قلب عاشق رهيف الحس، أسرته ابتسامة عبلة. وكان يظن أن ظفره بحريته سيُظفره بحبيبته، ويحرره من زراية أهلها به فخاب ظنه، وظلّ يشكو عبودية الحب في شعره ويقول أستاذنا الدكتور عمر فروخ: ولعل عنترة مات عزباً، ثم هو لم يتزوّج عبلة، فعبلة تزوجها رجل غيره. وذهب دارس آخر إلى أنه لم ينل حريته إلا بعد أن تقدمت به السن وشغل فترة من الزمن بحب عبلة، وشغل باقي عمره بالحرب فعشقها.
وفي مصرعه أخبار نجتزىء منها بما جاء في الأغاني: يقول الخبر الاول: أغار عنترة على بني نبهان من طريء، فطرد لهم طريدة، وهو شيخ كبير، فجعل يرتجز، وهو يطردها ويقول: آثار ظلمان بقاع محرب وكان زر بن جابر النبهاني في فتوة فرماه، وقال: خذها، وأنا ابن سلمى، فقطع مطاه، فتحامل بالرمية حتى أتى أهله. ويقول راوية الخبر الثاني: «غزا (عنترة) طيئاً مع قومه، فانهزمت عبس، فخر عن فرسه ولم يقدر من الكبر أن يعود فيركب. فدخل دغلا، وأبصره ربيئة طيء، فنزل إليه وهاب أن يأخذه أسيراً، فرماه فقتله. وجاء في الخبر الثالث: أنه كان قد أسنّ واحتاج، وعجز بكبر سنه عن الغارات، وكان له على رجل من غطفان بكر، فخرج يتقاضاه إياه، فهاجت عليه ربع من صيف، وهو بين شرج وناظرة فأصابته، فقتلته.
ومهما يكن السبب في مقتله، فقد عجزت هذه الأسباب عن أن تقتل ذكره وتطمس شخصيته الفذة، إذ أصبح عنترة ـ كما ذكرنا قبل ـ بطل أسطورة مشرقة تمثل القيم والشيم، وتجمع الحبّ إلى الحرب فهو فارس نبيل، وعاشق رقيق الشمائل، يغيث الملهوف، ويفك العاني، ويجبه الظلم، ويتصدى لعمارة بن زياد منافسه في حب عبلة، ويغالب الصعاب، ويخرج من المآزق مظفّراً محوطاً بإكبار الناس. فما الفضائل الحقيقية التي جعلت كاتب السيرة يتخير عنترة، ليجعله الفارس الكامل؟ وما شيمه التي ترسمها أخباره الصحيحة لا السيرة الموضوعة؟
شخصية عنترة بن شداد
تفرد عنترة بن شداد بشخصية ساحرة آسرة ذات قسمات واضحة أهمها:
١) الشجاعة المتعقلة: أما الشجاعة المتهورة التي ذهب بها كاتب السيرة مذهب الأسطورة فليست من طباع عنترة، صحيح أن الرجل كان أيداً قوي العضل والساعد ثابت الجنان، لكنه كان كذلك يحكم عقله في قلبه وعصبه. ولولا احتكام ساعده الشديد إلى رأيه السديد ما عاش تسعين سنة. قيل لعنترة: أنت أشجع وأشدها. قال: لا. قيل: فبماذا شاع لك هذا في الناس؟ قال: كنت أقدِم إذا رأيت الإقدام عزماً، وأحجم إذا رأيت الإحجام حزماً ولا أدخل إلا موضعاً أرى لي منه مخرجاً. وكنت أعتمد الضعيف الجبان، فأضربه الضربة الهائلة يطير لها قلب الشجاع فأثني عليه فأقتله. فعنترة لم يكن الهائج الأرعن، بل كان البطل الأروع، يقدم ويحجم، ويفكر في الفر قبل أن يبدأ الكر. سأل عمر بن الخطاب الحطيئة عن حرب قومه بني عبس، فقال: «كان فارسنا عنترة، فكنا نحمل إذا حمل، ونحجم إذا أحجم.
٢) الأنفة والزهد في الغنائم: عرف عنترة بن شداد بين قومه بالترفع عن الدنايا، وبالزهد في الأسلاب وبالقتال المنزّه عن الطمع، كان همه أن يدفع الخطر عن قومه، وأن يترك الغنائم لصغار العزائم: هَلاَّ سألتِ القَوْمَ يا بنةَ مالك إِنْ كُنْتِ جَاهِلَةٌ بِمَا لَمْ تَعْلَمي يُخبرك مَنْ شهد الوقيعة أنني أَغْشَى الوَغَى وَأَعِتُ عِنْدَ المغنم وربما حمله التعفف على الجوع فصبر له شماً وأنفة: ولـقَـدْ أَبـيـتُ على الطَّوَى وَأَظَلَّهُ حتى أنال به گريم المأكلِ.
٣) الحلم والرحمة: كان عنترة – على ما فيه من بأس شديد – موطّأ الكنف، ليّن العريكة ألوفاً مألوفاً، يستطيب الناس معايشته، ويفيئون إلى حلمه : أثني عَلَيَّ بما عَلِمْتِ فَإِنَّني سمْحَ مُخالَقَتِي إِذا لَمْ أُظْلَم ولم يكن هذا الحلم إلا مظهراً من مظاهر الكمال ونضج الشخصية، وعمق الثقة بالنفس، لقد كان يخضع قوته لعقله، فجاوز مرحلة المباهاة بالقوة إلى مرحلة تحليم القوة، وخلع على الشجاعة معنى قلما يتحلى به الشجعان، وهو أن يكون لها غرض إنساني نبيل فكان من أرق الناس في المواطن التي تحسن فيها الرقة، وأبعدهم من الطغيان وأحرصهم على الرحمة والرفق بكل مخلوق وحسبك أن تصغي إليه وهو يناجي جواده الجريح مناجاة الصديق العطوف فيخيل إليك أن حصانه يتكلم معه بلا صوت، ويبكي بين يديه بلا دموع: لَوْ كَانَ يَدْرِي مَا الْمُحَاوَرَةُ اشْتَکى وَلَكَانَ لَوْ عَلِمَ الكَلامَ مُكلِّمي.
٤) ولعلّ أعلى ما يُعليه في نظرنا سيطرته على غرائزه في مجتمع قبلي يصعب فيه كبح الغرائز والشهوات. فهو لا يسرف إذا شرب ولا يعربد إذا طرب، ولا يغوي المرأة إذا أحب، ولا يسرق اللذة التي حرمتها الأعراف والتقاليد. لقد شرب طرفة وامرؤ القيس والأعشى فأسرفوا، وأقضى بهم السرف إلى التبذل في كثير من الأحيان، فخلعوا العذار، ومجنوا، وفسقوا. أما عنترة فلم يدع للخمر سلطاناً على خلقه، فبقي طاهر الذيل، نقي العرض، عفاً براً: فإذا شربتُ فَإِنِّي مُسْتَهْلِكَ مالي، وَعِرْضِي وَافِرٌ لَمْ يُكْلَم وَإِذا صَحَوتُ فما أقصِّر عَنْ نَدىً وَكَما عَلِمْتِ شمائلي وتكرمي.
وتغزل الشعراء فعروا المرأة، ووصفوا الكشح والردف والثدي، وترصدوا وتصيدوا وراودوا الحصان والعاهر، أمّا عنترة فقد ظلت عفته عينا على شهوته فمنه أن يزور امرأة وزوجها غائب، وأن يرسل عينه في مفاتنها، وهي عنه غافلة: أَغْشَى فَتاةَ الحَيَّ عِنْدَ حَلِيلِها وإذا غَزْا فِي الجَيْشِ لا أَغْشَاها وأغُضُّ طَرْفِي إن بَدَتْ لي جارتي حتى تواري جارتي مأواها ولعل أرق ما يعبر عن تساميه بنفسه، وارتقائه بها سيطرته على رغابها الأمارة بالسوء، ولجم الغرائز الجامحة بالخلق الوعر ، والعقل الحصيف، والرفعة الحَصَان إنّي امرؤ سَمْحُ الخَلِيقَةِ مَاجِدٌ لا أُتَّبِعُ النَّفْسَ اللجُوج هواها.
وحينما حلل الدارسون المحدثون شمائل عنترة حاولوا أن يشفعوا التحليل بالتعليل، فوجد بعضهم ان شخصية عنترة ثمرة لعوامل صنعتها، وأهم هذه العوامل الوراثة. فقد ورث عن أبيه شهامة العرب وكرمهم، وورث عن أمه الحبشية قوة الجسد، والميل إلى المراوغة وعقدة السواد التي ظل يعاني منها حتى وهو في قمة انتصاراته، ورأى هذا الدارس أن عقدة السواد أثرت في علاقاته مع المرأة، وأعطته نوعاً من التحدي الذي خلق منه فارساً متميزاً. ورأى الدكتور عبده بدوي أن السواد أعطى الشاعر نوعاً من محاولة إثبات الذات في مواجهة المجتمع والحياة من حوله).
ومضى إلى أبعد من ذلك، إذ زعم أن لسواد الشاعر فضلا على تطور القصيدة العربية، فقال: «إن حاجز اللون كان وراء تحول هام في القصيدة العربية، وهو الانتقال من (ضمير الجمع) إلى (ضمير الفرد ذلك لأنه كان في حاجة إلى لفت الأنظار إليه. كما كانت القصيدة العربية في حاجة ماسة إليه كذلك، لتزدهر، وفي هذا القول ما فيه من غلو، لكن فيه حظّاً من الصواب يتمثل في تفرد عنترة بشخصية ناضجة، أنطقت الدكتور عبد الحميد يـونس بهذه الشهادة الهامة: إن وجدان الشعب العربي احتفل بعنترة في كل مكان، وجعل منه نموذجاً يصعد إليه الأفراد كلّما حَزب الأمر، أو هجع الوجدان العربي عن الاعتصام بسورة الحمية العربية، وكلما ارتطم الشعب العربي بعدو يريد أن يتحيفه، أو يعتدي على حماه.
شعر عنترة بن شداد ومعلقته
لعنترة ديوان طبع طبعات مختلفة، لكنها جميعاً لا تبرأ من المنحول المنسوب إلى عنترة. ومن طبعاته تلك التي حققها عبد المنعم شلبي وكتب مقدمتها إبراهيم الأبياري، ونشرتها المكتبة التجاربة الكبرى بالقاهرة بلا تاريخ وهي طبعة قليلة الضبط والتحقيق ومما يميزها أن المحقق أشار في مطلع كل قصيدة إلى ما رواه الأصمعي والبطليوسي، وما لم يروياه. وقد قصرنا دراستنا على ما أجمع الرواة على نسبته إلى عنترة، وعلى ما ورد في كتب النحو واللغة، لأن هذه الكتب لا تحتج إلا بالصحيح.
أكثر شعر عنترة بن شداد في الوصف وفي الحماسة والفخر، وبعضه في الغزل، وأقله في الهجاء، ودرة شعره المعلّقة. ولنظمها سبب يتصل بأصل عنترة ولونه. فقد رأيت كيف انتزع الشاعر الفارس إقرار أبيه بنسبه انتزاعاً، وبقي عليه أن ينتزع إقرار الناس بملكاته، وأن يدفع عنه عجرفية من يباهون بالشرف والشعر. وحدث أن شتمه رجل من سراة عبس، وعيّره لونه، وأمّه، فقال عنترة: إنّي لأحتضر البأس، وأوافي المغنم، وأعفّ عن المسألة، وأجود بما ملكت يدي، وأفصل الخطة الصماء». فقال له الرجل: أنا أشعر منك. قال: ستعلم ذلك، ثم أنشد معلقته». وفيها الدليل على عبقريته.
نظم عنترة معلقته على الكامل، وجعل روتها الميم، وهي في شرح الزوزني أربعة وسبعون بيتا، وفي غيره من الكتب خمسة وسبعون أوّل أغراضها الوقوف على الأطلال والتسليم عليها والدعاء للديار، والجزع لفراق الأحبة، ووصف الديار المقفرة بعد رحيل أهلها عنها. كلّ ذلك في ستة أبيات (١) – (٦) وثاني أغراضها الغزل، ويشغل من فقرات متباعدات أرقام أبياتها (٧) – (٩) و (١٣) – ٢٠) و (٥٧ – ٦٠) وفي هذه الفقرات يتحدث الشاعر عن عشقه عبلة، ويأسه من وصالها، وعن منزلتها عنده، ويشكو الصد والبعد ويصف طيب ثغرها، ويقرنه بروضة أنف طيبة الأرج، ثم يشير إلى تسقطه أخبارها، وافتتانه بجيدها وابتسامتها والتفاتها. وثالث الأغراض صفة الناقة (٢٢) – (٣٤) وتشبيهها بالظليم ورابعها الفخر وفي هذا الغرض يطيل عنترة، ويضمن فخره وصف الحرب ومحاورة الحصان والتعريض بابني ضمضم وبرجل اسمه عمرو.
أغراض شعر عنترة بن شداد
طرق عنترة الموضوعات التي طرقها غيره من شعراء العصر الجاهلي، لكنه أطال في جانب، وأوجز في جانب وأهم أغراضه:
١) الوصف
الوصف في شعر عنترة غزير المادة، متعدد الموصوفات، تناول فيه الشاعر ما وقع عليه بصره من مشاهد الصحراء، من الروضة الأنف التي ظهرت فيها (كل قرارة كالدرهم) إلى جانب الذباب الهزج الذي (يحك ذراعه بذراعه) ومن الناقة الشدنية التي احتملت جسده إلى (الزجاجة الصفراء) التي اختبلت عقله. ومن ديار عبلة بالجواء إلى الوكر الذي تبيض به مصاييف الحمام ومن الجيوش التي تشبه سيولاً وقد جاشت بهن الأباطح» إلى كل سنان كأنه شهاب بدا في ظلمة الليل واضح، لكن الموصوف الذي برع فيه عنترة وأطال هو الحصان، وعنه وحده نتحدث.
وصف عنترة الخيل مذاكيرها والإناث وصوّرها سائمة ترعى، وعادية تغير وكوكبة تستبق، وأفراداً تختال. ورسمَ أعضاءها مفصلة، وهياكلها تامة، وأرسل بصره في خلقها العجيب يتفحّص أوصالها تفحص العالم الخبير والفارس الممارس، وأعمل بصيرته في نفوسها يتحسّس مشاعرها تحسّس الصديق الشفيق، والأخ المؤاسي. ولا نبالغ إذا قلنا إنه أحبها فوق حبه النساء، ووصفها وصفاً تحسدها عليه عبلة.
فجِرْوَةَ فرس أبيه شداد من عتاق الخيل، تكرم في الشتاء، فيكف عنها الفحول لأنها اقتنيت للحرب لا للنسل، وتصان من العمل والخدمة، فلا يركبها ربها لشأن من شؤونه، ولا يعيرها أحداً من الناس:
فمَنْ يَكُ سَائِلاً عَنِيَّ، فَإِنِّي وجروة لا ترود ولا تُعارُ
مقرّبة الشتاءِ، ولا تراها وراءَ الحَيَّ يَتْبَعُها المِهارُ
ومهر عنترة خفيف القوائم، رشيق الخطا، ينقض على العدو انقضاض الذئب لا تضعف عزيمته الجراح وإن كست ترائبه صداراً من دم:
وزعْتُ رَعِيلَها بالرمح شَذْراً على زبدٍ كسرحانِ الظلامِ
أكُرُّ عليهمُ مهري كليماً قلائده – سبائبُ كالقِرامِ
وله في صفة حصانه أحد عشر بيتاً يرسم فيها جسم الحصان وحركاته، وصفاً مفصلاً، فحصانه ذو جسد ضخم له عجز صلب كالصخرة الناعمة في مسيل الماء، وعنقه كجذع شجرة شذبت أغصانه، ومنخراه كهفان تأوي إليهما الضبع:
ولرب مشعلة وزَعْتُ رعاها بمقلص نهْدِ المراكل هيكَل
نهد القطَاةِ كَأَنها مِنْ صَخْرَةٍ مَلساءَ يُغْشاها المَسيلُ بمَحْفلِ
وكأن هاديه إِذا اسْتَقْبَلْتَهُ جِذعٌ أذِلُّ وكان غير مُذَلّلِ
وكأنّ مخرجَ رَوْحِهِ في وجههِ سربانِ كانا مولجين لجيْألِ
وبعد أن وصف عنترة جواده هذا الوصف لم يصبر على فراقه، ولم يقنعه النظر إليه من بعيد، فنزا عليه وركبه ليقتحم به الصفوف ويغير على الأعداء، كأنه الصقر الكاسر:
فعليهِ أَقتَحِمُ الهَياجَ تَقَحُّماً فيها، وَأَنْقَضُّ انْقِضَاضَ الأَجْدَلِ
والصور التي اختارها عنترة لجواده تنافس صور امرىء القيس، بل تبزها، لأنها أقرب إلى الواقع، وأدلّ على الأصالة وقوة المراس، فهو لم يرسم له صوراً حضرية كخذروف الوليد، والشعر المرجّل المصبوع بالحناء، ولم ينظر إليه من بعيد نظرة الرسام كما فعل امرؤ القيس بل اعتنقه وانطلقا صقراً على صقر.
وفي المعلقة بلغ حب عنترة جواده مبلغه، إذ جاوز وصف الجسد إلى تحليل النفس، وانتقل من التأدب والمصانعة في مخاطبة الأدهم إلى المشاركة الوجدانية في تحسس آلامه. لقد صبر الأدهم على الأسنة الواغلة في جلده ولحمه، غادية رائحة في صدره كحبال البئر صاعدة هابطة، ولم ينكفئ ولم يخذل عنترة، ولكن عنترة أحس ما في نفسه من شكوى مكظومة، وألم حبيس، وود لو يستطيع أن يحاوره ليشكره، أو يناجيه ليواسيه، وقنع كل منهما بالنظر في عيني صاحبه، ففيهما ما عجزا عن ترجمته بلغة جامعة وتواءما وتلاءما على صمت:
يَدْعُونَ عنترَة والرَّماحُ كأَنها أشطان بئر في لَبان الأدهمِ
مازلت أرميهم بثغرة نحرهِ ولَبَانه حتى تسربل بالدَّمِ
فازْورّ من وقع القنا بلبانهِ وشكا إلى بعيْرةٍ وتحمحمِ
٢) الفخر
يُعد الفخر من أبرز الأغراض في شعر عنترة. وقد كان الشاعر مدفوعاً إليه دفعاً قوياً، لأنه كان يخوض معركة ضارية لإثبات نسب ولانتزاع حق، وللرد على خصوم، وللظفر بمحبوبة لا يراه أهلها كفؤاً لها، وللتعويض من لون مفروض عليه. ولما كان السراة من عبس قد أنكروا عنترة، وتعيّروا به، فقد جعل عنترة همه الأول مفاخرة السراة. وإذا كان عاجزاً عن مجاراتهم في ميدان الأنساب والأمجاد التالدة فهو قادر على قهرهم بقوة الساعد ومضاء السيف لأن القوة لا نسب لها ولا لون.
أغار مرة على بني العشراء – وهم قوم من فزارة – وتخير أشرافهم، فأعمل فيهم السيف، وفتك بهم فتكاً ضارياً، فتضاغوا بين يديه، كأنهم صغار الحيوان، وهو يتصيد منهم جبناء الأغنياء:
ألا أَبْلِغْ بَنِي العُشْرَاءِ عنِّي علانية فقد ذهب السِّرارُ
قتلْتُ سَرَاتَكُمْ وَخَسَلْتُ مِنْكُمْ خسيلاً مثلما خُسِلَ الوبارُ
وكان عنترة في بعض مفاخره حريصاً على الشماتة والتشفي، وعلى أن يسمي فرائسه، فرمحه اعتلق ظهر فلان وسيفه بقر بطن فلان فكأنه بهذه التسمية يريح نفسه من حقد قديم کظیم:
تركت جُبَيْلةَ بن أبي عَدِيٍّ يَبُلُّ ثيابهُ عَلَقٌ نَجيعُ
وآخَرَ منهم أجْررْتُ رُمْحي وفي البَجلِّي مِعْبلةٌ وقِيعُ
ولما كان يكره المخنثين، محمد المترفين، فقد جعل شطف العيش مفخرة والتبذل تحدياً لذوي الرّواء الكاذب، ومضى يبين لعبلة أن قيم الأشياء في جواهرها لا ظواهرها. فإذا أدهشها شحوبه وهزاله، فالسيف معروق لا لحم له، وإذا اقتحمته عينها حينما رأت شعثه وغيرته فالعطر حلية النساء، أما حلية الرجال فالدروع السوابغ والسيوف القواضب. ومن أجدر من عنترة بتلك الحلية؟ إنه دارعٌ كمّي، تصدأ الدروع على كشحه قبل أن يخلعها، وينفي صدأها عن بشرته الخشنة:
عجِبَتْ عبلةُ من فتىً مُتبذّلٍ عاري الأشاجِعِ شاحبٍ كالمُنصلِ
شعثِ المفارقِ مُنْهجٍ سِرْبالهُ لم يَدَّهِنْ حولاً ولمْ يترجَّلِ
لا يكتسيْ إلا الحديدَ إذا اكتسى وكذاكَ كلُّ مغاورٍ مُسْتبْسِلِ
قدْ طالما لَبِسَ الحديدَ فإنّما صدأُ الحديدِ بجلدهِ لم يُغْسَلِ
إن عنترة يلح على الإدلال بالقيم التي يمتلكها، لا بالقيم التي يتوارثها من لا قيمة لهم، ويصرف بصر عبلة عن النظر في ثيابه إلى الفحص عن قلبه، فإن لم يرض بصرها عن شكله ولونه فسترضى بصيرتها عن خلقه:
لا تصْرميني يا عُبيْلُ وراجعي في البَصيرة نظرةَ المُتأمّلِ
ولما كان أثمن ما في الإنسان عقله فعلى عبلة أن تنقب فيه عن هذه الجوهرة الخفية النفيسة، فإذا أعياها الظفر بدماغه فلتنظر إلى أثر الدماغ في السلوك، وقدرته، بعد التمرس بالصعاب، على حل المعضلات:
ذُللٌ رِكابي حَيْثُ شِنْتُ مُشايعي لُبِّي وأُحْفِزْهُ بأمرٍ مُبرمِ
وبعد المفاخر التي قدمها عنترة بين يديه يبدو عقله ونبله أجدى من غباء السراة وجبنهم. والدليل على دعواه أنهم يحتاجون إليه، وهو عنهم غني، وهذه الحاجة تنفح عنترة بلذة عظمى، فكلما أدارها في عقله كبر وصغروا وارتاح لهذه المفارقة، وعدها مفخرة المفاخر:
ولَقَدْ شَفَى نَفسِي وَأَبْرَاً سُقمها قيلُ الفَوارِسِ ويْكَ عَنْترُ أَقدِمِ
لقد أصبح احتماء الكبراء به برهاناً على صغرهم، ودليلا على أن تفاخرهم بالأنساب سراب لا يروي غلة، ورداء كاذب البريق تمزقه الحراب. وها هو ذا عنده الفحل يخلف وراءه المخانيث ذوي الأنساب يترددون ولا يقدمون، ثم يندفع إلى العدو ليدفعه عن أشراف عبس بسيفه البتّار:
وإذا الكتيبةُ أَحْجَمَتْ وتلاحظت أُلفيتُ خَيْراً مِنْ مُعممٍ مُخْولِ
والخيلُ نَعْلَمُ والفَوارِسُ أَنَّني فرَّقْتُ جمَعَهُمُ بِطَعْنَةِ فيصلِ
وربما افتخر عنترة بنسبه، وشفع النسب بالشجاعة وبالذبِّ عن الحمى ليذكر السادة بأنه بعد اعتراف أبيه به غدا فوقهم لا ضريعاً لهم، فهو يفضلهم بالشجاعة، وهم لا يفضلونه بكرم المحتد:
إنِّي امْرَةٌ مِنْ خَيْرٍ عَبْسٍ منصباً شطري وأحمي سائِري بالمنْصلِ
وزبدة القول: إن عنترة خلع على الفخر الفردي نزعة واقعية تتمثل في تقدير الخلق القويم، والعمل النافع لا الأمجاد الموروثة والشرف التليد، فهل معنى ذلك أن عنترة لم يسهم في الفخر القبلي؟
مهما تعظم ذات الفرد في المجتمع القبلي فالقبيلة أعظم، ومهما يشعر البطل بكيانه المتميز فإنه في حومة الوغى، ينتظمه التيار القبلي الواحد، فينسى ظلم الأقربين ليدفع الخطر عن الكيان الجمعي، ويناضل مع قومه، يكرون معاً، ويظفرون معاً. إذا شهروا سيوفهم حصدوا بها سنابل الرؤوس، وإذا داروا حول أعدائهم حسبتهم الرحي تطحن ما يمر بين حجريها من جماجم:
فلَمْ أَرَ حَيَّاً صابَرُ وا مِثْلَ صَبرنا ولا كَافَحُوا مِثْلَ الَّذِينَ نُكَافِحُ
ودُرْنا كَما دَارَتْ على قطبها الَّرحى ودارَتْ عَلى هام الرجالِ الصَّفَائِحُ
تداعَى بَنُو عَبسٍ بِكُلِّ مُهَنّدٍ حسامٍ يُزيلُ الهامَ والصَّفُّ جانِحُ
ولكنه كان يحاول في فخره القبلي أن يكون في موضع القيادة والنجدة، بأمر فيطاع، أو يستنفر فينفر فإما أن تناديه، عبس فيصدع بأمرها وإما أن يناديها فتقاد له. فإذا ظاهره فرسانها كربهم على الأعداء فاستباحهم بالسيوف والرماح وكرام الخيل:
لمَّا سمعْتُ دعاء مرَّة إذ دعا ودُعاءَ عبسٍ في الوغى ومُحلِّل
ناديتُ عبْساً فاستجابوا بالقنا وبكل أبيض صارم لم يَبْخلِ
حتّى استباحوا آل عوفٍ عنوةً بالمَشرفي وبالوشيجِ الذُّبَّلِ
٣) الهجاء
الفخر موصول بالهجو، فما شمخ أنف إلا انطوت الشمخة على الزراية بأنف راغم، صرح بذلك الشاعر أم لمح، ولا استطال بنفسه أو قبيلته إلا تضمنت الاستطالة مقايسة بين عمالقة وأقزام، باح بذلك الشاعر أم جمجم. ولما كان عنترة فارس زمانه فلم يكن يكتفي بالتعريض واللمز، وإنما كان الهجو، موجع الشتم.
هدده عمرو بن أسود وقومه فسخر من رماحهم العتيقة النخرة المكسرة، وقرنهم بالنعام مضرب المثل في الجبن، وجعل فم خصمه عمرو كفم ناقة قبيحة طمس الشعر الكثيف جوارح وجهها:
قدْ أَوْعَدُونيِ بِأَرْمَاحٍ مُعلَّبةٍ سُودٍ لُقِطْنِ من الحَومان أخْلاق
لم يسلبوها، وَلَمْ يُعطوا بها ثمناً أيدي النعام فلا أَسْفاهُم الساقي
عمْرُو بْنُ أَسْوَدَ فا زبّاءَ قاربةٍ ماءَ الكُلابِ عَلَيها الظَّبي معناقِ
وهجا عنترة بني زُبید فرماهم بالضعف والخوف، وسخر من هربهم، إذ ولّوا الأدبار والرماح تجتاح أقفاءهم كما يجتاح اللّهب الهشيم:
لقد وجدنا زبيداً غَيْرَ صَابِرَة يوم التقينا، وَخَيْلُ المَوتِ تستبِقُ
إذْ أَدبَرُوا فَعَمِلنا في ظهورهم ما تَعْمَلُ النَّارُ في الخَلفَى فتَحْترقُ
وكان عنترة في بعض هجائه يأتي بصور ساخرة، تصيب مقتلاً من الخصم. فقد هجا قبيلتين ببيتين قاتلين صور فيهما بني شيبان وبني لام، وقرن وجوه الشيبانيين السوداء بأدبار اللأميين البرصاء، فجاء بمشهد عجيب. ولا تظهر لك شناعة المفارقة بين النقيضين إلا إذا تذكرت أن عنترة كان يمدح بني عبس، فيصف وجوههم بالوضاءة، فإذا انتقلت من تألق النجوم وغرر الظباء في وجوه عبس إلى أقضاء القدر وأدبار البرص أدركت مكيدة الشاعر في قوله يفخر ويسخر:
يَمْشُونَ والمَاذِيُّ فَوْقَهُم يَتَوَقِّدُونَ تَوَقدَ النَّجْمِ
كَمْ مِنْ فَتَى فِيهِمْ أَخي ثِقَةٍ حُرٌّ أغَرَّ كغُرّة الرِّئْمِ
ليْسُوا كَأَقْوَامٍ علمتُهُمُ سودِ الوجوهِ كمِعدنِ البُرْمِ
عجِلتْ بنو شَيْبَانٌ مُدَّتَهُم والبقع أستاها بنو لأم
وإذا كان الشعراء يقرؤون الخوف في الوجوه فعنترة يقرؤه في الأدبار. لقد تعودنا أن نجد الخوف شحوباً في الوجه وقضقضة في الأسنان، وانفغاراً في الأفواه، واتساعاً في الأحداق، أما غريم الشاعر عمارة بن زياد فإنه يعبر عن ذعره بدبره، وعن خشب بأليته، فإذا لقي عنترة وليس معهما ثالث رقصت روانفه رقصة الهلع، وكاد قلبه ينخلع ويطير من صدره:
متى ما تَلْقَنِي فَرْدَيْنِ تَرْجُفْ روانِفُ أَلْيَتَيْكَ وتستطاراً
٤) الغزل
منْ حملَ كل ما في ديوان عنترة على محمل الشعر الصحيح وجد فيه كثيراً من الغزل، ومن ضربه على محك النقد ليوثقه قبل أن يصدقه لم يتحصل له من الديوان كله غير مقدمات من أبيات، أو مقطعات من نسيب فاتر الحسن لا يجد فيها شوق المفارق ولوعة المهجور، وتعلّق المتيم، ولا يجد صورة محبوبة واحدة محددة القسمات، بل بضع نسوة مختلفات الأسماء متباينات الملامح. ولما كنا إلى الرأي الثاني أميل فقد أهملنا كثيراً من غزل الديوان الذي تفوح منه رائحة الوضع، وخالفنا من ذهب إلى أن الغزل أهم الأغراض في شعر عنترة.
أول ما يطالعنا في غزل عنترة مقطّعات يسبقها فراق، ويصحبها تذكّر وعتاب وملاومة. ومن هذه المقطعات أبيات يصف فيها الشاعر سربا من ظباء مر عن يمينه وعن يساره فذكره صاحبته سمراء، فأحس حينئذ أن زندين يقتدحان نار الشوق بين جنبيه فعجز عن كتمان الشوق وباح بحبه الحبيس، ولام صاحبته، لأنها تقسو ويلين وتحقد ويصفح، وتنقد وينصح، وتقابل نصحه بالإعراض:
طربْتَ وهاجتْكَ الظّباءُ السَّوارِحُ غدَاةَ غَدَتْ منها منيح وَبَارِحُ
تغالت بك الأَشْوَاقُ حَتَّى كَأَنما بزنْدينِ في جوفي من الوجْدِ قادِحُ
وقد كُنْتَ تُخْفِي حُبُّ سَمْراءَ حِقْبَةٌ قَبُح لانَ منها بالذي أنت بائح
لعمرِي لَقَدْ أَعْذَرْت لَوْ تَعْذِرِيني وَخَشَنْتِ صَدْرًا جَيْبُهُ لَكِ نَاصِحُ
وفي مقدماته الغزلية القصيرة شكوى من تغير المحبوبة وإحساس بالحرمان والألم. قد أحب عنترة (رَقَاشِ) فأعرضت عنه، ووصلها فقطعته، فمضى يؤنب نفسه المتعلقة بامرأة نائية، تسكن وادياً يألفه الحمام بين قمتي جبل شمام:
نأتْكِ رِقاش إلا عن لِمَامِ وأمسى حَبْلُها خَلَقَ الرَّمَامِ
ومَا ذِكْرِي رقاش إِذا اسْتَقَرَّتْ لدى الطّرفاء عند ابني شَمامِ
وَمَسْكَنُ أَهْلِهَا مِنْ بَطْنِ جَزْعٍ تبيضُ به مصاييفُ الحمامِ
وربما كان نسيب عنترة برقاش ضرباً من التواجد لا الوجد، ولذلك خلا من تصوير المحاسن وتحليل المشاعر. أما أبياته في عبلة فنمط آخر من الغزل، فيه التعلق بفم قبله، وذاق حلاوة رضابه، وانتسم طيب نكهته، فوجده كنافجة المسك، أو كروضة ممطورة، تنشر أرجها العطر كلما افتر ثغرها عن أسنانها المتألقة:
إذْ تَسْتَبِيك بذي غُروب واضح عذبٍ مُقَبِّلهُ لَذِيذ المَطْعَم
وكَأَنها نَظَرَتْ بِعَيْنِي شَادِنٍ رشأً من الغزلان ليس بتوءمِ
وكأنَّ فأرةَ تاجرٍ بقسيمةٍ سَبَقَتْ عَوارِضَهَا إِلَيْكَ مِنَ الفمِ
أَوْ رَوْضَةً أنفاً تَضَمَّنَ نَبْتَها غَيْثُ قَلِيلَ الدَّمْنِ لَيْسَ بِمَعْلَم
ونحن نزعم أن عنترة لم يكن زير نساء كامرىء القيس، ولا خدين عواهر كالأعشى. وإنما كان بطلاً قبل أن يعشق، وأنه أحب عبلة لا سواها بنخوة الفارس لا بشهوة العاشق حنا يرقى برجولته ويرضيه عن نفسه أول الأمر، ويرضى عنه عبلة آخره. فهو لذلك يؤثرها على نساء الأرض، ويهب لحمايتها إذا استصرخته، ولا يراودها عن لذة ترى فيها مساساً بعفّتها:
وَلَئِن سَأَلْتَ بذاك عَبْلَةَ خبرتْ أَنْ لَا أُرِيدُ مِنَ النِّساءِ سواها
وأجيبها إِمَّا دَعَتْ لِعَظِيمَةٍ وأغيثها وأعفُّ عمّا سواها
ونزعم كذلك أن جوهر عشقه الألم والحرمان لأسباب كثيرة أولها الفرق بينه وبين عبلة، فهو عبد أسود مضطهد، وهي حرة بيضاء منعمة. وثانيهما الحسد، فهو يحسد لداته على أنسابهم وحريتهم ولداته يحسدونه على حب عبلة، وثالثها ابتعاد محبوبته عنه وبقاء صورتها معه في السلم والحرب، حتى إنه ليرى فمها في الروضة المعطاء، كما يراه على صفحة السيف المصقول:
فَوَدِدْتُ تقبيل السيوف لأنها لمَعَتْ كَبَارِقِ ثغرِكِ المتبسِّمِ
والرابع اليأس من وصالها والاقتران بها، وهذا اليأس حول هم الشباب إلى غم مقيم في الكهولة من ظفر بعبلة رجل غيره.
خصائصه الفنية
صنف ابن سلام عنترة في شعراء الطبقة السادسة، فجعله في قرن مع عمرو بن كلثوم، والحارث بن حلزة، وسويد بن أبي كاهل. وإذا جاز لنا أن نفاضل بين الأربعة فضلنا عنترة، لأن ملكته بلغته ما بلغ. فقد كان خادم قومه، وكان أقرانه سادة أقوامهم، فحلق بجناح، وحلقوا بجناحين أحدها مستعار حلق عنترة بموهبة فطرية وشجاعة فردية، وحلق الثلاثة بمواهبهم، ثم قدمته إليهم قبائلهم من تأييد وأمجاد موروثة. ولو لم يؤت من قوة الملكة الشاعرة فوفى ما أوتي من القوة الباطشة ما ثبت فى ميدان الشعور ثباته في حلبة الوغى. فما الخصائص الفنية التي تسم شعره؟
١) الصدق والواقعية: لعل أوضح صفة يقف عليها الناظر في شعر عنترة صدق هذا الشعر وواقعيته. فهو صادق في أفكاره مخلص لفلسفته التي يجبه بها مذاهب الآخرين صريح في الدعوة إلى ما يؤمن أنه الحق. فقد رأيته يعبر عن كل شيء حتى عما يسوءه كحديثه عن زراية الرجال به، وإعراض النساء عنه. وما نظنه أنه كان يجد في ذكر هذه الأمور حرجاً عظيماً، وإنما نظن أنه كان يجد فيها لذة، لأنه يذكرها ليدحضها، ويقر بنشأته المتواضعة الأولى ليفخر بما أنجز.
٢) الدقة: والصدق يقتضي الدقة في ترجمة الفكرة، ورسم الصورة، كتقييد الأطلال بأمكنتها وأزمنتها، ورسم جزئيات الموصوف، ورصد ما دق من أعضائه، وخفي من حركاته. ولعل أدق صوره صورة الذباب وهو يحك إحدى يديه بالأخرى كما يقدح النار رجل مخدج (ناقص اليد): هزِجَاً يحُكُّ ذراعَهُ بذراعِهِ قَدْحَ الْمُكِبٌ عَلَ.
٣) سهولة اللغة : في لغة عنترة سهولة ولين ووضوح. فلو قست أسلوبه بأساليب الشعراء في زمانه لوقفت على هذه الخصيصة. ولذلك سهل على الوضاعين في العصور المتأخرة أن يقلدوا شعره ويلحقوا ما اختلقوا بديوانه. ومما يتصل بهذه الخصيصة ما لاحظه الدكتور عبده بدوي، إذ وجد أن قاموس الشاعر يقف بصفة خاصة عند اللونين الأسود والأبيض، ويكثر من كلمات العبد والغراب والمسك والكحل بالإضافة إلى النار والبرق والغضب والسيف والغبار والدم والشرار». ولعل الناقد يرمي من تسجيل هذه الظاهرة إلى ربط شعره بفكره، ولغته بعقدته، وهو ربط مقبول، يشفع الخصيصة التي أشرنا إليها.
أسئلة شائعة
١. من هو عنترة بن شداد وما هو نسبه؟
عنترة بن شداد هو أحد أشهر فرسان وشعراء العصر الجاهلي، ينتمي إلى قبيلة بني عبس. والده هو شداد بن معاوية، وأمه جارية حبشية تدعى زبيبة، ولهذا السبب كان يُعد من “أغربة العرب” بسبب لونه الأسمر ونسبه المختلط.
٢. كيف نال عنترة بن شداد حريته واعتراف أبيه به؟
نال عنترة حريته في موقف بطولي، عندما أغار بعض العرب على قومه، طلب منه أبوه أن يكرّ ويقاتل، فرفض قائلاً “العبد لا يحسن الكر”. فوعده أبوه بالحرية إن هو قاتل، فقاتل عنترة قتال الأبطال، وبعدها اعترف به أبوه شداد وألحقه بنسبه.
٣. هل تزوج عنترة بن شداد من حبيبته عبلة؟
تشير المصادر المذكورة في الدراسة إلى أن عنترة على الأرجح لم يتزوج من عبلة، وأنه ربما مات أعزباً، بينما تزوجت هي من رجل آخر. ظل حبها مصدر إلهام وألم في شعره طوال حياته دون أن يظفر بالزواج منها.
٤. ما هي أبرز السمات التي ميزت شخصية عنترة بن شداد؟
تميزت شخصية عنترة بمجموعة من السمات الفريدة، أهمها الشجاعة المتعقلة التي تمزج بين الإقدام والحذر، والأنفة والزهد في غنائم الحرب، والحلم والرحمة حتى مع أعدائه وجواده، بالإضافة إلى العفة والسيطرة على غرائزه في مجتمع قبلي.
٥. كيف كانت نهاية عنترة بن شداد؟
تعددت الروايات في نهاية عنترة، حيث يذكر كتاب الأغاني ثلاث روايات: إحداها أنه قُتل بسهم من زر بن جابر النبهاني وهو شيخ كبير، والثانية أنه قُتل على يد ربيئة من قبيلة طيء بعد هزيمة قومه، والثالثة أنه مات بسبب عاصفة رملية وهو في طريقه لمقاضاة رجل من غطفان.
٦. ما هي الأغراض الشعرية الرئيسة في شعر عنترة بن شداد؟
تركز شعر عنترة على أربعة أغراض رئيسة هي: الوصف، وبشكل خاص وصف الخيل والمعارك، والفخر بشجاعته وبطولاته الفردية والقبلية، والهجاء اللاذع لخصومه، والغزل العفيف الذي كان معظمه موجهاً إلى حبيبته عبلة.
٧. ما هو سبب نظم عنترة لمعلقته الشهيرة؟
نظم عنترة معلقته رداً على رجل من قومه شتمه وعيّره بلونه ونسب أمه، وادعى أنه أشعر منه. فأنشد عنترة معلقته ليثبت عبقريته الشعرية، ويدافع عن مكانته، ويفخر بفروسيته وأخلاقه أمام منتقديه.
٨. كيف أثر أصل عنترة ولونه على شخصيته وشعره؟
كان لأصله المختلط ولونه الأسمر أثر عميق في تكوين شخصيته، حيث خلق لديه “عقدة السواد” التي دفعته إلى إثبات ذاته بالقوة والشجاعة. ويرى بعض النقاد أن هذا التحدي ساهم في تطور القصيدة العربية بالانتقال من ضمير الجمع إلى ضمير الفرد للفت الأنظار إلى بطولاته الشخصية.
٩. لماذا يعتبر عنترة بن شداد رمزاً خالداً في الوجدان العربي؟
أصبح عنترة رمزاً لأنه جسّد القيم العربية الأصيلة من شجاعة ونبل وعفة، وجمع في شخصيته بين قوة الفارس ورقة العاشق. احتفل به الوجدان العربي كنموذج للبطل الذي يغيث الملهوف ويتصدى للظلم، ويُستلهم في أوقات الشدة.
١٠. ما طبيعة العلاقة التي جمعت عنترة بفرسه؟
كانت علاقته بفرسه تتجاوز علاقة الفارس بجواده، فقد كانت علاقة صداقة ومشاركة وجدانية عميقة. ويظهر ذلك في شعره حيث كان يناجيه ويتحسس آلامه في المعركة، ويتمنى لو كان الجواد قادراً على الكلام ليشتكي إليه، مما يعكس جانباً إنسانياً رقيقاً في شخصيته.