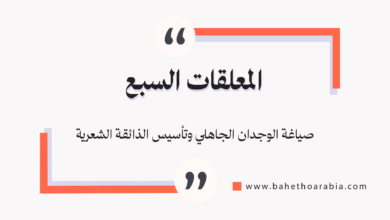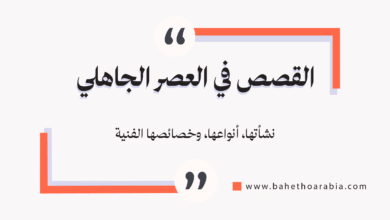الرواية السعودية: رحلة السرد في قلب التحولات الثقافية والاجتماعية

تمثل الرواية السعودية مرآة عاكسة لتاريخ المجتمع وتحولاته، وسجلاً إبداعياً حافلاً بالتجارب الإنسانية العميقة التي نحتت ملامحها عبر ما يقارب القرن من الزمن، مقدمةً خطاباً سردياً ثرياً ومتنوعاً.
تُعد الرواية السعودية اليوم جنساً أدبياً راسخاً يحتل مكانة بارزة في المشهد الثقافي العربي، بعد أن قطعت أشواطاً طويلة منذ بداياتها الأولى. لم تكن رحلة الرواية السعودية مجرد ترف فكري، بل كانت ضرورة فرضتها متطلبات التعبير عن الذات والمجتمع في خضم تغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية كبرى. لقد استطاعت الرواية السعودية أن تكون شاهداً حياً على هذه التحولات، وأن تقدم سرداً موازياً للتاريخ الرسمي، يكشف عن الخبايا والمسكوت عنه، ويغوص في أعماق النفس البشرية وهمومها. إن دراسة مسار الرواية السعودية يكشف عن نضج وعي فني وجمالي لدى كتابها، وقدرتهم على تطويع هذا الفن العالمي ليعبر عن خصوصية التجربة المحلية، بكل ما تحمله من تعقيدات وتناقضات.
النشأة والتأسيس: بذور السرد الأولى
يجمع المؤرخون والنقاد على أن البداية التاريخية للرواية السعودية كانت في عام ١٩٣٠م مع صدور رواية “التوأمان” لعبد القدوس الأنصاري. مثّل هذا العمل، الذي طُبع في دمشق، إرهاصاً مبكراً لولادة فن سردي جديد في بيئة كانت تمنح الأولوية للشعر والمقالة. تناولت “التوأمان” قضية العلاقة الحضارية بين الشرق والغرب من خلال قصة أخوين، أحدهما تلقى تعليماً تقليدياً والآخر تعليماً أجنبياً، لتنتصر في النهاية قيم الأصالة والتقاليد. ورغم ما يؤخذ على الرواية من ضعف فني ونزعة إصلاحية مباشرة، إلا أنها تظل علامة فارقة دشنت مسيرة الرواية السعودية.
تلت هذه البداية أعمال قليلة خلال عقدين من الزمن، اتسمت في مجملها بالخطاب الإصلاحي المباشر والتركيز على القضايا الاجتماعية. من أبرز أعمال هذه المرحلة رواية “فكرة” لأحمد السباعي (١٩٤٨م)، التي قدمت رؤية أكثر انفتاحاً على التغيير الاجتماعي من خلال بطلتها الطامحة لتجاوز واقعها، وتعتبر أول عمل في تاريخ الرواية السعودية يتناول هموم الفتاة وتطلعاتها. وفي العام نفسه، صدرت رواية “البعث” لمحمد علي مغربي، التي تبنت اتجاهاً مناقضاً لـ”التوأمان”، حيث دعت إلى ضرورة الإفادة من الآخر لنقل أدوات النهضة. وقد امتدت هذه المرحلة التي يسميها النقاد “مرحلة النشأة” أو “مرحلة الرواد” من عام ١٩٣٠م إلى منتصف الخمسينيات، وتميزت بقلة الإنتاج الروائي وضعف المستوى الفني العام، حيث لم يتجاوز عدد الروايات الصادرة الأربع. لقد كانت الرواية السعودية في طورها التكويني تبحث عن هويتها وتتحسس طريقها بصعوبة.
مرحلة النضج الفني: نحو وعي جمالي جديد
شكل صدور رواية “ثمن التضحية” لحامد دمنهوري عام ١٩٥٩م نقطة تحول حاسمة في مسيرة الرواية السعودية، حيث أجمع النقاد على اعتبارها البداية الفنية الحقيقية لهذا الجنس الأدبي. نقلت هذه الرواية، التي تأثر صاحبها بالأجواء الإبداعية المصرية خلال فترة دراسته، الرواية السعودية من طور البدايات المتعثرة إلى آفاق النضج الفني. تميزت “ثمن التضحية” بتماسك بنائها، وحرصها على تحقيق المقاييس الفنية المتعارف عليها، والالتصاق بالواقع، وتصوير التحولات الاجتماعية، مما جعل البعض يلقب دمنهوري بـ “أبو الرواية الفنية السعودية”.
شهدت هذه المرحلة، التي تمتد تقريباً من أواخر الخمسينيات إلى نهاية السبعينيات، مجموعة من التحولات الهامة التي أسهمت في تطور الرواية السعودية:
زيادة الإنتاج الروائي: مقارنة بالمرحلة السابقة، شهدت هذه الفترة زيادة واضحة في عدد الروايات المنشورة، مما يدل على تزايد الوعي بأهمية هذا الفن.
التطور الفني الملحوظ: برز اهتمام أكبر بتقنيات السرد الروائي، والعناية ببناء الشخصيات، ورصد العلاقات الإنسانية المعقدة، والاقتراب من لغة الرواية الحديثة بدلاً من اللغة المعجمية. ويبرز في هذا السياق اسم إبراهيم الناصر الحميدان الذي قدم أعمالاً مهمة مثل “ثقب في رداء الليل” (١٩٦١م)، التي تناولت لأول مرة ثنائية القرية والمدينة، و”سفينة الموتى” (١٩٦٩م).
ظهور الرواية النسائية: كانت هذه المرحلة شاهدة على أول مشاركة للمرأة في كتابة الرواية السعودية، حيث تعتبر سميرة خاشقجي رائدة الرواية النسائية بعملها “ودعت آمالي” (١٩٥٩م)، وتبعتها كاتبات أخريات مثل هند باغفار وهدى الرشيد. جاء ظهور الرواية النسائية متأخراً نسبياً بسبب عوامل اجتماعية أبرزها تأخر تعليم المرأة.
تنوع الموضوعات: لم تعد الرواية السعودية مقتصرة على الموضوع التعليمي أو الإصلاحي، بل ظهرت أنواع أخرى كالرواية الواقعية الفنية، والرواية التاريخية مع محمد زارع عقيل في “أمير الحب” (١٩٦٥م)، والرواية العاطفية.
على الرغم من هذا التطور، يرى بعض النقاد أن روايات السبعينيات اتسمت بالضعف الفني وركزت بشكل كبير على علاقة الرجل بالمرأة وأزمات الأسرة. ومع ذلك، فإن هذه المرحلة كانت ضرورية للتراكم الكمي والمعرفي الذي مهد الطريق للانطلاقة الكبرى التي شهدتها الرواية السعودية لاحقاً.
مرحلة الانطلاق والتحولات الكبرى: الطفرة والجرأة
بدءاً من ثمانينيات القرن العشرين، دخلت الرواية السعودية مرحلة جديدة أطلق عليها النقاد “مرحلة الانطلاق”، والتي تلتها “مرحلة التحولات الكبرى” منذ التسعينيات وحتى اليوم. شهدت هذه الفترة طفرة حقيقية على مستوى الكم والنوع، وتنوعاً كبيراً في الموضوعات والأساليب الفنية. ويمكن إرجاع أسباب هذا التحول إلى عدة عوامل متضافرة، منها انتشار التعليم وتطوره، وازدهار الصحافة، والانفتاح على الثقافات الأخرى عبر البعثات والترجمة، إضافة إلى التحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي مر بها المجتمع السعودي.
تميزت هذه المرحلة ببروز أسماء روائية كبيرة أحدثت نقلة نوعية في مسار الرواية السعودية. يعتبر عبد العزيز مشري من أبرز كتاب الثمانينيات، حيث تناولت أعماله مثل “الوسمية” و”الغيوم ومنابت الشجر” بعمق فني قضايا الريف السعودي وصراع القيم بين القرية والمدينة. كما تمثل خماسية عبد الرحمن منيف “مدن الملح” (بدءاً من ١٩٨٤) علامة فارقة في تاريخ الرواية السعودية والعربية، بتقديمها سرداً ملحمياً لتاريخ التحولات الكبرى في المنطقة الناجمة عن اكتشاف النفط، رغم أن النقد المحلي تجاهلها طويلاً لاعتبارات سياسية.
أما فترة التسعينيات، فقد دشنت عصراً جديداً من الجرأة في الطرح وتناول المسكوت عنه. شكلت رواية “شقة الحرية” (١٩٩٤م) لغازي القصيبي، وثلاثية “أطياف الأزقة المهجورة” (بدءاً من ١٩٩٥م) لتركي الحمد، حدثاً ثقافياً أثار جدلاً واسعاً. هاتان التجربتان، القادمتان من خارج حقل السرد التقليدي (القصيبي شاعر والحمد أكاديمي)، كسرتا رتابة السرد السابق وتناولتا موضوعات سياسية واجتماعية وفكرية بحرية غير مسبوقة، مما فتح الباب أمام جيل جديد من الكتاب للخوض في الممنوعات. لقد ساهمت هذه الأعمال في تنامي هامش الحرية في الإنتاج الروائي، وجعلت الرواية السعودية أكثر قدرة على كشف خبايا المجتمع وتاريخه الثقافي والاجتماعي.
الرواية السعودية في الألفية الجديدة: زمن “التسونامي”
مع بداية الألفية الثالثة، شهدت الرواية السعودية ما يشبه “التسونامي” أو “الطفرة”، حيث تزايد عدد الإصدارات بشكل هائل، وبرز عدد كبير من الروائيين والروائيات الجدد. أصبحت الرواية السعودية الجنس الأدبي الأكثر حضوراً ورواجاً، مدفوعة بتغيرات اجتماعية وثقافية، وتوسع دور النشر، وسهولة الوصول إلى المعلومة عبر الإنترنت.
من أبرز سمات هذه المرحلة:
هيمنة الصوت النسائي: شهدت هذه الفترة ازدهاراً غير مسبوق للكتابة النسائية، حتى أن عدد الروائيات الجديدات فاق عددهن الإجمالي في المراحل السابقة. أثارت روايات مثل “بنات الرياض” (٢٠٠٥م) لرجاء الصانع، و”الآخرون” (٢٠٠٦م) لصبا الحرز، و”سعوديات” لسارة العليوي، ضجة إعلامية كبيرة لتناولها عوالم المرأة السعودية وقضاياها بجرأة، مستخدمة تقنيات حديثة مثل البريد الإلكتروني في السرد.
الجرأة في كشف المستور: أصبح “الفضح” أو كشف المستور الاجتماعي والثقافي والسياسي سمة بارزة، بل هدفاً بحد ذاته لدى بعض الكتاب الجدد، مما أثار جدلاً حول القيمة الفنية لهذه الأعمال. تناولت الرواية السعودية موضوعات كانت تعتبر من المحرمات (التابوهات) الثلاثة: الدين والجنس والسياسة.
التجريب الفني: إلى جانب الأعمال ذات البناء التقليدي، ظهرت اتجاهات تجديدية وتجريبية سعت إلى كسر البنية السردية المألوفة، كما في أعمال رجاء عالم التي تمزج بين الواقع والأسطورة والرمز، وأحمد الدويحي.
تأثير التقنية: دخلت وسائل الاتصال الحديثة كالجوال والإنترنت كعناصر فاعلة في بنية العديد من الروايات، وعكست هموم جيل الشباب المعاصر وتفاعله مع العولمة.
لقد أصبحت الرواية السعودية في هذه المرحلة أكثر التصاقاً بالواقع المعاصر، وتعبيراً عن تعدد الأصوات داخل المجتمع. ورغم الانتقادات التي وجهت لبعض الأعمال بالهشاشة الفنية والتركيز على الإثارة، إلا أن هذه الطفرة الكمية أفرزت تجارب نوعية مهمة وأسماء لامعة مثل عبده خال، محمد حسن علوان، يوسف المحيميد، ليلى الجهني، وأميمة الخميس، الذين أثروا المشهد السردي بأعمال ناضجة فنياً وفكرياً.
الرواية النسائية السعودية: صوت الذات في مواجهة المجتمع
تحتل الرواية النسائية السعودية مكانة خاصة ضمن المشهد السردي العام، ليس فقط لكونها بدأت متأخرة عن نظيرتها الرجالية، بل لطبيعة القضايا التي حملتها والمسار الذي قطعته. منذ البدايات الأولى مع سميرة خاشقجي في أواخر الخمسينيات، كانت الرواية النسائية السعودية مثقلة بالهم الاجتماعي، وبهاجس الدفاع عن حقوق المرأة في مجتمع ذكوري.
مرت الرواية النسائية السعودية بمراحل تطور مشابهة للرواية السعودية بشكل عام، لكن بخصوصية واضحة. ففي مرحلة التأسيس (الستينيات والسبعينيات)، كانت الكاتبات مثل سميرة خاشقجي وهدى الرشيد وهند باغفار قد تلقين تعليمهن وثقافتهن خارج المملكة، مما انعكس على أعمالهن التي استفادت من بيئات ثقافية أكثر انفتاحاً. أما مرحلة النضج والتجريب (الثمانينيات والتسعينيات)، فقد شهدت ظهور كاتبات نشأن وتثقفن داخل المملكة، مثل رجاء عالم وليلى الجهني، وقدمن أعمالاً أكثر عمقاً وتجذراً في الواقع المحلي، مع اهتمام أكبر بالبناء الفني واللغة الشعرية وتوظيف الأسطورة.
مع بداية الألفية، دخلت الرواية النسائية السعودية مرحلة “الثورة” أو “الجرأة في الطرح”، حيث ارتفع صوت المرأة الروائية بشكل غير مسبوق، وتناولت قضايا المسكوت عنه في العلاقات الاجتماعية والأسرية والجنسية. ورغم أن بعض النقاد رأوا أن هذا التركيز على “الفضفضة” وكشف المستور جاء أحياناً على حساب القيمة الفنية، إلا أنه لا يمكن إنكار أن الرواية النسائية السعودية لعبت دوراً تنويرياً مهماً في كشف إشكاليات الذات الساردة وعلاقتها المعقدة بالآخر والمجتمع. لقد كانت الكتابة الروائية بالنسبة للمرأة السعودية وسيلة لاستكشاف الذات، ومواجهة السلطة الذكورية، وإعادة كتابة تاريخها الخاص.
العالمية والترجمة: الرواية السعودية تعبر الحدود
لم تعد الرواية السعودية حبيسة حدودها المحلية، بل استطاعت في العقود الأخيرة أن تعبر إلى العالمية من خلال الترجمة، وأن تحظى باهتمام القارئ والنقاد في الغرب. كان هناك دافعان رئيسيان وراء ترجمة الرواية السعودية: الأول هو الجوائز الأدبية المرموقة، والثاني هو طبيعة الموضوعات “المثيرة للجدل” التي تناولتها بعض الأعمال.
لعبت الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) دوراً محورياً في لفت انتباه دور النشر العالمية إلى الرواية السعودية. فوز رواية “ترمي بشرر” لعبده خال بالجائزة عام ٢٠١٠، و”طوق الحمام” لرجاء عالم عام ٢٠١١، و”موت صغير” لمحمد حسن علوان عام ٢٠١٧، لم يمنح هذه الأعمال قيمة إضافية فحسب، بل فتح الباب لترجمتها إلى لغات متعددة كالإنجليزية والفرنسية.
من جهة أخرى، اجتذبت الروايات التي تناولت قضايا حساسة في المجتمع السعودي اهتمام المترجمين والناشرين الغربيين. روايات مثل “شقة الحرية” لغازي القصيبي، وثلاثية تركي الحمد، وبشكل خاص “بنات الرياض” لرجاء الصانع التي تُرجمت إلى أكثر من ٤٠ لغة، وجدت طريقها إلى القارئ العالمي بسبب جرأتها في تصوير الصراعات الاجتماعية والدينية والسياسية في مجتمع يوصف غالباً بـ”المحافظ”.
ومع إطلاق هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية لمبادرات مثل “ترجم”، دخل ملف ترجمة الرواية السعودية مرحلة جديدة ومؤسسية، تهدف إلى تقديم صورة أكثر شمولية وتنوعاً للأدب السعودي، تتجاوز مجرد الأعمال المثيرة للجدل أو الفائزة بالجوائز. إن ترجمة الرواية السعودية لا تمثل جسراً للتواصل الثقافي فحسب، بل هي أيضاً أداة لإعادة رسم مكانة الأدب السعودي في السوق الأدبي العالمي.
الحركة النقدية والمؤسسات الثقافية: مواكبة ودعم
واكبت الحركة النقدية مسيرة الرواية السعودية منذ بداياتها، وإن كانت قد اتخذت أشكالاً مختلفة عبر الزمن. بدأت الممارسات النقدية الأولى في شكل مقالات صحفية انطباعية، ثم تطورت لتأخذ طابعاً أكاديمياً مع نشأة الجامعات وظهور جيل من النقاد المتخصصين. يمكن رصد اتجاهات نقدية متعددة تناولت الرواية السعودية، منها المنهج التاريخي الذي ركز على التأريخ والتوثيق، والمنهج الاجتماعي الذي حلل علاقة الرواية بالواقع، وصولاً إلى المناهج النصية الحديثة كالبنيوية والسيميائية والنقد الثقافي التي اهتمت بالبناء الفني والجمالي للنص ودراسة الأنساق الثقافية المضمرة فيه. ومن أبرز أسماء النقاد الذين تناولوا الرواية السعودية بالدرس والتحليل: منصور الحازمي، سلطان القحطاني، حسن النعمي، عبد الله الغذامي، سعد البازعي، محمد صالح الشنطي وغيرهم.
على صعيد المؤسسات، لعبت الأندية الأدبية دوراً تاريخياً في دعم الأدباء السعوديين، بما في ذلك الروائيون، من خلال تنظيم الفعاليات والملتقيات النقدية ونشر الأعمال الإبداعية. وفي السنوات الأخيرة، ومع إطلاق رؤية المملكة ٢٠٣٠، اكتسب القطاع الثقافي أهمية استراتيجية كبرى، وأصبحت المؤسسات الثقافية الرسمية لاعباً رئيسياً في دعم الإبداع. أنشأت وزارة الثقافة هيئات متخصصة مثل هيئة الأدب والنشر والترجمة، التي أطلقت مبادرات وبرامج لدعم الكتاب والناشرين وتحفيز حركة الترجمة. كما يساهم صندوق التنمية الثقافي في تمويل المشاريع الثقافية، بما فيها المشاريع المتعلقة بالرواية، مما يخلق بيئة أكثر تحفيزاً للاستثمار في هذا القطاع الحيوي. هذا الدعم المؤسسي يفتح آفاقاً واعدة لمستقبل الرواية السعودية، ويعزز من حضورها المحلي والعالمي.
في الختام، يمكن القول إن مسيرة الرواية السعودية هي قصة نجاح أدبي وثقافي بامتياز. لقد استطاعت أن تتطور من بدايات متواضعة إلى أن أصبحت فناً ناضجاً، قادراً على التعبير عن أعقد القضايا الإنسانية والاجتماعية بأساليب فنية متنوعة. إن الرواية السعودية لم تكن مجرد انعكاس للواقع، بل كانت أيضاً قوة فاعلة في تشكيله، عبر طرح الأسئلة الجريئة، وتحدي المسلمات، وفتح نوافذ جديدة على الفكر والجمال. ومع استمرار ظهور أجيال جديدة من الكتاب والكاتبات، وتزايد الدعم المؤسسي، فإن الرواية السعودية مرشحة لمزيد من التألق والإبداع في المستقبل.
سؤال وجواب
١- ما العمل الذي يُعد البداية التاريخية للرواية السعودية؟
تُعد رواية “التوأمان” لعبد القدوس الأنصاري الصادرة عام ١٩٣٠م البداية التاريخية للرواية السعودية، وقد تناولت العلاقة الحضارية بين الشرق والغرب.
٢- ما الرواية التي يعتبرها النقاد البداية الفنية الحقيقية للرواية السعودية؟
رواية “ثمن التضحية” لحامد دمنهوري الصادرة عام ١٩٥٩م، والتي تميزت بتماسك بنائها الفني والتصاقها بالواقع، مما نقل الرواية السعودية إلى مرحلة النضج.
٣- من هي رائدة الرواية النسائية السعودية وما هو عملها الأول؟
تعتبر سميرة خاشقجي رائدة الرواية النسائية السعودية، وعملها الأول هو رواية “ودعت آمالي” التي صدرت عام ١٩٥٩م.
٤- بماذا تميزت مرحلة التسعينيات في مسار الرواية السعودية؟
تميزت بالجرأة غير المسبوقة في طرح الموضوعات السياسية والاجتماعية والفكرية المسكوت عنها، وبرزت فيها أعمال مثل “شقة الحرية” لغازي القصيبي وثلاثية تركي الحمد.
٥- ما أبرز سمات الرواية السعودية في الألفية الجديدة؟
من أبرز سماتها الطفرة الكمية في الإصدارات، وهيمنة الصوت النسائي، والجرأة في كشف المستور الاجتماعي، والتجريب الفني، وتأثير وسائل التقنية الحديثة على السرد.
٦- كيف وصلت الرواية السعودية إلى العالمية؟
عبرت الرواية السعودية إلى العالمية من خلال عاملين رئيسيين: فوز أعمال روائية بجوائز أدبية مرموقة مثل الجائزة العالمية للرواية العربية، وترجمة الأعمال ذات الطرح الجريء.
٧- ما أهمية خماسية “مدن الملح” لعبد الرحمن منيف؟
تكمن أهميتها في كونها عملاً ملحمياً فارقاً في تاريخ الرواية العربية، حيث قدمت سرداً عميقاً للتحولات الكبرى التي أحدثها اكتشاف النفط في المنطقة.
٨- كيف تطورت الحركة النقدية المواكبة للرواية السعودية؟
تطورت من مقالات صحفية انطباعية في بداياتها إلى حركة نقدية أكاديمية متخصصة في الجامعات، تستخدم مناهج تحليلية حديثة لدراسة النصوص الروائية.
٩- ما الدور الذي تلعبه المؤسسات الثقافية الرسمية حالياً؟
تلعب دوراً استراتيجياً في دعم الرواية السعودية من خلال هيئات متخصصة مثل هيئة الأدب والنشر والترجمة، التي تقدم الدعم المادي وتطلق مبادرات لتعزيز النشر والترجمة.
١٠- ما الموضوعات التي كانت تعتبر من المحرمات وتناولتها الرواية السعودية الحديثة؟
تناولت الرواية السعودية الحديثة بجرأة الموضوعات التي كانت تعد من المحرمات (التابوهات) الثلاثة، وهي: الدين، والجنس، والسياسة، كاشفةً بذلك عن خبايا المجتمع وتحولاته.