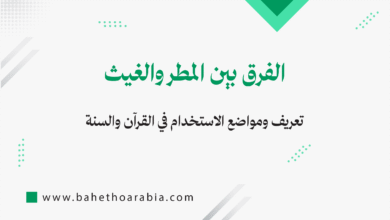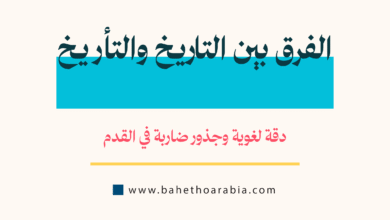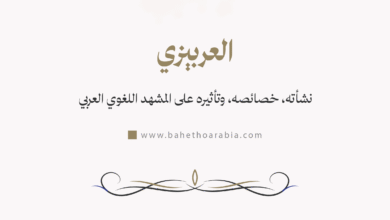الفرق بين الصهر والنسيب والنسب: في اللغة والقرآن
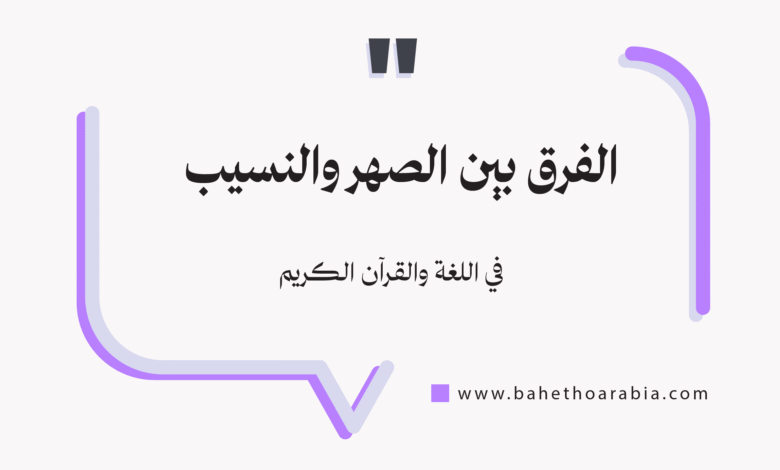
تزخر اللغة العربية بثراء فريد في تحديد العلاقات الإنسانية، وتضع لكل رابطة اجتماعية مصطلحًا دقيقًا يعبر عن جوهرها وعمقها. ومن بين أهم هذه الروابط التي تشكل نسيج المجتمع، تبرز مصطلحات “النَّسَب” و”الصِّهْر” و”النَّسِيب”، التي لا تقتصر دلالتها على المعنى اللغوي فحسب، بل تمتد لتكتسب أبعادًا تشريعية واجتماعية عميقة، خاصة في ضوء تفسير الآية الكريمة من سورة الفرقان.
التعريف اللغوي: جذور المعاني
قبل الخوض في التفسيرات المتعددة، لا بد من فهم الأصل اللغوي لهذه المصطلحات:
- النَّسَبُ: هو الأصل والأساس، ويشير إلى القرابة الناشئة عن الولادة والدم. وقد خصه البعض بقرابة الآباء، بينما توسع آخرون كابن السِّكِّيتِ ليشمل قرابة الأم والأب معًا. فالنسب هو رابطة الدم التي لا اختيار للإنسان فيها.
- النَّسِيبُ: هو الشخص الذي يرتبط بك برابطة النسب، فهو “المناسب” لك. ويُطلق أيضًا على الرجل ذي الحسب والمكانة الرفيعة. وجمعه “نُسَباء” و”أَنْسِباء”.
- الصِّهْرُ: هو القرابة التي تنشأ عن طريق الزواج. وأصل الكلمة يدل على “الاختلاط” أو “الملاصقة”، وهو وصف بليغ لما يحدث عند المصاهرة من امتزاج العائلتين وتكوين رابطة جديدة. ويطلق الصهر على زوج البنت، وزوج الأخت، وكذلك أقارب الزوجة كأبيها وأخيها.
النسب والصهر في القرآن: ركيزتا البناء الاجتماعي
يضع القرآن الكريم هذين المفهومين في منزلة سامية كأساسين لتكوين البشرية وتماسكها، وذلك في قوله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} (الفرقان: 54). فالإنسان، الذي خُلق من ماء مهين، تتشعب علاقاته وتتأسس حياته الاجتماعية عبر هاتين الدائرتين: دائرة الدم (النسب) ودائرة الزواج (الصهر). وقد تعددت آراء المفسرين في تحديد المقصود الدقيق بهما في هذه الآية، ويمكن تلخيصها في أبرز الاتجاهات التالية:
1. التفسير التشريعي (رأي ابن عباس والجمهور):
وهو التفسير الأشهر والأكثر قبولًا، ويربط بين النسب والصهر وبين أحكام الزواج والمحارم. ووفقًا لهذا الرأي:
- النَّسَب: يشير إلى المحرمات من النساء بسبب قرابة الدم، وهن سبع ذكرهن القرآن: الأمهات، والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت.
- الصِّهْر: يشير إلى المحرمات من النساء بسبب المصاهرة أو الرضاع، وهن سبع كذلك: أمهات الزوجات، والربائب (بنات الزوجة)، وزوجات الأبناء، والجمع بين الأختين، وأمهات الرضاعة، والأخوات من الرضاعة، وزوجات الآباء.
وهذا التفسير يوضح كيف أن الله تعالى بنى المجتمع على شبكة من العلاقات المحرمة التي تحفظ النقاء وتمنع الفوضى، وأخرى محللة تبني أسرًا جديدة.
2. التفسير اللغوي العام:
يرى بعض أئمة اللغة أن الفرق أبسط من ذلك وأكثر مباشرة:
- النَّسَب: هو ما يرجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء.
- الصِّهْر: هو ما كان من علاقة تشبه القرابة يحدثها الزواج.
وبهذا يكون المعنى: أن الله خلق الإنسان ثم جعل علاقاته تتفرع إلى فرعين رئيسيين: قرابة الولادة وقرابة النكاح.
3. التفسير القائم على الجنس:
طرح بعض المفسرين رأيًا لطيفًا مفاده أن الآية تقسم البشر إلى قسمين:
- ذوي نسب (الذكور): فهم الذين يُنسب إليهم، فيقال: فلان بن فلان.
- ذوات صهر (الإناث): فهن اللاتي يتم من خلالهن عقد روابط المصاهرة مع العائلات الأخرى.
4. آراء أخرى (الفراء والزجاج):
قدم بعض اللغويين القدامى تفسيرات مختلفة خالفت رأي الجمهور. فقد رأى الفراء أن النسب هو القرابة التي يحل نكاحها (كبنات العم والخال)، بينما الصهر هو ما لا يحل. وهذا الرأي يخالف تفسير ابن عباس تمامًا. أما الزجاج فاعتبر أن الأصهار هم الأقارب من النسب الذين لا يجوز الزواج بهم، مما يجعل تفسيره أقرب إلى تفسير الجمهور.
دقة التفريق: الصهر، والأختان، والأحماء
لم تكتفِ اللغة العربية بوضع مصطلح “الصهر” للعلاقة الناشئة عن الزواج، بل فصلت في فروعه بدقة:
- الأصهار: يُستخدم هذا المصطلح غالبًا ككلمة جامعة تشمل أقارب الزوج والزوجة معًا.
- الأختان: يُطلق هذا المصطلح بشكل أدق على أهل بيت الزوجة (أبوها وأخوها…).
- الأحماء: يُطلق على أهل بيت الزوج (أبوه وأخوه…).
وقد حقق بعضهم الأمر بأن “الصهر” هو اللفظ الذي يجمع “الأختان” و”الأحماء” تحته. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: “أَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَخَتْنِي وَأَبُو وَلَدِي”، حيث إن “الختن” هو زوج الابنة، وهو من أهل بيت الرجل.
خلاصة
إن مصطلحات النسب والصهر والنسيب ليست مجرد كلمات في معجم، بل هي مفاتيح لفهم البنية الاجتماعية التي أرادها الله للإنسان. فالنسب هو رباط الدم الفطري، والصهر هو رباط الميثاق المكتسب، وبهما معًا تتوسع الدوائر، وتتشابك الأواصر، ويتحقق التعارف والتكافل بين الناس. لقد أظهرت الآية الكريمة واللغة العربية بعمقها أن قيام المجتمع البشري واستقراره يرتكز على هذين الجناحين: جناح الدم الذي يمنح الأصالة، وجناح المصاهرة الذي يمنح الامتداد.
سؤال وجواب
1. ما هو الفرق الجوهري والمباشر بين “النَّسَب” و”الصِّهْر”؟
الإجابة: الفرق الجوهري هو أن “النسب” قرابة فطرية قائمة على الولادة والدم، بينما “الصهر” قرابة مكتسبة تنشأ بسبب عقد الزواج.
بشكل أكاديمي، يُعرّف النسب بأنه العلاقة التي ترجع إلى ولادة قريبة من جهة الآباء (أو الآباء والأمهات معًا كما ذكر ابن السكيت)، وهي علاقة لا اختيار للإنسان فيها. أما الصهر، فأصله اللغوي من “الاختلاط” أو “الملاصقة”، وهو مصطلح يصف بدقة تلك الرابطة الجديدة التي تحدثها المصاهرة، حيث يختلط أهل الزوجين وتتكون شبكة علاقات لم تكن موجودة من قبل. فالنسب أصل، والصهر فرع يتأسس عليه.
2. كيف فسّر جمهور العلماء، وعلى رأسهم ابن عباس، قوله تعالى: {فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا}؟
الإجابة: فسّر جمهور العلماء الآية تفسيرًا تشريعيًا، حيث ربطوا “النسب” بالمحرمات بسبب قرابة الدم، و”الصهر” بالمحرمات بسبب المصاهرة والرضاع.
التفسير الذي استقر عليه الجمهور، والمروي عن ابن عباس، يفصّل الآية بناءً على أحكام النكاح في سورة النساء. وبناءً عليه:
- النسب: يشمل المحرمات السبع بالولادة: (الأمهات، البنات، الأخوات، العمات، الخالات، بنات الأخ، بنات الأخت).
- الصهر: يشمل المحرمات السبع بالسبب المكتسب (الزواج أو الرضاع): (أمهات الزوجات، الربائب، زوجات الأبناء، الجمع بين الأختين، أمهات الرضاعة، الأخوات من الرضاعة، وزوجات الآباء).
وهذا التفسير هو الأصح والأكثر اعتمادًا لأنه يربط الآية بأحكام الشريعة العملية بشكل مباشر ومتكامل.
3. هل هناك تفسيرات أخرى للآية تختلف عن رأي الجمهور؟
الإجابة: نعم، هناك تفسيرات لغوية أخرى خالفت رأي الجمهور، أبرزها رأي الفَرَّاء والزجاج، بالإضافة إلى تفسير يربط بين النسب والصهر وجنس المولود.
خالف بعض اللغويين التفسير التشريعي السائد، ومن أبرز هذه الآراء:
- رأي الفَرَّاء: اعتبر أن النسب هو ما يحل نكاحه من الأقارب (كبنات العم والخال)، والصهر هو ما لا يحل نكاحه. وهو رأي معاكس تمامًا لتفسير ابن عباس.
- رأي الزَّجَّاج: رأى أن الأصهار هم الأقارب من النسب الذين لا يجوز الزواج بهم، مما يجعل تفسيره أقرب إلى تفسير الجمهور ولكن بمصطلحات مختلفة.
- تفسير قائم على الجنس: يرى أن الله قسم البشر إلى قسمين: ذكور (ذوي نسب) يُنسب إليهم، وإناث (ذوات صهر) يُصاهر بهن، أي يتم من خلالهن إنشاء علاقات المصاهرة.
4. ما الدقة اللغوية في التفريق بين “الأصهار” و”الأختان” و”الأحماء”؟
الإجابة: “الأصهار” هو المصطلح العام الذي يشمل أقارب الزوجين معًا، بينما “الأختان” هم أهل الزوجة تحديدًا، و”الأحماء” هم أهل الزوج تحديدًا.
هذا التفصيل الدقيق يعكس ثراء اللغة العربية في تحديد العلاقات. التحقيق اللغوي الذي أورده العلماء كالأصمعي وابن الأعرابي يفيد بالآتي:
- الأحماء (مفردها حمو): هم أقارب الزوج، مثل أبيه وأخيه.
- الأختان (مفردها خَتَن): هم أقارب الزوجة، مثل أبيها وأخيها.
- الصهر (وجمعه أصهار): هو اللفظ الجامع الذي يصح إطلاقه على المجموعتين. فالأصمعي يرى أنه يشمل أهل الزوجين معًا، وهو القول الأرجح لأن المصاهرة فعل مشترك يخلط بين العائلتين.
5. هل يمكن إطلاق لفظ “أصهار” على ذوي النسب (مثل الأعمام والأخوال)؟
الإجابة: في الاستخدام الدقيق، لا. لكن يمكن أن يُستخدم اللفظ على سبيل التوسع والتجوز ليشمل كل قريب ذي حرمة.
الأصل أن “الصهر” يطلق على القرابة الناشئة عن الزواج. لكن ورد أنه “قد يقال لأهل النسب والصهر جميعًا: أصهار”، وهذا من باب التوسع في الدلالة. كما ذكر ابن الأعرابي أن الرجل يكون “مُصْهِرًا بنا” إذا كان متحرمًا منهم إما بتزوج أو بنسب أو حتى بجوار. هذا يدل على أن جوهر الصهر هو علاقة الحرمة والاحترام التي تجمع بين طرفين، وإن كان أصلها وأشهر استخداماتها في علاقة الزواج.
6. ما المعنى الأصلي (الإيتمولوجي) لكلمة “صِهْر” وكيف يؤثر على فهم المصطلح؟
الإجابة: أصل كلمة “صهر” في اللغة يدور حول معنيي “الاختلاط” و”الملاصقة”، وهو ما يعكس جوهر علاقة المصاهرة.
فهم الجذر اللغوي يوضح الحكمة من التسمية. المصاهرة سُميت صهرًا لما فيها من:
- الاختلاط: حيث تختلط العائلتان وتتداخل أنسابهما وتنشأ بينهما روابط اجتماعية واقتصادية جديدة.
- الملاصقة: لأنها علاقة قوية تجعل كل طرف قريبًا وملاصقًا للآخر، وتفرض حقوقًا وواجبات تشبه حقوق قرابة الدم.
وهذا الأصل اللغوي يبرز أن المصاهرة ليست مجرد عقد قانوني، بل هي عملية اندماج اجتماعي عميقة.
7. ما هو موقع “النَّسِيب” بين مصطلحي “النَّسَب” و”الصِّهْر”؟
الإجابة: “النسيب” هو صفة للشخص المرتبط بك بـ”نسب”، وهو لا يرتبط مباشرة بمصطلح “الصهر”.
النسيب هو “المناسب” لك، أي من يجمعك به نسب. ويطلق على الشخص نفسه، فيقال: “فلان نسِيبي”، وجمعها “أنسبائي”. كما يحمل المصطلح دلالة اجتماعية إضافية، إذ يُطلق على الرجل “النسيب” بمعنى “ذو الحسب والمكانة”. لذلك، فالنسيب هو وصف للفرد المنتمي إلى نسب معين، بينما النسب هو اسم العلاقة نفسها، والصهر هو علاقة من نوع آخر تمامًا.
8. هل تدخل قرابة الرضاع ضمن مفهوم “الصهر” حسب التفسيرات المذكورة؟
الإجابة: نعم، حسب التفسير التشريعي المعتمد لابن عباس، تدخل المحرمات بالرضاع ضمن دائرة الصهر.
على الرغم من أن الضحاك قال إن الصهر هو قرابة الرضاع حصرًا، فإن الرأي الراجح الذي تبناه جمهور المفسرين هو أن “الصهر” في آية الفرقان يشمل كل ما حرم بالسبب المكتسب، لا بالولادة. وبما أن النبي ﷺ قال: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب”، فقد أُلحقت المحرمات بالرضاع (الأم المرضعة والأخت من الرضاعة) بالمحرمات بسبب المصاهرة، واعتُبرت جميعها من قسم “الصهر” في مقابل “النسب”.
9. ما الحكمة الإلهية من خلق البشر وجعلهم “نسبًا وصهرًا”؟
الإجابة: الحكمة هي بناء مجتمع إنساني متماسك وممتد، يقوم على رابطتين متكاملتين: رابطة الدم التي تضمن الأصالة والانتماء، ورابطة الزواج التي تضمن التوسع والتعارف.
الآية الكريمة {وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا} تختتم ببيان القدرة الإلهية في هذا النظام الاجتماعي البديع. فلو اقتصرت العلاقات على النسب فقط، لأصبحت المجتمعات عشائر منغلقة ومتناحرة. ولو كانت كلها مصاهرة بلا نسب، لضاع الأصل والانتماء. فجاء النظام الإلهي متوازنًا:
- النسب: يوفر الدعم الفطري والعصبة الأولى.
- الصهر: يكسر العزلة، ويجدد الدماء، وينشئ تحالفات وروابط جديدة، محققًا قوله تعالى: {وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا}.
10. هل المصطلحات المذكورة (أختان، أحماء) ما زالت مستخدمة بنفس الدقة في اللغة المعاصرة؟
الإجابة: غالبًا لا. في اللغة العربية المعاصرة، طغى استخدام كلمة “أصهار” و”أنسباء” على المصطلحات الدقيقة مثل “أختان” و”أحماء”.
في الاستخدام اليومي، أصبح من الشائع إطلاق كلمة “أصهار” على أقارب الزوج والزوجة معًا، أو استخدام كلمة “أنسباء” بشكل عام لوصف عائلة الزوج أو الزوجة. أما مصطلحات “الأختان” و”الأحماء”، فقد أصبحت تقتصر بشكل كبير على النصوص التراثية وكتب الفقه واللغة المتخصصة، وقلّ استخدامها في الخطاب العام، مما يمثل تغيرًا طبيعيًا في تطور اللغة الحية وتبسيطها.