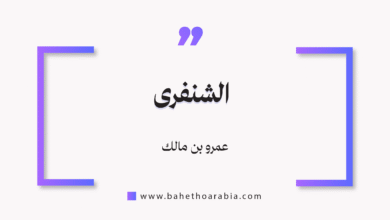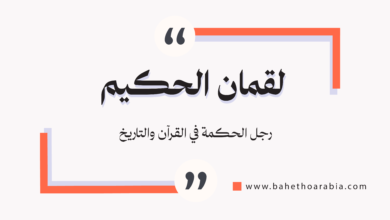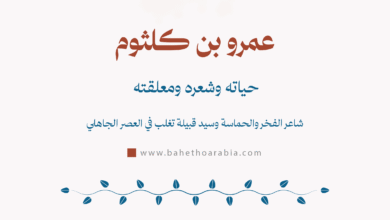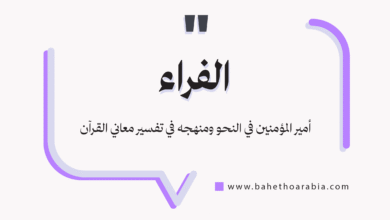النابغة الذبياني: حياته، وديوانه ومعلقته، وأغراض شعره ومنزلته
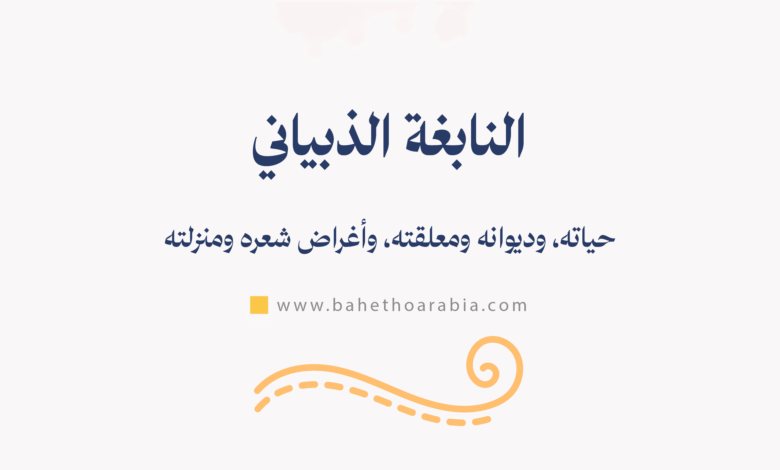
تتناول هذه الدراسة الأكاديمية شخصية الشاعر النابغة الذبياني بالتحليل المعمق، مستعرضةً مسيرته الحياتية، ومكانة ديوانه ومعلقته الشهيرة. كما تسلط الضوء على الأغراض الشعرية التي برع فيها النابغة الذبياني، كالمدح والاعتذار والغزل والوصف والرثاء والهجاء، وصولًا إلى تحديد منزلته الفنية الرفيعة، مع تقديم مختارات من إبداعاته الشعرية التي خلدت اسم النابغة الذبياني في تاريخ الأدب العربي.
حياة النابغة الذبياني
يُعَدُّ لقب “النابغة” تسمية أُطلقت على عدد من الشعراء، أبرزهم النابغة الذبياني والنابغة الجعدي والنابغة الشيباني، ويُجمع النقاد على أن شاعرنا النابغة الذبياني هو الأشهر والأقدر شعريًا بين الثلاثة.
يُعرف النابغة الذبياني بأبي أمامة زياد بن معاوية، ويمتد نسبه إلى ذبيان فغطفان. وقد لُقِّب بالنابغة لأنه أظهر نبوغًا في قول الشعر بعد تقدمه في السن. أما مراحل طفولته وصباه وشبابه، فهي ثلاث فترات تكتنفها الضبابية في سيرة النابغة الذبياني الحياتية، حيث لم تقدم كتب الأدب تفصيلاً يوضحها، باستثناء إشارة إلى تعلقه بامرأة تُدعى ماوية، والتي تعلق بها حاتم الطائي أيضًا، فكانت في النهاية من نصيب حاتم.
يتضمن ديوان النابغة الذبياني إشارات وقصائد تعكس مكانة الشاعر المرموقة في قومه، وتكشف عن مدى إكبارهم له ولشعره. ولعل السمة الأبرز في حياة النابغة الذبياني تتمثل في علاقته بالمناذرة والغساسنة، وقدرته على إقامة صلات وثيقة مع هاتين المملكتين المتنافستين.
سبق وأن أُشير إلى أن المناذرة قد أقاموا دولتهم في جنوبي العراق، متخذين من الحيرة عاصمة لهم، بينما بسط الغساسنة سلطانهم على الشام، وجعلوا من جِلَّق حاضرتهم. ومن الجدير بالذكر أن القسم الغربي من هضبة نجد كان موطن قبائل غطفان الثلاث: ذبيان، وعبس، وفزارة. وقد كانت مضارب قبيلة ذبيان التي ينتمي إليها النابغة الذبياني أقرب إلى الحيرة وجِلَّق من مضارب قبيلتي عبس وفزارة.
ويُحتمل أن هذا القرب الجغرافي قد أتاح لذبيان فرصة الاتصال بحاضرتي الإمارتين، ومكّن النابغة الذبياني من أن يكون على رأس المتصلين بأمراء الحيرة وجِلَّق، وأن يوظف هذه الصلة لما فيه منفعته ومنفعة قومه.
وقد ذهب الدكتور محمد زكي العشماوي إلى أن مضارب ذبيان في وادي الشربة كانت أقرب إلى جِلَّق منها إلى الحيرة، وأن النابغة الذبياني، بفضل هذا القرب وعوامل أخرى، قد اتصل بالغساسنة قبل اتصاله بالمناذرة. وعلى الرغم من تبنينا لهذا الرأي، لم نعثر على أخبار مفصلة توضح طبيعة هذه الصلة المبكرة.
اتصل النابغة الذبياني ببلاط الحيرة حوالي عام ٥٣٠م (أي سنة ٩٢ قبل الهجرة)، وربطته بأميرها المنذر بن ماء السماء علاقات وثيقة. وعندما ارتقى عمرو بن هند عرش الحيرة في عام (٥٥٤م)، وقعت جفوة بين الشاعر والأمير، مما أجبر الشاعر على مغادرة الحيرة والرحيل إلى جِلَّق. وبعد مقتل عمرو بن هند على يد عمرو بن كلثوم، عاد النابغة الذبياني إلى المناذرة واتصل بأميرهم أبي قابوس النعمان بن المنذر، حيث خصه بمدائحه، فنال لديه ثروة ومكانة وشهرة واسعة.
إلا أن صفو الحياة لم يدم طويلاً، إذ سرعان ما اعتكر، فغضب الأمير على الشاعر النابغة الذبياني وجفاه. وقد اختلفت آراء الدارسين في تفسير أسباب غضب النعمان. فقيل إن النابغة الذبياني رأى زوجة الأمير متجردة من ثيابها، فوصفها وتغزل بها غزلًا حسيًا يعدد مفاتنها. وقيل أيضًا إن النابغة الذبياني تطاول على الأمير واجترأ على هجائه. وهناك رأي ثالث يرجح أن خصوم النابغة الذبياني قد حسدوه على مكانته عند الأمير، فأوغروا صدره عليه، ونسبوا إليه ما لم يقله وما لم يفعله. نتيجة لذلك، خاف الشاعر ولاذ ببلاط الغساسنة خشية انتقام النعمان. وربما كان رحيل النابغة الذبياني إلى الغساسنة أشد وطأة على النعمان من الجرائر التي اتهمه بها الحساد، فأرسل إليه قائلاً: «إنك صرت إلى قوم قتلوا جدي، فأقمت فيهم تمدحهم». ويعلق الدكتور العشماوي على ذلك بقوله: «وواضح بالضرورة أن هؤلاء الملوك ليسوا إلا أعداء النعمان ومنافسيه، بل أعداء أسرة المناذرة منذ القدم. وكان طبيعيًا أن يثور النعمان ويغضب لعلاقة النابغة الذبياني بغسان ومدحهم والتقرب منهم. وكان ذلك يؤذيه أشد الأذى».
وعلى الرغم من أن النابغة الذبياني كان يمدح الغساسنة ويتقلب في نعيمهم، فإنه لم يستطع نسيان أبي قابوس. ولا يُستبعد أن يكون مدحه للغساسنة نوعًا من المراوغة السياسية التي تهدف إلى استثارة أبي قابوس، وتحويل غضبه على الشاعر إلى أسف على فراقه، ونقل التنافس بين الدولتين من الصراع السياسي إلى تنافس أدبي يهدف إلى استمالة ود أبي قابوس. ولهذا السبب، لم يقطع النابغة الذبياني صلته بالحيرة، بل ظل يوازن بين مدح الأمير الغساني والاعتذار للنعمان. وقد يكون هناك سبب آخر لحرص النابغة الذبياني على الارتباط بالنعمان، وهو أن بني ذبيان لم يكونوا يتورعون عن غزو الغساسنة، إذ كانوا يغيرون على مراعيهم ويستولون على ما يجدونه من إبل وشاء. وبهذه الإغارات، كانوا يحمّلون النابغة الذبياني أوزارهم ويضطرونه إلى استرضاء الغساسنة، مما جعل مكانته بينهم قلقة ومزعزعة. لذلك، كان الشاعر يترقب فرصة سانحة لاسترضاء النعمان والعودة إليه.
وقد سنحت الفرصة عندما شفع للنابغة عند أبي قابوس رجلان من بني فزارة، حيث صحبا الشاعر متخفيًا إلى الحيرة، ثم دسّا للأمير جارية تغني بأبيات من شعر النابغة الذبياني. فلما سمع غناءها قال: “أقسم بالله إنه لشعر النابغة”، ثم صفح عنه. وقيل إن سبب عودته إلى النعمان بعد هربه منه هو أنه بلغه أن الأمير عليل لا يُرجى شفاؤه، فأقلقه ذلك ولم يتمالك صبره على البعد عنه في مرضه، وخاف عليه وأشفق مما قد يحدث له، فتوجه إليه ووجده محمولًا على سريره يُنقل بين منطقة الغمر وقصور الحيرة.
ويغلب على ظن الباحثين أن النابغة الذبياني عاد إلى النعمان في عام ٦٠٠م أو بعده بقليل، لكن بقاءه عنده لم يطل، إذ قُتل النعمان عام ٦٠٢م، فاضطر الشاعر إلى مغادرة الحيرة والعودة إلى قومه في نجد، ثم توفي حوالي عام (٦٠٤م). وقال الدكتور عمر فروخ: «وتوفي النابغة الذبياني سنة ١٨ قبل الهجرة (٦٠٤م) قبل النعمان أبي قابوس بثلاث سنوات، وكان قد أسن جدًا».
عُرفت شخصية النابغة الذبياني بالأناة والرزانة وبعد النظر. وقد تهيأ له من الترف والثراء ما لم يتهيأ للكثير من شعراء عصره، لكن هذا الترف لم يفسده، ولم يدفعه إلى حوانيت الخمر وأسواق الشهوات. فقدّر فيه قومه وغيرهم من العرب رجاحة العقل، وسداد الرأي، والدقة في النقد، حتى إنهم ضربوا له قبة من أدم وحكّموه في الشعر، وبايعوه بإمرته. وعلى الرغم من اشتغاله بالسياسة، لم يؤثر عنه الغدر أو النفاق أو الكذب أو المصانعة. كما أن تقلبه بين المناذرة والغساسنة لم يحمله على إنكار فضل فريق لإرضاء الفريق الآخر، بل استطاع أن يحظى بمكانة خاصة لدى الطرفين. وتشير جميع أخباره وأشعاره الصحيحة إلى أنه كان سيدًا شريفًا من سادات قومه، فهو لا يتصرف بتصرفات امرئ القيس وطرفة وأمثالهما، بل يظهر بمظهر السيد الوقور ذي الخلق والشيم الكريمة.
ديوان النابغة الذبياني ومعلقته
يُنسب للنابغة الذبياني ديوان شعر رواه الأصمعي وابن السكيت، ثم أضاف الأعلم الشنتمري إلى رواية الأصمعي قصائد وأبياتًا أغفلتها ذاكرته. وقد رأى الدكتور طه حسين أن شعر النابغة الذبياني قد تعرض للتحريف والانتحال، وجعل المقياس في الحكم على صحة شعره هو موافقته لخصائص المدرسة الأوسية. كما رأى أن شعره البدوي أصح من شعره الحضري الذي يمدح فيه الملوك ويعتذر للنعمان. وقد خصص محقق الديوان فصلاً للشعر المنحول المنسوب إليه، ذكر فيه أكثر من سبعين بيتًا عُزيت إلى النابغة الذبياني. كما أحاط الدكتور محمد زكي العشماوي قصيدة “المتجردة” وغيرها من القصائد بسحب كثيفة من الشك. ومع ذلك، يظل القدر الأكبر من شعره، في نظر هؤلاء جميعًا، صحيحًا لا تشوبه شائبة من وضع أو تحريف.
يُعد أبرز ما يتضمنه ديوان النابغة الذبياني معلقته الشهيرة، وهي أطول قصائده وأكثرها جمعًا لأغراض الشعر، وأوفاها تعبيرًا عن حياة الشاعر وفنه. تقع القصيدة في تسعة وأربعين بيتًا، ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام:
أولها، وصف الأطلال، ويبدأ هذا الوصف بمخاطبة الديار وتحديد موقعها، وذكر الزمن الذي انقضى منذ أن فارقها الشاعر:
يا دار ميَّة بالعلياء فالسَّند *** أقْوَتْ وطال عليها سالفُ الأمدِ
وبعد مخاطبة الديار، يصف الشاعر وقوفه فيها وقت الأصيل، وقدمها، وخلاءها، وما أبقاه الزمن من معالمها، مثل مرابط الخيل، والنؤي المتهدم، وتأثير الأنواء والسيول في تراب هذا النؤي بعد رحيل أهلها.
أما القسم الثاني، فهو مخصص للناقة والصيد، ويقع في ثلاثة عشر بيتًا (من البيت ٧ إلى ١٩). في هذا القسم، يشبه النابغة الذبياني ناقته بثور وحشي تعاورته الرياح الباردة، وانهمر عليه مطر وبرد، ثم خاض معركة عنيفة خرج منها منتصرًا على كلاب الصيد الشرسة. وفي نهاية هذا القسم، يعود الشاعر إلى ناقته ليجعلها وسيلته التي توصله إلى النعمان، فيقول:
فتلك تُبلغني النعمانَ إنّ لهُ *** فضلاً على النَّاسِ في الأدنَى وفي البعَدِ
والقسم الأخير هو أطول الأقسام وأهمها، ويبلغ عدد أبياته ثلاثين بيتًا. يتضمن هذا القسم مدحًا واعتذارًا ووصفًا، تتداخل أبياته وصوره، مع اتكاء على القصص ومزج بين القصة والمدح. ومن هذه القصص خبر زرقاء اليمامة، وبناء تدمر بأيدي الجن بأمر من سليمان.
وأجمل ما في هذا القسم هو تصوير نهر الفرات بأسلوب فريد يختلط فيه الإعجاب بالخوف. وفي ختام القصيدة، يعتذر الشاعر للأمير، ويتبرأ مما نُسب إليه، ويصور جزعه الشديد من غضب النعمان.
الأغراض الشعرية في شعر النابغة الذبياني
حفل شعر النابغة الذبياني بموضوعات متعددة، كان أبرزها المدح والاعتذار، والرثاء، والهجاء، والوصف، والغزل.
١- المدح في شعر النابغة الذبياني
كان النابغة الذبياني على صلة وثيقة بملوك المناذرة والغساسنة، وقد عادت عليه هذه الصلة بما يحب في حياته، وبما يكره بعد وفاته، إذ ظفر بالثراء من الملوك وبالازدراء من النقاد.
قال ابن رشيق: «كانت العرب لا تتكسب بالشعر، وإنّما يصنع أحدهم ما يصنعه فكاهة أو مكافأة عن يد لا يستطيع أداء حقها، إلا بالشكر إعظاماً لها. حتى نشأ النابغة الذبياني، فمدح الملوك، وقبل الصلة على الشعر، وخضع للنعمان بن المنذر، وكان قادراً على الامتناع منه بمن حوله من عشيرته، أو من سار إليه من ملوك غسان، فسقطت منزلته، وتكسب مالاً جسيماً، حتى كان أكله وشربه في صحاف الذهب والفضة وأوانيه من عطاء الملوك.»
ومهما حاول الباحث أن يجد للنابغة مسوغًا يدفع به كلام النقاد، فإنه يعجز عن تبرئته من حب الإسراف والترف وبيع الشعر في سوق الرغبات. والشيء الوحيد الذي يُقرّب مسلكه من القبول هو شفاعته لقومه، إذ كان يشفع لصعاليك ذبيان كلما أغاروا على مرابع الغساسنة واستاقوا ماشيتهم، ويشفع لهم إذا أسرهم الغساسنة، ولا يجد في الشفاعة لهم سبيلًا غير المدح والتوسل والرجاء. وبذلك، ينطوي مدح النابغة الذبياني على منفعتين: خاصة وعامة. فالخاصة تعود عليه باليسار من الغساسنة والإكبار من ذبيان، والعامة ترد الأسرى إلى ذويهم.
ومن الحوادث التي تدل على مكانة النابغة الذبياني عند أمراء غسان وقادتهم أن النعمان بن الجلاح، أحد قادة الغساسنة، غزا بني ذبيان وأسر منهم، وكانت عقرب بنت النابغة بين الأسرى. فلما عرفها قال لها: «والله ما أحدٌ أكرم علينا من أبيك، ولا أنفع لنا عند الملك». ثم أكرمها وأطلق سراحها، وأتبعها بالأسرى من قومها إرضاءً للنابغة.
وقد رأى بعض الباحثين المحدثين أن النابغة الذبياني لم يكن يصدر في مدائحه الأولى عن طمع في المال، وإنما كان يمدح مدفوعًا بمقاصد كريمة، لكنه ذاق فيما بعد حلاوة العطاء فأطلق لسانه في المديح، وخص به الملوك لأنهم كانوا الأوفر مالًا والأغزر عطاءً. ولذلك، اتسمت الأفكار الشائعة في مدحه بالسمو والرفعة. فإذا مدح ملوك الغساسنة، نعتهم بالشجاعة وقيادة الجيوش، وسعة السلطان، والتفرد بالفضائل، والكرم العظيم، والعقول الراجحة، والتقلب على مهاد النعيم، كأنه يصف ما يصبو إليه هو:
إذا ما غزوا بالجيش حَلَّقَ فوقَهُمْ *** عصائب طير تهتدي بِعَصَائبِ
هم شيمة لم يُعْطِهَا اللهُ غيرهم *** من الجودِ والأَحْلامُ غَيرُ عَوازِبٍ
يصونونُ أَجْسَادًا قَدِيماً نَعِيمُها *** بخالِصَة الأردان خضر المناكب
وإذا مدح النعمان بن المنذر، بالغ في تعظيمه وجعله أقوى ملوك الأرض، فهو الشمس المشرقة والملوك كواكب صغيرة باهتة الضياء، فمتى بزغ نوره الوضاء تضاءلت واختفت:
ألم تر أن الله أعطاك سورة *** ترى كل مَلْكِ دُونَها يتذبذب
بأنك شَمْسُ والملوك كواكب *** إذا طلعت لم يَبْدُ مِنْهُنْ كُوكَبُ
وفي مدحه لابن الجلاح، يلح على فضيلة تحتاج إليها القيادة، وهي التفوق والسبق وتجاوز المنافسين. فقد سبق ابن الجلاح أقرانه كما يسبق الجواد الأصيل غيره، وتسنم مكانة عالية في المكارم فاقت مكانة معدّ في إكرام الأولياء والفتك بالأعداء، فكان فارس المحامد المتفوق في كل ميدان:
سبقت الرجال الباهشِينَ إلى العُلا *** كسبق الجَوادِ اصْطَادَ قَبْلَ الطواري
عَلَوْتَ مَعداً نائِلاً ونِكَايَةً *** فأنتَ لِغَيْثِ الحَمْدِ أَوَّلُ رَائِيا
وفي مدح هوذة بن أبي عمر العذري، يلح النابغة الذبياني على ذكر الفضائل التي يصف بها الملوك، فهوذة شريف عفيف كريم واسع الشهرة، يفضل إنس الحجاز وجنّها:
كان ابنُ أشْفَةَ طَيِّبَاً أَبْوَابُهُ *** عفاً شمائله غَزِيرَ النَّائِل
ربُّ الحِجَازِ سُهُولها وجبالها *** وأجلها من إنسها والخابل
والصفة المشتركة بين معانيه في مدائحه كلها هي المبالغة. وسبب هذه المبالغة أنه يوجه مديحه إلى ملوك وأمراء لا يرضيهم إلا التعظيم والتضخيم، ولا يؤذيهم الصدق في الحياة كلها كما يؤذيهم أن يصور الشعراء فضائلهم التي منحتها لهم الحياة مجردة من الهيبة التي خلعها عليهم السلطان.
٢- الاعتذار: بصمة النابغة الذبياني الشعرية
لو لم يكن الاعتذار غرضًا شعريًا جديدًا ابتكره النابغة الذبياني، لألحقناه بالمدح، لأنه في حقيقته لون من ألوانه. لكن الشاعر أطال فيه وفصل، وتفنن وتأنق حتى غدا غرضًا متفردًا بمن أبدعه، وهو النابغة الذبياني، ومتفردًا بمن قيل فيه، وهو النعمان بن المنذر، ومتفردًا بدوافعه وأفكاره.
أما الدوافع، فأهمها ندم الشاعر على مفارقة عظيم أجبره الحساد والوشاة على تركه، والرغبة الخفية في العودة إلى نعيم ذاق الشاعر حلاوته وشق عليه أن يخرج نفسه منه، والرهبة من نقمة تؤرق النابغة الذبياني وتقض مضجعه وتتركه فريسة لمخاوف تساوره بعنف لا يستطيع مغالبتها.
وأما الأفكار، فأبرزها تسويغ ما قاله الشاعر في مدح الغساسنة بأنه قال ما قال ليشكر من أكرموه. ومن ذا الذي يأخذ على الآخذ شكر المعطي، وينكر على الحامد إطراء المحسن؟ والنابغة الذبياني حين مدح الغساسنة دُعي فأجاب، شأنه شأن الشعراء الذين يسبحون بحمد النعمان صباح مساء:
ملوك وإخوان إذا مَا أَتَيْتُهُمْ *** أحَكَمُ في أَمْوَالِهِم وَأُقَرَّبُ
كفِعْلِكَ في قوم أَرَاكَ اصْطَنَعْتَهُمْ *** فَلَمْ تَرَهُمْ فِي شُكْرِ ذَلِكَ أَذْنَبُوا
ولا تخلو هذه الفكرة – على صحتها – من مراوغة ومساومة، فكأن النابغة الذبياني يقول للنعمان: أفض عليّ من خيرك ما تفيضه على صنائعك أعد إليك.
والفكرة الثانية هي تضخيم المخاوف التي تكتنف الشاعر، ووصف الهموم التي ركبته. فبعد أن فارق النعمان، عظمت مخاوفه حتى غدت كأنها حيات سود تتربص به، أو مخالب حادة مبثوثة في الظلام تريد أن تتخطفه وتلقي به تحت قدمي النعمان:
فَبِتْ كَأني سَاوَرَتْني ضَئِيلةٌ *** مِن الرُّقْش في أنيابها السُّمَّ نَاقِعُ
خطاطيف حُجن في حبال متينة *** تمد بها أيدٍ إليك نوازع
وما هذه السموم والمخالب والحبال في حقيقتها إلا ضغائن الحساد ومكايدهم، ورغباتهم في تقطيع الأواصر التي تربط الشاعر بالأمير.
أما الفكرة الثالثة، فهي خضوع الشاعر للأمير، وتصوير الفارق الكبير بينهما. فالشاعر طريد شريد ومتهم مظلوم مزقته ألسن الحساد بالوشاية، والأمير قاضٍ عادل يعرف كيف يرد الظلامة وينصف الظنين:
فإن أكَ مَظْلُومًا فَعَبْدُ ظَلَمْنَهُ *** وإن تك ذا عُتْبَى فَمِثْلُكَ يُعتبِ
والرابعة هي تعظيم سلطان النعمان، وجعله سيدًا قادرًا قاهرًا يبسط يده الباطشة على الدنيا كلها، فلا يفوته مطلوب ولا يجد الهارب منه مأمنًا يلوذ به:
فإنك كالليلِ الذي هو مُدْرِكي *** وإن خلت أن المنتأى عَنْكَ وَاسِعُ
والخامسة هي حلف الأيمان المغلظة بالكعبة المقدسة، ودماء الضحايا التي تراق على الأنصاب، وبالله الذي جعل مكة حرمًا آمنًا تأوي إليه الطير فلا يؤذيها أحد. يقسم الشاعر هذه الأيمان كلها ليثبت للنعمان بأنه لم يقل لفظة واحدة مما عُزي إليه، وإنما هي فرية مكذوبة قالها قوم يكرهونه، فكانت قولتهم أشد وقعًا على صدره من ضربة قاصمة تمزق كبده. ولو قال شيئًا يسيرًا من الكثير الذي رُمي به، لدعا على يده بالشلل حتى تعجز عن رفع السوط:
فلا لَعَمُرُ الذي مَسْحْتُ كَعْبَتَهُ *** وما هُرِيقَ على الأَنصابِ مِنْ جَسَدِ؟
والمؤمن العائذاتِ الطير يمسحها *** ركبانُ مكّة بين الغَيْل والسّعد
ما قلتُ مِنْ شَيْءٍ ما أتيت به *** إذن فلا رَفَعَتْ سَوْطي إليَّ يدي
إلا مقالة أقوامٍ شَقِيتُ بها *** كانَتْ مَقَالَتَهُمْ قَرْعَاً على الكَبِدِ
وفي هذه الأفكار ما يرضي غرور الأمير ويسل من نفسه الغضب والموجدة، ويقنعه بصدق الشاعر وندمه. والندم في نظر الأمير باب التوبة، والتوبة في نظر الشاعر طريق العودة. وهذه الأفكار المتسقة دليل على براعة النابغة الذبياني ودهائه، وحسن تأتيه للأمور، وتغلبه على المعضلات.
٣- الغزل في تجربة النابغة الذبياني
ذكر الرواة أن النابغة الذبياني لم يقل الشعر إلا بعد أن تقدم في السن. وفي هذا القول ما يفسر طبيعة غزله الذي طغى فيه التصوير الحسي على الانفعال الصادق، لافتقاره إلى التجربة والمعاناة، وحلت فيه ذكريات الهوى الباهتة محل صوره المتوهجة الحية. وقد أقر الشاعر نفسه بهذه الظاهرة عندما وقف على الأطلال، فهاجت الرسوم شجونه، وذكرته بأحبته، فسخر من الدموع في مآقيه، وراح يزجر نفسه عن الانغماس في اللهو وعن التصابي بعد أن رحل الشباب:
تكفكَفْتُ مِنِّي عَبْرَةً، فَرَدَدْتُها *** على النَّحْرِ مِنْهَا مُسْتَهَلَّ وَدَامِعُ
عَلَى حين عاتبت المشيب عَلَى الصَّبَا *** وقُلْتُ أَلا أَصْحُ والشَّيْبُ وَازِعُ
وربما وجد الشاعر في الانشغال بزيارة الكعبة ما يصرفه عن ملاعبة المرأة التي تفتن الرجل ببياض الوجه وكمال الجمال وطلاوة الحديث، لأن كهولة الشاعر نقلته من الغزل إلى العبادة:
غَرَاءُ أَكْمَلُ مَنْ يَمْشِي عَلَى قَدَم *** حُسْنَا وَأَمْلَحُ مَنْ حاوَرَتَهُ الكَلِما
حياك رَبِّي، فَإِنَّا لا يحل لَنَا *** لهو النَّسَاءِ، وإِن الدِّين قَدْ عَزَما
وإذا تسنى للشاعر الكهل أن يتصابى، وجدت في تصابيه مزيجًا من فطرة البدو النقية ورقة الحضر المترفة. أما فطرة البدو فتظهر في وصف الظعائن والوقفات القصيرة التي يختطف فيها الشاعر نظرات خاطفة من وجه صاحبته المسافرة. فإذا هي مشرقة كالشمس، عفيفة النظرات، تعطر العطر بأريجها الطاهر، وتطفئ البرق بنورها الوهاج:
رأيت نعماً، وأصحابي على عجل *** والعيسُ للبين قد شدّت بأكوار
بيْضَاءَ كالشَّمْسِ وَافَتْ يَوْمَ أَسْعُدِها *** لم تؤذِ أَهْلاً، ولم تفحش على جارٍ
والطيبُ يَزْدَادُ طيباً أن يكون بها *** في جيد واضِحَةِ الحَدينِ مِعْطار
ألمحةٌ من سنا برق رأى بصري *** أم وجهُ نُعْمِ بَدَا لي أمْ سَنَا نَارٍ
أما رقة الحضر فتبدو في الدالية المشهورة التي وصف بها النابغة الذبياني “المتجردة” وصفًا حسيًا مترفًا يليق بحليلة النعمان أو خليلته، لكنه يتجاوز المنظور إلى المحظور، فيسيء من حيث يريد الإحسان. ومن تصويره المترف غير الفاضح، وصفه لعنق المتجردة المحلى بعقد من نفيس الجوهر، وهي تطل من أستارها الشفيفة كالشمس في أوج مجدها. ومن يبصرها في تلك الحال يبتهج بمرآها ابتهاج صياد استخرج لؤلؤة نادرة من صدفة، أو ابتهاج من يبصر تمثالًا من مرمر نحته على أكمل صورة نحات بارع، ثم رفعه على منصة من الآجر، كما توضع تماثيل الآلهة في صدور المعابد:
والنَّظم في سلكٍ يُزَيِّنُ نحرها *** ذَهَب تَوَقَدُ كالشهاب الموقي
قامت تراءى بين سجفي كلَّةٍ *** كالشمس يومَ طُلُوعِها بالأسعد
أو دُرَّةٍ صَدَفيَّةٍ غواصها *** بَهِجٌ متى يَرَها يُهِلّ ويسجد
أو دميةٍ من مرمرٍ مرفوعةٍ *** بُنيت بآجرٍ يُشَادُ وقرمد
في هذه الأبيات تطغى الحضارة على البداوة، ويبدو النابغة الذبياني كمصور من مصوري اليونان، مما دعا بعض النقاد إلى الشك في نسبة القصيدة إليه، ودعا بعضهم إلى الظن بأنه لم يصف امرأة من بشر، بل وصف تمثالًا من حجر كتماثيل أفروديت التي كانت معروفة في مدن الشام المتأثرة بالحضارة اليونانية والرومانية، وهو ظن مرفوض مدحوض، فالقصيدة تنبض بالحياة المتفجرة من جسد حي، ينطوي على رغبات البشر، ويعجز فن النحت عن تفجيرها من المرمر.
٤- الوصف عند النابغة الذبياني والمدرسة الأوسية
يُعد النابغة الذبياني واحدًا من أبرز شعراء المدرسة الأوسية، إلى جانب الحطيئة وزهير وكعب. وقد عني شعراء هذه المدرسة عناية واضحة بالوصف الحسي الدقيق، وذكر التفصيلات الواقعية، وتسجيل جزئيات الموضوع، وصبغ المشاهد المرسومة بألوان زاهية قوية التأثير.
وربما كان النابغة الذبياني أبرع الشعراء في مدرسة أوس بن حجر، لأنه جمع بين الحضارة والبداوة، وأغنى خياله بمرئيات لم تقع عليها أبصار الشعراء الأعراب. غير أن موصوفاته متناثرة بين أغراضه الشعرية، ولا تنعقد منها موضوعات مستقلة يخصص لها الشاعر قصائد كاملة.
نستثني من ذلك أرجوزة قصيرة في وصف حية، مطلعها:
صُلُّ صفاً لا تنطوي من القصرْ *** طويلة الإطراق من غير خَفَرْ
وقد زهدنا في دراستها لأنها من شعره الذي تكتنفه سحب الشك والوضع. وخير منها صوره التي تنبث في تضاعيف مدحه واعتذاره، والتي تمثل بداوته وتحضره، وتفصح عن كثير من جوانبه النفسية.
من هذه الصور مشهد من مشاهد الأطلال، وصف فيه الرماد الذي اسود وصار كالكحل، والنؤي الذي غاصت حجارته في الرمال وتكسرت أطرافه، ومساحب الرياح التي غدت كالحصير الذي ينسج الحاكة لحمته وسداه:
رمادُ ككُحْل العَيْنِ لأياً أبينهُ *** ونُؤْي كجدم الحوض أَثْلَمُ خَاشِعُ
كأن مجرّ الرّامسات ذُيولَها *** عليهِ حَصِير نمّقته الصوانِعُ
وربما كان مشهد الصيد أجمل من صورة الأطلال، لأن النابغة الذبياني وفر له من عناصر التلوين والحركة ما جعله شبيهًا بشريط من الصور المتحركة.
بدأ الشاعر المشهد بالحديث عن ناقته التي تجتاز به الفلاة لتبلغه قصر النعمان، فجعلها لصلابتها وتفردها في السير وقت الهاجرة كالثور المتفرد عن القطيع. وهذا الثور أرقط منقط القوائم، ضامر البطن كالسيف الذي أحسن الحداد صقله. وكان قبل أن يبلغ منطقة (الجليل) قد تعرض في ليلة باردة لمطر غزير أرسلته سحابة سكوب، اجتمع في ودقها المطر الغزير والبرد الجامد:
كأنّ رحلي وَقَدْ زالَ النهارُ بِنَا *** يوم الجليل على مُسْتَأْنس وَحَدِ
مِنْ وَحْشِ وَجْرَة مُوشِي أَكارِعُهُ *** طاوي المصير كسيف الصَّيقل الفَردِ
أسْرَتْ عَلَيْهِ مِنَ الْجَوْزَاءِ سَارِيَةً *** تُزْجِي الشَّمَالُ عَلَيْهِ جَامِدَ البَرَدِ
ثم سرت في المشهد روح عنيفة حينما سمع الثور صوت صياد يحث كلابه المدربة، ففزع وبات في حال تسوء الصديق وتشمت العدو، اجتمع فيها الرعب والجوع. وفجأة، أطلق الصياد كلابه، فانطلقت نحو الثور، فعدا أمامها بقوائم صلبة، ليس في مفاصلها ترهل ولا استرخاء:
فارْتَاعَ مِنْ صَوْتِ كَلابِ فَبَاتَ لَهُ *** طُوعَ الشَوامِتِ مِنْ خَوْفٍ وَمِنْ صَرَدِ
فَبَثّهُنَّ عليه، واستمر به *** صُمْعَ الكُعوبِ بريئاتٍ مِنَ الحَرَدِ
اقتربت الكلاب من الثور، وكان أسبقها الكلب (ضُمرانُ)، فأغراه الصياد بالنزال، فنازل خصمه منازلة الشجعان، لكن شجاعته لم تجده نفعًا، إذ اخترق قرن الثور جسد الكلب من صدره إلى ظهره، فظهر رأس القرن في إبط الكلب كمبضع البيطار في ساق البعير. ومن نظر إلى جسد الكلب المعلق بقرن الثور ظنه ذبيحة أعدها قوم للشواء، فأدخلوها في السفود، وألقوها على الموقد ثم تشاغلوا عنها. هذا المشهد ألقى الرعب في قلوب الكلاب فتفرقت مذعورة، ولم يبق منها قرب الثور سوى ضمران الطعين، يحاول وهو معلق بما بقي فيه من روح أن يمضغ طرف القرن، ولكن هيهات، فقد كانت الطعنة قاتلة ولم يبق فيه من العزم ما يكفي لتحريك فكه، فراح يلفظ أنفاسه الأخيرة على رأس الثور المنتصر:
وكَانَ ضَمَّرَانَ مِنْهُ حيثُ يُوزَعُهُ *** طعَنَ الْمَعَارِكِ عِنْدَ الْمُحْجَرِ النُّجُدِ
شَكٍّ الفريصة بالمدْرَى فَأَنفَذَهَا *** طعْنَ الْمُبيطِرِ إِذْ يَشْفِي مِنَ العَضَدِ
كأنه خارِجَاً مِنْ جَنْبِ صَفْحَتِهِ *** سَفُودُ شَرَب نَسُوهُ عِنْدَ مُفْتأد
فظلَّ يَعْجُمُ أَعْلَى الرُّوقِ مُنْقَبِضَاً *** في حالِكِ اللَّوْنِ صَدْقٍ غيرِ ذِي أودِ
وحينما رأت الكلاب مصرع ضمران، ازدجرت، وسرى الخوف في أوصال (واشق) صاحب ضمران، فارتد عن الثور بعد أن حدثته نفسه بالثأر، وقال في نفسه: ما فائدة الانتحار في موضع لا تجدي فيه الشجاعة اليائسة، ولا مطمع فيه لكلب أو صياد؟ فأحجم:
لما رأى وَاشِقٌ إِفْعَاصَ صَاحِبِهِ *** ولا سبيل إلى عقل ولا قودِ
قالَتْ لَهُ النَّفْسُ إني لا أرى طمَعاً *** وإن مَولاكَ لَم يَسْلَمْ وَلَمَّ يَصِدِ
بعد هذا الوصف المفصل للثور والكلاب، يعود النابغة الذبياني إلى ناقته ليقرنها بهذا الثور المنتصر، ويقول: «فتلك تبلغني النعمان». ومثل هذا الاستطراد كثير في شعر النابغة الذبياني، لكنه لا يضعف وحدة الموضوع، ولا يفكك الأفكار، بل يكسبها نوعًا من العمق. لأن الشاعر بعد أن يعرض الفكرة المجردة، يُدخل القارئ في بهو كبير تتصدره صورة عريضة، رسم فيها الشاعر مشهدًا يكمل الفكرة، أو ينقلها من عالم التجريد إلى عالم الحس. فإذا انتهى الشاعر من تصويرها والقارئ من تصورها، عاد الشاعر إلى الفكرة ليصل آخرها بأولها.
ومن صوره العريضة التي توضح هذه الظاهرة صورة الفرات التي رسمها الشاعر وهو يمدح النعمان ويعتذر له، ويصفه بالقوة والكرم. فقد التفت الشاعر عن الممدوح إلى الفرات، فإذا بالرياح تثير فيه الأمواج الضخمة، فتندفع رؤوس الأمواج غاضبة صاخبة، وتلقي بالزبد على شاطئيه، وإذا بالسيول المنحدرة إلى النهر من كل جانب تحمل حطام الشجر والأعشاب. وبين الماء الوافد على النهر والماء المتوثب منه، تترنح على الأمواج سفينة يحار ملاحها في قيادتها، ويزيده الخوف من الموج ارتباكًا، فيتشبث بسكان السفينة، ويستفرغ في قيادتها جهده، ويبلغ منه الإعياء مبلغه، لعله يشق طريقه بين الموج. حتى إذا بدأ الخوف يسري من نفس الملاح إلى نفس القارئ، التفت النابغة الذبياني إلى النعمان، فإذا هو ضاحك مستبشر، يبسط يده للمحتاجين، فيتدفق منها مال أغزر من ماء الفرات، وخير دائم لا ينقطع في يوم من الأيام:
فَمَا الفُراتُ إِذا جَاشَتْ غَوَاربُهُ *** تَرْمِي أَوَاذِيتُهُ العِبرَين بالزبد
يمدُّهُ كل وادٍ مُترع لجبِ *** فيه ركام من الينبوتِ والخَضَدِ
يُظل مِنْ خَوْفِهِ المَلَاحَ مُعْتَصِماً *** بالخيزرانة بَعْدَ الايْن والنجد
يَوْمَا بِأَجْوَدَ مِنْهُ سَيبَ نافلة *** ولا يحُولُ عطاءُ اليوم دون غدِ
من هذه الصور ومن صورة المتجردة التي وردت في غزل النابغة الذبياني، يظهر أن الاستطراد المطول يتيح للنابغة أن يوفر للمشهد حقه من الرسم. فهو لا يقنع من الرسم بتشبيه سريع أو استعارة عابرة، بل يقف أمام اللوحة التي رسمها وقفة متأنية، تسمح له بتلوين الصورة، وتحريكها، والتدقيق في جزئياتها، وتسخيرها لخدمة الفكرة، وتحميلها ما تحمل نفس الشاعر من مشاعر الحب والخوف والرجاء. وحسبك دليلًا على ما نقول صورة الفرات التي جعل فيها نفسه الملاح الخائف من وعيد النعمان، الطامع في كرمه، الغارق في نعمه، المستبشر بعفوه، وجعل حساده والوشاة رياحًا تحاول أن تثير غضب النعمان وتدفعه إلى الانتقام من النابغة، فيلقيها النعمان عن جانبيه كما يلقي الفرات الزبد والغثاء، ويبقى كما عهده الناس كريمًا دفاقًا يفيض خيره على الناس أجمعين.
ومن الغريب أن يحكم بعض الدارسين المحدثين على وصف النابغة الذبياني بالجمود وجفاف العواطف، فيقول: «إلا أن وصف النابغة لا يخلو من جمود وجفاف أحيانًا. فقلما تمتزج نفسه بموصوفاته، وقلما تجد في الطبيعة ما يثير انفعالاته العميقة، فهو نوعًا ما جامد أمام المشاهد التي يصفها». وهذا الحكم يغمط حق الرجل، فقد رأيت كيف حلّت نفسه وهو يصف الفرات، ورأيت كيف تحسس مشاعر الثور وأبرز زهوه، وكيف أبرز أحاسيس ضمران وواشق ونقل إليك الخوف واليأس والاستسلام. غير أن النابغة الذبياني لا يترجم العواطف بألفاظ مباشرة أو بأسلوب مبتذل، بل يبث العواطف في الخطوط والألوان والحركات والظلال، ويكلف القارئ باستنباطها.
تأمل صورة المتجردة، وقد فاجأها رجل غريب، ينقل بين مفاتنها بصرًا نمامًا متطفلًا، فيسقط خمارها عن وجهها من المفاجأة والارتباك، فتواري – وهي خائفة خجلة – سحر الوجه باليد، وتأبى المحاسن أن تحتجب، فترسل في عيني الغريب نظرات تجمع بين الخوف والتوسل، والزهو والتواضع، والإغواء والزجر، والندم والاستسلام، والتأنيب والترغيب، وهي صامتة لا تبوح بكلمة أو نأمة:
سقط النَّصِيفُ وَلَم تُرِدْ إِسْقَاطَهُ *** فتناولَـتْـهُ واتْقَتْنا باليد
نظَرَتْ إليكَ بحَاجَةٍ لَمْ تَقْضِها *** نظر السقيمِ إلى وُجُوهِ العُوَّدِ
فكيف يوصف وصف كهذا بالجمود والجفاف؟
٥- الرثاء الرسمي في شعر النابغة الذبياني
كان الرثاء في شعر النابغة الذبياني رثاءً رسميًا في أغلب الأحيان، يندب فيه الشاعر الأمراء ليقضي حقهم عليه. فيذكر محامد الفقيد، وينوه بمجده الأصيل، ثم يلجأ إلى الحكمة التي تنصح الناس بقبول الموت لأنه قدر مقدور لا مهرب منه. وقد يدعي الزهادة في الحياة بعد رحيل الأمير، لأن حياته بعد ذوي الفضل تصبح ضجرًا قاتلًا. وردت هذه الأفكار في رثاء النعمان بن الحارث بن أبي شمر، إذ قال فيه:
فإن تكُ قَدْ وَدَعْتَ غَيْرَ مُذَمَّم *** أواهيَ مُلْكِ، ثَبتتها الأوائلُ
فلا تَبْعَدَنُ إن المنيَّةَ موعد *** وكُل امرى يوماً به الحال زائلُ
فإن تحيَ لا أَمْلَلْ حَيَاتِي، وإِنْ تَمُتْ *** فما في حَياةٍ بعدَ مَوْتِكَ طَائِلُ
وفي الرثاء، يؤخذ على النابغة الذبياني أنه كان يذكر المريض بالموت ويرثيه وهو حي. فقد بلغه أن أبا قابوس مريض لا يُرجى شفاؤه، فدعا له بالشفاء، ثم خوّفه من الموت، وخوّف الناس مما سيحل بهم من فقر وشر بعد موته، لأن قاصدي الأمير – والنابغة الذبياني منهم – سوف يُردون عن باب الإمارة خائبين. وفي هذا المعنى ما فيه من نزعة نفعية بغيضة، يحركها الطمع لا الوفاء:
وَنَحْنُ نُرَجِّي الخُلدَ إِنْ فَازَ قِدْحُنا *** وَنَرْهَبُ قِدْحَ الموتِ إن جاء قامِرا
لك الخير إِنْ دارَتْ بِكَ الأَرضُ وَاحِداً *** وأصبح جدُ النَّاسِ يَظْلَعُ عَاثِرا
ورُدَّت مطايا الرّاغبين، وعُرِّيَتْ *** جيادك، لا يخفي لها الدهرُ حَافِرا
ويعتبر الرثاء بصورة عامة دون الأغراض الأخرى في شعر النابغة الذبياني من حيث القدر والمقدار.
٦- الهجاء في ديوان النابغة الذبياني
يُعتبر الهجاء، مثله مثل الرثاء، ضئيل الحضور في شعر النابغة الذبياني، إذ يرد في تضاعيف المدائح والاعتذاريات حين ينعطف الحديث بالشاعر إلى ذكر الخصوم، فيقرعهم، ويزدري بافترائهم الكذب عليه، ويصف مثالبهم كقبح الوجوه، وبذاءة الألسنة، والولوغ في أعراض الناس بالباطل، كقوله:
لعمرِي وَمَا عَمْرِي على بهِّينٍ *** لقَدْ نَطَقَتْ بُطْلًا عَلَى الأَقَارِعُ
أقارعُ عَوْفٍ لا أُحَاوِلُ غيرها *** وجوه قرودٍ، تَبْتَغِي مَنْ تُجادَعُ
ويرد الهجاء أحيانًا أخرى في مقطعات قصيرة يهدد بها خصومه بشعر كالجمر لا يطيقون مسه، كقوله في حزيم وزبان ابني سيار اللذين فضلا شعر بدر بن حذار على شعره:
أَلا مَنْ مُبْلِغُ عَنِي حُزَيْماً *** وزبان الذي لم يَرْعَ صِهْرِي
فإياكم وَعُوراً دامیاتٍ *** كأنّ صلاءَ هُنَّ صلاء جمْرِ
فإني قد أَتاني ما صَنَعْتُم *** ومارشَّحْتُم مِنْ شِعر بَدْرٍ
لكن هجاءه يظل في الحالين دون أغراضه الأخرى من حيث الجودة والتصوير والتأثير، لأن النابغة الذبياني لم يؤت الطبع الحاد والميل إلى العدوان والتفرغ لتتبع العورات وقذف الناس، فجاء هجاؤه فاترًا، وكان أقرب إلى التحذير والوعيد، وخلا من الضربات الموجعة، وإن لم يخل من التصوير الساخر، كجعله عيينة بن حصن بعيرًا يخاف وقع الأصوات فينفر منها، ونعامة حمقاء خرقاء سريعة الهرب:
كأنك من جمال بني أُقَيشٍ *** يقعقعُ خلف رجلَهِ بشنِّ
تكون تمامةً طَوْراً، وَطَوْراً *** هُوي الريحِ تنسج كلَّ فنِّ
منزلة النابغة الذبياني وخصائصه الفنية
كاد المتقدمون من النقاد يُجمعون على تقديم النابغة الذبياني على سائر الشعراء، فسلكه ابن سلام في شعراء الطبقة الأولى، واحتج بأقوال من فضلوه على أقرانه من شعراء هذه الطبقة، وهم: زهير وامرؤ القيس والأعشى. ومن هذه الأقوال:
(كان أوس فحل مضر، حتى نشأ النابغة وزهير، فأخملاه).
ويروى أن عمر بن الخطاب قال: «أي شعرائكم يقول:
فلَسْتَ بِمُسْتَبْقِ أَخَا لَا تَلُمُّهُ *** على شَعَثٍ، أَيُّ الرِّجالِ المُهَذَبُ
قالوا: النابغة. قال: هو أشعرهم.»
وجاء في الأغاني: «قام رجل إلى ابن عباس فقال: أي الناس أشعر؟ فقال ابن عباس: أخبره يا أبا الأسود. قال: الذي يقول:
فإنك كالليلِ الَّذِي هُوَ مُدْرِكي *** وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ المنتَأَى عَنْكَ وَاسِعُ»
وجاء في العمدة: «وأما النابغة فقال من يحتج له: كان أحسنهم ديباجة شعر، وأكثرهم رونق كلام، وأذهبهم في فنون الشعر، وأكثرهم طويلة جيدة، ومدحًا وهجاء وفخرًا وصفة…»
وكل قول من هذه الأقوال يتناول جانبًا من شعر النابغة الذبياني، فكلمة عمر ترجح شعره لحكمته وحلمه، وكلمة أبي الأسود ترجحه لخياله الواسع وإحساسه الصادق، والكلمة الأخيرة تفضله لخصائصه الفنية. فما هي أهم هذه الخصائص؟
لعل أهمها التنقيح، ورسم الصور الواقعية، والعناية برسم الألواح العريضة، والاستعانة بالسرد القصصي.
١- الصنعة والتنقيح: طُبع شعر النابغة الذبياني بطابع المدرسة الأوسية التي تعنى بتنقيح الشعر، واختيار اللفظ، والتأنق في الصياغة، والزهد في الغريب الوحشي، وموازنة الجمل، وتزيين المعاني بوشي المطابقة والمقابلة، كقوله في الشكوى، وقد طابق بين الهم الخفي والهم الظاهر، وبين الورود والصدور:
كتمتك ليلًا بالجمومين سَاهِراً *** وهمين هما مُسْتَكِناً وَظَاهِر
أحَادِيثَ نَفْسٍ تَشْتَكِي ما يريبها *** وورد همومٍ لن يجدنَ مَصادِر
ولهذه الصناعة اللفظية جمال من نمط آخر، هو حلاوة الإيقاع، وعذوبة الجرس، وتناغم الحروف في الألفاظ المتجاورة، وملاءمة الوزن للفكرة. فقد رأيت كيف اختار الوزن الرحب الهادئ في البيتين السابقين للحديث عن همه. فلما وصف المتجردة، تخير لها بحرًا راقصًا متدافع النغم، وأكثر من الألفاظ الرشيقة، ولم يغفل التقطيع الموسيقي، والمقابلة بين جزئي البيت، كقوله:
أو دُميَةٍ مِنْ مَرْمَرٍ مَرْفُوعَةٍ *** بُنيت بآجرٍ يُشادُ وقرْمَدِ
لا واردٌ منها يحورُ لمصدرٍ *** عَنْها ولا صدرٌ يحورُ لموْردِ
٢- الواقعية في رسم الصور الحسية: يكثر النابغة الذبياني من رسم الصور الواقعية التي تصافح أبصار الناس وأسماعهم. فالكلب المعلق بقرن الثور كالشواء الذي اعتلقه سفود، والنسور الجاثمة خلف الجيش تنتظر الفرائس كالشيوخ في ثياب المراتب، ووجه صاحبته نعم لمحة من سنا برق، وصوت أنياب الناقة حين تحتك كأنه “صريف القعو بالمسد”، أي كأنه احتكاك البكرة بالحبل.
٣- رسم الألواح العريضة: جاوز النابغة الذبياني التشبيهات والاستعارات الجزئية غير المؤتلفة، ورسم صورًا عريضة متكاملة الأجزاء، كان يبدؤها بتشبيه بسيط، ثم يلتفت عن المشبه إلى المشبه به ليفصل في الحديث عن قسماته وسماته وليمد أطراف الصورة يمينًا ويسارًا.
شبه نفسه حينما بلغه غضب النعمان عليه بلديغ، وثبت عليه حية رقطاء شديدة السم. ولما كان العرب يعتقدون أن النوم يساعد على تفشي السم في الجسم، فقد كانوا يعلقون الأساور والأجراس في يدي اللديغ ليمنعوه من النوم، فيبقى مؤرقًا الليل كله. وهذه الحية ذات سم ناقع يعجز الأطباء عن مغالبة سمها ورد طغيانه عن اللديغ:
فبتُّ كَأَن سَاوَرَتْني ضَئِيلَةٌ *** من الرقش في أنيابها السُّمُ نَافِعُ
يُسهَّدُ مِنْ لَيْلِ التَّمَامِ سَلِيمُها *** لحلى النِّسَاءِ في يديهِ قَعَاقِعُ
تناذرها الرَّاقون من سُوءٍ سُمِّها *** تطَلِّقه طَوراً، وطوراً تُراجعُ
وأجمل من هذه الصورة وأوسع هي صورة الفرات التي مرت بك سابقًا في الحديث عن الوصف.
٤- الاستعانة بالسرد القصصي: لوّن النابغة الذبياني شعره بالسرد القصصي، فأغناه وأحياه وأكسبه عمقًا فكريًا، وأمده بتجارب إنسانية. وقصصه على نوعين: قصص واقعية وقصص رمزية.
فالواقعية تُستمد من تاريخ العرب وأخبارهم، كقصة زرقاء اليمامة التي مر بها سرب من القطا، فقدرت أن عدده ست وستون قطاة. وتقول القصة إن السرب وقع في شبكة صياد، فإذا عدته كما ذكرت زرقاء اليمامة. أخذ النابغة الذبياني هذه القصة ليعظ بها النعمان، وليحذره من كيد الحساد، عسى أن يكون صادق الحس، دقيق النظر، خبيرًا بالنفوس:
احكُمْ كَحُكْمِ فَتَاةِ الحَيِّ إِذْ نَظَرَتْ *** إلى حمامٍ شراعٍ واردِ الثَّمَدِ
والرمزية مستمدة من أساطير العرب. والعرب كغيرهم من شعوب الأرض، لهم تراث من أخبار وأساطير صاغوا منها أمثالًا واستنبطوا منها عبرًا. لكن الجديد في صنيع النابغة الذبياني أنه نظم بعض هذه الأساطير شعرًا، وجعل أبطالها من البشر والحيوانات، وأجرى الحوار على ألسنة الفريقين، كأقصوصة الحية التي سردها في اثني عشر بيتًا، ليعاتب بني مرة الذين تحالفوا عليه وعلى قومه، وليحذرهم من الغدر به كما غدر حليف الحية. وخلاصة الأسطورة أن أعرابيًا حالف حية قتلت أخاه على أن تؤدي إليه دينارًا كل يوم، ويتنازل عن ثأر أخيه. ثم ندم وهمّ بقتل الحية فرماها بالفأس، فأخطأها. قال النابغة الذبياني:
وَإني لألقى مِنْ ذوي الضّغنِ منهم *** وَمَا أَصْبَحَتْ تَشْكُو مِنَ الوَجْدِ سَاهِرَة
كما لَقِيَتْ ذاتُ الصَّفَا مِنْ حليفها *** وما انفكتْ الأَمْثَالُ في النَّاسِ سَائِرَة
خاتمة
وفي الختام، يتجلى من خلال هذا التحليل الشامل أن شخصية النابغة الذبياني وشعره يمثلان علامة فارقة في تاريخ الأدب العربي الجاهلي. فلم يكن النابغة الذبياني مجرد شاعر فحل، بل كان دبلوماسيًا بارعًا ورائدًا في فنون شعرية أرساها بنفسه. لقد صهر النابغة الذبياني في بوتقة واحدة تجاربه الحياتية المتقلبة بين البداوة والحضارة، وعلاقاته المعقدة مع ملوك الحيرة وغسان، ليخرج لنا إرثًا شعريًا فريدًا.
إن براعة النابغة الذبياني لا تكمن فقط في جودة مدائحه أو رقة غزله، بل في قدرته على ابتكار غرض “الاعتذار” وتحويله إلى فن قائم بذاته، كاشفًا عن عمق نفسي وبراعة في استمالة القلوب والعقول. كما أن فنه الوصفي، المتميز برسم اللوحات العريضة والاستعانة بالسرد القصصي، قد رفع من شأن القصيدة الجاهلية ونقلها إلى آفاق جديدة من التصوير الفني.
بذلك، استحق النابغة الذبياني مكانته الرفيعة التي أجمع عليها النقاد قديمًا وحديثًا، ليظل اسمه رمزًا للشاعر السيد، الذي وظف موهبته ليس فقط لكسب العيش والجاه، بل للدفاع عن قومه وترسيخ مكانته كصوت لا يُستهان به في عصره، تاركًا بصمة لا تُمحى تؤكد أن شعر النابغة الذبياني سيبقى مصدر إلهام ودراسة للأجيال القادمة.